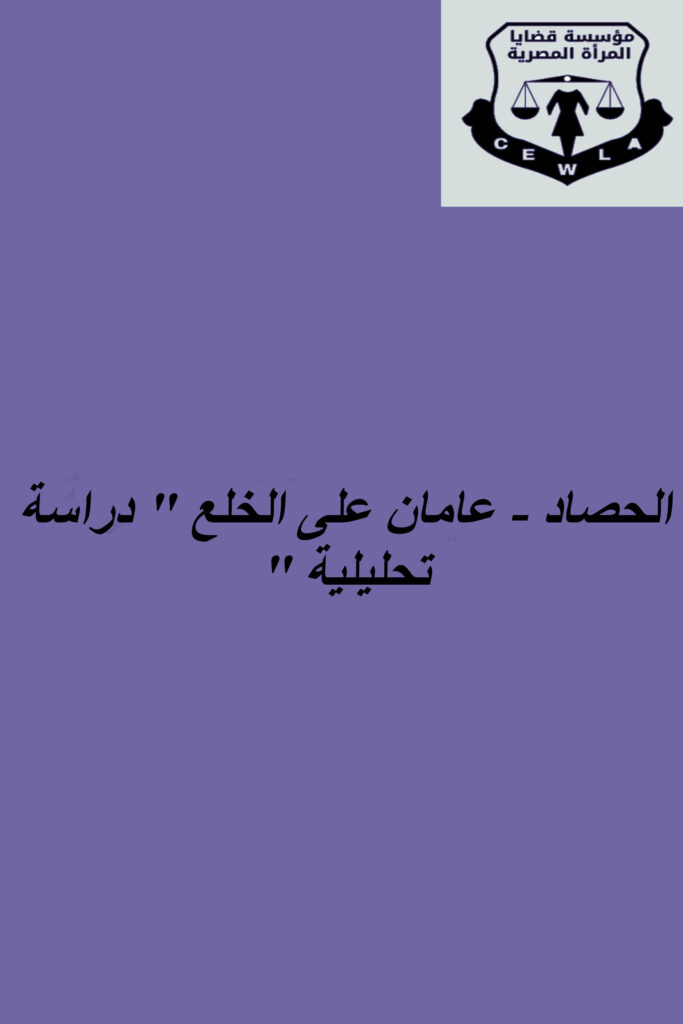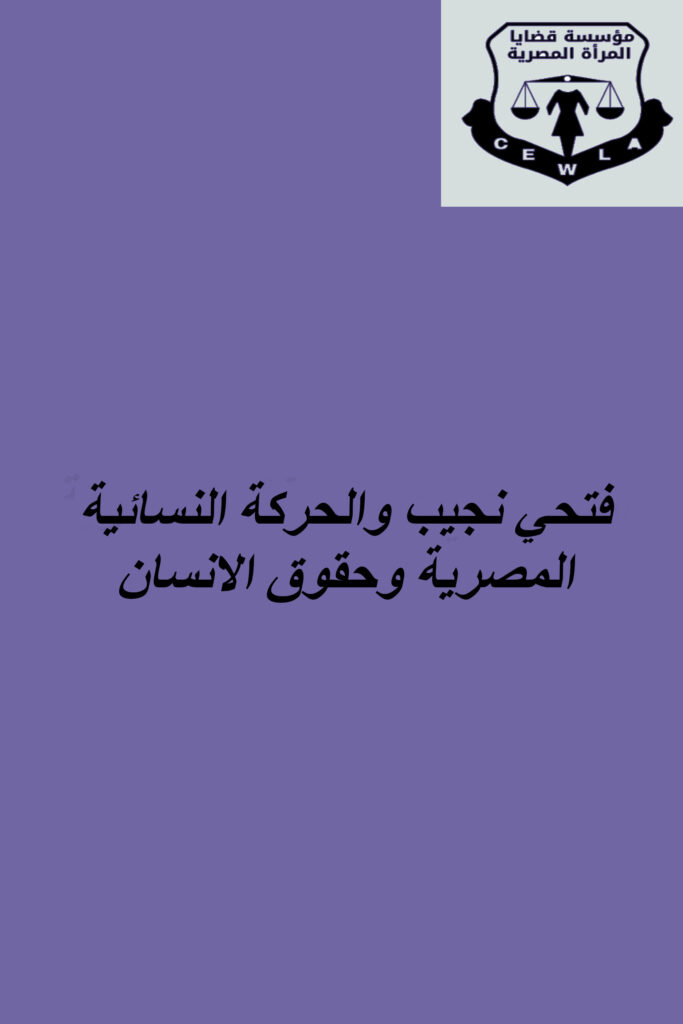الجنسانية في النظرية والتاريخ
نظرية السياسات الجنسية *
إن حالات الوصف الجنسي الثلاث التي بحثنا فيها حتى الآن جديرة بالملاحظة بسبب الحيز الكبير الذي احتلته مسألة الصعود والسلطة في كل منها. لا يمكن القول بأن الجماع يحدث في فراغ، فرغم كونه يبدو في حد ذاته نشاطًا بيولوجيًا وجسديًا، إلا أن موقعه عميق في السياق الأوسع للشئون الإنسانية بحيث يمكن اعتباره عالمًا مصغرًا لمختلف المواقف والقيم الخاصة بثقافة بعينها، وضمن أمور أخرى يمكن أن يمثل نموذجًا للسياسات الجنسية على المستوى الفردي أو الشخصي. لكن الانتقال من مساحات الحميمية إلى الساحة الأوسع للسياق السياسي هو بالطبع خطوة كبيرة. فعندما نطرح مصطلح “السياسات الجنسية” يجب أولاً أن نجاوب على سؤال يفرض نفسه “هل يمكن النظر إلى العلاقة بين الجنسين في ضوء السياسة من الأساس؟” وتعتمد الإجابة على كيفية تعريفنا لكلمة السياسات (politics).(1) إن هذا المقال لا يعرِّف السياسة باعتبارها ذلك العالم الضيق والمقتصر على الاجتماعات والرؤساء والأحزاب، بل المقصود بمصطلح “السياسات” هو علاقات القوى والترتيبات التي تستخدمها جماعة للتحكم في جماعة أخرى. ويمكن أن نضيف بين قوسين أنه، رغم إمكانية اعتبار السياسة الفضلي هي تنظيم الحياة الإنسانية حول مبادئ ملائمة ومنطقية، بحيث يمكن إلغاء فكرة السلطة التي يمارسها البعض على الآخر، إلا أنه يجب علينا أن نعترف أن ذلك لا يعكس السياسة كما نعرفها، وأن هذا هو الأمر الذي يجب أن نتناوله. والعرض التالي، والذي يمكن أن نصفه بأنه “ملاحظات نحو نظرية الأبوية”، سيسعى إلى إثبات أن الجنس هو حالة ذات تبعات سياسية. وحيث أن هذا جهد أولي، فإنه لابد وأن يكون مؤقتًا وغير كامل. وحيث أن النية هي تقديم وصف عام فإن الأطروحات لابد وأن تكون عامة، كما لابد وأن نتجاهل الاستثناءات، كما سوف تتقاطع العناوين، التي بدورها سوف تتسم بالعشوائية. نذكر هنا كلمة “السياسات” حين نتحدث عن الجنسين. أولاً، لأن مثل هذه الكلمة مفيدة في تحديد الطبيعة الحقيقية لوضعهما النسبي والتاريخي وفي الوقت الحاضر. ومن المناسب، بل ومن الضروري في الوقت الحالي، أن نبتكر علم نفس وفلسفة أفضل لعلاقات القوى تتجاوز الإطار النظري البسيط المطروح في السياسات الرسمية التقليدية. بل قد يكون من الضروري أن نولي بعض الانتباه إلى وضع نظرية سياسية تتعامل مع موازين القوى على أسس أقل تقليدية من تلك التي اعتدناها.2 لذلك فقد وجدت أنه من المهم أن نعرفها على أساس الاتصال الشخصي والتفاعل ما بين الأفراد في جماعات محددة وواضحة المعالم: الأعراق والطبقات والطوائف والجنس. ذلك أنه تحديدًا بسبب غياب تمثيل بعض الجماعات في عدد من الهياكل السياسية المعترف بها، يبقى وضعها ثابتًا وقمعها مستمرًا. ففي أمريكا أجبرتنا الأحداث الأخيرة على الاعتراف أخيرًا بأن العلاقة بين الأعراق هي بالفعل علاقة سياسية تشمل التحكم العام لجماعة محددة بالميلاد، في جماعة أخرى محددة أيضًا بالميلاد. صحيح أن ظاهرة الجماعات التي تسيطر بحكم الميلاد تخبو سريعًا، ولكن مع ذلك تبقى هناك منظومة شديدة القدم والعالمية لهيمنة مجموعة ما على أخرى بحكم ميلادها، وهي المنظومة السائدة في مجال الجنس. وقد أقنعتنا دراسة العنصرية بوجود علاقة سياسية فعلية بين الأعراق تكرس سلسلة من الظروف القمعية، حيث لا تحظى الجماعة الأدنى على الإنصاف اللازم من خلال المؤسسات السياسية القائمة، ومن ثم تُمنع من تنظيم نفسها في أشكال النضال والمعارضة السياسية التقليدية. وبنفس الطريقة تقريبًا فإن فحصًا موضوعيًا لمنظومة العلاقات الجنسية يوضح أن الوضع بين الجنسين الآن وعبر التاريخ شبيه بتلك الحالة التي وصفها ماكس فيبر Max Weber بأنه وضع سيادة أي علاقة من الهيمنة والامتثال.3 الأمر الذي يظل بدون دراسة، بل وغير معترف به في كثير من الأحوال (رغم اتخاذه شكلاً مؤسسيًا) في نظامنا الاجتماعي هو الأولوية المكتسبة بالميلاد والتي تسمح للذكور بالتحكم في النساء. من خلال هذا النظام تحقق شكل مبتكر من “الاستعمار الداخلي”، وهو شكل يميل إلى أن يكون أكثر فاعلية ودقة من أي شكل من أشكال التمييز، وأكثر صرامة من التقسيم الطبقي، وأكثر انسجامًا في ذاته وبالتأكيد أكثر ديمومة. وبغض النظر عن تواري ظهوره في الوقت الحالي، إلا أن الهيمنة الجنسية تسود رغم ذلك باعتبارها أكثر الأيديولوجيات انتشارًا في ثقافتنا، إذ تطرح مفهوم السلطة باعتباره لب كينونتها. الأمر كذلك لأن مجتمعنا، مثل كل الحضارات التاريخية، مجتمع أبوي.4 وتتضح هذه الحقيقة فورًا إذا تذكرنا أن الجيش والصناعة والتكنولوجيا والجامعات والعلوم والمناصب السياسية والمالية، أي باختصار كل مجالات السلطة في المجتمع، بما في ذلك سلطة الشرطة القمعية، تقع كلها في أيد الذكور. وحيث أن جوهر السياسة هو السلطة، فإن إدراكنا هذا لا يخلو من أثر. وكل ما تبقى من سلطات ما وراء الطبيعة، ورجال الدين و”قساوسته”، بالاشتراك مع الأخلاقيات والقيم والفلسفة وفنون ثقافتنا، أي الحضارة ذاتها، كما أشار تي إس إليوت T. S. Eliot ذات مرة، هي كلها من صناعة الذكور. فإذا اعتبرنا أن الحكومة الأبوية هي المؤسسة التي بواسطتها يتحكم نصف السكان من الذكور في نصف السكان من الإناث، سوف يبدو أن مبادئ الأبوية تنقسم إلى عنصرين: الذكور سوف يتحكمون في الإناث، وكبار السن من الذكور سوف يتحكمون في الذكور الأصغر منهم سنًا. ومع ذلك، ومثلما هو الحال في أية مؤسسة بشرية، كثيرًا ما توجد مسافة ما بين الواقع والمثالي، أي توجد تناقضات واستثناءات داخل هذا النظام. فعلى حين نجد أن الأبوية كمؤسسة هي بمثابة عنصر اجتماعي ثابت وذي جذور عميقة بحيث تتخلل كافة الأشكال السياسية والاجتماعية والاقتصادية الأخرى، سواء كانت الطائفة أو الطبقة، الإقطاع أو البيروقراطية، مثلما تتخلل كل الأديان الكبرى, إلا أنها شهدت أيضًا تباينات كبيرة عبر التاريخ والمكان. ففي ظل الديمقراطية،5 على سبيل المثال، قلما تولت الإناث مناصب، وحين فعلن (مثلما يحدث الآن) فبأعداد صغيرة للغاية حتى أنها لا ترقى إلى التمثيل الرمزي. ومن ناحية أخرى، نجد أن الأرستقراطية، ومع تأكيدها على السمات السحرية والجذابة للسلالة وصلة الدم، قد تسمح أحيانًا للنساء بامتلاك السلطة. أما مبدأ الحكم بواسطة الذكور الأكبر سنًا فكثيرًا ما يتم تجاوزه. فإذا وضعنا في الاعتبار التباين ودرجات الأبوية – على سبيل المثال بين السعودية والسويد، أو إندونيسيا والصين الحمراء – فسوف يتضح لنا أن نظامنا الخاص في الولايات المتحدة وأوروبا تبدل وأصبح أكثر وهنًا وضعفًا بسبب الإصلاحات والتي سيتم تناولها في الفصل التالي. وفيما يلي مظاهر الأبوية.لاحظت هانا أرندت Hannah Arendt أن الحكومة تستند إلى السلطة إما مدعومة، بالتوافق عليها, أو مفروضة، بواسطة العنف.6 وما يحدث في الحالة الأولى هو التكيف مع الأيديولوجية، فنرى السياسات الجنسية تحقق التوافق من خلال “التكيف الاجتماعي” لكل جنس مع النظم السياسية الأساسية للأبوية، سواء من حيث المزاج (temperament) أو الدور (role) أو المكانة (status). أما فيما يخص المكانة، فإن انتشار التوافق الضمني العام على تفوق الذكور يضمن المكانة المتميزة للذكور والأدنى للإناث. أما العنصر الأول، أي المزاج، فيشير إلى تكوين الشخصية الإنسانية بحسب مسارات نمطية محددة لكل فئة جنسية (مزاج ذكوري وأنثوي)، بناء على احتياجات وقيم الجماعة المهيمنة وما يفتخر به أفرادها وما يجدونه ملائمًا في التعامل مع الجماعة الأدنى، من حيث العدوانية والذكاء والقوة لدى الذكر، والسلبية والجهل والطاعة والعفة وقلة الحيلة لدى الأنثى. ويكتمل ذلك بعنصر آخر هو الدور المقرر لكل جنس. ففيما يتعلق بالأنشطة المختلفة، يوكل للأنثى أدوار الخدمة المنزلية ورعاية الأطفال، أما باقي الإنجازات والاهتمامات والطموحات البشرية فموكلة للذكر، ويسعى الدور
المحدد الموكل للأنثى إلى اقتصار خبرتها على ما هو بيولوجي، لذلك فإن كل ما يمكن أن نصفه بأنه إنساني خاص بالبشر موكل إلى حد كبير إلى الذكر (مع أن الحيوانات أيضًا تنجب وترعى صغارها بطريقتها). وبالطبع تعتمد المكانة التي يتمتع بها المرء على المهام الموكلة لكل طرف، فإذا أردنا تحليل العناصر الثلاثة معًا، يمكننا اعتبار المكانة هي العنصر السياسي، والدور باعتباره العنصر الاجتماعي، والمزاج باعتباره العنصر النفسي. إلا أنه من المؤكد أن كلا من تلك العناصر يعتمد على الآخر ويشلكون سلسلة، فمن يتمتعون بالمكانة الأعلى يميلون إلى لعب أدوار السيادة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تشجيعهم منذ البداية على اكتساب مزاج الهيمنة. ولا يحتاج الأمر إلى دليل أن الأمر نفسه ينطبق على الطوائف والطبقات الاجتماعية.
تفترض الأديان الأبوية والرأي العام، وبدرجة ما العلم أيضًا،7 أن هذه الاختلافات النفسية والاجتماعية تستند إلى فروق بيولوجية بين الجنسين، بحيث يقال إن الثقافة لا تفعل أكثر من التعاون مع الطبيعة في تحديد السلوك. ومع ذلك لا يبدو أن الاختلافات المزاجية التي تولد في ظل الأبوية (سمات الشخصية “الذكورية” و”الأنثوية”) تنشأ من الطبيعة البشرية، والأمر نفسه ينطبق بدرجة أكبر على الدور والمكانة.
فالبنية العضلية الأثقل للرجل، والتي هي سمة جنسية ثانوية وشائعة بين الثدييات، لها أصول بيولوجية، لكنها تلقى تشجيعًا ثقافيًا من خلال التربية والغذاء والرياضة. ومع ذلك فهي بالكاد كافية لتحديد موازين القوى السياسية في أي من الحضارات،8 ذلك أن سيادة الرجال، مثلها مثل المعايير
السياسية الأخرى، لا تكمن في النهاية في القوة الجسدية، وإنما في منظومة قيم ليست بيولوجية على الإطلاق. وقد تمكنت الحضارات دومًا من استبدال القوة العضلية لتحل محلها وسائل أخرى (التكنولوجيا والتسليح والمعرفة)، حتى لم تعد أن الحضارة المعاصرة في حاجة إليها. فأصبح الجهد العضلي بشكل عام, حاليًا كما كان في الماضي، عنصرًا مرتبطًا بالطبقة، حيث أدنى الشرائح الطبقية هي من تقوم بالمهام العضلية، وذلك بغض النظر عن عنصر القوة.
وكثيرًا ما يُفترض أن الأبوية جزء لا يتجزأ من الحياة الاجتماعية البشرية، ويمكن تفسيرها، ولا يمكن الاستغناء عنها، على أساس من الطبيعة الفسيولوجية للبشرية. ومثل هذه النظرية تمنع الأبوية أصولاً منطقية إلى جانب أصولها التاريخية. ومع ذلك، إذا لم تكن الأبوية ذات أصول بدائية, كما يعتقد بعض علماء الأنثروبولوجيا، وإنما سبقتها أشكال أخرى من التنظيم الاجتماعي، سوف نصفها بأنها سابقة على البدائية، تصبح القوة الجسدية كتفسير للأبوية غير كافية لتفسير هيمنتها, إلا إذا كان ظهور القوة الجسدية المتفوقة للذكر فد جاء مصحوبًا ببعض التغيير في الوعي من خلال قيم جديدة ومعرفة جديدة. ودائمًا ما يأتي الحدس بشأن الأصول مصاحبًا بالإحباط بسبب غياب الأدلة، والتخمين بشأن حقب ما قبل التاريخ، وبالتالي فهو أمر ينطبق على ما نحن بصدده، فيبقى مجرد تخمين، ولكننا إذا تعمقنا فيه قد نطرح إمكانية وجود حقبة افتراضية سابقة على الأبوية.9 الجوهري في مثل هذا الطرح هو بالضرورة حالة ذهنية تعزي الأصول إلى الخصوبة أو العمليات الحيوية. ففي المجتمعات البدائية، وقبل أن تتطور إلى الحضارة أو أي حالة أخرى غير الحالة البدائية، قد تجد البشرية دليلاً مقنعًا على قوة وجود خارقة في إنجاب الأطفال، أي نوع من الإعجاز المرتبط قياسيًا بنمو الحياة النباتية على الأرض.
ولعل اكتشاف الأبوة تسببت في هذا التحول الجذري في الرؤية، إذ توجد بعض الأدلة على تحول طقوس الخصوبة في المجتمعات القديمة في لحظة ما تجاه الأبوية، مع استبدال أو التقليل من شأن
دور الأنثى في التكاثر، ومن ثم فسرت قوة الحياة بالقضيب وحده. كما قد تكرس الأديان الأبوية هذا الرأي من خلال إيجاد إله ذكر أو آلهة ذكور، واستبعاد أو إقصاء أو إزاحة الإلهات وطرح فكر لاهوتي يدعم ويؤسس مبدأ سيادة الذكر، ومن ثم يصبح أحد أهم أدواره هو الحفاظ على هيكل الأبوية والتأكيد على صحتها.10
وكفانا الآن متعة اللعب بلعبة الأصول، فمسألة الأصول التاريخية للأبوية – سواء كان أصل الأبوية يعود بالأساس إلى القوة الجسدية للذكر أو إلى تحول لاحق ومؤثر للغاية في ظروف محددة – تبقى في هذه اللحظة غير قابلة للحسم. كما أنها في الأغلب غير مهمة في علاقتها بالأبوية المعاصرة، حيث تواجهنا حقيقة السياسات الجنسية التي ما زال الكثيرون يؤكدون أن أصولها تنبع من الطبيعة. لكن، للأسف، وحيث أن الاختلافات النفسية والاجتماعية بين الجنسين، والتي تُستخدم لتبرير العلاقة السياسية القائمة، ليست هي الاختلافات الواضحة والمحددة والقابلة للقياس والمحايدة التي يتطلبها البحث العلمي، بل هي على العكس تمامًا – غامضة وغير منسجمة، بل وفي أحيان شبه دينية في صياغتها – فيجب أن نعترف أن الكثير من أوجه التمييز الشائعة بين جنس وآخر، فيما يخص الدور والمزاج، ناهيك عن المكانة، لها في الواقع أسس ثقافية وليس بيولوجية. فمحاولات إثبات أن الهيمنة المزاجية متأصلة في تكوين الذكر باءت بالفشل الواضح، وهي الهيمنة التي إن ثبتت أصولها البيولوجية لكانت حجة هامة للغاية للمدافعين عن الحتمية البيولوجية، حيث يترتب عليها بالضرورة التفوق في الدور والمكانة. وقد اختلف الباحثون في المجال اختلافًا حادًا ويائسًا بشأن طبيعة الفروق الجنسية، لكن أكثرهم منطقية يئس من إيجاد أية معادلة محددة تربط بين المزاج والطبيعة البيولوجية. ويبدو أننا لن نستنير قريبًا بوجود أي فروق متأصلة ذات دلالة بين الذكر والأنثى فيما يتجاوز الفروق البيولوجية والوراثية التي نعلمها. وتبقى علوم الغدد الصماء والوراثة عاجزة عن تقديم تفسير مدعوم بالدليل القاطع على وجود فروق عقلية أو وجدانية. 11
ولا يقتصر الأمر على عدم وجود أدلة كافية تدعم نظرية الأصول الجسدية للتمييز الاجتماعي الحالي للأبوية (المكانة، الدور، المزاج)، بل إننا لسنا في موقع يسمح لنا بدراسة التمايز بينها، لأن الاختلافات، التي نعلم الآن أنها ذات جذور ثقافية، تتجاوزها كثيرًا. وبغض النظر عن الاختلافات “الحقيقية” بين الجنسين، فإن التعرف عليها يستدعي أولاً تغيير طريقة التعامل مع الجنسين، أي مساواتهما في المعاملة. وهو أمر بعيد المنال في الوقت الحالي. ولا تستبعد الأبحاث الجديدة الهامة, اليوم أكثر من أي وقت مضى، احتمالات وجود فروق مزاجية متأصلة فحسب، بل وتطرح أيضًا الأسئلة حول صدق وديمومة الهوية النفسجنسية (psycho-sexual identity). وهي بذلك تقدم دليلاً إيجابيًا ومحددًا بدرجة ما على الطابع “الثقافي” للجندر، أي بنية الشخصية فيما يتعلق بالفئة الجنسية.
ويقال اليوم إن ما يعرِّفه روبرت ستولر وغيره من المتخصصين بوصفه “هوية الجندر الأساسية” هي هوية تتشكل في الصغار عند سن الثمانية عشر شهرًا. ونجده يميز بين الجنس (sex) والجندر (gender) كالتالي:
تؤكد القواميس أن الدلالة الأهم للجنس هي الدلالة البيولوجية، مثلما نجد على سبيل المثال في مصطلحات مثل العلاقة الجنسية أو الجنس الذكري. ومن هنا سوف تشير كلمة الجنس هنا إلى جنس الذكر أو الأنثى، وستشير كلمة جنسي إلى ما له علاقة بالتشريح والفسيولوجيا. ولا يشمل ذلك بالتأكيد مساحات شاسعة من السلوك والمشاعر والأفكار والخيالات المرتبطة بجنس أو بآخر، وإن كانت لا تحمل بالأساس دلالات بيولوجية. وسوف استخدم مصطلح الجندر عند تناول بعض تلك الظواهر النفسية، فيمكننا الحديث عن الجنس الذكري أو الجنس الأنثوي؛ لكن يمكننا أيضًا الحديث عن الذكورة والأنوثة دون أن يكون لذلك بالضرورة أية علاقة بالتشريح أو الفسيولوجيا، بالتالي، ورغم أن المنطق قد يرى أن الجنس والجندر لا محالة مرتبطان فيما بينهما، إلا أن أحد أهداف هذه الدراسة هو التأكيد على أن هذين المجالين (الجنس والجندر) غير مرتبطين ارتباطًا حتميًا، بل إن كلاً منهما قد يتخذ له مسارًا مستقلاً.12
وقد توصل الباحثون والباحثات في مركز هوية الجندر بكاليفورنيا (California Gender Identity Center) إلى حالات عدم الوضوح التشريحي للأعضاء التناسلية، وبالتالي تعيين الجندر الخطأ عند الميلاد، واكتشفوا أنه من الأسهل إجراء جراحة تحويلية للمراهق الذكر عند اكتشاف هويته البيولوجية المخالفة للجندر الذي تحدد له وتربى بناء عليه، مقارنة بصعوبة محو آثار سنوات التربية والتعليم التي جعلت هذا الشخص أنثويًا في مزاجه وحركاته وإدراكه لذاته وشخصيته واهتماماته. إن الدراسات التي أجريت في كاليفورنيا تحت إشراف روبرت ستولر تقدم الدليل على أن هوية الجندر (بمعنى: أنا فتاة أو أنا صبي) هي الهوية الأولى التي يملكها الإنسان – إنها الهوية الأولى وكذلك هي الأكثر ديمومة وشمولاً.
ويؤكد ستولر لاحقًا على التمييز بين الجنس باعتباره تكوينًا بيولوجيًا، والجندر باعتباره تكوينا نفسيًا، ومن ثم ثقافيًا، فيقول: “إن الجندر مصطلح له معان نفسية أو ثقافية أكثر منها بيولوجية. وإذا كانت التسميات الملائمة للجنس هي “ذكر” و”أنثى” فإن المصطلحات المرادفة لها بالنسبة للجندر هي “ذكوري” و “أنثوي”، والأخيران يمكن أن يكونا مستقلين تمامًا عن الجنس (البيولوجي).” 13 بل أن الجندر على درجة من العشوائية، حتى أنه يمكن أن يكون على نقيض الفسيولوجيا: “… فرغم أن الأعضاء التناسلية الخارجية (القضيب والخصيتين وكيس الصفن) تسهم في تكوين الشعور بالذكورة، إلا أن أيًا منها، منفردة أو حتى مجتمعة، ليس جوهريًا لها. وفي غياب أدلة حاسمة أميل إلى الاتفاق مع موني Money والهامبسونز Hampsons الذين درسوا مجموعات كبيرة من المرضى ذوي الجنسية البينية intersexed وكشفوا أن الجندر يتحدد بعوامل تالية على الميلاد بغض النظر عن تشريح وفسيولوجيا الأعضاء الخارجية “14.
إن الاعتقاد السائد الآن هو أن الجنين البشري في الأصل أنثوي إلى أن يبدأ تأثير هرمون الأندروجين في مرحلة معينة من التكوين فيتحول حاملو كروموسوم 7 إلى ذكور.15 ومن الناحية النفسجنسية (على سبيل المثال فيما يتعلق بالذكورة والأنوثة في مقابل الذكر والأنثى) لا يوجد فرق بين الجنسين عند الميلاد. لذلك فإن الطابع النفسجنسي للشخصية تال على الميلاد ومكتسب.
إن الحالة القائمة عند الميلاد، والمستمرة لعدة شهور بعد ذلك، هي حالة من عدم التمايز النفسجنسي, مثلما هو الحال في الجنين، يمر التمايز الجنسي في الشكل خلال مرحلة من المرونة إلى حالة من الثبات غير القابل للتغيير، حتى أن البشرية افترضت تاريخيًا أن ذلك الشعور القوي والثابت بالهوية الجنسية الشخصية لا يمكن إلا أن ينبع من مصدر داخلي وفطري، لا أن يكون موضوعًا للخبرة والتعلم التالي على الميلاد. يكمن الخطأ في هذا الافتراض التقليدي في التقليل من شأن قوة واستمرارية الشيء المتعلم والمكتسب. لقد أدت تجارب أخصائيي السلوك، التي أجريت على الحيوانات لدراسة التطبع، إلى تصحيح هذه الفكرة الخاطئة.16
يعتقد جون موني John Money الذي اقتبسنا منه أعلاه أن “اكتساب لغة الأم هو المرادف الإنساني للتطبع” وأن بدايات تشكل الجندر تبدأ مع “تحديد لغة الأم”،17 وهو ما يتم غالبًا في عمر الثمانية عشر شهرًا تقريبًا. وقد أكدت دراسات جيروم كاجين Jerome Kagin أن طريقة التعامل مع الأطفال في مرحلة ما قبل الكلام،18 من حيث المعاملة واللمس والدغدغة وكيفية توجيه الحديث إليهم من حيث هويتهم الجنسية (“هل هو صبي أم فتاة؟” “أهلا صديقي الصغير!” “أليست جميلة؟”
إلخ)، تركز بدرجة كبيرة على التعلم عن طريق اللمس، الأمر الذي يؤثر بشدة على شعور الطفل بذاته، حتى قبل أن يصبح قادرًا على استخدام اللغة.
ويسبب ظروفنا الاجتماعية، أصبح الذكر والأنثى يمثلان ثقافتين متباينتين، وخبراتهما الحياتية مختلفة للغاية، وهي مسألة مهمة، ذلك أن تبلور هوية الجندر خلال فترة الطفولة يشمل ضمنيًا تصور الأهل والزملاء والثقافة عما هو ملائم لكل جندر فيما يتعلق بالمزاج والخصال والاهتمامات والمكانة والقيمة والحركة والتعبير. فكل لحظة في حياة الطفل/ ة تحمل رسالة ضمنية عن الأسلوب الملائم للتفكير والسلوك للوصول أو ترضية متطلبات الجندر المعين له/ ها. وفي فترة المراهقة تتصاعد مهام التكيف بلا رحمة تكاد تصل حد الأزمة، ثم غالبًا ما تهدأ وتستقر عند النضج.
حيث أن الأسس البيولوجية للأبوية تبدو إلى هذا الحد غير مستقرة، يجد المرء لنفسه بعض المبرر في الإعجاب بسطوة “التكيف الاجتماعي” الذي استمر طوال هذا الوقت “مستندًا إلى الإيمان وحده” أو من خلال منظومة قيمية مكتسبة فحسب. فحتى الآن يبدو أن العنصر الحاسم لضمان الحفاظ على الاختلافات المزاجية بين الجنسين هو التعلم والتكيف في الطفولة المبكرة. وعملية التكيف هذه تدور في حلقة من الاستدامة وتحقيق الذات. ولنأخذ مثالاً بسيطًا على ذلك: إن توقعات الثقافة من هوية الجندر تشجع الذكر الشاب على اكتساب نزعات عدوانية والأنثى على كبت تلك النزعات أو تحويلها إلى الداخل. والنتيجة هي أن الذكر عادة ما يحظى بالتشجيع على النزعات العدوانية، الأمر الذي يحمل في كثير من الأحيان إمكانيات سلوك ضد اجتماعي. وبالتالي تتقبل الثقافة فكرة أن امتلاك الذكر للخصيتين والقضيب والكيس الصفن في حد ذاته، يميز النزعة العدوانية بل وأحيانًا تحتفي بفجاجة بهذا الأمر في مديح من قبيل “ولد دكر”، بينما تتضح عملية التشجيع نفسها في إنتاج الميزة “الأنثوية” الرئيسة المتمثلة في السلبية.
وباستخدام المصطلحات المعاصرة، ينتظم التقسيم الأساسي للسمات المزاجية على محور “العدوانية مذكر” و”السلبية مؤنث”، وبناء عليها تنتظم باقي الصفات والسمات بطريقة ما، وأحيانًا بمنتهى البراعة، لتنسجم مع هذا التقسيم. فإذا كانت العدوانية هي سمة الطبقة السائدة، يجب أن تصبح السمة المقابلة في موضوع السيادة هي الانقياد والطاعة. ويأمل هذا المنطق في العادة في إمكانية الاعتماد على “الطبيعة” في تبرير النظام الأبوي، من خلال مصادفة خارجية مستحيلة ما. الأمر الهام الذي لابد أن نتذكره هنا هو أنه في ظل الأبوية يوكل للذكر، دون تفكير، مهمة تحديد العرف أو “الطبيعي”. ولو لم يكن الأمر كذلك لاستطعنا أن نصف السلوك الأنثوي بأنه نشيط والسلوك “الذكري” بأنه مفرط النشاط أو مفرط العدوانية.
هنا يمكننا أن نضيف، كخاتمة، أن الفترة الأخيرة شهدت عودة إلى المعلومات الناجمة عن العلوم الجسدية لدعم حجج اجتماعية مثل تلك التي طرحها لايونيل تايجر Lionel Tiger الذي يسعى إلى تبرير وراثي للأبوية من خلال اقتراح “غريزة ارتباطية” في الذكور تضمن تحكمهم السياسي والاجتماعي في المجتمع البشري.19 ويمكننا التعرف على تبعات مثل هذه النظرية بتطبيق فرضياتها على أية جماعة حاكمة. وتبدو نظرية تايجر بمقابة سوء تمثيل لأعمال لورنز Lorenz ودارسين آخرين لسلوك الحيوان. وبما أن دليله على السمة الفطرية هو التاريخ والتنظيم الأبوي، فإن حججه بوجود دليل مادي عليها زائفة وتدور في فراغ، ذلك أننا لا نستطيع أن نطور الدليل الوراثي إلا في حال كان لدينا دليل وراثي (وليس تاريخي) أصلاً لنبني عليه. وحيث إن العديد من الباحثين يستبعدون تمامًا نظرية الغرائز (أنماط سلوكية معقدة متأصلة) في تحديد سلوك البشر، مع الاعتراف فقط بالانعكاسات اللاإرادية والدوافع (وهي استجابات عصبية أبسط بكثير)،20 فإن احتمالات وجود “غريزة ارتباطية” تبدو بائسة للغاية.
وفي حال اعتبرنا الجنس في حياة البشر دافعًا، يبقى من الضروري أن نشير إلى أن مساحة كبيرة من حياتنا، سواء في مرحلة “التكيف الاجتماعي” المبكرة أو في الخبرة التالية كراشدين والمسماة “بالسلوك الجنسي”، تكاد أن تكون تمامًا نتاج التعلم، حتى أن فعل الجماع نفسه هو نتاج سلسلة طويلة من ردود الفعل والاستجابات المكتسبة، سواء من حيث الأنماط أو المواقف، بل وحتى فيما يتعلق بموضوع الاختيار الجنسي، حيث تتحدد كلها من خلال محيطنا الاجتماعي.
إن الطابع الاعتباطي لتفسير الأبوية للمزاج والدور له تأثير ضعيف على قوة تلك التفسيرات علينا. كما أن الصفات المتناقضة والمتضارية والقطبية لوصف فئات “الذكري” و”الأنثوي” المفروضة على الشخصية الإنسانية لا تثير الأسئلة الجادة بيننا بما يكفي. وبسبب هذه التفسيرات تصبح كل شخصية أكثر بقليل، أو أقل بكثير، من نصف إمكانياتها البشرية. ومن الناحية السياسية فإن فكرة أن لكل مجموعة شخصية وأفعالاً حتمية وتكميلية للمجموعة الثانية تصبح فكرة ذات أهمية ثانوية للفكرة الأهم، وهي أن كل مجموعة تملك مكانة أو قوة أو سلطة بعينها. وفيما يتعلق بعملية الامتثال تصبح الأبوية أيديولوجية حاكمة بلا منازع، والأرجح أنه ما من نظام آخر فرض مثل هذا التحكم المعقد على أفراده.
المؤسسة الأهم في الأبوية هي الأسرة، فهي مرآة للمجتمع الأكبر كما أنها الرابط فيه، بمعنى وجود وحدة أبوية داخل كل كيان أبوي. ومن خلال الوساطة بين الفرد والبنية الاجتماعية تمارس الأسرة التحكم والامتثال حيث لا تكفي السلطة السياسية والسلطات الأخرى.21 ونجد دور الأسرة وأدوارها النمطية بمثابة الأداة الأساسية والوحدة التأسيسية للمجتمع الأبوي، إذ تقوم بدور وكيل المجتمع الأوسع، حيث لا تشجع أفرادها على التأقلم والامتثال فحسب، بل تقوم بدور إحدى وحدات الحكومة الأبوية التي تحمي مواطنيها من خلال أرباب الأسر. وحتى في المجتمعات الأبوية التي حصلت فيها النساء على المواطنة القانونية، عادة ما تُحكم النساء من خلال الأسرة وحدها ولا تبقى لديهن علاقة رسمية مع الدولة أو تكون علاقتهن بها ضعيفة.٢٢
ونظرًا لأهمية التعاون بين الأسرة والمجتمع الأوسع، وإلا تهاوى كل منهما، تصبح مصائر المؤسسات الأبوية الثلاثة، الأسرة والمجتمع والدولة، مترابطة فيما بينها. وقد أدى ذلك في معظم أشكال الأبوية إلى تقديم الدعم الديني لمقولات من أمثلة التعاليم الكاثوليكية بأن “الأب هو رأس العائلة” أو في اليهودية التي تمنح سلطة شبه كهنوتية للأب. وتفعل الحكومات المدنية اليوم نفس الشيء حين تقرر أن الذكر هو رب الأسرة في مسوح التعداد السكاني والمحاسبة الضرائبية وإصدار الجوازات، الخ. أما النساء المعيلات لأسرهن فهن غير مرحب بهن، حيث أنهن يجسدن حالة من الفقر أو سوء الحظ. وهنالك أيضًا التعاليم الكونفوشيوسية التي توازي العلاقة بين الحاكم والمحكوم بالعلاقة بين الأب وأبنائه، الأمر الذي يشير إلى الطابع الإقطاعي للأسرة الأبوية (وأيضًا إلى الطابع الأسري للإقطاع) حتى في الديمقراطيات الحديثة.23
تاريخيًا منحت الأبوية الأب تقريبًا الملكية التامة لزوجاته وأطفاله، بما في ذلك سلطات سوء المعاملة الجسدية، وفي كثير من الأحوال أيضًا سلطة القتل والبيع. كلاسيكيًا، وباعتباره رب الأسرة, يكون الأب هو المنجب والمالك في نظام تشمل الملكية فيه علاقات النسب.24 لكن، في إطار الأبوية الصارمة، لا يُعترف بدرجة النسب إلا عن طريق الارتباط بسلالة الذكر. فقرابة العصب تستثني سلالة الأنثى من حقوق الملكية، بل وتحرمها أحيانًا من الاعتراف ذاته.25 الصياغة الأولى للأسرة الأبوية قام بها سير هنري ماين Sir Henry Maine، وهو مؤرخ من القرن التاسع عشر اهتم بدراسة التشريعات القديمة. يقول ماين إن الأساس الأبوي للنسب يتحدد بحسب السيادة والخضوع أكثر منه بحسب صلة الدم؛ فالنساء رغم كونهن غريبات يتم إدماجهن في السلالة، على حين يستبعد أبناء الأخت. وقد أسند ماين تعريفه للأسرة إلى السلطة الأبوية لروما فجاءت كالتالي: “أكبر أولياء الأمور الذكور سنًا في الأسرة هو صاحب السلطة الأعلى في الأسرة، وتمتد هيمنته في الحياة كما في الموت ولا تضاهيها هيمنة على أبنائه وبيوته وعبيده.” 26 ففي الأسرة الأبوية العتيقة “تتكون الجماعة من الملكية الحية وغير الحية، والزوجة والأطفال والعبيد والأرض والمتاع، كلها يجمعها خضوعها للسلطة المستبدة لأكبر الذكور سنًا.”٢٧
اعتراضًا على نظرية ماين طرح ماكلينون McLennon أن النموذج الروماني الذي يطرحه ماين يمثل شكلاً مبالغًا فيه للأبوية، وليس بأي حال من الأحوال، مثلما يطرح ماين، سائدًا في كافة أنحاء العالم.28 كما أن وجود أدلة على وجود مجتمعات تتبع سلالة الأم (مجتمعات قديمة في أفريقيا وأماكن أخرى) تدحض افتراض ماين بتعميم علاقات العصب هذه. إن أطروحة ماين المركزية بشأن الطابع الأزلي أو “الطبيعي” للأبوية ليس بالتأكيد سوى بمثابة تبرير ساذج لمؤسسة كان ماين يمجدها،29 لذلك أن فرضية الطابع الأزلي للأبوية يدحضها الكثير من الأدلة التي تشير إلى نتيجة مفادها أن السلطة الأبوية الكاملة، خاصة فيما يتعلق بالأسرة، هي تطور لاحق، وأن التآكل الكامل لوضع الأنثى كان أمرًا تدريجيًا، مثلما كان استرجاعه.
وفي النظم الأبوية المعاصرة تبدلت الأولوية العرفية للذكر من خلال ضمان الحماية بعد الطلاق30 والمواطنة وحق الملكية للنساء. مع ذلك يستمر وضعهن على ما هو عليه فيما يتعلق بفقدان اللقب، وإلزامهن بقبول منزل الزوج، والافتراض القانوني العام بأن الزواج يشمل استبدال خدمات الأنثى المنزلية (والجنسية) في مقابل الدعم المالي.31
إن المساهمة الأساسية للأسرة في منظومة الأبوية هي التكييف الاجتماعي للصغار (إلى حد كبير من خلال ضرب المثل والصرامة من قبل الأهل) مع المعايير المفروضة من الأيديولوجية الأبوية فيما يخص الدور والمزاج والمكانة. ورغم أن التباينات القليلة في التفاصيل تعتمد على استيعاب الأهل للقيم الثقافية، إلا أن الأثر العام هو تحقيق الانسجام الذي يدعمه لاحقًا الزملاء والمدارس والإعلام ومصادر التعلم الأخرى، سواء الرسمية أو غير الرسمية. وعلى حين قد نتحاجج حول توازن السلطة بين الشخصيات في الأسر المختلفة، إلا أنه يجب علينا أن نتذكر أن الثقافة ككل تدعم السلطة الذكورية في كافة مجالات الحياة – وخارج المنزل – على حين لا تسمح للأنثى بأي منها.
ولضمان اقتصار هذه الوظائف الحيوية من الإنجاب وتكييف الصغار على إطار الأسرة الأبوية, تصر الأخيرة على الشرعية. ويصف برونيسلاف مالينوفسكي Bronislaw Malinowski هذا الأمر بكونه “مبدأ الشرعية”، ويعرفها بأنها التأكيد على أن “لا يأتي طفل إلى هذا العالم بدون رجل – ورجل واحد – يقوم بدور الأب الاجتماعي”.32 إن هذا الشرط الثابت والذي يبدو عالميًا (وقد تختلف العقوبة على تجاوزه بحسب الطبقة ومع كل ازدواجية المعايير المتوقعة) يمكِّن النظام الأبوي من التأكيد على أن مكانة الطفل والأم تعتمد أولاً ونهائيًا على الذكر. وحيث أن الأمر لا يتعلق فقط بمنزلته الجنسية, وإنما أيضًا سلطته الاقتصادية التي عادة ما يعتمد عليها من يعيلهم، فإن مكانة الذكر داخل الأسرة – مثلما خارجها – هي مكانة قوية ماديًا وأيديولوجيا أيضًا.
ورغم عدم وجود أسباب بيولوجية تفسر لماذا يجب على الوظيفتين الأساسيتين للأسرة (التكييف الاجتماعي والتكاثر) أن يكونا غير قابلتين للانفصام، أو حتى لماذا يجب أن ترتبطا بوجود الأسرة، إلا أن الجهود الثورية أو المثالية التي حاولت إزاحة هذه الوظائف عن الأسرة إما انتهت بخيبة الأمل أو واجهت كمّا من الصعوبات بحيث اضطرت إلى العودة التدريجية إلى التقاليد. وهو دليل قوي على عمق جذور الأبوية في كل مجتمعاتنا، ومدى شمول تأثيرها على أفراد الأسرة. كما قد يمثل أيضًا تذكيرًا بأن محاولات التغيير بدون فهم عمیق وشامل للمؤسسة الاجتماعية والسياسية المرغوب تغييرها، نادرًا ما تكون ناجحة. ذلك فإن أي تغيير اجتماعي جذري لا يمكن أن يحدث دون أن يكون له تأثير على الأبوية. ليس فقط لأنه الشكل السياسي الذي يُخضع نسبة كبيرة من السكان (النساء والشباب) بل لأنه يقوم مقام الحصن الحامي للملكية والمصالح التقليدية. فالزيجات هي تحالفات مالية، وكل منزل يعمل كهيئة اقتصادية مثل الشركة. إن “الأسرة هي حجر الزاوية في نظام الطبقات، هي الآلية الاجتماعية التي تحافظ عليه” على حد تعبير أحد الباحثين في موضوع الأسرة.33
في المجال الطبقي، أكثر من أي مجال آخر، يصبح وضع الأنثى – الشبيه بوضع الطائفة – في ظل الأبوية، عرضه للإرباك، ذلك أن المكانة الجنسية كثيرًا ما تؤثر – بشكل سطحي- وبطريقة مربكة على الموقع الطبقي. وفي مجتمع تعتمد فيه المكانة الاجتماعية على الظروف الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية للطبقة، من الممكن لبعض الإناث أن يبدو الأمر وكأنهن ذوات مكانة أعلى من الذكور، لكن الأمر لا يظل كذلك إذا دققنا النظر. وقد يكون من الأسهل استخدام المجاز في شرح ذلك، فالطبيب أو المحامي الأسود يتمتع بمكانة اجتماعية أعلى من المزارع الفقير الأبيض. لكن العرق, الذي هو في ذاته نظام طائفي، يستوعب الطبقة، ويقنع الأخير- المزارع الفقير الأبيض- بأنه يتمتع بمكانة أعلى في الحياة، كما يقمع روح المهني الأسود بغض النظر عن نجاحه المادي. وبنفس المعنى، يلجأ سائق الشاحنة أو الجزار دائمًا إلى “رجولته” فيعتمد عليها ويفتخر بها. وتتضمن أدبيات الثلاثين عامًا الماضية عددًا كبيرًا من الحالات التي ينتصر فيها عنصر الفحولة على المكانة الاجتماعية للنساء الثريات أو حتى المتعلمات. ففي السياق الأدبي يمكن للمرء أن يتناول الأماني وأن يحقق الرغبات، أما في الحياة الواقعية فإن أمورًا مثل التحرش والتعليقات الخارجة أو العدوانية يمكن أن تمثل شكلاً آخر من أشكال الرغبة الجنسية في فرض السطوة، وكلاهما يعكس أمنية أكثر منها واقعًا، ذلك أن الانقسامات الطبقية غالبًا ما تتمتع بمناعة تجاه عدوانية الأفراد. ومع ذلك، ورغم أن الانقسام الطبقي لا يتهدد بشدة بمثل تلك التعبيرات العدائية، إلا أن التراتبية الجنسية أكثر استعدادًا “لمعاقبة” الأنثى بشكل فعال.
تتوقف وظيفة العادات الطبقية أو العرقية في ظل الأبوية إلى حد كبير على الدرجة التي يُسمح بها لمبدأ سيادة الذكورة أن يعبر عن نفسه عاليًا وبوضوح. هنا نواجه بما يبدو أنه مفارقة: فعلى حين نجد الذكر في الشرائح الاجتماعية الدنيا أكثر استعدادًا لانتزاع السلطة مستندًا إلى قوته ومكانته الجنسية وحدها، إلا أنه كثيرًا ما يضطر إلى اقتسام السلطة مع نساء طبقته الناشطات اقتصاديًا، على حين في الطبقات الوسطى والعليا لا نجد هذا الميل الشديد إلى التأكيد على الهيمنة الأبوية الفجة، حيث أن الرجال المتمتعين بتلك المرتبة يملكون السلطة في كل الأحوال.34
من المقبول عامة أن الأبوية الغربية أصبحت أكثر مرونة مع ظهور الحب الرومانسي. ورغم صحة ذلك، إلا أن هناك مبالغة شديدة في تقدير أثره، فبالمقارنة مع صراحة السلوك “الرجولي” أو الشرقي، لابد وأن نلحظ قدر التنازل الذي يحمله السلوك الشهم التقليدي، فهو نوع من المصالحة الكريمة التي تسمح للأنثى الأدنى بالحفاظ على بعض من ماء الوجه. وعلى حين تمثل هذه الشهامة تخفيفًا للظلم الواقع على النساء بموجب منزلتهن الاجتماعية، إلا أنها أيضًا أداة للتمويه على ذلك الظلم. ويجب أن نعترف بأن سلوك الشهامة يمثل لعبة تلعبها الجماعة المسيطرة لرفع الأفراد المسيطر عليهم إلى مستوى أعلى، إذ يؤكد المؤرخون للحب الرومانسي على أن إبداعات الشعراء لم يكن لها أي تأثير على الوضع القانوني أو الاقتصادي لنساء، والقليل جدًا على الوضع الاجتماعي.35 هذا وقد لاحظ عالم الاجتماع هوجو بايجل Hugo Beigel أن الصيغ الرومانسية والأفلاطونية للحب ما هي إلا “منح” يتنازل عنها الذكر من إجمالي سلطاته،36 وكلاهما تجسد تأثيره في إخفاء الطابع الأبوي للثقافة الغربية، ومن خلال ميلهما العام إلى إضفاء مزايا مستحيلة على النساء انتهت بعزل النساء داخل دائرة سلوكية شديدة الضيق وشديدة التحديد. من بين عادات العصر الفيكتوري، على سبيل المثال، الإصرار على أن تقوم الأنثى بدور الخادم لضمير الذكر، وأن تعيش حياة الخير التي يراها الذكر مجهدة، وإن شعر أن شخصًا ما يجب أن يعيشها.
يسمح مفهوم الحب الرومانسي بوسيلة للتلاعب بالمشاعر يستغلها الذكر بحرية، حيث أن الحب هو الظرف الوحيد الذي يُغفر للمرأة فيه (نظريًا) ممارستها للنشاط الجنسي. كذلك فإن قناعات الحب الرومانسي ملائمة للطرفين، حيث أنه الحالة الوحيدة التي تسمح للأنثى بالتغلب على ما تلقته من تربية خاصة بتحريم الممارسة الجنسية. كذلك يغطي الحب الرومانسي على حقيقة وضع الأنثى وعبء التبعية الاقتصادية. أما عن “الفروسية” فإن مثل هذا السلوك النبيل المتأصل في الطبقات الوسطى قد انحدر إلى طقوس مملة، بالكاد تخفي الوضع القائم.
في داخل الأبوية يضطر المرء كثيرًا إلى التعامل مع المفارقات التي تتجاوز كونها أمورًا مرتبطة بأسلوب كل طبقة. فقد لاحظ ديفيد ريزمان David Riesman أنه مع استيعاب الطبقة العاملة في الطبقة الوسطى، حدث نفس الشيء مع عاداتها ومواقفها الجنسية. حيث تم استيعاب الشوفينية الذكورية الفجة، التي كانت فيما مضى تخص الذكور المهاجرين أو الذكور من الطبقات الدنيا، واكتسبت بريقًا ما من خلال عدد من الشخصيات المعاصرة التي حولتها هي وبعض عادات ومواقف ذكور الطبقة العاملة إلى جزء من نمط جديد وأنيق للحياة. وقد بلغ تأثير هذا النموذج لفحولة الطبقة العاملة (أو بصيغة أدق الصيغة الأدبية أو صيغة الطبقة الوسطى له) في وقتنا هذا، حد أنه قد يحل محل نظيره الأقل وضوحًا و”كياسة” في الماضي.37
ومن أهم التأثيرات الطبقية في ظل الأبوية هو وضع امرأة في مواجهة امرأة أخرى، الأمر الذي كان في الماضي يخلق مفارقة هامة بين العاهرة والسيدة، وفي الوقت الحالي بين المرأة المهنية وربة المنزل. فالأولى تحسد الثانية على “أمانها” ووضعها المميز، على حين تحلم الثانية بأن تتجاوز حدود الاحترام لتحصل على ما تعتبره حرية ومغامرات واتصالاً بالعالم الأوسع الذي تتمتع به الأولى. ومن خلال الميزات المتعددة لازدواج المعايير يشارك الذكر في العالمين، ويمكنه من ذلك موارده الاجتماعية والاقتصادية الأعلى التي تسمح له بملاعبة النساء المغتربات عن ذواتهن، الواحدة ضد الأخرى, كمتنافستين. كذلك يمكن أن نتعرف على تصنيفات أخرى للنساء في مواجهة بعضهن البعض, حيث لا تقتصر على الطبقة الأعلى وإنما تشمل أيضًا الجمال والسن.
وقد يمكننا في التحليل الأخير أن نقول إن النساء يملن إلى تجاوز التصنيف الطبقي المعتاد في الأبوية، حيث أن ارتباط الأنثى بالطبقة أقل ديمومة من الذكر، بغض النظر عن التعليم أو الطبقة عند الميلاد. فالتبعية الاقتصادية تجعل من انتماء المرأة الطبقي أمرًا هامشيًا وثانويًا ومؤقتًا. فقد لاحظ أرسطو Aristotle أن الجارية الوحيدة التي يملك الرجل العادي ادعاء ملكيتها هي امرأته، كما أن الخدمة غير مدفوعة الأجر للعمالة المنزلية توفر لذكر الطبقة العاملة “وسادة” يتكئ عليها في مواجهة لطمات النظام الطبقي الذي يوفر له بعضًا من أوجه الترف النفسي الذي تتمتع به الطبقة المرفهة. وترتفع قلة من النساء عن الطبقة العاملة، في حدود مواردهن الخاصة، وفيما يتعلق بحظوتهن الشخصية وقدراتهن الاقتصادية، لكن النساء، كجماعة، لا يتمتعن بالكثير من المصالح والمزايا التي توفرها أي طبقة لأفرادها من الذكور. لذلك فإن إمكانيات النساء في الاستثمار في النظام الطبقي أقل من الذكور. لكن من الهام أن نفهم أنه مثلما في أية مجموعة يعتمد وجودها على علاقة طفيلية مع حاكميها، كذلك النساء طبقة تابعة تعيش على الفائض، وحياتهن الهامشية تلك كثيرًا ما تجعلهن رجعيات، حيث أنهن مثل كل الأفراد في موقعهن (والعبيد هنا مثال كلاسيكي) يساوين بين بقائهن وبين رخاء وازدهار وثراء من يطعمهن. والسعي إلى حلول تحررية جذرية خاصة بهن يبدو أملاً بعيدًا للأغلبية بحيث لا يجرؤن على تصورها أو التفكير فيها، ومن ثم يبقى الوضع على حاله . حتى يتكون الوعي بإمكانيات تغييره.
ويبرز العرق كأحد آخر العناصر المؤثرة في السياسة الجنسية، فيصبح من الضروري، خاصة في مناقشة الأدبيات الحديثة، أن نتناوله بشيء من التعليق. فقد اعتاد الذكر الأبيض، تاريخيًا، أن يمنح الأنثى من عرقه، باعتبارها “امرأته”، مرتبة أعلى من الذكر الأسود.38 لكن مع انكشاف وتآكل الأيديولوجية العنصرية البيضاء، بدأت المواقف الحمائية القديمة للعنصرية تجاه النساء (البيض) في التحلل أيضًا. وأصبحت أولويات الحفاظ على السيادة الذكورية تتجاوز تلك الخاصة بالسيادة البيضاء. وقد يكون التعصب الجنسي أكثر تغلغلاً في مجتمعنا عن العنصرية، فعلى سبيل المثال, نلاحظ في كتابات البعض، ممن يمكننا وصفهم اليوم بوضوح أنهم عنصريون من أمثال د. ه لورانس، حالات يسود فيها ذكور الطائفة الأدنى أو يوجهون الإهانة لرفيقات الرجل الأبيض العاصيات. ومن المعروف أن إناث الأعراق غير البيضاء لا يظهرن في مثل تلك الأساطير سوى باعتبارهن مثالاً للطاعة النسائية “الأصيلة”، والتي يجب على النساء الأخريات، الأقل تربية، أن يسعين إلى تقليدها. وكثيرًا ما يقع علم الاجتماع المعاصر الأبيض في انحياز أبوي شبيه حين يميل خطابه إلى التأكيد على أن الجانب “الأمومي” لمجتمع السود و”خصي” الذكر الأسود هما أكثر مظاهر القمع الأسود بؤسا في المجتمع العنصري الأبيض، بما يعني ضمنيًا أن التمييز العنصري قابل للحل باستعادة السلطة الذكورية. وبغض النظر عن حقيقة ذلك في الواقع، يمكننا القول إن تحليلاً من هذا النوع يقبل بالقيم الأبوية دون التشكك فيها ويميل إلى التغطية على كل من الطابع الحقيقي ومسئولية الظلم العنصري تجاه البشر الملونين من الجنسين.
إن من أكفأ فروع الحكم الأبوي ما يتمثل في تحكمه الاقتصادي في الإناث المحكومات به. فلم يُسمح للنساء، في ظل الأبوية التقليدية، باعتبارهن لا يتمتعن بالصفة القانونية كأشخاص، بأي وجود اقتصادي، حيث لم يكن بمقدورهن امتلاك أو كسب المال. وحيث أن النساء عملن دائمًا في مجتمعات أبوية، وفي الغالب في أكثر الأعمال روتينية وإجهادًا، فإن ما نحن بصدده هنا ليس هو العمل وإنما الجزاء الاقتصادي مقابل هذا العمل. صحيح أن النساء صرن يتمتعن ببعض الحقوق الاقتصادية في المجتمعات الأبوية الحديثة التي شهدت إصلاحات، إلا أن “عمل النساء” الذي تنخرط فيه حوالي ثلثي السكان من النساء في أكثر دول العالم تقدمًا، يظل غير مدفوع الأجر.39 في نظام الاقتصاد المالي، حيث يعتمد الاستقلال والمكانة الاجتماعية على المال، يصبح هذا الأمر ذا أهمية كبيرة. وبشكل عام، يمثل وضع النساء في ظل الأبوية امتدادًا لتبعتيهن الاقتصادية. ومثلما يتسم وضعهن الاجتماعي بكونه هشًا ومؤقتًا وهامشيًا ولا يتحقق سوى من خلال الذكور، كذلك تكون علاقتهن بالاقتصاد هشة وهامشية.
ومن بين ثلث النساء اللاتي يعملن بأجر، يمثل متوسط أجورهن نصف متوسط الأجور التي يتمتع بها الذكور. والأرقام التالية هي إحصائيات وزارة العمل الأمريكية التي تحدد متوسط الدخل السنوي: الذكر الأبيض 6704 دولار، الذكر الملون ٤٢٧٧ دولار، الأنثى البيضاء ٣٩٩١ دولار. الأنثى الملونة ٢٨١٦ دولار.40 وتستحق هذه الفروق اهتمامًا خاصًا حين نعلم أن المستوى التعليمي للنساء
يكون عامة أعلى من الذكور في نفس فئة الأجور.41 كذلك، فإن مجالات العمل المتاحة للنساء في النظم الأبوية الحديثة، مع قليل من الاستثناءات، في أغلبها أقل شأنًا وقليلة الأجر والشأن. 42
تمثل النساء في البلدان الرأسمالية الحديثة أيضًا قوى عاملة احتياطية، تُستدعى في أوقات الحرب والتوسع، ويُستغني عنها في أوقات السلم والكساد. بهذا الدور استبدلت النساء الأمريكيات العمالة المهاجرة ويتنافسن الآن مع الأقليات العرقية. كذلك في البلدان الاشتراكية عادة ما تلتحق القوى العاملة النسائية بالوظائف الأقل، رغم وجود نسبة عالية من النساء في بعض المهن المحددة مثل الطب. تجدر الإشارة هنا إلى أن السماح للنساء بالانخراط في هذه الأعمال يستهدف خدمة المجتمع أو الدولة، وليس النساء أنفسهن (البلدان الاشتراكية أيضًا أبوية).
وحيث إن النظرة إلى استقلال المرأة في الحياة الاقتصادية تكون محل تشكك وعدم ترحيب، لا تتوقف الهيئات التوجيهية بأنواعها (الدين، علم النفس، الإعلانات، الخ) عن النصح أو حتى التنديد بتشغيل نساء الطبقة الوسطى، خاصة الأمهات. أما عمل نساء الطبقة العاملة فأحيانًا ما تتقبله الطبقة الوسطى على اعتبار أنه “احتياج”، وإن ليس دائمًا كذلك من قبل الطبقة العاملة. كذلك يوفر عمل نساء الطبقة العاملة العمالة الرخيصة في المصانع والخدمات قليلة الشأن والوظائف التكميلية، كما أن أجره ومهامه غير مجزية تمامًا، بحيث أنه لا يهدد الأبوية لا ماليًا ولا نفسيًا، على عكس التوظيف الأعلى شأنًا للنساء. والنساء اللاتي يعملن بأجر يعملن عملاً مزدوجًا، حيث أن أعباء الخدمات المنزلية ورعاية الأطفال تبقى مسئوليتهن، لا تتولاها مراكز الرعاية النهارية أو أي هيئات اجتماعية أخرى، كما لا يقلل من عبئها تعاون الأزواج. ولم يؤثر اختراع الأجهزة المخففة للعمل اليدوي كثيرًا على استمرار كدحهن، حتى وإن أثرت على نوعيته.43 هنالك تمييز بالغ في أمور التعيين والأمومة والأجور وساعات العمل،44 ففي الولايات المتحدة صدر أخيرًا قانون يجرم التمييز في التعيين، وهو أول ضمان تشريعي للحقوق، والوحيد، الذي يُمنح للنساء الأمريكيات منذ حصولهن على حق التصويت، لكنه لا يُفعل ولم يُفعل منذ صدوره ولم يُطبق كي يتم تفعيله. 45
وفيما يتعلق بالصناعة والإنتاج، يبقى وضع النساء شبيهًا من نواح كثيرة بوضع الشعوب المستعمرة والشعوب في مراحل ما قبل الصناعة، فرغم تحقيقهن لاستقلالهن الاقتصادي الأول أثناء الثورة الصناعية وأصبحن الآن يمثلن نسبة كبيرة، قليلة الأجر، من عاملات المصانع، إلا أن النساء لا يشاركن مباشرة في التكنولوجيا أو الإنتاج. وما ينتجنه في العادة (الخدمات المنزلية والشخصية) ليس له قيمة في السوق، ومن ثم فهو يقع ضمن نمط إنتاج ما قبل الرأسمالية. وحتى حين يشاركن بعملهن في إنتاج السلع فإنهن لا يملكن أو يتحكمن أو حتى يفهمن العملية التي يشاركن فيها قد نحتاج إلى مثال لتوضيح ذلك: الثلاجة جهاز تستخدمه كل النساء، بعضهن يجمعنه في المصانع والقليلات جدًا ممن حصلن على تعليم علمي يفهمن مبادئ تشغيلها. مع ذلك فإن الصناعات الثقيلة التي تجهز الصلب اللازم لصناعتها وتنتج الأصباغ لأجزائها المختلفة، كلها في أيدي الذكور. الأمر نفسه ينطبق على الآلة الكاتبة، والسيارة، الخ. ورغم أن المعرفة مجزأة حتى بين العمال الذكور، إلا أنهم مجتمعين يمكن أن يعيدوا بناء أي جهاز. لكن في غياب الذكور، لن تتمكن النساء على الأرجح من استبدال أو تصليح مثل تلك الأجهزة بأي درجة بسبب المساحة الشاسعة التي تفصل النساء عن التكنولوجيا اليوم. أما مسافة النساء عن التكنولوجيا الأكثر تعقيدًا فهي أكبر من ذلك: وبناء المنشآت الضخمة، وتطوير أجهزة الكومبيوتر، والوصول إلى القمر، كلها أمثلة على ذلك. فإذا كانت المعرفة قوة، فإن القوة أيضًا معرفة، ومن العناصر الهامة التي تتسبب وتحافظ على الوضع الأدنى للنساء هو الجهل الممنهج الذي تفرضه الأبوية عليهن.
وبما أن التعليم والاقتصاد مترابطان بشدة في الدول المتقدمة، يصبح من الدال أن المستوى العام وأسلوب التعليم العالي للنساء، خاصة في الكثير من المؤسسات الباقية التي تمنع الاختلاط،
أقرب إلى عقلية عصر النهضة عنه إلى مهارات مجتمع العلوم والتكنولوجيا في منتصف القرن العشرين. هذا ونجد أن الأبوية تسمح، تاريخيًا، بقدر ما من معرفة القراءة والكتابة للنساء على حين أغلقت فرص التعليم العالي أمامهن. وعلى حين فتحت الأبوية المعاصرة، حديثًا إلى حد ما، كل المستويات التعليمية أمام النساء،46 إلا أن طبيعة وجودة التعليم ليست متساوية للجنسين، ويتضح هذا الفرق بالطبع في عمليات التكييف الاجتماعي المبكرة، لكنه يستمر ويتغلغل في التعليم العالي أيضًا. إن الجامعات، التي كانت ذات يوم أماكن للبحث وتدريب عدد قليل من المهنيين، أصبحت الآن تنتج أيضًا الموارد البشرية الفنية. لكن الأمر ليس كذلك بالنسبة للنساء، ذلك أن كلياتهن لا تنتج باحثات ولا مهنيات ولا فنيات، كما أنها في العادة لا تقام بواسطة الحكومات والشركات مثلما ينشئون كليات الذكور أو الكليات والجامعات المختلطة التي تستهدف بالأساس تعليم الذكور.
ومثلما تشجع الأبوية عدم التوازن المزاجي في سمات الشخصية بين الجنسين، كذلك تفعل مؤسساتها التعليمية، المختلطة وغير المختلطة، حيث تقدم برمجة ثقافية موجهة نحو التصنيف العام بين “الذكوري” و”الأنثوي”، فتصف الإنسانيات وبعض العلوم الاجتماعية (في فروعها الدنيا أو الهامشية) للأنثى، والعلوم والتكنولوجيا والمهنية وإدارة الأعمال والهندسة للذكر. وبالطبع ما زال توازن التشغيل والتمايز والتشجيع من نصيب الأخير. إن السيطرة على هذه المجالات هي شأن من شئون السلطة السياسية بامتياز، كذلك يمكن أن نشير إلى أن الهيمنة الحصرية للذكور على المجالات الأكثر تمايزًا تخدم مباشرة مصالح القوى الأبوية في الصناعة والحكومة والجيش. وحيث أن الأبوية تشجع عدم التوازن في المزاج بحسب الجنس، فإن كلا من قسمي التعليم (العلوم والإنسانيات) يعكسان هذا الخلل في التوازن. فالإنسانيات أقل تمايزًا لأنها لا تقتصر على الذكور، أما العلوم والتكنولوجيا وإدارة الأعمال، فلكونها تكاد تقتصر على الذكور، نجدها تعكس التشوه في الشخصية “الذكورية”، ممثلاً في بعض الطباع الجشعة أو العدوانية.
اتساقًا مع قلة شأن المجال الثقافي الذي تسعى الأبوية إلى اقتصار النساء عليه، فإن التشجيع الحالي لاهتماماتهن “الفنية” من خلال دراسة الإنسانيات ليس سوى امتدادًا “للإنجازات” التي حققنها سابقًا تحضيرًا للدخول إلى سوق الزواج. أما الإنجازات في مجال الفنون والإنسانيات فهي مقتصرة اليوم، مثلما كانت تاريخيًا، على الذكور، كما أن التمثيل الرمزي المتمثل في سوزان سونتاج Susan Sontag أو ليدي موراساكي Lady Murasaki لا يبطل القاعدة.
لم نعتد على ربط الأبوية بالعنف، ذلك أن نظام التكيف معها والالتزام بقيمها وطول فترة هيمنتها على المجتمع البشري بالكاد يجعلها مضطرة إلى اللجوء إلى العنف. وفي العادة ننظر إلى وحشيتها في الماضي باعتبارها أمرًا غريبًا أو عادة “بدائية”. أما العنف الذي يحدث في الوقت المعاصر فيُعتبر نتاج انحرافات فردية، ويقتصر إما على السلوك المرضي أو الاستثنائي دون تعميم. ومع ذلك، ومثلما الحال في ظل أي أيديولوجية شمولية (العنصرية والاستعمار مرادفان مناسبان في هذا الصدد)، ما كانت السيطرة في المجتمع الأبوي لتصبح كاملة، بل غير قابلة للتحقيق، دون أن تعتمد على حكم القوة سواء في الحالات الطارئة أو كإمكانية متاحة طوال الوقت للترهيب والتخويف.
فقد لجأت أغلب الأنظمة الأبوية تاريخيًا إلى مأسسة العنف أو القوة من خلال نظمها التشريعية. فعلى سبيل المثال حرمت النظم الأبوية الحازمة، مثلما في الإسلام، الاستقلال الجنسي أو العلاقات الجنسية غير الشرعية وعاقبتها بالموت. وما زالت الزانية تتعرض للرجم في أفغانستان والسعودية تحت إشراف أحد الشيوخ الحاضرين لعملية الرجم. وقد كان القتل عن طريق الرجم بالحجارة في الماضي وسيلة شائعة في أنحاء الشرق الأدنى، وما زال قائمًا في جزيرة صقلية. ولسنا بحاجة إلى القول بأنه لم ولا توجد عقوبة للشريك الذكر، فباستثناء الزمن القريب أو حالات استثنائية، لم يكن الزنا معترفًا به في حالة الذكور إلا باعتباره تعديًّا يمارسه أحد الذكور على ملكية ذكر آخر. في طوكوجاوا باليابان، على سبيل المثال، توجد حزمة تفصيلية من التمييز القانوني في هذا الشأن تختلف باختلاف الطبقة، فمن حق الساموراي، بل ومن واجبه إزاء الرأي العام، أن يقتل الزوجة الزانية، على حين يمكن للمواطن العادي أو المزارع أن يتعامل مع الأمر كيفما يشاء. ففي حالات الزنا عبر الطبقات، يتعرض الذكر من الطبقات الدنيا والمدان في ممارسة الجنس مع زوجة رئيسه في العمل، لقطع الرقبة هو وإياها، لأنه انتهك محرمات الطبقة والملكية. وبالطبع كان لذكور الشرائح العليا نفس الرخصة في إغواء نساء الطبقات الدنيا مثلما هو شائع في المجتمعات الغربية. وبشكل غير مباشر، هناك شكل من أشكال “عقوبة الإعدام” ما زال قائمًا حتى في أمريكا اليوم. ذلك أن النظم القانونية الأبوية، من خلال حرمان النساء من التحكم في أجسادهن، تدفعين نحو الإجهاض غير القانوني؛ وتشير التقديرات إلى أنه ما بين ألفي إلى خمسة آلاف امرأة يتوفين في كل عام نتيجة هذا السبب.47
وباستثناء الرخصة الاجتماعية لاستخدام سوء المعاملة الجسدية بين بعض الجماعات الطبقية والعرقية، ينتشر العنف في أغلب الأنظمة الأبوية المعاصرة. وتجدر الإشارة إلى أن العنف نفسه مقتصر على الذكر القادر نفسيًا وعمليًا على ممارسة العنف الجسدي.48 وحيث تلاشت أهمية القوة الجسدية بسبب استخدام السلاح، تبقى الأنثى غير ممارسة للعنف بسبب تنشئتها الاجتماعية، وأمام الاعتداء عليها تكاد تكون الأنثى دائمًا غير قادرة على الدفاع عن نفسها بسبب تنشئتها الجسدية والوجدانية. ولسنا بحاجة إلى القول إن لذلك آثاره طويلة المدى على السلوك الاجتماعي والنفسي لكل جنس.
يعتمد عنف الأبوية أيضًا على وجه الخصوص على العنف ذي الطبيعة الجنسية الذي يتحقق في أوضح أشكاله في فعل الاغتصاب. ولا تمثل إحصائيات الاغتصاب المنشورة سوى قدرًا قليلاً من الحالات الفعلية،49 حيث أن “العار” المرتبط بالحدث كاف لمنع النساء من الإبلاغ ورفع الدعاوى في ضوء الطبيعة العلنية للمحاكمة. ويُعتبر الاغتصاب، تاريخيًّا، اعتداء يمارسه ذكر على ذكر آخر – من خلال الاعتداء على “امرأته”، ويستهدف الثأر، مثلما يمارس في الجنوب الأمريكي، إرضاء الذكر وإثارة الكراهية العنصرية وخدمة مصالح الملكية والشرف. وفي حالات الاغتصاب تتخذ مشاعر العدوان والكراهية والاحتقار والرغبة في تحطيم أو انتهاك الشخصية شكلاً يتناسب مع السياسات الجنسية. وفي الفقرات التحليلية التي وردت في بداية هذه الدراسة رأينا كيف كانت هذا المشاعر قائمة بدرجة ما ومثلت عنصرًا محوريًا في تفسير اللغة واللهجة التي استخدمتها الكاتبة. 50
لقد اعتادت المجتمعات الأبوية على الربط ما بين مشاعر القسوة والجنسانية، حيث الأخيرة غالبًا ما تتساوى مع الشر والسلطة. وهو ما يتضح في الخيال الجنسي الذي يكشف عنه التحليل النفسي، كما فيما يكشف عنه التصوير الإباحي. فالقاعدة هنا أن السادية مرتبطة بالذكر (الدور الذكوري) والضحية بالأنثى “الدور الأنثوي”. 51 ومن اللافت للنظر أن رد الفعل الوجداني تجاه العنف ضد النساء في المجتمع الأبوي غالبًا ما يكون متذبذبًا؛ حيث غالبًا ما تثير روايات ضرب النساء، على سبيل المثال، الضحك وبعض الشعور بالإحراج. أما الأعمال الوحشية، مثل القتل الجماعي الذي ارتكبه ريتشارد سبيك Richard Speck، والذي قوبل أحيانًا بنوع من السخط المنافق باعتباره فضيحة، قادرة على إحداث رد فعل جماعي طريف في أحيان أخرى، إذ قد نسمع في مثل تلك المواقف رجالاً يعبرون عن الحسد أو التسلية. وفي ضوء الطابع السادي للخيال الجمعي الذي يخاطب جمهور الذكور في الإعلام الإباحي أو شبه الإباحي، يمكن للمرء أن يتوقع أن الأمر لا يخلو على الإطلاق من درجة ما من التوحد مع الحدث، وقد يكون ذلك شبيهًا بالرعشة التي يشعر بها المجتمع العنصري حين يمارس أفراده عمليات الجلد. وعلى مستوى اللاوعي قد تخدم الجريمتان الجماعة الأوسع باعتبارهما طقسًا ما يبعث على الشعور بالراحة وتفريغ الطاقة.
تعبر العدوانية عن نفسها بعدة طرق، أحدها الضحك. فالأدبيات الكارهة للنساء، وهي الوسيلة الرئيسة للعدوانية الذكورية، تحمل في طياتها العظة والفكاهة في نفس الوقت، وهي أكثر وسائل الدعاية وضوحًا بين كل الأشكال الفنية في الأبوية، وهدفها هو تشجيع استمرار التصنيفات الجنسية. وقد تضمنت أدبيات العصور القديمة والقرون الوسطى وعصر النهضة عناصر ضخمة من كراهية النساء.52 كما لا ينقص الشرق التقاليد العتيقة في هذا الشأن، خاصة في الكونفوشيوسية التي انتشرت في اليابان والصين كذلك. أما التراث الغربي فقد كان مقيدًا إلى حد ما في هذا الشأن مع ظهور الحب الأفلاطوني، لكن المساجلات والهجمات القديمة كانت متزامنة مع ظهور فكرة تمجيد النساء. ففي حالة الشاعر بترارخ Petrach والكاتب بوكاشيو Boccaccio وغيرهما, يمكن أن نجد تعبيرًا قويًا عن الموقفين، كدليل على الأرجح على اختلاف الحالات المزاجية، أو كموقف نبيل مستمد من الاحتياجات العابرة للعامة. 53 ومع تحول الحب الأفلاطوني إلى الحب الرومانسي فقد الأدب الكاره للنساء بريقه. وشهد القرن الثامن عشر في بعض الأماكن انحدار هذا النوع من الأدب إلى الهجاء الساخر والجارح، وبحلول القرن التاسع عشر اختفت أشكاله اللاذعة تمامًا تقريبًا من الأدبيات الإنجليزية. أما عودته من جديد في مواقف وأدبيات القرن العشرين فهو نتيجة لرفض أي إصلاح في المنظومة الأبوية، يدعمه في ذلك اتساع مساحة حرية التعبير الذي حدث بمعدلات سريعة خلال الخمسين عامًا الماضية.
ومع انحسار الرقابة، أصبحت العدوانية الذكورية (النفسية أو الجسدية)، خاصة في السياق الجنسي، أكثر ظهورًا ووضوحًا. ورغم استمرارية العدوانية الذكورية فإن ما نحن بصدده هنا ليس مجرد زيادة في العدوانية بقدر ما هو صراحة جديدة في التعبير عن العدوانية في السياق الجنسي على وجه الخصوص. إنه لأمر مرتبط بالتفريغ والحرية أن يتمكن الإنسان من التعبير عما كان محرمًا في السابق خارج إطار المجال الإباحي أو أي مجالات “سرية” أخرى مثل كتابات دي ساد De Sade. عندما نتذكر رقة التعبير والمثالية في وصف الجماع عند شعراء العصر الرومانسي (على سبيل المثال قصيدة الشاعر كيتس: Keats, “Eve of St. Agnes”) أو لدى روائيي العصر الفيكتوري (على سبيل المثال هاردي Hardy) ونقارنها بكتابات ميللر Miller أو ويليم بوروWilliam Burroughs ,تصبح لدينا فكرة عن أن الأدب المعاصر لم يستلهم التعبير الصريح في الكتابات الإباحية فحسب، بل وأيضًا طابعها الضد اجتماعي، فمنذ مُنح هذا الميل للإساءة أو الإهانة حرية التعبير، أصبح من الأسهل بكثير بحث العداء الجنسي لدى الذكر.
يقدم تاريخ الأبوية أشكالاً مختلفة للقسوة والأفعال البربرية: مثل ممارسة الـ “ساتي” أي قتل الأرملة في الهند، التشويه الشديد نتيجة ربط الأقدام في الصين، ما يرتبط بفرض الحجاب في الإسلام، أو انتشار ممارسة حبس النساء في حدود فناء المنزل مع الاحتجاب التام، وممارسات مثل ختان الإناث، وبيع أو استعباد النساء تحت أي مسمى، والإجبار على الزواج، وتزويج الأطفال، واتخاذ المحظيات أو الدعارة. إنها كلها ممارسات ما زالت قائمة – في أفريقيا وفي الشرق الأدنى والأقصى بل وفي شتى أماكن العالم. إن المبرر الذي يصاحب هذا الفرض لسلطة الذكر، والذي يطلق عليه مجازًا اسم “الحرب بين الجنسين”، يحمل أوجه شبه كثيرة مع وصف الأمم المتحاربة، حيث هي فظاعة مبررة على أساس أن العدو من الجنس الأدنى أو حتى لا ينتمي إلى الجنس البشري أصلاً. وما زالت هذه المعتقدات التقليدية تغزو وعينًا وتؤثر على تفكيرنا بدرجة قد لا يرغب سوى قلة منا الاعتراف بها.
تشهد الدلائل من الأنثروبولوجيا والأساطير الدينية والأدبية على الطابع السياسي النفعي للقناعات الأبوية بشأن النساء. إذ يشير أحد علماء الأنثروبولوجيا إلى منظومة أبوية مستقرة من الافتراضات بأن “الاختلافات البيولوجية لدى المرأة هي ما تجعلها أقل شأنًا” وحيث أن “المؤسسات البشرية تنمو من مخاوف عميقة وبدائية وتتشكل من خلال عمليات نفسية غير منطقية .. فإن المواقف الاجتماعية من النساء تصدر عن توترات بدائية يعبر عنها الذكر.”54 وفي ظل الأبوية لم تكن صفات الأنثى أو الرموز المشيرة إليها صنيعتها هي. وحيث أن كلا من العالم البدائي والعالم المتحضر عوالم ذكورية، فإن الأفكار التي شكلت الثقافة في علاقتها بالأنثى كانت هي أيضًا من تصميم الذكور. فصورة المرأة كما نعرفها هي صورة خلقها الرجال وشكلوها بحيث تناسب احتياجاتهم، وهي هذه الاحتياجات تنبع من الخوف من “الآخر” المتمثل في المرأة. لكن هذه الفكرة نفسها تفترض أن الأبوية قد استقرت وأن الذكر اعتبر نفسه النموذج البشري والموضوع والمرجع الذي يعتبر المرأة “أخرى” أو غريبة نسبة إليه، وبغض النظر عن مصدرها تبقى وظيفة العداء الجنسي الذكوري هي توفير الوسائل للتحكم في جماعة أقل شأنًا، وتبرير الوضع الأدنى لمن هم في منزلة أقل، و”تفسير” القمع الذي يتعرضون له في حياتهم.
إن هذا الشعور بأن الوظائف الجنسية للنساء تفتقد إلى الطهارة هو شعور دائم ومنتشر في شتى أنحاء العالم. ويمكننا أن نرى ما يدل عليه في كل مكان، في الأدب والأساطير وفي الحياة البدائية كما في المتحضرة. ومن اللافت للنظر أن هذه الفكرة ما زالت مستمرة إلى يومنا هذا. فالدورة الشهرية، على سبيل المثال، ما زالت حدثًا محاطًا بالسرية إلى حد كبير والوصمة المرتبطة بها لابد وأن لها تأثير شديد على الأنا الأنثوية. وهناك كم ضخم من الأدبيات الأنثروبولوجية حول التحريم المحيط بالدورة الشهرية، بل وما زالت ممارسة عزل “المذنبات” في أكواخ على أطراف القرية تتم في أنحاء العالم البدائي، كما أن اللغة الدارجة المعاصرة تصف الحيض “باللعنة”. وهنالك الكثير من الأدلة التي ترجح أن جذور عدم الراحة التي تشعر بها النساء أثناء هذه الفترة هي في كثير من الأحوال جذور نفسجسدية أكثر منها فسيولوجية، وثقافية أكثر منها بيولوجية. الأمر نفسه قد ينطبق على الحمل والولادة كما تشير التجارب الحديثة مع “الولادة بدون ألم”. ويبدو أن الظروف والمعتقدات الأبوية لها تأثير سام على شعور الأنثى بذاتها الجسدية، إلى أن يتحول ذلك إلى ذلك العبء الذي يتحدثون عنه.
تعتقد الشعوب البدائية أن الأعضاء الجنسية للأنثى جرح، فيقولون أحيانًا أن عصفورًا أو ثعبانًا زارها وشوهها لتصبح على هذه الحالة. وحيث أنها جُرحت، فقد أصبحت تنزف. المصطلح العامي للمهبل باللغة الإنجليزية هو الجرح البليغ (gash)، والوصف الفرويدي لأعضاء الأنثى يستخدم مصطلحات مثل “الخصي”. وحالة التوتر والقرف التي تثيرها الأعضاء الجنسية للأنثى في المجتمعات الأبوية يدل عليها الحظر الوارد في الأديان والثقافات والأدب. ونجد في الجماعات البدائية أن الخوف يمثل أيضًا عنصرًا في هذا الشأن، حيث يسود الاعتقاد بأن المهبل يخصي من خلال أسنان تنمو داخله (Vagina dentata). أما القضيب، رمز تفوق الذكر في المجتمعات الأبوية البدائية والمتحضرة، فيُمنح أهمية خارقة، كما أنه مصدر للفخر اللانهائي، وأيضًا القلق اللانهائي.
كما تحرم كل الأنظمة الأبوية تقريبًا على النساء لمس الأدوات المستخدمة في الطقوس الحربية أو الدينية أو الطعام. ففي المجتمعات القديمة والبدائية لم يكن يُسمح للنساء بشكل عام أن يتناولن الطعام مع الرجال. وإلى يومنا هذا ما زالت النساء تأكل منفصلة عن الرجال في عدد كبير من الثقافات، خاصة في الشرق الأدنى والأقصى. ويبدو أن بعض الأسباب وراء هذه العادة تعود على الأرجح إلى الخوف من التلوث الجنسي، فقد تُجبر الإناث من خلال عملهن كخادمات في المنازل على تحضير الطعام، وفي نفس الوقت قد ينشرن العدوى من خلال ذلك. إن هذا الوضع شبيه بوضع الملونين في الولايات المتحدة، حيث يُعتبرون قذرين وناقلين للعدوى، ومع ذلك يُجبرون، كخدم في المنازل، على إعداد الطعام لأسيادهم. وفي كلتا الحالتين تحل المعضلة بطريقة بائسة وغير منطقية من خلال الفصل بين فعل تناول الطعام وإعداده، حيث يتم طهيه بعيدًا عن مرمى البصر بواسطة الجماعة ذاتها التي يُخشي من تلويثها مائدة الطعام. وفي اتساق يستحق الإعجاب، لا يسمح بعض ذكور الهندوس لزوجاتهم بلمس الطعام نهائيًا. ففي كل جماعة أبوية تقريبًا، من المتوقع أن يأكل الذكر المهيمن أولاً أو أن يتناول الطعام الأفضل، وحتى في الحالات التي يتناول فيها الجنسان الطعام معًا، تقوم الأنثى على خدمة الذكر.55
وقد أحاطت كل الأنظمة الأبوية العذرية وفضها بطقوس وممنوعات تفصيلية، إذ تطرح العذرية بين الشعوب البدائية مشكلة مثيرة للاهتمام فيما يخص تذبذب الموقف منها. فهي، من ناحية، مثلما هو الحال في كل نظام أبوي، خير غامض، لأنها دليل على أن الملكية المنقولة سليمة. لكنها من ناحية أخرى تمثل شرًا غير معروف مرتبط بسحر الدماء و”الآخر” المخيف. وقد يصل الاحتفاء بفض البكارة حد استعداد العريس – المالك في العديد من القبائل – أن يتنازل عن فض ختم ممتلكاته الجديدة لشخص أقوى أو أكبر سنًا، قادر على التعامل مع الأخطار المحدقة. 56 ويبدو أن الخوف من فض البكارة ينبع من الخوف من الجنسانية الغريبة للأنثى، فعلى الرغم من أن أي ألم مصاحب لعملية الفض يكون من نصيب الأنثى (وأغلب المجتمعات تتسبب لها في الكثير من المعاناة الجسدية والنفسية) إلا أن المصلحة الاجتماعية، المتجسدة في العادات والطقوس الأبوية، تنحاز تمامًا إلى مصالح الملكية والتمايز الخاصة بالذكر، أو المخاطر التي قد يتعرض لها، كما في بعض المجتمعات الأبوية.
وتصف الأسطورة الأبوية عصرًا ذهبيًا قبل ظهور النساء، على حين تسمح ممارساتها الاجتماعية للذكور بالتخفف من صحبة النساء. ويسود الفصل الجنسي في إطار الأبوية حتى أننا نجد دليلاً عليه في كل شيء، فكل دوائر السلطة في الأبوية المعاصرة تكاد تكون دوائر من الذكور، لكن الرجال يشكلون أيضًا مجموعاتهم الخاصة على كل مستوى. ومجموعات النساء تتسم في العادة بكونها ثانوية أو تابعة، تقليدًا لجهود الذكور وأساليبهم، عابرة وأقل أهمية. وقلما تعمل هذه المجموعات دون عودة أو استدعاء للسلطة الذكرية، حيث تستند مجموعات الكنيسة أو المجموعات الدينية إلى السلطة الأعلى لرجل الدين، والجماعة السياسية إلى المشرعين من الرجال، الخ.
وفي المواقف التي لا يكون فيها اختلاط بين الجنسين تتضح بشدة السمات الخاصة بالمزاج المقبول ثقافيًا. يصح هذا الأمر على وجه الخصوص في المنظمات التي تقتصر على الرجال التي تشير إلها الدراسات الأنثروبولوجية باسم “مؤسسات بيوت الرجال” (Men’s house institutions). بيوت الرجال هي قلعة من العلاقات والمشاعر الأبوية، وفي المجتمعات البدائية كانت بيوت الرجال تساهم في تقوية الخبرة الذكورية الجماعية من خلال الرقص والشائعات والضيافة والترفيه والطقوس الدينية، كما كانت تحوي أيضًا ترسانات السلاح الخاصة بالذكور.
وقد أشار ديفيد ريزمان إلى أن الألعاب الرياضية والأنشطة الأخرى تمنح الذكور تضامنًا لا يهتم المجتمع بمنحه للإناث. 57 وعلى حين قد يلعب الصيد والسياسة والدين والتجارة دورًا إلا أن الألعاب الرياضية والحرب هي الأساس الرئيس لتماسك الرفاق فيما بينهم في بيوت الرجال. والباحثون في ثقافة بيوت الرجال، بداية من هاتون وبستر Hutton Webster وهاينريخ شورتس Heinrich Schurtz، إلى ليونيل تايجر Lionel Tiger، يميلون إلى لعب دور المحارب المحب لجنسه، الذي يستهدف تبرير عملية الفصل الجنسي في مؤسسته. 58 يعتقد شورتس أن الألفة الفطرية والدافع نحو المتعة الأخوية بين الأقران هي التي تدفع بالذكر بعيدًا عن الصحبة الأدنى والمقيدة للنساء. وعلى الرغم من قناعته بوجود “رابطة غريزية” غامضة لدى الذكور، يبذل تايجر جهدًا منظمًا لينصح المجتمع بالحفاظ على تقليد بيوت الرجال من الاندثار. أما الوظيفة الأساسية للمؤسسة، باعتبارها مركز سلطة في سياق الفصل الجنسي، فهي جانب من الظاهرة كثيرًا ما لا يحظى بالانتباه اللازم.
تؤدي بيوت الرجال في ميلانيزيا عدة أغراض، إضافة إلى كونها ترسانة سلاح ومكانا لاحتفالات وطقوس استهلال الذكورة. ولا يختلف الشعور العام في بيوت الرجال كثيرًا عن المؤسسات العسكرية في العالم الحديث، حيث تفوح منها رائحة الجهد الجسدي والعنف وروح القتل وخفقان مشاعر الجنسية المثلية. إنها مسرح تقديم الأضاحي واحتفالات الصيد وجلسات التفاخر. هنا يتم تقوية وتجهيز الشباب ليصبحوا رجالاً، أما الصبية فقيمتهم شديدة الضآلة في بيوت الرجال حتى أنهم يوصفون بأنهم “زوجات” مرشديهم، ومصطلح “الزوجة” هنا يشير إلى قلة الشأن وكونهم موضوعات للجنس. فالشباب الذي لم يصل إلى مرحلة الرجولة بعد يصبح محل الاهتمام الجنسي لمن هم أكبر وأفضل منهم، وهي العلاقة التي نجدها أيضًا في نظام الساموراي وفي كهنوت الشرق وساحة الألعاب الرياضية في اليونان. وتقول الحكمة البدائية أنه قبل غرس أخلاقيات الذكورة في الصغير يجب أولاً ترهيبه من الوضع الأدنى للأنثى. ونجد دراسة أنثروبولوجية لبيوت الرجال في ميلانيزيا تساويها بالعالم السري لدى جينيه Genet أو الجيش الأمريكي عند مايلر Mailer: “يبدو أن القسوة الجنسية مع الصبي الشاب والجهد المبذول لتحويله إلى امرأة يعزز رغبة المحارب القديم في السلطة ويشبع شعوره بالعدوانية تجاه المنافس الذكر الذي ما زال في طور النضوج. وفي النهاية، حين يضمه إلى جماعة الذكور، تعزز التضامن الذكوري في محاولته الرمزية الاستغناء عن النساء،” 59 فإن التقليل من شأن الأنثى هو سمة أبوية ثابتة. ومثل أي عملية قاسية، تنتج عملية الاستهلال، عند من يتمكنون من تحملها واجتيازها، أنصارًا يمارسون العملية ذاتها بكثير من السعادة ويتسببون للقادمين الجدد في نفس المعاناة التي مروا بها.
إن مصطلح التحليل النفسي الذي يصف حالة المراهقة العامة السائدة في ثقافة بيوت الرجال هو “الحالة القضيبية”، أي قلاع من الفحولة، تكرس أكثر صفات الأبوية تجسيدًا للسلطة والقوة. وقد أكد عالم أنثروبولوجيا التحليل النفسي المجري جيزا روهايم Geza Roheim على الطابع الأبوي لتنظيم بيوت الرجال في القبائل البدائية التي درسها، ووصف ممارساتها الطائفية والدينية باعتبارها “مجموعة من الرجال تتوحد في عبادة موضوع يتخذ شكل القضيب، وتستبعد النساء من مجتمعها.” 60 وتتميز نبرة وأخلاقيات ثقافة بيوت الرجال بالسادية، وتتمركز حول القوة والسلطة، كما أنها تتصف أيضًا بالمثلية الجنسية الكامنة، التي كثيرًا ما تكون نرجسية في طاقتها ودوافعها.61
كذلك فإن استدلال بيوت الرجال بأن القضيب سلاح، يتساوى تمامًا مع أي سلاح آخر، واضح للغاية. إن ممارسة إخصاء السجناء هي في حد ذاتها لها دلالة على الخلط الثقافي بين التشريح والمكانة وبين التسليح. وينبع الكثير من تبجيل الرفاقية الذكورية في الحروب من ما يمكن أن نصفه بـ “روح بيوت الرجال”، حيث تتنكر جوانبها السادية والوحشية في شكل المجد العسكري ونموذج هزلي من الحساسية الذكورية. وهناك جزء كبير من ثقافتنا يتقاطع مع هذا التقليد، وقد نجد أول أثر له في الأدب الغربي في الحميمية البطولية بين باتروكلوس Patroclus وأخيل Achilles. كما يمكن تتبع تطوره عبر الأساطير والحكايات وحتى نشيد البطولة (chanson de geste). وما زال التقليد مزدهرًا في روايات وأفلام الحرب، ناهيك عن الكتب المصورة.
ويشهد بيت الرجال الكثير من النشاط الجنسي، ولسنا بحاجة إلى القول بأنه نشاط مثلي. لكن تحريم السلوك الجنسي المثلي (على الأقل بين الأنداد) له سطوة أقوى بكثير من الرغبة، ويسعى إلى إعادة توجيه الطاقة الجنسية نحو العنف. وهو ارتباط بين الجنسانية والعنف يمثل على وجه الخصوص عقلية ذات طابع عسكري. 62 والطابع السلبي والعسكري للمثلية الجنسية، في بيوت الرجال، ليس بأي حال من الأحوال متطابقًا مع حس المثلية الجنسية. بل إن الحالة العقلية للمحارب، بكل ما بها من فحولة مفرطة، لا تتجاوز كونها مثلية بدائية أو ضمنية في توجهها الذكوري أكثر منها مثلية صريحة، (وتمثل الخبرة النازية مثالاً صارخًا في ذلك). كذلك فإن لعب أدوار الغيرية الجنسية واحتقار الأعضاء الأصغر سنًا والأقل خشونة والأكثر “أنوثة” يدلان على أن المبدأ الأساسي هنا هو كراهية النساء، أو الغيرية الجنسية المشوهة أكثر منها الإيجابية. وبالتالي فإن الإلهام الحقيقي وراء منظمات بيوت الرجال ينبع من الحالة الأبوية أكثر منها من أي ظروف متأصلة في علاقات الحب بين البشر.
وإذا لم يكن الموقف الإيجابي من الحب الجنسي الغيري من اختراع القرن الثاني عشر تمامًا (كما ورد في الرأي الشهير لساينبوس Seignebos)، يمكن مع ذلك القول بأنه حدث جديد. أغلب النظم الأبوية تبذل جهدًا كبيرًا لاستبعاد الحب كأساس لاختيار الشريك. فالأبويات المعاصرة تفعل ذلك باستخدام العوامل الطبقية والعرقية والدينية، والفكر الغربي التقليدي كان أقرب إلى أن يرى في الحب الجنسي الغيري إما ضربة قاتلة من سوء الحظ لابد وأن تنتهي بمأساة، أو تقاربًا حيوانيًا
ومثيرًا للاحتقار مع من أهم أقل شأنًا. وكان الموقف العام في العصور الوسطى حازمًا في قناعته بأن الحب خطيئة إن كان جنسيًا، وأن الجنس خطيئة إن كان محبًا.
يمارس المجتمع البدائي كراهيته للنساء من خلال التحريم والسحر الذي يتحول إلى أساطير تفسر تلك الكراهية، بينما يتحول ذلك في الثقافات التاريخية إلى مبررات أخلاقية ثم إلى كتابات أدبية، ثم إلى تبريرات علمية للسياسات المتحكمة في الجنس في العصر الحديث. وتُعد الأسطورة بالتأكيد تقدمًا موفقًا على المستوى الدعائي، حيث أنها كثيرًا ما تسند حججها إلى الأخلاقيات أو نظريات الأصول. أما أهم أسطورتين في الثقافة الغربية في هذا الشأن فهما الرواية الكلاسيكية لصندوق باندورا وقصة السقوط في الإنجيل. وفي كلتا الحالتين مرت روايات السحر عن الشر الأنثوي عبر مراحل أدبية انتهت إلى أن أصبحت مبررًا أخلاقيًا شديد التأثير لاستمرار الأمور على ما هي عليه.
يبدو أن باندورا هي نسخة أدنى من آلهة الخصوبة في منطقة الشرق الأوسط، حيث أنها في ملحمة “ثيوجوني” Theogony لهسيود Hesiod ترتدي إكليلاً من الورود وتاجًا من القماش منقوشًا عليه كل مخلوفات الأرض والبحر. 63 ويرجع هسيود لها بداية الجنسانية التي تضع نهاية العصر الذهبي “حين كان الرجال من مختلف الأعراق يعيشون على الأرض، أحرارًا من كل الشرور، أحرارًا من العمل المضني، وأحرارًا من كل الأمراض المهلكة.”64 أما باندورا فكانت هي أصل “جنس النساء الملعون، ذلك الطاعون الذي يجب أن يتعايش معه الرجال”. 65 وقد بدأ استحداث ما اعتُبر شرور عالم الذكور البشري مع استحداث الأنثى ومعها خاصيتها الفريدة، الجنسانية. ففي كتاب الأعمال والأيام (Works and Days) يتناول هسيود تفاصيل باندورا وما تمثله من إغواء محفوف بالمخاطر “له عقل العاهرة وطبيعة كاذبة”، مليء “بقسوة الرغبة والاشتهاء التي تستهلك الجسد”. “وأكاذيب وكلمات ماكرة وروح مخادعة”، إنها كمين أرسله زيوس “ليتسبب في خراب الرجال”. 66
إن الله يقف إلى جانب الأبوية. ومن أهم وسائل الأبوية في التحكم والسيطرة هي الطابع السريع والحازم لتعاليمها فيما يتعلق بطبيعة وأصل الأنثى وتحميلها وحدها المخاطر والشرور التي تنسبها إلى الجنسانية. وهنالك مثل يوناني مثير للاهتمام في هذا الشأن: حين يرغب في الاحتفاء بالجنسانية يحتفي بالخصوبة من خلال القضيب؛ وحين يرغب في تشويه الجنسانية يقتبس من باندورا. ويميل الدين والتعاليم الأخلاقية الأبوية إلى الجمع ما بين الأنثى والجنس، وكأن العبء الكامل للمسؤولية والوصمة المرتبطة بالجنس يقع على الأنثى وحدها، وبذلك يصبح الجنس، المعروف بأنه قذر وخاطئ وموهن، مرتبطًا بالأنثى، على حين تبقى هوية الذكر بشرية أكثر منها جنسية.
وأسطورة باندورا واحدة من مثالين غربيين يدينان الأنثى من خلال جنسانيتها ويفسران وضعها باعتباره عقابًا مستحقًا على الخطيئة الأولى التي ما زال الجنس البشري كله يعاني من تبعاتها المؤسفة. ثم دخلت الأخلاقيات إلى الصورة لتحل محل الطقوس والمحرمات والسحر البدائي. يحمل الوسيط الأكثر تطورًا للأسطورة أيضًا تفسيرات رسمية للتاريخ الجنسي. ففي أسطورة هسيود, حين يرسل زيوس، كنموذج للأب الحقود والمستبد، شرور أبيمثيوس على شكل الأعضاء الجنسية للأنثى، فإنه في الواقع يعاقبه على معارفه ونشاطه الجنسي الغيري عند البلوغ. ومن خلال فتحه للوعاء الذي تأتي به (الفرج أو غشاء البكارة، صندوق باندورا) يشبع الذكر فضوله، لكنه يتحمل عبء المعرفة فقط من خلال معاقبة نفسه بيد الإله الأب عن طريق الموت والكوارث المرتبطة بالحياة بعد السقوط. هنا نشهد استمرارًا لعنصر المنافسة الذكورية عبر العمر والمكانة، خاصة تلك القائمة بين الأب المتسلط والابن المنافس، إلى جانب استمرار صفة المكر في الأنثى.
وتمثل أسطورة السقوط نسخة منمقة بشدة لذات الموضوعات. وحيث أنها تمثل الأسطورة المركزية في الخيال اليهودي والمسيحي ومن ثم أيضًا في تراثنا الثقافي المباشر، يجدر بنا أن نقيم ونعترف بالسطوة الخارقة التي ما زالت تفرضها علينا حتى ونحن في عصر المنطق العقلي الذي تخلى منذ زمن طويل عن الإيمان الحرفي بها، مع الاحتفاظ بعنصرها الوجداني. 67 وما زالت هذه النسخة الأسطورية للأنثى، باعتبارها سبب معاناة ومعرفة وخطيئة البشرية، تمثل الأساس للمواقف من الجنس، حيث أنها تطرح الحجة الأهم على الإطلاق في التراث الأبوي الغربي.
وقد عاش بنو إسرائيل في حالة من الحرب المستمرة مع طقوس الخصوبة لجيرانهم؛ وحققت هذه الأخيرة قدرًا من الجاذبية، بحيث أصبحت سببًا دائمًا للعصيان. وتحمل شخصية حواء، مثل شخصية باندورا، بقايا إلهة خصوبة مهزومة. وهناك بعض الدلائل على ذلك، قد تكون في اللاوعي، وفي النصوص الإنجيلية التي تذكر، حتى قبل أن تبدأ رواية السقوط، أن “آدم أطلق على زوجته اسم حواء، لأنها كانت أم كل الأشياء الحية”. وحيث أن الرواية تمثل مجموعة من التقاليد الشفهية المختلفة، فإنها تقدم روايتين متناقضتين لخلق حواء، في إحداهما خُلق الجنسان في نفس الوقت، وفي الثانية خلقت حواء لاحقًا على آدم. إن فكرة كونها لاحقة تكونت من ضلعه هي حدث يؤكد على احتكار الذكر لقوة الحياة من خلال إله خلق العالم بدون تدخل من الأنثى.
تمثل أسطورة آدم وحواء، ضمن أمور أخرى، سردًا لكيفية اختراع البشرية للجماع الجنسي. وقد ظهر الكثير من تلك الروايات في الأساطير والحكايات البدائية، ويبدو أغلبها لنا الآن روايات مسلية للبراءة البدائية التي تحتاج إلى قدر غير قليل من الشرح لفهمها. لكن هناك أيضًا موضوعات أخرى هامة في الرواية: فقدان البساطة البدائية، قدوم الموت، الخبرة الواعية الأولى بالمعرفة. وكلها تدور حول الجنس. إن آدم ممنوع من أكل ثمرة الحياة أو معرفة الخير من الشر، والتحذير يوضح بدقة ما سوف يحدث إن ذاق الثمرة المحرمة: “يوم تأكل منها موتًا تموت”. لكنه يأكل ولا يموت (على الأقل في الرواية)، ما قد نستنتج منه أن الحية قالت الصدق.
لكن لحظة أن يأكل الزوجان من الشجرة المحرمة يدركان عريهما ويشعران بالعار، فالأمر يتعلق بالجنسانية بوضوح، رغم إصرار الأسطورة على أنها أمر هامشي نسبة إلى التحريم الأكبر لعصيان الأوامر في أمر يرتبط برغبة أخرى وأقل إثارة للخلاف، أي الرغبة في الطعام. هذا ويشير روهايم أن فعل “الأكل” بالعبرية يشير أيضًا إلى الجماع. ونجد في كل موقع من الإنجيل تترادف “المعرفة” بالجنسانية، التي هي بوضوح نتيجة للاتصال بالقضيب، المتجسد في الأسطورة في هيئة حية. إن إلقاء اللوم بشأن شرور وآلام الحياة، الخروج من الجنة وكل ما تلاه، على الجنسانية كان لابد منطقيًا أن يشمل الذكر، لكن اتهام الذكر ليس هو الغرض من الرواية، التي صيغت على هذا الشكل تحديدًا لاعتبار الأنثى مسئولة عن كل مصاعب الحياة. لذلك فإن الأنثى هي التي تغوى أولاً “وتستدرج” بواسطة القضيب، الذي تجسد في شيء آخر، ألا وهو الحية. بذلك يكون آدم قد “نجح في التخلص” من الذنب الجنسي، الذي يفسر الكبت الشديد له في نصوص الإنجيل. لكن الرمزية الواضحة للغاية في ارتباط الحية بالقضيب في كافة المصادر تكشف عن ضعف منطق العقل الأسطوري وتحولاته. وبالتالي، فإن المرأة بدونيتها وضعفها تأخذ وتأكل، هي الكائن البدائي البسيط, متأثرة بالإطراء وإن صدر عن أحد الزواحف. بعد ذلك فقط يسقط الذكر ومعه البشرية كلها, حيث جعلت الأسطورة منه الفصيل الأصل وحواء ما هي إلا مخلوق جنسي، بحسب الرواية، قابل للاستغناء عنه أو الاستبدال. وحيث تسجل الأسطورة المغامرة الجنسية الأولى، آدم غوته امرأة، التي بدورها غواها قضيب. فقد جاء دفاع أول رجل في التاريخ قائلاً “المرأة التي جعلتها معي هي أعطتني من الشجرة فأكلت”، وحيث أنها ضعفت أمام غواية الحية – القضيب، أصبحت حواء متهمة بممارسة آدم للجنس.
إن لعنة آدم هي أن يكدح في “عرق جبينه”، أي العمل الذي يربط الذكور بينه وبين الحضارة. وقد كان الفردوس عالمًا خياليًا بدون جهد أو نشاط، دمره دخول الأنثى بما حملته من جنسانيتها. أما عقوبة حواء فهي ذات طابع سياسي أكثر من أي شيء آخر و”تفسير” عبقري لوضعها الأدنى: “تكثيرًا أكثر أتعاب حبلك بالوجع تلدين أولادًا وإلى رجلك يكون اشتياقك وهو يسود عليك” [سفر التكوين 16: 3]. وهكذا مرة أخرى، مثلما في أسطورة باندورا، يعاقب أب صارم أبناءه بسبب الجنسانية الغيرية في سنوات رشدهم. ومن السهل الاتفاق مع تعليق روهايم على الموقف السلبي الذي تتخذه الأسطورة تجاه الجنسانية: “النضوج الجنسي يُعتبر حظًا سيئًا، أمرًا حرم البشرية من السعادة … وتفسيرًا لكيفية مجيء الموت إلى العالم.” 68 أما الأمر الذي يتطلب مزيدًا من التأكيد علية هنا هو مسئولية الأنثى، ذلك المخلوق الهامشي، في التسبب في هذا الطاعون، وعدالة الحكم عليها بحالة أدنى باعتبارها صاحبة الدور الأساسي في تلك الخطيئة الأولى. وسنجد أن هذه العلاقة بين المرأة والجنس والخطيئة سوف تمثل الأساس لنمط الفكر الأبوي الغربي فيما بعد.
إن لكل من جوانب الأبوية التي تم وصفها تأثيره على التركيبة النفسية لكلا الجنسين. والنتيجة الرئيسة لذلك هي استبطان الأيديولوجية الأبوية. فالمكانة والمزاج والدور كلها نظم قيمية ذات تداعيات نفسية لانهائية على كل جنس، ويلعب الزواج الأبوي، والأسرة بمراتبها المختلفة وتقسيم العمل داخلها، دورًا هامًا في تطبيق تلك القيم. كما أن للوضع الاقتصادي الأعلى للذكر، والوضع الأدنى للأنثى أيضًا تداعيات خطيرة، إذ تنال الأنثى في ظل الأبوية نصيبًا كبيرًا من الشعور بالذنب المرتبط بالجنسانية، حيث تعتبرها الثقافة مذنبة أو أكثر الأطراف ذنبًا في أي علاقة جنسية، بغض النظر عن الظروف المخففة المحيطة بها. وهذا الميل نحو تشييء الأنثى يجعلها في كثير من الأحوال أداة جنسية أكثر منها شخصًا، وخاصة حين تُحرم من حقوقها الإنسانية بسبب وضعها التابع. وحتى حيث تمت معالجة هذا الأمر جزئيًا، يظل التأثير الجمعي للدين والعادات قويًا للغاية وله تبعات نفسية شديدة. فما زالت الحرية الجنسية محرمة على المرأة، وما زال التحكم قائمًا في جسدها من خلال طقوس العذرية والمعايير المزدوجة وتجريم الإجهاض، وفي كثير من الأماكن لا يتوفر لها استخدام وسائل منع الحمل ماديًا أو نفسيًا.
إن ذلك الإشراف المستمر الذي تعيش الأنثى في ظله يسعى إلى التأكيد على التعامل مع النساء كأطفال حتى في الحالات التي يحصلن فيها على درجات عالية من التعليم. فالأنثى تضطر دائمًا إلى السعي نحو البقاء أو التقدم من خلال موافقة الذكور باعتبارهم أصحاب السلطة. وقد تفعل ذلك من خلال التملق أو من خلال مبادلة جنسانيتها مقابل الحصول على الدعم والمكانة. وحيث أن لتاريخ الثقافة الأبوية وتصويرها في كافة مستويات الإعلام الثقافي، السابق والحالي، تأثيرًا مدمرًا على صورتها عن ذاتها، تُحرم الأنثى في العادة من كل شيء ما عدا القليل الذي يضمن لها قدرًا من احترام الذات أو الكرامة. وفي الكثير من الأنظمة الأبوية تقتصر اللغة والتراث الثقافي الحالة الإنسانية على الذكر، ففي اللغات الهندو – أوروبية لا نملك إلا أن نلحظ ذلك، حيث أنه رغم الادعاء المعتاد بأن “الإنسان” و”الإنسانية” مصطلحات تنطبق بالتساوي على الجنسين، إلا أن الحقيقة التي لا تكاد تخفى على أحد هي أن الاستخدام العام لها في الممارسة يفضل الذكر أكثر بكثير مما يشير إلى الأنثى أو يكاد يقتصر على الأول. 69
وحين تصاغ الأنا، في أية مجموعة من الأشخاص، وفي عدد بالغ من الصيغ، من خلال المعتقدات الاجتماعية والأيديولوجية والتقاليد، لابد وأن تصبح النتيجة شديدة الضر هذا بالإضافة إلى التحقير المستمر، حتى وإن كان في بعض الحالات ضمنيًا، والذي تتعرض له النساء يوميًا في تعاملاتهن الشخصية والتمييز الذي يتحملنه فيما يتعلق بالسلوك والتشغيل والتعليم. كل ذلك يجعلنا لا نندهش إن اكتسبت النساء كجماعة خصائص مثل تلك الشائعة بين الأقليات والجماعات المهمشة. هذا وقد قام فيليب جولدبرج Philip Goldberg بتجربة ذكية تثبت ما يعلمه الجميع، وهو أن استبطان حالة عدم الاحترام المحيطة بالنساء يؤدي إلى احتقارهن لأنفسهن وفيما بينهن. 70 ففي هذه التجربة البسيطة طُلب من عدد من الطالبات أن يقيّمن مقالاً وقعه بالتبادل كل من جون ماكاي John McKay وجوان ماكاي Joan McKay. وقد توافقت الطالبات في التقييم بشكل عام على أن جون مفكر رائع وأن تحليل جوان سطحي. لكن المقالين كانا متطابقين: فقد اعتمد تقييم الطالبات على جنس الكاتب الافتراضي.
ونظرًا إلى أن النساء في ظل الأبوية يُعتبرن في أغلب الأحوال مواطنات هامشيات، وذلك في حال اعتبارهن مواطنات من الأصل، يتشابه وضعهن مع وضع أقليات أخرى، حيث لا تعتمد صفة الأقلية على الحجم العددي للجماعة وإنما على مكانتها: “الأقلية هي أي مجموعة من البشر، يفرزها المجتمع عن باقي المجموعات في المجتمع الذي تعيش فيه، لكي تلقى معاملة خاصة وغير مساوية للباقين”. 71 ولو تنشغل سوى قلة قليلة جدًا من علماء الاجتماع بقدر من الجدية بوضع الأقلية للنساء. 72 وما زال على علم النفس أن يقوم بدراسات جادة بشأن الأضرار التي تصيب أنا الأنثى، الأمر الذي يمكن مقارنته بالأعمال الرائعة التي تناولت آثار العنصرية على نفسية الملونين والمستعمَرين إذ يشهد القدر القليل للغاية من البحوث الحديثة، التي اهتمت بالآثار النفسية والاجتماعية للتفوق الذكوري على الأنثى وعلى الثقافة بشكل عام، على الجهل أو عدم الاهتمام الشائع بين صفوف مجتمع العلوم الاجتماعية المحافظ الذي يفترض أن الأبوية هي الأمر الواقع والوضع الذي أملته الطبيعة.
وتؤكد الأدبيات القليلة التي قدمتها لنا العلوم الاجتماعية في هذا الشأن على الطباع المتوقعة لوضع الأقلية بين النساء: كراهية جماعية ورفض للذات، احتقار للنفس وللزميلات. ونتيجة لهذا التأكيد المستمر – مهما كان ضمنيًا أو خفيًا – على دونيتها ينتهي الأمر بالأنثى أن تقبله باعتباره حقيقة. 73 ومن السمات الأخرى لوضع الأقلية هي القسوة الشديدة التي يُحكم بها على أفراد جماعة الأقلية، ولا تطبق المعايير المزدوجة على السلوك الجنسي فحسب وإنما أيضًا على كل جوانب السلوك. وفي الحالات النادرة التي ترتكب فيها النساء جرائم، يُحكم على النساء في الولايات الأمريكية بعقوبات أشد من الرجال، 74 وفي العادة تحصل المرأة المدانة على إدانة اجتماعية غير متناسبة تمامًا مع جسامة فعلها، وبسبب التشهير الإعلامي قد تُحاكم في كثير من الأحوال بناء على “حياتها الجنسية”. ولكن تدريبها على السلبية في إطار الأبوية يكون على درجة من القوة والتأثير بحيث نادرًا ما نجد المرأة انبساطية بالدرجة الكافية التي تجعلها تلجأ إلى الجريمة بسبب تدني أوضاعها. ومثلما يجب على أي فرد في جماعة أقلية أن يعتذر عن تجاوزات زميله أو إدانته بحماس شديد، كذلك النساء، عادة ما يصبحن لاذعات وقاسيات وخائفات حين يعبر عن استهجانهن لأي تجاوز من جماعتهن.
إن السبب وراء القلق الشديد الذي يصيب أي فرد ضمن جماعة أقلية هو احتمال ثبوت صحة الأساطير المنتشرة بشأن دونيته، وقد يصل هذا القلق إلى حد التسبب في الشعور بعدم الأمان بين النساء. فمن النساء من يجدن صعوبة شديدة في احتمال وضعهن الأدنى بحيث ينكرن أو يكبتن وجوده أصلاً، بينما نجد أن عددًا كبيرًا منهن يدركن ويعترفن بالظروف المحيطة بهن حين يسألن عنها بطريقة ملائمة. وفي دراستين حول هذا الموضوع، تم طرح سؤال على النساء عما إذا كن يفضلن لو أنهن قد جئن إلى الحياة ذكورًا لا إناثًا. فاتضح في إحدى الدراستين أن رُبع النساء أكدن على ذلك بينما تمنى نصف عدد النساء ذلك في الدراسة الثانية. 75 وحين سُئل الأطفال عن هذا الأمر، ورغم كونهم أصغر سنًا من القدرة على استخدام آليات التجنب والإنكار، فضلت الإناث في أغلب الحالات لو أنهن ولدن ضمن الفئة الأكثر امتيازًا، على حين رفض أغلب الذكور فكرة أن يولدوا إناثًا. 76 ولسن بالطبع هنا بحاجة إلى التأكيد كثيرًا على ظاهرة تفضيل الأهل ميلاد الذكور. وفي ضوء الإمكانية التي قد تتاح في المستقبل حيث قد يتمكن الأهل من اختيار جنس المولود, يثير ذلك الأمر بعض القلق في الدوائر العلمية.77
ونجد أن الدراسات المقارنة، مثل التي أجراها ميردال Myrdal وهاكر Hacker وديكسون Dixon ,بين الصفات الممنوحة للملونين والنساء، تشير إلى أن الرأي السائد يرى في المجموعتين خصالاً مشتركة، هي: ذكاء منخفضًا، وميلاً للمتعة الغريزية أو الحسية، وطبيعة عاطفية بدائية وطفولية, وإقدامًا أو انجذابًا وهميًا في الأمور الجنسية، ورضا عن الأحوال كجماعة مما يدلل على التكيف مع تلك الأحوال، وميلاً إلى الخداع وإخفاء المشاعر. كما أن هاتين الجماعتين مجبرتان على اللجوء إلى نفس آليات التكيف: أداء متملق وتوسلي يستهدف كسب الرضا، وميل نحو دراسة نقاط الضعف أو إمكانيات إفساد الجماعة المهيمنة، وتجسيد حالة من العجز المفتعل مصحوبة بمناشدات خادعة للمساعدة وادعاء عدم المعرفة. 78 ومما يدعو للسخرية أن الأدبيات الكارهة للنساء ركزت على مدار قرون عديدة على تلك الخصال بالذات، وتناولت بعدوانية شديدة مكر وفساد الأنثى وخاصة من جوانبها الجنسية أو “الشهوانية” طبقًا لتلك الأدبيات.
وكما هو الحال في كل الجماعات الهامشية الأخرى، توجد حفنة من النساء يصلن إلى مرتبة أعلى تسمح لهن بالقيام بنوع من الرقابة الثقافية على الباقيات. وتتحدث دراسة هيوز Hughes عن الهامشية باعتبارها حالة من الإرباك تعيشها النساء والملونون والجيل الثاني من الأمريكيين الذين صعدوا اجتماعيًا، ورغم ذلك حُرموا من مردود جهودهم بسبب أصولهم. 79 وينطبق هذا الأمر على وجه الخصوص على النساء “الجديدات” أو المتعلمات، إذ تضطر تلك النماذج الاستثنائية عامة إلى الإدلاء بتصريحات إذعان متكررة، بل وساخرة، لتبرير صعودهن، فتتخذ تلك التصريحات في العادة شكل الإذعان “للأنوثة”، بمعنى الاستمتاع بالطاعة تجاه السلطة وتعبيرًا عن شهية كبيرة للسيطرة الذكورية. وأفضل الأشخاص للعب هذا الدور، سياسيًا، هم المهرجون ومن يقبلون القيام بأدوار تجعلهم موضوعًا جنسيًا علنيًا، فمن الشائع بين الأقليات أن يُسمح لنسبة قليلة من المحظوظين بتسلية حكامهم، كذلك نجد من بين النساء من تسلي وتُرضي وتمنح وتتملق الرجال بجنسانيتهن. وفي غالبية الأقليات يُسمح للرياضيين أو المفكرين أن يبرزوا “كنجوم”، على أن يكون التوحد معهم كافيًا لإرضاء زملائهم الأقل حظًا. ومن المنطقي أن مثل هذه الحالات الاستثنائية لا تلقى تشجيعًا في حالة النساء، على أساس أن أكثر التبريرات شيوعًا لوضعهن الأدنى تكمن في ضعفهن الجسدي أو دونيتين الفكرية، وبالتالي يصبح من المنطقي أن يكون إظهار الشجاعة أو القوة الجسدية أمورًا غير مقبولة، كما أنه من غير المناسب إظهار أي درجة جادة من الذكاء.
ولعل السلاح النفسي الأمضى للأبوية هو ببساطة انتشارها وديمومتها، ولا يكاد يكون لها مرادف بحيث يمكن مقارنتها به، فعلى حين يمكن أن ينطبق القول ذاته على الطبقة، إلا أن للأبوية تأثيرها الأكثر رسوخًا وتأثيرًا من خلال نجاحها المستمر في تصوير نفسها باعتبارها معبرة عن طبيعة الأمور. وحاليًا ينتشر الدين في المجتمع الإنساني، بينما كانت العبودية كذلك في الماضي، وفي كلتا الحالتين نجد دومًا من بين المدافعين عنهما من يفضلون الحديث بمنطق القدر أو “الغريزة” الإنسانية العصبة على التغيير، بل وحتى عن “الأصول البيولوجية”. فحين يتمكن نظام سلطوي من السيطرة، لا يصبح مضطرًا إلى التعبير عن نفسه بصوت عال؛ وحين ينكشف أداؤه ويصبح محل تساؤل، لا يصير موضوعًا للنقاش فحسب وإنما يغدو أيضًا عرضه للتغيير، وهو ما سنناقشه لاحقًا.
* Kate Millet, 1969. “Theory of Sexual Politics”, Sexual Politics, Kate Millet, University of Illinois Press, 2000, pp. 23- 58.
1 التعريف الرابع في قاموس التراث الأمريكي هو الأقرب إلى حد كبير: “أساليب أو تكتيكات ذات صلة بإدارة دولة أو حكومة” (American Heritage Dictionary, New York: American Heritage and Houghton Mifflin, 1996). ويمكننا أن نمد هذا التعريف ليشمل حزمة من الحيل التي تستهدف الحفاظ على نظام ما. وإذا اعتبرنا الأبوية مؤسسة استقرت باستخدام مثل هذه الآليات للسيطرة، يصبح لدينا تعريف عملي لمفهوم السياسة الوارد في هذا المقال.
2 يرجع الفضل هنا إلى رونالد سامسون لبحثه النابه عن العلاقة بين هياكل السلطة الرسمية وبين الأسرة، وتحليله لكيفية إفساد السلطة للعلاقات الإنسانية الأساسية في كتابه عن علم نفس السلطة (Ronald V. Samson, The Psychology of Power, New York: Random House, 1968)
3 “السيطرة بالمعنى العام جدًا للسلطة، أي إمكانية فرض رغبة الشخص على سلوك أشخاص آخرين، يمكن أن تتخذ أشكالاً شديدة التباين” في هذه الفقرة المحورية من المجتمع يركز فيبر على وجه الخصوص على شكلين: التحكم من خلال السلطة الاجتماعية (“الأبوية، القضاء، الملكية”) والتحكم من خلال القدرة الاقتصادية. في الأبوية، مثلما في أشكال أخرى من الهيمنة “يصبح التحكم في السلع الاقتصادية، أي السلطة الاقتصادية، نتيجة للهيمنة إضافة إلى كونه أحد أدواتها الهامة”. وهي فقرة مقتبسة من ترجمة كل من ماكس راينشتين (Max Rheinstein) وإدوارد شيل (Edward Shil) لأجزاء من كتاب ماكس فيبير “الاقتصاد والمجتمع” (Max Weber, Wirtschaft und Gesellschaft) والذي صدر بالإنجليزية بعنوان (Max Weber on Law in Economy and Society, New York: Simon And Schuster 1967, pp. 323- 24)
4 بحسب علمنا لا توجد مجتمعات أمومية في الوقت الحاضر. السلالة الأمومية، التي قد تكون أحد بقايا مرحلة انتقالية في النظام الأمومي، كما يرى بعض علماء الأنثروبولجيا، لا تمثل استثناء عن الحكم الأبوي، بل تمارس السلطة التي يملكها الذكور من خلال سلالة الأنثى، على سبيل المثال العلاقة الخاصة في بعض المجتمعات بين الرجل وابن شقيقته.
5 في الديمقراطية الراديكالية، بالطبع، لا مجال للأبوية. سوف نجد دلائل على الرضا العام بنظام ديمقراطي غير كامل ممثلة في ندرة شغل النساء لمراكز السلطة في “الديمقراطيات” الحديثة.
6 Hannah Arendt. “Speculations on Violence.” The New York Review of Books 12: 4, 27 February 1969, p. 24,
7 نشير هنا إلى العلوم الاجتماعية أكثر من العلوم الطبيعية، وتاريخيًا نجد أن العلوم الطبية كانت قد قبلت بتلك المعتقدات. ولكن الأمر لم يعد كذلك اليوم، حيث تشير أفضل البحوث الطبية إلى أن التنميط الجنسي لا أساس له في البيولوجيا.
8 “بعد أن لاحظ مؤرخو التاريخ الروماني أن لا الميلاد ولا الترابط يؤسسان للأسرة الرومانية، استنتجوا أن هذه الأسس لابد وأن تتمثل في سلطة الأب أو الزوج. وصنعوا من تلك السلطة نوعًا من مؤسسة بدائية للسلطة، لكنهم لم يفسروا كيف تأسست تلك السلطة في البداية، إلا إذا كان ذلك بواسطة تفوق قوة الزوج على زوجته أو الأب على أبنائه. لكننا اليوم نخدع أنفسنا للأسف حين نفترض أن القوة هي أصل القانون. وسوف نرى لاحقًا أن سلطة الأب أو الزوج أبعد ما تكون عن كونها السبب الأول، بل هي ذاتها نتيجة مستمدة من الدين وتأسست واستقرت بالدين. القوة الخارقة ليست إذا هي المبدأ الذي أسس الأسرة” (Numa Denis Fustel de Coulanges, The Ancient City, 1864)
(English translation by Willard Small 1873, Doubleday Anchor Reprint, pp. 41- 42). ولكن للأسف يغيب عن نوما دينيس فوستيل دي كولاج أن يذكر كيف تطور الأمر بحيث أصبح الدين يبجل السلطة الأبوية، حيث أن الدين الأبوي هو أيضًا نتيجة وليس السبب الأصلي.
9 يمكن أيضًا أن تذكر هنا مبدأ كون النظام الاجتماعي لا يعني بالضرورة هيمنة جنس على الآخر مثلما قد يعني استخدام مصطلح “الأمومي” من حيث مرادفته للأبوية. وفي ضوء نمط أبسط من الحياة وكون الأديان المتمركز حول خصوبة الأنثى يعوضها قوة الذكر الجسدية، يمكن أن نفترض أن مجتمعات ما قبل الأبوية كانت تشهد درجة ما من المساواة بين جنس وآخر.
10 يبدو أن شيئًا من هذا القبيل حدث حين استبدلت ثقافة القرى الزراعية في العصر الحجري الحديث لتحل محلها حضارة أحدث، وكذلك استبدال الأبوية مع نشأة المدن (انظر/ ي الفصل الأول من كتاب: Louis Mumford ,The City in History, New York: Harcourt, Brace 1961) إن اكتشافا مثل اكتشاف الأبوة، ذلك الإنجاز الضخم للمعرفة “العلمية”, يمكن أن يكون قد أدى، نظريًا، إلى زيادة السكان وفائض العمل والتقسيم الطبقي وهنالك من الأسباب ما يكفي لافتراض أن الانتقال من الصيد إلى الحرب كان له دوره أيضًا في هذا الصدد.
11 لم يتوفر حتى الآن أدلة مقنعة في هذا الشأن. التجارب التي تبحث في العلاقة بين الهورمونات وبين سلوك الحيوان لم تؤتي نتائج متضاربة فحسب وإنما تحمل أيضًا مخاطر استنتاج نتائج تخص الجنس البشري. انظر
David C. Glass (ed.), Biology and Behavior (New York: Rockefeller University and the Russell Sage Foundations, 1968).
12 مقتبس من مقدمة الكتاب الآتي: Robert J. Stoller, Sex and Gender New York: Science House, 1968, pp. viii- ix
13 المصدر السابق، ص۹.
14 المصدر السابق، ص48.
15 Mary Jane Sherfey. “The Evolution and Nature of Female Sexuality in Relation to Psychoanalytic Theory,” Journal of the American Psychoanalytic Association, vol. 14, no. 1, January 1966, New York: International Universities Press Inc.); and John Money, “Psychosexual Differentiation”, in Sex Research, New Developments, New York: Holt, 1965.
16 سبق ذكره: Money, p. 12
17 المصدر السابق، ص۱۳.
18 Jerome Kagin, “The Acquisition and Significance of Sex-Typing” in Review of Child Development Research, ed. M. Hoffman, New York: Russell Sage Foundation, 1964.
19 Lionel Tiger, Men in Groups, New York: Random House, 1968.
20 من خلال الغريزة يمكن للمخلوقات الأدنى من الإنسان أن تقوم بأنشطة معقدة مثل بناء العش؛ أما رد الفعل أو الدافع فيتصل بقدرة الإنسان على أن يطرف عينه أو على الشعور بالجوع، الخ.
21 William J. Goode, The Family, Englewood Cliffs: New Hersey, Prentice- Hall, 1964.
22 الأسرة والمجتمع والدولة ثلاث هيئات منفصلة لكنها مرتبطة فيما بينها. وتقل أهمية النساء كلما انتقلنا من الأولى إلى الثالثة، لكن حيث أن كل من الفئات الثلاثة قائمة أو تتأثر بمؤسسة الأبوية ككل، فلا تشغلني هنا أوجه الخلاف بينها بقدر ما يشغلني التشابه العام فيما بينها.
23 Joseph K. Folsom, The Family and Democratic Society, New York: John Wiley, 1934, 1943.
٢٤ العلاقة الزوجية أو علاقات الدم مع رب الأسرة كانت مملوكة له.
25 النسب الأبوي يشمل فقط ورثة الذكر أكثر من أبناء الأخت، الخ. وبعد بضعة أجيال تنقطع الصلة بسلالة الأنثى إن “من يحملون الاسم” فقط، أي سلالة فروع الذكور، هم المعترف بهم فيما يخص الميراث أو القراية.
26 Sir Henry Maine, Ancient Law, London: Murray, 1861, p. 122.
27 Sir Henry Maine, The Early History of Institutions, London, 1875, pp. 310- 11.
28 John McLennon, The Patriarchal Theory, London: Macmillan, 1885.
۲۹ اعتبر ماين أن الأسرة الأبوية هي الخلية التي تطور منها المجتمع في أسر ممتدة وقبائل وأمم وليس ببساطة من أصل ١٢ قبيلة من سلالة يعقوب كما في تاريخ إسرائيل. وحيث أن ماين أرجع أصول الأبوية إلى اكتشاف الأبوة، وهي بأي حال ليست حالة بدائية، فإن ذلك أيضًا يدحض الطابع الأزلي للمجتمع الأبوي.
30 الكثير من النظم الأبوية منحت الذكر وحده حق الطلاق. ولم يصبح متاحًا بدرجة ما للأنثى سوى خلال هذا القرن. ويذكر جود أن معدلات الطلاق كانت بنفس درجة ارتفاعها في اليابان خلال ثمانينيات القرن التاسع عشر مثلما هي في الولايات المتحدة اليوم: Goode, op.cit., p. 3.
31 يمنح الطلاق للذكر في حال فشلت زوجته في خدماتها المنزلية أو رفقته، ولا يمنح له في حال فشلت زوجته في دعمه ماليًا. ويمنح الطلاق للمرأة إذا فشل الزوج في إعالتها، ولا يمنح لها في حال فشل في مساعدتها في الخدمة المنزلية أو رفقتها. وفي سابقة قانونية عام 1967 في ولاية الينوي سمح للزوجة أن ترفع دعوى طلاق في حال فشل الزوج في رفقتها.
32 Bronislaw Malinowski. Sex, Culture and Myth, New York: Harcourt, 1962, p. 63.
ويتضح الأمر بشكل أكبر في مقولة له سابقة يقول فيها إن في كل المجتمعات البشرية تنص التقاليد الأخلاقية والقانون على أن جماعة مكونة من امرأة وأبنائها لا تمثل وحدة اجتماعية كاملة:
Bronislaw Malinowski, Sex and Repression in Savage Society, London: Humanities, 1927, p. 213.
33 Goode, op. cit., p. 80.
34 Goode, op. cit., p. 74.
35 جوهر تلخيص فالينسي للوضع قبل ظهور الشعر الغنائي في فرنسا في الفترة بين القرنين الحادي عشر والثالث عشر هو أن الحب الأفلاطوني كان أمرًا غير مألوف: “فيما يتعلق بالخلفية الاجتماعية كل ما يمكن أن نقوله بثقة هو أننا لا نعلم شيئا عن هدف العلاقات بين الرجال والنساء في القرون الوسطى التي قد تشجع على قصائد الحب التي ابتكرها شعراء التروبادور”: Maurice Valency, in Praise of Low, New York: Macmillan 1954, p. 5
36 Hugo Beigel, “Romantic Love,” The American Sociological Review, Vol. 16, 1951, p. 331
37 يمكن أن نتتبع شخصية روجاك Rojack الخيالية باعتباره رمزا لفحولة شخصية إرنست إفرهارد Ernest Everhard في كتابات جاك لندن Jack London أو شخصية ستانلي كوفالسكي Stanley Kowalski في كتابات تينيسي ویلیامز Tennessee Williams. إن تمكن روجاك من القراءة والكتابة أيضًا ليس أكثر من إضافة أنيقة “لرجولته” المستمدة من قدرته على مضاجعة أية وكل امرأة يتمكن من الحصول عليها أو إغوائها أو وطئها.
38 يبدو أن “الوردة النقية للأنوثة البيضاء” كانت في بعض الأوقات على الأقل مصدر خيبة أمل لسيدها العنصري مثلها. ونجد دليلاً على ذلك نجده في الرابطة التاريخية للمطالبين بإلغاء العنصرية والحركة النسائية، وكذلك في نسبة زيجات الأنثى البيضاء بالذكر الأسود مقارنة بزيجات الذكر الأبيض والأنثى السوداء. ومن الصعوبة بمكان الحصول على أرقام بشأن الزواج المختلط: بقدر جود أن نسبة النساء البيض اللاتي تزوجن من رجال سود بنسبة تصل من ثلاثة إلى عشرة أضعاف نسبة الرجال البيض الذين تزوجوا من نساء سود. ويقول روبرت ك. مرتون إن “أغلب العلاقات المختلطة – وليس الزيجات – تتم بين رجال بيض وزنجيات”:
Robert K. Merton “Intermarriage and the Social Structure”, Patriarchy, Vol. , 4, August 1941, p. 374
ولسنا بحاجة إلى التأكيد على أن معدل الاتصال الجنسي الأعلى بين الذكور البيض والإناث السود كان خارج إطار الزواج كما كان – من جانب الذكر الأبيض – اتصالاً استغلاليًا بالأساس. وفي ظل العبودية كان ذلك بوضوح اغتصابًا.
39 السويد حالة استثنائية في اعتبارها العمل المنزلي خدمة مادية مقدمة وتؤخذ في الاعتبار في قضايا الطلاق. ونجد أن نسبة 33% – 40% من الإناث يعملن بأجر في البلاد الغربية، ما يترك ثلثي الإناث خارج سوق العمل. وتنخفض النسبة عن ذلك في السويد والاتحاد السوفيتي.
40 نسبة النساء اللاتي يحققن دخلاً يبلغ أكثر من عشرة آلاف دولارًا أمريكيًا في عام 1966 كانت 7/ 10 من 1%:
Mary Dublin Keyserling, “Realities of Women’s Current Position in the Labor Force”, in Sex Discrimination in Employment Practices, a Report from the Conference (pamphlet) University Extension, UCLA and the Women’s Bureau, September 19, 1968.
41 The 1965 Handbook on Women Workers, United States Department of Labor, Women’s Bureau.
في كل جماعة كبيرة عاملة كان متوسط أجر النساء أقل من أجر الرجال. وينطبق الشيء نفسه على كافة المستويات التعليمية، مقارنة الدخول بين النساء والرجال الذين حصلوا على نفس الدرجة من التعليم كشفت أن النساء اللاتي أتممن أربع سنوات من الدراسة الجامعية حصلن على أجر لا يتجاوز 47% من أجر الرجال الحاصلين على نفس القدر من التعليم. وكانت النسبة بين خريجات المدارس الثانوية 38% والإلزامية 33% فقط.
42 للمزيد عن توزيع النساء في المناصب قليلة الدخل والشأن، انظر/ ي:
Background Facts on Working Women (pamphlet), U.S. Department of Labor, Women’s Bureau.
43 “للمرأة المتزوجة التي ليس لديها أطفال يتطلب الحد الأدنى من العمل المنزلي ما بين 15 إلى عشرين ساعة أسبوعيًا، وإذا كان لديها صغار يتراوح الحد الأدنى على الأرجح ما بين 70 -80 ساعة أسبوعيًا”:
Margaret Benston, “The Political Economy of Women’s Liberation,” Monthly Review, vol. XXI, September 1969.
44 Sex Discrimination in Employment Practices (op. cit.); and Carolyn Bird, Born Female, New York: McKay, 1968.
45 البند السابع من قانون الحقوق المدنية الصادر في عام 1964، والذي ينص على تضمين “الجنس” في القانون بما يمنح الحق المدني في عدم التمييز في العمل، كان شبه نكتة ونصف محاولة من جانب أعضاء الكونجرس في الجنوب لإجبار الولايات الصناعية في الشمال على عدم السماح بصدور القانون.
46 كثيرًا ما ننسى مدى حداثة التعليم العالي للنساء، فلم يمض عليه في الولايات المتحدة أكثر من مائة عام، بل وبالكاد 50 عامًا في الكثير من البلدان الغربية. ففي جامعة أكسفورد لم تمنح النساء الدرجات العلمية بنفس الشروط التي تمنحها إياها للذكور حتى عام ١٩٢٠. وفي اليابان وعدد من البلدان الأخرى لم تفتح الجامعات أبوابها أمام النساء إلا في الفترة التالية على الحرب العالمية الثانية. وما زالت هناك مجالات يكاد التعليم العالي لا يتوفر فيها للنساء. فالتعليم العالي ليس متاحًا للنساء كما هو متاح للرجال. وفي ذلك يقول تقرير برنستون “رغم أن الفتيات يحصلن على الدرجات النهائية بمعدل أعلى من الفتيان في المرحلة الثانوية إلا أن التحاق الذكور بالجامعة يفوق التحاق الإناث بنسبة 50%:
The Princeton Report to the Alumni on Co- Education (pamphlet), N.J: Princeton, 1968, p. 10.
كما توجد تقديرات أخرى كثيرة بأن نسبة الطلاب في الجامعات تنقسم إلى ذكرين لكل أنثى، وفي عدد كبير من البلاد تنخفض النسبة عن ذلك كثيرًا.
47 بما أن الإجهاض يحدث خارج القانون يصبح من الصعب الحصول على أرقام دقيقة، وتعتمد هذه النسبة على تقديرات من يمارسون الإجهاض وخدمات التحويل لهم. كذلك لا يوجد رصد لحالات الانتحار بين النساء الحوامل.
48 ترد على البال استثناءات حية في حروب التحرير في فيتنام والصين، الخ. لكن عبر الجزء الأكبر من التاريخ كانت النساء غير مسلحات وممنوعات من ممارسة الدفاع عن أنفسهن.
49 ما زالت هذه الأرقام عالية، فعدد حالات الاغتصاب التي تم الإبلاغ عنها في مدينة نيويورك في عام 1967 وصل إلى ٢٤٣٢ حالة بحسب وزارة الداخلية.
50 من المثير للاهتمام أن الذكور ضحايا الاغتصاب بواسطة ذكور آخرين كثيرًا ما يشعرون بانتهاك مزدوج، حيث أنهم لم يتعرضوا للجماع العنيف والمؤلم وحسب بل أُسيء إليهم أيضًا من حيث الانحدار بهم إلى مرتبة الأنثى. والكثير من ذلك يتضح عند جينيه Genet ومدى الاحتقار الذي يكنه مجتمع المثلية الجنسية لأفراده “السلبيين” أو “الأنثويين”.
51 المازوخية الذكورية عادة ما ينظر إليها باعتبارها الاستثناء، وكثيرًا ما تُفسر باعتبارها مثلية جنسية كامنة أو جزءًا من لعب الشخص “للدور الأنثوي”, أي دور الضحية.
52 هناك كم هائل من الأدبيات الكارهة للنساء بحيث لا يمكن عمل أي ملخص واف لها، أفضل المراجع في هذا الشأن نجدها في الآتي:Katherine M. Rogers, The Troublesome Helpmate: A History of Misogyny in Literature, Seattle: University of Washington Press, 1966.
53 بالإضافة إلى قصائد الحب الرائعة، ألف بترارخ أيضًا قصائد هجاء في النساء. كذلك بوكاشيو وازن الفروسية في الروايات الرومانسية (Filostrato, Ameto, Fiammetta) بروايات أخرى تضمنت توبيخًا قاسيًا للنساء أكثر سوداوية من هجوم القرون الوسطي (Corbuscio).
54 جزء كبير مما لخصته في هذا القسم أدين به لتقييم هايز المفيد للمفاهيم الثقافية المحيطة بالأنثى:
H.R. Hays, The Dangerous Sex: the Myth of Feminine Evil, New York: Putnam, 1964.
55 ظروف الترف المحيطة بالمطعم “الأفضل” تمثل استثناء طريفًا، حيث لا يقتصر على إعداد الطعام وإنما أيضًا خدمة تقديمه على الذكور، وبثمن يتناسب مع المناسبة.
56 Sigmund Freud, Totem and Taboo, and Ernest Crawley. The Mystic Rose, London: Methuen, 1902, 1927
57 David Riesman, “Two Generations, in The Woman in America, edited by Robert Lifton, Boston: Beacon, 1967. Also, James Coleman, The Adolescent Society.
58 Heinrich Schutz, Altersklassen und Maennerbuende, Berlin, 1902; and Lionel Tiger, op. Cit.
59 Hays, The Dangerous Sex, p. 56.
60 Geza Roheim, “Psychoanalysis of Primitive Cultural Types,” International Journal of Psychoanalysis Vol. XIII, London, 1932.
61 كل هذه الخصال تنطبق بدرجة ما على الدائرة البوهيمية التي تتحدث عنها روايات ميللر، والجيش الذي لا يغيب أبدًا عن وعي مايلر، وثقافة الجنسية المثلية التي تستند إليها ملاحظات جينيه. وحيث أن الموضوعات الثلاثة التي تتناولها دراستنا ترتبط ارتباطًا وثيقًا بثقافة بيوت الرجال الانفصالية، يصبح من المفيد أن نولها انتباها خاصة.
62 يوضح جينيه هذا في روايته The Screens ، أما مايلر فيكشف ذلك في كل كتاباته.
63 أينما يقف المرء في الجدال الطويل بين علماء الأنثروبولوجيا حول الأصول الأبوية مقابل الأصول الأمومية للأصول الاجتماعية, يمكن أن نتتبع تقليلاً من رتبة إلهات الخصوبة واستبدالهن بآلية أبوبة في مرحلة ما خلال الثقافة القديمة.
64 Hesiod, Works and Days, translated by Richmond Lattimore, University of Michigan, 1953, p. 70.
65 Hesiod, Theogony, translated by Norman O. Brown, Indianapolis: Liberal Arts Press, 1953, p. 70.
66 Hesiod, Works and Days phrases from lines 53- 100; some of the phrases are from Lattimore’s translation, some from A. W. Mait’s translation, Oxford, 1908.
67 من المحال أن نقيم عمق تغلغل أسطورة الفردوس في وعينا وانغماس أنماطها في عاداتنا في التفكير، حيث نقابل نكهتها وتصميمها في أقل المواقع توقعًا لذلك. وتمثل فيلم أنطونيوني “انفجار” على سبيل مثالاً واحدًا من بين أمثلة كثيرة على ذلك، حيث تدور أحداث الفيلم في بستان خيالي، مليء بالخيالات البدائية الجنسية في أغلبها، يثيرها مشاغب ببندقية قضيبية الشكل، ومرة أخرى تخون الأنثى الذكر ما يتسبب في موته. المصور الذي يشهد على الحدث يتفاعل معه كما لو كان يعايش لتوّه المعرفة المضنية للإحساس البدائي الأول والخطيئة الأولى في نفس الوقت.
68 Geza Roheim, “Eden”, Psychoanalytic Review, Vol. XXVII, New York, 1940. Theodor Reik, The Creation of Woman, and the account given in Hays, op. Cit.
69 هناك ما يثير الاهتمام في اللغات خارج هذه المجموعة. ففي اللغة اليابانية على سبيل المثال هناك كلمة للرجل وأخرى للمرأة وثالثة للإنسان. ولا يخطر على بال أحد استخدام الأولى أو الثانية لتشمل الثالثة.
70 Philip Goldberg “Are Women Prejudiced Against Women?”, Transaction, April 1968.
71 Louis Wirth, “Problems of Minority Groups,” in The Science of Man in the World Crisis, ed. By Ralph Linton, New York: Appleton, 1945, p. 347.
72 Helen Mayer Hacker, “Women as Minority Group,” Social Forces, Vol. XXX, October 1951; Gunnar Myrdal, An American Dilemma, Appendix 5 is a parallel of black minority status with women’s minority status; Everett C. Hughes, “Social Change and Status Protest: An Essay on the Marginal Man,” Phylon, Vol. X, First Quarter, 1949, Joseph K. Folsom, The Family and Democratic Society, 1943; Godwin Watson. “Psychological Aspects of Sex Roles.” Social Psychology, Issues and Insights, Philadelphia: Lippincott, 1966.
73 تعليقي عن النساء كأقليات قمت بتلخيصه من كل المقالات السابقة، وأدين بشكل خاص لعرض نقدي لها في مسودة غير منشورة للأستاذة مارلين ديكسون Marlene Dixon التي كانت تعمل سابقًا في قسم الاجتماع بجامعة شيكاغو كما كانت عضوة في لجنة التنمية البشرية هناك وهي تعمل حاليًا في جامعة ماجيل. 74 أنظر/ي قرار المحكمة العليا في بنسلفانيا:
The Commonwealth v. Daniels, 37 L. W. 2064, Pennsylvania Supreme Court, 7/ 1/ 68 (reversing 36 L.W. 2004).
75 Helen Hacker, op. cit., and Carolyn Bird, op. Cit
76 وقد كشفت دراسة أجريت على تلاميذ الصف الرابع أن عدد الفتيات اللاتي تمنين لو كن فتيانا عشر أضعاف عدد الفتيان الذين تمنوا لو كانوا فتيات: .Watson, op.cit. , p. 477
77 Amitai Etzioni ”Sex Control, Science and Society,” Science, September 1968, pp.1107-12
78 Myrdal, op. cit., Hacker, op. cit., Dixon, op cit.
79 Hughes, op. cit.
American Heritage Dictionary,New York: American Heritage and Houghton Mifflin, 1996.
Arendt, Hannah, “Speculations on Violence,” The New York Review of Books. 12:4,27 February 1969.
Background Facts on Working Women (pamphlert), U.S. Department of Labor, Women’s Bureau.
Beigel, Hugo, “Romantic Love,” The American Sociological Review, Vo. 16,1951.
Benston, Margaret, “The Political Economy of Women’s Liberation,” Monthly Review, vol. xxl, September 1969.
Bird, Carolyn, Born Female, New York” Mckay, 1968.
Crawley, Ernest, The Mystic Rose , London” Methuen, 1927.
De Coulanges, Numa Denis Fustel. The Ancient City, 1864, English translation by Willard Small 1873, Doubleday Anchor Reprint.
Etzioni, Amitai, “Sex Control, Science and Society,” Science, September 1968.
Folsom, Joseph K., The Family and Democratic Society, New York” John Wiley, 1934, 1943.
Freud, Sigmund, Totem and Taboo, London” Methuen, 1902.
Glass, David C. (ed.), Biology and Behavior, New York” Rockefeller University and the Russell Sage Foundations,1968.
Goldberg, Philip, “Are Women Prejudiced Against Women?”, Transaction, April1968.
Goode, WillianJ., The Family, Englewood Cliffs:New Hersey, Prentice-Hall, 1964.
Hacker, Helen Mayer, “Women as Minority Group,” Social Forces, Vol. XXX, October 1951.
Hays, H.R,. The Dangerous Sex: the Myth of Feminine Evil, New York: Putnam, 1964.
Hesiod, Theogony, translated by Norman O. Brown, Indianapolis: Liberal Arts Press, 1953.
—–, Works and Days, translated by Rechmond Lattimore, University of Michigan Man ,” Phylon, Vol. X, First Quarter, 1949.
Kagin, Jerme, “The Acquistion and Significance of Sec-Typing, “ in Review of Child Development Research, ed. M. Hoffman, New York: Ressell Sage Forndation, 1964.
Keyserling, Mary Dublin, “Realities of Women’s Current Position in the Labor Force”, in Sex Discrimination in Employment Practices, a Report form the Conference (pamphlet) University Extension, UCLA and the Women’s Bureau, September 19,1968.
Maine, Sir Henry, Ancient Law, London: Murray, 1861.
—-, The Early History of Institutions, London, 1875.
Malinowski, Bronislaw, Sex and Repression in Savage Society, London: Humanities, 1927.
—-, Sex, Culture and Myth, New York: Harcourt, 1962.
Mclennon, John, The Patriarchal Theory, London: Macmillan, 1885.
Merton, Robert K,. “Intermarriage and the Social Structure”, Patriachy, Vol,. 4, August 1941.
Money, John, “”Psychosexual Differentiation”, in Sex Research, New Developments, New York: Holt, 1965.
Mumford, Loris, The City in History, New York” Harcourt, Brace, 1961.
Myrdal, Gynnar, An American Dilemma: the Negro Problem and Modern Democracy, New York: Harper& Brothers, 1944.
Riesman, David, “Two Generations”, in The Women in America, edited by Robert Lifton, Boston: Beacon, 1967.
Rogers, Katherine M,. The Troublesome Helpmate: A History of Misogyny in Literature, Seattle: University of Washington Press, 1966.
Roheim, Geza, “Eden”, Psychoanalytic Review, Vol. XXCLL, New York, 1940.
—-, “Psychoanalysis of Primitve Cultural Types,” International Journal of Psychoanalysis Vol. Xlll, London, 1932.
Samson, RonaldV., The Psychology of Power, New York:Random House, 1968.
Schutz, Schutz Heinrich, Altersklassen und Maennerbuende, Berlin, 1902.
Sherfey, Mary Jane, “ The Evolution and Nature of Female Sexuality in Relation to Psychoanalytic Theory, “ Journal of the American Psychoanalytic Association, vol. 14no.1, January 1966, New York: International Universities Press Inc.
Stoller, Robert J,. Sex and Gender, New York: Science House, 1968.
The 1965 Handbook on Women Workers, United States Department of Labor, Women’s Bureau, The Primceton Report to the Alumni on Co-Education (pamphlet), N.J: Princeton, 1968.
Tiger, Lionel, Men in Groups, New York:Random House, 1968.
Valency, Maurice, In Praise of Love, New York: Macmillan, 1958.
Watson, Godwin, “Psychological Aspects of Sex Roles, “ Social Psychology, Issues and Insights, Philadelphia: Lippincott, 1966.
Weber, Mac, On Law in Economy and Society, New York: Simon and Schuster 1967.
Wirth, Louis, “Problems of Minority Groups,” in The Science of Man in the World Crisis, ed. By Ralph Linton, New York: Appleton, 1945.