خائفة من وغد محتمل!
اعداد بواسطة:
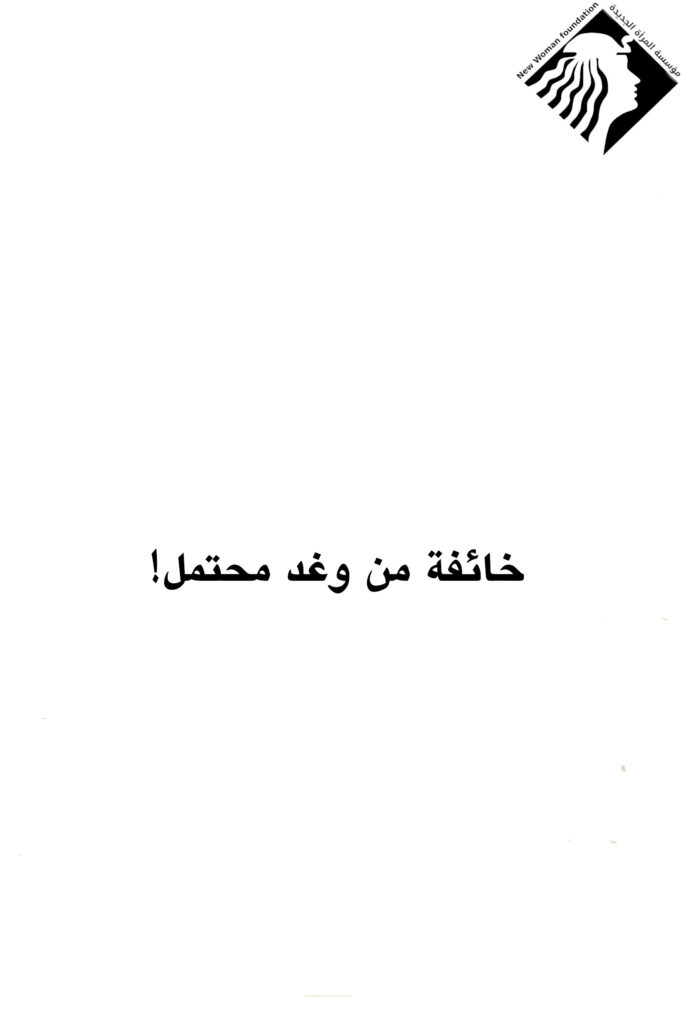

أركن سيارتي، أنظر إلى المرايا الجانبية لأتأكد من خلو الطريق قبل أن أترجل منها. أتجه في خطوات مسرعة للبناية التي أقصدها. ألعن وأسب زحام القاهرة الذي جعلني أوقف السيارة على بعد خمسين مترًا من مكان عملي، أتطلع إلى الرجل القادم في مواجهتي، تتسارع دقات قلبي، إنه يقترب. ماذا سيقول؟ كيف سينظر إلي؟ هل سيحاول أن يلمسني؟ ماذا أقول؟ ماذا أفعل؟ أتمنى أن يقول كلمات غير جارحة لكي لا أضطر إلى الرد عليه، فقد أخذت على نفسي عهدًا ألا أتعرض من جديد لشعور الضعف وقلة الحيلة الذي دأبت على الشعور به طوال عشر سنوات مضت كلما تعرضت لمعاكسة بذيئة ولم أفعل شيئًا. ها هو يقترب، أكثر فأكثر. لقد مر في سلام! يا إلهي! أتنفس الصعداء عن حق. “جت سليمة“!
أبدأ يومي، ولكن شحنة الأدرينالين التي سرت في جسدى من فرط توترى على امتداد هذه الأمتار الخمسين قد شدت عضلات عنقي وظهرى. أشعر بأني منهكة تمامًا. لقد استنفد هذا الوغد المحتمل طاقتي. كيف يفترض بي أن أنتج كعضو فعال في مجتمعي وأنا على هذا الحال؟ أتجرع كل ما يمكن أن أحصل عليه من كافيين لأركز في عملي. كم أود أن أستلقي على سريري الآن دون أن أعمل، ولكن هيهات. يجب أن أعمل لأتمكن من سداد أقساط السيارة، فهي الملاذ الآمن الذي يحميني من الشارع ومن رجال الشارع، إذا ما تغاضينا بالطبع عن حافلات الجيش التي تحمل جنودًا يقتحمون السيارة ومن في السيارة بأعينهم أحيانًا وبإشارات أيديهم أحيانًا أخرى. النقود! أشعر بالخجل من نفسي واستحي أحيانًا لتمكني من الاحتماء في سيارتي، بينما تواجه مئات، بل آلاف الفتيات والسيدات يوميًا ما لا يمكنهن تجنبه. أشعر بما يشعرن به من قلة حيلة وإرغام على أمرهن. هن أيضًا لا بد أن يعملن، وأن يخرجن للشارع، رضين بذلك أم أبين.
أعود بذاكرتي للوراء، ماذا حدث؟ أتذكر وأنا في سن المراهقة أنني كنت أستمتع بالمعاكسات، كنت أشعر بإطراء شديد. لماذا تغيرت؟ وهل أنا حقًا التي تغيرت؟ بل تغيرت طبيعة المعاكسات على ما أعتقد. لم تكن أبدًا بهذه البذاءة والحقارة. كانت في العادة تعتمد على مفردات دينية من أمثلة “سبحان الله” “سبحان الخلاق” “ما شاء الله عليكي.” لم أسمع أبدًا في صغرى أى كلام حقير عن أي من أعضاء جسدي الحساسة. كانت المعاكسات تعبير حقيقي عن الإعجاب لا غير أو حتى من قبيل خفة الدم مثل “أحلاكم اللي في النص” التي كانت تقال أحيانًا لفتاتين. ولكن معاكسات اليوم تحمل أكثر من ذلك، شيئًا ما لا أستطيع التعبير عنه، أنا لا أبالغ عندما أقول إنني أشعر أحيانًا بأنني أغتصب من فرط قذارة النظرات وبذاءة الكلمات.
ما الذي تسبب في هذا التغير؟ أهي حقًا نانسي عجرم وهيفاء وهبي والدش الذي يثير غريزة الرجال فلا يملك أولئك “الغلابة” إلا التنفيس عن ذلك وإسقاطه علينا في الشارع؟ أهو حقًا غلاء المعيشة وتأخر سن الزواج والكبت الجنسي؟ لا أعتقد ذلك. أشعر أن هذه المعاكسات تحمل في طياتها ما هو أكثر من مجرد كبت جنسي. أين الكبت الجنسي في عبارات من أمثلة “بص الفيل” أو “معاكي فكة عشر بنات” التي توجه للفتيات الممتلئات لتجعلهن يكرهن أنفسهن والعالم من حولهن؟ أين الكبت الجنسي في عبارات من أمثلة “طويل وأهبل” التي تقال للفتيات الطويلات من قبل رجال قصار القامة ليداروا على شعورهم الشخصي بالنقص على حساب نفسية هذه الفتيات؟
ثمة سبب آخر وراء تلك المعاكسات، بل فلنقل أسباب، فالحياة ليست بهذه البساطة، فمن ناحية، هناك كبت، نعم، ولكنه متعلق بالعجز الذي نشعر به جميعًا حيال تغيير معطيات حياتنا. هنالك الاكتئاب والبؤس الذي أراه في عيني الرجل ذى الجلباب الذي جاء، على الأغلب، من قرية نائية وترك زوجته وأطفاله ليعمل باليومية ويهان من أجل حفنة جنيهات. إني أرى في عينيه نظرة انتقام وانتصار لا شهوةً جنسية. أراه وكأنه ينتقم لنفسه وينتصر على طبقته وظروفه التي لا يملك تغييرها بإيذائي أنا، وكأنه يحقق ما يريده برؤية الضعف أو الخوف في عيني أنا. هناك زهو الانتصار. أشعر بمحنته وحقده المبرر، ولكن ماذا عساي أن أفعل؟ وهل كتب على النساء دائمًا أن يتحملن تبعات الأزمات الوطنية والاجتماعية إلى الأبد؟
ومن ناحية أخرى، هناك السلبية التي رضعناها صغارًا فأصبحت جزءًا لا يتجزأ منا. هناك مقولات الأمهات التي تتردد بداخلنا دون وعي منا “أنظرى أمامك” “لا تردى على المعاكسات” “لا تدني من مستواكي بالرد عليه” “ما تعمليش فضيحة لنفسك” وغيرها من المقولات التي لا تغني من جوع، والتي أرى في رأيي أنها أحد أهم أسباب تفشي هذه الظاهرة، إنها سلبيتنا نحن النساء. نحن أيضًا مسئولات.
في بعض دول الخليج، حيث الكبت الجنسي على أوجه، لا يجرؤ أي رجل على التعرض بكلمة لأى امرأة لأنه يعلم أن دوريات الشرطة في كل مكان ولأنه قد يحبس بدعوى التحرش بها. نحن أيضًا لدينا دوريات شرطة ولكنها تقوم بالمعاكسات نيابة عن الشعب، ونحن لدينا أيضًا قانون يعاقب على ذلك ولكننا نعاني من سلبية جعلت من هذا القانون حبرًا على ورق. إذا علم كل رجل أن ما يقوله سوف يرد عليه، وأن الفتاة التي يعاكسها قد “تلم الناس عليه” ولا تخشى على نفسها من الفضيحة ودخول الأقسام لتحرر له محضرًا وسابقة في ملفه الجنائي، لفكر مرتين قبل أن ينطق فوه وقبل أن تتحرك يداه. وإذا ما كنا أكثر ثقة في أنفسنا، لما اكترثنا إلى ما سوف يقال كالعادة من أننا المسئولات عن ذلك لأننا كنا نضع أحمر وأخضر أو كنا نلبس “محزق” أو قصير، سواء كان ذلك حقيقيًا أم لا. فربما ينجح الخوف في ردعهم بعدما أصبحت المبادئ من أمثلة “عيب كده دي ممكن تكون أختك أو أمك” ليست ذات أثر على الإطلاق.
هل يكفي ذلك حقًا لعلاج مجتمعنا المريض؟ لا أعلم، فالمرض عضال. ولكنني عن نفسي أصبح أفضل حالاً إذا لم أضف إلى الانتهاك والعنف الذي أتعرض له شعورًا خانقًا من العجز وقلة الحيلة والمهانة.














