التاريخ المنسي من يتذكر أدوار النساء في السياسة
اعداد بواسطة:
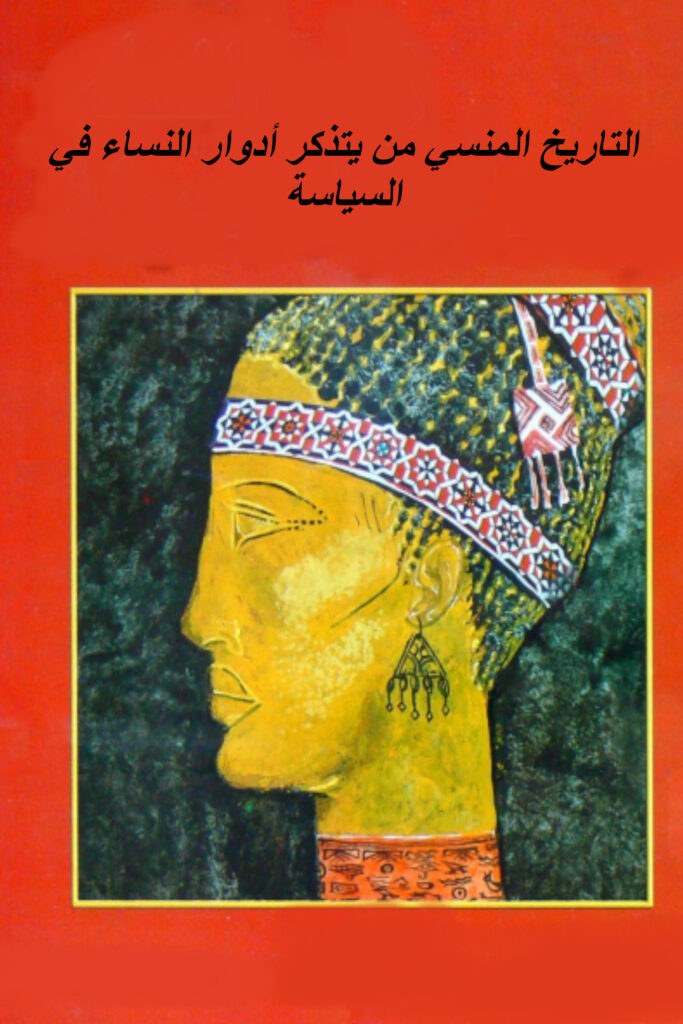
التاريخ المنسي
من يتذكر أدوار النساء في السياسة
في مقدمة كتابها (الفلاحون الفلسطينيون من الاقتلاع إلى الثورة)، تساءلت الباحثة – روز ماري صايغ – كيف يمكن أن يتوارى شعب بأكمله خلف قضيته السياسية؟. ويبدو أن هذا التواري، خلف القضية السياسية، دفعت النساء ثمنه أكثر من غيرهن. إذ عندما حاول البعض أن يبحث عن تاريخ المنسيين – من دفعوا دماءهم ثمناً لتحرر وطنهم، والذين كان معظمهم من الفلاحين البسطاء – بدلاً من التركيز المعتاد على دور النخبة السياسية المتنفذة، التي كانت في معظمها من الفئات والشرائح الغنية، تم تذكر تاريخ الفلاحين من الرجال، لم تذكر النساء. فحين نقرأ عبد الوهاب الكيالي، أكرم زعيتر، صبحى ياسين، وأيضاً غسان كنفاني، وهم من حاولوا إلقاء الضوء على دور الفلاحين في ثورات الشعب الفلسطيني، منذ تبلور خطر الحركة الصهيونية؛ نجد شذرات قليلة هي التي تتحدث عن دور ما للنساء، خاصة نساء الريف معقل المقاومة والبطولة في آن. فكثيراً ما أشار هؤلاء الكتاب إلى دور الفلاحين كطبقة مسحوقة، في ذلك الوقت، ولكن عندما يرد الحديث أحياناً، عن النساء، يختفي – فجأة – هذا البعد الطبقي المتبع للتأريخ للفلاحين، ونرى – فقط – التأريخ لنساء النخبة من الطبقات العليا، أو بنات النخبة السياسية المتنفذة في ذلك الوقت. ففي مرجع تاريخي هام، عن الحركة الوطنية الفلسطينية، في الثلاثينيات والأربعينيات – أوج فترة المقاومة والانتفاضات الشعبية – نرى في يوميات أكرم زعيتر – وصفًا تفصيلياً شاملاً لمؤتمر نساء الشرق، الذي نظمته في القاهرة هدى شعراوى؛ لدعم القضية الفلسطينية، عام ۱۹۳۸، مع ذكر كلمات معظم المتحدثات تقريباً. ونرى الشيء نفسه يتكرر، في معظم المراجع التاريخية التي غطت هذه الفترة. فالصورة المعتادة في كتب التاريخ تلك، هي لنساء يلبسن قبعات غربية أو غطاء شرقيًا للرأس، يلبسن الكعب العالي، وملابس أوروبية أنيقة، يقفن خارج مقر المندوب السامي بالقدس، للاحتجاج على قسوة التدابير البريطانية المتخذة ضد الفلسطينيين أثناء الحوادث سنة ١٩٢٩. والصورة التي حازت على شهرة واسعة في السنة نفسها تظهر مجموعة من النساء في سياراتهن يطفن بها حول مقر المندوب السامي، (حوالى ٨٠ سيارة)، وبعض القنصليات الأوروبية الأخرى في مدينة القدس، لتسليم عريضة تتضمن احتجاج النساء على الهجرة اليهودية، كما تتضمن مطالب الشعب ردًا على القمع البريطاني، بعد أحداث هبة البراق في عام ۱۹۲۹ (۱). وصورة أخرى لنساء في اللباس الأوربي والكعب العالى، وهن يجمعن التبرعات لإعالة عائلات الشهداء، عند باب الخليل في القدس (2). وفي المرجع ذاته (قبل الشتات)؛ حيث عشرات الصور التي تؤرخ لمراحل مختلفة، من ١٨٧٦ – ١٩٤٨؛ حيث نرى معظم صور النساء، إما من نساء الطبقات العليا وهن في وضعية استرخاء للتصوير، وإما صورة واحدة تظهر امرأة في “فعل” جمع التبرعات، إبان فترة ثورة الثلاثينيات. أما معظم صور النساء الريفيات، فتظهرهن، إما بكامل زيهن التقليدي وبكامل زينتهن، والقليل منها لنساء يعملن في الزراعة. أما صور “المقاومة” والمظاهرات فهى – في معظمها – لرجال ورجال فقط. ونرى الصورة تتكرر، والتعليق عليها – تقريبًا – عن دور النساء الفلسطينيات، في ثورة الثلاثينيات. والمشهد نفسه يتكرر – أيضًا – في الكتب الحديثة، عن تاريخ فلسطين في تلك الحقبة. ففي كتاب صدر أثناء الانتفاضة عن تاريخ الحركة النسائية الفلسطينية (عزت ضراغمة)، تتصدر غلاف الكتاب صورة لنساء ريفيات، ولكن – في داخله – نجد المعنى نفسه المشار إليه سابقًا، يتكرر مرة أخرى، فيتم التطرق – فقط – لتاريخ نساء النخبة من الطبقات العليا.
والسؤال هنا، لماذا، عند التطرق لدور ما للنساء، نجد – دائماً – الحديث يدور عن الشريحة نفسها من نساء الطبقة العليا؟. وكيف يمكن التأريخ الثورة هي – بالأساس – ثورة فلاحين، كثورة ١٩٣٦ مثلاً، ولا يتم ملاحظة ما كانت تفعله النساء الريفيات في هذه الثورة، وهن المتضررات أكثر من غيرهن، على الأقل أكثر من نساء الطبقات العليا في المدن؟. فكثيرة هي الإفادات التي تشير إلى العنف والقمع المستخدم ضد الفلاحين؛ إذ قتل الكثير منهم شنقاً؛ لمجرد ضبط سلاح معهم، مهما كان نوعه، ومهما كانت درجة قدمه. وكثيرًا ما هدمت بيوتهم، وخربت مزروعاتهم، أو أحرقت وأتلف خزين مأكولاتهم السنوى للأسباب ذاتها. وهو الأمر الذي أدى، إلى أن يكون “الفعل السياسي للنساء – في معظمه – عفويًا وفردياً وخارج نطاق التنظيم” (۳)، وهو ما ينطبق على النساء في الريف أكثر من غيرهن؛ نظرًا إلى ضخامة وشراسة أشكال القمع التي تعرض لها سكان الريف الفلسطيني، في تلك الفترة.
يشير هذا الأمر، إلى مدى أهمية تتبع الأدوار المختلفة، التي تقوم بها النساء إبان مشاركتهن في النضال الوطني، خاصة إذا كانت له صفة الاستمرارية لمدى طويل، كما هي الحال بالنسبة إلى قضية الشعب الفلسطيني. كما يشير إلى عدم كفاية التأريخ لتجربة شعب ما، دون التطرق إلى الأدوار التي تقوم بها الشرائح الاجتماعية المختلفة؛ وذلك بالتركيز على دور النخب السياسية فقط، سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات معترفًا بها، ومسلطة الأضواء عليها. إن التركيز على فحص دور القيادة، أو النخب، أو الحزب، أو المؤسسة، أو الإطار، عادة ما يؤدى إلى إهمال الأدوار التي يقوم بها أفراد، أو جماعات من الشعب، خارج نطاق هذه الأطر أو الأجسام، وخارج دائرة الضوء المسلط عليها من الكتاب والمؤرخين. هذا الأمر يجعل مفهوم السياسة “الرسمية“، بما يعنيه من تركيز على تلك المؤسسات المشار إليها سابقاً، غير كاف لفحص مدى مشاركة المجموعات الاجتماعية المختلفة، حسب انتمائها الطبقي، ووضعيتها الاجتماعية – الاقتصادية الثقافية. ومن هنا، تنبع الحاجة إلى استخدام مفاهيم جديدة، لا تلقى مزيدًا من الضوء، على شرائح وفئات اجتماعية همش المؤرخون أدوارها فحسب، ولكن – أيضًا – لإلقاء مزيد من الضوء على العلاقات والدينامكيات الداخلية، في قلب الشريحة الواحدة، أو الطبقة الواحدة؛ ليتم فحص اختلاف القوة، وبالتالي، الأدوار بين الرجال والنساء، أو علاقات النوع الاجتماعي.
إن اتباع منهج يعتمد على فحص علاقة النساء بالرجال في المجال السياسي الرسمي، وغير الرسمي، وفحص بناء هياكل القوة الاجتماعية بين الاثنين، وليس – فقط – التركيز على النساء كنساء، ولكن بعلاقتهن بالمجتمع الواسع (GAD Approach وليس Wid Approach )، سيؤدى إلى إدخال مجموعات جديدة، لم يكن ينظر إلى أدوارها سابقاً. إذ سيكون التركيز، ليس – فقط – على الفروقات بين النساء والرجال، في الحياة السياسية، ولكن بين النساء أنفسهن. كما يشمل المدخل الأول، ليس – فقط – إظهار وجود النساء، في عالم السياسة غير الرسمي، ولكن – أيضًا – إظهار علاقتهن بالرجال. أي ماذا تفعل النساء؟. وماذا يفعل الرجال، في هذا المجال غير الرسمي؟.
محاولة للخروج من الظل
غطت صور النساء الفلسطينيات جميع وسائل الإعلام، في بداية الانتفاضة الفلسطينية، في كانون أول عام ۱۹۸۷، وبدا الأمر وكأن النساء يقمن بدور جديد يمارسنه لأول مرة، ولكن دراسة الواقع تشير إلى غير ذلك.
إن المتتبع للدور السياسي للمرأة الفلسطينية، قد يربطه بتطور “القضية الفلسطينية” منذ بداية القرن، وبالتالي نمو “الحركة الوطنية” الفلسطينية، التي احتضنت وشجعت وجود منظمات وجمعيات نسائية مرتبطة بها. ولكن – في الواقع – بالإمكان تتبع الدور السياسي – غير الرسمي – للمرأة الفلسطينية، منذ نهايات القرن الثامن عشر، حيث كانت النساء تلعب دوراً في الصراع السياسي الاجتماعي، الذي كان يقسم المجتمع الفلسطيني في ذلك الوقت، بين “قيس ويمن“. إذ ما كانت تلبسه المرأة، يعتبر مؤشراً على انتمائها “الحزبي” أو العصبوي – إن صح التعبير – وعلى انتماء عائلتها أيضًا (٤).
ولكن بدأ التركيز على الدور الذي تلعبه النساء في الحياة السياسية مع نمو المشروع الصهيوني في فلسطين، وأيضًا نمو الحركة الوطنية الفلسطينية في ذلك الوقت، في هذه الحقبة، ركزت معظم الكتابات التي أرخت لهذه الفترة، على الدور السياسي (الرسمي) الذي قامت به – تحديداً – نساء الطبقة الوسطى المدينية والمتعلمة (أكرم زعيتر: الحركة الوطنية الفلسطينية – يوميات أكرم زعيتر – ۱۹۸۰، ماتييل مغنم: المرأة العربية والمشكلة الفلسطينية، ۱۹۳۷، وأيضا:
Ellen Fleischmann: The Nation and Its’ New Women Feminism، Nationalism، Colonialism، and the Palestinian Women’s Movement، 1920 -1948).
إن هذا التركيز أبعد الاهتمام عن الدور السياسي الذي كانت تقوم به النساء، خارج نطاق الجمعيات والمنظمات التي كانت تدار من قبل النخبة النسائية في ذلك الوقت، والتي كانت “تمثل” المرأة في المستويات المحلية أو العربية أو الدولية. تلك الجمعيات والمنظمات التي كانت مرتبطة بالحركة الوطنية في ذلك الوقت، وتعتبر نفسها جزءاً منها. حتى المصادر التاريخية التي كتبت عن دور الفلاحين في ثورة الثلاثينيات (عبد الوهاب الكيالي: الموجز في تاريخ فلسطين الحديث)، نادراً ما تطرقت إلى ما كانت تقوم به النساء من مهام في هذه الفترة، على الرغم من محاولة هذه المصادر، إلقاء الضوء على الدور السياسي – غير الرسمي – الذي كانت تقوم به الفئات والشرائح الاجتماعية المختلفة، خارج نطاق السياسة الرسمية التي كانت تحتكرها النخبة في ذلك الوقت.
قد يعود هذا الإهمال؛ إلى عدم كتابة التاريخ الاجتماعي بعد للشعب الفلسطيني ككل، ولكن – أيضًا – إلى عدم “رؤية” النساء كفاعلات سياسيًا في ذلك الوقت. بمعنى أنه ليس بالضرورة أن يؤدى تناول دور الطبقات الاجتماعية المختلفة بالتأريخ، أن يؤدى هذا إلى تناول دور النساء، أو النظر – تحديداً – لعلاقات النوع الاجتماعي (Gender Relations)، فتناول المجتمع بالدراسة من منظور طبقي، لا يعني – بالضرورة – تناوله من منظور نوعی (Gender). هذا لا ينفي أن هناك محاولات قليلة – تعتمد خاصة على التاريخ الشفوي – بدأت تسد هذا النقص، سواء في إعادة كتابة التاريخ من منظور اجتماعی (طبقي)، أو في إعادة النظر للأدوار التي كانت تقوم بها النساء، “وإظهار” دورهن (٥).
إن القليل الذي يتطرق إلى دور النساء خارج نطاق المنظمات المدينية، يظهر فجوة واضحة بين ما كانت تركز عليه منظمات نساء النخبة السياسية في المدن، من طرق لمقاومة الحركة الصهيونية والانتداب، وما تقوم به النساء في الريف من مهام (مركز الثورة الرئيسي بعد ۱۹۳۳). فبينما كان تركيز النخبة على كتابة العرائض والاحتجاجات والتنديدات للمندوب السامي البريطاني، بالإضافة إلى تنظيم المظاهرات في المدن (التي لم يكن يحضرها – عادة – النساء الريفيات) (٦)، أو متابعة أحوال المساجين؛ بهدف تلبية احتياجاتهم، واحتياجات عائلاتهم، أي – باختصار – دور “إغاثى” واحتجاجي، نجد أن دور النساء في الريف، كان مختلفاً. إذ يلاحظ Swedenburg، “أن دور النساء كان مركزيًا في تقوية دور الثوار في الالتحام بالفلاحين، وفي اطالة أمد الثورة المسلحة، وفي الإفلات من عيون العملاء، وأيضًا من الوقوع في أسر القوات البريطانية” (٧). كثيرة هي النشاطات التي كانت تقوم بها النساء في ذلك الوقت، لتخرطهن – مباشرة – في “فعل” المقاومة، ومنها: قيام النساء والأطفال ليلاً ببناء الحواجز الحجرية الضخمة (سلاسل بعرض وارتفاع أمتار)، وإمداد المقاتلين في الجبال بالمؤن الغذائية الكافية (كانت النساء تخبز مئات الأرغفة ليلاً) (۸). أيضاً، كانت النساء تقوم بدور نشط، من على رؤوس التلال في استكشاف مواقع وتحركات العدو، وأيضاً، القيام بطلعات استكشافية – استخبارية؛ وذلك بدقة وسرعة شديدة (9). فتقارير قوات الأمن البريطانية، كانت تشير إلى أن “النساء تقوم بدور نشط في شؤون القرية، ويحرضن – دائماً – الشباب على أخذ دور فاعل؛ من أجل الدفاع عن وطنهم (١٠). كذلك عدم تردد النساء في اللجوء إلى العنف؛ للدفاع عن قراهن وعائلاتهن، عندما كان يأتى جنود القوات البريطانية، والتي كانت النساء تقوم برشقها بالحجارة من على أسطح منازلهن، وهو ما يؤدى إلى قتلهن أحيانًا على يد تلك القوات (۱۱). إضافة إلى المشاركة في مظاهرات احتجاجية عنيفة مثل تلك التي تعرف بأحداث “هبة البراق“، في شهر آب ۱۹۲۹، والتي قتل فيها برصاص الجيش البريطاني، ٩ نساء قرويات، من بين ۱۲۰ قتيلاً عربياً. أكثر من ذلك، هناك أدلة تشير لمشاركة النساء في نشاطات عسكرية مباشرة، سواء بمهاجمة الجنود البريطانيين عندما يأتون لاعتقال النشطاء السياسين من بيوتهم، أو حتى محاولة إحدى النساء تصفية عميل تسبب في قتل زوجها، وأخرى قتلت – بالفعل – كابتنا بريطانيا، وقطعت يدها بسبب ذلك، كذلك مشاركة نساء في التدريبات، بزي عسكری، مثال فاطمة غزال، والتي يقال إنها قتلت في معركة وادى عزون ١٩٣٦، وأيضاً أخريات. هناك أدلة – أيضًا – على اشتراك النساء في تهريب السلاح وتخبئته ونقله للثوار. أيضاً، شواهد تدل على اشتراك بعض النساء، في منظمة “الكف الأسود“، والتي اعتقلت لإرسالها رسائل تهديد إلى البوليس البريطاني، وكانت النساء المعتقلات يحكمن بأحكام عالية تصل ما بين ٧ إلى عشر سنوات (۱۲). ولتفادي العقوبات الجماعية التي كانت تنزلها القوات البريطانية بالقرويين، كانت النساء تنكر تعرفها على جثث أقرابائهن وأبنائهن؛ لتجنيب قراهن العقوبات الجماعية التي تتمثل في هدم البيوت وإحراق المزروعات (۱۳).
ومؤخراً، بدأت تظهر معلومات – تعتمد على التاريخ الشفوي – تشير إلى أنه في بعض القرى، كانت النساء آخر من رحل من قراهن (١٤). (وهو ما قد يثير شكوكًا قوية حول الادعاءات، عن ما هو شائع، بأن الرجال رحلوا خوفًا على شرف نسائهم). وبذلك كانت النساء، بمثابة الذاكرة الحية التي عملت على نقل كل ما خزنته من وقائع، لنقله فيما بعد إلى أبنائهن وأحفادهن.
ومن الملاحظ – هنا – أن معظم البطولات التي قامت بها هؤلاء النسوة لا تحفظ بأسمائهن، والتي كانت – في أغلبها – غير معروفة إلا بانتمائهن إلى أسماء الرجال (أخت فلان أو زوجة فلان… إلخ) (١٥).
إلا أن ما يثير الاهتمام – هنا – هو أنه توجد بعض الشواهد التي تدل على تأثير الفلاحين في لحظات المد الوطنى – خاصة في أثناء ثورة ١٩٣٦، ومع زيادة شدة القمع البريطاني ضد الفلاحين – على قيادات النخبة. ففي عام ۱۹۳۸، وبعد استهداف القوات البريطانية للابسي العقال – لبس القرويين – باعتبارهم كلهم ثوارًا، صدر بيان من إحدى القيادات، تحض فيه على نزع الطربوش عن الرأس (وهو غطاء الرأس، لدى جميع سكان المدن)، ولبس الكوفية والعقال؛ وبذلك يزول الفارق بين المجاهدين (القرويين في معظمهم) وغيرهم؛ وليكون رمزاً لكون الناس جميعاً ثائرين (١٦).
إننا لا نجد هذا التأثير الثقافي – وإن كان رمزياً – بين النساء القرويات، والنساء في المدن (النخبة الرسمية)، والذي على ما يبدو الفصل والهوة الاجتماعية بينهما كانت أوسع، إذ على الرغم من اشتراك النخبة النسائية في العديد من المظاهرات داخل فلسطين، وأيضاً الاشتراك في العديد من المؤتمرات الخارجية، لا نرى مصدراً تاريخيًا واحدًا يظهر هؤلاء النسوة بالثوب الفلسطيني مثلاً، وهو – بالأساس – زى النساء الريفيات. وبعد وفاة عز الدين القسام، والذي يعزى إليه تفجير ثورة عام ١٩٣٦، بتركيزه على تنظيم وتدريب الفلاحين والفقراء، لمقاومة القوات البريطانية بالسلاح والعنف، بدلاً من إرسال العرائض والمذكرات والوفود لمخاطبة البريطانيين عبرها، كما كان متبعًا من قبل النخبة السياسية الرسمية آنذاك نرى، أن ابنته ميمنة القسام، ذكر اسمها لمرة واحدة في أثناء مؤتمر نساء الشرق، ولم تذكر بعد ذلك في أية وثيقة أو مؤتمر (17). إن هذا قد يشير إلى عدم تقدير مدى شعبية والدها في أوساط الفلاحين والفقراء، وبالتالي، عدم تقدير أهمية إظهارها وإبرازها كوجه يعبر عن شريحة أخرى، كانت محط اهتمام شديد ورعاية من قبل والدها.
وبعد هزيمة عام ١٩٤٨، والتي أسفرت عن تأسيس دولة يهودية على 77% من أرض فلسطين، واقتلاع الفلسطينيين من نحو عشرين مدينة وأربعمائة قرية، غدت بأملاكها ومزارعها، جزءاً من الدولة اليهودية الجديدة. كما لقى عشرة آلاف فلسطيني – على الأقل – مصرعهم، في حين أصيب ثلاثة أضعاف ذلك العدد بجروح، وبات تسعمائة ألف شخص لاجئ تقريبًا، أي ما يعادل ٦٠% من سكان فلسطين – آنذاك – بلا مأوى (۱۸). لقد كان هذا انهياراً للمجتمع الفلسطيني بكل مكوناته؛ مما أسفر عن وجود ظاهرة جديدة في هذا المجتمع، أطلق عليها “مخيمات اللاجئين“. في كانون ثان عام ١٩٤٩، عندما أعد برنامج لحصص الطعام، كان عدد اللاجئين الذين سجلوا يقدر بما يعادل مليون لاجئ. وبمقارنة هذا الرقم، بتعداد سكان فلسطين، قبل عام ١٩٤٨، يتضح أن ثلاثة من كل أربعة فلسطينيين قد فروا من بيوتهم، أو وصلوا إلى حالة الفقر المدقع، وكانت الغالبية العظمى منهم تعتمد على الإغاثة الدولية التي تضمن لهم البقاء على قيد الحياة. وكانت المخيمات بعد موجات هجرة الذكور في الخمسينيات والستينيات والسبعينيات إلى دول النفط الغنية، الملجأ الأم لكبار السن، والنساء والأطفال؛ مما كان يضيف أعباء هائلة على النساء في تلك المخيمات في “تدبير” شؤون الأسرة، سواء كانت المأساة هي المعيل، في حال فقدان رب الأسرة، أم المربى في حال وجود المعيل، في مكان بعيد لكسب الرزق، كما هي الحال، في معظم مخيمات قطاع غزة.
في إحصاء لوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين في عام ۱۹۸۹ (WOR 760/ A/ 1989) تبين أن نسبة النساء المعيلات لأسرهن، كانت كما يلى:
أرباب الأسر حسب الجنس عام ۱۹۸۹
|
الجنس |
الضفة الغربية |
قطاع غزة |
الأردن |
لبنان |
سوريا |
المجموع |
|
ذكور |
58728 |
84932 |
102145 |
52755 |
4461 |
943179 |
|
إناث |
32291 |
17796 |
22731 |
14846 |
12987 |
100651 |
|
المجموع |
91019 |
102728 |
125476 |
67601 |
57606 |
1043830 |
|
(نسبة مئوية للإناث) |
36.2 |
17.3 |
18.2 |
22.0 |
22.5 |
22.9 |
المصدر: أوضاع المرأة الفلسطينية داخل وخارج فلسطين، التقرير الوطني لدولة فلسطين، تقرير أولى. الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية (بدون تاريخ ولكن الأرجح أنه تم في عام ١٩٩٥ على هامش التحضير لمؤتمر بكين).
إن النسب المشار إليها سابقاً، تعتبر عالية حسب المقاييس العالمية، والتي تتراوح نسب الأسر التي تعيلها نساء بين ١٥ – ۲٥% (راجع تقرير الموارد البشرية). وقد يرجع تدنى هذه النسبة في قطاع غزة، مقارنة بالضفة الغربية، إلى زيادة نسب الأسر المعيشية الممتدة في قطاع غزة، مقارنة بالنسبة إلى الضفة الغربية؛ حيث تبلغ نسبة تلك الأسر في الضفة، ٢٤.٦% وفي قطاع غزة تصل إلى 35.3% وبالطبع، تزيد نسبة الأسر النووية في الضفة الغربية، مقارنة بغزة، لتصل إلى 72.1% في الضفة، و ٦٢.٧% في قطاع غزة. إن هذه الظروف العامة، ساهمت – بشكل واضح – في التنشئة السياسية للمرأة الفلسطينية، كما لكل أفراد المجتمع. وهو ما قد يميز المجتمعات الفلسطينية عن غيرها من بقية الدول العربية، والتي تعاني من حالة لامبالاة سياسية من قبل شعوبها، وخاصة بين النساء.
إن هذا الدور غير المرئي نراه يتسع ويتعاظم في لحظات المد الوطني – بشكل عام – وفي لحظات الأزمات أيضاً، وذلك دون الحاجة للدخول في تنظيم أو حزب أو مؤسسة. وهو ما نراه ونلاحظه – دائماً – في محطات المد الوطنى كافة، على طول سنوات النضال الفلسطيني ضد الانتداب البريطاني والحركة الصهيونية.
لذا لم يكن جديداً على المرأة الفلسطينية، لعب الدور الذي “وضح” في وسائل الإعلام المختلفة، إبان الانتفاضة، والذى تمحور – أحياناً – في المشاركة في المظاهرات العنيفة، التي ميزت الانتفاضة في بدايتها، والتي سقط فيها برصاص جنود الجيش الإسرائيلي، سهيلة الكعبي، وسحر الجرمي، في ۱۱/ 12/ 1987، من مخيم بلاطة في نابلس. كما اتخذ هذا الدور أيضًا – كما كان في الماضى – أشكال مقاومة عنيفة، لاعتقال أفراد العائلة، مثل حالة وجيهة ربايعة – دير أبو مشعل – والتي لم تتردد، في محاولة قتل جندى بفأس في يدها، والذي كان يصوب على ابنها الهارب؛ مما أدى إلى قتلها هي في 30/ 3/ 1988.
كذلك لعبت النساء دوراً هاماً في الاستجابة لطلب القيادة السياسية في تنظيم حملات لنسج ملابس صوفية للمعتقلين، خياطة الأعلام كرمز لطلب الاستقلال، توفير بدائل منزلية للسلع الإسرائيلية ومقاطعة شرائها، وكذلك بث ثقافة سياسية وطنية للأطفال والنشء. إضافة إلى ذلك، توجد أشكال من النشاط السياسي غير الرسمي، والتي تدور خارج إطار العائلة والأسرة المعيشية، والتي كانت تتطلب التنقل المستمر والسفر – أحياناً – لمسافات بعيدة، وتشمل: الزيارات المنتظمة للمعتقلين من الأقارب والأبناء، والتي تبدأ – عادة – من ساعات الفجر الأولى، حتى منتصف الليل، بما يشمل ذلك من تعرض للإذلال والمهانة، سواء عن طريق ساعات الانتظار الطويلة على أبواب السجون، أو بالضرب، أو بالتفتيش الشخصي المهين، وكل ذلك مقابل دقائق لا تتعدى – أحياناً – نصف الساعة لرؤية الأبناء والأحباء. أيضاً، عادة ما تقوم النساء بمتابعة القضايا الخاصة بالمعتقلين، سواء في مكاتب المحامين، أو أروقة المحاكم الإسرائيلية، متابعة جباية مخصصات الشهداء والجرحى والمعتقلين المعتمدة، من مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، وهو ما كان يستدعى – أحياناً – السفر إلى الأردن، أو إلى لبنان وتونس، فيما بعد. إضافة إلى ذلك، هناك دور النساء الرابط الأواصر العائلة الصغيرة أو الكبيرة، وأحياناً لأبناء القرية الواحدة، بين من هم في داخل الوطن مع من هم في خارجه.
هذه الأنشطة والمهام “السياسية” المختلفة التي قامت وتقوم المرأة الفلسطينية بأدائها غالباً ما ينظر إليها كأعمال فردية تقوم بها النساء لحماية عائلاتهن وأقربائهن، وبالتالي، فهي من متطلبات المعيشة والحياة اليومية للمرأة لحماية بيتها وأسرتها، خاصة وأن معظم هذه الأنشطة، تدور داخل المنزل أو حول العائلة.
ونظراً إلى هذه الطبيعة الخاصة للأدوار “السياسية” التي تقوم بها النساء، لا يرى المؤرخون – وهم رجال في معظمهم – هذه الأدوار، ولا يذكرونها كدور، ولكن ينظرون إليها كعمل “عادی“، “طبیعی“، تستلزمه متطلبات وظروف الحياة اليومية التي تواجه النساء، وبالتالي، لا يعتبر “فعلاً” يستحق التأريخ. إن هذه النظرة لا ترى – فقط – الفروق بين أدوار النساء، وأدوار الرجال في المجتمع، ولكن أيضًا – لا تقدر الأدوار التي تقوم بها النساء، ولا تراها – أصلاً – كأنوار تستحق التأريخ، سواء أكانت سياسية أم اقتصادية أم حتى اجتماعية. إذ لو قتلت امرأة قروية ما في مظاهرة، أو أمام بيتها، نظراً إلى مقاومتها، فهي قتلت نتيجة ظرف ما خاص بها، وليس نتيجة اختيار لدور أرادت أن تؤديه، حتى لو أودى بحياتها، وبالتالي، ينظر – دائماً – لهذه الحالات كحالات “فردية” مهما تعددت. وينظر دائماً إلى الدور “السياسي” كدور للنخبة، حتى لو لم تسقط منها شهيدة واحدة.
إن هذا الأمر يطرح تساؤلاً يتعلق بمن يكتب تاريخ من؟. ومن يؤرخ لمن؟. وما الأسباب التي حدت بالنخبة السياسية (الرسمية)، وبالتالي بمؤرخيها إلى عدم رؤية هذه الحالات كمؤشر وتعبير عن مدى جاهزية النساء الريفيات، والريفيات تحديداً، للعب دور أكثر مباشرة، وأكثر مقاومة من دور النخبة المدينية؟.
إن عدم رؤية ما تقوم به النساء الريفيات من أدوار إبان ثورة شعبية فلاحية عارمة كثورة عام ١٩٣٦، قد يكون وراء تسجيل وتمجيد دور النخبة النسائية في ذلك الوقت، والتي تجلى دورها أكثر ما تجلى في كتابة العرائض، المشاركة في المؤتمرات، تنظيم المظاهرات في المدن أساساً، جمع التبرعات لإغاثة المنكوبين والمتضررين، من سياسات الاحتلال البريطاني في ذلك الوقت. وعلى الرغم من أهمية هذا الدور – وأيضاً – الاحتياج له، لكن من المستغرب أن “فعل المقاومة المباشر“، وما يستتبعه من تنكيل وتشريد وقتل لا يستحق القدر نفسه من الاهتمام؛ ليسجل ويؤرخ له. وبالتالي، دفنت بطولات كثيرة دون أن تؤدى إلى خلق بطلة واحدة، وتوارت تضحيات كبيرة دون أن تخلق رمزاً واحداً، وسقط العديد شهداء، ولكن دون أن يخلفن صورة واحدة، يكتب عليها اسم إحداهن. وهو الأمر الذى أدى لانتساب كثير من هذه البطولات إلى أسماء عائلات أو رجال النساء، وليس إلى النساء أنفسهن، فرأينا بطولات عن زوجة فلان، أو أخت فلان أو بنت فلان…. إلخ.
إن هذا الأمر يجعل مفاهيم مثل النوع الاجتماعي، والطبقة، مفاهيم أساسية لإعادة كتابة التاريخ، وإعادة رؤيته، ليس – فقط – من منظور النساء، ولكن – أيضًا – من منظور.
طبقتهن الاجتماعية عندها، لن يعاد الاعتبار فقط، لمن فعل ماذا، ولكن – أيضًا – كيف فعله. إذ ليس من المعقول، أن يدخل التاريخ ويمجد، من فقد ساعات من وقته، ويطوى أدراج النسيان، من فقد بيته وأطفاله ودماء وحياته، تضحية وفداء للوطن نفسه.
هناك عناصر عدة، تتفاعل مع هذه المهام والأنشطة، بشكل يساعد النساء على التطور (empowerment)، وبالتالي، تلعب النساء دورًا مؤثرًا في عملية التغيير، على المستوى السياسي والاجتماعي، أو على العكس من ذلك، تستعمل كعوامل لتهميش وعزل النساء من أن يلعبن دورًا مؤثرًا وفاعلاً على مستوى السياسة الرسمي.
إن هذه المهام والأنشطة – عادة – ما تؤثر عليها عوامل مرتبطة بالمجتمع ككل، تؤثر في هذه النشاطات، كما تتأثر بها. وغالباً ما تؤثر هذه العوامل على تلك الأنشطة والمهام؛ لتحولها إلى دور سياسي، يلعب دورًا في عملية التطور والتغيير في المجتمع، وأيضاً، في تطوير وتغيير وضعية المرأة في المجتمع المعنى. وكثيرة هي العوامل التي أثرت على المهام والأنشطة السياسية، التي قامت وتقوم بها المرأة الفلسطينية، والتي بالإمكان ذكر أهمها فيما يلي.
الاحتلال الإسرائيلي
أصبح من الشائع في الأدبيات العالمية، عند تناول دور المرأة في المجتمع، وخاصة في السياسة، عدم تناوله بمعزل عن تأثير الاستعمار أو “الكولونيالية“، بالإضافة إلى “الوطنية” كعناصر رئيسية تؤثر على النساء، خاصة في دول العالم الثالث. ويتلخص تأثير الكولونيالية على النساء بشكل عام، في عدة قضايا منها: تأخير وتأجيل النضال الاجتماعي بسبب هيمنة القضية الوطنية على غيرها من القضايا، كما عمل الاستعمار على تأكيد عدم المساواة السائدة في المجتمع، وبالتالي، تعميق الفجوات الاجتماعية والإثنية وأيضاً الدينية (سياسة فرق تسد)، كذلك عمل على التحكم في النظام القيمي الثقافي السائد بهدف استخدام ما يرسخ علاقة الهيمنة والتبعية الاستعمارية وأيضاً تشويش وتحقير ما يقف في وجه هذه الهيمنة (انظر : Chandra Mohanty 1984، Jill Bystydzienski 1992، Kumari Jayawardena 1986).
إن النظر في تأثير دور الاستعمار على أدوار المرأة في المجتمع الفلسطيني، لا يقف عند دور الاحتلال الاستيطاني الإسرائيلي، ولكن تسبقه – أيضًا – فترة الاحتلال البريطاني، وما سبق هذا الاحتلال من “احتلالات” أخرى؛ وذلك لكى لا يكون محور التأريخ هو تاريخ الكولونيالية الأوروبية. إن الغوص في هذا التاريخ سيخرج هذه الورقة عن مسارها، وهو تتبع العناصر التي أثرت على الأدوار التي تقوم بها النساء في المجتمع، وخاصة الدور السياسي.
إن العنصر الأساسي الذي أثر فيه الاحتلال الإسرائيلي بعد عام ١٩٦٧ على المرأة وبالتالي على دورها السياسي، هو إلغاء هذه المسافة بين عالم المرأة الخاص (المنزل)، وعالمها العام (المجتمع)، على الرغم من عدم اعتمادنا هذه الثنائية في تحليل أوضاع المرأة الفلسطينية، بشكل عام. إن هذا الإلغاء تم بسبب اتباع الاحتلال الإسرائيلي سياسة العقوبات الجماعية ضد الشعب الفلسطيني عامة. إن هذه السياسة ليست جديدة بالنسبة للفلسطينيين، إذ كان الانتداب البريطاني يستعملها – أيضًا – خاصة ضد الفلاحين في القرى؛ حيث نجد أن مداهمات الجنود لبيوت الفلاحين كانت من الأشياء المعتادة؛ بحثاً عن السلاح والمطلوبين (١٩). إن هذه المداهمات، كانت تعنى تحطيم الأثاث البسيط في البيت، تمزيق الفراش، تخريب مؤونة السنة من الغذاء، سواء أكانت من الحنطة، أم من الطحين، أم من الحبوب، أم من السمن أم من الجبن أم من – وهو الأهم بالنسبة إلى العائلة الفلسطينية – زيت الزيتون. إن هذا التخريب – عادة – ما كان يتبعه حرق أو هدم بيوت النشطاء من الفلاحين، والذين يثبت ضلوعهم في نشاطات عسكرية، ضد قوات الانتداب البريطاني (من أوراق أكرم زعيتر، وثائق الحركة الوطنية الفلسطينية ١٩٨٤، ص. ٦.١، كذلك يوميات أكرم زعيتر: الحركة الوطنية الفلسطينية ١٩٣٥ – ١٩٣٩ ص ٤١٤).
إن توسع سلطات الاحتلال الإسرائيلية في سياسة العقوبات الجماعية لم تطل “النشطاء من الفلاحين” فقط، كما كان الحال وقت الانتداب البريطاني، ولكن طالت السكان عامة – خاصة أثناء الانتفاضة – وذلك لأن هدف الاحتلال الإسرائيلي ليس قمع الفلاحين ووقف الثورة، كما كان عليه الحال في الثلاثينيات، ولكن إكمال مشروع الحركة الصهيونية في قلع الشعب من وطنه. لذا تنوعت أشكال “العقوبات الجماعية“، من مداهمة البيوت سواء في المخيم أو في القرية أو في المدينة، إلى مداهمة أماكن العمل، سواء ورشة، أو مزرعة، إلى مداهمة أماكن الدراسة سواء أكانت روضة أم مدرسة أم جامعة (أغلقت جميع المؤسسات التعليمية – بما فيها رياض الأطفال – ابتداء من 9 كانون الأول ۱۹۸۷، وحتى ۳۱ كانون ثان ۱۹۸۹، حيث حرم ذلك أكثر من ۳۲۸.000 طالب وطالبة، في كل المستويات التعليمية، وفي كل المناطق من التعليم الرسمي) (۲۰)، إضافة إلى التوسع الكبير في سياسة هدم البيوت، والتي ألقت بآلاف من الأسر الفلسطينية في العراء؛ ليس بسبب النشاطات الأمنية فقط، ولكن – أيضًا – بسبب المخالفات لسياسة “التنظيم الهيكلي” الإسرائيلية للحد من توسع القرى والمدن الفلسطينية بشكل طبيعي. هذا عدا عن إجراءات منع التجول المكثفة والطويلة، بشكل شبه مستمر، والتي شلت حركة السكان، ليس – فقط – في قلب مناطق سكناهم، ولكن أيضًا بين المناطق وبعضها، سواء أكانت مدنًا أم قرى.
إن هذه الإجراءات، أو بالأحرى السياسات، عملت على هدم الحدود الفاصلة، بين البيت كمكان آمن يلجأ إليه الإنسان وقت الخطر، وأى مكان آخر خارجه، سواء أكان سجنًا، شارعًا مدرسة، أو مكان عمل.
إن هذه السياسات، كانت بمثابة المدرسة التي نشأت أجيال مختلفة في كنفها، ووضعت أطر التنشئة السياسية للفلسطينيين، تلك التنشئة التي تربى عليها كل فرد في كل مكان يذهب إليه، أو يعيش فيه في حياته اليومية، ما عدا – وعلى الرغم من غيابها – في مؤسسات التعليم الرسمية، والتي كانت تحرم تعليم الفلسطينيين عن تاريخهم، وخاصة السياسي.
إن هذا الإلغاء لحدود البيت كمكان أمن تلجأ إليه النساء وأطفالهم، دفع بالجميع – بما فيهم النساء والأطفال – للخروج إلى الشوارع، والتظاهر بعنف ضد الاحتلال. إن هذا يجعل الاتهام الموجه إلى النساء الفلسطينيات، بأنهن يلقين بأطفالهن في الشوارع؛ لكى “يجبر” الجنود على قتلهم شيئًا مثيرًا للسخرية، فكثيرة هي الحالات التي قتل وضرب فيها بوحشية، آباء وأمهات وأخوة داخل بيوتهم – وبشكل متعمد – على مرأى ومسمع من أطفالهم، أو بالعكس نكل بأطفال أمام والديهم، دون أن يتمكنوا من توفير الحماية لهم (۲۱).
التأثير على وتفعيل منظومة القيم الثقافية
إن استخدام القيم السائدة بهدف إحلال علاقات سيطرة محل أخرى ليست سلاحاً ذا طرف واحد، ولكن – في الغالب – ذو طرفين. فكما استخدم الاستعمار القيم السائدة بهدف تفتيت وإحكام السيطرة على الشعب المحكوم، هناك – أيضًا – إمكان استخدام ما هو سائد من قيم لتحفيز المقاومة، ولتوحيد الشعب في وجه المحتلين (فرانز فانون، وجوه بيضاء وأقنعة سوداء ١٩٥٢، ومعذبو الأرض ١٩٦١).
لقد عمل الانتداب البريطاني قبل الاحتلال الإسرائيلي، على استخدام منظومة القيم السائدة بهدف قمع المقاومة من جهة، والحفاظ على علاقات اللامساواة من جهة أخرى. فكثيرة هي الحالات التي انتهكت فيها قيم، تتعلق باحترام العربي لنفسه، عن طريق محافظته في لبسه، وتغطية جسده، سواء أكان ذلك للرجل أم للمرأة. وتعج كتب التاريخ بالأمثلة، التي عرى فيها الرجال أمام النساء بهدف إذلالهن، وكسر شوكة مقاومتهم (يورد أكرم زعيتر في يومياته عن حادثة وقعت في قرية الجديدة، في عكا حيث أجبر الجنود البريطانيون جميع الرجال على خلع كامل لباسهم، والوقوف لمدة أربع ساعات عراة تماماً، وإحضار نساء القرية لمشاهدتهم في هذه الحالة، ص ٤١٨).
كذلك هناك حالات أخرى، تم فيها استخدام مفهوم “الشرف” العربي، والمرتبط بطهارة النساء لإفزاع الفلاحين، وتهجيرهم من قراهم. إن هذا الاستخدام، برز على يد القوات اليهودية، التي سعت لتهجير الفلاحين من قراهم، خاصة في المعارك التي تلت تقسيم فلسطين في عام ١٩٤٧ (بنى موريس ۱۹۸۷، ص ۱۱۳ – 115 وآخرون) (۲). إن هذا الاستخدام، برز – أيضًا – من قبل القوات الإسرائيلية بعد عام ١٩٦٧؛ حيث كان هناك سعى مستمر لإيصال رسالة فحواها أن المرأة التي تشترك في أنشطة سياسية عامة، تستهدف الاحتلال، سينتهك “شرفها“. لقد ترجم هذا عبر عشرات الحالات، من الاعتداءات الجنسية على المعتقلات، في السجون الإسرائيلية، خاصة المتهمات في قضايا عسكرية (محاكمة رندة النابلسي، في عام ١٩٦٩، رسمية عودة، لطيفة الحوارى، عايشة عودة، وأخريات)، أو التلويح والإيحاء بالاعتداء على مئات من الحالات الأخرى.
لقد توسعت سلطات الاحتلال الإسرائيلية في استخدام هذا النهج إبان الانتفاضة نظراً إلى اتساع دور النساء في المشاركة. فكثيراً ما كان الجنود يخلعون ملابسهم، للتلويح للنساء بحركات جنسية؛ إمعاناً في الإهانة. إن هذه الممارسات، مازالت تستخدم حتى الآن، فإمعاناً في التنكيل بقرية صوريف (إحدى قرى الخليل)، والتي خرج منها انتحاري لتفجير نفسه في أحد مقاهي تل أبيب. داهم عدد ضخم من الجنود القرية، وانزلوا شتى ألوان العقوبات الجماعية بأهلها، من نسف بيوت، لاعتقال شباب، لتحطيم أثاث، وتخريب خزين البيوت من مواد غذائية، بالإضافة إلى الاعتداء الجنسى على ثلاث نساء من القرية (۲۳). أيضًا انتشرت عديد من القصص التي تتحدث عن الابتزاز الجنسي، الذي تقوم به الأجهزة السرية الإسرائيلية ضد الناشطين، أو أهاليهم، وخاصة النساء (الإسقاط)، وهو الشيء الذي أدى – في قطاع غزة مثلاً – إلى فرض قيود عديدة على خروج الفتيات، وساهم – أيضًا – في انتشار الزواج في سن مبكرة للفتيات طلباً للسترة (طبقاً لمركز الإحصاء الفلسطيني – أخذ الإحصاء من ريما).
إن هذا لا يعنى أن عملية استخدام القيم تسير في اتجاه واحد دائماً لصالح المستعمرين. فكما كانت تستخدم قوات الانتداب البريطاني القيم السائدة عن الصدق والأمانة في ابتزاز معلومات من الفلاحين (كان الجنود يضعون يد الفلاح على القرآن ليحلف أن زوجته ستكون طالقًا منه، إن لم يقل الصدق). فكان أن أصدرت جمعية الشبان المسلمين في مصر بياناً، أفتت فيه بتكفير الذين ينضمون إلى بريطانيا، في محاربة فلسطين، تكفيراً يرتب عليهم طلاق زوجاتهم (٢٤)، كذلك الحركة الوطنية الحديثة، عندما عملت على رفع شأن النساء المعتقلات والخاضعات للتحقيق الإسرائيلي، على الرغم من معرفة تبعاته وشراسته ضد النساء، واستخدام ما تعرضن له كشئ يعطى قيمة أكثر لهؤلاء النسوة؛ وذلك عن طريق الزيارات المستمرة لأهالى المعتقلات، ومشاركة الزائرين من الأهل والجيران، الحديث عن مناقب المعتقلة، وما قامت به من بطولات لنصرة شعبها.
وعلى الرغم من العديد من الأمثلة التي تحدث فيها المرأة الفلسطينية هذا الاستخدام المبطن للقيم والتقاليد للحد من دورها، مثل النظر إلى النساء – مثلاً – كعنصر تقلیدی خامل، وهو الذي حدا بسلطة الاحتلال في عام ١٩٧٦ لإعطاء النساء الحق في الانتخابات البلدية في الضفة الغربية أملاً في أن تصوت النساء لصالح الكتل المعتدلة (التقليدية، أو التي تعتمد على قاعدتها العائلية والعشائرية) ولكن الغالبية العظمى من النساء في ذلك الوقت، ساهمن في إنجاح الكتل الراديكالية، والقريبة من منظمة التحرير الفلسطينية، إلا أنه، وفي بعض الظروف، نجح الاحتلال في تفعيل تلك القيم للحد من الدور السياسي للنساء، خاصة عندما عزز ذلك توجه تیار سیاسی فلسطيني يستند إلى إيديولوجية سياسية دينية، وإيديولوجية اجتماعية تقليدية (تيارات الإسلام السياسي) تجاه النساء.
* إصلاح جاد: محاضرة جامعية بجامعة بيرزيت، فلسطين. وعضوة مركز دراسات المرأة بالجامعة.
1 – وليد الخالدي. قبل الشتات: التاريخ المصور للشعب الفلسطينى ١٨٧٦ –١٩٤٨، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، ۱۹۸۷، ص ۱۰۱.
2 – المصدر السابق: ص ٢٢٢.
3 – Rosemary Sayigh، “Femmes Palestiniennes: une histoire en quete d’historiens”، Revue d’etudes Palestiniennes 23 (Spring 1987) p. 14.
4 – E. N. Haddad، Political Parties in Syria and Palestine (Qaisi and Yemeni). The Journal of Palestine Oriental Society، Volume II. Jerusalem، 1922.
5 – See for example: Ted Swedenburg. Problems in Oral History: The Second Sex and the Palestinian Revolution، (Chicago: Lawrence Hill Books، 1992). Bir- zeit Research Center Project “Race Against Time to Reconstruct the Social-Economic and Political History of Destroyed Palestinian Villages in 1948 Judith Tucke، “Ties that Bound: Women and Family in Eighteenth and Nineteenth Century Nablus”، Women in Middle Eastern History، ed. Nikki Keddie and Beth Baron (New Haven: Yale University Press، 1922). Peteet Julie، Gender in Crises: Women and the Palestinian Resistance Movement (New York: Columbia University Press، 1991). Sayigh Rose Mary. Palestinians From Peasants to Revolutionaries (London: Zed Press، 1979).
6 – Fleischmann Ellen، “The Nation and its New Women: Women، Feminism Nationalism، Colonialism، and the Palestinian Women’s Movement، 1920 – 1948″. Diss Georgetown University، 1996. p.200
-
– Swedenburg، ibid. p. 180
8 – مقابلة مع السيد بهجت أبو غربية، أحد القادة العسكريين، الذي برزوا في عمليات المقاومة، وقائد عمليات المقاومة عن منطقة القدس، إبان حرب ١٩٤٨، تمت في عمان، بتاريخ ١٥/ 10/ 1992.
9 – Elizabeth Finn، Palestine Peasantry: Notes on Their Clans، Warfare، Religion، and Laws (London: Marshall Brothers، 1923)، p. 27. Mentioned in Fleischmann، ibid. p.208.
10 – “Military Lessons of the Arab Rebellion in Palestien 1936”، General Staff Headquarters، British Forces in Palestien and Trans-Jordan، Feb. 1938، Wo 282 6، Mentioned in Fleischmann، ibid، p.208.
١١ – نساء في حلحول وبيت نجار قمن برجم الجنود بالحجارة، وجرح بعضهن؛ جراء ذلك. وكذلك قتلت شابة في كفر كنا، وغيرها حالات أخرى. ذكر في Fleichmann، ibid، p. 209.
12 – Fleichmann، ibid، p. 209.
13 – أكرم زعيتر. الحركة الوطنية الفلسطينية، 1935 – ۱۹۳۹. مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بیروت، ۱۹۸۰، ص ٤٧٩. ورد ذلك في خطبة “السيدة وحيدة حسين الخالدي عضوة وفد فلسطين لمؤتمر “نساء الشرق“، والذي نظمته هدى شعراوى في القاهرة ۱۹۳۸.
١٤ – نصر يعقوب، وفاهوم الشلبي. قرية أبو شوشة، من سلسلة القرى الفلسطينية المدمرة رقم (۱۸). مركز دراسة وتوثيق المجتمع الفلسطيني، آذار ١٩٩٥، ص ٥.
15 – Fleichmann، ibid، p.210.
١٦ – زعيتر، ص ٤٤٠.
۱۷ – زعيتر ص ٤٨٤.
۱۸ – وليد الخالدي، قبل الشتات: (التاريخ المصور للشعب الفلسطيني ١٨٧٦ – ١٩٤٨. مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، ۱۹۸۷، ص ۱۳.
19 – Newton، 1971، mentioned in Peteet: ibid، p. 55.
20 – Facts Information Committee، Jerusalem، The Palestinian Uprising. Edit. Samir Abed- Rabbo and Doris Safie، Association of Arab- Amercan University Graduates. (Belmont Massachusetts، 1990) p. 307.
21 – Facts Information Committee، Jerusalem. Towards a State of Independence، 1988.
22 – Menitoned in Peteet، ibid، p. 59.
۲۳ – أعداد جريدة الأيام الفلسطينية في الأسبوع الأول من شهر نيسان ۱۹۹۷.
٢٤ – أكرم زعيتر الحركة الوطنية الفلسطينية 1935 – ۱۹۳۹ (يوميات أكرم زعيتر) مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، ۱۹۸۰، ص ۱۹۱.














