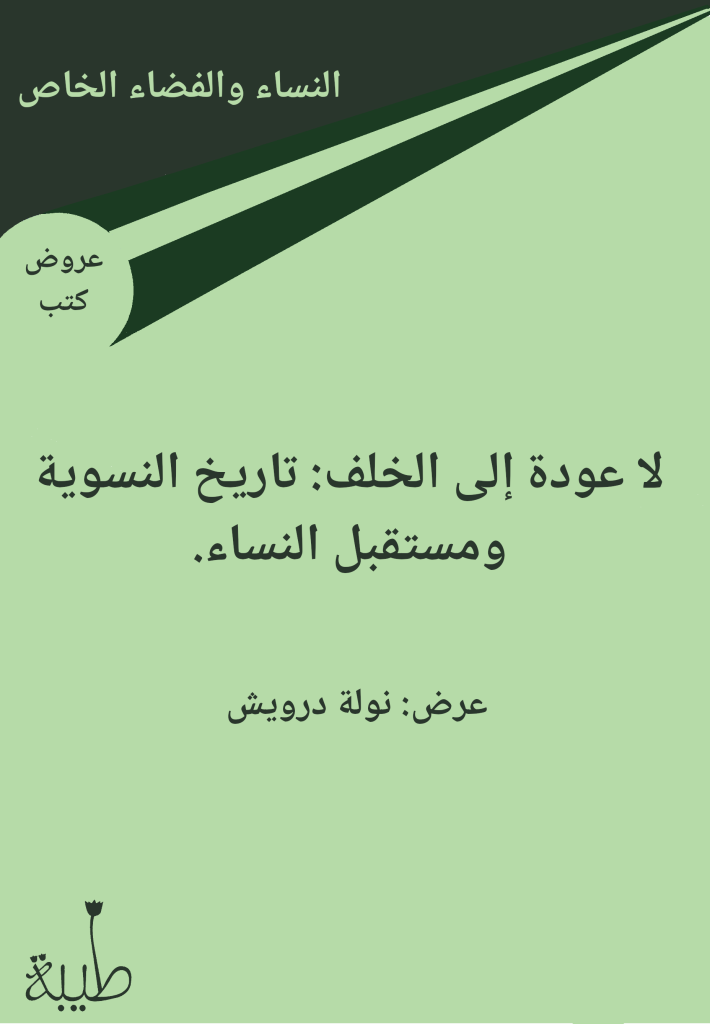لا عودة إلى الخلف.. تاريخ النسوية ومستقبل النساء
مؤلفة هذا الكتاب– إستيل فريدمان– أستاذة جامعية ومؤسسة برنامج الدراسات النسوية بجامعة ستانفورد الأمريكية، وقد قامت بنشر عدة مؤلفات حول تاريخ النساء في الولايات المتحدة الأمريكية، يتكون الكتاب الذي نعرضه من ٤٤٦ صفحة ويضم مقدمة، وخمسة أجزاء، بالإضافة إلى الهوامش، والملاحق، والملاحظات الببلوغرافية، وقائمة المصطلحات والأسماء، وهو مؤلف حديث، صدرت طبعته الأولى في مارس ۲۰۰۲.
في مقدمتها للكتاب، تشير فريدمان إلى أنها تعتبر قيامها بتدريس المدخل إلى الدراسات النسوية بمثابة مساهمتها الخاصة للنسوية، ولذا رأت أهمية نقل هذه التجربة في كتاب لتصل إلى أوسع جمهور ممكن، وهي تشير إلى تطور فكرها وموقفها عبر السنوات، فتتذكر– على سبيل المثال– رفضها في الستينيات الاستماع حتى إلى تعبير «التاريخ النسائي» بزعم أنها تفضل القيام بتدريس التاريخ «الحقيقي». غير أن هذه الرؤية قد تغيرت عبر قـراءات متعددة، تذكر منها دوريس ليسنج، سيمون دي بوفوار، کیت ميللت، وآخريات. كما ساهم في تغيير هذه الرؤية، البيئة والظروف المحيطة، والتناقض الموجود بين تطلعات جيلها إلى السلام والحب، بينما يهيمن العنف على الثقافة التي تنتمى إليها.
ولا يفوتها أن تتقدم بالشكر لكل من ساعدها وساهم في إخراج هذا المؤلف إلى نور، فهي تشير بطريقة واضحة إلى مساهمة كل من الزملاء والطلبة في برنامج الدراسات النسوية بجامعة ستانفورد، فتقدم لنا عشرات الأسماء من الزميلات والزملاء والطلبة الذين ساعدوها بطريقة أو بأخرى، سواء من خلال ملاحظاتهم أو المعلومات التي أمـدوها بها، أو تسجيل محاضراتهـا أو الاستماع إلى شرائط هذه المحاضرات والإشارة إلى المواضع التي تحتاج إلى تطوير. كما لجأت المؤلفة إلى بعض المتخصصين للقيام بقراءات نقدية، فاستشارات على سبيل المثال خبراء في تاريخ الشرق الأوسط وأفريقيا والصين، أما خارج أسوار الجامعة، فقد لقيت دعمًا وافرًا من أسرتها وأصدقائها، ومع كل هذه المساعدات المشار إليها، وحيث ولد هذا الكتاب في حضن جدران الفصل، فإنها تهديه إلى طلابها الذين تعلمت الكثير منهم.
قبل الدخول في الأجزاء الخمسة المكونة لهذا المؤلف، تبدأ الكاتبة بفصل يقدم “الحالة التاريخية للنسوية“، فهي تشير إلى أن القرنين الماضيين قد شهدا ثورة بدّلت حياة النساء، وهي ثورة لا تشبه الثورات الوطنية، فهي تمتد عبر القارات على مدى عقود، وبدلاً من اللجوء إلى الكفاح المسلح، تقوم هذه الثورة ببطء بغرس بذور التغيير، والتسلل إلى ضمائرنا من خلال الفكرة البسيطة أن النساء بالقدرة والقيمة نفسها للرجال. وتقول إن الكتاب يشرح لماذا وكيف حدثت الثورة النسوية، وهناك– من وجهة نظرها– مرحلتان أساسيتان ساهمتا في بروز ونمو النسوية، هما: صعود الرأسمالية وما أدت إليه من نهوض للأوضاع الاقتصادية للرجال مع تحديد أدوار النساء باعتبارهن أتباعًا للرجال، والنظريات الجديدة حول حقوق الفرد والحكومة الممثلة والتي ساهمت– إلى جانب الرأسمالية– في تطوير مزيد من الحقوق للرجال فقط، وقد نظرت الحركات النسوية إلى هذه الأوضاع باعتبارها منافية للعدل، وأكدت على القيمة الاقتصادية لمساهمات النساء، وطالبت بحصول النساء على الحقوق السياسية. ثم امتدت الحركات النسوية لتخترق الحدود الجغرافية، وتنتشر في كل العالم، وتتفاعل وتتضامن فيما بينها، وتؤثر على بعضها البعض، وترى أن العولمة الاقتصادية، والجهود الدولية لخلق حكومات ديمقراطية سوف تولد أشكالاً جديدة من النسوية. أما فيما يتعلق بالمصطلح نفسه، أي بكلمة “النسوية” (Feminism)، فهو مصطلح حديث نسبيًا، ظهر في ثمانينيات القرن التاسع عشر في فرنسا، ثم انتشر في أوروبا خلال تسعينيات القرن نفسه، وصولاً إلى الأمريكتين قي عام 1910. وقد أثار هذا المصطلح جدلاً واسعًا، ليس فقط بين صفوف الرجال، بل أيضًا بين صفوف بعض النسويات اللاتي ترددن في استعماله أو إطلاق هذه الصفة على أنفسهن، خاصة حينما ينطوى المصطلح على المطالبة بحقوق كونية للنساء باعتبارهن مواطنات، ولا يقتصر على المطالبة بحقوق محددة باعتبارهن أمهات. ظل المصطلح يحمل معنى مبتسراً حتى بداية ستينيات القرن العشرين، حتى في صفوف أكثر الإصلاحيين تقدمًا، غير أن مطالب الحركات النسائية في الغرب قد تطورت تطورًا كبيرًا مع حلول الستينيات، فأصبحت لا تقتصر على المطالبة بالمساواة مع الرجال، بل امتدت إلى المطالبة بالاعتراف بالاختلاف المتعلق بحياتهن الإنجابية والجنسية، وقد تزامن في الفترة نفسها تقريبًا ظهور مصطلح «النوع» بديلاً عن «الجنس»، ليشير إلى القناعة المتنامية بأن الممارسات الاجتماعية هي التي تساهم في صياغة مفهومنا للذكر والأنثى، إلى جانب العوامل البيولوجية. غير أن مصطلح «نسوية» أصبح مقرونًا بنطاق واسع من الناشطات المختلفات فيما بينهن، واللاتي يمثلن– بالتالي– تنويعة كبيرة من المطالب والسياسات، فهناك النسويات السود، والنسويات الأمريكيات من أصول آسيوية، ونسويات العالم الثالث، والنسويات الإسلاميات، والنسويات المسيحيات، إلخ، وقد أدت هذه المساهمات المتعددة إلى تطور حركة نسوية أكثر تنوعًا ونضجًا، وتسعى المؤلفة إلى تقديم تعريف عن النسوية المعاصرة، فتقول: « النسوية عبارة عن عقيدة تؤمن بضرورة المساواة بين الرجال والنساء، وحيث تقوم معظم المجتمعات بالتمييز لصالح الرجال كفئة، هناك أهمية لوجود حركات اجتماعية من أجل تحقيق المساواة بين الرجال والنساء، مع الأخذ بعين الاعتبار أن قضايا النوع في تداخل دائم مع أشكال أخرى من التراتبية الاجتماعية، وهي تتساءل: لماذا هذا التخوف من النسوية ؟ فكثيرًا ما ينظر إلى النسويات باعتبارهن مصدرًا للخوف والقلق، أو أن وجودهن غير ذي فائدة أصلاً، ترى المؤلفة أن هذا الخوف يعود إلى التنميط القاسي الذي طويلاً ما أحاط بالناشطات في هذا المجال، سواء أطلقن على أنفسهن صـفة النسوية أو لم يفعلن، كما ساهم الإعلام في تعميق هذا الإدراك، فعلى سبيل المثال، قام الإعلام الأمريكي بتقديم النسوية على أنها من الأمور التي عفا عليها الزمن، والواقع أن النسوية تمثل تهديدًا لعديد من النساء والرجال، لأنها تقدم نقدًا قويًا لفكرة التراتبية الاجتماعية الأبدية، والتبعية المزعومة للنساء تجاه الرجال. وبالتالي، تقوم النسوية بتعريض هذا البناء التاريخي للخطر، وتولد تخوفات متعلقة بإمكانية حدوث تغييرات في النمط المألوف للأسرة، ولعلاقات بين الجنسين. وقد ساد هذا الخوف عديدًا من المجتمعات والمجموعات الإنسانية، فعلى سبيل المثال، اعتبرت النساء الملونات– لفترة طويلة– أن النسوية متنافسة مع الحركات المنادية بالعدالة العنصرية. وفي البلدان النامية والمستعمرات السابقة كثيراً ما يتم إقران النسوية بالاستعمار الغربي. وحتى في البلدان التي تتضمن حركات نسائية قوية، تفرض النسوية على كل من الرجال والنساء التفكير والتأمل في التباينات الاجتماعية، وفي علاقاتهم بأنظمة السلطة القائمة. وهي تؤدى بذلك إلى توليد الخوف لدى البعض من فقدان الامتيازات التي طالما أعتبروها أبديـة وأكيدة، بينما ترغم البعض الآخر على التفكير المؤلم في الامتيازات التي لا ينعمون بها. وترى المؤلفة أن معرفة أدق بمعنى النسوية من شأنها التخفيف من تلك المخاوف، كما تشير إلى أربعة أسئلة أساسية، ظلت تسعى إلى الإجابة عليها على امتداد الكتاب، وهي:
-
هل تؤدى الخبرات النسائية إلى تغيير إدراكنا للحياة الاجتماعية والسياسية، وكيف تختلف النساء فيما بينهن ؟
-
لماذا برزت النسوية تاريخيًا، وكيف تغيرت عبر الزمان والمكان ؟
-
ماذا تريد النسويات، أي هل تؤدى التفسيرات النسوية لعدم المساواة إلى توليد أساليب جديدة للتفكير والعمل ؟
-
أين تذهب النسوية، وما أفضل الاستراتيجيات للنهوض بالمساواة بين النوعين؟ على الرغم من طول عرض هذه المقدمة، فقد رأيت أهميتها لتكون خلفية وافية لقراءتنا هذا الكتاب، مع التركيز على الجوانب المتعلقة بما يسمى بالفضاء العام والفضاء الخاص.
يحمل الجزء الأول عنوان «ما قبل النسوية»، وهو يبدأ بتناول النظام الأبوي مع إشارة سريعة إلى النظام الأموي الذي لا يعني–حسب الكاتبة– حكم النساء على الرجال، بل يصف مرحلة كانت فيها العلاقات أكثر ندية بين الجنسين. ثم يقدم هذا الفصل بعض الأمثلة المقارنة للأبوية في أفريقيا، والصين، وأوروبا. وفي موضع آخر من هذا الجزء بعنوان «المدن، والتجارة، والأسواق» يتناول الكتاب جزئية مهمة بالنسبة لنا حول اتساع وانكماش الفضاءات المختلفة، وهو ما تعوزه المؤلفة إلى الانتقال من الاعتماد على الزراعة إلى ممارسة التجارة، وتشير إلى أن هذا الانتقال قد أدى– في بعض الأحيان– إلى إضفاء قيمة اجتماعية أكبر للنساء، بينما أدى– في أحيان أخرى– إلى تعميق دونيتهن، فأصبحت النساء–في بعض المناطق– قادرات على الحصول على دخل نتيجة لعملهن، مما شجع بعضهن على تأجيل الزواج، بل على استبعاده أصلاً، كما حدث في بعض الحالات في الصين أو في أوروبا. غير أن ذلك كان معناه الدخول في نوع من حياة الرهبنة، وعلى الرغم من أن الراهبات الأوروبيات قد اعتنين لقرون طويلة بالفقراء، والمرضى من المجتمعات المحيطة بهن، كان هناك اتجاه متنامٍ داخل الكنيسة لإبقاء الراهبات في الأديرة، بدلاً من الخروج إلى العالم الواسع.
وترى الباحثة أن الرأسمالية قد سرعت من نمو الأسواق، وظهور التخصصات في العمل، كما عمقت الاعتقاد بوجود فضاءات منفصلة بالنسبة للذكور والأناث. فقد ساهمت بدايات الرأسمالية في تقليص فرص النساء للعمل خارج منازلهـن، فلم تفتح أمامهن سوى مجالات محددة للعمل، مثـل انتاج وغسيل الملابس، ومع حلول القرن السادس عشر، لم يبق أمام النساء سوى مهنة واحدة، هي مهنة الداية أو القابلة. ومع انتشار العمل مدفوع الأجر، بدأت تتلاشى قيمة العمل التقليدي الذي تقوم به المرأة داخل المنزل. كما تعمقت الأيديولوجيات المنادية بالفضاءات المنفصلة في القرن التاسع عشر، وقد ساهمت في ذلك نظرية داروين حول الارتقاء الطبيعي التي تعتبر الطبيعة الذكورية أقوى بكثير من الطبيعة الأنثوية، فانتقى أمثلة لبعض الحيوانات مثل الطاووس، متناسيًا أمثلة أخرى كالعقرب التي تقتل شريكها بعد الجماع، أو بعض الطيور الإناث اللاتي يتركن للذكور مسئولية الجلوس على البيض وإطعام الصغار.
وتشير المؤلفة إلى أن الاستعمار الأوروبي قد صدر معه إلى المستعمرات كثيرًا من الأفكار التمييزية، ومن أمثلة ذلك تهميش عمل النساء لصالح الرجال في أفريقيا، حيث أصبحت أدوار النساء محصورة في الأعمال المنزلية.
حول « بروز النسوية تاريخيًا » يشير الجزء الثاني إلى أن المطالب النسائية بدأت تتصاعد في منتصف القرن التاسع عشر، وهي ما عرف باسم ” النسوية الليبرالية “، وتسوق لنا المؤلفة مثال المجلة النسوية الفرنسية “صوت النساء” (La Voix des Femmes) التي كتبت في عددها الأول الصادر في مارس 1948 «لن يسمح للرجال بعد الآن أن يقولوا “نحن البشرية“، فالحرية لكل الرجال معناها لكل النساء».
حينما حلت المصانع محل الصناعات الحرفية المنزلية، اتسعت الفجوة بين عمل الرجال مدفوع الأجر، وعمل النساء غير مدفوع الأجر، فازدادت تبعية النساء للرجال، كما أدت النظريات السياسية للرأسمالية حول الحقوق الفردية، والعقد الاجتماعي، إلى توليد خطوط إقصائية أكثر حدة، أصبحت هذه المفاهيم تميز بين العامل الأبيض الذي من شأنه أن يصبح مواطنًا حرًا وغيره من التابعين غير العقلاء، أو الفئات البشرية الأدنى، مثل النساء والخدم والأجناس غير البيضاء، وبإيجاز يمكن القول أن الرأسمالية والثورات الديمقراطية قد ساهمت في وضع النساء في مرتبة أدنى من الرجال، غير أنها فتحت الباب أمام إمكانية النقد، مما سمح للنساء بالاعتراض على عدم المساواة المبنية على أساس النوع.
بعد عام 1800، حل مفهوم الحقوق الفردية للمواطنين محل السلطات المفروضة للنخب، فمع انتشار الرأسمالية خلال القرن التاسع عشر، بدأت تتطور الحقوق السياسية (مثل حق التصويت) لتمتد من الطبقات العليا إلى الطبقات المتوسطة، وصولاً إلى الرجال الذين يحصلون على دخل ولكنهم لا يمتلكون أي ملكية. ولكن ماذا عنى ذلك بالنسبة للنساء ؟ لقد تميزت الأسر المتوسطة بالصورة المثالية للمرأة باعتبارها أم مكانها المنزل، مستبعدة من مجال العمل المنتج، ومعتمدة اعتمادًا كليًا على دخل زوجها. وعلى الرغم من أن عمل النساء غير مدفوع الأجر داخل الأسرة قد قدم مساهمات اقتصادية جوهرية، ظلت نظرية الفضاءات المنفصلة تخصص الحقوق الاقتصادية والسياسية للرجال وحدهم. وتشير الكاتبة إلى أن المطالب المتعلقة بتعليم النساء تعود إلى سبعينيات القرن السابع عشر، وأن نساء من الأرستقراطية قد بدأن خلال القرن الثامن عشر في عقد صالونات أدبية وفكرية. ومع نهايات القرن، وقيام الثورة الأمريكية ضد الحكم البريطاني (1776)، والثورة الفرنسية ضد حكم الأرستقراطية (1789)، بات واضحًا أن النظام القديم على حافة الانهيار، حيث بدأ الناس العاديون– رجالاً ونساء– في المطالبة بحقهم في التمثيل السياسي. وقد انتشرت مطالب الحرية، والأخـوة، والمساواة على امتداد أوروبا خلال هذه الفترة، فتجمعت النساء الفرنسيات في مسيرة نحو قصر فرسای، مطالبات بالخبز، وقامت مؤلفة المسرح الفرنسية «أو لامب دي جوج» بإصدار «إعلان حقوق المرأة والمواطنة» في عام 1791، حيث نادت النساء باكتشاف حقوقهن. هذا، ولم تمنح الثورة الفرنسية حقوق المواطنة إلى النساء، بل إن قانون نابليون بونابرت لعام ١٨٠٤ قد منح الرجال سلطات رسمية على زوجاتهم، وانعكست عودة التركيز على الأدوار الأسرية للنساء في إقران المطالبة بتعليم الإناث بالواجبات المتعلقة بالأمومة. ثم تصاعدت المطالب النسائية بالمساواة في إنجلترا خلال القرن التاسع عشر، كما بدأت تبرز المطالب النسوية في مناطق أخرى من العالم، مثل الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا وبعض بلدان أمريكا اللاتينية واليابان.
أما بالنسبة للأيديولوجيات الأشتراكية، يبدو الأشتراكيون المثاليون– من أمثال سان سيمون، وفورييه– أكثر راديكالية من الماركسيين فيما يتعلق بحقوق النساء، فكانوا ينادون– على الأقل من الناحية النظرية– بأن يشترك كل من النساء والرجال في إعداد الطعام، ورعاية الأطفال، وكانوا يرون أن من شأن هذا العمل المنزلى الجماعي التقريب بين طبيعة الأعباء التي تقع على الرجال والنساء، والتقليل من الفجوة الموجودة بين الفضائين والناتجة عن انجراف الرجال خارج المنزل للقيام بأعمال مدفوعة الأجر، بل إن تحرر النساء من جزء من الأعباء المنزلية سوف يمكنهم من العمـل إلى جانب الرجال في مجالات إنتاجية.
أما ماركس وإنجلز، فقد أقرا بالاستغلال المزدوج الذي تعاني منه النساء العاملات (داخل المنزل وفي مكان العمل)، غير أن الماركسية لم تضع في حسابها القيمة الاقتصادية لعمل النساء في المنزل، حيث لا يؤدى هذا العمل إلى توليد فائض القيمة. وقد أخفقت الماركسية– على غرار النسوية الليبرالية– في حل معضلة ازدواجية عمل المرأة. إلا أن الماركسية قد ألهمت النساء بتنظيم أنفسهن في حركات اشتراكية على امتداد العالم. وقد ساهمت الاشتراكيات في إثراء تاريخ النسوية باستراتيجيات سياسية متعددة، فهناك فلورا تريستان التي ركزت على التعليم، وكلارا زتكن التي نادت بتنظيم النساء العاملات وبحق النساء في الاقتراع، وألكسندرا كولونتاى التي أصرت على أهمية الإنجاب، والحياة الجنسية، ورعاية الأطفال في تعبئتها للنساء العاملات. كما أثرت الاشتراكيات في الحركات النقابية الموجودة في البلدان الديمقراطية. وفي عام 1911 بدأ الاشتراكيون اعتبار ۸ مارس يومًا لتكريم النساء اللاتي دخلن في إضرابات لتحسين شروط العمل خلال القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين.
تحت العنوان الفرعي «فضاء النساء: الأمومة، الفرق بين النوعين، والنسوية الراديكالية» ترى الكاتبة أنه ليس غريبًا أن تكون أوائل النسويات قد قمن بتقدير فكرة الأمومة، بدلا من لفظها. فكثيراً ما لجأت نساء الطبقات الوسطى، والاشتراكيات إلى حجة الأدوار المتعلقة بالأمومة للمطالبة بحق الإناث في التعليم، ومع الدخول في حقبة الصناعة والحيـاة الحضرية– وما تبعهما من تفاقم للفقر وانتشار الجريمة– أصبح المنزل رمزًا للجنة البعيدة عن الفساد. وقد استعملت النساء كثيراً أمومتهـن للتقدم باسم حماية الأطفال والأسرة. غير أن هذه الاستراتيجية تنطوي على أخطار، ففي حين يمكن تعبئة النساء– باعتبارهن أمهات– للحصول على بعض الحقوق، قد يؤدى ذلك إلى حصرهن كأمهات في موضع التبعية الاقتصادية والسياسية، أي إما إلى تعميق الرؤية المبنية على الفضاءات المنفصلة، أو الانقلاب ضدها وانتقاد بعض مظاهر عدم المساواة.
خلال القرن العشرين، قامت المنظرات النسويات بالاستناد إلى فكرة الأمومة «الموروثة» أو «العزيزية» لمد السلطات المعنوية للنساء خارج نطاق الأسرة إلى الفضاء العام، فقمن ببلورة سياسات تنتقد التوجه الأسرى لحصر النساء والحد من صلاحياتهن، بينما تحتفى– في الوقت ذاته– بالقيم السامية المرتبطة بالنساء نتيجة لأدوارهن الأسرية، وتلك المتعلقة بالأمومة. وقد كتبت كل من شارلوت بركنـز جيلمان في الولايات المتحدة، وفرجينيا وولف في إنجلترا عن الفروق النوعية التي تضفى على المرأة بعدًا متميزًا. وهكذا دخلنا– مع نهايات القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين– في تطور نظرية الفروق والتمايز بين الجنسين. فقد سعى تحليل جيلمان لقضايا النوع إلى تجاوز محدودية نظرية الفضاءات المنفصلة، وحل التناقض الظاهري للاختلاف. فهي ترى أنه– بالإضافة إلى الفضاءات المتباينة والمحددة لكل من الرجال والنساء– مازال هناك «فضاء مشترك في انتماء كليهما إلى البشرية». كما أثارت فرجينيا وولف القيم المتميزة للنساء، والتي تشكلت عبر الفضاء الخاص للمنزل، باعتبارها مصدرًا للسلام في العالم. وكانت تؤكد على أنه كلما دخلت النساء في الفضاء العام، عليهن عدم نسيان الدروس التي تعلمنها داخل المنزل، أي تلك الدروس المتعلقة بمقاومة الأبوية. وعلى الرغم من أنها كانت تنتقد حصر النساء في المنازل، كانت تقدر التعليم العالي باعتباره أحد السبل التي تحقق الاكتفاء الذاتي وحصول النساء على الحقوق السياسية، رفضت وولف فكرة اندراج النساء المتعلمات في الوظائف التي يحتلهـا أبناؤهن من الرجال المتعلمين حيث تؤدى هذه الوظائف إلى استدامة مجتمع يشجع الظلم الاجتماعي، ويعمل على انتشار الحرب. كما كانت تنادي النساء المتعلمات بعدم التخلي عن الفضائل المكتسبة في الفضاء الخاص خلال قرون ماضية، والتي تتمثل في التقشف– أي الحصول على دخل لا يزيد عن الحاجة للعيش بطريقة مستقلة و «العفة»- المتمثلة في رفض بيع العقل مقابل الحصول على مال– والتحرر «من أي وفاء زائف لأمة، أو دين أو مدرسة أو أسرة».
وعلى الرغم من الاختلافات الظاهرة بين المدارس النسوية، تؤكد المؤلفة على تداخل هذه المدارس وتفاعلها معًا. غير أنها تشير إلى الحاجة لتطوير التحالفات بين النساء من أعراق وأمم مختلفة، فعلى النسويات الغربيات إعادة النظر في رؤيتهن المجزأة للعدالة في ضوء أشكال عدم المساواة الموجودة تاريخيًا على الصعيد العنصري والثقافي. كما تضيف أن مواجهة هذه التحديات سوف تؤدى– على الأمد الطويل– إلى إعادة بللورة النسوية وجعلها أكثر مرونة، وأكثر تضمينا، وذات قابلية أكبر للديمومة.
يستمر هذا الجزء باستعراض القضايا العنصرية وتشكيل هوية النسوية الأمريكية، ثم ينتقل إلى المرحلة الكونية والتحديات التي تواجه النسوية، حيث يبدأ الفصل الخامس من هذا الجزء بالاقتباس التالي:
«إن الحديث عن النسوية لامرأة لا تمتلك قدرة الحصول على المياه أو الطعام أو المنزل يعد دربا من دروب الهراء» (من منتدى المنظمات غير الحكومية، الدانمارك ١٩٨٠).
كما تشير إلى كلمات الشاعرة الأمريكية، أدريين ريتش، التي ترى أن «فئة النساء اللاتي لا تحملن وجهًا أو لا ينتمين إلى عنصر أو طبقة، عبارة عن بدعة ابتدعتها النساء الغربيات، البيض، المتمحورات على أنفسهن».
لا تعد الحركات النسائية الدولية امتدادًا للمدارس النسوية الغربية، بل لها مصادر متنوعة. ففي بعض الأقطار– مثـل الهند ومصر– قامت الحركات الوطنية المعادية للاستعمار بتعبئة النساء، كما ساهمت المنظمات الدولية في توفير مجال لالتقاء الحركات النسائية المختلفة، والاتصال والتحاور فيما بينهـا. لقد تزامن بروز الحركات النسوية الغربية خلال القرن التاسع عشر مع انتشار الامبراطوريات الأوروبية في أفريقيا، والشرق الأوسط، وآسيا. وقد ادعت السلطات الاستعمارية أنها قادرة على تطوير ممارسات مستنيرة تجاه النساء في المستوطنات من خلال التعليم والقانون، غير أن ذلك التحرر المزعوم لم يحدث في الواقع، بل إن اندراج نساء هذه الأقطار في الحركة من أجل التحرر الوطني هو الذي نمى لديهن التطلع إلى التحرر من الأوضاع المفروضة عليهن كنساء. ويتضمن هذا الجزء أمثلة واقعية من نضال هدى شعراوي وزميلاتها في مصر، ونضال النساء في الهند، وفي جنوب أفريقيا وتركيا والجزائر.
أما فيما يتعلق بالنسوية الدولية، يشير الكتاب إلى أن الحركة النسوية ظلت اسمية جمد ل حتى الحرب العالمية الأولى، كما ترى المؤلفة أن المحاولات الأولى لخلق حركة نسائية دولية كثيرًا ما اتسمت بإعادة إنتاج أنماط العلاقات الاستعمارية. فبدأت تتعالى أصوات من الدول النامية، ومن حركة النساء السود، اعتراضًا على الفرضية المتعالية للغرب في هذا المجال. هذا، في الوقت الذي أدركت فيه بعض النسويات الغربيات أن من شأنهن اكتساب معرفة كبيرة من نساء ينتمين إلى أجزاء من العالم. وفي نهاية عقد الأمم المتحدة للمرأة (١٩٧٥–١٩٨٥)، قامت نساء البلدان النامية بإعادة صياغة النسوية، رافضات أسطورة عالمية الأخوية النسائية، لصالح إطار يتسم بمزيد من التضمين والمرونة. وهو ما عبرت عنه المشاركات في مؤتمر نیروبی (١٩٨٥) حيث قلـن أن النسوية «تمثل التعبير السياسي لاهتمامات ومصالح نساء ينتمون إلى أقاليم، وطبقات وجنسيات وخلفيات عرقية مختلفة…. هناك– ولابد أن يكون هناك– مدارس نسوية متنوعة، تستجيب للاحتياجات المختلفة للنساء المختلفات اللاتي يقمن بتحديدها بأنفسهن، ومن أجل أنفسهن».
يتناول الجزء الثالث من الكتاب «سياسات العمل والأسرة»، فكثير من الانتقادات النسوية المتعلقة بالعمل والأسرة تنصب على عدم ظهور عمل المرأة. وفي حين هناك اتجاهات تربط بين النسوية ودخول النساء في صفوف القوى العاملة، إلا أن النساء قد عملن طوال التاريخ، وحتى قبل ظهور نظام العمل المأجور. وتتساءل الكاتبة كيف العمل المنزلي الذي تقوم به النساء غير مرئى، وهي ترى أنه كلما جديت الرأسمالية والصناعة العمال خارج المنزل، وبدأ قياس قيمة العمل بالأجر، اتسعت عمل الرجـال وقيمة عمل النساء، هذا في الوقت الذي مثـل عمل النساء المنزلى إضافة أساسية لنمو الاقتصاديات الرأسمالية. وهي تشير إلى أن العمل في الريف يتطلب جهودًا كبيرة على مستوى كل أقطار العالم. ففي آسيا وأفريقيا تقوم النساء الريفيات بضخ وحمل المياه لمدة تصل إلى خمس ساعات أسبوعيًا، بينما ترتفع هذه المدة في بلد مثل الموزمبيق خلال فترات الجفاف لتصل إلى 15 ساعة أسبوعياً. وعلى الرغم من العمل الشاق الذي تقوم به هؤلاء الريفيات، لا تمتلك أغلبيتهن حقوق الملكية نفسها التي يمتلكها الرجال على الأرض. لقد سبقت الإشارة إلى أثر التطور الصناعي في خلق فجوة بين قيمة العمل مدفوع الأجر والعمل غير مدفوع الأجر. وعلى الرغم من الإضافة الفعلية التي يحققها عمل النساء المنزلي، ظلت ربات البيوت في وضع اقتصادی متدنٍ. هذا بينما ترى الكاتبة الأمريكية– ذات الأصول النيجيرية– بوش إيميثيتا أن «ربة الأسرة هي– في الوقت ذاته– سيدة اقتصاد، وممرضة، وفنانة، ودبلوماسية، وما يفوق ذلك. وعلى الرغم من هذا، مازلنا نجلس في المقاعد الخلفية، بل ونضع أنفسنا في هذه الأماكن، فكم من مرة سمعنا إحدى الزميلات تقول «أنا مجرد ربة منزل».
لقد تم تاريخيًا إرساء العمل المنزلي باعتباره نقيضًا للمواطنة الكاملة، كما أن العمل مدفوع الأجر للمرأة خارج المنزل لا يعفيهـا بالضرورة من أداء الواجبات المنزلية. ففي جنوبی آسیا– على سبيل المثال– تمضى النساء العاملات بأجر ما يتراوح بين ٢٠ إلى 30 ساعة أسبوعيًا في العمل المنزلي الإضافي. وهذا الأمر لا يقتصر على البلدان النامية، بل هو صحيح أيضًا في البلدان المتقدمة، مثل اليابان، وكوريا الجنوبية، والولايات المتحدة الأمريكية.
أما حينما نتطرق إلى العمل المنزلى مدفوع الأجر الذي يقوم به الخدم والمأجورون، فهو بدوره لم يحظ بالاعتراف أو بالحق في الحماية في مجتمعات كثيرة. وغالبًا ما تكون النساء هن اللاتي يعملن في تلك الوظائف. ففي البرازيل، على سبيل المثال، كانت تتشكل ربع القوة العاملة النسائية في عام 1985 من خدم المنازل، وتنتشر هذه الأوضاع انتشارًا واسعًا في ظل الاقتصاديات التي لا توفر بدائل أخرى للعمل.
وحتى حينما تدخل النساء في مجالات عمـل يسيطر عليها الرجـال تقليديًا، تؤدى الأيديولوجيـة المبنية على تقسيم الأدوار الاجتماعية إلى خلق فوارق مهمة متعلقة بمعنى العمل وقيمته. ويشير تاريخ المهن في الغرب إلى أنه حينما تدخلب أعداد مهمة من النساء مهنة ما، تصبح هذه المهنة «مؤنثة»، وتندرج ضمن هذه المهن التدريس، والتمريض، وإدارة المكتبات، الخ. وفي الواقع تفقد المهنة رونقها وبالتالي تتدنى فيها الأجور. هذا، بينما بقيت مهن كثيرة مغلقة لفترات طويلة على الرجال، ومنها مجالات الطب والحقوق. إن الأيديولوجية المبنية على التمييز بين الجنسين تعمل أيضًا على التمييز بين الوظائف، كما تقسـم القوة العاملة بصفة عامة، مما يؤدى إلى عدم المساواة ليس فقط من حيث الوضع ولكن أيضًا من حيث المقابل المادي.
لقد قامت النساء العاملات حول العالم باستعمال كل الوسائل من أجل إجبار أصحاب العمل والحكومات على الاستجابة لاحتياجاتهن، وقد جاء ذلك نتيجة لعقود من النضال الذي خاضته النسويات. فكلما ازدادت دخول النساء في صفوف قوة العمل مدفوعة الأجر، ارتفعت مطالب النسويات بتبني مجموعة من السياسات من شأنها حل الإشكالية المتعلقة بالتوفيق بين العمل مدفوع الأجر والأمومة. فمن ناحية، من شأن تلك السياسات تأمين فرص أجر وترقٍ متساوية، تمكن النساء من التطلع إلى الحصول على دخل يكفل لهـن الاكتفاء الذاتي. كما تقر تلك السياسات– من ناحية أخرى– التطلعات الإنجابية للنساء، وتسعى إلى حماية عطائهن الرعائي داخل الأسرة. وقد سعت النسويات– على مدى الزمن– إلى تحقيق نوع من التوازن بين هذه الاستراتيجيات المزدوجة من خلال رفض السياسات التي تعمق الفصل بين الخاص والعام. كما تجتهد المطالب النسوية في إعادة صياغة مكان العمل، بحيث يتلاءم مع واقع الوالدية. ويعنى ذلك عمليًا، إدراج الرجال في مهام متعلقة بالرعاية الأسرية، مع توفير إمكانيات العمل المأجور للنساء.
كما تشير الدراسة إلى أهمية توافر أنظمة الأمان والأمن الاجتماعي لتلبية الاحتياجات الأسرية للنساء، وخاصة النساء المعيلات لأسر. غير أن عمليات الإصلاح التي اجتاحت العالم مع نهايات القرن العشرين قد أصابت الأوضاع الاقتصادية للنساء. ففى منتصف التسعينيات، أصبحت السويديات يحصلن على ٧٢ ٪ بالنسبة للأجور التي يتقضاها الذكور، مقارنة بنسبة 80 ٪ في العقد السابق. كما أصابت سياسات التكييف الهيكلي التي فرضها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي النساء في الأقطار النامية.
ويعلمنا تاريخ النضالات الاجتماعية النسوية أن الحل للمشاكل التي تواجهها النساء العاملات لن يأتي إلا مع الاعتراف بالعلاقة الوطيدة الموجودة بين العمل المنزلي غير مدفوع الأجر والعمل في السوق مدفوع الأجر.
جاء الجزء الرابع بعنوان «السياسات المتعلقة بالصحة والحياة الجنسية»، فقد سعت الحركات النسوية منذ البداية إلى مد الحقوق الجسدية التي يتمتع بها الرجال لتشمل النساء. ويشير هذا الجزء إلى حق النساء في التحكم في أجسادهن، وفي اختياراتهن الإنجابية. فعدم المساواة الاجتماعيـة مازالت تفرض تكاليف باهظة فيما يتعلق بتنشئة الأطفال، في مجتمعات لا تتسـم بالتعاطف سواء مع النساء أو مع الأطفال. وهناك أعداد متنامية من النساء حول العالم يقمـن برعاية أطفالهن بمفردهن. فقد تضاعفت أعداد النساء غير المتزوجات اللاتي ينجبن أطفالاً في الغرب، بينما غدت ظواهر مثل الطلاق، والهجر، والترمل، تترك آلاف الأمهات دون دعم اقتصادي على مستوى العالم أجمع. ثم يتناول هذا الجزء من الكتاب موضوع النوع والعنف، فتشير المؤلفة إلى أن قليل من الرجال والنساء قد طرحوا على أنفسهم تساؤلات– في الماضي– حول مشروعية استعمال القوة الجسدية في أزمنة السلم والحرب. ففي المجتمعات التراتبية، من حق الأسياد ضرب العبيد، والأزواج معاقبة زوجاتهم، والأهل ضرب أطفالهم، كما يحدث أحيانًا قبول الجريمة لو كانت ناتجة عن رغبة الأسرة أو القبيلة الانتقام لما يصيب شرفها، وهي ممارسة واسعة الشيوع على مستوى العالم. لقد أضفت الحروب المشروعية على قتل المحاربين الأعداء، وعلى اغتصاب النساء المدنيـات، ويشكل الأطفال، والنساء، والأقليات، أهداف مشروعة لممارسة القوة. لقد لعب التشكيل الاجتماعي للنوع دورًا مهمًا في رسم معالم تاريخ العنف. وكثيرًا ما يلجأ الرجال إلى استعمال القوة كجزء من حقوقهم، باعتبارهم أزواج على سبيل المثال. وفي حين تختلف المدارس النسوية حول تعريف العنف وأساليب مواجهته، هناك ثلاثة عناصر مشتركة تجتمع عليها، هي:
1– أهمية النظر إلى كل أشكال العنف ضد النساء باعتبارها ممارسات غير مشروعة.
٢– أهمية توفير خدمات علاجية لتمكين ضحايا العنف، وتغيير سلوك الرجال.
3– أهمية قيام الدولة بسن القوانين التي تجرم العنف الذكوري وتحمى النساء والأطفال منه.
ثم ينتقل هذا الجزء إلى التشكيل التاريخي للاغتصاب، حيث تشير الكاتبة إلى أن معنى الاغتصاب يتغير بتغير الإطار الاجتماعي الذي يحدث فيه. ففي المجتمعات الأبوية، ينظر إلى الاغتصاب باعتباره جريمة ضد الملكية الأسرية وليس ضد المرأة، بينما تميل المجتمعات الليبرالية للنظر إلى الاغتصاب باعتباره جريمة ناتجة عن رغبة جنسية لفرد ما. وفي المقابل، قام التحليل النسوى بإعادة صياغة مفهوم الاغتصاب باعتباره جريمة يرتكبها الرجال لممارسة السلطة والسيطرة على النساء. وفي حين تنادي النسويات بالإصلاحات التشريعية للحد من وقوع أحداث الاغتصاب، إلا أنهن يرون أن هذه الإصلاحات ليست كافية. فحيث ينتمي الاغتصاب إلى منظومة علاقات القوة غير المتكافئة بين الرجال والنساء، وفيما بين الطبقات والأعراق، هناك حاجة أيضًا إلى التصدي لمظاهر عدم المساواة تلك. ويتطلب ذلك كسر دائرة الملكية الذكورية للنساء، ومقاومة التشيىء الجنسى للنساء، والنضال ضـد العقبات الهيكلية التي تقف عائقًا أمام المساواة بين الأجناس والأعراق.
وتعتبر النسويات كل أشكال الأفعال الجنسية أو الجسدية غير المرغوب فيها مصدرًا لعدم المساواة بين الجنسين، وفي حين يحدث التحرش الجنسي في الأماكن العامة (مثل العمل، أو المدرسة، الخ)، ويخضع بالتالي– في إطار مجتمعات عديدة– إلى قوانين تجرمه، ظل العنف الأسرى الممارس ضد النساء محميًا لزمن طويل تحت زعم الخصوصية المتعلقة بالأسرة، والحق الضمني الذي يسمح للرجال بالتحكم في الزوجات والأطفال. تقول إحدى النساء «لقد تعلمت منذ سن مبكرة أن من حق الرجل ضرب زوجته، وإن امتنع عن ذلك فعليها الشعور بالامتنان». ترى النسويات المعاصرات أن العنف الأسرى مشكلة تعانى منهـا النساء عبر الطبقات، والأعراق، والحدود الوطنية. وسعت نضالاتهن إلى كشف المشكلة على امتداد العالم، وكسر جدار الصمت المفروض حولها، وتوفير الخدمات للضحايا، وتمكين النساء من المطالبة بحقوقهن، والإصرار على حماية الشرطة من التعرض لهذه الانتهاكات.
في الجزء الخامس بعنوان «رؤى واستراتيجيات نسوية» تتناول الكاتبة مجالات الإبداع النسائي، وأهمية إعادة صياغة اللغة بحيث تكف أن تكون منحازة للرجال، ودخول الفنانات المجال العام مع جذب مجالهن الخاص إليه.
وأخيرًا، تختتم المؤلفة كتابها بفصل يحمل عنوان «لا عودة إلى الوراء»، تستهله بكلمات امرأة من كوستاريكا كان على النساء كسر الفاصـل الموجود بين المجالين الخاص العام، وجعل همومهن قضية عامة (ماريا سوارس 1993)، وترى الكاتبة أن سد هذه الفجوة يعد أحد أهم إسهامات الحركات النسوية في القرن العشرين، أي أن يعاد صياغة مفهـوم السياسات بحيث تتضمن كلاً من المحورين الخاص والعام، وتعكس هموم واهتمامات كل من الرجال والنساء، كما أن دخول النساء إلى الساحة السياسية من شأنه إحداث تغيرات كبيرة على السياسات الوطنية والكونية، فالنساء يأتين إلى الساحة السيـاسـيـة ومعهـن عديد من المسائل كان يتم التغاضى عنها بسبب الفصل بين العام والخاص، وتتضمـن هذه المسائل قضايا مثـل الصحة الإنجابية، والعنف، ورفاهة الأطفال.
يشير هذا الكتاب بوضوح إلى التوجه النسوى المتواصل نحو اعتبار الخاص والعام امتدادًا وانعكاسًا لبعضهما البعض، ففي الواقع، ماهو العام إلا تراص ومحصلة لجزيئات الخاص ؟ وفي حين قد يرى البعـض عدم التطرق إلى ما يعرف بالمجـال الخاص ذي الحساسية، والاكتفاء بما هو عام لا يثير الجدل، يمكن التساؤل حول كيفية الفصل بين العام والخاص حينما ترتفع أصوات تنادي بعودة المرأة إلى المنزل، على سبيل المثال، أو تتعامل القوانين بطريقة غير متساوية بين الرجال والنساء في أمور تتعلق بحياتهم الخاصة ؟
نولـة درويش: عضوة مؤسسة بمؤسسة المرأة الجديدة.