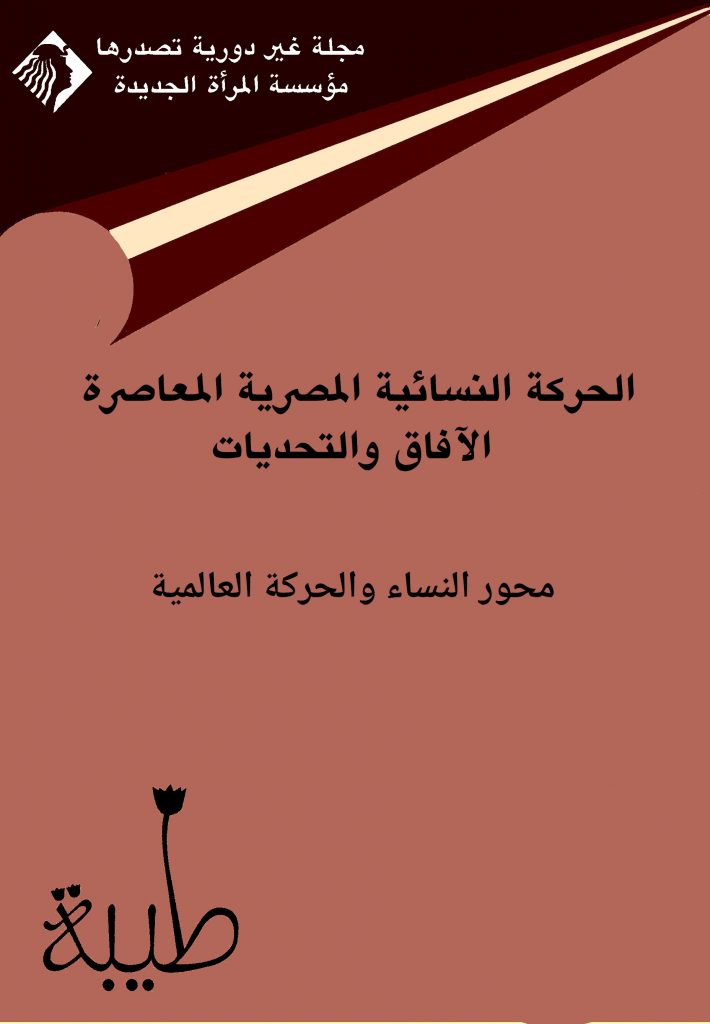الحركة النسائية والحركة العمالية
بدت صفحة مجتمعنا خلال العام الأخير، وقد علاها الاضطراب والتقلب.. تحركت موجاتها بين تقدم وانحسار.. غادرها سكونها الرتيب الذي لازمها طويلاً مفسحًا الطريق أمام إمكانيات التغيير الذي بات مطلبًا وشعارًا للجميع. أصبح التغيير هدفًا يجمع الفرقاء،ولكن الكثيرين رغم ذلك لم يتمكنوا من الإجابة عن السؤال الضروري! التغيير كيف؟ وإلى أين؟
كشف الحراك الذي اعترى الساحة نواقصنا جميعًا.. سنوات الضحالة هزمت كل ما هو نبيل وأصيل في مجتمعنا الذي تهمشت قطاعات واسعة منه فاقدة انتماءها إليه.. وباعدت المسافات والتناقضات بين طبقاته وفئاته، حتى كدنا نرى أسوارًا تفصل بينهم. ضاع المشروع القومي الواحد الذي يمكن له أن يتقاطع مع مصالح الطبقات والأطراف المختلفة.. وعجزت هذه الطبقات والفئات والأطراف أيضًا عن صياغة مشاريعها وبدائلها.. حتى بدا المستقبل وكأنما أغلق أبوابه.
ولأن الحياة لم تعد ممكنة كما كانت.. لأن الوضع لم يعد ممكنًا أن يستمر على ما هو عليه.. أصبح التغيير ضرورة.. غير أن الضرورة ربما تكون عمياء!!
إذا شئنا أن يكون التغيير مشروعًا للمستقبل، أو بالأحرى إذا حاولنا المراهنة على مشروع للمستقبل، ربما كان السبيل هو تطوير الحركات الاجتماعية القادرة على تنظيم الطبقات والفئات الاجتماعية المختلفة، وصياغة مطالبها، وبدائلها. وعندما تتقاطع هذه البدائل – وهي بالضرورة ستتقاطع بقدر أصالتها وتعبيرها من المصالح الحقيقية المتقاطعة فعليًا لهذه الفئات – يمكن التوافق على مشروع مجتمعی نهضوي تنموى وإنساني. عندما يمكن للطبقات والفئات والشرائح والقطاعات الاجتماعية المختلفة أن تمارس نفوذها في المجتمع من خلال حركات حية فاعلة، يمكن لهذا المجتمع أن يبرح موضع اللاتوازن الذي آل إليه.
إن محاولة البحث في مجال التقاطع بين كل من الحركة العمالية والحركة النسائية لابد لها أن تترابط مع محاولات البحث في الحالة الراهنة لكلتا الحركتين. إلى أي درجة تقتربان من مفهوم الحركات الاجتماعية؟ ما هي الإشكاليات التي تعترضهما وتعوق تطورهما؟.. هل هي حركات القطاعات العريضة؟ أو هل تمضى حقًا في هذا الاتجاه؟
وإذا كانت هذه الورقة غير مخصصة لتناول أوضاع الحركة العمالية، فإنها بالضرورة سوف تلمس إشكالياتها على نحو أو آخر، كما أنها قد تنصرف إلى التقاط بعض خصائص الحركة النسائية الراهنة.
غير أنه قد يكون من الملائم التوقف في البداية أمام الأوضاع الراهنة للمشاركة النسائية في الحركة العمالية.
تتركز العمالة النسائية في قطاعات صناعة النسيج، والإلكترونيات، والدواء، ثم الصناعات الغذائية. كما تشغل نسبة لا يستهان بها من وظائف القطاع الخدمي (على الأخص التعليمي والصحي حيث تكاد تحتكر وظائف التمريض) وصناعة السياحة، والأجهزة الإدارية التابعة للحكومة. وخلال ربع القرن الماضي تزايدت بصورة ملحوظة معدلات العمالة النسائية في الزراعة، فضلاً عن عمالة القطاع غير الرسمي، والخدمة المنزلية.
ويمكن القول بغير كثير من العناء أن المشاركة النسائية في الحركة العمالية والنقابية قد اتسمت ولا تزال بدرجة من الضعف الشديد، حيث يمكن تتبع ملامحها على النحو التالي:
أ – المرأة في الحركة العمالية
-
خلال حلقات الحركة العمالية الاحتجاجية التي امتدت من السبعينيات إلى منتصف التسعينيات والتي تمركزت في وحدات القطاع العام الصناعية، وعلى الأخص في قطاعات الصناعات المعدنية والهندسية والنسيج، قنعت المرأة العاملة بصفة عامة بدور المساندة دون المشاركة الفاعلة في التحركات العمالية، حيث استقرت تقاليد الحركة آنذاك على هذا النوع من تقسيم العمل– حتى أن العرف العمالي قد جرى على تأمين مغادرة النساء للمصانع، ومواقع العمل في بداية الاعتصام – الذي مثل الشكل السائد للحركة الاحتجاجية.
-
في كثير من الأحوال كانت النساء العاملات يقمن على توفير الغذاء للمعتصمين في الداخل إذا استمر اعتصامهم ليلاً، حيث يتولين بأنفسهن مهمات توصيل الغذاء، بمشاركة زوجات العمال وأسرهم.
-
في مواقع العمل الكبرى التي أحاطتها المدن السكنية الخاصة بها (غزل المحلة، الغزل والنسيج بكفر الدوار، الحديد والصلب) عادة ما كانت هذه المدن تتحول إلى محيط للدعم والمساندة التي تلعب فيها المرأة دورًا بارزًا.
-
كان من شأن هذا التقسيم المستقر عليه للعمل إلى امتناع الأدوار القيادية في الحركة على المرأة العاملة، وحجب القيادة الطبيعية التي تخرج من صفوفها عن الالتحاق بالصفوف الأولى للقيادات. وإذا كانت الحركة العمالية التي امتدت عبر هذه الحلقات قد تمكنت من تطوير قيادتها فيما عُرف بـ“القيادات العمالية” التي لعبت دورًا بارزًا في صياغة مطالبها، وتوجهاتها، فقد غابت المرأة عن هذه القيادة.
2 – الأسباب التي أدت إلى ضعف المشاركة في الحركة العمالية
ربما يكون من الصعب تحديد الأسباب التي تكمن وراء الظواهر الاجتماعية على وجه الدقة، حيث كثيرًا ما تتداخل الأسباب والنتائج في نسيج واحد للظاهرة على النحو الذي يجعل من غير السهل تفكيكها. غير أن محاولة التعرف على أسباب ضعف مشاركة المرأة العاملة في الحركة العمالية قد تسفر عن الآتى:
-
تمركز الحركة العمالية خلال الحقبة الممتدة من السبعينيات إلى التسعينيات في مواقع الصناعة الكبرى التي لم تمثل العمالة النسائية نسبة يعتد بها من عمالتها فيما عدا قطاع النسيج
-
الموروث الثقافي المجتمعي الذي يحيا لدينا في مكان ما، ربما يستقر في الخلفية، أو يقفز إلى المقدمة. هذا الموروث الذي يجعل على المرأة في أي عمل وفي وسط أي جماعة أن تتمتع بما لا يمكن إغفاله من الإمكانيات، وأن تبذل ما لا يمكن تجاهله أو الاستغناء عنه من الجهد لكي تجد مكانها وتحظى بـ“اعتراف جماعة الذكور“!!
-
موروث الحركة العمالية ذاتها، هذه الحركة التي تمتد جذورها إلى أوائل القرن العشرين، والتي تنامت وتطورت وصاغت خبراتها المتميزة والنوعية خلال النصف الأول منه حيث لم تزل تنهل من معين هذه الخبرات، وتحمل موروثها. غير أن هذا الموروث رغم ما يتسم به من طابع تقدمي إيجابي غير معاد للمرأة أو عملها من الناحية الأساسية، إلا أنه لا يتضمن أيضًا خبرة المشاركة الفاعلة والمؤثرة للمرأة في الحركة العمالية ولعب دور في قيادتها.
-
غياب المطالب النوعية ذات الأهمية للمرأة خلال هذه الحقبة التي احتل فيها القطاع العام الوزن الأكبر في الهيكل الاقتصادي والإنتاجي، حيث كفلت القوانين التي عالجت علاقات العمل في هذا القطاع المساواة بين الجنسين في الأجور والمزايا، وسائر حقوق العمل الأخرى. وبينما انصرفت مطالب الحركة العمالية الاحتجاجية في هذا الوقت إلى زيادة الأجور المتغيرة (الحوافز، البدلات، منحة المدارس، الوجبة) كانت هذه المطالب تخص النساء والرجال العمال معًا ولم تنفرد المرأة بغير بعض المطالب الجزئية وعلى وجه التحديد ساعة الرضاعة، وتوفير حضانات للأطفال في مواقع العمل وهي المطالب التي تبنتها الحركة، وسرعان ما تحققت.
-
مثلما يعيد تقسيم العمل على أساس النوع إنتاج نفسه، فإن ضعف المشاركة يعيد إنتاج نفسه أيضًا حيث أنه يؤدى إلى ندرة القيادات النسائية، وعدم تبلور مطالب وأشكال حركة نوعية، ومن حيث يكرس ثقافة وخبرة الإحجام عند المرأة، وثقافة وخبرة الإقصاء عند الرجل.
3 – المرأة العاملة والتنظيم النقابي
-
لعله غنى عن الذكر أن ضعف مشاركة المرأة في الحركة العمالية قد انعكس أيضًا على درجة تمثيلها في التنظيم النقابي“الرسمي” بسبب ندرة القيادات العمالية النسائية التي تسعى للاضطلاع بأدوار قيادية، وتتطلع إلى تمثيل العمال في المواقع النقابية.
-
لم يكن من السهل على القيادات النسائية أن تحقق الفوز في الانتخابات النقابية، والذي يتطلب ويفترض الحصول على ثقة زملائها من الرجال وأصواتهم، حيث تعترضها كافة المعوقات المعروفة والتي تواجه المرأة في كافة أنواع الانتخابات، وفي مقدمتها انخفاض درجة استعداد الرجل لانتخاب امرأة في مجتمعنا، والموروث الثقافي الذي لا يستسيغ قيادة المرأة للرجال.
-
التنظيم النقابي الرسمي – المحظور تكوين نقابات غيره أو خارجه بقوة القانون – يفتقد إلى الديمقراطية والاستقلالية مما يحول دون تغيير رجالاته في المستويات العليا أو إحلال آخرين محلهم مما يجعل بلوغ القيادات العمالية من الرجال أو النساء مثل هذه المستويات أمرًا في حكم المستحيل. كذلك لا تجرى انتخابات حقيقية للمستويات القاعدية (اللجان النقابية) سوى في المواقع الصناعية البارزة،بينما يتم تشكيل أعداد واسعة من اللجان النقابية – على الأخص في الوحدات الإدارية التابعة للأجهزة الحكومية – بما يشبه التزكية. ذلك كله يحول دون إمكانية وصول المرأة العاملة إلى مقاعد التنظيم النقابي اللهم في المواقع التي تكاد تستغرقها عمالة المرأة أو تمثل فيها المرأة أغلبية ساحقة.
-
هكذا أصبح تمثيل المرأة في التنظيم النقابي“الرسمي” تمثيلاً رمزيًا في المستويات العليا، حيث أصبحت“عائشة عبد الهادي” عضو مجلس إدارة الاتحاد العام، ونائب رئيسه ظاهرة فريدة. كما أنها ليس لها وجود يذكر في اللجان النقابية للمواقع الصناعية، بينما يمكن مصادفة أعداد أوسع من النقابيات في اللجان النقابية للوحدات الإدارية، أو بعض الوحدات التجارية. وعلى أية حال يندر أن تفوز النساء بأكثر من مقعد واحد في اللجنة النقابية التي تتكون في الأعم الأغلب من الأحوال من أحد عشر عضواً.
4- معدلات المشاركة النسائية في الحركة العمالية.
تعيش الحركة العمالية ذاتها منعطفًا حادًا دلفت إليه جراء المستجدات التي أحاطت سوق العمل خلال العقد الأخير، حيث أخذت الأوزان النسبية للقطاعات المختلفة في التبدل. وبينما اتجه القطاع العام إلى التقلص المتزايد، أخذ القطاع الخاص في الاتساع النسبي، واشتغلت نسبة لا يستهان بها من قوة العمل في أعمال غير منتظمة ضمن السوق المتنامي للعمل غير الرسمي الذي يعج بفوضى ضاربة، وبلغت نسبة البطالة معدلات غير مسبوقة تدور حول 20%. وتحت وطأة هذه المتغيرات اتجه مركز ثقل الحركة إلى الانتقال من القطاع العام إلى القطاع الخاص ليس فقط بسبب تقلص الأول، وإنما أيضًا بسبب تردي أوضاع وشروط العمل في الثاني.
وعلى الرغم مما يعانيه عمال قطاع الأعمال العام (القطاع العام سابقًا) من الانتقاص المستمر لحقوقهم ومكتسباتهم السابقة على الأخص في مجالات الأجور المتغيرة، والمزايا، والخدمات الصحية، إلا أن معدلات التحركات العمالية الاحتجاجية قد اتجهت إلى التناقص في هذا القطاع، ربما بسبب الشعور العام بعدم الاستقرار في وحداته التي تتجه معظمها إلى البيع أو التصفية، حيث يصبح المعاش المبكر أفضل الاحتمالات الواردة، وربما بسبب توقف التعيينات في هذه الوحدات منذ أكثر من خمسة عشر عامًا على النحو الذي أدى إلى تجمد الدماء في شرايينها، وحرمانها من الطاقات الشبابية. فضلاً عن ذلك هناك الابتزاز الدائم لهؤلاء العمال بتدهور أحوال الشركات، وانخفاض إنتاجية الأجر على الرغم من أن الأسباب الأساسية لهذا التدهور إنما تكمن في التخبط، والفساد الإداري، والتوقف الكامل عن تطوير الطاقات الإنتاجية مع النزح والنهب المستمر الذي يكاد يصل في بعض الأحيان إلى حد التخريب.
وعلى الصعيد الآخر يعاني عمال القطاع الخاص من افتقاد الحماية القانونية والنقابية، ويعملون في ظل شروط عمل بالغة السوء يتوالى تدنيها مع ارتفاع معدلات البطالة؛ حيث الأجور المتدنية وساعات العمل التي تصل في المتوسط إلى اثنتي عشرة ساعة يوميًا، وانعدام الإجازات، وتعسف أصحاب الأعمال، فضلاً عن سيف الفصل من العمل المسلط بسبب عقود العمل المؤقتة أو الاستقالات التي يوقع عليها العمال مسبقًا مع استلامهم العمل ليحتفظ بها صاحب العمل، ويكون بمقدوره تأريخها واستخدامها في أي وقت.
لقد دفعت هذه الأوضاع عمال القطاع الخاص إلى تنظيم الحركات الاحتجاجية على الرغم من حداثة سن غالبيتهم وانقطاع صلتهم بالخبرات السابقة للحركة العمالية، غير أن الدفاع عن لقمة العيش هو المدرسة الأولى التي يتعلم فيها العمال.
هكذا أخذت الحركة العمالية في الانتقال من القطاع العام إلى الخاص. غير أن ذلك يحدث دون أن تمتلك هذه الحركة الآليات التي تمكنها من نقل الخبرة، وتنظيم الصفوف.. بسبب افتقادها لتنظيمها النقابي الذي يعيش هو الآخر أزمة بنيوية كبرى، ذلك أن ما يعانيه لم يعد افتقاد الاستقلالية وغياب الديمقراطية والبيروقراطية، وإنما أيضًا انحسار عضويته التي اعتاد ضمها بصورة تلقائية“شبه إجبارية” في وحدات القطاع العام التي يصبح العامل فيها عضوًا نقابيًا بمجرد التحاقه بالعمل، ويقتطع الاشتراك النقابي من أجره“أتوماتيكيًا” بمعرفة الإدارة. وبينما أخذت هذه العضوية في التقلص بسبب تقلص وحدات القطاع العام نفسها، يعجز هذا التنظيم“شبه الرسمي” عن الامتداد إلى القطاع الخاص، أو التصدي لرجال الأعمال الذين ينكرون على عمالهم تمامًا الحق في تكوين النقابات.
ربما كان هذا الاستعراض السريع لأوضاع سوق العمل والحركة العمالية ضروريًا للتوقف عند أوضاع المشاركة النسائية الآن، فالمرأة العاملة هي جزء من قوة العمل التي يؤدي تدهور الأوضاع في سوقها إلى تردي أوضاعها. إن المتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية تؤدى إلى المزيد من تقسيم العمل على أساس النوع، وتهدر المساواة في فرص العمل، وتهبط بالمرأة العاملة إلى مرتبة أدنى في سوق العمل تدفعها إلى القبول بشروط عمل أسوأ.
وإذا كان من المفيد تقديم بعض النماذج في هذا الصدد فإن مصانع جلال زوربا للملابس الجاهزة قد تكون واحدة. تقع هذه المصانع في مدينة البدرشين، وحلوان، ومدينة 15 مايو، وتمثل العمالة النسائية الغالبية العظمي من قوة العمل بها. في هذه المصانع تضطر الفتيات والنساء إلى العمل اثنتي عشرة ساعة يوميًا مقابل أجر يعادل مائتي جنيه شهريًا على الأكثر، ويصل معدل تدوير العمالة إلى 200 % سنويًا.
لقد كان للعاملات في أحد هذه المصانع (حلوان) سبق القيام بأول إضراب عمالي نسائی (بالكامل) – فيما أعتقد – في مايو 2002، حيث تحركن تحت وطأة التعسف الشديد معهن من قبل صاحب العمل مطالبات بتحسين شروط العمل. ربما تكون هؤلاء العاملات قد استطعن تلمس بعض الخبرات التي انتقلت إليهن من آبائهن أو معارفهن من عمال حلوان مما كان له أثره في مساعدتهن وتمكينهن من التحرك الاحتجاجي، غير أن قراءة بعض المؤشرات الأخرى ربما تؤدى إلى استنتاج اتجاه المشاركة النسائية في الحركة النسائية إلى تزايد معدلاتها.
إن عددًا من التحركات العمالية خلال السنوات القليلة الماضية قد شهدت المزيد من المشاركة النسائية،وقد تبدت هذه المشاركة على الأخص في التحركات التي صاحبت خصخصة أو بيع بعض الشركات حيث تكمن بواعث الحركة هنا في المخاوف الشديدة على فرصة العمل، وسنوات العمل التي تبدو وكأنها تذهب هباءً. لقد برزت المشاركة النسائية في هذه الأحوال بوضوح مثلما حدث في شركة القاهرة للصباغة والتجهيز، وأحد أقسام شركة مصر حلوان للغزل والنسيج (حرير حلوان)، وأيضًا في شركة تليمصر التي تميزت بوجود قيادات نسائية تلعب دورًا بارزًا في الحركة.
ربما يكون من المفيد التحديق بجرأة في عيني هذا السؤال الصادم:هل نحن حقًا أمام حركات اجتماعية؟ وتبدو الإجابة بالإيجاب هنا عسيرة، على الأخص إذا شرعنا في المقارنة مع الحركات الاجتماعية التي نشهدها في أمريكا اللاتينية أو بعض البلدان الآسيوية والتي تتسع لقطاعات جماهيرية واسعة، وتنجح في تنظيمها بصورة مرنة تتيح لها التعبير عن مطالبها المباشرة، وممارسة نفوذها عبر أشكال مختلفة ومتنوعة من الحركة.
غير أن معيارًا محددًا لا يمكن اعتماده دون غيره في القياس هنا. كما أنه لا يمكن تصور أن بناء الحركات الاجتماعية دفعة واحدة في الفراغ، بل إنه بغير شك عملية متنامية تجرى في تفاعل مستمر مع التحديات النوعية للواقع الذي تنمو فيه.
1 – التحديات التي تواجه تطور الحركات الاجتماعية في بلادنا
ربما يكون من قبيل التزيد في هذا المقام استعراض المسار الطويل التي تمت فيه مصادرة أشكال التنظيم والحركة المستقلة للطبقات والفئات والشرائح الاجتماعية المختلفة عبر بضعة من العقود، غير أنه ينبغي التوقف أمام الأوضاع الراهنة التي خلفها هذا المسار:
-
لم تزل القيود القانونية تحاصر الحق في التنظيم المستقل، وتحول دون تطور المجتمع المدني بمنظماته المختلفة بدءًا من النقابات العمالية والمهنية، وانتهاءً بالجمعيات والمؤسسات ومنظمات حقوق الإنسان والمرأة وغيرها، حيث تشكل مجموعة القوانين المنظمة لهذه المنظمات منظومة متكاملة لتكريس هيمنة الدولة على المجتمع المدني، وبسط سيطرتها وأذرعها الأخطبوطية على مناحيه المختلفة،وحيث تجرى“قولبة” أشكال التنظيم داخل أطر خائفة النظم وتمسك بزمامها“جهة إدارية ما” لها كافة الصلاحيات، ولديها ما يكفي من البيروقراطية لتعويق وإحباط كل وأية محاولة للفكاك من الأسر.
-
هذه القيود الثقيلة التي كبلت ولم تزل أشكال الحركة والتنظيم المستقل لم تترك متنفسًا للتعبير عن المصالح المختلفة والمتناقضة بطبيعة الحال للفئات والطبقات والقطاعات المختلفة، وتنظيم عمليات الصراع والتفاوض فيما بينها، بينما كانت المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية تدفع إلى المزيد من تناقض المصالح وتضادها.
انقطاع خبرة القطاعات والفئات الشعبية المختلفة لزمن ليس بالقصير بأشكال التعبير عن مصالحها وحمايتها كان من شأنه أن تفقد الثقة في قدرتها على ممارسة نفوذها وتأثيرها، بينما أدت المصادرة الطويلة للحق في التنظيم، والإصرار على إبقاء الناس أفرادًا يواجه كل منهم بمفرده أجهزة الدولة – ينتظر عطاياها أو يتحمل بطشها – إلى البحث عن الحلول الفردية للخروج من المأزق الحياتي الدائم فغاب الشعور بالجماعة، وضاع الانتماء إليها أيًا ما كانت.
-
أدت محاولات التكيف مع واقع المصادرة الذي استطال إلى التمسك بالروابط العصبية أو القبلية، حيث سعت الدولة ذاتها إلى تغذية هذه الروابط لبعض الوقت سعيًا إلى الاستفادة منها في إحكام السيطرة من خلال رجالاتها، غير أنها بطبيعة الحال قد أخذت في الإفلات والابتعاد.
-
تردى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لفئات واسعة، وتهميشها إلى حد حرمانها من أبسط الخدمات، وفي الوقت ذاته حرمانها من حقها في تنظيم صفوفها الذي يمكنها من الضغط، والمفاوضة بشأن مصالحها وحقوقها، يدفع بها إلى الحنق والغضب الشديدين على الدولة بل والمجتمع كله، ومن ثم الوطن، ويجعل منها فريسة سهلة لكل صور التعصب وعلى الأخص التعصب الديني.
-
العجز عن تطوير الحركات المستقلة وبلورة مطالبها، والضغط من أجل تحقيقها، والغياب الطويل لخبرات إيجابية في هذا الشأن دفع بالناس – أفراداً وجماعات – إلى اللجوء لأشكال وطرق أخرى للحصول على المكاسب بدءًا بالفهلوة، والتحايل على القانون ووضع اليد – وجميعها طرق يغذيها ترهل أجهزة الدولة وتفشي الفساد – وانتهاءً باستثمار المواسم الانتخابية للحصول على الرشاوى الفردية والجماعية.. لننتهى إلى ما رأيناه في الانتخابات البرلمانية الأخيرة!!..
-
ربما يكون من المفيد هنا الإشارة إلى أن الحكومات وأجهزة الدولة كانت هي البادئة بتقديم الرشاوى الجماعية في الانتخابات وغير الانتخابات وذلك بتقديم بعض المزايا أو الحقوق لفئات أو طبقات اجتماعية لتمرير سياسة أو إجراء ما، أو مقايضة بعض الحقوق بحقوق أخرى. ولعله غنى عن الذكر البون الشاسع بين تقديم الرشاوى، والحصول على بعض الحقوق من خلال مفاوضة اجتماعية؛ حيث المفاوضة تمارسها أطراف منظمة متبلورة المطالب، لديها القدرة على ممارسة الضغط، ثم إحراز بعض المكاسب.
2 – الحركة العمالية.. أين تقف الآن؟
ربما تكون الحركة العمالية هي الأكثر قربًا في مجتمعنا لما يمكن اعتباره حركة اجتماعية، فعلى الرغم من القيود التي كبلتها استطاعت هذه الحركة أن تحتفظ بدينامياتها المستقلة على نحو ما. وقد تنامت هذه الحركة منذ منتصف السبعينيات إلى منتصف التسعينيات فيما يمكن اعتباره موجتين متلاحقتين لكل منهما بعض من خصائص متميزة. وفى عقدها الأخير مرت الحركة العمالية – ولم تز– بإشكاليات لا يستهان بها تتعلق بالتغيرات البنيوية الكبرى التي اعترت الطبقة العاملة المصرية، غير أنها لم تفقد رغم ذلك قدرتها على الاستمرار.
ولكي لا يُساء الفهم على أي نحو، ينبغي توضيح أن الحديث عن الحركة العمالية باعتبارها الأكثر قوة وحيوية إنما يجرى قياسًا على واقع بالغ الضعف، والنضوب. غير أننا على نحو ما يمكن أن نشهد ملامح الحركة الاجتماعية التي استطاعت الاستمرار،وتمكنت من بلورة ما يمكن اعتباره برنامجًا مطلبيًا خلال موجتها الثانية الممتدة من منتصف الثمانينات إلى منتصف التسعينيات، وإن ظلت تحركاتها من الناحية الأساسية تحركات دفاعية، موقعية، ولم تتمكن من كسر الطوق الذي حال بينها وبين امتلاك أدواتها التنظيمية وعلى الأخص نقاباتها المستقلة، كما ظلت قدرتها على التأثير في المجتمع كله محدودة بمحدودية مطالبها. ورغم نجاحها في انتزاع بعض المكاسب الجزئية، إلا أنها لم تجرؤ – وما كان لها أن تستطيع في ظل المستوى الذي توقفت عنده – على إجراء مفاوضة اجتماعية واسعة تتعلق بنصيبها أو نصيب الطبقات الشعبية الأخرى من الناتج القومي الذي كان الاعتداء عليه يتم على قدم وساق.
وأيًا ما يكن من أمر، تواجه الحركة العمالية الآن مأزقًا مفصليًا جراء التغيرات التي صادفت بنية الطبقة العاملة، وانحسار عمالة القطاع العام التي تشكل منها الجسم الرئيسي للحركة إبان عقديها الماضيين، مما كان له أبلغ الأثر في إرباكها، وتآكل أنسجتها القيادية.
إن المتغيرات الاقتصادية لم تؤد فقط إلى تبدل الأوزان النسبية للقطاعين العام والخاص، واتساع أعداد العاملين في القطاعات الخدمية مقارنة بالقطاعات الصناعية، وإنما أيضًا تزايد واتساع العمل غير المنتظم و“غير الرسمى” على حساب العمل المنظم والمنتظم، فضلاً عن تعطيل وتهميش جزء لا يستهان به من قوة العمل. وبات من المؤكد أن الحركة العمالية لن تتمكن من التطور والنمو ما لم تتمكن من مجابهة هذه المعضلات الكبرى، على النحو الذي يفتح أبوابها لهذه القطاعات التي تقف خارجها رغم وزنها الكبير في المجتمع.
3 – الحركة النسائية.. أين تقف الآن؟
رغم امتداد موجتها الحديثة في مجتمعنا قرابة عقدين من الزمان، لم تزل الحركة النسائية من الناحية الأساسية نخبوية البناء. ورغم أنها استطاعت إفساح مساحة واسعة لها بين منظمات المجتمع المدني، إلا أنها بقيت بمعنى ما طافية على صفحة مجتمعنا، يمكن رؤيتها مع أي إطلالة عليه من خارجه، لكن جذورها لم تمتد إلى الأرض بعد.
لقد حرصت هذه الحركة أشد الحرص على استقلاليتها، وعلى بلورة برنامجها النوعي، غير أنها ربما تكون قد أفرطت في هذا الحرص إلى الحد الذي فرض حولها سياجًا حال دون ارتباطها بالقضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية الأخرى.
ولعله من نافل القول أن نضال المرأة من أجل انتزاع حقوقها لا يجرى في فراغ، وإنما في المجتمع الذي تشكل هذا المرأة نصف قوامه، حيث من المؤكد أن مطالبها النوعية ترتبط بالوضع النوعي لهذا المجتمع، بإشكالياته، ومتغيراته، وقضاياه.
وعلى سبيل المثال شكلت حركات المرأة في كثير من مناطق العالم وبلدانه جزءًا لا يستهان به من قوام الحركة المناهضة للسياسات النيوليبرالية، من حيث أثرت هذه السياسات على أوضاع المرأة، على تقسيم العمل على أساس النوع وعلى حرمانها من حقها في الخدمات.. . إلخ.
وبكلمات أكثر تحديدًا، إن البرنامج النوعي للحركة النسائية لا ينبغي اختصاره في مشاكلها مع الرجل، ولكنه ينبغي أن يتسع لكل مطالب النساء اللاتي يعانين قهراً اقتصاديًا واجتماعيًا من صنوف مختلفة.
لكي تكون الحركة النسائية حركة اجتماعية حقًا، ينبغي لها أن تعبر عن مصالح النساء المباشرة ومطالب النساء المباشرة كما هي في الواقع، وسيكون بمقدور هذه الحركة أن تتسع كلما اتسعت لمطالب فئات نسوية أكثر اتساعًا.
إذا أرادت الحركة النسائية أن تضرب بجذورها في الأرض.. فإن عليها أن تستشرف
الطريق إلى الأرض.. كيف؟
كلما اقتربت الحركة من مطالب قطاعات أوسع من النساء كلما كان ممكنًا جذبهن إليها، وضمهن في صفوفها. ومن جانب آخر.. عندما تأتى أعداد أوسع من النساء فإن برنامج الحركة النسائية سوف يتغير ويتسع وتتبدل أولوياته وتفاصيله.
تتقاطع الحركة النسائية والحركة العمالية عند أكثر من نقطة. إنهما يلتقيان على المطالب الديمقراطية التي تتيح لكليهما إمكانيات الحركة المستقلة والنمو، والتمسك بتطوير المجتمع المدني واتساعه وحقه في فرض رقابته على الدولة، والتأثير عليها، والتفاوض معها.
كما يلتقيان عند النساء العاملات وحقهن في المساواة في فرص العمل والأجر، وعلى الأخص هؤلاء العاملات اللاتي يعملن دون حماية قانونية أو نقابية في القطاع، ويضطررن لقضاء اثنتي عشرة ساعة متصلة أمام إحدى ماكينات الملابس.
غير أن نقطة التقاطع الأكثر أهمية – كما أراها – هي هذه البقعة الواسعة التي تشغلها الجائلات وعاملات النظافة والتليفونات بعقود مؤقتة، المهمشات اللاتي يضطررن إلى العمل، أي نوع من العمل من أجل الحصول على لقمة العيش، وهؤلاء المعيلات اللاتي لا يجدن مصدراً للرزق للإنفاق منه على أولادهن، إنها عمالة القطاع غير الرسمي.
هؤلاء النسوة هن الأكثر قهرًا في هذا المجتمع، وكأنهن يحملنه على كواهلهن، وهن في ذات الوقت قد بلغن حدًا من رفض هذا المجتمع، والحنق عليه.. لماذا؟.. لأن هذا المجتمع قد همشهن خارجه، دون أي التزام حيالهن!!
لكي يمكن ضم هؤلاء إلى حركاتنا، ينبغي أن نساعدهن على بلورة مطالبهن، وأن نتبنى هذه المطالب.. ثم ندعوهن للمشاركة في حركة ضغط من أجل تحقيق مطالبهن.
إن مطالب الضمان الاجتماعي – حسبما أعتقد – هي المطالب الأكثر جوهرية للقطاعات العريضة من النساء. إننا مجتمع بلا شبكة ضمان اجتماعی.. مجتمع يقذف بأبنائه دون أدنى شعور بالمسئولية.. وليس ثمة وسيلة تعيد هؤلاء اللاتي ابتعدن كثيرًا عنه سوى استعادته لمسئوليته عنهن.
عند هذه النقطة.. ينبغي أن تلتقى الحركة العمالية والحركة النسائية لكي يمكن لكليهما أن تضرب بجذورها في الأرض.
رحمة رفعت: ناشطة في مجال حقوق الإنسان، ومحامية، ومنسقة البرامج بدار الخدمات النقابية والعمالية.