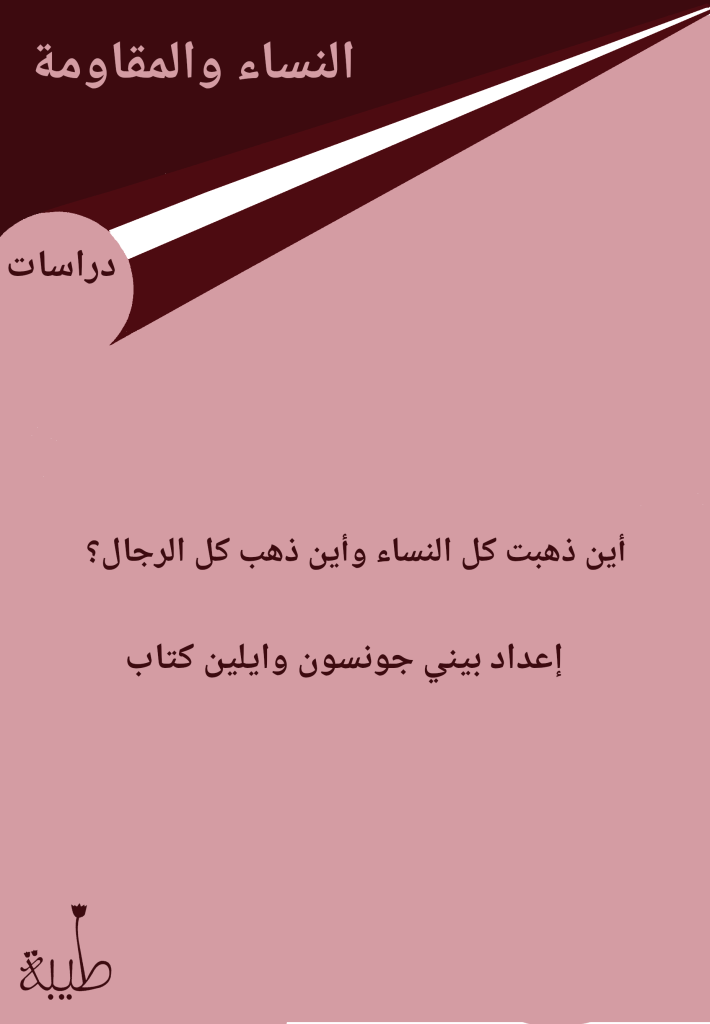أين ذهبت كل النساء (وأين ذهب كل الرجال )؟ *
تأملات حول قضايا النوع والانتفاضة الفلسطينية الثانية (1)
بعد مرور ما يقرب من شهرين على اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية في ٢٨ سبتمبر عام ۲۰۰۰، أصدر رئيس الحكومة الإسرائيلية قرارا غير مألوف حتى وفقا للمنطق العسكري المبني على استعمال أقصى أنواع القمع في مواجهة الانتفاضة، ذلك أن الرد الإسرائيلي على التمرد تضمن استعمال المروحيات والدبابات في وجه السكان غير المسلحين كما أطلق أحد أكثر الجيوش قوة في العالم لضرب المناضلين الفلسطينيين وضباط الشرطة والأمن الذين لا يمتلكون سوى الأسلحة الخفيفة. أما الأمر العسكري المذكور فقد منع “الرجال الفلسطينيين من السفر في المركبات الخاصة على طرق الضفة الغربية” (هاريل وهاس، ٣.٢٠٠٠). كما كان على الجنود إعادة السيارات الخاصة بالذكور إلى قراهم أو بلدتهم الأصلية ولم يسمح باستئناف السفر إلا في حالة وجود مسافرة على متن المركبة.
وسواء كان هذا القرار موضع التنفيذ أم لا، فإنه يشكل مثالا لمنطق الفصل العنصري الذي ارتبط بفترة أوسلو، وهو ما يشكل طريقة إسرائيل في تطبيق الاتفاقيات المرحلية، بل قد يكون أيضا جزءا من الاتفاقيات ذاتها. إذ يفتقد مضمون الاتفاقيات المرحلية أي خطاب خاص بالحقوق وهذا ما يتضح من مجموعة الإجراءات غير المبنية على المساواة بل التي تستند على منطق الاختلاف والتمييز والتوزيع غير المتكافئ للموارد. لقد تضمنت الإجراءات المشار إليها تقسيم الأراضي الفلسطينية إلى مناطق غير متلامسة واستمر الاحتلال والرقابة الإسرائيلية على الحدود وعلى أغلبية الأراضي الفلسطينية، وهذا في ظل تنامي المستوطنات ومع السلطات المحدودة وغير السيادية للسلطة الفلسطينية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن عودة القيادات الفلسطينية من المنفى – أي كوادر منظمة التحرير الفلسطينية – كانت مرهونة بتأسيس قوة أمنية قوية” (وفقا للاتفاقيات المرحلية لعام 1994 وعام 1995) من شأنها حماية الأمن الإسرائيلي ومراقبة المعارضة الفلسطينية المناهضة لعملية السلام. وهذا ما عبر عنه نائب رئيس الأركان الإسرائيلي آنذاك بقوله “سوف يكون لهم (يعني بهذا الشرطة الفلسطينية) أيضا تشكيل أمني يهدف التحكم في الشارع الفلسطيني” (ليبكين – شاهاك 1995 في واجنر 2000-113). ومن المفارقات أن تنامي القوة الأمنية الفلسطينية ووجود 40.000 رجل تحت السلاح قد ساهما في عسكرة الانتفاضة الحالية.
وبينما ظنت القيادة الفلسطينية أن تلك الإجراءات التمييزية مجرد إجراءات مؤقتة سيتم تعديلها بناء على تبني مواقف مبدئية أثناء المرحلة الأخيرة من المفاوضات، فإن آثار هذه الإجراءات – بما في ذلك وصول عدد المستوطنين إلى ما يقرب من الضعف خلال سنوات ما بعد أوسلو (١٩٩٣ إلى الآن) – ظلت محفورة على الأجساد وفي الحياة السياسية ويمكن رؤيتها بوضوح في مظاهر اندلاع الانتفاضة الثانية. إن السبب المباشر لتفجير الانتفاضة يعود إلى الزيارة الاستفزازية المقصودة التي قام بها السياسي الإسرائيلي اليميني آرييل شارون إلى المسجد الأقصى في الجزء القديم من مدينة القدس، وإلى قتل خمسة من المتظاهرين والمصلين في اليوم التالي على يد الشرطة الإسرائيلية، إلا أن الفشل السياسي لمفاوضات كامب ديفيد في يوليو ٢٠٠٠ كان السبب الخفي وراء تلك الأحداث. فقد وجدت القيادة الفلسطينية نفسها في كامب ديفيد أمام مشروع أمريكي حول الاتفاق النهائي تخطى كل الخطوط الحمراء الفلسطينية، بما في ذلك تجاهل مطالب السيادة على القدس الشرقية، وحل عادل للاجئين الفلسطينيين، وتفتيت المستوطنات، ودولة مستقلة ذات أراضي متجاورة في إطار حدود عام 1967 (هانية ٢٠٠٠، حمامي وتاماري ۲۰۰۱).
ومما لا يقل أهمية – وإن كان أقل وضوحا – النظر في كيفية تأثير ممارسات عدم المساواة بين إسرائيل والفلسطينيين على تشكيل العلاقة فيما بين الفلسطينيين أنفسهم وخاصة فيما بين الدولة الوليدة والمواطنين. وقد يكون ذلك أكثر وضوحا في هيمنة الجانب الأمني وأساسا الأمن الإسرائيلي – أحيانا على حساب مراعاة حقوق الإنسان وسيادة القانون. كما أثرت هذه الفروق الكبيرة بشدة في الحد من تشكل المواطنة الفلسطينية وحقوق المواطنين السياسية والاجتماعية والاقتصادية خلال المرحلة الانتقالية، وهنا تبدو القضايا الخاصة بالنوع مثالا جيدا. فقد نص الميثاق الذي أصدرته الحركة النسائية الفلسطينية عام 1994 في بداية المرحلة الانتقالية. على سبيل المثال، على عدد من الحقوق المرأة، مثل حرية التحرك والحق المطلق في الجنسية، وهي نفس الحقوق التي يحرم منها كل السكان.
إن الممارسات الإسرائيلية من فرض الحصار واحتجاز السكان الفلسطينيين خلال الانتفاضة الحالية تعد تصعيدا لسياسة الإغلاق الإسرائيلية التي حكمت المرحلة الانتقالية. ومعنى ذلك أنه يمكن الاستمرار في تقييد حركة الفلسطينيين حسب الرغبة بينما يتمتع المستوطنين بحرية حركة كاملة، مع كل ما يترتب على ذلك من أذى سياسي واجتماعي واقتصادي للسكان الفلسطينيين. إن إغلاق الحدود بين مناطق الضفة الغربية وشمال وجنوب غزة أثناء الانتفاضة الثانية، وكذلك المنع من الدخول إلى القدس وإلى إسرائيل، قد تسببا في توقف ما يقرب من 110,000 عامل فلسطيني عن العمل ممن كانوا يعملون فيما سبق في إسرائيل. كما أدى هذا إلى انخفاض الأنشطة الإنتاجية المحلية بنسبة 50%، وإلى ارتفاع معدلات الفقر بنسبة 50%، وإلى تفاقم الأزمة الإنسانية بنسب متصاعدة (مكتب الأمم المتحدة للمنسق الخاص، نوفمبر ۲۰۰۰).
ما من شك في أن منطق الفصل العنصري له تجلياته في قضايا النوع، ففي القرار الذي أشرنا إليه في بداية هذه الورقة يبدو واضحا أن التمييز بين الجنسين مبدأ منظم للقمع الإسرائيلي، ويبقى السؤال ما إذا كان أيضا مبدأ منظما للمقاومة الفلسطينية، إن الأعداد اللانهائية للموتى في صفوف الذكور من شباب وأطفال تعد تأكيدا على كلا الافتراضين. هذا، وقد شكل القرار العسكري مادة للسخرية، كما عبرت الفلسطينيات مازحات “أخيرا. هناك دور للنساء!”. وسوف نناقش بمزيد من التفصيل فيما بعد كون النساء الناشطات قد مارسن العديد من الأنشطة المفيدة أثناء الانتفاضة وتحملن أعباء متزايدة في رعاية المنزل والمجتمع والتواؤم مع الظروف المحيطة، إلا أن هذه الأنشطة ظلت غير مرئية بالنسبة للعامة، كما تنظر القيادات النسائية إلى هذه الأدوار على أنها غير ملائمة وهامشية.
إن عدم بروز هذه الأدوار يعود إلى الغياب المتصاعد للمجتمع المدني في الانتفاضة الحالية. ولا نعني بهذا أن منظمات المجتمع المدني خاملة تماما، بل أن أنشطة تلك المنظمات لم تؤثر بطريقة مباشرة حتى الآن على سياسات الانتفاضة. فقد ظلت أنشطة هامشية بدلا من أن تشكل ذلك “المجال العام لحركة المجتمع المدني” (کالهون ١٤٠١٩٩٩) حيث يتم ترجمة الحريات العامة والخطاب النقدي إلى قدرة على التأثير أو مرجعية للسياسات، حسب المفهوم الذي ينادي به جورجن هابرماس، ويمكن القول أن هناك ارتباطا وثيقا بين تهميش النساء وتهميش المجتمع المدني واستبعادهما من المجال السياسي والعام. وتشير وقائع الانتفاضة الحالية إلى أن غياب النساء من المجال العام مصحوب عادة باستبعاد معظم الرجال من نفس هذا المجال.
يمكن الإشارة إلى وجود عدد من الخصائص الهامة المرتبطة بالثقافة السياسية الفلسطينية في مرحلة ما بعد أوسلو وهي التي أثرت على المشاركة والمقاومة (يمكن الرجوع إلى بشارة، 1998، جیاکمان، ۱۹۹۸، جاد، جونسون وجياكمان، ۲۰۰۰). إلا أننا سوف نركز هنا على أحد التناقضات الأساسية وهي تتمثل في التناقض القائم بين دور القيادة الفلسطينية كفاعل للتحرر الوطني – وهو الأساس الذي تستمد منه شرعيتها – والسلطات السيادية المحدودة التي تتمتع بها هذه القيادة مع الإجراءات الأمنية المشددة والادوار البوليسية للسلطة الفلسطينية في المرحلة الانتقالية. فعلى الرغم من وضع السلطة باعتبارها نظاما أمنيا، فإن دراسة حمامي وجونسون تشير إلى أن السلطة تتضمن “وجوه متعددة ومتناقضة“، إذ ما زالت حركة التحرر الوطني التي انبثقت منها – وعلى الرغم من دورها القمعي – تمثل الحلم الوطني الذي تركز عليه التطلعات الشعبية (حمامي وجونسون، ۱۹۹۹، ۱۲۳).
لقد اتجه حل تلك التناقضات إلى الخيار السياسي فيما يمكن تسميته “بالشعبوية التسلطية“، وهو ما ينفي خصوصية الجماهير ويتطلع إلى التعامل مع “السكان“. إن التوجه للناس أو “الشارع” يضفي – أو يحمل ضمنيا – شرعية حيوية بالنسبة للحكومة، إلا أنه يؤدي إلى ضعف أو غياب الدور الجماهيري في تبني التوجهات السياسية وفي تشكيل الرأي العام وأساسا في المشاركة في عملية اتخاذ القرار. إن الاتجاه المعاكس للشعبوية التسلطية – أي اتجاه تعبئة جماهير ديمقراطية نشيطة – موجود في فلسطين خاصة في المنظمات غير الحكومية ولكنه موجود أيضا في حضور وتاريخ الحركات الاجتماعية وما زال، بما في ذلك في الحركة النسائية النشيطة التي تحمل رؤية استراتيجية. ويحتاج تهميش هذه القوى في الانتفاضة الثانية إلى تفسير.
إن الأزمة السياسية العميقة التي تعاني منها الوطنية الفلسطينية في مرحلة ما بعد أوسلو قد ساهمت بطريقة رئيسية في هبوط النشاط السياسي الجماهيري وفي الانتقال من السياسة غير الرسمية إلى السياسة الرسمية وهو ما يشكل الخطوات الانتقالية نحو بناء الدولة. ومن المثير للاهتمام أن الحركة النسائية قد كانت من أنجح الحركات الاجتماعية في مد الجسور خلال المرحلة الانتقالية وذلك لأسباب عديدة، من المفارقات أن منها استبعاد النساء من القيادة الوطنية. إن هذا التهميش قد ولد لدى النساء القدرة على التحرك باستقلالية أكبر مقارنة بالمنظمات الجماهيرية والحركات الاجتماعية الفلسطينية الأخرى. وفي ذات الوقت، فإن خبرة الحركة النسائية في التعبئة الجماهيرية قد حل محلها في الانتفاضة الثانية نموذج المنظمات غير الحكومية في تشكيل جماعات الضغط والدفاع الاجتماعي وعقد ورش العمل حول الأنشطة التربوية والتنموية. إلا أن ذلك لم يحول دون القيام بالمظاهرات المناهضة لإغلاق الضفة الغربية وغزة ومن أجل الإفراج عن السجناء.
وقد كان لهذا التحول أثارا متناقضة فيما يتعلق بقضية المساواة بين الجنسين في المرحلة الانتقالية. ففي الوقت الذي أكسب هذا الانتقال الحركة النسائية بعض الأدوات والموارد من أجل الإصلاح القانوني والقيام بالمبادرات التفاوضية، فقد أضعف من جهة أخرى من قدرة هذه الحركة على تعبئة – وتمثيل – النساء في المواقع والطبقات الاجتماعية المختلفة كما أضعف من قدرتها على إثبات “أصالة” وطنيتها. إن تحول المنظمات غير الحكومية النسائية إلى “الاتجاه المهني” (حمامي، ١٩٩٥) وتاريخ هذه الحركة الوطني والاجتماعي من الآليات المهمة التي يجب أخذها بعين الاعتبار عند التفكير في الإمكانيات المستقبلية لهذه الحركة في مرحلة تأسيس الدولة الفلسطينية.
كما تؤكد الانتفاضة الثانية على واقع آخر أكثر اعتدالا. ذلك أنه مهما توجت محاولات الحركة النسائية بالنجاح في تطوير مبادرات من أجل الحصول على المساواة بين الجنسين في مرحلة أوسلو وسواء تمثلت هذه المبادرات في نموذج البرلمان النسائي، أو في التفاوض لإلغاء التمييز ضد النساء، أو في مبادرات إعلامية، أو مبادرات متعلقة بالعلف ضد النساء، الخ – فإن تلك المبادرات على غرار المبادرات المماثلة التي قامت بها باقي المنظمات غير الحكومية أو حتى تلك الخاصة بالمشروعات الحكومية الموجهة نحو القضايا الاجتماعية والتنموية قد تم تحجيمها واستبعادها من دوائر السلطة السياسية. ومن المؤسف حقا أن النساء قد بدأن في استعمال الخطاب المعاصر الذي ينادي “بالتمكين” في الوقت الذي بدأن فيه فعليا في فقدان سلطاتهن. وقد يفيد هنا إجراء مقارنة بين الانتفاضتين الفلسطينيتين للوصول إلى مزيد من الفهم حول تلك الآليات.
على الرغم من الاثني عشر عاما التي تفصل بين الانتفاضتين، فإن لهما سبب أساسي مشترك وهو استمرار الاحتلال الإسرائيلي العسكري للضفة الغربية وغزة والسياسات القمعية لهذا الاحتلال، إلا أن الواقع الاجتماعي والسياسي الجديد إثر اتفاقيات أوسلو هو الذي فجر انتفاضة الأقصى وصاغ معالمها المختلفة. ذلك أن الواقع السياسي الجديد يتضمن وجود السلطة الفلسطينية بمنهجها في الحكم وثقافتها السياسية، كما يتضمن في ذات الوقت وجود علاقات رسمية ومفاوضات وأشكال من التعاون بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، مما يعنيه ذلك من وجود أنماط جديدة متعلقة بالمشاركة أو الاستبعاد وتغير في أسلوب القمع العسكري الإسرائيلي وبروز ظاهرة العسكرة الفلسطينية. إن العلاقة المتبادلة فيما بين هذين الشكلين قد ولدت جوا عميقا من عدم الاستقرار إلى جانب تشكيل صورة جديدة للنشاط السياسي الفلسطيني قائمة على استبعاد مشاركة معظم المجتمع وخاصة النساء.
لقد اندلعت انتفاضة عام 1987 في إطار كان قد شهد ما يزيد عن عقد من النشاط الديمقراطي قادته منظمات جماهيرية فلسطينية في الضفة الغربية وفي غزة وارتبطت ارتباطا وثيقا بالحركة الوطنية الفلسطينية (يمكن العثور على المزيد من التفاصيل في دراسات تاراكي، ١٩٩١، وكتاب، ۱۹۹۳). وقد قامت تلك المنظمات بتعبئة أقسام واسعة من المجتمع، ضمت الطلاب، والنساء، والعمال، والمهنيين، الذين أصبحوا بدورهم الفاعلين الأساسيين في التعبئة للانتفاضة واستدامتها. وقد عكفت برامج تلك الفئات على دمج الأبعاد السياسية والاجتماعية والثقافية وتوجهت نحو كلا من التطلعات والاحتياجات الفعلية للسكان. وفي حالة اللجان الشعبية النسائية تمثل ذلك في الأنشطة المدرة للدخل وفي مراكز الرعاية اليومية. هذا بينما اندلعت انتفاضة الأقصى في فترة كانت قد خفتت فيها الأنشطة السياسية ذات الطابع الديمقراطي وتم استبدالها بالأنشطة الرسمية التي غالبا ما اتخذت طابع الهياكل السياسية المغلقة مع استبعاد المجتمع المدني.
وعلى غرار المنظمات الجماهيرية الأخرى، كانت الحركة النسائية في انتفاضة 1987 قادرة على تلبية تطلعات الناس نحو الاستقلال من خلال أشكال غير مركزية من التنظيم والتعبئة اتجهت نحو الدمج بين قضايا التحرر الوطني والنهوض الاجتماعي، حيث قامت اللجان الشعبية بتعبئة المجتمع من أجل تلبية احتياجاته الخاصة، مثل تعليم الأطفال بعد إغلاق المدارس بمقتضى الأمر العسكري، وحماية الأحياء، وتشجيع الاقتصاد المنزلي، والمساهمة في توفير التموين الغذائي للمحتاجين. كما عملت هذه اللجان كأدوات لتطوير الوعي الاجتماعي والسياسي في دعم الانتفاضة واستدامتها.
ويمكن النظر إلى هذه الأشكال من المشاركة الديمقراطية على أنها “بصفة عامة نمط سياسي وثقافي يساهم في تحقق أكبر للقدرات الإنسانية المبدعة” (بيستيدزينسكي وسيخون، ١٩٩٩). إن الديمقراطية بهذا المعنى هي عملية تساند تطوير مفاهيم وهياكل توفر للناس فرصا للتعبير عن آرائهم في قضايا تمس حياتهم حيث يجد عامة الناس وسائل منظمة لهذا التعبير. ومن جهة أخرى، تمتلك تلك المنظمات القدرة على القيام بدور الوسيط بين الناس والدولة من خلال توسيع المجال العام وإدراجه كمجال مستقل في إطار الدولة (بيستيدزينسكي وسيخون، 1999).
إن تلاشي تلك المنظمات الجماهيرية خلال المرحلة الانتقالية قد أدى إلى وجود نخبة قيادية غير مسئولة أمام دوائر بعينها، بل أصبحت هذه النخبة تبحث عن شرعيتها في “الأهالي” نظرا لدورها الرمزي في حماية التحرر الوطني وأدوارها التاريخية كممثلة للقضية الفلسطينية. كما لم تتمكن الأحزاب المعارضة اليسارية الضعيفة من الاحتفاظ بأنشطتها أو استمرارها حيث أضعفتها الخلافات الداخلية ووهنها الهيكلي خاصة في إطار غياب الديمقراطية الداخلية والهيمنة المتصاعدة للسلطة الفلسطينية. أما المعارضة الإسلامية فقد ظلت هي الوحيدة القادرة على الاحتفاظ بقاعدة شعبية.
وهكذا استطاعت الدولة الفلسطينية الوليدة أن تغير واقع السياسة والمقاومة وأن تقلل من مشاركة الناس بصفة عامة – والنساء بصفة خاصة – حيث حلت السياسات الرسمية محل الأشكال غير الرسمية للتعبئة إلى حد كبير، كما تمكنت قيادات “الخارج” من الاستيلاء على سلطات زعماء “الداخل في الضفة الغربية وفي غزة. لقد شكلت ازدواجية الأنشطة السياسية الرسمية القوية إلى جانب الأنشطة غير الرسمية الضعيفة الخطوة الأولى على طريق تهميش المجتمع المدني والحد من مشاركة النساء. كما أدى تضاؤل المنظمات الجماهيرية وإخفاق الأحزاب السياسية اليسارية إلى أن أصبح الحيز العام في المرحلة الانتقالية حكرا ضمنيا على السلطة الفلسطينية، وخاصة من قبل أجهزتها الأمنية على الرغم من ظهور ظرفي لأصوات معارضة ارتفعت لتنتقد بعض القضايا السياسية والاجتماعية (مارشال، ١٩٩٤، ١٤٤).
لقد فرض المناخ السياسي الجديد على الحركة النسائية وغيرها من الحركات الاجتماعية الأخرى أسئلة صعبة ومحيرة فيما يتعلق بتطوير استراتيجيات تتجه لكل من قضايا النوع في إطار الدولة الصاعدة والظروف الواقعية للاحتلال التي يواجهها الرجال والنساء يوميا.
اتسمت الانتفاضة الأولى بالوحدة والتناغم الوطنيين بما ينطوي عليه ذلك – كما هو الحال في نضالات أخرى للتحرر الوطني – من خفض المطالب المباشرة المتعلقة بالنضال الطبقي وبالنوع. إلا أنه عند نقطة التقاء الانتفاضة الأولى والتقدم في عمليات السلام بدأت تطفو على السطح المسائل المتعلقة بالنوع بطريقة أقوى. ويعد ميثاق المرأة لعام 1994 من الأدلة على قوة الحركة النسائية في هذه الفترة، حيث تبنى هذا الميثاق اتحاد المرأة الفلسطينية وأغلبية المنظمات النسائية الفلسطينية بعد لقاءات تشاورية وحوارات واسعة النطاق. و يشير هذا الميثاق إلى مبدأ “المساواة بين الجنسين” الذي تبناه الإعلان الفلسطيني للتحرر في عام 1988، كما يؤكد الميثاق على الحقوق الوطنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية للنساء، متقدما هكذا بعقد اجتماعي ونوعي جديد للمجتمع الفلسطيني، إلا أن هذا الإنجاز لم تتم ترجمته إلى عملية تعبئة جماهيرية. ذلك أن اللجان النسائية الشعبية والطلائع النسائية المرتبطة بالأحزاب السياسية الفلسطينية لم تتمكن من التنسيق فيما بينها بسبب الاختلافات السياسية التي سادت المناخ العام إثر اتفاقيات أوسلو. وبالإضافة إلى ذلك، فإن مطالب الميثاق الخاصة بالحقوق المتساوية قد أضعفها غياب الحقوق الوطنية وحقوق المواطنة لكافة السكان خلال المرحلة الانتقالية.
لقد واجهت الحركة النسائية الفلسطينية عدد من الإشكاليات في المرحلة الانتقالية، منها المطالبة بالحقوق المتساوية في ظل ميلاد الدولة الجديدة واستمرار القمع الإسرائيلي الاستعماري والحاجة الفعلية لكلا من الرجال والنساء للاستقلال. وقد شكلت كل هذه العوامل حالة يصعب مواجهتها على الرغم من الجهود المتميزة لعدد من النشيطات التطوير استراتيجيات متعددة المداخل، وفي الواقع أن استراتيجية “ما بعد الاستقلال” قد هيمنت على هذه المحاولات بما تضمنته من مبادرات للإصلاح القانوني، وإدخال المعاملة المتساوية في الإجراءات الحكومية، وإدراج النساء في الوزارات، والضغط من أجل المزيد من المدارس للنساء في الريف، والمشروعات الصحية الموجهة للنساء وقضايا تنموية أخرى، وتنظيم ورش العمل حول قضايا الديمقراطية، والاهتمام بقضايا اجتماعية ذات خصوصية مثل العنف الأسري. وعلى الرغم من إنجاز العديد من المهام الجيدة، فإن النشاط النسائي قد فقد كثيرا من طابعه السياسي. كما وضعت الجهات المانحة الدولية المتكاثرة قضايا النساء في مقدمة الأولويات ولكن في الإطار المحدود لبناء الدولة وليس في إطار معركة متواصلة من أجل الاستقلال والديمقراطية الحقيقية. وهكذا، لم يتم التوجه بجدية نحو طبيعة نظام الحكم الفلسطيني باعتباره أحد القضايا الأساسية في عملية التحول الديمقراطي (حمامي وكتاب، ١٩٩٠). نتيجة لذلك، أصبح طرح المطالبة بالمساواة بين الجنسين في الحيز العام عملية أكثر تعقيدا وصعوبة بسبب ابتعاد هذه القضايا عن القضايا محل اهتمام نظام الحكم والنظام السياسي، وحتى الأجهزة التي كانت تحمل ضمنيا بذور التحول الديمقراطي – مثل المجلس التشريعي الفلسطيني – أصبحت مشلولة الحركة بسبب طبيعة الحكم التسلطية، إن عملية تحلل التعبئة تلك – والتبعية الشعبية الناتجة عنها – تشكل أسباب كافية لكي نفهم لماذا لا يشارك الناس بصفة عامة والنساء بصفة خاصة بطريقة نشطة في الانتفاضة الحالية.
تشير انتفاضة الأقصى وما ذكر سابقا حول الحركة النسائية إلى وجود انشقاقات كامنة داخل الحركة النسائية نفسها، مثل الانقسام بين من يعتقدون أن حصول النساء على المزيد من الحقوق يمكن أن يحدث في إطار الدولة من خلال الضغط على متخذي وصانعي القرار ومن يخشون فقدان الاستقلالية والتعرض للمخاطر السياسية في إطار برنامج للتحول الديمقراطي والتحرر. إن هذه التناقضات قد تأججت داخل بنية الحركة النسائية. وهذا ينطبق خاصة على حالة اتحاد المرأة الفلسطينية – على غرار الاتحادات الأخرى – والتي تعد منظمة تساندها الدولة وليست كياناً مستقلاً، تطور في إطار البنية القديمة لمنظمة التحرير الفلسطينية. إن وضع هذه المنظمة – باعتبارها ممثلة للنساء الفلسطينيات على الرغم من عدم إجراء انتخابات داخلها لأكثر من عقد – يدمر إمكانيات تعبئة النساء حول قضايا مثل المساواة والحكم الديمقراطي والمشاركة السياسية.
ومن جهة أخرى، فإن اللجنة الفنية لقضايا المرأة، وهي منظمة غير حكومية تقوم بالتنسيق بين لجان المرأة الفلسطينية والمنظمات المعنية بالبحوث حول المرأة، كانت لها رؤية بديلة حول تعزيز قدرات النساء ومشاركتهن. وقد قامت بالدفاع عن هذه الرؤية، إلا أنها لم تدخل في جدل مباشر حولها مع اتحاد المرأة الفلسطينية. وقد قامت اللجنة الفنية لقضايا المرأة خلال الانتفاضة الحالية بأنشطة تراوحت ما بين مسيرات بالشموع، وحملات نتجه نحو الرأي العام، وتنظيم المؤتمرات الصحفية (حول قضايا تتعلق بالطفولة كما سنرى لاحقا)، وتقديم العون لأسر الشهداء، واستضافة وفود التضامن، وأنشطة أخرى. إن هذه الأنشطة تندرج بصفة عامة تحت قضايا التضامن والرعاية الاجتماعية، إلا أنها لم ترق حتى الآن إلى تشكيل استراتيجيات ناجحة تتعامل مع القضايا السياسية المحورية كما أنها لم تتمكن من توسيع رقعة المشاركة النسائية بطريقة كبيرة.
وهناك مشكلة لدى النسويات في الإجابة على التساؤل حول ما إذا كانت الدولة قادرة على أن تصبح قوة فاعلة تعمل على تحقيق المزيد من المساواة أم أنها أداة للقمع الأبوي أم أنها الاثنين معا (ألفاريز، ١٩٩٠). ففي حالة فلسطين، لا تمتلك السلطة الفلسطينية القدرة أو الرغبة السياسية في أن تصبح قوة للتحول الديمقراطي، وبالتالي أصبحت هناك حاجة ملحة إلى تطوير كيان مستقل يكون مسئولا أمام النساء وخاضعا لمساءلتهن. ذلك أن المعارك التي تقودها الحركات الاجتماعية والقائمة على أساس النوع أو على أساس طبقي ينبغي أن تدار سواء من داخل أو خارج الجهاز السياسي للدولة، إلا أن الوضع الفلسطيني الحالي يتطلب المزيد من التركيز على المجال الموجود خارج نطاق الدولة حيث تستطيع القوى الفعلية ممارسة الضغوط على الدولة وجعلها أكثر استجابة لتطلعات النساء.
كما أن التبعات الاجتماعية والاقتصادية للقمع الإسرائيلي للانتفاضة قد أثرت على النساء في أماكن متعددة، حيث تعيش الآن ما يزيد عن نصف أسر قطاع غزة والكثير ممن يقيمون في معسكرات اللاجئين في حالة من الفقر. فالاعتراف بتنوع المشاكل التي تواجه النساء يسمح بتطوير برامج وخطط عمل تكون جاذبة لمزيد من النساء.
لقد طورت انتفاضة الأقصى خطاب سياسي مزدوج يؤثر بدوره على مستوى المشاركة. فالسلطة الفلسطينية تستغل الانتفاضة أساسا كقوة ضاغطة لتغيير شروط التفاوض والوصول إلى اتفاق حول الوضع النهائي في أقرب وقت ممكن. أما القيادات الشعبية للحركة الوطنية التي تمثل كيانات سياسية غير رسمية إلى حد ما فهي تتبنى إطارا يتسم أكثر بالرؤية الاستراتيجية، حيث تنظر إلى الانتفاضة باعتبارها وسيلة لتحرير الأرض والحصول على الحقوق الوطنية من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي. وعلى الرغم من أنه قد يتلاقى الهدفان في بعض الأحيان، إلا أنه توجد تناقضات عميقة فيما بينهما. ذلك أنه من غير المحتمل أن تصل السلطة الفلسطينية إلى اتفاق سريع يحل القضايا التاريخية الأساسية المتعلقة بالصراع الإسرائيلي – الفلسطيني. وهكذا يلوح في الأفق بروز الصراعات الداخلية المصحوبة بإجراءات السلطة المنافية للديمقراطية. وفي هذا الإطار، تتناقض المشاركة الواسعة مع مصالح النخبة الحاكمة.
إن مواقع وطبيعة المقاومة الفلسطينية في الانتفاضتين هي عوامل أساسية لفهم تهميش النساء والمجتمع المدني، ففي الانتفاضة الأولى، كانت المقاومة تدور في المجتمع وفي الشوارع والأحياء والمنازل، كما كانت الأحجار تمثل السلاح الأساسي للدفاع عن كرامة المجتمع المحلي. و في هذا الإطار شاركت النساء في صدامات مباشرة مع الجيش الإسرائيلي، سواء بصفتهن متظاهرات أو قاذفات للحجارة أو حاميات ومنقذات للشبان. وكانت المنازل، والمجتمع ككل، مسرحا لصراعات يومية مع الجنود الإسرائيليين. وبهذا الصدد يشير يوفال ديفيس إلى أنه “عادة ما يختفي التقسيم الواضح بين الجنسين وقت الحرب حينما لا يكون هناك تقسيما واضحا بين ميدان المعركة والجبهة الداخلية” (يوفال ديفيس، ۱۹۹۷).
أما في الانتفاضة الحالية، فإن المواجهات تحدث عند الحدود ونقاط العبور والتفتيش فيما بين المناطق التي حددتها اتفاقيات أوسلو. وتمثل هذه النقاط حدود “السيادة” الفلسطينية وتقع تحت رقابة الجيش الإسرائيلي. لقد مارس الإسرائيليين سلطتهم على هذه الأماكن على مدى أعوام ليمنعوا الفلسطينيين من الحصول على الرزق ومن ممارسة الحياة الاجتماعية أو من تقوية أواصر الوحدة الوطنية. وفي هذه الظروف، تتقلص أدوار النساء في المقاومة المباشرة إلى أضيق الحدود في غياب البعد الاجتماعي مع عسكرة الشارع والآثار المتفاوتة للحظر على حركة النساء، ويمكن القول أن هناك علاقة طردية بين تنامي العسكرة وممارسة العنف العسكري وبين مشاركة النساء والمجتمع الأوسع.
إن تشكل المناضلين في مواجهة غير المناضلين مسألة تظل مرتبطة بقضايا النوع، فهي مبنية على المفاهيم الإيديولوجية للأنوثة والذكورة وليس على القدرة الفعلية على المقاومة (يوفال ديفيس، ١٩٩٧)، وهو ما يحدث أيضا في مجتمعات أخرى. إن اتساع دور النساء في الانتفاضة الأولى كان ممكنا حيث ظل التقسيم ما بين مقاتلين وغير مقاتلين أمرا غير خاضع لحدود قاطعة. أما في الانتفاضة الثانية، فإن تعريف “المناضلين” يرتبط ارتباطا وثيقا بعوامل السن والنوع. نتيجة لذلك، تم إبراز الدور الإنجابي للنساء كحاملات للمقاتلين وأمهات للشهداء – وهو الدور الذي تتبناه الثقافة السياسية الفلسطينية – باعتبارهن رموز للمقاومة (بينيت، ۲۰۰۱). هذا في الوقت الذي تواجه فيه الأمهات حاليا اختيارات صعبة بل ومميتة. وسوف نناقش فيما بعد ثلاث أزمات مرتبطة بالموضوع أدت إليها (أو أبرزتها) مستويات وأشكال ومواقع ممارسات القوة المبالغة للإسرائيليين خلال الانتفاضة الثانية وهي: أزمة في الذكورة، وأزمة في الأبوة وخاصة ما يتعلق بأدوار الآباء في توفير الحماية والتموين للأسر، وأزمة في الأمومة حيث تواجه الأمهات تناقضات قاسية في مسئولياتهن تجاه الأطفال.
لقد شهدت الشهور الأربعة الأولى للانتفاضة الثانية حالات عنيفة من الموت والأضرار فاقت بكثير ما حدث خلال سنوات الانتفاضة الأولى، فحتى منتصف فبراير كانت قوات الأمن والمدنيون الإسرائيليون قد قتلت ما لا يقل عن ٣٥٤ فلسطينيا أغلبهم من المدنيين وما لا يقل عن ١٠٢ منهم تحت سن 18 سنة. كما تشير التقديرات إلى وجود ما يقرب من ۱۱۰۰0 مصابا فلسطينيا. ومن جهة أخرى، قامت قوات الأمن الفلسطينية والمدنيون بقتل ما يقرب من 50 إسرائيليا، منهم 19 ينتمون إلى قوات الأمن الإسرائيلية والباقي مستوطنين وبدرجة أقل مدنيين من داخل إسرائيل من بينهم شخص واحد يبلغ 16 سنة. وبينما يتعلل المدافعون عن إسرائيل بأوضاع الصراع القائمة – جزئيا لإطلاق يد الجنود الإسرائيليين في استعمال القوة وتدمير الملكيات دون حاجة إلى تحريات مسبقة ودون حق الطرف الآخر في المطالبة بتعويضات – فإن الواقع يقول أن الانتفاضة الثانية أقرب إلى الحرب وإن كانت غير متكافئة في ظل هذا الاحتلال العسكري، وهو الأمر الذي يختلف عن الانتفاضة الأولى حيث اتسم الصراع بحدة أقل. وكما يقول أحد الصحفيين المخضرمين فإن هذه الحالة تسمى “في عالم الواقع حريا مدنية” (فيسك، ۲۰ ديسمبر ۲۰۰۰).
لا تختلف جذريا مواقف النساء والرجال الفلسطينيين حول الطبيعة العنيفة لهذه الحرب. وتشير البيانات المقسمة على أساس النوع الواردة في استطلاع الرأي الذي تم نشره في يناير أن 70% من النساء و74% من الرجال يوافقون على العمليات العسكرية الفلسطينية باعتبارها ردا مناسبا على الاعتداءات الإسرائيلية. كما تبين الإحصائيات أن 48% من النساء و٥٢% من الرجال يوافقون على العمليات الانتحارية مما يشير إلى وجود فجوة نوعية تبلغ 4% فقط. أما أهم فجوة ظهرت فيما بين نتائج هذا الاستطلاع واستطلاعات سابقة للانتفاضة فهي تكمن في أن ما يقرب من ربع الفلسطينيين فقط (٢٦% في الاستطلاع الذي أجراه مركز القدس للإعلام والاتصال في مارس ١٩٩٩) كانوا موافقين فيما قبل على العمليات العسكرية. كما وجدنا فجوة مهمة أخرى تتعلق بمدى تفاؤل الفلسطينيين بالمستقبل والذي تحول من ارتفاع نسبي إلى شبه اختفاء. إن الإخفاق الساحق لإسرائيل في صنع السلام خلال السنوات الانتقالية بالإضافة إلى استعراض القوة الحالي يفسر هذا الهبوط الحاد في التفاؤل على الرغم من أن أغلبية الفلسطينيين ما زالوا يدعمون عملية السلام، كما سنرى فيما يلي.
لقد أشار استطلاع رأي شهر يناير المذكور أعلاه إلى أن 16% من النساء و٢٢% من الرجال ينظرون إلى المقاومة المسلحة على أنها الطريق الوحيد، كما تؤمن الأغلبية بأهمية وجود أشكال مزدوجة من النضال العسكري والنضال الشعبي. إن الفجوة البسيطة في إجابات الجنسين على السؤال السابق تتسع حينما يتم التطرق إلى طرق الوصول إلى اتفاق مقبول لكلا الطرفين. فبينما تفضل ٢٧% من النساء طريق المفاوضات لا يميل نحو هذا الاختيار سوى 16% من الرجال. كما أن ٢٢% من النساء اخترن طريق المواجهة في مقابل ٢٩% من الرجال، وتفضل ٣٤% من النساء استعمال طريقة مختلطة تجمع بين الوسيلتين في مقابل ٣٨% من الرجال. وأخيرا، فإن 13% من النساء و١٥% من الرجال يعتقدون أنه لا يمكن الوصول إلى اتفاق.
تتضح هذه الفروق أيضا في دعم عملية السلام، وهو في حد ذاته مفهوم غامض. إلا أن دعم النساء لعملية السلام يرتفع بطريقة ملحوظة عن دعم الرجال. فقد لاحظ أحد المحللين لاستطلاعات الرأي “أن ٤٠٧٣% من الإناث و65% فقط من الذكور يدعمون عملية السلام في المتوسط على مدى ثلاث سنوات” (مركز القدس للإعلام والاتصال، ۲۰۰۱، ۷)، كما نجد نفس الفجوة النوعية إلى حد كبير في استطلاع الرأي لشهر ديسمبر على الرغم من أن دعم عملية السلام قد انخفض كثيرا حيث بلغت الاستجابات الإيجابية نسبة 50% عند النساء و٤٢% عند الرجال. وقد يمكن تفسير ذلك بميل النساء نحو الاستقرار، وهو ما يتضح أيضا من النسبة المرتفعة من اللاتي أشرن إلى الرئيس ياسر عرفات باعتباره أكثر الوجوه احتراما. إلا أن مواقف النساء والرجال من استعمال الفلسطينيين للعنف تظل متقاربة إلى حد بعيد. وربما يكون الزعم بأنه “تركيبة الرجال الطبيعية مرتبطة بالحرب، بينما تركيبة النساء الطبيعية مرتبطة بالسلام” (ديفيس، ١٩٩٧، ٩٤) أصدق فيما يتعلق بأدوار الجنسين عنه فيما يخص المواقف والمعتقدات.
إن المشاركة المتفاوتة للنساء والرجال في المصادمات العنيفة قصة أخرى على الرغم من أن معظم الرجال الفلسطينيين فوق سن ٢٥ سنة غير مشاركين أيضا. إن طبيعة المصادمات الشعبية العنيفة التي طبعت الشهور الأولى للانتفاضة اتسمت بتقسيم واضح بين الجنسين كما خضعت لعامل السن. فإذا ما شكلت الحرب “أكثر الأماكن المباشرة” لتشكيل وإعادة إنتاج الذكورة (مورجان في برود وكاوفمان، ١٩٩٤، ١٦٥)، فإن بعض الحروب والصراعات الخاصة تقوم بهذا الدور بطرق محددة تذكرنا بأنه “يتم إعادة إنتاج الأبوية سواء داخل كل نوع أو فيما بين النوعين” وبالتالي “يتطلب ذلك المزيد من الاهتمام بتلك المؤسسات المسئولة بطريقة حيوية عن إنتاج وتشكيل الهوية الذكورية” (كانديوتي، ١٩٩٤، ١٩٩). ففي المصادمات التي نتحدث عنها، يشير ارتفاع نسبة الوفيات والإصابات في صفوف المتظاهرين والمناضلين الفلسطينيين بالإضافة إلى أماكن وأشكال ونتائج تلك المصادمات إلى وجود أزمة ذكورة، مما يتطلب اهتماما خاصا.
لا يمكن اختصار تضحيات ونضالات الشبان والأطفال الفلسطينيين في المظاهرات التي يقومون بها عند نقاط العبور والتفتيش إلى أزمة في الهوية الذكرية. فما من شك أن أزمة الهوية الوطنية، والطبقية والعرقية متداخلة بعمق في هذا المجال. فالمسألة مختلفة تماما، حيث تتولد أزمة الهوية النوعية نتيجة وجود سلسلة من الأزمات ذات الصلة، سواء في الوطنية الفلسطينية بعد أوسلو على المستوى السياسي، أوفي الآثار المهينة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي كنتيجة لنظام الفصل العنصري المنبثق عن أوسلو، أوفي آثار الاحتلال على الاقتصاد، والتي تشكل جميعا أسبابا لتهميش بعض مجموعات الرجال في سوق العمل مما زعزع من أدوارهم الذكرية داخل الأسر. صحيح أن الأغلبية العظمى المعيلي الأسر الفقيرة من الذكور المندرجين في القوى العاملة (التقرير الوطني للفقر، 1998، 43) إلا أن ارتفاع معدلات البطالة أو العمل في وظائف متدنية وبأجور منخفضة مقارنة بمستوى الأسعار قد يؤدي إلى إخفاق هؤلاء المعيلين في الوفاء بالاحتياجات الفعلية لأسرهم. والواقع أن دخول الشباب في صفوف القوة العاملة وتأسيس أسر يعتبر معضلة حقيقية. هذا في الوقت الذي قامت فيه شروط أوسلو المهينة يزعزعة أدوار هؤلاء الشبان كأبطال ومسئولين عن المقاومة الوطنية.
ويمكن مقارنة هذا الوضع بالأزمة النوعية التي حدثت في زمن سابق والتي وصفها طومسون في سوريا ولبنان غداة الدمار الذي حل بعد الحرب العالمية الأولى ويسبب النظام الاستعماري المرتبط بهذه الحرب. إذ يشير طومسون إلى:
“التمزق العميق الذي عانته الأسر أثناء وبعد الحرب العالمية الأولى، وإنشاء دول وطنية جديدة على المستوى النظري، وفرض الحكم الفرنسي. إن تزاوج هذه الشروط الثلاثة قد ساهم في ظهور ردود أفعال اتسمت ببروز الضغوط العصبية بسبب تغير اقتصاديات الأسر وتبدل أدوار الجنسين على المستوى الخاص وإعادة هيكلة المجتمع ونظام الحكم على المستوى الكلي” (طومسون، ۲۰۰۰، ٦).
ويسمى طومسون ردود الأفعال المرتبطة بالضغوط داخل الأسر، وفي المجتمع ونظام الحكم بـ “أزمة الأبوة” (طومسون، ٢٠٠٠، ٦). إن التمزق الذي يحياه الفلسطينيون على هذه الأصعدة الثلاثة – أي داخل الأسر بكل ما تواجهه من صدمات، وفي المجتمع، ومع نظام الحكم الذي يعيش حالة تشتت ما بين سلطة وطنية ضعيفة واستعمار إسرائيلي متسلط – يؤدي هو الآخر إلى بروز الضغوط العصبية فيما يتعلق بأدوار الجنسين وهي الضغوط التي أدت الانتفاضة الحالية إلى تفاقمها.
ففي الانتفاضة الثانية يعبر الشباب المتجهون إلى نقاط العبور عن رفضهم لظروف معيشتهم والوجه المظلم لإمكانيات المستقبل، سواء باعتبارهم عمال عاطلين أو أطفال لاجئين محاصرين في قطاع غزة، أو حتى أفراد من قوات الأمن يقومون بحراسة الحدود ولكنهم ممنوعين من الابتعاد عن هذه الحدود. إلا أن هؤلاء يواجهون هناك قوة تعتبرهم مهمشين وآدميين من درجة أدنى. كما أنهم يواجهون غياب حكومة وطنية لها وجود نظري لكنها مسلوبة السلطة عمليا وغير قادرة على القيادة. ومن الملفت للنظر هنا أن الرئيس ياسر عرفات المعروف باسم “الوالد” والذي مارس طويلا سلطة “أبوية” أو “نوع من اللاهوت الجديد” (هلال، ۱۹۹۷) على الحركة الوطنية لم يتوجه مباشرة إلى شعبه إلا مرة واحدة فقط خلال الأشهر الأربعة الأولى للانتفاضة. فقد لعب بالأحرى دورا مراوغا ما بين الالتزام بعملية أوسلو التي يرتبط بها سواء تحت ضغط القوة أو بمقتضى الاتفاقيات وبين ركوب موجة التمرد ولكن بحرص. كما أن الموارد السياسية والثقافية المتاحة للشباب المتمرد تمكنهم من المقاومة ولكنها لا تمكنهم من الوصول إلى حل.
عند حديثه عن العنف الذي مارسه الجنود الإسرائيليين خلال الانتفاضة الأولى ضد الشبان الفلسطينيين سواء في الشوارع أو في السجون يشير بيتت إلى أنه “يتم تقديم عمليات التعرض للضرب (والاعتقال) على اعتبار أنها طقوس بلوغ حيوية بالنسبة لتشكل الهوية الخاصة للذكر البالغ وهذا يؤدي إلى نتائج خطيرة على مستوى الوعي السياسي وعلى مستوى العمل السياسي” (بيتيت، ۲۰۰۰، ۱۰۳). إن الشبان الفلسطينيين الذين يتعرضون للعنف الإسرائيلي ينتقلون من مرحلة أولى من الانعزال عن المجتمع إلى مرحلة خطيرة يكونون فيها “خارج الزمن الاجتماعي” حيث يخضعون لعنف جسدي يقاومونه وأخيرا إلى مرحلة إعادة الدخول في الحياة الاجتماعية الطبيعية والتي غالبا ما يصاحبها الحكايات التي يتداولها الوسط المحيط حول التجربة، وهو ما يؤدي إلى التعظيم من “الاعتراف المجتمعي ومن الرصيد الذكري والثوري وهو ما يقود هؤلاء الشبان إلى القيام بأدوار قيادية في المنظمات السياسية” (بیتت، ۲۰۰۰، ۱۱۲).
تبرز هنا الحاجة إلى إجراء المزيد من البحوث لعقد المقارنة ما بين طقوس الانتفاضة الأولى و“الطقوس” المرتبطة بالانتفاضة الثانية. إلا أننا نتصور أنه توجد فروق جوهرية فيما بينهما. فهناك أولا الوجود المتعاظم للموت والتعرض للإصابة في مواقع الصدام حيث يعرض المتظاهرين أنفسهم للنيران الإسرائيلية. وهكذا تعبر للانتفاضة الذي يحبذ الاستشهاد، صحيح أن الانتفاضة الأولى كانت تكرم شهداءها، إلا أن حرب العصابات ساحات الصدام المختلفة عن الوضع السياسي الصعب في مرحلة ما بعد أوسلو والذي يفوق التوجه الديني للانتفاضة الذي يحبذ الاستشهاد. صحيح أن الانتفاضة الأولى كانت تكرم شهداءها، إلا أن حرب العصابات شكلت طابعا مميزا لها وخرج المحتجون وقاذفو الأحجار من داخل المجتمع وألقوا برسائلهم وقذائفهم ثم عادوا إلى المجتمع الذي ينتمون إليه لاستئناف حياتهم. أما في مصادمات الانتفاضة الثانية، فإن المجتمع لا يشكل محيطا قابلا لتوفير الاستدامة والحماية بل هو بالأحرى جمهور يسمع عن أحداث سواء تقع تحت العيون في نقاط العبور والتفتيش أو من خلال مشاهدة قنوات التليفزيون المحلية والفضائيات التي تقدم التغطية الحية داخل المنازل ساعة بساعة.
كما يوجد هناك فرق أساسي في عمليات إعادة الاندماج في المجتمع وفي الاعتراف بالذكور وبالرصيد السياسي الذي يحصلون عليه حيث أن معظم المتظاهرين في الانتفاضة الحالية من الشباب وهم لا يحصلون على وضع الكوادر السياسية ولا يتحولون إلى قيادات داخل مجتمعاتهم. وهنا يأتي دور ما أسميناه سابقا بـ“الشعبوية التسلطية” وهو النظام الذي تستند شرعيته إلى “الناس” أو “الشارع” والذي يضع في نفس الوقت قيودا على المشاركة السياسية الديمقراطية. وسواء تعلق ذلك بالسلطة الفلسطينية أو بحركة فتح – وهو الحزب المهيمن على كل من الانتفاضة والحكومة – فإن القيادات السياسية تستعمل الشباب المتمرد، بينما لا يحدث تغيير في العلاقات المتبادلة فيما بين الطرفين. ومن الواضح أن هذه النقطة تحتاج إلى كثير من البحث بما في ذلك أثر التدهور في تدخلات الحيز العام وهو ما يشير إليه هابرماس في إطار ثقافي مختلف تماما حيث يتجاوب الجمهور بالتصفيق أو بالامتناع عن التصفيق عوضا عن الخطاب النقدي” (كالهون ١٩٩٢، ٢٦).
إن هذه الآليات تدفعنا إلى القول بأن أزمة الذكورة لا يتم حلها من خلال المقاومة الشعبية، بل قد يكون تصعيد الأعمال العسكرية هو الحل الوحيد المطروح اليوم. ومع استمرار الانتفاضة المصحوبة بطمس العمليات العسكرية للمصادمات الشعبية التي تقوم بها مجموعات صغيرة من الشبان، فإن الأزمة تتسم بالمزيد من العسكرة وتصبح المشاركة أكثر تقلصا فيما عدا ما يتعلق بتعرض هؤلاء الشبان للعنف الإسرائيلي. وفي حين تمكن الأنشطة العسكرية وصول بعض المشاركين من الشباب إلى السلطة، فإن هذه السلطة تظل مجزأة ومنفصلة عن المجتمع، مما يجعلها أكثر قابلية للتحول إلى صراعات على السلطة عن كونها ممارسات للسلطة السياسية في إطار ديمقراطي.
يبدو من المهم التطرق إلى الصورتين اللتين حازتا على أكبر قدر من الشعبية في الانتفاضة الثانية. فالصورة الأولى معروفة دوليا وهي لذلك الأب الشاب الذي حاول بلا جدوى حماية ابنه الصغير محمد الدرة البالغ من العمر اثني عشر عاما، وقد تناولتها كل أجهزة الإعلام الفلسطينية بأشكال متعددة برزت من خلالها صورة مأساوية “لأزمة الأبوة” (طومسون ٢٠٠٠، ٢٨٤) مشيرة ليس فقط إلى إخفاق السلطة الأبوية بل إلى الفشل في توفير الحماية الأبوية. أما الرمز الثاني فهو لفارس عودة، وهو شاب فلسطيني نحيل ينتمي أيضا إلى قطاع غزة ويبدو وكأنه يبلغ هو الآخر ١٢ سنة، يقف متحديا أمام دبابة إسرائيلية عملاقة، وفي يده حجر، وهي الصورة المنتشرة في المحلات والمكاتب والمنازل الفلسطينية، وفي نظرة متفحصة “لكلتا الصورتين اللتين ملأتا عيون الفلسطينيين خلال الشهور الثلاثة الأخيرة” يكتب زكريا محمد أن “محمد الدرة قدم لنا رمزنا بموته، أما عودة فقد قدم لنا رمزنا بوقفته المتحدية” (محمد ۲۰۰۱، ۱۰).
إلا أن نظرة زكريا محمد أكثر تفردا، فهو يلاحظ أن أولاد الثانية عشر لا زالوا ينظرون إلى الحرب باعتبارها لعبة وهو بالتالي يرفض نعتهم بالشهداء حيث تعني تلك الصفة ضمنيا “أن الضحية واعية تماما بمعنى الحرب وتعلم ماذا يعني الموت من أجل قضية ما” (محمد ۲۰۰۰، ۹). إلا أن هذا التحليل لا يأخذ في الاعتبار كون الفتى الذي يقف أمام الدبابة يواجه وضعا ميئوسا منه، كما لم تأخذ ردود الفعل الشعبية هذا الواقع بعين الاعتبار. بل أن هناك ألما إضافيا وهو أن فارس قد أصيب برصاصة في العنق خلال مظاهرات جرت بعد عشرة أيام وظل ينزف حتى الموت في نقطة تفتيش كارني. إن المعاني المتناقضة التي تحملها هذه الصور تحتاج إلى وقفة. فهي تمثل موقف ينطوي على تحدي بكل تأكيد، إلا أنه يبدو وكأنه محكوم عليه بالفشل حيث طفل شديد الضعف يمثل رمزا للمقاومة الوطنية. لقد كان الشباب وخاصة أطفال الحجارة – رموزا للانتفاضة الأولى، وأملا في المستقبل وفي تحقيق الاستقلال. إن الصورتان تجسدان بطريقة واضحة السلطة الإسرائيلية العنيفة والتي لا تخضع لأية مساءلة في مواجهة طفل معرض للخطر لا يتمتع بأية حماية وهي الصور التي لا يواكبها مقاومة أو إجراءات سياسية من قبل البالغين. إن رمز فارس عودة يتفاعل مع ذلك الرمز الذي يمثله محمد الدرة – وهي رموز لأطفال فشل الأب في حمايتهم – بل أخفق المجتمع ككل ونظام الحكم في ذلك، إننا نتصور أن تلك الإخفاقات في الحماية تؤدي في المقام الأول إلى أزمات في الأبوة.
إن تناول الأنشطة النسائية أثناء الانتفاضة قد يبدأ بمشاركة النساء في منظومة من الأنشطة غير الرسمية التي تراوحت ما بين مساعدة “الشباب” خلال المظاهرات والمشاركة الواسعة في المسيرات الجنائزية وصولا إلى رعاية الأسر والمصابين، إلا أننا سوف نبدأ بوالدة فارس عودة، ذلك الطفل الذي تحدى الدبابة الإسرائيلية. تشير تقارير الصحافة إلى أن أمنة عودة كانت قلقة للغاية بشأن ابنها الذي كان قد أقسم على الانتقام لمقتل ابن عمه على أيدي الجيش الإسرائيلي. وقد حاولت هذه الأم أن تتحدث مع وليدها بل ذهبت تبحث عنه عند نقاط العبور، وكانت كلماتها لمراسل واشنطن بوست: “قد أكون ذهبت إلى هناك أكثر من 50 مرة للعثور عليه“. وفي الواقع إنها كانت وجها مألوفا عند نقطة عبور كارني لدرجة أن الأطفال كانوا يمازحون فارس بقولهم “يا فارس. ما فرقة الضرب العنيف هذه التي تبحث عنك؟” (هوكستادر، ۱۲ ديسمبر ۲۰۰۰، ۲).
لقد تميزت النشاطات النسائية في الانتفاضتين بشكل من أشكال الامتداد لأدوار النساء وبالأخص “نشاطية الأمومة” والتي كانت أكثر ظهورا في الانتفاضة الأولى حينما قامت النساء الأكبر سنا بإيواء الشباب والجنود المتمردين، أما فيما يتعلق بالانتفاضة الثانية، فإن هذه “الأمومة الحامية” لا تجد مكانا لها وهو ما يتجلى في انخفاض حاد “لأزمة الأمومة” التي تصاحب أزمة الأبوة المشار إليها سابقا. وفي حين تميل أجهزة الإعلام إلى إبراز صور الأمهات اللاتي يباركن استشهاد أبنائهن، تشير حالة آمنة عودة إلى الصراع الحقيقي الذي تعيشه الأمهات وإلى أن مباركة الأمهات للاستشهاد لا تعني في كل الأحوال انتهاء الصراعات الداخلية المميتة. فإذا ما صح افتراض روديك بأن ممارسات الأمومة تحكمها “ثلاثة دوافع هي الحفاظ على الطفل ونموه وقبوله” (روديك في ميير ١٩٩٧، ٥٨٩)، فإن هذه الدوافع قد تبدو مؤلمة ومتناقضة فيما بينها حيث تتعارض أهداف الحفاظ والنمو (بما تحمله من معاني الفهم والالتزام السياسي) مع القبول خاصة حينما تقوم الدولة والمجتمع – أو المحيط الاجتماعي – بتكريم المقاومة حتى وإن كانت تعني القيام بممارسات خارجة عن المألوف. إن كلمات النساء أنفسهن عن افتقاد القدرة النسبية على حل تلك التناقضات تشير إلى أسباب إضافية للضغوط التي يقمن تحت وطأتها.
في هذا الإطار، من الطبيعي أن تصبح أحد أكثر مبادرات الحركة النسائية الفلسطينية استمرارا هي تلك التي تناهض المزاعم بأن الأمهات الفلسطينيات يرسلن أطفالهن إلى نقاط العبور للاستشهاد، وهي الإدانة التي يطلقها المعتدي الإسرائيلي بوقاحة مدعيا أن الضحايا هم المتسببين في موتهم. لقد أصدرت الحركة النسائية والأمهات الفلسطينيات المقيمات في ظل الاحتلال في الضفة الغربية وفي غزة نداء في ٢٩ أكتوبر ٢٠٠٠ من أجل حماية الأطفال الفلسطينيين جاء فيه أن “أهم أولوية هي حماية أطفالنا وكفالة الحق لهم للعيش بلا خوف أو أذى أو إهانة“. كما أكد النداء على “أنه لا يتم إرسال أطفالنا إلى الخطوط الأمامية، فأماكن الخطر والمواجهة تحيطهم من كل جانب بالقرب من بيوتهم ومدارسهم. فبالنسبة لمعظم أطفالنا تعتبر الشوارع هي أماكن اللعب ونحن لا نمتلك وسائل تأمين لعبهم وتعليمهم التي نتطلع إليها. كما أننا نلاحظ أن الجيش الإسرائيلي يحضر إلى الأرض الفلسطينية لمواجهة أطفالنا والعكس ليس صحيحا” (اللجنة الفنية لقضايا المرأة ٢٠٠٠).
كما لاحظت العديد من الناشطات أن السلطة الفلسطينية لم تتخذ التدابير اللازمة لمنع الأطفال من الاشتراك عند نقاط التفتيش، ونظمت الحركة النسائية الندوات وأصدرت النداءات وعقدت مؤتمرا صحفيا قدمت خلاله أمهات الأطفال الشهداء في مواجهة الصورة العنصرية التي يقدمها الآخرون حول الأمهات الفلسطينيات. لقد استعملت إسرائيل كلمات الملكة سيلفيا التي ألقتها في نيويورك استعمالا واسعا في حملاتها الدعائية. إلا أن ملكة السويد – والتي تم توجيه النداء المذكور أعلاه إليها – قد اضطرت إلى تقديم توضيح واعتذار.
والواقع أن الحركة النسائية الفلسطينية قد نظمت التظاهرات العامة الوحيدة التي خرجت عن إطار المسيرات الجنائزية أو الاستعراضات العسكرية لبعض الفرق السياسية، فقد نجحت في تنظيم مسيرات بالشموع في رام الله وغزة وفي القدس، ونجحت في استقطاب العديد من المشاركين على الرغم من أن الدعاية لتلك الفعاليات كانت بسيطة وكان مداها الزمني والجغرافي محدودا، إن كون الرجال والنساء والأطفال قد احتشدوا في هذه المظاهرات يشير إلى حاجة الجمهور الملحة لوجود وسيلة للتعبير السياسي والاجتماعي. وقد وفرت الحركة النسائية بهذه المناسبة فرصة – ولو محدودة – لالتقاء المجتمع المدني ككل. لقد دخلت عدة مجموعات من الشباب وسط المتظاهرين وتقدمت نحو نقاط التفتيش في رام الله باستعداد تام للمواجهة القادمة، كان البعض منهم متحمسا لجمهرة المتظاهرين بينما سخر البعض الآخر من الشموع وشجعوا كل المشاركين على التوجه إلى نقطة التفتيش. ومن الواضح أن هؤلاء الشبان قد بدءوا نشاطهم منطلقين من عالمهم الثوري الخاص الذي يرتكز على أخلاقيات مساندة الأنداد. كما حاول بعضهم إطلاق شعاراتهم التي بدت أكثر التهابا وأقل وعيا من تلك التي أطلقها جمهور المتظاهرين. ومن الملفت للنظر أن النساء نجحن في إسكات هؤلاء الشبان باسم الديمقراطية، وهو ما يشكل ربما واحدة من النقاشات العامة النادرة بين المناضلين والجمهور أثناء انتفاضة برز فيها المجال العام على شاشات الفضائيات أكثر مما حدث في شوارع رام الله والمدن الفلسطينية الأخرى.
تدرك تماما العديد من الناشطات في الحركة النسائية الاختلافات الواردة في أدوار النساء خلال الانتفاضتين، كما أنهن يعبرن بوضوح عن الحاجة الملحة إلى تطوير استراتيجيات جديدة تربط ما بين جدول أعمالهن كنساء والأهداف الوطنية والنضال. وقد شاركت الناشطات من معظم المنظمات النسائية يوم 16 ديسمبر في تجمع بمدينة رام الله تحت عنوان “الحركة النسائية والوضع الراهن: نحو المزج بين جدول الأعمال الوطني والنسوي“. لقد أكدت العديد من المتحدثات على الفروق الواردة بين الانتفاضتين خاصة فيما يتعلق ببروز المشاركة النسائية في الانتفاضة الأولى حيث كان “الاحتلال في كل مكان وكانت هناك مشاركة شعبية واسعة. أما في الانتفاضة الثانية، فإن الأعباء التي تقع على كاهل النساء قد تزايدت، وهي تعود على سبيل المثال إلى ارتفاع التكلفة الإنسانية بما في ذلك وجود الآلاف من المعوقين الذين يحتاجون إلى رعاية، إلا أن هذا الشكل من أشكال المشاركة يختفي وراء أسوار المنازل.
تصف إحدى المتحدثات التي كان لها دور قيادي خلال الانتفاضة الأولى هذه القيادة بأنها “قيادة مدنية لها جذورها في المجتمع الذي تتجاوب مع احتياجاته، وهو ما مثل إطارا مناسبا لمشاركة النساء“. وبينما اعترفت الناشطات أن التنازل عن تلك المسئوليات لصالح السلطة الفلسطينية هو في إطار بناء الدولة، بما في ذلك المسئوليات الرعائية التي وقعت مسئوليتها أحيانا وجزئيا على عاتق النساء، فإنهن قد عبرن عن قلقهن العميق لسلب النساء أدوارهن. ومن الملفت أيضا أن عددا من النساء معظمهن عائدات من الخارج سواء كن من أعضاء منظمة التحرير أو من أسرهن التي عادت في إطار اتفاقيات أوسلو – من اتحاد المرأة الفلسطينية قد اعترضن على صحة عقد المقارنة بين الانتفاضتين ورفضن فكرة المشاركة المحدودة للنساء. وقد اعتبرن أن مشاركة الكوادر النسائية في اللجان المنسقة الرسمية على مستوى البلديات وفي الأحزاب السياسية، وكذلك دور النساء في “تشجيع أطفالهن” على المقاومة تمثل أشكالا مهمة وصالحة للمشاركة، وفي نفس الاتجاه نادت العديد من المشاركات بتشجيع الشابات على المشاركة في المظاهرات عند نقاط التفتيش. إن هذه الفكرة تتفق منطقيا مع وجهة النظر التي ترى أن تكون المشاركة في النضال الوطني على هذا النحو، إلا أننا نعتبر أن وجهة النظر هذه ستؤدي استراتيجيا إلى نهاية قاتلة الحركة النسائية.
تشير ورقة نظرية تؤسس لبعض المفاهيم، أعدتها إحدى الناشطات من منظمة غير حكومية تقوم بالنضال من أجل الإصلاح التشريعي وتقديم المساعدات القانونية للنساء خلال فترة أوسلو، إلى أن القضايا الوطنية والنسوية متداخلة تماما وهي تنادي الحركة بعدم غلق الأبواب التي تفتحت خلال المرحلة الانتقالية حيث تم طرح قضايا حقوق النساء والأطفال والإنسان على الساحة الفلسطينية. وبينما بدت هذه الفكرة صحيحة من جوانب عدة، ذكرت إحدى الناشطات الحضور بالفشل الكبير الذي أصاب عمل المنظمات غير الحكومية في مرحلة أوسلو، وهو ما يقوم على الفشل في الاعتراف بأن السياسة تعني السلطة وأن غياب الديمقراطية في السياق الفلسطيني يحتاج إلى مواجهة سياسية ولا يمكن أن يستند فقط على أنشطة المنظمات غير الحكومية.
كما أشارت متحدثة أخرى أن العلاقة مفقودة بين النسوية والنساء، بل والمجتمع ككل. ومن هنا ظهر توجه استراتيجي للنضال ضد تقليص أدوار النساء، ليس من خلال المناداة بأن تستولي الشابات على الأدوار العسكرية للشبان، بل في توسيع إطار المشاركة من خلال ممارسات سياسية بديلة. ترتبط هذه الاحتياجات ارتباطا وثيقا بتطلعات الشعب الفلسطيني، إلا أن هناك مسئولية تقع على المجتمع المدني لإبراز هذه العلاقة والقيام بدور فعلي في الحياة السياسية. ويمثل تطوير سياسات بديلة في الإطار المعقد للانتفاضة مطلبا سهلا، إلا أنه مجال واسع ليس فقط للمشاركة النسائية والمساواة بين الجنسين، بل من أجل إنجاز التحول الديمقراطي في دولة فلسطينية مستقلة.
* نشر هذا البحث باللغة الإنجليزية في عدة دوريات أجنبية، وهذه الترجمة معدة خصيصا لطيبة.
1 – تتقدم الباحثتان بالشكر إلى زميلتهن في مركز الدراسات النسوية، ريما حمامي، التي أمدتهن باقتراحات وملاحظات قيمة.
٢ – المنطقة ( أ ) تقع تحت الحماية الفلسطينية المطلقة وهي تتضمن مدن الضفة الغربية – باستثناء القدس الشرقية – في إطار حدود ضيقة وقطعتين منفصلتين من قطاع غزة: المنطقة (ب) تقع تحت سلطة فلسطينية – ىإسرائيلية مشتركة وهي تتضمن أغلبية قرى الضفة الغربية: والمنطقة (ج) تقع تحت سلطة إسرائيلية مطلقة وهي تضم كل المستوطنات والمنشآت العسكرية والطرق الجانبية.
3 – هذه الأرقام تتضمن 13 فلسطينيا يحملون الجنسية الإسرائيلية قتلتهم الشرطة الإسرائيلية في أكتوبر ۲۰۰۰.
4 – نشكر مركز القدس للإعلام والاتصال، وبالأخص د. لاما جمجوم، لإمدادنا بهذه البيانات المهمة والمقسمة على أساس النوع حول استطلاع الرأي الذي قام به المركز ضمن سلسلة استطلاعات الرأي والمتوافرة على موقع المركز على شبكة الإنترنت www.jmcc.org