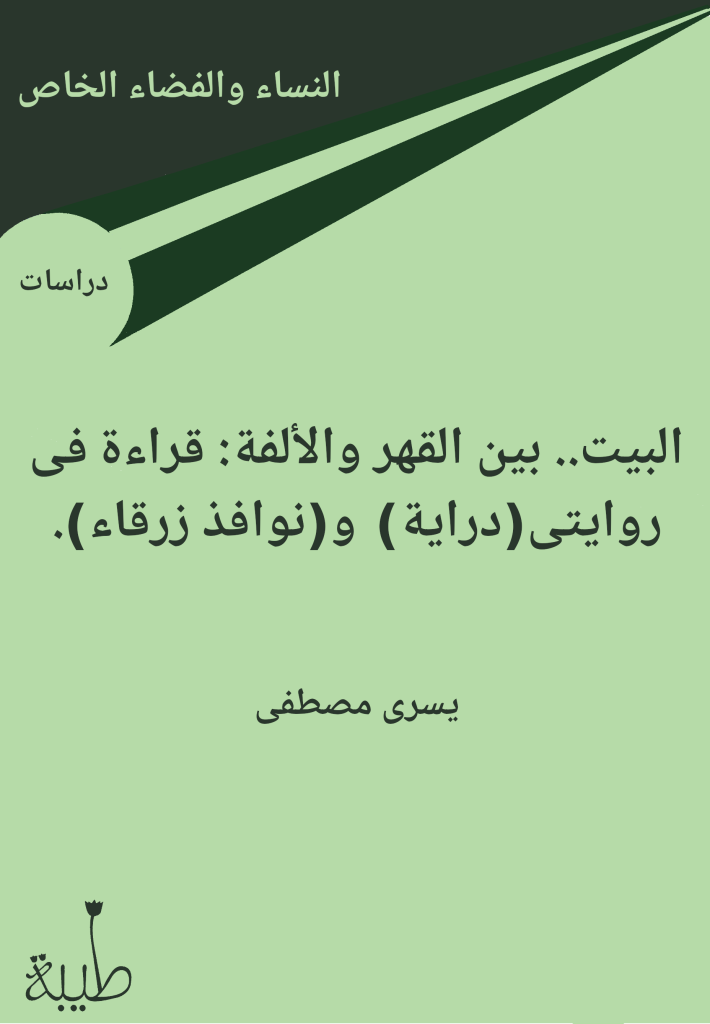
البيت.. بين القهر والألفة:
قراءة في روایتی: «دارية» و «نوافذ زرقاء»
هل ثمة حيز يمكن أن نصفه بالخاص والحميمي أكثر من البيت ؟ إنه المأوى الذي نحتمى فيه من عالم يقتحم خصوصيتنا. فما أقسى أن يعيش الفرد بلا بيت يأويه، وما أقسى أن يعيش الفرد في بيت لا يأوى مشاعره وأحاسيسه. إنها الألفة التي قد تغمر الحيز بين عتبة البيت ونوافذه، ففي حضورها تكون عتبة البيت دخولا إلى عالم الدفء والحماية، وفي غيابها تكون نوافذه عتبات النظرات الحالمة بالتحرر والانعتاق. ويظل البيت الحيز اللصيق بخصوصيتنا، وتظل الذاكرة تستدعى البيت بوصفه: «ركننا في العالم… كوننا الأول.. كون حقيقي بكل ما في الكلمة من معنى».
ولعل من أفضل ما قيل عن البيت هو ذلك الكتاب القيم والشاعري للمفكر الفرنسي غاستون باشلار، فهو قطعة فنية تضعنا أمام رؤية للبيت تتجاوز هندسة العمارة إلى هندسة الذاكرة. فهو كتاب في الخيال الذي يصنع المأوى، خيال ساكن البيت الذي يبنى «جدرانا من ظلال رقيقة، مريحا نفسه بوهم الحماية– أو، على العكس. نراه يرتعش خلف جدران سميكة متشككا بفائدة أقوى التحصينات. باختصار، وطبقا لجدل لا نهائي فإن ساكن البيت يضفى عليه حدودًا. أنه يعيش تجربة البيت بكل واقعيتها وحقيقتها من خلال الأفكار والأحلام.. ». وأهمية هذه الرؤية أنها تحترم تلقائيتنا إزاء البيوت، وتجعل من الذاكرة إبداعًا خاصًا.
ولكن البيت بجدرانه وغرفه الرحبة أو الضيقة، بنوافذه التي تطل على عالم نراقبه ويراقبنا، هو حيز ثقافي، فهو ليس فراغا نسكنه، وإنما أيضًا ثقافة وقيما تسكننا، إن عمارة البيوت مصممة هندسيا وثقافيا. كل هذا يجعل من البيت حيزا غير محايد وربما غير مأمون العواقب، فبقدر ألفته كحيز خاص، فهو أيضًا مجارفة، تلك المجارفة التي تعيشها فتاة تنتقل من بيت الأب إلى بيت الزوج. فمما لا شك فيه أن علاقة المرأة بالبيت في ثقافتنا علاقة خاصة جدا. فالمرأة هي الأكثر التصاقًا بالبيت بحكم الشروط الثقافية السائدة. تلك الشروط التي فرضت على المرأة أن تكون كائنا بيتيا، ولم تفرض على البيت أن يكون حيزا نسويا. وهذا هو موضوع هذا المقال الذي يتناول «الإحساس» بالبيت في روايتين لكاتبتين مصريتين هما سحر الموجي وروايتها «دارية»، وابتهال سالم وروايتها «نوافذ زرقاء».
وأتصور أن استكشاف علاقة المرأة بالبيت من خلال أعمال إبداعية بأقلام نسائية، هو في الحقيقة امتلاك شيء جوهري في هذه العلاقة، أي تلقائية الحالة الشاعرية، قد تدهشنا بصدقها. فالبيت، كما يقول باشلار، «يعشق التلقائية». تلقائية الطفل عندما يرسم بيتا، فعندما «تطلب من الطفل أن يرسم بيته فإنك تطلب إليه أن يكشف لك عن أعمق حلم للملجأ الذي يرى فيه سعادته. إن كان الطفل سعيداً فسوف يرسم بيتا مريحا، تتوفر فيه الحماية والأمن، بيتا مبنيا على أساسيات عميقة الجذور». ولكن «حين يكون الطفل تعسا فإن البيت يحمل آثار تلك التعاسة».
ولم يكن لاختيار هاتين الروايتين أي مغزى يتعلق بالنقد الأدبي، خاصة وأن كاتب هذا المقال لم يكن يوما ناقدا أدبيا. كل ما هنالك أنهما يعطيان مساحة لاقتفاء أثر علاقة المرأة بالبيت. فضلا عن أنهما يقدمان نموذجين لعلاقة المرأة بالبيت. فإحساس «دارية» الحالمة بالانعتاق من بيت زوجية لم يجلب لها سوى الإحساس بالذنب والعجز، يختلف عن إحساس «بهلول» فتاة «نوافذ زرقاء» التي سلبت كل شيء خاص، بداية من اسمها وانتهاء بحلمها الأخير: البيت.
يعكس البيت في رواية «دارية» لسحر الموجى ملامح الشخصية المكبلة والمتطلعة والحالمة بشكل شفاف ومحكى ومرئي. فمنذ العبارات الأولى تضعنا الكاتبة أمام طبيعة علاقة «دارية» بزوجها فليس هناك «ما يربط هذا الرجل وتلك المرأة». تلك الحقيقة الغائبة عن داريـة المتهمة بالعجز والقصور والتي عاشت سنواتها الأولى في «حالة حب مصحوبة باعتذار دائم». تكتب «لا أفهمني» و«لا أتبين مکانی». تأتى صورة البيت منذ البداية لترسم ملامح الذات المكبلة: «هل كان من السهل عليها أن تدرك أنها عروس ورقية مجوفة من الداخل، يملؤها هواء. تتطاير فيه لحظات حنين مجهولة المصدر– غير محددة الأهداف– تنتابها أحيانًا عندما تختلى بنفسها في ظلام شرفة شقتها في ضاحية «15 مايو» في ليالي الصيف الحارة. تجلس على كليم فوق الأرض. تنظر من وراء القضبان الحديدية إلى البنايات المتلاصقة القريبة. مغلقة على ناسها والحكايا».
هذا المشهد السجنى يسكـن لاوعيها المسكون بالشعور بالذنب والذي بات كابوسا يحاصرها: «السور الحجري السميك، تعلوه أسوار شائكة، يحيط بالمكان». وتكتشف ذاتها في المكان، فيكون اكتشاف المكان كحيز للقهر، سابقا على الاعتراف بالقاهر ذاته، وهكذا تواصل بصيغة المتكلم: «أنا في زنزانة، جدرانها كالحة بلا لون. شقوق ثعبانية سوداء. تتناثر فوقها آثار أكف وأرواح مسحوقة. يجابهـني بعنف صوت لا أدرى صاحبه: أنت متهمة بالقتل العمد.. ».
غالبا ما نقاوم واقعنا بأحلام اليقظة، فنستحضر لحظات الألفة التي عشناها، والتي تأتي في الذاكرة بيوتا دافئة، تلك التي «نعيشها مرة أخرى كحلم يقظة.. »، كما يقول باشلار. وهكذا نجد دارية تتحصن بألفة في الذاكرة فتستحضر ذكرى الأم والأب الذي كان يقول لها «كوني دارية»، فيأتي حلمها بيتيا يغازل حيز الألفة القديم: «عندما أصحو يبقى معى النور الغامر، موقع السلطان حسـن والرفاعي والسكون الجميل. ودفء يد أبي. ويبقى بداخلي إحساس بسلام وسكينة وهدوء. أعيد قراءة آخر خطاباته لي. تخفق الورقات الأربع بروحه وروح أمي ونبض بيتنا القديم عندما كنا معا قبل تفرق الزمن والمسافة… يبقى أشياء معي..». إن البيت القديم هو ذلك الحيز المسيـج بالدفء والذي تقودنا إليه أحلام يقظتنا كما يقول باشلار. وهكذا نجد دارية تناجي بيتها القديم، بيت الطفولة، فتقول:
«أيتها الجدران القديمة
دثرینی
ألق على عباءة أمي الصوفية
طمئنيني أن كل شرور العالم
لا تطولني.. ».
إنها الذاكرة التي تجعل من عتبة البيت لحظة فاصلة بين الذات وشرور العالم. ولكن البيت القديم يخرج من الذاكرة عندما تلجأ إليه بعد أن تغادر بيت الزوجية، البيت واقعا محملا بتناقضات الذات المستلبة والحالمة والبعيدة لأول مرة عن أطفالها: «أدخلت داريـة حقيبة ملابسها وصندوق كتبها في غرفة أمها. طلاء الحائط قديم. مُصفر. تآكل الجدار الملاصق لباب الغرفة من تأثير رطوبة السنوات وخلو المنزل من صاحبته. قطع أثاث الغرفة تغطيها طبقات تراب العمر المنقضى. والحزن القديم الذي يعشش في الأركان. فوق صورة زفاف أمها وأبيها. تقبع بقايا الذكريات في الدولاب. فوق قطع الملابس. لم تزل رغم السنوات العشر تحتفظ برائحتها».
يتحـول البيت القديم بوجودها فيه إلى واقع، ويعود بيت الزوجية المتروك إلى الذاكرة على استحياء: «غريبة هي. هذه ليست غرفتها الواسعة ذات الأثاث العصري الأبيض. لون حلمها القديم. لكنها سرعان ما تواصل الهروب في الذاكرة الأبعد، ذاكرة الطفولة، وكأنها تطرد بيت الزوجية الرابض على عتبة الذاكرة، فتصالح بيت طفولتها، فهي: «ليست غريبة تمامًا عن الغربة التي احتضنتها سنوات استعذبت فيها الهروب من حجرتها والدخول في دفء سرير أمها ذي اللحاف الستان الوردي يزينه كورنيش رقيق على الحافة. تلبدٌ في عبق الجلد الناعـم. تحتضن الجسد الضئيل من الخلف. وتنام بعمق براءة الأيام الأولى». ويعيدها الإحساس بافتقاد طفليها إلى بيت الزوجية المستعصى على الدخول إلى حيز الذاكرة، فتتمنى لو تنتزع منه ذلك الحيز القريب من قلبها، غرفة طفليها، لتضمه إلى البيت القديم والذي تقول عنه: «إن هذا المكان لا يحوى غرفة ملاصقة لغرفتها. بها سريران. واحد لأمينة وواحد لجاسر».
وفجأة وكأن الذات الحائرة، والتي ما زالت مستلبة في الشعور بالذنب، تكتشف حقيقة ما، حقيقة مشاعرها. فيأتيهـا الوعى بالذات من على جدران غرفتها في البيت القديم، من قصيدة حب معلقة على جدران غرفتها تأتيهـا الزمن وكأنها ظلت هناك محفوظة في ذاكرة المنزل ورابضة على جدرانه في انتظار لحظة تنفذ فيها إلى وعى دارية، وها هي تأتي، فتكتشف دارية جمال وحدتها.
«جميل جدًا
أن تستيقظ في الصباح
وحيدًا تمامًا
دون أن يكون عليك أن تقول لشخص ما
أنك تحبه
في حين أنك لم تعد تحبه»
وهكذا تبدأ دارية في امتلاك وعيها وذاتهـا كذات حرة، ولكنها تمتلك واقعها، فتمارس إحساسها بالحرية في التذكر، وتذهب نحو الألفة هناك، في زمن الطفولة، تفتح نافذة الغرفة المطلة على حديقة طفولتها.. تغلق عينيها. تستنشق نفسا طويلا من الهواء المندى بزهور الذكرى. ولأن البيت القديم هو بيت بلا قيود، فإن جدرانه تفقد جدرانيتها، حيث تصبح الجدران «في بيت أبيها هواء».
تستعيد دارية ذاتها خارج جدران البيوت وتقرر ألا تسير في ظل جدار آمن، وإنما في الفضاء الرحب الذي طالما حلمت به. فهذا الفضاء هو غذاء عصفورها الحالم بأن يقتات حرية. وخارج جدران البيوت، تتحقق الذات ولكن تظل ترنو إلى الألفة، فتبحث عن الحب لا عن البيت. وتغيب البيوت وتعود إلى الذاكرة مبتورة أو مشوهة. فلا تتذكر في بيت مـن الأسرة إلا سلمـه الخارجي، وتتسـع الهوة بينها وبين بيت الزوجية:
«… أشعر بالاختناق عندما أنظر إلى صفصافـتي، متهدلة، عجوز، تخيم عليها ظلال الكآبة.. ». وما بين البيوت القديمة والفضاء الحاضر، لا تجد دارية سوى التحقق في الخيال الذي بات واقعها البديل، في الكتابة.
«نوافذ زرقاء»، رواية أخرى، بطلتها فتاة حالمة بخيول ترمـح في السماء، والحنين إلى اللون الأزرق. ولكنها في الواقع لم يكن لديها ما تملكه حتى اسمها الأنثوى فقد سلب منها ليصبح لقبها «بهلول»، بكل ما يحمله هذا الاسم من دلالة في الثقافة المصرية، دلالة الطيبة «والاختلال» العقلي، ولكن أولا، وقبل كل شيء، التهميش. تقول لأبيها:
-
برضه بتقول بهلول ؟ فيه بنت اسمها «بهلول» ؟ فيجيب:
-
بهلول یا حبیبتی، کائن جميل، بیسلى الملك ويضحك الناس. تقول:
-
یعنى لو أنا سليت الملك يعفى عن «شهرزاد» ؟
حلمت بهلول بأن تخلص شهرزاد من الملك وتحميها من سيف «مسرور»، لقد كان حلمها أبعد من ذاتها المسلوبة. لن تنجح بهلول في أن تحمى أية شهرزاد أو ذاتها من بطش أي ملك، سواء كان هذا الملك أسرتها، أو الحرب التي سلبتها ساق زوجها، أو أصحاب العمل الذين يسرقون قوة عملها، أو حتى دعاة الحريات الشخصية من بين شباب الحركة الطلابية اليساريين، فمنهم من سرق بكارة صديقتها، وهـم من سرقوا حلمها الأخير في بيت صغير يجمع بقاياها المبعثرة: زوجها ورضيعها.
بهلول فتاة رقيقة أحبت بعمق وتمردت على أهلها من أجل حبها، وتركت بيت أسرتها، ولكن بعد أن ألقت علينا بعضا من ملامحه، ذلك البيت الذي تجبر فيه الفتاة على أن تترك تعليمها وتُرحل خارج البلاد مع عريس لـم تر صورته، عمره ضعف عمرها، ذلك البيت الذي يراقب علامات أنوثتها بارتياب ولا يترك لها حيزا لتتعرف على جسدها: «كان الطرق على باب الحمام، يخترق رأسك الصغير، فتختبئ داخل عريك، منزويا في ركن الحمام، كنت مندهشـا من بدنك الذي بدأ يخرطه خراط البنات». ويفاجئها السؤال، سؤال أمها الذي تمنت لو تستدفئ داخل رحمها: «كنت بتعملى إيه عندك ؟ ردى !». وتحت وطأة السؤال يتحول عريها البرئ إلى خطيئة مبهمة.
كان على بهلول أن تترك هذا البيت ليس فقط لتمارس حقها في أن تعيش مع من تحب: «بل لأنك تبغى حياة أفضل تصنعها بنفسك، وتتحمل حلوها ومرها مع الشخص الذي اختاره قلبك..». وكان وصف البيت في لحظة الخروج كافيا لكي نستشعر ذكوريته الراكدة: «كانت رائحة الأنفاس الغاطة في النوم حتى آذان الظهر تملأ المنزل، المقاعد متباعدة في فوضى، بقايا العشاء والأكواب الفارغة تملأ المنزل، وأعقاب السجائر مبعثرة على الأرض، ساعة الحائط معطلة، حتى الجريدة ملقاة بإهمال على مقعد جانبی..». كان ذلك مشهد المنزل قبل أن تتركه مخاطبة نفسها: «أخذت نفسا عميقا وأنت تشد حمالة الحقيبة على كتفك، استدرت، ساحبا الباب خلفك وعلى عتبته، انتعلت فردتي حذائك، تاركا خلفك روحك المطفأة… ركبت حصان التمرد، ساعيا نحو حياة تصنعها بنفسك.. ».
كان خروج بهلول تمردا وحلما، ولكن التمرد قد لا يكون إلى ومضة، ومضة القرار بالتمرد، لنواصل بعدها رحلة جديدة في تفاصيل القهر والاستغلال. فقد تمردت شهرزاد لا لتتحرر وإنما لتكون شاهدة على جرائم «الملوك» بحقها وبحق أخريات. وفي العالم الفسيح الذي يسرق منها طعم الحياة في ممرات من السراب الموحش. وفي الوحدة تأتى أحلام اليقظة: «في الصباح الباكر، وكما هي عادتك يا بهلول، يأخذك الحنين إلى أحمد الدافئ وطنك وملجأك حين تدور بك الدوائر ويمزقك الشوق إلى صغيرك».
وكان مأواها حجرة بائسة في بيت للمغتربات، فلم تنعم بفرصة أن يكون لها بيت وزوجها، أحمد، غائب على الجبهة في انتظار حرب ستسرق منه ساقا، وتسرق منها الحلم بالخلاص من الاستغلال والقهر. وفي بيت المغتربات تدخل بهلول، وتقول: «ألقيت نظرة على حجرة النوم كانت السرائر خالية من الأرواح». ومن هذا المكان الخالي من الأرواح تخرج بهلول إلى عالم لا يرحم وتعود إليه من جديد ليس من حيزها وزمانها الخاص، وإنما إلى لحظات بلا معنى، خارج الزمن: «إلى الجدران التي تأويك خارج الزمن عدت يا بهلول.. حتى سريرك، ملجأك من شقاء العالم، تخشى أن تغوص في ملته الهابطة فلا تقوم لك قيامة».
هذا المكان / الفراغ الذي لا تتشكل ألفته إلا كلحظة عابرة لم تكن بالنسبة لبهلول سوی لحظة متعة في العطاء. فها هي تعيد رسم ملامح المكان متذكرة عودة زوجها من الجبهة في أجازة قصيرة ليعيشا لحظة حب قصيرة مناصفة بين الناس وبين السرير البائس: «كل هذا يهون أمام رغبته الشبقية فيك يا «بهلول» لابد أن تذهب معه إلى السينما، وفي مقعدين في مؤخرة الصالة المظلمة، يضمك إليه، يتحسسك، يقتنص قبلات، يرفع الجيبة حتى أعلى فخذيك، يفك سوستة بنطلونه الميرى ويصر أن تضغطى بيديك إلى أن تلتهب مشاعره، وعلى السرير ذي الملة الهابطة يا «بهلول» تكملان فيلمكما المثير حتى تصلا معا إلى الذروة». يذهب الزوج والشبق العابر، وتظل «بهلول» في غرفتها الخالية من الروح والنـور: «أفقت من غفوتك يا «بهلول» على بصيص ضوء يأتى من خلف الشباك، قمت حافي القدمين، أضأت النور، فغمر الحجرة ضوء أصفر، طالما اشتهيت تغییره..».
فقد الزوج ساقه في الحرب، وصارت المستشفى العسكري هي مكان اللقاء، مكان موحش وقذر، تسير «بهلول» في ممراته الموحشة لزيارة زوجها، وفي دورة مياه قذرة في المستشفى يجبرها على مضاجعته، تحت تهديد الضعف والانكسار: «انت فاكرانی مش راجل ؟». فتعود إلى حجرتها تضرب الحائط بيديها إلى أن تتورما، وتناجي نفسها: « تود لو انفتح على العالم الوسيع، وتطلق لساقيك الريح، وتجرى على العشب لتلحق بكرة الشمس الذهبية المختبئة في قلب الأفق».
يأتي بريق الأمل الوحيد لبهلول، إنه البيت، فقد خصصت القوات المسلحة وحدة سكنية لهم. «وحدة» سكنية، ذلك التعبير الهندسي الفقير للبيت، يتحول في خيال بهلول إلى ملجأ أخيـر، فيتكثف لديها الإحساس بألفة الحيز الخاص وقد مـس الفرح قلبها، وتتحدث ربما لأول مرة بضمير المتكلم: «أخيرًا، حانستقر، ويكون جوزي وابنى في حضني، أخيرًا الدنيا حست بينا». ولكن لم تكتمل فرحتها، فقد قال لها محدثها أحد «المناضلين» السياسيين: «للأسف إحنا محتاجين الشقة لعمل سياسي، فيه رفاق خارجين من السجـن ومش لاقيين مكان وبصراحة الشقة مناسبة»… تعود سريعا إلى ضمير الغائب: «مادت الأرض تحتك يا «بهلول»… انطفأت فرحتك الوليدة، ماذا يقصد ومن يحتاج من، والمكان الذي طال انتظارك له حتى تلملم بقاياك المبعثرة في شوارع القاهرة مهدد بالضياع منـك.. مكانك / عشـك الصغير، ملاذك، تحب، تكتـب، ترقص، تصمت، تتعرى، تنام، تلهو مع صغيرك، تتأمله وهو ينمو كالزرعة الخضراء أمام عينيك».
ويصل الأمر ذروته عندما تعلم أن زوجها الذي ضحت من أجله وسوف تضحى ربما إلى الأبد، الزوج الذي ضاجعها في دورة مياه قذرة، قد كتب لرفاقه توكيلاً لاستخدام الشقة / الحلم دون أن يخبرها. ينتابهـا إحساس بالخوف والعرى، وتحاصرها الكوابيس وهي نائمة في حجرتها التي بلا روح والمفتوحة على عالم القهر: «النباح يأتيك من النوافذ ولوح الزجاج تدفعه رياح الخماسين محدثا طرقًا منتظمًا».
يتشابه الفعل الأخير لكل من «دارية» و«بهلول»، فقد غاب البيت كحيز للخصوصية والألفة، وجاءت «الكتابة» كفعل خاص يبشر بالفـة محتملة ويضفى معنى على عزلة لم يـختـراها. ومع ذلك فإن هذا المشهد الأخير والذي يتشابه في الروايتين يكشف عن الاختلاف بين داريـة الحالمة بالتحقق خارج الجدران، وبهلول التي فشلت في أن تجمع أشلاءها داخل جدران أليفة.
فعلى الرغم من أن دارية بدت وكأنها سيدة ذاكرتها ومبدعة حريتها تاركة خلفها زمان ومكان اتهماها بالشعور بالذنب والعجـز، إلا أنها لم تكن كذلك فعليا، فلم يكن خيالها سوى ساحة هروب من راهنية الزمان والمكان، أي ساحة للمراوحة بين زمن الطفولة البرئ وزمن آخر يهددها. وهكذا يأتي مشهدها الأخير، وكأنه مزيد من الارتحال في الخيال والذاكرة فتفتح نافذتها المطلة على الفضاء الرحب، وكأنها تفتح نافذة روحها، فيأتيها عبق الياسمين الذي يصبح حروفا وكلمات فتسحب ورقة بيضاء وقلما، وتكتب.
أما بهلول والتي تخيلت أنها ستكون مبدعة مصيرها مع من أحبـه قلبها، فلم تكن رحلتها إلا محاولات فاشلة لاستعادة ما سُلب منها في زمان ومكان ليسا لها. فلم يكن أمامها سوى الهروب داخل جدران غرفتها البائسة، لتغلق نافذتها على زمن عزلتها وتنفصل عن الزمن الذي سلبها الحلم الأخير بحيز خاص. ولكن حتى هذا الزمن كان قد سكن جسدها المرهق والمستبعـد فأصابه باضطراب مزمن: «تحسست السخونة المبللة تحتك، أدركت أن الدورة أتتك في غير ميعادهـا كالعادة». فجاءت كلماتها صرخة صامتة وحزنا على حيز خاص لم يتحقق: «تحاول جاهدا البحث عن مفر من الحزن المتراكم داخل صمتك تمسك قلمك / حريتك الوحيدة، تخط أول سطورك. لا مكان / لا وطن».
لقد كان فعل الكتابة عند دارية مزيدا من الإبحار في الذاكرة والخيال، أما بهلول فلم تكن كلماتها المكتوبة سوى اعتراف صادم بغربة الذات في الخاص والعام، وصرخة أخيرة لذات منفية في اللامكان واللاوطن.
يسرى مصطفى: باحث في مجال حقوق الإنسان.














