التشكيل الثقافي للجنس. العمل والثقافة: تذكر تجارب العمل لدى الفلسطينيات الريفيات قبل نكبة ١٩٤٨
اعداد بواسطة:
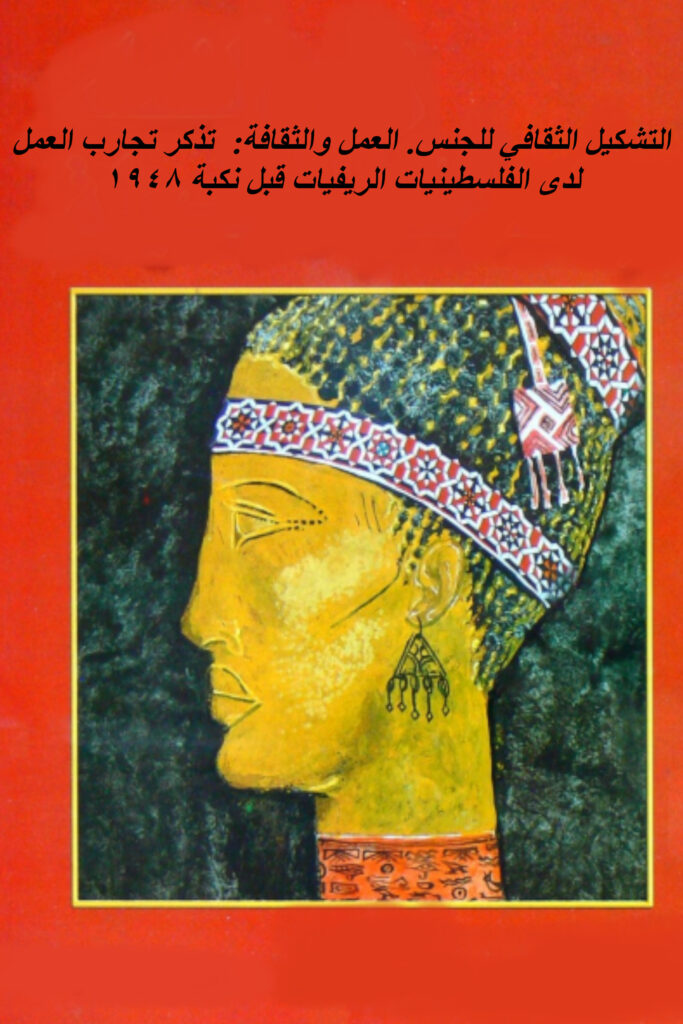
التشكيل الثقافي للجنس. العمل والثقافة:
تذكر تجارب العمل لدى الفلسطينيات الريفيات قبل نكبة ١٩٤٨
إن القول بأن الثقافة لازالت تمثل العقبة الكبرى أمام اندماج المرأة ضمن القوى العاملة الحديثة، هو قول شائع يتكرر في كثير من أدبيات العلوم الاجتماعية والتنمية، التي تدور حول المرأة والعمل في فلسطين (۱). كما أن أعمال البحث والمسح الميداني حول القوى العاملة السائدة، تشير – باستمرار – إلى الانخفاض الشديد في معدلات مشاركة المرأة الفلسطينية في القوى العاملة الرسمية؛ إذ تبلغ نسبة تلك المشاركة حوالى ۱۰%، مقارنة بمشاركة المرأة في دول المنطقة، والتي تبلغ معدلاتها 25%، وتزيد تلك النسبة على مستوى الدول النامية؛ حيث تبلغ متوسطا مقداره 39% (UNDP 1996، 38). إضافة إلى ذلك، تشير الدراسات التي تبحث في التوجهات العامة، حول عمل المرأة، أن غالبية الرجال يدعون أنه من الأفضل ألا تعمل المرأة خارج بيتها، معتمدين في ذلك على ثقل الأعراف والتقاليد، التي تعزل المرأة عن العمل خارج البيت (٢). ويتم تناول هذه الإشكالية على أنها تتوافق مع انضمام المرأة إلى قوى العمل الحديثة، وهي الظاهرة التي ينظر إليها باعتبارها أقرب إلى أن تكون ثورة غير مكتملة للمرأة، في سبيل الانتقال من العالم غير الاقتصادي (التقليدي)، إلى العالم الاقتصادي (الحديث).
وبينما نلاحظ، أن هذا النموذج قديم في أدبيات العلوم الاجتماعية، ويعكس جزئياً الجدال السائد في بدايات الكتابة النسوية في الشرق الأوسط في القرن التاسع عشر، فإننا نجد أن بعض أشكال هذا النموذج القديم، يتم إعادة التأكيد عليها، واستخدامها في الحاضر من قبل “الحركات الإسلامية“، على الرغم من أنه وعلى النقيض من أدبيات التنمية، تم تقديم ذلك النموذج على أنه يمثل الوضع الطبيعي والمطلوب. ففي الخطاب الإسلامي الفلسطيني يتم النظر إلى غياب المرأة عن نشاط السوق، لا على أنه الوضع الطبيعى والمفضل والمطلوب دينيًا، وإنما باعتباره أساسيًا في تحديد قوة، وربما مستقبل الأمة الفلسطينية (۳).
ولا تهدف هذه الورقة إلى عرض الأوضاع في الزمن المعاصر، وإنما تركز على الماضي كوسيلة لإثارة التساؤلات حول إشكالية العلاقة بين قضايا الثقافة، وتشكيل الجنس (gender)، والعمل في الشرق الأوسط. وذلك على مستوى النص المكتوب، والواقع المعيش. وتعمل هذه الورقة – تحديدًا – على تتبع كيفية تحول الممارسات المختلفة القائمة على أساس الجنس، من رجل وامرأة، وتنوع خطاب العمل في المجتمعات الفلسطينية الريفية أثناء الحماية البريطانية، وصور التغير، وإعادة التشكل في سياق مجتمعات اللاجئين، في قطاع غزة، بعد نكبة ١٩٤٨. وقد كانت أوجه عمل المرأة الريفية، وحقوقها، وأدوارها، ومسئولياتها، تمثل مجالات عملية متنوعة ومتفاوتة، إلا أنها كانت غائبة تمامًا، في بواكير الجدال الوطني، الدائر حول قضايا التشكيل الثقافي والاجتماعي للجنس والحياة العامة. وهو جدال كان مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بالنظام الطبقي. ومن الملاحظ أيضًا غياب التاريخ الاقتصادى لنشاط المرأة الريفية في تصريحات الإسلاميين المعاصرين، حول الثقافة والتراث. كما تقوم عمليات المسح والإحصاء الجارية لبحث القوى العاملة الفلسطينية، بطمس النشاط الاقتصادي للمرأة الريفية المعاصرة، وتجاهله تحت مسميات “العمل الأسرى مدفوع الأجر“.
ويتضح أن “الثقافة” لعبت دورًا هامًا وبارزًا في فرض أدوار ومسئوليات اقتصادية متنوعة، على أهل الريف، من نساء ورجال؛ وذلك فيما يتعلق بعلاقة أفراد الجنسين، تجاه بعضهم البعض وفي المفاهيم المتعلقة بتلك الأدوار. كما لعبت الثقافة دورًا محوريًا وسيطًا، في نقل التحديات التي فرضها سياق اللجوء، وواقع اللاجئين؛ وذلك على المجتمع وهويات أفراده. وكذلك على تشكل الأفراد ثقافيًا واجتماعيًا، على أساس الجنس. ومع أن الأبعاد المتصلة بقضايا التشكل الثقافي والاجتماعي للجنس في الثقافة الريفية الشعبية كانت – أحيانًا – تعترف بالمفاهيم السائدة، حول التفرقة بين الجنسين (مثل مفهوم “الثقافة“، الذي نشرته وكالات المساعدة للاجئين، وكذلك الحركة الإسلامية المعاصرة)، إلا أن تلك الثقافة الريفية، لم تجد هذه المفاهيم قريبة من واقع الفلاحين الذين لجأوا إلى ثقافتهم المتأصلة في هيكل الحياة اليومية للمجتمع الريفي، وطبيعته. وفي الوقت ذاته، نلاحظ أنه مع انهيار الهيكل المادى للحياة الريفية، في فلسطين عام ١٩٤٨، ظلت تلك الأشكال الثقافية باقية. ولا يرجع ذلك إلى “ثبات” الثقافة، وإنما إلى طبيعة اندماج الثقافة الشعبية وتداخلها في تشكيل وإعادة تكوين هويات الأفراد كذوات تنتمى إلى المجتمع، وكذلك على أساس الفروق الناجمة عن التشكل الثقافي والاجتماعي للجنس.
وقد تبين من خلال العمل الميداني، بين الجيل الأول من اللاجئات الريفيات في غزة، أن مفهوم ارتباط عمل المرأة بالأعمال المنزلية فقط، وحصره بمعزل عن أعمال الشرق، يكاد يكون غائباً، في جيل ما قبل عام ١٩٤٨. أما السؤال الذى يمكن توجيهه، إلى تلك الفئة من النساء فليس “هل كانت المرأة تعمل، خارج البيت أم لا؟، وإنما عن طبيعة العمل الذي كانت تقوم به المرأة، وأسبابه وكيفية قيامها به وكيف كانت تتصرف في نتائج وثمار عملها؟ فليس المهم – هنا – مجرد كون المرأة قادرة على القيام بأنشطة عمل مختلفة، وامتلاكها أشكالاً متنوعة من رؤوس الأموال، وتعاملها مع ظروف مختلفة وأسواق عديدة، وإنما الهام للغاية، هو أن الأنشطة التي كانت تقوم بها المرأة كانت ذات أهمية اقتصادية للأسرة الريفية. ولذا كانت معترفًا بها من قبل المجتمع، كما يتضح من خلال الجوانب المختلفة للثقافة الشعبية (على المستويات الطقسية والرمزية والمادية).
إن هذه المجموعة المعقدة من العلاقات الاقتصادية والاجتماعية التي تضع الفروق بين الجنسين – في الاعتبار – لم تتعرض للضياع أو الزوال مع نكبة ١٩٤٨، وضياع الأرض. أما المجالات الاقتصادية المحددة، لكل من الرجل والمرأة الناشئة في الحاضر شديد الاختلاف عن الماضي، فقد تم اجتيازها بالاستعانة بصور الخطاب المتعلق بالنظام المعقد النابع من قضايا التشكل الثقافي والاجتماعي للجنس، وكذلك العمل في سياق المجتمع الريفي. كما أن التأكيد على قواعد تقسيم العمل، ورؤوس الأموال، وموارد الفلاحين رجالاً ونساءً (على الرغم مما تعرضت له من تحولات جذرية)، لم يكن يدور حول معركة المرأة من أجل الاحتفاظ ببعض حقوقها الاقتصادية، وإنما كان – أيضًا – جزءاً من الأسلوب الذي انتهجته فئة اللاجئين من الفلاحين، في سبيل مواجهة التحديات التي تواجه هويتهم الاجتماعية في سياق حياتهم كلاجئين.
كان الوضع الزراعي للريف في جنوب فلسطين، خاضعًا للأسر الريفية صغيرة الأملاك، وذلك خلال السنوات الأخيرة من الحماية البريطانية على فلسطين. ونظرًا إلى التوسع الكبير والسريع في التعامل مع الأرض كسلعة، وعدم اكتمال مفاهيم الخصخصة حينذاك، وجدت الأسر نفسها متداخلة في العديد من علاقات حيازة الأراضي (٤). وعلى الرغم من أنه لا توجد حالة نمطية محددة، فإننا نجد أن الفلاحين كانوا يتملكون جزءاً من أراضيهم، على أساس الملكية الحرة (خاصة الأراضي المزروعة بالخضر وأشجار الفاكهة، التي غالباً ما كانت تحيط بالقرية مباشرة، أما الأراضي الأبعد منها، خاصة أراضى زراعة الحبوب فكانت تخضع للتعدد ونظام “المشاع“). وكان أهل القرية يتشاركون في المحصول مع غيرهم من الأسر في حالة زيادة الأرض عن العمالة، أو يشاركون غيرهم في حالة قلة مساحة الأرض بالنسبة إلى العمالة. وقد كانت ظاهرة قلة الأراضي، وعجزها عن توفير ما يلزم الأسرة من أجل الإنتاج الزراعي يمثل مشكلة شائعة، مثله في ذلك مثل عدم تملك الأسر لأية أراضٍ على الإطلاق، إلا أن عدم كفاية العمالة كان يمثل قضية كثيرًا ما يشار إليها.
ويلاحظ أنه في سهول السواحل الجنوبية لفلسطين، كان هناك نوعان سائدان من الإنتاج الزراعي. ففي القرى الداخلية، قامت زراعة الحبوب اعتمادًا على مياه الأمطار. أما القرى الساحلية، فقد قامت بها زراعة الفاكهة والخضر اعتمادًا على الري المنظم. وهي زراعة تهدف إلى تسويق الإنتاج في المراكز الحضرية المحلية. ومما هو معروف – تاريخيا – أن الحبوب كانت تمثل المحصول الأساسي؛ كمصدر للرزق، وكانت تمثل المحصول الرئيسي الذي تدفع عليه الضرائب، ويعتمد عليه في عمليات المقايضة والتبادل، كما كانت الحبوب هي المصدر الرئيسي للغذاء في الريف. وهكذا ظلت الأسر الريفية خلال الحماية البريطانية، معتمدة على إنتاجها الشتوى من الحبوب؛ بحيث يتم تخزين جزء من ذلك الإنتاج؛ لتوفير احتياجات الأسرة طوال العام، بينما كان يتم تقدير جزء آخر منه للعمالة الزراعية المشاركة في الحصاد، كمقابل لعملهم. أما الباقي فكان يتم توجيهه إلى التجار في المدن؛ لتسديد القروض، وتوفير المال اللازم لدفع الضرائب، ومتطلبات العام التالى (Kamen، 1991، 199).
وكانت الحبوب – أيضًا – هي وسيلة المقايضة الرئيسية بالنسبة إلى الأسر الريفية؛ وذلك للحصول على السلع اللازمة، كالشاي والأقمشة والصابون من السوق المحلية، وهو ما سيتم تناوله في الصفحات التالية.
وبينما احتفظت زراعة الحبوب بأهميتها للأسر الريفية عبر البلاد، فإنها ظلت تمثل المحصول الرئيسي في مناطق السهول الداخلية؛ حيث لا توجد مياه تقوم عليها زراعة الري. أما في القرى الساحلية، فكان إنتاج الحبوب موجهًا – في الأساس – نحو الاستهلاك المحلى للأسر الريفية نفسها، في حين كانت زراعة الفاكهة والخضر، هي وسائل الدخل الأكثر أهمية؛ حيث تمتع الفلاحون بوفرة مياه الري، ووجود الأسواق في المدن القريبة التي يسكنها عدد كبير من الناس، مثل يافا ومجدل والرملة واللد (Baldensperger 1907، 272; Baldensperger 1918. 21). وقد كان لاختلاف أنواع الحاصلات الزراعية تأثيره على متطلبات العمل، فزراعة الحبوب تتطلب عملاً مكثفًا، ولكن على مدى فترات زمنية قصيرة، أثناء الحرث والحصاد، فكان مقدار العمل والجهد المطلوب الحصاد الحبوب في مساحة ٤٠ دونم من الأرض الزراعية، يفوق قدرات أسرة ريفية واحدة تتملك مثل تلك المساحة. ومن هنا كان اللجوء إلى الاستعانة، أثناء فترة الحصاد، بالأيدى العاملة الأجيرة (من الفلاحين الذين لا يمتلكون أراضي خاصة بهم، بما في ذلك الفلاحات). أى أن زراعة الحبوب كانت تتطلب أيادي عاملة كثيرة، ولكن لفترت زمنية قصيرة من العام. وكانت الدورة الزراعية في القرى الداخلية تبدأ مع بداية سقوط الأمطار، في شهر نوفمبر، وتنتهى في أوائل الصيف، مع انتهاء موسم الحصاد. أما في القرى الساحلية، فكانت زراعة الحبوب، تمثل جزءاً من الموسم الزراعي، حيث تنشغل الأسر الريفية، بالزراعة المستمرة طوال العام، وبذلك كان الموسم الزراعي ممتدًا، والعمل مكثفًا. ولم يكن توقف النشاط الزراعي، يزيد على فترة قصيرة، في موسم الخريف، ما بين نهاية حصاد الكروم والتين، وبداية الشتاء، حين تبدأ عملية البذر. وقد كان لاختلاف متطلبات العمل والأيدي العاملة، تبعًا لطبيعة الحاصلات الزراعية، أثره في تقسيم العمل، بين الرجل والمرأة، على أساس الجنس، وأثره – كذلك – في الوسائل المختلفة والمتباينة، التي حصلت بها المرأة على مصادر مستقلة للدخل والمعيشة. فقد كان عمل المرأة في مجال إنتاج محاصيل التسويق ضرورياً على مدار العام، في القرى الساحلية، بينما كان نصف العام متاحًا للنساء في السهول؛ لإيجاد أشكال مستقلة من الإنتاج؛ بما يحقق لهن دخلاً في فترة الكمون الزراعي.
إن الأنماط المحددة للنشاط الزراعي الذي تمارسه المرأة، كانت تخضع لعوامل متعددة، مثل مساحة الملكية، ونوع المنتجات الزراعية، وحجم الأسرة، وأعمار أفرادها؛ إذ كان تقسيم العمل في الأسر الريفية يعتمد على عنصري الجنس والعمر. فكان على البنات، وزوجات الأبناء، القيام بدور رئيسي في أعمال الحقل، بينما تمتعت النساء الأكبر سنًا بإمكان التركيز على الأعمال والمهام المنزلية.
ويمكن ملاحظة أهمية عمل المرأة فيما يتعلق بارتفاع معدلات سن الزواج عند المرأة (خاصة في سياق الإنتاج؛ من أجل التسويق في المناطق الساحلية)، وسهولة زواج الأرامل والمطلقات الشابات، كزوجات ثانيات لأزواجهن – (وهما ظاهرتان تعرضتا لتغيير كبير، في جيل بنات وحفيدات تلك الأجيال السابقة؛ وذلك بين اللاجئين الفلسطينين في قطاع غزة).
إن تقسيم العمل تبعاً للجنس في مجال إنتاج المحاصيل الزراعية، كان أمراً واضحاً وجلياً. فكان الرجال يقومون بعمليات الحرث بينما كانت النساء تقمن بالبذر فيما يتعلق بأعمال إنتاج الحبوب. أما في فترة الحصاد، فكان على النساء قطع المحصول وجمعه في أكوام، ثم يقوم الرجال بعملية درس الحبوب، بينما تقع مهمة غربلة الحبوب، وتنقيتها على النساء. وقد كان ذلك التقسيم الواضح للعمل، في إطار إنتاج النوع الواحد من المحاصيل الزراعية، من الأشياء التي تتم الإشارة إليها باستمرار أثناء لقاءات العمل الميداني. ومع ذلك، كانت تلك القواعد تخضع للتغيير والتجاوز في حالات نقص الأيدى العاملة؛ حيث ذكرت بعض النساء، قيامهن بحرث الأراضي التي تملكها الأسرة. وفيما يختص بزراعة الكروم – على سبيل المثال – نلاحظ أن الرجال كانوا يقومون برش وتهذيب أشجار الكروم، بينما كانت النساء تقوم باستخراج الجذور والحصاد، وجمع ما سقط أثناء التقليم والتهذيب.
إن التقسيم الحقيقي للأدوار بين الجنسين قام حول ملكية وسائل الإنتاج، وأنماط التسويق. فقد كان رب الأسرة – رأس العائلة – في العادة، مالكًا للأرض ومسئولاً عن المحاصيل الأساسية، كمصدر للمعيشة، ومجال للتسويق. وعلى الرغم من دراية الفلاحات بحقوقهن، وما ورثنه من أراض زراعية، إلا أنهن نادراً ما طالبن بها، بل تنازلن عنها لصالح أشقائهن – الرجال – في مقابل حصولهن على مساندتهم الدائمة لهن (5). وقد ذكرت مجموعة من النساء، أن التنازل عن ميراثهن لأشقائهن، كان في صالحهن، على سبيل تقديم الهبات، ولضمان بقاء التراث العائلي، والحصول على المساندة والتأييد. ومن ناحية أخرى كان في إمكان الأرملة – في أواسط عمرها – التي مات عنها زوجها تاركًا لها ابنًا واحدًا، أن تظل بلا زواج، وأن تتحكم في الأرض وترعاها، إلى أن يتولى ابنها الزمام (٦). وفي حالات أكثر، كانت المرأة تتمكن من الحصول على قطعة أرض بشرائها؛ وذلك في حالة الريفيات الثريات (الفلاحة التي تزوجت من أحد ملاك الأرض المحدثين)، حيث تتمكن الواحدة منهن من شراء الأراضي وتملكها من “المهر” الذي حصلت عليه بزواجها (۷).
إن مثل هؤلاء النساء، ممن لم يشتركن في عملية الإنتاج – بشكل مباشر – عادة ما استعن بمساهم في المحصول يشارك بعمله. وأخيرًا، تجدر الإشارة إلى بعض الدلائل، التي تشير إلى قيام “زواج البدل“، الذى كان يقوم على تبادل الأرض بين عائلتين، مقابل النساء. ويشير ذلك، إلى أنه على العكس من الافتراض الشائع، بأن زواج البدل كان يحرم المرأة من أي مصدر للأمان (لما يتضمنه زواج البدل، من حرمان المرأة من مهرها)، إلا أن المرأة كانت تحصل من خلاله على صور أخرى من الملكية، بدلاً من الأموال والنقد.
الأسواق ونظام المقايضة والبدل
كانت مسئوليات الرجل تدور حول ضمان رأس المال والعمل الضروري للزراعة؛ من حيث تنظيم شئون العمالة، والتفاوض مع التجار، حول القروض والأسعار. وكانت المحاصيل الآتية من القرى الجنوبية توجه إلى التجار في يافا، وكان تسويقها يقع في أيدي الرجال الذين تولوا شئون الحصول على القروض من المرابين والتجار، والتفاهم بشأن تمويل المواد الأساسية اللازمة للزراعة في السنوات التالية، وضمان وسائل نقل المحاصيل، وتسديد الديون، وجمع الدخل في نهاية موسم الحصاد. وفي مقابل تلك المحاصيل التي يتم الاعتماد عليها في الإعاشة والتسويق، كان للمرأة حقوقها التسويقية. فقد كان التسويق المحلى لفائض الإنتاج يقع – مباشرة – تحت سيطرة المرأة، حيث كانت مدينة “مجدل“، تمثل سوقًا مركزية. وكانت النساء تقمن بالبيع التجار (وعادة ما كان المنتج هو عبارة عن البشائر الصغيرة، لبعض الفواكه والخضر)، وكذلك تقمن بالبيع – مباشرة – دون وساطة التجار، كما كانت النساء تقمن بالمقايضة والمبادلة مع بعض الباعة، مقابل الحصول على بعض الأشياء الخاصة بهن، ولتوفير الضروريات المنزلية. ومما هو جدير بالملاحظة، أن المنتجات التي قامت النساء ببيعها كانت جزءاً من الإنتاج العائلى، ولم تكن محاصيل أنتجتها المرأة وحدها، أو حتى محاصيل ناتجة عن أرضها الخاصة. وقد قامت النساء بالإشارة إلى ذلك، لا على سبيل أنه حقها، وإنما لحاجتها إلى البيع؛ كي تتمكن من الشراء. وهكذا، ارتبطت عملية البيع بشكل مباشر بالشراء: “فالمرأة تأخذ عدة أرطال من القمح لحاجتها إلى الإنفاق“، أى أن المقايضة وتبادل السلع، كانا هما الهدف الأساسي والمباشر، لقيام المرأة بنشاط تجارى وتسويقى. وكانت النساء تقمن باستبدال تلك المحاصيل في السوق المحلى – عادة – في مقابل الحصول على احتياجات الأسرة (من زيت وبن وحلوى للأطفال)، وكذلك الأقمشة والخيوط، أى الاحتياجات الخاصة بالنساء.
ومن الملاحظ أن “اختيار” ما يجب شراؤه، كان يقع ضمن مسئوليات المرأة، وهو ما يتضح من خلال حديث النساء عن “البيع والشراء“. وتشير علاقة المرأة بالسوق، وحقها في بيع الفائض من الإنتاج، إلى تمتعها بحق تقدير مقدار دخل الأسرة بنفسها؛ اعتمادًا على عملها ودورها في عملية إنتاج السلع الزراعية الاستهلاكية الرئيسية.
إن قيام النساء بالمقايضة، وبيع فائض الإنتاج الأسرى، في مراكز السوق المحلية، يرجع كما يشير عدد من الباحثين والمعلقين من بدايات القرن العشرين (بما في ذلك Granqvist ذاتها)، إلى أن الرجال لا يرون وهم يحملون أى شيء أبدًا في الريف، بينما يمكن رؤية النساء حاملات إنتاجهن في الطريق إلى السوق (۸). والأهم من ذلك، هو أن الفلاحات اللاجئات في قطاع غزة، تدعين أن ملاك الأرض من رجال الريف، لا يقومون بـ “حمل” أي منتج أبدا، كما أنهم لا يمارسون البيع على الإطلاق، فالحمل والبيع هو عمل المرأة.
وإضافة إلى حقوق النساء أعمال السوق، ومشاركتهن في البيع والشراء، كان لهن دخل – أيضًا – من رأس مالهن الخاص، الذي يتمثل – تحديدًا – في تربية الحيوانات. فقد كانت تربية الحيوانات، خاصة الدواجن، تعتبر ضمن مسئوليات وأملاك المرأة (9). ففي القرى الساحلية؛ حيث يطول الموسم الزراعى، كانت المرأة تقوم بتربية بعض الدواجن؛ بهدف استخدامها لاستهلاك الأسرة، كما كانت تستخدمها – أحيانًا – كوسيلة للمبادلة بسلع أخرى. أما في القرى السهلية؛ حيث يقصر موسم الزراعة، لعبت تربية الدواجن – التي تقوم بها المرأة – دوراً أساسياً في اقتصاد الأسرة، وكانت تلك العملية تتم – في الأساس – بهدف المبادلة بسلع أخرى، وعلى نطاق أوسع كثيرًا (١٠).
وكانت الحيوانات ملكاً للمرأة، تحصل عليها من مالها. وتبعاً لمهارتها ونشاطها، كان بإمكانها مضاعفة إنتاجها، ورأس مالها، من الحيوانات. وقد كان البيض من العناصر التي شاع استخدامها في المقايضة، وكان يعتبر من السلع الثمينة أثناء الحماية البريطانية؛ حيث كانت المرأة تحمل عدة بيضات إلى السوق؛ لمبادلتها بسلع أخرى هي في حاجة إليها.
“الثقافة السائدة” فيما يتعلق بالنشاط الإنتاجي للمرأة الريفية
يمثل إنتاج الدواجن مجالاً يوضح مدى التعقيد والطبيعة التبادلية لأدوار المرأة الإنتاجية وحقوقها في إطار الأسرة. فقد كانت الدواجن تمثل رأس المال الخاص بالمرأة ومنتجًا يصلح الأعمال المقايضة على مستوى بسيط، كما كانت سلعة تقوم المرأة ببيعها لتجار يافا المتجولين لصالح معسكرات الجيش البريطاني (۱۱).
وكان البيض يمثل طعامًا احتفاليًا؛ فنادرًا ما كان يتم تناول البيض، واستهلاكه بانتظام، وإنما يتم مقايضته أولاً بأول، فيما عدا الفترة التي تسبق موسم الأعياد في شهر إبريل، خاصة “خميس البيض“، حيث كان يتم جمع البيض، وتخزينه قبلها. أما الدواجن ذاتها، فكانت تمثل طعامًا يتم تقديمه في المناسبات وخاصة عند تكريم ضيف خاص، وكان يتم إطعام الدواجن، من مخزون الحبوب الخاصة بالأسرة. ومن هنا، كان حق المرأة في الاستفادة من العمل الذي تقوم به في سبيل هذا الإنتاج. وفي الوقت ذاته، الذى كان يتم فيه اعتبار الدواجن ملكًا للمرأة، فإنها كانت تستخدم لتوفير احتياجات الأسرة بأكملها، وتقديمها كوجبات للاحتفاء بضيوف يحلون على الأسرة، وكذلك تقديمها هدايا في الاحتفالات المختلفة المرتبطة بالأعياد التي كانت تمثل مناسبات هامة في الثقافة الريفية (١٢).
ويدل ذلك، على مدى قصور وجهة النظر التي تحدد دور المرأة، كواحدة من الأيدى العاملة في الأسرة، أو تضعها على النقيض من ذلك، في إطار نمط “الرجل الاقتصادي” المتفرد، أى نموذج “المقاول“، الساعى إلى تحقيق المكاسب الشخصية، وجمع الثروات. أما الطريق الذى انتهجته المرأة، واختارته (“الاختيار” هو اللفظ الذي تستخدمه النساء في هذا السياق)، والذي يعتمد على الاستعانة برأس المال الخاص بها، من أجل الأسرة بأكملها، فإن مكانة الأسرة الاقتصادية والاجتماعية، بل والرمزية، كانت تشير إلى أن المرأة كانت تعتبر نفسها، كما كان المجتمع ينظر إليها أيضًا، على أنها شريك منتج في عملية الإنتاج الاقتصادي والاجتماعي للأسرة الريفية، بصورة يكاد يستحيل إدراكها من خلال سياق الزمن الحالى. إن حق المرأة الريفية، وقدرتها على امتلاك رؤوس الأموال والإنتاج، وكذلك اختيار كيفية توزيع السلع وتسويقها، والتصرف في عائد هذا الإنتاج في إطار الأسرة، إنما يشير إلى أن المرأة كانت تتمتع بسلطة اقتصادية واجتماعية، أثناء الحماية البريطانية، وهو وضع تعرض للطمس والاختفاء بفعل إعادة الترتيب “الحديث” لنظام الأسرة.
ويتضح – مما سبق – أن المرأة الريفية على اختلاف ظروفها الاقتصادية وتنوع فئاتها العمرية، قد تم “تعويضها” بطرق متنوعة ومتفاوتة عن عملها وجهودها، في سبيل الإنتاج الزراعي داخل الأسرة. والأهم من ذلك، هو أن حصول المرأة على رأس المال المستقل، الذي يحقق إنتاجًا، كان يمثل عنصرًا محوريًا، في شبكة العلاقات الإنتاجية داخل الأسرة، وكان يتضمن مجموعة من الحقوق والواجبات المتبادلة في إطار الأسرة الواحدة. ولم تكن هذه الحقوق والواجبات اقتصادية بحتة، وإنما كانت متداخلة مع مجموعة من العلاقات الاجتماعية والإيديولوجية (علاقات النساء بأشقائهن، وكرم الضيافة، والاحتفالات الجماعية بالموالد). وهكذا لم تكن الأنشطة التي تقوم بها المرأة مجرد “حق” من حقوقها، ولا شكل من أشكال المشاركة الاقتصادية الهامة في تحمل مسئوليات الأسرة فحسب، وإنما كانت – أيضًا – تمثل جزءاً أساسياً مكونًا لشبكة العلاقات الاجتماعية والثقافية للحياة الريفية كلها.
ما الذي حدث لتلك الأنظمة المعقدة للعلاقات الاقتصادية والاجتماعية الخاضعة للتشكل الثقافي للجنس عندما فقد الفلاحون الفلسطينيون أراضيهم، وصاروا لاجئين في قطاع غزة، عام ١٩٤٨؟. بدايات ذلك الوضع الجديد – ومثلما هي الحال مع اللاجئين عادة – قامت تلك الأسر من الفلاحين اللاجئين باستهلاك رؤوس أموالهم؛ فقامت النساء ببيع عملاتهن المعدنية، وكذلك تصرفت الأسر التي تمكنت من جر حيواناتها (الحمير المستخدمة للركوب، والانتقال، وغيرها من الحيوانات) ببيعها (۱۳). فالسرعة والفزع الذى صاحب رحيل الفلاحين من أراضيهم (مع القصف الجوى المتواصل، على منطقة الساحل الجنوبي لفلسطين حينذاك)، لم يدع لمعظم الأسر اللاجئة فرصة لحمل أملاكهم، فيما عدا حاجاتهم الأساسية، من ملبس ومفروشات. ومع قيام نظام توزيع التموين الغذائي بانتظام، من قبل طائفة الكويكرز Quakers، ثم مؤسسة UNWRA، في عام ١٩٥٠، أخذ نظام جديد لتقسيم العمل بين الجنسين في الظهور بين الأسر الريفية اللاجئة. ومما هو جدير بالملاحظة أن كلا من الكويكرز وUNWRA، قاما بتسجيل بيانات الأسر طبقاً لمفاهيمهم الخاصة بالأسر، أي أن تصنيف الأسرة الفلسطينية كان يتم على أساس أنها تتكون من رجل واحد يمثل السلطة الأبوية، وهو الذي يعمل لكسب رزق الأسرة، ومجموعة النساء، والأطفال التابعين له (١٤). وبالتالي، كانت الأسر تسجل تحت اسم “الرجل الأبوى“، وكانت تحصل على نصيبها من التموين عن طريقه ويمجرد حصوله على عمل مريح (يزيد قليلاً على القيمة النقدية للتموين)، يفقد هو وأسرته التي يعولها نصيبهم من التموين. ونجد أن إبراهيم سكيك – المؤرخ الاجتماعي لقطاع غزة – يذكر مدى خوف اللاجئين من فقدان حقهم في التموين، ويراه مبررًا لخروج اللاجئات الريفيات إلى العمل في الخمسينيات (١٥). وقد قام إبراهيم سكيك بإلقاء ظلال من خبرته المدنية على أهل الريف، تلك الخبرة التي تمثل واقعًا كانت المرأة فيه غائبة عن الأدوار الإنتاجية، كما كان – في الوقت ذاته – عاجزًا عن رؤية المرأة الريفية تلعب دورًا أساسيًا في المشروع الحداثي الذي يدخل امرأة الطبقة المتوسطة في غزة، إلى حيز العمل – وهى الحركة التي كان إبراهيم سكيك نفسه، يعبر عن مساندته لها.
وقد قامت اللاجئات الريفيات والأسر الريفية، بإعادة تشكيل العديد من صور العلاقات الانتاجية، وصياغتها تبعًا للسياق الجديد، وذلك على الرغم من الغياب التام لمصادر الإنتاج التي كانت تعتمد عليها الأسر الريفية، ويقوم عليها إنتاج المرأة الريفية. أما الرجل، وخاصة الفلاح صاحب الأرض سابقًا، فلم يعد لديه في معظم الأحوال مجال للعثور على ما تطلق عليه الثقافة الريفية العمل “المحترم والشريف“، والذي كان يتطلب أرضًا يملكها، وعملاً يقوم به بنفسه ولنفسه، وليس أجيرًا لدى الآخرين. وهكذا أصبح هذا الفلاح – السابق – يقوم بدور اقتصادي واحد، هو ضمان التموين لأسرته. وتعلق معظم اللاجئات الريفيات – من زوجات وينات ذلك الجيل الأول، ممن فقدوا أملاكهم – على هؤلاء الرجال بوصفهم لا يفعلون شيئًا، سوى قضاء بقية حياتهم، جالسين بلا عمل.
وعلى النقيض من ذلك، يلاحظ أن الأدوار الإنتاجية للنساء في السابق، وأساليب تعاملهن في إطار الأسر الكبيرة، يشيران إلى تعرض هذه الأدوار للتكيف، في إطار الواقع الجديد، وكذلك قدرة النساء – في رأيى – على التكيف بشكل عام. فقد توجهت كثير من النساء إلى تولى أعمال شبيهة، بما كان يفرضه تقسيم العمل بين الجنسين، في قراهم بالسابق. ومن هنا صارت أكثر أشكال العمل شيوعًا بين اللاجئات من الريف، هو الاتجار البسيط في المنتجات الزراعية؛ إذ قامت النساء بشراء المنتجات من فلاحى غزة المحليين، ثم بيعها في معسكر اللاجئين. أما “القيمة المضافة“، فترجع – جزئياً – إلى قيام النساء بنقل تلك المنتجات بأنفسهن، سيرا على الأقدام من الحقول الزراعية البعيدة، إلى مركز سوق المدينة. وعلى الرغم من تشابه ذلك مع أنشطة التسويق التقليدية للمرأة الريفية، فإن القيام ببيع السلع الزراعية، بدلاً من بيع فائض الإنتاج الذاتي، يقوم – بالطبع – على علاقات اقتصادية مغايرة تمامًا. فشراء السلع من الفلاحين، ثم بيعها للاجئين، إنما يعني تحول المرأة في الواقع، إلى “تاجرة“، وهي علاقة اقتصادية كانت – في السابق – حكرًا على الرجل. ولذا ظلت أوجه النشاط تلك توصف بأنها “بيع وشراء“، وهو المسمى ذاته الذي كان سائدًا من قبل في قراهم. أما الدخل الذي يضمنه هذا العمل فظل ملكًا للمرأة، تنفقه كما تريد وكان ينفق آخر الأمر، على احتياجات الأسرة، وقد نتج عن قيام علاقات طويلة المدى بين اللاجئات والفلاحين في غزة (ونجاحهن – في الوقت ذاته – في ادخار مبالغ مالية من عملهن هذا)، أن قامت هؤلاء اللاجئات في بعض الحالات، بعقد اتفاقات مشاركة في المحصول، مع بعض الفلاحين المحليين من الرجال.
وليس هنا مجال للخوض في تفاصيل أوجه النشاط الاقتصادي الذي انضمت إليه المرأة، أو عرض مدى علاقة ذلك النشاط بالأدوار السابقة للمرأة، أو ما أدت إليه فيما بعد، من ظواهر جديدة، مثل انضمام المرأة إلى العمالة بأجر، عن طريق القيام بحصاد الأراضي الزراعية، وكذلك تهميش إنتاج الدواجن، ليصبح موجها إلى إشباع حاجات الأسرة فحسب، بل إن عملية بيع المنتجات الزراعية، وتفاوتها تبعًا للاجئين أنفسهم، تشير كلها إلى أن الأدوار الاقتصادية للمرأة، وحقوقها، وأنشطتها، ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالمفاهيم الثقافية، والحقوق، والهويات الاجتماعية، داخل كل مجتمع. إن اختفاء مثل هذه العلاقات الاقتصادية لا يؤدى إلى مجرد تهميش النساء، وتحديد دور المرأة، في إطار الحياة المنزلية، وإنما ينعكس – بشدة – على تعبير المجتمع عن ذاته.
إن المفهوم الذي يحدد عمل المرأة، بدورها في البيت؛ كعنصر غير فعال اقتصاديًا، هو مفهوم ثقافي حديث، خاصة بالنسبة إلى طبقات الفلاحين الذين يوصفون بعامة الشعب. وقد كان من نتائج ذلك التحول، حدوث حالة “نسيان تاريخي“، إضافة إلى عدم القدرة على إدراك العلاقات الاقتصادية، التي كانت قائمة في السابق بين أدوار الجنسين في الأسر الريفية خارج الواقع الحديث، الذي تسود فيه سلطة الرجل، وخضوع المرأة واعتمادها عليه. وقد تضمنت هذه العملية – جزئياً – تكوين هويات جديدة، وذوات حديثة، تعمل على تفسير التدين، والاحترام بعزل المرأة عن حركة السوق، واعتبار الرجل العامل مسئولاً وحده عن مصلحة الأسرة، وشئونها الاقتصادية.
وجدير بالذكر، أن التأكيد على أن تلك الثقافة الحديثة – الداعية إلى بقاء المرأة عالة اقتصادية – هي جزء من طبيعة مفهوم الثقافة، في كونها ثابتة لا تتغير عبر التاريخ، هو تأكيد لا يرجع إلى مجرد عمليات تأريخ غير دقيق، أو إلى غياب أدوار الفلاحات والثقافة الشعبية، في كتابة تاريخ فلسطين، وإنما هو ناتج – أيضًا – عن الكيفية التي ننظر بها إلى التاريخ والثقافة الفلسطينية، من موقعنا كـ “ذوات حديثة“.
إن الثقافة الريفية، خاصة في إطار التأريخ الوطني الفلسطيني، لا يتم تناولها سوى من منطلق الأدوات والمنتجات والمصنوعات الفولكلورية؛ إذ يتم التعامل مع الأقوال المأثورة، وأوجه النشاط المختلفة، والأزياء والاحتفالات، على أنها كلها دلائل ثابتة تشير إلى الارتباط القائم بين الفلاحين، والأرض، ومجتمعاتهم، التي تعرضت للدمار.
إن تجربة الحياة اليومية التي أوجدت تلك الأدوات الفولكلورية، ووضعتها في إطار من العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والإيديولوجية – حيث احتلت المرأة موقعًا محوريًا فعالاً – هي تجربة غائبة في الكتابات الوطنية، التي تنظر إلى الأبعاد الحية للواقع الريفي (على النقيض من الأدوات المادية)، على أنها تمثل عناصر من ثقافة مهزومة. فالقبلية والأمية ورق النساء والفقر، هي أقرب إلى أن تكون إشارات حداثية إلى ماضٍ ريفي، يمثل تاريخًا كان حيًا يومًا ما، إن هذا التصوير السلبي للماضي الريفي، هو استعارة مجازية لا بد منها في سبيل تأكيد أن القومية تمثل خطوة أولى، للتحرر الحداثي، من تخلف وهزيمة الماضي.
* – ريما حمامي: محاضرة بقسم الاجتماع، جامعة بيرزيت، فلسطين، وعضوة مركز دراسات المرأة بالجامعة.
1 – يمكن الرجوع إلى نموذج ورد حديثًا، في هذا الصدد، في الكتاب التالي:
– Lina Hamardee- Banarjee et. Al.، Ar the Crossroads: Challenges and Choices for Palestinian Women in the West Bank and Gaza Strip (New York: UNDP، 1993) pp. 66- 67.
2 – أظهر أول مسح ميدانى للأسر، قامت به FAFO، أن نسبة ٤٣% – فقط – من الذكور الذين تبدأ أعمارهم، من ١٥ عامًا فأكثر، أعربوا عن تأييدهم لعمل المرأة خارج البيت، مقارنة بـ 78% من النساء المؤيدات لذلك
(Heiberg & Ovenson 1993، 251)
3 – للحصول على موقف “حماس“، في هذا الصدد، انظر: المادة ١٧، من ميثاق حماس، بعنوان “دور المرأة المسلمة“.
4 – للمزيد حول مظاهر علاقات حيازة الأراضي، في ظل الحماية البريطانية، انظر:
– Goadby، Frederic and Moses Doukhan. The Land Law of Palestine (Tel Aviv: Shoshany’s Printing Co.، 1935).
– Granott، A. (A. Granovsky). The Land System in Palestine (London: Eyre and Spottiswood، 1952).
وللمزيد حول الأسرة الريفية، في ظل الحماية البريطانية، انظر:
– Kamen، Charles S. Little Common Ground: Arab Agriculture and Jewish Settlement in Palestine 1920 – 1948 (Pittsburgh: University of Pittsburgh Press، 1991).
5 – يتفق ذلك مع ما يتوصل إليه العديد من الباحثين، حول وضع الفلاحين في فلسطين في ظل الحماية البريطانية:
– Moors 1990، 197 -198.
– Moors 1992، 47.
– Goadby and Doukhan 1935، 101.
– Granott 1952، 235.
6 – تشير Granqvist إلى نموذج لأرملة كهذه في قرية Irtas، في العشرينيات، من هذا القرن، قائلة: “يمكن للمرأة التي يموت عنها زوجها، أن تتمتع بالسلطة والحرية؛ بمجرد بقائها أرملة” (Granavist 1935، 319)
كما تشير – أيضًا – إلى حالة الزوجات المتعددات لرجل واحد، ممن قمن بتقسيم أملاك زوجهن المتوفي بينهن (Granqvist 1931، 119).
7 – يذكر Moors عددًا من سكان الجبل من النساء ممن قمن باستبدال جزء من المهر، مقابل الحصول على ملكية منتجة؛ وذلك أثناء الحماية البريطانية. كما تذكر Granqvist نموذجًا لامرأة قامت بالشيء ذاته، في قرية Irtas في الفترة ذاتها أيضًا (Moors 1990، 198. Granqvist 1931، 119).
8 – انظر دراسات
(Baldensperger 1900، 176. Canaan 1931، 194).
9 – ترجع الأهمية الاقتصادية لإنتاج النساء من الدواجن، إلى أن إحصائيات عام ١٩٣٧، كانت تشير إلى أن إنتاج البيض، الذي يتم تصنيفه؛ على أنه “منتج زراعي بدائي“، كان يمثل 30% من إنتاج البيض، على مستوى الدولة، مقارنة بنسبة 33%، مما يطلق عليه “المنتجات العربية واليهودية الحديثة“، ونسبة ٤٦% من مجموع الواردات. (Horowitz & Hinden 1938، 50 – 51).
١٠ – يقول Baldensperger : “إن الدواجن هي – دائمًا – ملك للمرأة”
(Baldensperger 1900، 176).
۱۱ – للمزيد حول وضع المرأة في قرية “الفالوجا“، وقيامها بالبيع لتجار يافا المتجولين، انظر: (Kanaaneh & al- Madani 1987، 11).
١٢ – للمزيد حول الاحتفالات الريفية، في ظل الحماية البريطانية، انظر: (al- Mubayyid، 1987، Canaan، 1923).
۱۳ – للمزيد حول الأوضاع الاقتصادية للاجئين في غزة، فيما بعد حرب ١٩٤٨، انظر:
– Baster، James. “Economic Aspects of the Settlement of Palestine Refugees”. The Middle East Journal، 8 (1) : 54 – 68.
– Baster، James. “Economic Problems in the Gaza Strip”. The Middle East Journal. 9 (3): 323 – 327.
– Cheal، Beryl. “Refugees in the Gaza Strip، December 1948- May 1950″. Journal of Palestine Studies. 18 (1) 138 – 157.
14 – Nolte، Richard H. “The Gaza Strip: A Report From Richard Nolte”. American University Field Staff. 6 (1): 1 – 26.
– Stevens، Georgina. “Arab Refugees: 1948 – 1952”. The Middle East Journal 6 (3): 281 – 297.
15 – Skeik 1982، 28 – 29.














