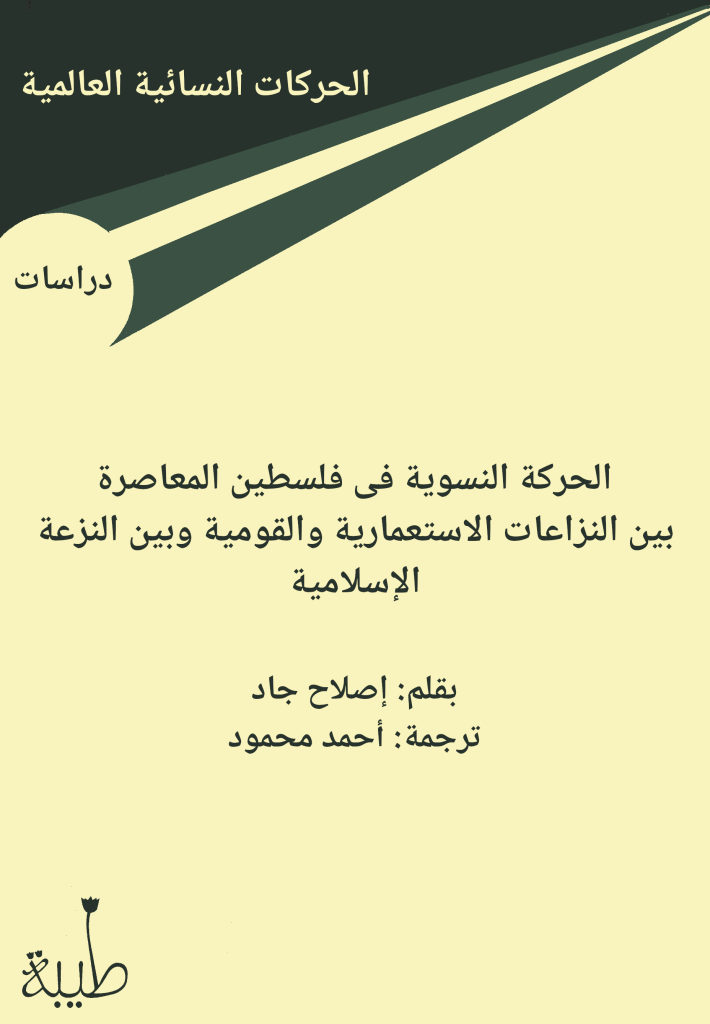الحركة النسوية في فلسطين المعاصرة
بين النزعات الاستعمارية والقومية وبين النزعة الإسلامية(*)
أحد الأهداف الرئيسية لهذا المشروع البحثي هو بحث الصلات ونقاط التقاطع النزعات الاستعمارية والقومية والإسلاموية والحركة النسوية في فلسطين المعاصرة.
بينما نظرت النزعة القومية الفلسطينية إلى النساء على أنهن «عنصر مساعد وهامشي، فقد أتاحت لهن فضاء جديدًا في المجال العام. وهكذا نجد أنه يصدر عن النزعة القومية اتجاهان أحدهما قمعي والآخر تحريري فيما يتعلق بالنساء. وكثيراً ما كانت النخب النسوية في حركات النساء المتعاقبة منذ العشرينيات حتى الوقت الراهن تنظر إلى الريفيات واللاجئات على أنهن غير مستنيرات. غير أنه كانت هناك فترات يجري فيها إزالة الحاجز الحضري الريفي بنجاح بقدر سمح بحدوث منجزات حركات النساء. وكان النجاح في تنظيم الآلاف من النساء وتعبئتهن هو الأساس الذي أقامت عليه الناشطات مطالبتهن بتغيير نظام النوع الاجتماعي داخل أحزابهن وفي مجتمعهن.
لقد بحثت، على وجه الخصوص، الطرق التي شكلت بها الحركة النسوية الفلسطينية نفسها من داخل الحركة القومية المعاصرة بعد الهزيمة العسكرية في عام 1967. وكما حدث في الحالات السابقة، لم يُوجد التشكيل المعاصر للحركة القومية الفلسطينية رؤية نوع اجتماعي، إلا أن خطاب الأحزاب اليسارية بشأن تحرير النساء كان بمثابة منبر مهم استطاعت من فوقه الناشطات المطالبة بفضاء مساوٍ في المجال السياسي. ونجحت النساء خلال «الثورة» في حشد التأييد لها بين نساء مخيمات اللاجئين في لبنان. وشكل ذلك أساسًا لمطالبتهن بالحقوق من قادتهن الذكور في الحركة القومية ومحاولاتهن تغيير نظام النوع الاجتماعي السائد مجتمعاتهن المحلية.
وكان ظهور القيادة القومية المحلية الراديكالية والشعبية في الضفة الغربية وغزة بعد 1967، وقد ابتعدت عن الممارسة السلطوية المباشرة لمنظمة التحرير الفلسطينية، خطوة مهمة في سبيل وضع استراتيجية تقوم على مبادرات الشعب والمشاركة المباشرة. وكان ذلك هو السياق الذي ظهرت فيه منظمات النساء المحلية في منتصف السبعينيات استطاعت خلالها النشاطات لأول مرة في تاريخ حركات النساء الفلسطينيات إزالة الحاجز القائم بين النساء الحضرية وبنات الطبقة الوسطى والنساء الريفيات. ونجحت خلال نشاطها في تحدي نظام النوع الاجتماعي السائد وإيجاد حركة نسائية محلية النشأة جمعت بين الكفاح القومي والكفاح من أجل تغيير نظام النوع النساء من الاجتماعي السائد.
حاولت طوال هذا البحث بيان ضرورة بحث الصراع وتفكيك حركة النساء المعاصرة في فلسطين في سياق تشكيل السلطة الفلسطينية الأكثر اتساعا بعد توقيع اتفاقية أوسلو في عام 1993 التي بشرت بمرحلة بناء شبه الدولة، وهو ما ثبت أنه وهم. وأدى استمرار الاحتلال الإسرائيلي متخذا مظهر عملية سلام أوسلو إلى فشل السلطة الفلسطينية في أن تجعل من نفسها دولة وتتسبب في تفكك البناء السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية والأحزاب السياسية المكونة لها. وأدى هذا بالتالي إلى نفوذ متزايد للقوى الإسلامية وما نتج عن ذلك من تغيرات طرأت على مكونات الحركة القومية الفلسطينية التي كان يحكمها حتى ذلك الوقت شكل ومضمون علمانيان. وأدى ظهور السلطة الفلسطينية إلى تغييرات جذرية في الأشكال المختلفة لممارسة النشاط السياسي والاجتماعي في المجتمع المدني. وكانت تلك التغييرات تهدف إلى الحفاظ على المجتمعات المحلية الفلسطينية، وتنظيمهما وتعبئتها لمقاومة الاحتلال. وكانت النساء مساهمات فعالات في هاتين العمليتين.
ركزت بشكل خاص على أثر السلطة الفلسطينية على حركات النساء. وأوضحت أنه جرى بعد تكوينها تفكيك المنظمات الجماهيرية لمصلحة تشكيل المنظمات غير الحكومية. وقد انتقدت في الفصل الثالث دعاوى الليبرالية الجديدة بأن المنظمات غير الحكومية تمثل شكلاً قابلاً للتطبيق من المجتمع المدني في الشرق الأوسط بصور عامة. والواقع أن إضفاء الصبغة الاحترافية وتوجيه المشروع كان لهما أثر يبعث على التفكيك ولا يشملان الإسهام فيما يتعدى الطبقة البيروقراطية.
أوضحت كذلك أن «منطق المشروع»، يضع قدرًا أكبر من السلطة والنفوذ في أيدي رجال الإدارة، وهو بذلك يجعل بني المنظمات غير الحكومية طاردة وليست جاذبة. والأمر الأكثر أهمية هو حدوث تغير في الاهتمام يبتعد عن التركيز على التغيير الاجتماعي في اتجاه مشروع أكثر محدودية تعطى الأولوية فيه للممولين وليس لـ «المشاركين» أو «الجماعة المستهدفة».
وفي ظل الوضع دائم التغير الذي يميز فلسطين، من المهم الاعتماد على الدروس المستفادة من ممارسة النشاط السياسي والاجتماعي التي يكون بمقتضاها نشر الحركة الاجتماعية المستدامة القائمة على أسس جماهيرية مطلوبًا، وحيث يجب استدامة إقامة شبكات الاتصال والتشاور والصلات الشخصية والتعبئة على أساس يومي. ويهمل تركيز السلطة والرغبة في وضع الأنشطة كافة داخل إطار منطقي تلك الشروط ويركز على رسم صورة ترضي المانحين. وقد انتهيت إلى أنه ليس هناك عامل واحد بل عوامل عدة تفسر فشل بعض مشروعات المنظمات غير الحكومية.
لم تثبت مقاربة المنظمات غير الحكومية للمشروعات الصغيرة ذات المدد الزمنية المحدودة أنها مجهزة لتعبئة الحركات أو الجماعات الاجتماعية الأخرى أو إقامة صلات بانها بشأن قضايا الهم القومي. وأعتقد كذلك أن المنظمات غير الحكومية قد لا تكون مناسبة لمعالجة القضايا الخلافية الخاصة بالتغيير الاجتماعي التي تضطر فيها إلى مواجهة مثل تلك الجماعات المعبأة تعبئة جيدة كالإسلامويين. بل إنني أمضي إلى حد الإشارة إلى أن خطاب المنظمات غير الحكومية بشأن الحقوق العامة منفصل إلى حد كبير عن سياقه المحلي، مما جعل تلك المنظمات، دون أن تقصد، تساعد الحركات الإسلامية وتشجعها. وفي مقابلاتي مع الإسلامويات في قسم العمل النسائي وجدت أن الإسلامويين لم يكونوا رؤية نوعية واضحة، مثلهم في ذلك مثل منافسيهم القوميين وإن كانوا على عكس صورتهم عند الغرب. كما وجدت أن أيديولوجيتهم السياسية نصورة عامة وأيديولوجيتهم النوعية على وجه الخصوص ليست لها أصول في النصوص الدينية، بل هي رد فعل للمواقف العلمانية وترتبط بالخطاب العلماني البديل.
حاولت أيضًا بيان كيف شكلت الإسلامويات فضاءً عامًا لفئة بعينها من النساء، وهن هؤلاء المتعلمات الآتيات من خلفيات فقيرة من المخيمات بشكل أساسي، وكان من اللائق أخلاقيًا بالنسبة لهن أن ينشطن في مجالات الحياة العامة كافة. كما أوضحت كيف أنهن رسخن أقدامهن بين النساء الفقيرات بتقديمهن الخدمات وإبقائهن الاعتراف بالأسرى قائمًا. وهذه إضافة مهمة إلى نشاط النساء في مرحلة الكفاح الوطني.
ومع ذلك فقد أبرزت أيضًا مثالين مختلفين استُغلت فيهما الشريعة، باعتبارها مبدأ مرشدا لحقوق النساء، بطرق متناقضة. ففي جدل أثارته منظمات النساء النسوية بشأن الإصلاح القانوني، استخدم الإسلامويون الشريعة في البداية باعتبارها ثابتة ومقدسة من أجل نقض مشروعية جماعات النساء غير الإسلامية وإسكاتها. كما أنهم استغلوها للتشكيك في فكرة السيادة الشعبية التي تدعو لها السلطة الفلسطينية كأساس للتشريعات الجديدة. ولا يزال الأمر غامضا بشأن ما إذا كان الإسلامويون يعتزمون إقامة سيادة تعتمد على إرادة الله بدلاً من إرادة الشعب أم لا. ولن يتضح ذلك إلا في المستقبل، حيث لم يكشف النقاب عن مشروع الدولة الخاص بهم بعد.
غير أن الجدل نفسه الدائر حول الشريعة أثار تحليلاً داخليًّا للذات في صفوف الحركة الإسلاموية نفسها. فقد اضطر الإسلامويون تحت ضغط جماعات النساء العلمانية النسوية إلى تقديم رؤيتهم البديلة القائمة على الشريعة. ولهذا السبب اضطروا إلى مشاركة الموقف النسائي العلماني. وقد رفضوا في خطابهم منهج المساواة التامة ودحضوه. وفي الوقت ذاته كانت الإسلامويات المتعلمات تعليمًا عاليًا والمهنيات يستفدن من المساواة التامة في ممارستهن اليومية للدفاع عن الحقوق المتساوية للنساء في المجال العام، وخاصة فيما يتصل بالعمل والنشاط السياسي.
وفي حالات أخرى، أظهرت كيف أن القيادات الإسلاموية من الذكور تفاعلت بسرعة، كما تشير زبيدة، لـ «إصلاح» الشريعة (زبيدة 2003: 1) فيما يتعلق بالقانون الجنائي، وذلك مرة أخرى من أجل التشكيك في جماعات النساء النسوية والعلمانية ومنعها من اقتراح أية إصلاحات. والأهمية التي تعطيها القيادة الإسلاموية للشريعة بشأن حقوق النساء تقل عما تعطيه من أهمية لتأكيد نفوذ الإسلامويين المهيمن في المجتمع وإزاء السلطة الفلسطينية. وقد يكون كذلك بشأن تحديد طبيعة الدولة الفلسطينية أو الإسلامية المستقبلية التي لم تتحدد بعد من خلال استراتيجية «المواطنة الفاعلة».
هذا ومع أن الإسلامويين وجدوا ملجأ في فكرة «المواطنة الفاعلة»، فلن يؤدي. بالضرورة في الحالة الفلسطينية إلى دولة أكثر استبدادًا «نوعية النزعة». فقد أظهر ما نوفر لدي من بيانات أن الإسلامويين اضطروا أثناء سعيهم لتعريف أنفسهم بأنهم حركة وطنية إلى الاقتباس من الرؤى الجديدة وإدماجها لتوسيع دوائر تأييدهم. وأوضحتُ أن هناك بعض المراحل الاستراتيجية من نشاط المجتمع المدني كانت الإسلامويات فيها مشاركات في الكفاح. وأدمجت في بعض مجالات نشاط المجتمع المدني، كما في الحركة الطلابية، والهيكل الحزبي ذاته، النساء اللائي كن مهمشات اجتماعيًا من القيادة الوطنية التي كانت فيها نساء النخبة ممثلات تمثيلاً زائداً على الحد.
إلا أنه بالرغم من مراحل الانفتاح والمشاركة هناك أخطار الانغلاق والارتداد إلى تفسيرات الإسلام التي قد تؤثر على النساء سلبًا. ورغم دعوة الإسلامويين إلى مشاركة النساء الكاملة في الحياة العامة، فإنهم قد يرتدون إلى دور النساء العريق باعتبارهن «أمهات الأمة» الخصيبات. ولم يتضح موقفهم من تعدد الزوجات بعد. وفي حالة النساء اللائي قمن بعمليات انتحارية، كان هناك جدل شديد بشأن «ملاءمة» النساء للعمل العسكري. ومع ذلك فقد أثبت أن نوع الدولة «الإسلامية» التي قد يؤدي إليها هذا النشط يتوقف على السياق الذي قد يهيئه العلمانيون. فقد دفعت تحديات عديدة الإسلامويين إلى اتخاذ مواقف من القضايا العلمانية مثل التعددية وحقوق النساء والمصلحة العامة والتنمية المستدامة والذات الاجتماعية مقابل الذات الفردية، وجميعها أفكار موضوعة على الأجندة في سياق علماني، مما يجبر الإسلامويين على الانحياز إلى الأمور التي تشير الدلائل إلى أنها صاحبة الحظ الأوفر من التأييد.
خلاصة القول أن خطاب الإسلامويات لا يعتمد على النصوص الدينية وحدها، بل كذلك على المجالات الاستطرادية التي خلقتها الناشطات الأخريات. وقد تشكل هذه المشاركة أرضية مشتركة للإسلامويات والعلمانيات كي يشاركن من خلال التشجيع على قراءات جديدة للنصوص الدينية وكذلك عن طريق المشاركة في أشكال الكفاح اليومي للنساء في ظل الاحتلال، ويتطلب هذا التكيف المتبادل (هدسون 1996: سلامة 2001) من كل طرف مراعاة الحذر بشأن التغيرات التي تحدث في خطابات الطرق الآخر، وهو أفضل من الرفض التام الذي تتسم به بعض المنظمات غير الحكومية النسوية، كما هو مبين في الفصل الرابع.
ولا يمكن للإسلامويين تجاهل المجالات التي حققت فيها النساء منجزات حديثة كالتعليم وفرص العمل، بل يجب عليهم الإقرار بها والاعتماد عليها (روي 1999: زبيدة 2000). وهكذا فإن نمط الدولة الذي قد يرغب الإسلامويين في بنائه لن يعتمد على برنامج عمل ديني، بل سوف يعتمد إلى حد كبير على نمط الدولة والمجتمع الذي يعيشون فيه بالفعل، وعلى الرؤى والتحديات التي تمثلها الجماعات القومية والعلمانية الأخرى. وفي هذا السياق أرى أن المكاسب التي حققها الإسلامويون كانت نتيجة لفشل المؤسسة السياسية الفلسطينية، وهو ما يشير إلى أنه من المهم بالنسبة للعلمانيين أن يعيدوا بحث مفاهيمهم واستراتيجياتهم.
هناك تجاهل حتى يومنا هذا في الشرق الأوسط وفلسطين لنقد قدرة «التحديث» على تحقيق التقدم والتحرر للمجتمع بصورة عامة والنساء على نحو خاص. وقد أوضحت، على سبيل المثال، الطرق التي نشرت بها النخبة الحداثية القومية التحديث لتهميش جماعات اجتماعية مثل النساء الريفيات، بينما لا تفعل الكثير في الوقت ذاته لتحدي النظام النوعي السائد القائم على «الإسلام» و«التقاليد». وردًا على ذلك تجاوبت الحركتان القومية والإسلاموية مع نشاط النساء الذي نجح في الحالتين في جعل القوميات مسئولات عن مطالبهن الخاصة بالمساواة الرجال. وبينما ينتقد مع القوميون العلمانيون العرب، ومن بينهم الفلسطينيون، التدخلات السياسية والعسكرية والعدوانية لسلطات الاحتلال، فقد تركوا انتقاد تدخلات تلك السلطات الاجتماعية والسياسية والثقافية إلى حد كبير للإسلامويين. وتقدم الجماعات الإسلاموية نفسها ويصورها الآخرون على أنها القوة الوحيدة التي تتحدى وعود العصرية التي لم تتحقق.
كان لفترة عمليات بناء الدولة الخيالية دور مهم في تفكيك أشكال الحركات السياسية والاجتماعية والعلمانية لمصلحة الجماعات الإسلاموية. فقد أتت تلك العملية بالنخبة الحضرية من الطبقة الوسطى، في هياكل السلطة (في صورة بيروقراطيات يعملن من أجل التغيير الاجتماعي) وفي المنظمات الجماهيرية، إلى مقدمة الصورة على حساب الناشطات الريفيات والمقيمات في المخيمات. وأصبحت المهنيات الحضريات، تصاحبهن عمليات إنشاء المنظمات غير الحكومية، مهيمنات في الحكومة والمجتمع المدني.
إحدى الطرق التي يمكن بها خلق أرضية مشتركة أو «مشاركة حوارية» (بنين وستوك 1997: 22) بين الإسلامويين والعلمانيين هي بحث العصرية الاستعمارية. فكما قلت في الفصل الخامس، لابد من التصدي لثنائية «الأصالة» مقابل «المعاصرة» (المفهومة على أنها التغريب) على نحو جاد. ويقول الكثير من الباحثين إن الثقافات والتقاليد ليست مستقرة أو «ثابتة» (العظمة 1996: تشاترجي 1993). والتراث الذي يسعى الإسلامويون إلى إحيائه مُنشأ حديث مخترَع. ومن خلال إقرار اقتراح نانسي فريزر الخاص بالتحرك إلى ما وراء سياسة الهوية، فإني أعترف بأن الأسلامويين جماعة مؤثرة تمثل بعض التجمعات الاجتماعية في المجتمع المدني وتحظى بدعمها.
لم يكن هدفي هو تثبيت السياسات الإسلاموية أو إقرارها بل تحاشي إساءة الاعتراف بها أو تهميشها. ويقول فريزر إن «إساءة الاعتراف يمثل شكلاً أشكال الخضوع المؤسس، وبذلك يكون انتهاكا خطيرا للعدالة» (فريزر 2000: 7). وتسعى دعاوى الاعتراف هذه إلى جعل الطرف الخاضع شريكًا كاملاً في الحياة الاجتماعية قادرًا على التفاعل مع الآخرين باعتبارهم شركاء للمساعدة في الفهم، الذي يقول فريزر إنه «ما يعوق تكافؤ المشاركة في أية حالة» (فريزر 2000: 9). والاعتراف بالإسلامويين باعتبارهم شركاء متساوين في النشاط داخل المجتمع المدني ليس مهما فقط في السياق العام في الشرق الأوسط، حيث يخضعون للقمع العنيف من قِبَل الحكومات القائمة، بل هو مهم على نحو خاص في حالة فلسطين حيث تجري معركة البقاء الوطني. وكما قلت في الفصل الخامس، فإن القمع العنيف الذي يخضعون له أفادهم، لمجرد أن من يضطهدونهم مزدرون من غالبية الشعب باعتبارهم أصدقاء فاسدين ومستبدين للغرب.
لا يمكن حصر الإسلامويين الفلسطينيين في المجال الخاص بـ «التراث» و«الدين» (تشاترجي 1993: 26). والمشكلة هنا كما يقول أسد هي أن «المواطنين المحدثين لا يؤيدون نسقا أخلاقيا موحدا، وأنه «يقال إن التغاير الأخلاقي أحد السمات المحددة للمجتمع الحديث» (أسد 2003: 186). ولا يمثل تأكيد التضامن الوطني، رغم بعض الآمال، أي دين للدول القومية (المرجع السابق: 187 و 193)، لأن التغاير الأخلاقي للمجتمع الحديث يعني أنه لا يمكن تعريف شيء بأنه وعي أخلاقي جماعي.
وليست العلمانية نقيض الدين، غير أنها قد تعكس صورته. بعبارة أخرى، فإنه إذا أفرزت الحركة القومية نظام حكم مستنيرًا ومتسامحًا، فسوف تنتج دينًا مستنيراً ومتسامحا. بينما إذا كانت الحركة القومية مستبدة وقمعية، فسوف تنتج بالأسلوب نفسه دينا عنيفا ومتعصبا. وكما أوضحت في الفصل الخامس، فقد «استعار» الإسلامويون أساليب فعاليتهم وممارستهم السياسية من المجال العلماني، الذي استمدوا منه كذلك أفكارهم بالديمقراطية وحقوق المواطن والأيديولوجيا النوعية، كما «استعاروا» استخدام العنف في الكفاح ضد هيمنة قوى التيار العام. وهكذا فإن الإصرار على الفصل الحاد بين الديني والعلماني ليس على قدر كبير من الصواب في ضوء حقيقة أن الثاني ينتج الأول باستمرار.
توازي الاستعانة المشتركة بالقيم الحديثة والعلمانية معادلة مضللة، وأعني بها معادلة مجاوزو الحقوق العامة للمطالبة بـ «الثقافات الأصيلة» عند تأكيد الفروق الثقافية التي يستعين بها المحافظون القوميون والجماعات الدينية والأصولية عادةً. في وتقوم مقاربة حقوق الإنسان العامة على إطار متقاطع ثقافيا تستخدمه لتحليل قمع النساء وإخضاعهن وتقترح الأدوات العامة لتمكين النساء. وقد أوضح ذلك الخلاف الذي أثاره البرلمان النموذجي الذي سعى من خلاله مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي WCLAC باعتباره منظمة غير حكومية نسائية علمانية إلى إصلاح التشريع القائم من خلال تبني مقاربة حقوق الإنسان الخاصة بالنساء. وأظهرت الأحداث التي أعقبت هذا المشروع أن فصل حقوق النساء عن الحقوق الوطنية الجماعية في سياق الاحتلال قد يؤدي إلى تهميش النساء كجماعة اجتماعية وبالتالي إلى تشظيهن وتفككهن. ومن المفارقة أن مقاربة حقوق الإنسان العامة، التي قصد بها أن تكون أداة للتمكين أنحاء العالم، أضعفت عضوات الحركة النسوية المحليات. كما أنها تطورت على حساب فهم الواقع التاريخي الذي خلقته الموجات المتعاقبة من الاستعمار والأدوار اللاحقة التي فرضت على النساء أو قبلنها هن (نيسياه 1996: 1). وكما أوضحت في الفصل الرابع، فقد أخطأت مقاربة حقوق النساء التي تبناها مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي وقامت على الحقوق الفردية وحقوق النساء العالمية بتأكيدها أن القوة الاجتماعية تكمن في الدولة وليس في الجماعات الاجتماعية والسياسية الأخرى، كالإسلامويين الذين يعارضونها وينافسونها.
باتت هذه المقاربة بتجاهلها السياق الوطني تتناقض تناقضًا شديدًا مع القيم الثقافية السائدة بقوة التي تقدر الشخص الذي يعطي ويضحي ويكافح من أجل أمته أو أمتها المحتلة والمحرومة والمهانة. وقد فهم الكثيرون، ومنهم الإسلامويون على وجه الخصوص، إعطاء أهمية للمقاربة القائمة على الحقوق على أنه مطالبة بدولة على حافة الانهيار. ووصم ذلك المطالبين بأنهم من يريدون أن «يأخذوا» بدلاً. من أن «يعطوا». وبتجاهل السياق الاجتماعي السياسي التي نُفذ فيه «مشروع» تغيير القانون والمطالبة بحقوق النساء، وفر المشروع دون أن يقصد أرضية أكبر للإسلامويين كي ينقضوا مشروعية الدعوة إلى الاستعاضة عن النظام النوعي بنظام آخر يقوم على حقوق النساء العامة.
وفي ضوء كل من التجربة التاريخية والبيانات الصادرة عن العمل الميداني، يتضح أن نقاط ضعف حركة النساء الفلسطينيات تجلت في الفترات التي عجزت فيها حركة النساء عن أن تكون قوة معبئة شاملة. وقد أوضحت أن تكوين المنظمات غير الحكومية أدى إلى مزيد من تشظي حركة النساء، وبينت أن نقاط النجاح كانت موجودة في الفترات التي كانت فيها الأجندتان النسوية والقومية متآزرتين إلى أقصى حد.
أحمد محمود: صحفى ومترجم.
(*) هذه خاتمة رسالة الباحثة لنيل درجة الدكتوراه، تستخلص فيها نتائج بحثها وبها إشارة إلى ما أوردته من دراسة في الفصول المختلفة للبحث.