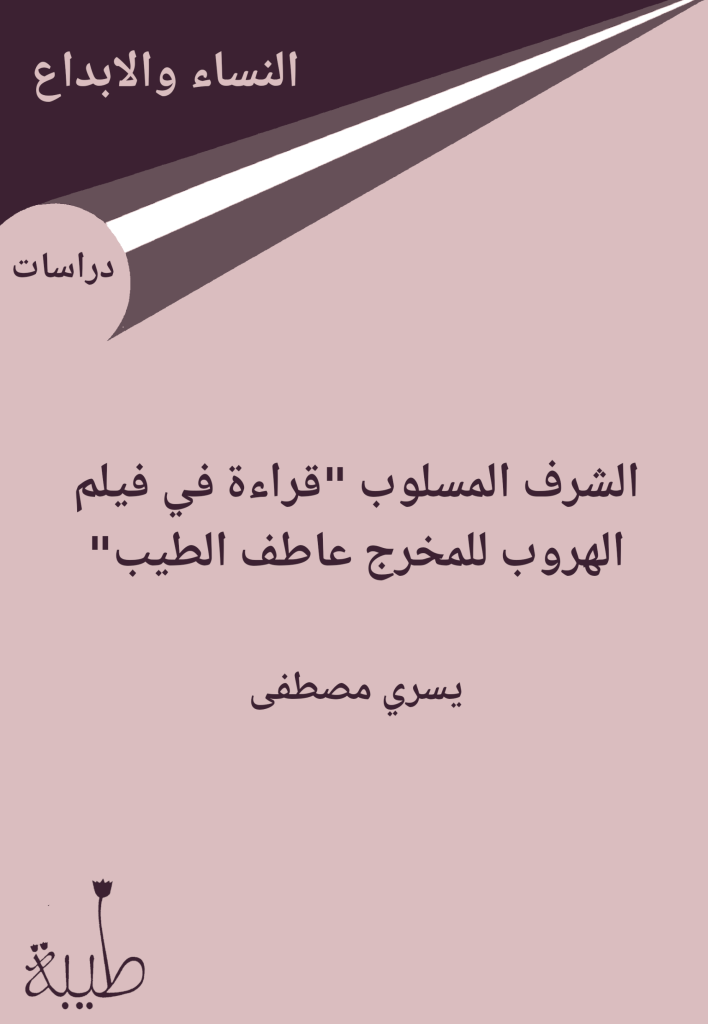الشرف المسلوب
“قراءة في فيلم الهروب للمخرج عاطف الطيب“
يسرى مصطفى*
يرتبط السؤال عن صورة المرأة في السينما، من ناحية، بنقد الأعمال الفنية التي توظف جسد المرأة كموضوع للفرجة والإغراء كما هو الحال بالنسبة للغالبية العظمى من الأفلام التجارية، كما يرتبط، من ناحية أخرى، بنقد الأعمال الفنية التي تعمل على إعادة إنتاج القيم الاجتماعية السائدة والتي تحط من شأن النساء وتعيد إنتاج الأدوار النمطية لكل من الرجال والنساء وكأنها أمور طبيعية أبدية. وعلى مستوى آخر فإن المعنيين بصورة المرأة في السينما غالبا ما يثمنون الأعمال الفنية التي تتناول قضايا المرأة كموضوع للتحرر من القهر وكسر الصور النمطية للنساء بما في ذلك تلك الأعمال التي تقدم، بدون تمييز، أدوار الرجال والنساء في خدمة قضية ما اجتماعية أو سياسية. وفي كل الأحول فإن مسألة صورة المرأة في السينما من القضايا التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بقضايا الحرية والمساواة والعدالة. ويهدف هذا المقال إلى تناول صورة المرأة في السينما المصرية ولكن من زاوية تبدو مختلفة. فليس الهدف طرح موضوع صورة المرأة في الأعمال التجارية الفجة التي تقدم المرأة كجسد المفرجة، فهذه القضية باتت معروفة وموضع نقد للعديد من الأصوات المدافعة عن حقوق النساء. ولكن ما يهدف إليه المقال هو مناقشة صورة المرأة في عمل فني يحمل وبشكل واضح رسالة اجتماعية وسياسية وحقوقية. ولذا فقد تم اختيار مخرج لا يمكن الاختلاف على التزامه وإيمانه بالحقوق والحريات، وهو الراحل عاطف الطيب. ومن بين أفلامه تم اختيار فيلم هو واحد من أهم الأفلام التي تعرضت بالنقد للمؤسسة الأمنية ومن ثم فقد تم اعتباره واحدًا من الأفلام الأقرب لمفهوم حقوق الإنسان. ولمزيد من الإيضاح أود أن أبدأ هذا المقال بالإجابة عن سؤالين وهما: لماذا عاطف الطيب؟ ولماذا فيلم الهروب؟ من ناحية أولى، يعتبر عاطف الطيب (1947-1995) واحدًا من أبرز المخرجين السينمائيين المصريين، وتصنف أفلامه ضمن “المدرسة الواقعية” حيث تشكل امتدادًا لمدرسة المخرج المصرى المعروف صلاح أبو سيف. وقد بدأ الطيب سلسلة أفلامه فى بداية الثمانينيات. وليس غريبًا أن تعكس أفلامه هموم المجتمع المصري في السبعينيات والثمانينيات بكل ما في هذين العقدين من تغيرات وتحولات سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية. فمن الانفتاح الاقتصادي” وما تضمنه من تغير في القيم الثقافية والاجتماعية، إلى موجات الأصولية الدينية، فقد كان المجتمع خليطًا من النزعات الاستهلاكية المكبوتة لدى الغالبية بفعل التهميش، والنزعات الأصولية التي هي نتاج للكبت والتهميش والقهر السياسي. في هذا المناخ، لم يكن عاطف الطيب، مجرد موثق لوقائع بعينها، بل ناقدًا بالمعنى الاجتماعي والسياسي. فقد كان واعيا بدوره كفنان ملتزم يعمل من أجل كشف الاهتراء الاجتماعي والقهر السياسي. وفي حياته الفنية القصيرة أثرى السينما المصرية بمجموعة من الأفلام المتميزة والتي عالجت بقوة قضايا حساسة مثل: الظلم الاجتماعي والفساد والتعذيب والاعتقال التعسفي والتغير في القيم الاجتماعية والثقافية. ولعل القارئ يستحضر أفلامًا مثل: “سواق الأوتوبيس”، “الحب فوق هضبة الهرم”، و”ملف في الآداب”، و “كتيبة الإعدام”، و “ضد الحكومة”، و “البرئ”، و “الهروب”، و “ليلة ساخنة” إلخ. وقد صار من المعروف أن عاطف الطيب يمثل نموذج المثقف والفنان الملتزم الذي لم يستجب لإغراءات السوق. ومن هنا تأتى دلالة اختيار نموذج مثل عاطف الطيب، بمعنى أننا نتعامل مع نموذج فنى واعٍ غير تجاري يطرح قضايا هي من صميم الواقع المصرى. وعليه فإن صورة المرأة في أفلام عاطف الطيب تحظى بأهمية خاصة، فهي صورة يقدمها فنان ومثقف واعٍ ومشغول بهموم مجتمعه وفئاته المهمشة والمضطهدة. ومن ناحية أخرى، لماذا فيلم “الهروب”؟ على الرغم من أن فيلم الهروب ليس أهم أفلام المخرج عاطف الطيب، ولكنه بلا شك واحدًا من أهم أفلامه. فقضية هذا الفيلم هو كشف انتهاكات جهاز الأمن. وعلى الرغم من أنه ليس الفيلم الوحيد الذي عالج فيه عاطف الطيب هذه القضية، حيث كانت المؤسسة الأمنية موضوعًا للعديد من أفلامه، إلا أن ما يضيفه فيلم “الهروب”، وكذلك فيلم “البرئ”، يتمثل في كشف دواخل المؤسسة الأمنية وآلية عملها. فمن الناحية السياسية والحقوقية (بالمعنى المدنى السياسي) يعد فيلم “الهروب” أحد العلامات في السينما المصرية، ومع ذلك، فإن هذا العمل الفني المتميز يظل موضع سؤال من منظور صورة المرأة. فبشكل عام يحتل مفهوم “الشرف” مكانة محورية في العديد من أعمال عاطف الطيب. فالخيانة والدعارة دالتا الفساد في عدد غير قليل من أعماله، وفي سياق مناقشته لتغير القيم الاجتماعية وشيوع الفساد، تم استخدام فكرة الشرف وتوظيفها دراميا كدلالة على الانحراف القيمي وانهيار مبدأ الكرامة. وأي كان نوع الرسالة التي يريد أن يقدمها، إلا أن مفهوم الشرف يستدعى دائمًا صورة المرأة، كخائنة أو داعرة. يحكى لنا فيلم “الهروب” قصة رجل صعيدي (منتصر)، وهو الدور الذي قدمه ببراعة الفنان الراحل أحمد زكي، يسعى للانتقام ممن زجوا به في السجن وأغووا زوجته لتهرب خارج البلاد، وخيانة الزوجة هي محور أزمة بطل الفيلم الذي لم يعد لديه ما يحيا من أجله إلا الانتقام لشرفه المسلوب بقتل الزوجة الخائنة وقتل من أغواها. وهذا هو المسار الشخصى الذي سيجعل من بطل الفيلم مجرمًا مطاردًا من قبل أجهزة الأمن، وبطلاً يثأر لكرامته وشرفه. ومن ناحية أخرى هناك المسار الرئيسي وهو طريقة تعامل جهاز الأمن مع هذه الحالة، فالفيلم لا يعالج ملاحقة منتصر كسرد بوليسي، بل إن قيمة الفيلم تكمن في كشف آلية تعامل جهاز الأمن مع هذه الحالة والتلاعب بها وتوظيفها سياسيًا وإعلاميًا من أجل إخفاء جرائم فساد النظام أو انتهاكات رجال الشرطة ضد حركات الاحتجاج الطلابية. وحتى يتمكن الفيلم من كشف آليات عمل هذا الجهاز فإن التقاء المسار الشخصي مع المسار الأمني يتم على عدة مستويات. فمن أجل إجبار منتصر على تسليم نفسه يجرى احتجاز أمه وأخيه كرهينتين، كما تلعب العائلة دورًا في حمايته وتحريره من قبضة رجال الشرطة في أكثر من موقف. وهناك كذلك شخصية محورية في التقاء المسار الشخصى بالأمنى وهو الضابط “سالم”، والذي أدى دوره الفنان عبد العزيز مخيون. فقد كانت هذه الشخصية نقطة التقاء المجتمع العشائري التقليدي حيث ينتمى الضابط، والمؤسسة الأمنية بحكم وظيفته والتزامه بواجباته إزاء ملاحقة المجرم. ويراد لهذا الضابط أن يقف على هامش مجتمعه بتقاليده وأعرافه بحكم الواجب، وعلى هامش المؤسسة الأمنية متمردًا على ألاعيبها، فيكون موته برصاص الشرطة هو ومنتصر، وهكذا يموت البطل الباحث عن الشرف، والضابط الملتزم بالواجب. وينجح عاطف الطيب في أن يجعل المشاهد يتعاطف مع بطله كضحية مزدوجة لزوجته الخائنة ولجهاز الشرطة. وهكذا تصبح مسألة القتل على خلفية الشرف خارج المساءلة. وعلى الرغم من أن جرائم الشرف تصنف على أنها انتهاك جسيم حقوق الإنسان، بما تمثله من انتهاك صريح للحق في الحياة، إلا أن هذا النوع من الانتهاك يتوارى، بل يوظف من أجل إبراز انتهاكات جهاز الأمن سواء فيما يتعلق بالاعتقال أو تضليل الرأي العام إلخ. ويمكن القول بأن الرسالة التي ينقلها الفيلم، بقدر ما تنزع المشروعية الأخلاقية عن ممارسات جهاز الأمن، فإنها، ومن أجل تحقيق هذا الغرض، تضفى قدرًا من المشروعية الأخلاقية على جرائم الشرف، فمؤسسة الأمن لا تنتهك فقط حقوق الأفراد وتتلاعب بهم، بل إنها تذهب إلى ما هو أبعد من ذلك أي المصادرة على رجولتنا وكرامتنا عندما تمنعنا عن الانتقام لشرفنا. ولعل النقطة المحورية التي ينبغي التركيز عليها هي كيف تم توظيف النساء في هذا الفيلم من أجل صياغة صورة الرجل البطل كمدافع عن الشرف والكرامة. فعلى الرغم من هامشية المرأة في هذا الفيلم، فإن الهامش يعد مركزيًا في صناعة البطل، كرجل يحمل رسالة أخلاقية ترتبط بالكرامة وبالتالي فهو موضوع للتعاطف الأخلاقي، ومن ثم السياسي. يقدم لنا الفيلم ثلاث شخصيات نسائية حول البطل يرسمن ملامح رجولته وهن الأم، والزوجة الخائنة، والعشيقة. وعلى الرغم من هامشية هذه الشخصيات النسائية، فإنهن كن اللاعبات الرئيسيات في رسم ملامح شخصية البطل، بل وصياغة قضيته في مواجهة جهاز الشرطة كقضية كرامة وشرف. فمن ناحية هناك الأم التي تمثل الحد الأقصى للشرف وقيم المجتمع العشائري التقليدي، وهي الشخص الوحيد الذي يعيد البطل الهارب إلى مجتمعه معرضًا نفسه للمخاطر، مرة عندما يجرى احتجازها كرهينة لإجباره على تسليم نفسه، ومرة عندما تموت ويقرر الهروب من المحكمة لحضور جنازتها. فحضور الأم في هذين المشهدين كان الهدف منه التأكيد على الالتزام الأخلاقي لبطلنا كرجل. وعلى الطرف النقيض هناك الزوجة التي تشكل الحد الأقصى للخيانة وسلب الشرف، وهي خيانة مرتبطة بعملية فساد وبالتالي فإن الرغبة في قتل الزوجة تحمل دلالة مزدوجة، الانتقام لشرف شخصى وشرف مجتمعي، وبين الأم والزوجة الخائنة تقع العشيقة (الراقصة) والتي تبرز جانبا آخر في رجولة البطل (أو بالأحرى ذكورته) فهي تجسيد لأنثى هامشية توفر الحب والحماية والجنس كذلك، فهي الشخصية التي تعبر عن الهامش حيث إنها لا تطلب علاقة مؤسساتية ملزمة اجتماعيًا أو أخلاقيًا، فلا هي ضمن منظومة القيم التقليدية للبطل، ولا هي جزء من المجتمع الفاسد إلا من خلال هويتها كضحية مهمشة، ولكنها الجسد والعاطفة الأنثوية اللازمة لاستكمال مشهد الرجولة. وهكذا فقد ساهمت الشخصيات النسائية في رسم الصورة المحورية للبطل الرجل من خلال وضعهن الهامشي. وهذه الصورة الرجولية هي التي يرى المشاهد من خلالها علاقة البطل بالمؤسسة الأمنية. فهي ليست علاقة مجرم بمؤسسة تتلاعب به، ولكنها علاقة بين رجل ملتزم أخلاقيًا تجاه أمه، وذكر محبوب لعشيقته، وحامل لقيمة الشرف في مواجهة جهاز أمن لا يرى فيه سوى مجرم يمكن توظيفه لأغراض أخرى. يعيدنا هذا إلى السؤال الرئيسي وهو: هل ينطوى فيلم الهروب على نظرة تقليدية للمرأة، لا تتجاهل فقط ما لها من حقوق، بل تبررها؟ لا شك أن رسالة الفيلم نبيلة من حيث أحد جوانبها، أي ذلك الجانب السياسي الذي يكشف ممارسات أحد أهم أجهزة الدولة. فالنقد السياسي واضح ويحتل المشهد بكامله. ولكن المشكلة أن مثل هذه الرسائل النبيلة قد تنطوى على تناقضات ومفارقات. فقد نتحدث عن حرية ما ونتجاهل حريات وحقوق أخرى. وفى تصوري أن أفكار عاطف الطيب “التقدمية” تعكس مفردات الواقع الثقافي المهين والذي لا يقدم خطابًا متماسكًا حول الحقوق والحريات، بل يصنفها ضمن سلم أولويات يعكس، بشكل صريح أو ضمني، خلفياتنا ومعتقداتنا السياسية والأيديولوجية. فالمثقف المصرى، كمثال، يضع القضايا في مراتب وضمن أولويات تتفاوت في أهميتها، فعلى رأس القائمة كانت ومازالت القضايا الوطنية والتي تقدم دائمًا بوصفها القضايا الكبرى، ويليها في الأهمية قضايا اجتماعية سياسية كتلك التي ظهرت، كقضايا أساسية، في سياق نقد سياسات الانفتاح في مرحلة ما بعد الناصرية مثل قضايا الفساد وتغير القيم الاجتماعية. ثم جاءت بعض قضايا حقوق الإنسان المدنية والسياسية، وتنتهى القائمة بما يمكن أن نسميه بالقضايا الصغرى أو الثانوية وفي مقدمتها قضايا المرأة. وتبقى هناك اختلافات بين المثقفين فيما يتعلق برؤيتهم للقضايا وتصنيفها فقضية المرأة تم تناولها في السينما المصرية بشكل جيد وإبداعي من قبل العديد من الأفلام في سياق محاربة العادات والتقاليد السلبية التي تكبل المجتمع، ومنها جريمة القتل على خلفية الشرف، والتمييز في العمل وقوانين الأسرة إلخ. إن المسارين المشار إليهما، هما إشارة إلى تلك القسمة التي تضع السياسي في مرتبة القضايا الكبرى، التي يجب على المثقف الملتزم أن ينقدها ويبرزها ويجعلها مرئية، أما القضايا الصغرى (وهي هنا جريمة الشرف المحتملة) فهي منخفضة إلى حد التوظيف الدرامي. وقد تبدو وكأنها مسألة هامشية، ولكنها في حقيقة الأمر مسألة محورية في هامشيتها لأنها ركيزة الرجولة التي يجب على المشاهد أن يتعاطف معها. إن الهروب من أجهزة الأمن، ليس هروبًا من أجل القتل، ولكنه هروب من أجل استعادة الكرامة، ووضع نهاية “للشرف الجريح”. فبطل الفيلم، الذي سيصبح موضوعًا لكشف آلية عمل السلطة الأمنية، هو رجل من الصعيد يمتلك كل مقومات الرجولة المرغوبة في وعينا العام، وفي مقدمة ذلك كرامته “الذكورية” والتي أصيبت في مقتل بعدما خانته زوجته وهربت. وهكذا تصبح علامة الرجولة هي “الشرف الجريح” والذي لن يستعاد إلا بقتل من تسببت في هذا الجرح. وفي تصوري أن الفيلم قد نجح في نقل رسالة تبرز حقوقًا وتخفى أخرى بل وتبررها، وأعنى بذلك كشف انتهاكات وألاعيب المؤسسة الأمنية، وإخفاء القتل على خلفية الشرف وتوظيفه. وفي هذا السياق أضرب مثالاً أعتقد أنه بالغ الدلالة. لقد حظى الفيلم باهتمام منظمات حقوق الإنسان، بوصفه أحد الأعمال الفنية الجريئة لمخرج لم يأل جهدًا لكشف انتهاكات السلطة. وقد عقد مركز حقوق الإنسان لمساعدة السجناء ندوة عن الفيلم تحدث فيها الدكتور ناجي فوزی(www.hercap.org/SEMINARS/cenima/hroub.htm#1). وقد حددت الورقة الخلفية لهذه الندوة مجموعة من القضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان مثل الاعتداء على حرية المواطن بدون سند قانوني، ووضع السجناء أو المحتجزين، وقضايا أخرى. وبالطبع لم يرد ذكر جريمة الشرف المحتملة والمحورية في الفيلم كانتهاك للحق في الحياة. ولكن اللافت للنظر في هذه الندوة هو عنوانها حيث جاءت بعنوان “ثمن الكرامة”. ودلالة هذا العنوان واضحة بمعنى أنها تشير إلى قراءة ما للحبكة الدرامية بمساريها، فالمسار الشخصي (المتمحور حول جريمة قتل محتملة من أجل استعادة الشرف) صيغ ونظر إليه بطريقة تؤكد وتعلى من شأن الكرامة، وهكذا تمت صياغة المسار الثاني المتمثل في ممارسات الجهاز الأمني على أنه ليس مجرد انتهاك لحقوق الإنسان، بل جدار عازل لتحقق كرامة البطل والتي دفع ثمنها بعد قتله على يد الشرطة. إذا صحت هذه القراءة لفيلم الهروب، فإن قضية صورة المرأة لن تكون مشكلة الأفلام التجارية فقط، أي تلك الأفلام التي توظف جسد المرأة وتعيد إنتاج المنظومات القيمية السائدة، فثمة أعمال فنية ناقدة ومدافعة عن الحريات، إلا أنها تظل أسيرة النظرة التقليدية للمرأة. والأخطر هو أن يجرى التعامل مع هذه الأعمال من قبل المدافعين عن حقوق الإنسان برؤية لا ترى الحقوق في تكاملها. وفي اعتقادي أنه من السهل كشف ونقد الأعمال التي توظف جسد المرأة لأنها واضحة (وكثيرة لحد الفجاجة) في موقفها وفي رسالتها، ولكن المعضلة الحقيقية تبرز عندما يجرى توظيف المرأة لخدمة قضايا سياسية أو حقوقية، فتصبح حقوق النساء ضحية الدفاع عن أو إبراز حقوق أخرى.کی أنفخ بعضًا من الحياة في كل هذا التجريدات، دعوني اتجه الآن إلى الخيال الأدبي العائلي والصعوبات التي يواجهها الباحثون حين يحاولون وضع كتابة هذا النوع في كتب التاريخ. يصف “إيان وات” على نحو مقنع الطابع الاجتماعي الاقتصادي للقراء الجدد الذين كتب لهم ديفو وريتشاردسون وفيلدينج، وهم القراء الذين أدى ظهورهم بدوره إلى ظهور الرواية. ولكن “وات” ليس لديه تفسير مشابه بالنسبة لـ “جين أوستن”. فشعبيتها تعزى إلى موهبتها، وتعزى موهبتها إلى الطبيعة، وهو بذلك ينتهى إلى أنه من المؤكد أن الطبيعة منحت “أوستن” عينًا قادرة على رؤية التفاصيل1. ومع أن “ويليامز” يتجاوز نظريات التأمل تلك في روايته شديدة الإبداع لثورة المعلومات، فإن نموذج التاريخ الخاص به لا يخدمنا في النهاية بشكل أفضل مما يخدمنا به نموذج وات حين يتصل الأمر بتفسير الخيال الأدبي العائلي. ويعتبر كتابه Long Revolution العمل الفكري قوة سياسية في حد ذاتها ما كان للرأسمالية بدونها أن تنتشر بالقدر الذي يبدو أنها انتشرت به من يسر واكتمال. ولكن مهما كانت القوة التي يمنحها “ويليامز” لهذا المجال، فهي تخص الثقافة، وهي بذلك توجد كعلاقة ثانوية مع التاريخ السياسي. ولإضفاء الصبغة التاريخية على الكتابة، يشعر “ويليامز” أنه مضطر لأن يجعل لها أصلاً في أحداث خارج الكتابة وسابقة لها. وهو لا يأخذ في اعتباره إمكانية أن الانتشار الكلاسيكي للرأسمالية تأسس على الكتابة، وبشكل أقل بكثير على كتابة النساء أو الكتابة التي تخاطب مصالح القارئات2. ويرى “ويليامز” وكذلك “وات” أن الأحداث التاريخية تقع في المؤسسات الرسمية للدولة أو من خلال مقاومة تلك المؤسسات، وأن كلا شكلي السلطة يمارس في المقام الأول من خلال الرجال.
وجدت أن وات وويليامز مفيدان بشكل خاص في إقامة الصلات بين تاريخ الخيال الأدبي وظهور الطبقات الوسطى الجديدة في إنجلترا. وأنا في الوقت نفسه أشعر بالارتباك حين أجد أنه أثناء إقامة العلاقة بين الكتابة والتاريخ السياسي فإن هذين الباحثين اللذين يعملان بما يمليه عليه ضميرهما في غير ذلك يهملان تمامًا تبرير الحقيقة الأكثر وضوحًا، وهي أنه في وقت ما من القرن الثامن عشر، وطبقًا لكلمات فيرجينيا وولف “بدأت نساء الطبقة الوسطى الكتابة”3. وإذا كان ظهور الرواية، كما يقول وات وويليامز، يرتبط ارتباطًا مباشرًا بظهور الطبقات الوسطى الجديدة، فحينئذ نجد أن أفضل أدلتنا الأدبية تشير إلى أن ظهور الرواية ارتبط بنشوء كتابة النساء كذلك. وبالطبع فقد ضاعفت المصاعب التي يستتبعها إضفاء الصبغة التاريخية على الخيال الأدبي بإثارة هذه المسألة، ذلك أننى أشرت إلى أنه لكى نضفى الصبغة التاريخية على الخيال الأدبي لا بد أن نضفي الصبغة السياسية ليس على العمل الفكري فحسب بل على العمل الأنثوى كذلك. ويوجد قدر كبير من الخيال الأدبي البريطاني عند تقاطع هذين النسقين الحديثين بشكل محدد من الثقافة، وهو بذلك يبعد عن التيار العام للتاريخ السياسي على نحو مضاعف.
الكتابة التي أسميها الخيال الأدبي العائلي كتابة تتسم بالنوعية، فهي على عكس أعمال الأديبات الأوليات تصل إلينا على أنها كتابة نساء. وتسمية كتابة معينة بأنها أنثوية يعني تسمية الكتابة الأخرى بالذكورية. والمضمون الذي يميز رواية لجين أوستن لا يميز “العالم” الخاص بها عن عالم شكسبير أو بليك أو ديكنز أو بيتس فحسب، فالحدود التي تقيمها بين الداخل والخارج حدود شخصية على نحو أكثر اتساعًا وأهمية من الناحية التاريخية. وهي تحدد الفرق بين العالم الذي للروائيات عليه سلطان- مجال الشخصي- وذلك العالم الذي يسيطر عليه الرجال وسياستهم. وعندما تفعل أوستن ذلك تجعل ريتشاردسون أبًا الرواية، لأنها، مثله، تربط عمل الروائي بكتابة النساء وكذلك بأشكال أخرى من العمل نسائية بشكل مناسب4. ولكي نتجاوز المأزق الذي يمنعنا من وضع هذا العمل في سياقه داخل التاريخ، يبدو لي أن علينا التخلص من فكرة أن جندرة مناطق واسعة من الثقافة كان نتيجة لأحداث سياسية كانت السيطرة عليها للرجال. وحين نعتبر الجندر نفسه تشكيلاً سياسيًا تعطى الثقافات الحديثة للنساء سلطانًا عليه، سوف يكون علينا قلب هذه الأولويات. وعندما نفعل ذلك نواجه احتمال حدوث ثورة في البيت قبل انتشار نظام المصنع وكل ما قام على تحوله إلى وسيلة لتوزيع ثروة البلاد5.
لكي أتعامل مع هذا الاحتمال، أبدأ بالافتراض الذي طرحه ماركس في “الأيديولوجيا الألمانية” وطوره جرامشى فيما بعد ليصبح مفهوم “الهيمنة” في مقالاته حول تكوين المثقفين وتنظيم الثقافة والتعليم؛ فلا تكتمل الثورة السياسية بدون الثورة الثقافية. فلكي تهيمن الجماعة السائدة لا بد لها أن تقدم للجميع رؤية تجعل شكل الهيمنة يبدو حقيقيًا وضروريًا، إن لم يكن مرغوبًا فيه وصحيحًا. وطور جرامشى التناقض الكامن المتأصل في فكرة العمل الخاصة بماركس- وهي أن العمل ليس سلعة فحسب، بل ممارسة خاصة كذلك- ليصبح نظرية أكدت تعدد جوانب سلطة الطبقة الوسطى؛ فهو لم يسيطر على البعد المادى للإنتاج فحسب، بل على البعد الاجتماعى كذلك. وعلاوة على ذلك، رأى جرامشي خلال القرن العشرين أن شكل السلطة الذي يعمل من خلال الموقع المكاني والإشراف وعلاقة الفرد بالآلات يفسح الطريق لشيء أكثر انتشارًا- السيطرة البيروقراطية التي تقسم الأفراد وترتبهم كي تضع عملهم على مستويات اجتماعية منفصلة. والواقع أنه عندما جرى تعميم الأجر ليشمل أفراد هذه البيروقراطية وغيرها من البيروقراطيات، انكمش عدد من يؤدون العمل الإنتاجي وأهميتهم.
لهذا السب، فقد بدأ مؤخرًا عدد من يعملون منا في الإنسانيات والعلوم الاجتماعية يشعرون بأن نظريات المقاومة التي تقوم على طبقة ذات صبغة جوهرية أو أية جماعة ذات صبغة جوهرية، فيما يتعلق بهذا الأمر، لن تكون مناسبة. وما إن تتناول النظرية تلك الجوهريات حتى لا تعود تمثل إمكانية دمج السلطة خارج المجتمع التعددي. بل إنها تحدد المواقف المتناقضة داخل ذلك النظام، حيث لا تدعم بذلك إلا مزيد من الفروق في النظام التفاضلى القائم على مستوى تجريدي من الأفكار، ومع ذلك فالنظام الذي أشير إليه ليس نظامًا في المجرد، بل هو المؤسسة التأديبية ذاتها. وهو حين يتحرك بتثاقل بواسطة التشابه من موقع ثقافي إلى آخر يصل إلى وضع النموذج الفكري. وتضيع القضايا السياسية في بنيته المفتتة. إن لكل شيء أهميته. وكل الحقائق متكافئة- غير أن البعض منها معقد، وهو في هذا الجانب وحده أكثر إرضاءً من غيره، وفي متاهة الاختلافات، اختفى الفرق بين الإيجابي والسلبي، ويبدو أن فردوس الليبرالية وشيك المنال6.
وعند إدراكها اللحظة التاريخية على هذا النحو، يمكن للواحدة أن تعتبر نفسها في ضوء شدید المادية خاص بالافتراضات الفوكوية بأن الدولة الحديثة خلقت في الكتابة، وأنها موجودة بشكل أساسي حالة ذهنية، وتؤبد نفسها من خلال جمع المعلومات وتنظيمها ونشرها على نحو شديد التنظيم. وفكرة النظام الذي يسميه فوكو في بعض الأحيان “الخطاب” أو “السلطة” وفي أحيان أخرى “الجنسانية” أو “التأديب” هي في واقع الأمر فكرة سائدة. غير أنه في عالم من المؤكد أن الأفكار تحكمه على نحو يزيد على حكم الوسائل الاقتصادية المادية له، لابد أن تكون حريصين إلى حد كبير على ألا نفترض وجود “واقع” مناظر باعتباره مصدرًا لها. ولا يمكننا أن نمنح تلك الأفكار ما حققته من استقلالية وكلية وترابط غامض، غير أنه لا يسعنا كذلك البحث عن حقيقة أكثر أولية قبلها أو دونها. بل يجب علينا فهمها، كما يقترح فوكو، على أنها الإدراك الذاتي لطبقة حققت الهيمنة. وتعتمد الهيمنة في حالة المجتمعات ما بعد الصناعية الحديثة على الإدراك الذاتي القادر على ابتلاع كل معارضة في نظام واحد من الاختلافات متناهية الصغر.
تعتمد قوة النظام على إنتاج شكل بعينه من الوعي يتسم بالتفرد ويضع المعايير. وبدلاً مما يسميه “الفرضية القمعية”، وهو افتراض أن الثقافة إما “تقمع” رغبة الفرد أو “تفرض نفسها عليه، يقدم فوكو فرضية منتجة قلبت هذه البديهية رأسًا على عقب، فهو يقول في المجلد الأول من كتابه “تاريخ الجنسانية” إن أشكال الذاتية التي نعتبرها أشد ما تكون ضرورية لنا باعتبارنا ذوات لم يكن لها وجود قبل إضفاء الصبغة الرمزية عليها، وإن أعمق دخائل وجودنا وأكثرها خصوصية من إنتاج الثقافة7. وقد أعد كتابه “المراقبة والعقاب” مقولة تاريخية مفصلة كي يبين أن حقيقة الفرد الحديث وجدت أولاً ككتابة، قبل تحويل الإنسان بنجاح إلى كلام وفكر ورغبة باطنة8. وهكذا يمكننا فوكو من رؤية التنوير الأوروبي على أنه ثورة في الكلمات، وهو ما أعطى الكتابة سلطة جديدة ورهيبة على عالم الأشياء، حيث شكلت الأشخاص الذين أقاموا علاقة مع العالم من خلال القراءة. ويمكنني القول بأنه في إنجلترا كانت تلك الثورة الثقافية النوع الوحيد من الثورة الذي حدث خلال القرن الثامن عشر، لأن الثورة في الكلمات داخل إنجلترا اتخذت شكلاً حال دون وقوع الثورة الشعبية9.
بعد إزالة الحاجز المفاهيمي بين الكتابة والتاريخ السياسي، مهدنا الطريق لرؤية العمل الفكرى للنساء باعتباره جزءًا من تيار الأحداث السياسية العام. إلا أن فوكو لن يساعدنا في تحقيق هذه الخطوة على وجه التحديد. فهو في كتابه “تاريخ الجنسانية” غير مهتم بتاريخ الجندر. كما أن الكتاب لا يتناول الدور الذي قامت به الكتابة من أجل النساء وبواسطتهن وحولهن في تاريخ الجنسانية. ولهذا السبب لا تحدد إجراءاته الأحداث التي فصلت الحياة الأسرية عن السياسة، وتلك هي نفسها الأحداث التي تربط تكوين المجال العائلى بتطور الثقافة المؤسسية في إنجلترا. ويتغاضى كتاب فوكو “المراقبة والعقاب” عن حقيقة كون الأسرة المعيشية الحديثة بمثابة النموذج الأولى الأساسي للمؤسسات الحديثة. كما يهمل كتابه “تاريخ الجنسانية” تنظير سلطة ذلك النموذج الأولى كما تتدفق من هذه الرواية للحياة الشخصية الحديثة إلى روايته الخاصة بالسلطة المؤسسية لإشباع نظرية التأديب وتوضيحها. وبالرغم من الاتجاه اللاديكارتي لكتابه، لا يقتحم فوكو بشكل نهائي الحاجز الذي يفصل موقفه كمنظر للذات الجنسية في “تاريخ الجنسانية” عن الموقف الذي تبناہ کی ينظر الذات السياسية في “المراقبة والعقاب”. ومع ذلك فهو لا يستخدم المجاز نفسه فحسب ليتأمل الاثنتين؛ بل إنه يعطى كذلك النظريات المنتجة للذات الجنسية (تلك التي تنظم البيت) الأولية في هذا التفكير بشأن الاستراتيجيات التي تخضع الفرد للدولة (تلك الخاصة بالمؤسسات التأديبية).
أهم نقطة في الفصل المهم عن “نزعة المراقبة المركزية” في كتاب فوكو “المراقبة والعقاب” هي مجازه الخاص بالمدينة التي تعرضت للطاعون. فعلى عكس الجذام، الذي يدعو إلى استراتيجيات مانعة أكثر اتساقا مع الخيال الأرستقراطي للسلطة، يبدو أن الطاعون، کما يلعب هو بالمجاز، يتطلب الاحتواء والحصر باعتبارهما شرطين لنظام المراقبة الحديث. وتقسيم الناس إلى أقسام فرعية يتزايد صغرها تكون الأسرة المعيشية هي وحدة قياسها يتبعه التطهير الطقسي لكل أسرة معيشية:
بعد خمسة أو ستة أيام من بداية الحجر الصحي، بدأت عملية تطهير المنازل الواحد تلو الآخر. وقد طلب من السكان جميعًا مغادرة المنازل؛ وفي كل غرفة يرفع “الأثاث والسلع” من على الأرض أو تعلق في الهواء؛ وينثر العطر في أنحاء الغرفة؛ وبعد إحكام غلق النوافذ والأبواب، وحتى فتحات المفاتيح، بالشمع، يشعل العطر. وبعد ذلك يغلق المنزل بالكامل بينما يستنفد العطر؛ ويفتش الذين نفذوا العمل، مثلما فتشوا عند الدخول “في حضور سكان المنزل، كي يروا أنهم حين غادروا لم يكن معهم شيء لم يكن بحوزتهم عند الدخول“. وبعد أربع ساعات يسمح للسكان بدخول المنزل من جديد. (ص 177).
ينتج مثل هذا الحصر والتطهير للمنزل أسرة معيشية جديدة خالية من أثر أي اتصال غير منظم مع العالم، ويكون غشاؤها قابلاً لأن تنفذ منه أنواع بعينها من المعلومات. وعند قراءتي لهذه الرواية عن الطاعون أفاجأ بالفرق بين مكانه في الخيال الحديث واستخدامه بواسطة بوكاتشيو، الذي تخيل مجتمعًا أرستقراطيًا صغيرًا جرت حمايته بأمان في الريف لقضاء الوقت خاليًا من عدوى المدينة. وفي هذا العالم الحديث الباكر ينظر إلى الذين بقوا في المدينة على أنهم جماعة اجتماعية مختلفة بالمرة، تتصرف مثل الجماعة المشاغبة التي يمكن اختراقها على نحو كبير واحتفى بها باختين. فما أهمية أن يتخيل فوكو، على عكس باختين، مدينة تجرى تنقيتها من الداخل للخارج عن طريق إنتاج فضاءات منزلية نقية من الناحية الصحية داخل الدولة! وفى هذه المحاولة لتخيل الحاضر من موقع الماضي، تكون الأسرة المعيشية بمثابة فضاءات سحرية يذهب فيها الناس للموت عسى أن يولدوا من جديدة كأفراد حديثين- محصورين ومنظمين لأنفسهم.
بعد أن يسعى فوكو للوصول إلى هذا المنطق الداخلي لمجازه على هذا النحو، نجده يوسعه للخارج من العالم العائلي المحصور حديثًا- كأنه نتيجة لمصدر جديد للسلطة- إلى المجالات الثقافية والسياسية، ومنها إلى التاريخ. وهو يشير في البداية إلى كيف أن “الخيال الأدبي كله الخاص بالمهرجان نما حول الطاعون: القوانين المعلقة، والمحظورات المرفوعة، وجنون الزمن المنقضي، والأجسام المختلطة ببعضها بدون احترام، والأفراد غير المقنعين الذين يتخلون عن هويتهم الرسمية والشكل الذي كان يتم التعرف عليهم من خلاله، مما يسمح بحقيقة مختلفة تمامًا بالظهور. ويستمر في كلامه فيقول “ولكن كان هناك كذلك حلم سیاسي خاص بالطاعون، كان مناقضًا له تمامًا؛ ليس المهرجان الجماعي، وإنها التقسيمات المقيدة؛ وليس القوانين التي يتم التعدى عليها، وإنما اختراق التنظيم وصولاً إلى حتى أصغر تفاصيل الحياة اليومية…؛ وليس الأقنعة التي تلبس وتخلع، بل أن يخصص لكل فرد اسمه “الحقيقي”، ومكانه “الحقيقي”، ومرضه “الحقيقي” (ص 197- 198). وهكذا تقوم نظرية فوكو الكاملة الخاصة بتطور المؤسسات الحديثة على الصورة المجازية للمدينة التي أصابها الطاعون: “إذا كان صحيحًا أن الجذام أدى إلى ظهور طقوس العزل، التي كانت إلى حد ما بمثابة النموذج لشكل عام للمحبس الكبير، ثم أدى الطاعون إلى ظهور المشروعات التأديبية” (ص 198). ويسمح له الاستخدام المجازي للمرض بإعلان مستشفى القرن الثامن عشر بمسرحه المستقل على أنه النموذج الأولى التاريخي للسجن الحديث.
ومن المؤكد أن فوكو يعجبني لتخطيه الحد الفاصل بين العلاجي والعقابي لبيان مقدار ما يشتركان فيه. غير أني أظن أن هذه كذلك طريقة لتحاشى الدلالات الكاملة لمجازه المختار، وهو المدينة التي أصابها الطاعون، وهي الدلالات التي قد تقضى على الاختلافات بين الذات الجنسية والذات السياسية، وبين هاتين الذاتين والجسم المادي للذات، وجميعها تقوم على الحفاظ على الخط الذي يقسّم المعلومات الثقافية بناء على النوع. وهذا هو الفاصل بين الداخل والخارج المزروع في مجازه منذ البداية لتمييز الشخصي عن الحياة السياسية. وهذا هو أول تقسيم للزيجوت المفاهيمي، وهو الخط الذي لا يمكن بدونه لخيال العالم السياسي كله أن يوجد نظامه العنيد، والتماثل الذي ينفذ إلى الملامح المحددة التي تعرضها الثقافة في جانب ما وليس في غيره. وبينما يفتح فوكو السلطة السياسية على نحو كبير لتشمل مؤسسات غير تلك المكلفة رسميًا بتوزيع الثروة والسلطة، فهو يوسع المجال الثقافي للتأديب فقط إلى الحد الذي باتت معه المؤسسات، عندما صارت مؤسسات، خاضعة لسيطرة الرجال، وهكذا فإذا كانت السلطة لا تنشأ في عقول الرجال الأفراد أو داخل أجسام الرجال على نحو جماعي، فهي تنشأ نتيجة للأنماط الثقافية التي تجعل الرجال يفكرون في أنفسهم كأنواع بعينها من الرجال ويمارسون السلطة بناءً على ذلك.
ولكن إذا سعينا للوصول إلى دلالات مجاز فوكو الخاص بالسلطة الحديثة، فإن مدينته التي أصابها الطاعون، مقابل علاج بوكاتشيو، تحتوى على شكل من الأسرة المعيشية التي هي الحل المثالى والواضح لاختلاط الأجسام غير المقيد الذي ينشر العدوى. وعندما توسع مفهومنا الخاص بالسياسي على نحو يزيد على فوكو، فإننا نكتشف الأسس التي تقول على أساسها إن الأسرة المعيشية الحديثة وليس العيادة هي التي قدمت الوضع المؤسسي الأولى الذي ظهرت فيه الحكومة لأول مرة من خلال الإشراف القاسي، وظهرت في صورتها الأكثر خيرية. ولم يتنبه فوكو إلى ذلك التواصل بين البيت والدولة بالرغم من وضوحه وضوح الكلمات التي على صفحته. ومع ذلك فالأكثر غرابة هو عدم اعترافه بحقيقة أن البيت الذي تدافع عنه جماعات فرعية عديدة تطمح إلى وضع “الجدارة بالاحترام”، وهو البيت الذي تشرف عليه امرأة، سبق تكوين المؤسسات الاجتماعية الأخرى بخمسين سنة على الأقل. وليس هناك الكثير الذي يشير إلى أن هذه الأسرة المعيشية لها جذورها في التطبيق قبل بداية القرن التاسع عشر بكثير، بالرغم من ظهورها في كثير من الأحيان في الأدب والمجادلة السياسية الخاصة بالقرن السابق. ويمكن القول إنه نتيجة للكتابة انتقلت الأسرة الجديدة إلى مجال الحكم السليم، حيث باتت تبرر توزيع الثروة الوطنية من خلال الأجور التي تدفع للرجال، والواقع أنها لا تزال حتى يومنا هذا تتمتع بقدر كبير من النفوذ كمجاز وكناية، وكنموذج غير معترف به، وكمصدر لسلطة الطبقة الوسطى.10
هذه هي النقطة من مناقشتي التي يجب فيها الاستعانة بالرؤية النسوية، غير أنه لا يمكن أن تنغمس النزعة النسوية على نحو مريح في خطاب الظلم. فلا بد من تسييسها بالكامل. وأعنى بذلك أنه يجب علينا أن نكون مستعدين لقبول فكرة أننا، كنساء الطبقة الوسطى، ممكنات، وإن لم نكن ممكنات على النحو الذي جرى العرف على أنه ذكوري. ولابد أن تعترف بأننا كمفكرات تنتمي إلى الطبقة الوسطى لسنا مرايا نقدية لعملية منفصلة وأكثر أولية ينظمها الآخرون- سواء أكان هؤلاء الآخرون هم الساسة أو البيروقراطيين أو قباطنة الصناعة، أو مجرد الرجال. ونحن كمفكرات متورطات على نحو مضاعف في عملية إعادة إنتاج الحالة الذهنية التي تقوم عليها المؤسسات الأخرى ذات الطابع السياسي الصريح والعلني. وعلى هذا الأساس أرفض فكرة أن كتابة النساء توجد في مجال خبرة خارج التاريخ أن هذه الكتابة السياسي. فأنا لم يعد بمقدوري قبول ما تفترضه كتب التاريخ التقليدية- وهو أن هذه الكتابة تشغل المكانة الثانية الخاصة بـ “تأمل” أو “نتائج” التغيرات داخل المؤسسات الاجتماعية الأكثر أولية- أي الجيش أو المستشفى أو السجن أو المصنع. فعلى العكس من ذلك، يكشف ما لدى من أدلة أن الرواية العائلية خلصت لغة العلاقة الجنسية من لغة الاقتصاد السياسي. ووضع خطاب هذه الرواية (طبقًا لمعنى هذا المصطلح الخاص بواين بوث) منطقًا ثقافيًا جديدًا أصبح في النهاية الحكم السليم والحساسية والرأى العام. وبهذه الطريقة نجحت المعرفة الأنثوية في محاربة نوع من السلطة يقوم على اللقب والثروة والقوة البدنية بنوع آخر من السلطة قوامه السيطرة على القراءة والكتابة. وعن طريق معادلة القراءة الجيدة بما كان مفيدًا للقارئات، وضع المستوى الجديد للقراءة الأساس الدلالي للحكم السليم ووضع التقاليد السردية التي تشكل الرأى العام. وساعد المعيار الجديد لمعرفة القراءة والكتابة ظهور طبقة جديدة من الناس إلى الوجود. وقد طالبت تلك الطبقة بحق الخصوصية بالنيابة عن كل فرد. ومع ذلك فقد حركت هذه الطبقة الغزو المنظم للحياة الخاصة من خلال المراقبة والملاحظة والتقييم والعلاج، وباختصار، فقد حكمت، ومازالت تحكم، من خلال ما لا حصر له من- التكنيكات متناهية الصغر الخاصة بالتنشئة الاجتماعية التي قد يمكن تجميعها كلها تحت عنوان التعليم.11 وخلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر، أنشئت مؤسسات لأداء تلك العمليات لجماهير الناس بالطريقة نفسها التي كانت تتبعها الرواية العائلية مع شخصياتها.
الكثيرات منا اللائي نشأن داخل ثقافة مؤسسية حملن في نهاية الأمر صوتًا يشبه كثيرًا ذلك الصوت الذي كان في رأس راوي الرواية أو راويتها. ولأنهن لديهن حساسية تجاه أدنى علامة من علامات الاضطراب- كلمة بذيئة، أو قطعة ملابس غير ملائمة، أو بعض الطعام ينزلق من على الشوكة، أو الأسوأ من ذلك وهو فقدان السيطرة على وظائف الجسم- فمن المؤكد أكثر أن وجود هذا الصوت، الذي يبلغ عمره الآن حوالي مائتي عام، يجعلنا نجاری الشرطة أو الجيش ولسن خائفات منهما. فأشكال السلطة غير الرسمية لها ميزة رهيبة على تلك الأشكال النظامية على نحو صريح وعلني. إنها تجعلنا خائفات من أنفسنا. وهي تعمل طبقًا لافتراض أننا نؤوى رغبات ضارة للمصلحة العامة. وإيمانًا منا بوجود الذات القامين أساسًا، فإننا نراقب أنفسنا- في المرايا، وعلى الساعات، وعلى الموازين، ومن خلال الفحوص الطبية، وبواسطة أي عدد من الممارسات الأخرى كهذه. ونحن بذلك نغرس في نفوسنا حالة تقوم على الصراع بين الذات ومصالح الدولة، ونشعر بأننا مؤهلات تمامًا لتطبيق سلطتها- التي هي على أية حال مفيدة لمن يطبقها فحسب- على الآخرين.
اقتناعًا منی عن بأن السلطة التي تمارس داخل المجال الأنثوى ومن خلاله هي على أقل تقدير على نفس القدر من القوة التي تتسم بها أشكال السلطة التقليدية المرتبطة بالذكور، فإنى أرغب في رسم صورة سريعة للعلاقة بين الاثنتين خلال العصر الحديث. وسوف أشير إلى أن الثقافات المؤسسية الحديثة تقوم على فصل “السياسي” “الشخصي” وأنها تنتج هذا الفصل وتحافظ عليه على أساس نوعي- أي تكوين المجالات الذكورية والأنثوية للثقافة. فأنا أرى أنه حتى حين فصلت أشكال بعينها من المعلومات الثقافية داخل هذين المجالين المتناقضين، فقد جمع بينها باعتبارها مجموعة معقدة من الضغوط التي تعمل على جسم الشخص وعقله لحثه على التنظيم الذاتي، وربما أمكننا ملاحظة هذا التعاون شديد الفعالية بين تلك الأشكال الرسمية وغير الرسمية للسلطة كأوضح ما يكون في تكوين نظام التعليم القومي خلال العصر الفيكتوري وفي منظومة الجهود كلها التي استمرت في الوقت نفسه لتخصيص وقت الفراغ.12 وتسهم الرواية البريطانية بنوعي الجهود، ولذلك فهى تعرض أنماط التعاون بينهما.
لتقديم ماريا إيدجورث ووالدها لكتابها بالغ التأثير Practical Education في عام 1801 يعلنان الانفصال عن المنهج الدراسي الذي يعزز التمييزات السياسية التقليدية: “لقد صمتنا فيما يتعلق بالدين والسياسة لأننا لا نطمح إلى كسب الأنصار، أو من يغيرون معتقداتهم وينضمون إلينا، ولأننا لا نوجه كلامنا إلى أية طائفة أو أي حزب”13. وهما يؤكدان للقارئ في الوقت ذاته أنه “فيما يتعلق بها أشيع تسميته بتعليم القلب، فقد سعينا إلى اقتراح أيسر سبل الحث على العادات المفيدة واللائقة، والتعاطف المنظم إلى حد كبير، والعواطف الخيرية” (ص viii). ويستعيض برنامجهما عن مصطلحي العاطفة والسلوك المجردين بمصطلحات هوية الشخص الاقتصادية الاجتماعية المحددة. وغرسًا للهوية في الصفات الذاتية نفسها التي سعت المناهج الدراسية السابقة إلى تلقينها للشابات وحدهن، يعطى برنامج إيدجورث أولوية لغرفة الدراسة وقاعة الجلوس على الكنيسة والمحاكم بأغراض تنظيم السلوك الإنساني. وبذلك يعد برنامجهما التعليمي بكبت العلامات السياسية الخاصة بالهوية الإنسانية (وهي في حد ذاتها إشارة سياسية قوية). ولأن ماريا إيدچورث ووالدها يدركان تمامًا السلطة التي يمكن ممارستها من التعليم، فهما يؤهلان منهجهما لتعليم القلب على أساس أن يوفر طريقة جديدة وأكثر فاعلية للرقابة. وهما يقولان إن “عمل التعليم هو منع الجرائم، والحيلولة دون كل تلك الميول المعتادة التي تؤدي بالضرورة إلى ارتكابها” (ص 354).
لکی تحقق ماريا إيدچورث ووالدها هدفها السياسي الطموح فإنهما يستعينان باقتصاد المتعة الذي لا يمكن فهمه في الواقع بمعزل عن الرواية والنقد الذي كان ينتج لمراقبتها وتشجيعها. وأول كل شيء هو أن ماريا إيدجورث ووالدها يقبلان وجهة النظر التي كانت سائدة خلال القرن الثامن عشر وتقول إنه من المؤكد أن الرواية تضلل الرغبة الأنثوية:
فيما يتعلق بالقصص العاطفية، وكتب الترفيه المجرد، لابد أن نشير إلى أنه ينبغي استخدامها بحساب، وخاصةً في تعليم الفتيات. فهذا النوع من القراءة ينمى ما يسمى القلب قبل الأوان، ويحد من صوت العقل، ويحث على عدم الاكتراث بتلك المتع والأعمال الشائعة التي… تشكل إلى حد كبير الجزء الأعظم من سعادتنا اليومية. (ص 105)
غير أنه هذا التحول العقلي ذاته أمكنه التعرف بسهولة على القيمة العملية للمتعة حينما يستفاد منها وتوجه إلى الأهداف الصحيحة. ولأن المربين ذوى التفكير المتقدم مقتنعون بأن “متعة الأدب” تؤثر على القارئ بالطريقة نفسها التي يؤثر بها “تذوق الحلويات” على الطفل (ص 80)، فقد بدأوا يقرون قراءة الروايات، ما دامت محكومة بالمبادئ التي تجعل التوافق أمرًا مرغوبًا فيه.
عند صياغة نظرية للتعليم الجماعي يكون فيه للرواية دور هامشي على نحو خادع تقوم به، كانت ماريا إيدجورث ووالدها وزملاؤهما يتبنون خطابًا استخدمه المصلحون السابقون لتوجيه اتهامات بالعنف والفساد للأرستقراطية القديمة. وقد وضعوا أنفسهم داخل تراث من المعارضة البروتستانتية المتشددة يعود إلى القرن السادس عشر، وهو التراث الذي يقول باستمرار إنه ينبغي على السلطة السياسية أن تقوم على التفوق الأخلاقي. ووفرت العلاقات الجنسية إلى شروط التقدم بهذا الادعاء بحيث لا يمكن اعتبار أي تصوير للأسرة المعيشية محايدًا من الناحية السياسية. وللطعن في تلك الفكرة الخاصة بالدولة التي تقوم على السلطة الموروثة، صورت الأطروحات البيوريتانية عن الزواج وحوكمة الأسرة المعيشية الأسرة على أنها وحدة اجتماعية منغلقة على نفسها ليس للدولة حق التدخل في شئونها، وقد اشترطوا النسب مقابل الحياة العائلية. ولكن عند مطالبة تلك الأطروحات بالسيادة للأب الطبيعي على أسرته المعيشية لم تكن تقترح توزيعًا جديدًا للسلطة السياسية. ذلك أنها كانت تحاول فحسب تحديد سلطة الملك. ولكي نفهم التحول الاجتماعي الذي حققته الثورة الإنجليزية (وهو لم يتحقق إلا بعد أكثر من قرن، طبقًا لما قاله كريستوفر هيل)، لابد لنا من الابتعاد عما نعتبرها أفكارًا سياسية خاصة بالجدل البيوريتاني ونأخذ في اعتبارنا ما يحدث للنوع.14
بناءً على ما تقوله كاثلين م. ديفيز، فقد شدد مذهب المساواة البيوريتاني على اختلاف الأدوار الجنسية التي كانت فيها الأنثى بكل تأكيد خاضعة للذكر، وليس على مساواة المرأة من حيث النوع. وهي توضح ذلك بقولها إن “نتيجة هذه الشراكة كانت تحديد الواجبات والصفات المشتركة والتكميلية”. وكان النوع الاجتماعي مفهومًا بوضوح في تلك المصطلحات المتقابلة التي يمكن عرضها بيانيا:15
| الزوج
الحصول على السلع السفر، والبحث عن القوت الحصول على المال والمؤن التعامل مع رجال كثيرين يحصل على “التسلية” يكون ماهرًا في الحديث هو العاطي ارتد ما يحلو لك إرسال كل الأشياء في الخارج |
الزوجة
جمعها معًا وحفظها رعاية المنزل عدم إنفاقها عبثاً الحديث مع عدد قليل تكون معزولة ومنطوية تتفاخر بالصمت هي المدخرة ارتدى ما يليق بك الإشراف وإعطاء الأوامر في الداخل |
عندما صور مؤلفو ما لا حصر له من النصوص البيوريتانية الأسرة المعيشية على هذا النحو باعتبارها معارضة للنوعين المتكاملين طلبوا من القراء تخيل الأسرة المعيشية على أنها وحدة اجتماعية منغلقة على نفسها. ولكن إذا كان هؤلاء المؤلفون يرغبون في تعريف الأسرة بأنها مصدر مستقل للسلطة، فإن ما قصدوه لم يصل. فقد كانت الأسرة المعيشية البيوريتانية تتكون من الذكر والأنثى اللذين كانا مميزين من ناحية التركيب، حيث كانا نسخة موجبة وأخرى سالبة من الشيء نفسه. ولم يكن بالإمكان بعد تخيل سلطة ربة البيت المذكورة أعلاه على أنها شيء موجب، في حد ذاتها. وإلى أن بدأت تتيقظ وأخذت ترتب حياتها الشخصية، كان يسود فهم واحد للسلطة، وكان الرجال يحاربون كي يقرروا التوازن فيما بين أجزائها المختلفة.
على عكس مؤلفى كتب الزواج والاقتصاد المنزلى في القرن السابع عشر، استطاع المصلحون التعليميون في إنجلترا القرن التاسع عشر الرجوع إلى ذلك القدر الضخم من الكتابة التي كان غرضها الأساسي هو إنتاج امرأة جديدة من الناحية التاريخية، وخلال القرون التي انقضت بين الثورة الإنجليزية والوقت الراهن كانت هذه المرأة محوطة بقيم تروق لمجموعة كاملة من جماعات المصالح المتنافسة، ومن خلالها استولت تلك الجماعات على العلاقات العائلية والحياة الشخصية. وأعتقد أنها بهذه الطريقة خلقت الحاجة إلى ذلك النوع من المراقبة التي توفره المؤسسات الحديثة. والواقع أن العقدين الأخيرين من القرن السابع عشر شهدا انفجارًا في الكتابة التي تستهدف تعليم بنات الجماعات الاجتماعية الطموحة، ووعد المنهج الجديد بتعليم تلك النساء بطريقة تجعلهن مرغوبات أكثر من النساء اللائي ليس لديهن ما يزكيهن سوى مكانتهن وثروتهن. وقد أعلى ذلك المنهج من شأن المرأة التي تكمن قيمتها بشكل أساسي في أنوثتها وليس في العلامات التقليدية للمكانة الاجتماعية، وهي تلك المرأة التي تملك العمق العاطفي وليس السطح المثير بدنيًا، وهي بعبارة أخرى المرأة المتفوقة في الصفات نفسها التي تفرق بينها وبين الذكر. وبما أنه أعيد تعريف النوع من هذه الناحية، لم تعد المرأة التي يعلى من شأنها التراث الأرستقراطي تبدو مرغوبة. وعندما اصبحت الوجه الآخر لهذه العملة الجنسية الجديدة، كانت تمثل السطح وليس العمق، وكانت تجسد المادة في مقابل القيمة الأخلاقية، وتعرض الحسية الشهوانية بدلاً من الاهتمام الذي لا يمل بسعادة الآخرين. ولم تعد المرأة الأرستقراطية المتصورة على هذا النحو تحدد الأنثى التي على أكبر قدر من المرغوبية.
ولكن لم يحدث حتى منتصف القرن التاسع عشر أن بدأ مشروع تحديد الناس بناء على النوع يكتسب بعض النفوذ السياسي الضخم الذي لا يزال يتمتع به إلى الآن. وفى حوالى ثلاثينيات القرن التاسع عشر بدأ الناس يرون خطاب الجنسانية يسترخي في نظرته النقدية بشأن الأرستقراطية عندما أصبحت الطبقات العاملة المكونة حديثًا هدفًا أكثر وضوحًا للإصلاح الأخلاقي. وفجأة انتبه المؤلفون للعناصر التي لم تكن تهم من قبل. فقد اكتشف هؤلاء المصلحون والأدباء أن الحرفيين وعمال المدن المتمردين، على سبيل المثال، يفتقرون إلى ذلك النوع من الدافع الذي يفترض أنه يميز الأفراد العاديين. وقد بحث العديد من الكتاب عن مصدر الفقر والأمية والتغير الديموجرافي بين هؤلاء الأفراد غير المتطورين الذين وجدوا أن سلوكهم بصورة عامة ليس مشوشًا فحسب، بل نوعيًا على نحو غامض. وعندما نجح مفكرو الطبقة الوسطى في ترجمة المشكلة الاقتصادية الطاغية إلى فضيحة جنسية استطاعوا المضي قدمًا وعرض أنفسهم، وتقنيتهم، ومهاراتهم الإشرافية، ومؤسسات التعليم والرفاهة الخاصة بهم على أنهم العلاج المناسب للمقاومة السياسية المتزايدة.
وكما يشير فوكو، فإنه من الأمانة أن نذكر أن الطبقات الوسطى لم تطبق الإجراءات المؤسسية على الآخرين قبل تجربتها على نفسها أولاً. وعند وضع المنهج الدراسي، اختار المسئولون الحكوميون والمربون المكلفون بذلك منهجًا على نمط النظرية التعليمية التي نشأت حول ماريا إيدجورث ووالدها ودائرتهما الفكرية، ورثة التراث المعارض16. وكان ذلك في المقام الأول المنهج نفسه الذي اقترحه مربو القرن الثامن عشر ومصلحوه باعتباره أفضل طريقة لإنتاج الابنة القابلة للزواج. وبحلول نهاية القرن الثامن عشر، كانت ماريا إيدجورث ووالدها من بين الذين قرروا بالفعل أن البرنامج الذي يهدف إلى إنتاج المرأة المثالية يمكن تطبيقه على الفتيان بالقدر الذي يطبق به على الفتيات. وبحلول منتصف القرن التاسع عشر يمكننا رؤية الحكومة تكتشف الطريقة التي تطبق بها البرنامج نفسه على أساس جماهيري. وبتوفير الأساس المفاهيمي للمنهج الدراسي القومي، أصبحت بذلك فكرة بعينها للذات مألوفة، وعندما حددت أشكال الهوية النوعية الطريقة التي يفكر بها الناس في أنفسهم وكذلك في الآخرين، باتت الذات هي الواقع الاجتماعي السائد.
لا ينصف التاريخ المختصر على هذا النحو الخلافات الشرسة التي تخللت تأسيس نظام التعليم القومي في إنجلترا. وأنا ألفت الانتباه فحسب إلى هذه المادة باعتبارها موقعًا تلاقي فيه التاريخ السياسي على نحو واضح بتاريخ الجنسانية وكذلك بتاريخ الرواية لينتجوا نوعًا محددًا من الفرد، وأنا أفعل ذلك كي أشير إلى الدلالات السياسية لتصوير تلك التواريخ على أنها أشكال منفصلة من السرد، وبما أن خطاب الإصلاح بدأ ينكر تحيزه السياسي والديني ويقدم نفسه بدلاً من ذلك على أنه حقيقة أخلاقية ونفسية، فمن الواضح أنه قطع صلاته بالماضي الأرستقراطي واتخذ دورًا جديدًا في التاريخ. وهو لم يعد يمثل شكلاً من المقاومة بل شمل مجالاً متخصصًا من مجالات الثقافة منفصلاً عن العلاقات السياسية حين يمكن قول الحقائق اللاسياسية. وقد اعتمد وضع الخيال الأدبى على هذا الحدث، فمنذ ذلك الحين أنكرت الرواية الأساس السياسي لمدلولها وأشارت بدلاً من ذلك إلى مناطق الذات الخاصة أو إلى عالم الفن المتخصص ولكنها لم تشر قط إلى استخدام الكلمات التي خلقت تلك الفروق المهمة بالنسبة لثقافتنا ومازالت تحافظ عليها. وكانت الروايات التي تؤدي العمليات البلاغية الخاصة بالتقسيم والانغلاق كأحسن ما يكون، وحولت بذلك المعلومات السياسية إلى خطاب للجنسانية، هي التي تحظى بالتأييد من بين أنواع الخيال. وأعطت الأعمال الخيالية تلك الرواية اسمًا طيبًا، وهو الاسم الخالي من السياسة، وغالبًا ما كان اسم امرأة مثل باميلا، أو إيفلينا، أو چين إير. وبعد ذلك، ومع ترجمة الهوية الإنسانية إلى هوية جنسية ظهر قمع شائع لمعرفة القراءة والكتابة السياسية كان يميز الثقافة السابقة، وجاء معه كذلك نسيان الجماهير أن هناك تاريخًا للجنسانية تجب روايته.
دعوني أعرض نموذجًا مفصلاً للمبادلة بين القارئ والنص الأدبي لتقديم معنى الطريقة التي تعمل بها سلطة الحياة العائلية من خلال هذه المبادلة. فقد عرضت “شارلوت ” هذا السلطة نفسها عند كتابة روايتها “شيرلي”. وتحتوي الرواية على مشهد لا داعى له تقرأ فيه مسرحية “كوريولانوس” لشكسبير جهرًا وتنقد، وكأنها تقدم للقارئ قواعد موجزة للقراءة، وهي القواعد التي يجب أن تفتن المؤرخين الأدبيين، وهي ليست أحكام برونتي نفسها، بل إنها أحكام جرى وضعها خلال القرن السابق بواسطة ما لا حصر لهم من مؤلفي كتب سلوك السيدات والأطروحات التعليمية. وقد اقترح هؤلاء المؤلفون أول منهج دراسي ليشمل الأدب البريطاني المحلي. وتقريبًا في الفترة التي جلست فيها برونتي لتكتس “شيرلي”، كان جيل جديد من الكتاب قد شرع في مسألة كيفية تمييز القراءة النافعة عن القراءة الضارة. وقد أدت جهودهم إلى تضخم العدد المتزايد للمجلات الفيكتورية. وما إذا كان ينبغي للفتيات قراءة الروايات أم لا هو الهم الذي شكل المناقشات التي دارت حول المنهج الدراسي للنساء خلال القرن الثامن عشر، ثم تكونت النظرية التعليمية للقرن التاسع عشر حول مسألة كيفية جعل الخيال مفيدًا لتعليم الأجانب وأفراد الطبقة العاملة وكذلك النساء والأطفال. وظهرت قواعد للقراءة إلى جانب المنهج الدراسي القياسي القومي الذي مد المنهج الذي كان مقصودًا به في الأصل فتيات الطبقات المتعلمة ليشمل الشبان والشابات الإنجليز على مستويات مختلفة ونظراءهم في أنحاء المستعمرات. وهي إلى حد كبير نظرية التعليم نفسها التي تشكل نظامنا التعليمي في الوقت الراهن. وباستخدام هذا المثال من “شيرلي” لبيان الأساس المنطقي للإجراءات التي مد بها مفكرو العصر الفيكتوري ما كان ينظر إليه على أنه شكل أنثوى لمعرفة القراءة والكتابة إلى التعليم الذكوري، أريد كذلك توضیح اختلاف مهم بين فهم شارلوت برونتي لهذه العملية وفهمنا لها. فأنا أعتقد أنها كانت أكثر وعيًا بسياسة التفسير الأدبي منا.
تستخدم إحدى بطلاتها الأقل تعددًا في جوانبها، وهي كارولين هلستون، شكسبير لقضاء أمسية من وقت الفراغ مع ابن عمها المحبوب وزوج المستقبل روبرت مور، وهو صاحب مصنع متعجرف تجعله طريقته التسلطية التي يتعامل به مع عمال المصنع يتلقى تهديدات بانتقام محطمي الآلات. وخلال تلك اللحظة، وهي اللحظة الحميمية الوحيدة التي يقضيانها معًا حتى نهاية الرواية، يرفضان كل التسلية المتاحة للمحبين في رواية أوستن لمصلحة قراءة مسرحية “كوريولانوس” لشكسبير. ويوضح فعل القراءة هذا، الذي يزيد كثيرًا في تفاصيله عن أي تبادل فيما سبق من خيال أدبي، الإجراءات التي كان يظن من خلالها أن قراءة الأدب تنتج شكلاً من المعرفة هو في الوقت ذاته أحد أشكال الرقابة الاجتماعية. وروبرت مور نصفه بلجيكي ونصفه الآخر إنجليزي. وحسبما ترى كارولين، فإنه “سوف يصبح إنجليزيًا بالكامل” من خلال قراءة شكسبير.17 وهي توضح له ذلك بصبر وأناة قائلة: ” لم يكن أجدادك الفرنسيون يا روبرت يتحدثون بهذا القدر من الحلاوة، ولا على هذا النحو من الرصانة، ولا بهذا الشكل من الروعة الذي كان يتحدث به أجدادك الإنجليز. ” غير أن كون المرء إنجليزياً لا يحدد نسقًا ما من الولاءات السياسية- كما كان الحال في زمن شكسبير. بل إنه يشير إلى صفات العقل الإنساني الأساسية. وقد اختارت كارولين جزءًا ليقرأه روبرت جهرًا، وهو ذلك الجزء الذي تقول إنه “ينسجم مع الشيء الذي بداخلك. وسوف يوقظ طبيعتك، ويملأ عقلك بالموسيقى، وسوف يمر كاليد الماهرة فوق قلبك…. فلندع ويليام المجيد يقترب ويلمسه؛ وسوف ترى كيف يستخلص القوة الإنجليزية واللحن الإنجليزي من أوتاره.”
أسميت هذه العلاقة تبادلاً بين القارئ والنص كي أؤكد حقيقة أنه لا يمكن توجيه الكتابة إلى مهمة تشكيل القراء بدون التخلي عن الملامح القديمة واكتساب ملامح جديدة قائمة بذاتها؛ فالتركيز على القارئ یعنی شرح نصف المنطق التحولي الخاص بهذا التبادل. وكما يصبح روبرت، البلجيكي الفظ، رجلاً إنجليزيًا رقيقًا من خلال قراءة شكسبير، فكذلك يتحول الكاتب المسرحي اليعقوبي من خلال الوضع العائلي الذي يقرأ فيه. إذ تحث كارولين روبرت على تلقى إنجليزية فترة تاريخية أخرى باعتبارها صوت أحد الأجداد يتحدث إليه عبر الزمن والحدود الثقافية. وليس مستغربًا أن شكسبير، الذي بعث بذلك، قد نال مشاعر التوق والقلق الخاصة بصاحب مصنع في أوائل القرن التاسع عشر. وبينما نلاحظ شاعر الملاحم وهو يتحول إلى رجل القرن التاسع عشر، نشهد كذلك نسخة مبكرة من تدريبنا الأدبي. ويمكننا هنا أن نرى كيف أن الأصوات التي تتحدث من مواقف شديدة الاختلاف في الفضاء والزمان الاجتماعيين، وتنقل من خلال الأنثى المتعلمة ابنة الطبقة الوسطى إلى الذكر، ونحصل نحن من خلاله على تطبيق كلي، تترجم بسرعة إلى جوانب الوعي الحديث.
هكذا يصبح شكسبير وسيلة لإنتاج حالات ذهنية محددة داخل القارئ. وتوضح كارولين أنه من المفترض أن قراءة شكسبير “تثيرك لتعطيك إحساسات جديدة. فهي تجعلك تشعر بحياتك بقوة، ليس فقط بفضائلك، بل كذلك بنقاطك المنحرفة الآثمة، اكتشف بالإحساس الذي سوف تهبه لك القراءة في الحال مقدار ارتفاعك وانخفاضك” (ص 115). وإذا فقد شكسبير تلك التحولات العقلية التي تربطه بفترته التاريخية، فحينئذ يفقد روبرت ملامح من النوع نفسه في تصوير برونتي لمشهد القراءة. وهذا هو المهم بالطبع. فقراءة شكسبير تترجم مواقف روبرت الخاصة إلى ملامح أساسية للعقل. إنها تجسد تلك الملامح وتخضعها للتقييم. و”القوة الإنجليزية” التي يكتسبها روبرت من خلال قراءة الأدب هي قوة ملاحظة نفسه من خلال عدسة النزعة الإنسانية الليبرالية- باعتبارها نفسًا منتشيةً بفخامة اعتياد تحرر تمامًا من التحيز التاريخي والالتزام السياسي. فمن خلال هذه العدسة تجعلنا الرواية ندرك التحولات التي طرأت على روب روبرت أثناء قراءته لمسرحية “كوريولانوس” برعاية رقيقة من كارولين هلستون: “خروجًا من خط الأحكام المسبقة الضيق، بدأ يجد متعة في الصورة الكبيرة للطبيعة البشرية، ويشعر بالواقع المطبوع على الشخصيات التي كانت تتحدث من تلك الصفحة التي أمامه” (ص 116).
تحت رعايتها روبرت على استنكار نمط من أنماط القوة- تربطه كارولين بطبيعة کوریولانوس الأبوية المهيمنة- وتبنى نمط آخر- تعرفه بأنه الشكل الخيري للنزعة الأبوية. وبما أن مسرحية “كوريولانوس” تقدمها امرأة وتستخدم للتوسط من أجل تبادل جنسي، فهي تصبح وسيلة لإحداث تحول تاريخي؛ إذ تصبح “كوريولانوس” هي كارولين. أي أن المسرحية بأدائها ككتابة وقراءة تصبح وسيلة لاستيعاب شكل السلطة الذي تعرفه الأنثي. وتتضح الدلالات السياسية لإضفاء الصبغة الأنثوية على القارئ حين تقدم كارولين لروبرت مغزى “تغيير السلوك بناءً على المسرحية:… يجب ألا تتفاخر بمكان عملك؛ يجب ألا تهمل فرص ترضيتهم، ويجب ألا تكون ذات طبيعة تفتقر إلى المرونة، حيث تنطق بالطلب بصرامة وكأنه أمر ” (ص 114). وليس هناك غموض في مسرحة العملية التي تخلص بها القراءة روبرت من الشر الأجنبي. ويبدو أنها تعرف على وجه التحديد الهدف السياسي الذي يتحقق عندما يملأ قالب الرجل الإنجليزي والأب الخير. كما تجعل برونتي المرأة مسئولة عن هذه العملية بالرغم من إعطائها بطلتها الفقرات الأقل إلحاحًا لتقرأها. وهكذا فإن سلطة كارولين الخجول والأنثوية والحميدة تمامًا تكاد لا تُرى. ومع ذلك فمن الواضح أنها من يعلن أن للقراءة سلطة “تحريكك، وإعطائك إحساسات جديدة، فهي تجعلك تشعر بحياتك بقوة، ليس فقط بفضائلك، بل كذلك بنقاطك المنحرفة الأئمة” (ص 115). وعندما ينتهى روبرت من القراءة تكون هي من يسأل “هل شعرت بشكسبير الآن؟” (ص 117). وهي تكبت كل ما ينتمي إلى الماضى باعتباره صخبًا كثيرًا في مسعاها لاختبار تيارات العاطفة الكبيرة التي تنساب مباشرةً من شكسبير إلى قارئ العصر الحديث، وهو القارئ الذي يعد إنجليزيًا خالصًا. وهكذا فإن كارولين بتوجيهها قراءته بابتساماتها ولفتها لنظره تنفذ نسقًا من الإجراءات الرقيقة الخاصة بترجمة المعلومات الثقافية إلى ظلال من وعي الطبقة الوسطى ومادة النص الأدبي. ومع أن وضع “شيرلي” أثناء تمردات محطمى الماكينات- يجعلها تنطوي على مفارقة تاريخية مقدارها حوالى ثلاثين سنة، والحل الذي تقترحه لمشكلة المقاومة السياسية، من خلال إنتاج عقلية طبقة حاكمة جديدة، يميز هذه الرواية على أنها فيكتورية الطابع تمامًا- ربما سابقة لزمانها.
وعندما نُشرت استراتيجيات التناص هنا وفي أماكن أخرى في أنحاء الثقافة الفيكتورية، انتصر نسق معقد من الاختلافات السيكولوجية انتصارًا تامًا وبوضوح على التراث الذي طال أجله من العلامات السياسية، مؤذنًا بشكل جديد من سلطة الدولة. وقد استولت تلك السلطة- وهي سلطة التمثيل على الشيء الممثل- على السلطان من الطبقة الأرستقراطية القديمة على أساس أن الحكومة ملتزمة أخلاقيًا بإعادة تأهيل الأفراد المنحرفين وليس إخضاعهم بالقوة. وأوضحت مجزرة بيترلو في عام 1819 أن قدرة الدولة على العنف قد أصبحت مصدر حرج للدولة. وعملت مظاهر القوة الواضحة ضد السلطة الشرعية مثلما عملت ضد الفصائل التخريبية.18 وإذا كانت أعمال التمرد الصريح قد بررت التدخل في تلك المناطق من المجتمع التي لم تكن الحكومة مضطرة للتعامل معها من قبل، فحينذاك منح استخدام الحكومة للقوة مصداقية لاتهامات العمال الخاص بقمع الحكومة. وفي تلك الفترة من التاريخ – الإنجليز- على وجه التحديد باتت سلطة المراقبة هي المسيطرة، حيث حلت محل مظاهر العنف التقليدية. وعلى نحو واضح يشبه شكل اليقظة التي تضمن الأسرة المعيشية المنظمة، لم تخلق هذه السلطة المساواة بقدر ما قللت من شأن علامات الاختلاف المادية عن طريق ترجمة هذه العلامات إلى اختلافات في النوعية والكثافة والاتجاه وقدرة من التنظيم الذاتي الخاصة برغبة الفرد.
وأنا لا أوحى بقولى هذا بأنه ينبغي استخدام الخيال الأدبي البريطاني لتحديد أشكال القمع أو لأداء أعمال التحرير، وإن كان لمشروعي هدف سیاسی محدد. فأنا أرغب فحسب في تصوير خطاب الجنسانية باعتباره مشاركًا بعمق في شكل الرواية- إن لم يكن مسئولاً عنه على نحو مباشر- وبيان أن مشاركة الرواية، في الوقت نفسه، في إنتاج الذات التي تعرف نفسها وترى تلك النفس بالنسبة للأنفس الأخرى بناءً على الاستراتيجيات نفسها المضفية للصيغة الأنثوية التي شكلت الخيال الأدبي. بعبارة أخرى، فأنا أعتبر الخيال الأدبي وثيقة ووسيلة للتاريخ الثقافي. وأعتقد أنه ساعد في صياغة الفضاء المرتب الذي نعترف به الآن على أنه الأسرة المعيشية، ذلك أنه جعل هذا الفضاء مفيدًا تمامًا واستخدمه كسياق لتصوير السلوك الطبيعي. والخيال الأدبي بقيامه بهذا كله تحدى الأسس البديلة للعلاقات الإنسانية. وبما أن تاريخ هذا المجال الأنثوى مرسوم على هيئة تاريخ سياسي، فسوف يحدد بشجاعة الخطوط العامة للخطوة الثقافية المؤثرة التي أعتقد أن تفوق ثقافة الطبقة الوسطى يقوم عليها بشكل مطلق. ويعني هذا أنه سيعيد تمثيل اللحظة التي غزت فيها الكتابة الأسرة المعيشية وعدلتها واحتوتها بناءً على الاستراتيجيات التي تميز الخاص عن الحياة الاجتماعية وبالتالى تفصل الجنسانية عن التاريخ السياسي.
بینما عزل الآخرون الاستراتيجيات النظرية التي تضفى صبغة طبيعية على إخضاع الذكر للأنثي، لم يبحث أحد المجاز الذي يفاضل بين الجنسين بحثًا دقيقًا حيث تربطهما معًا بالرغبة الجنسية. وإذا لم يكن هناك من يسأل لماذا وكيف ومتى أصبح التفاضل النوعي أس الهوية الإنسانية، فلا يمكن أن تساعدنا أية درجة من التكلف البلاغي على فهم القدرة المجملة لهذا المجاز وتلك المصالح الحقيقية التي تخدمها تلك القدرة حتمًا. ومصطلحا “ذكر” و”أنثى” أساسيان لسيميوطيقا الحياة العصرية بحيث لا يمكن لأحد استخدامهما بدون درجة ما من أداء الاشارة التي تجعل الذهن محسوسًا نفسها التي يجب أن نفهم كيف تعمل ونرغب في إضفاء الصبغة التاريخية على سلطتها. وعندما نجرى قرعتنا السياسية في التشكيل الزوجي للنوع، فإننا نضع أنفسنا في داخل رباط مزدوج كلاسيكي، يحبسنا في بدائل ليست في واقع الأمر بدائل بحال من الأحوال. ويعني هذا أن أي موقف سياسي يقوم في الأساس على الهوية الجنسية يؤكد في النهاية الخيارات المحدودة التي يقدمها هذا النموذج الثنائي. وما إن نفكر في هذه البنية حتى تظهر العلاقات الجنسية كنموذج لكل علاقات السلطة. ويجعل هذا بالإمكان رؤية الأنثى على أنها ممثل للإخضاع كله واستخدام ذاتيتها وكأنها شكل من المقاومة. ومع ذلك فإننا حين نرسم الصراع الاجتماعي داخل الشكل العائلي تغيب عن أنظارنا الانتماءات السياسية العديدة والمتناقضة التي يمثل أي شخص بعينه موقعًا لها. وتعمل قدرة الجنسانية على الاستيلاء على صوت الضحية من خلال الانعكاس بنفس قدر استيلائها عليه من خلال الالتزام بالتنظيم الداخلي للنموذج.
ومع ذلك فهناك طريقة أدين فيها بكل شيء للحركة النسوية الأكاديمية التي أبدو منتقدة لها، ذلك أنه لو لم يكن مقبولاً الآن قراءة نصوص النساء على أنها نصوص نساء لما كانت هناك دعوة إلى إضفاء الصبغة التاريخية على هذا المجال من الثقافة. وفي ضوء حقيقة عرض مجموعة نورتون الكاتبات على أنهن جزء من المسح القياسي للأدب البريطاني، وكذلك كمجموعة قائمة بذاتها، وفي ضوء حقيقة أننا الآن لدينا أتباع ذكور للحركة النسوية يبذلون قصارى جهدهم للمشاركة في هذه الحركة، فأنا أشعر أن الوقت قد حان لعمل تقييم لمواردنا. كما أن الوقت قد حان لدراسة سبب شعور النقد الأدبي في الوقت الراهن بارتياح تجاه الانتقاد الذي بدأ كنقد لكل من القانون التقليدي وللإجراءات التفسيرية التي يحركها القانون. ويجب أن يدلنا هذا على أنه من خلال شق مجال منفصل للنساء داخل النقد الأدبي، مازال من الواجب على النقد النسوى زعزعة ميتافيزيقا الجنسانية الحاكمة. وما زال نقاد التاريخ الأدبي متحفظين تجاه الفكرة الذكورية للسياسة باعتبارها ولكنهم لا يزالون متمسكين بها، حيث وفر المزيد والمزيد من المناطق في الدراسات الأدبية أرضًا لموضوعاتية الجنسانية التي تشجعها الحركة النسوية الأكاديمية. والواقع أن التقسيم الجنسي للعمل بهدد بإعادة إنتاج نفسه داخل الأكاديميا بينما تفسر بها الباحثات الأدب باعتباره تعبيرًا عن الذات الجنسية بينما يهتم الباحثون بأمور التاريخ والسياسة. وللقضاء على هذه العملية، أعتقد أنه يجب علينا قراءة الخيال الأدبي ليس على أنه أدب، بل باعتباره تاريخًا للفروق النوعية والوسيلة التي أعدنا بها إنتاج الشكل الطبقي والثقافى المحدد للوعي.
(*) Nancy Armstrong. “Some Call it Fiction: On the Politics of Domesticity” in Feminisms: An Anthology of Literary Theory and Criticism. Eds. Robyn R. Warahol and Diane Price Herndl. New Jersey: Rutgers University Press, 1997.
** صحفى ومترجم
- Ian Watt, The Rise of the Novel (Berkeley: University of California.1 Press, 1957), p. 57.
- في The Long Revolution (New York: Columbia University Press, 1961). يعرض ويليامز كيف عارض البعد “الإبداعي” أو الثقافي للتجربة الاجتماعي أشكال السلطة السياسة القائمة خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر وانتصر. والواقع أن الباب الأول من هذا الكتاب يعطى الثقافة أولوية على المؤسسات الرسمية التابعة للدولة (كما كان يجب أثناء القرن الثامن عشر)، زاعمًا أن التاريخ الثقافي “أكثر من قسم، وهو مجال تغير خاص. وفي هذا المجال الإبداعي، التغيرات والصراعات الخاصة بأسلوب الحياة ككل متضمنة بالضرورة (ص 122). ويكمن في هذا الوعد بتوسيع فئة “السياسي” على نحو عريض لتشمل أسلوب الحياة” تلك الإشارة النقيضة إلى أن الممارسات السياسية هي كذلك فئة خاصة من “الكل”. وتظهر الفكرة الثانية للسياسة في الجزء الثاني، حيث يصف ويليامز تلك العمليات التاريخية كزيادة الجمهور القارئ، والصحافة الشعبية، والإنجليزية الفصحى التي حولت من خلالها الطبقات الوسطى سلطة اللغة إلى سلطة سياسية. وهنا يسيطر التعريف الضيق للأحداث السياسية، كتلك التي تحدث في دور الحكومة، والمحاكم، والسوق، على البعد الثقافي “الإبداعي” للتجربة الاجتماعية. ويقول ويليامز إنه “كما أن 1688 تاريخ سياسي مهم، فإن 1695 مهمة كذلك في تاريخ الصحافة. ففي ذلك العام أعلن البرلمان تجديد قانون الترخيص لعام 1662، وأصبح المسرح معد تمامًا للتوسع” (ص 180). ولو كان ويليامز قد جمع بالفعل البيانات التي كانت ستكون سجل الحياة “كلها، كان من الممكن أن يخرج من تلك الدائرة. ولكن أثناء بناء التواريخ الثقافية كان ينحنى باستمرار للتراث ويتوقف قبل دخول المجال النسائي.
- Virginia Woolf, A Room of One’s Own (New York: Harcourt, Brace.3 and World, 1975), p. 69.
- للاطلاع على رواية تراث أوائل القرن الثامن عشر الذي يربط الرواية بالثقافة الإجرامية، انظر شؤف Leonard Davis, Factual Fiction: The Origin of the English Novel (New York: Colombia University Press, 1983), PP 123-137 للاطلاع على الاعتراض على الروايات بسبب جاذبيتها شبه الإيروتيكية، انظر John Richetti, Popular Fiction Before Richardson’s Narrative Patterns 1700-1734 (Oxford: 1969). وفي أحد أعداد مجلة أديسون Spectator على سبيل المثال، يحذر مستر سبكتاتور القراء من أخطار شهر مايو، حيث ينصحهم بأن النساء “يكن على نحو بعينه كيف يفتشن على القصص البطولية والشوكولاتة والروايات وما شابه ذلك من المثيرات، وهو ما أعتبر استعماله خطيرًا جدًا أثناء كرنفال الطبيعة الكبير هذا”، مقتطف في Four Before Richardson: Selected English Novels 1720- 1727, William H. McBurney, ed. (Lincoln: University of Nebraska Press, 1963), p. ix. ومع ذلك يكتشف قرب نهاية القرن الثامن عشر شخص عدد كبير من المقالات التعليمية تحاكي رواية Northanger Abbey لأوستن دفاعًا عن بعض الأعمال الروائية باعتبارها الطريقة المناسبة لشغل وقت الفراغ. والروايات التي كان من المفترض أن يكون ذلك الأثر المفيد على الشابات كانت إما من إنتاج روائيات كان لهن رواج في عصر برني والروائيات الأخريات أو من تأليف روائيين كان يحتفون بالفضائل المنزلية ذاتها ويرون شكل السعادة المنزلية ذاتها على أنها المكافأة النهائية لعرض تلك الفضائل. وفي تلك الفترة، كما يوضح هومر و. براون، نشرت روایات بعينها بتحرير سكوت وباربو وكانت تميز بأنها قراءة مؤدبة، وعلى أساس هذا القدر المحدود والشاذ من الأعمال، بنى تاريخ الأدب في اتجاه للوراء زمنيًا (من كتابه Institutions of the English Novel in the Eighteenth Century)
- أشار عدد من المؤرخين الاجتماعيين إلى أن نظام المصنع، ومعه الهيمنة الاقتصادية للطبقات الوسطى الجديدة، كان موقوفًا حتى بداية القرن التاسع عشر، وفي كتاب The Making of the English Working Class (New York: Random House, 1966) p.198 يشير إ.ب. طومسون إلى أن خوف النزعة اليعقوبية أفرزت تحالفًا جديدًا بين ملاك الأراضي ورجال الصناعة قسم المقاومة التقليدية للتحول الصناعي، وفي كتاب The Machinery Question and the Making of Political Economy (Cambridge: Cambridge University Press, 1980) تشرح ماكسين برج كيف أن تطور الاقتصادي السياسي باعتباره منطقًا لحل المشاكل في نهاية القرن الثامن عشر على رؤية التحول الصناعي كأنه حل وليس مشكلة يجب تجنبها بأي ثمن. وفي ظل تلك الظروف رأى مؤلفون عديدون لأول مرة كيف أنه كان لأشخاص عديدين مصالح اقتصادية مشتركة مع رجال الصناعة ووصفوهم على أنهم طبقة. وفي كتاب Desire and Domestic Fiction: A Political History of the Novel (New York: Oxford University Press, 1987) أمضى قدمًا بهذه المقولة بالإشارة إلى أنه جرى إقناع جماعات اجتماعية عديدة تتراوح بين صغار الأعيان والعمال المهرة قبل أن تشعر بأن هناك مصالح اقتصادية مشتركة فيما بينها إلى حد كبير بواسطة مؤلفين غير معروفين لنا اليوم كي يقبلوا فكرة الحياة الشخصية التي تركز علية نوع المرأة التي يرغب الشخص الزواج منها ونوع السعادة التي توفرها (ص 59-95).
- عند مناقشة فویرباخ، لا يؤكد ماركس فقط على أن “الأفكار الحاكمة” الخاصة بحقبة ما هي أفكار الطبقة الحاكمة التي “تنظم إنتاج وتوزيع الأفكار الخاصة بعصرها” (ص 64). كما يتوقع أنه أثناء الحقبة الحديثة سوف يصبح إنتاج وتوزيع الأفكار (إى إنتاج الوعي) على قدر متزايد من الأهمية بالنسبة للحفاظ على “الدولة” البورجوازية وبالنسبة لتفككها المحتمل، The German Ideology, Part One, C.J. Arthur, ed. (New York: International Publishers, 1985) ودون الرجوع إلى الفلسفة المثالية التي سعى منها ماركس إلى إنقاذ “إنتاج الأفكار”، يطبق جرامشى التناقش الكامن في فكرة ماركس الخاصة بالعمل على العمل الفكري. فالمفكر لا يرتبط بالضرورة بالطبقة الحاكمة من خلال إعادة إنتاج الأفكار الموروثة من الماضي وإنما قد يوسع في لحظة من اللحظات أفقه السياسي بإعارة الوحدة والتماسك لوجهة نظر إحدى الجماعات الناشئة، The Modern Prince,and Other Writings (New York: International Publishers 1957) وفي Hegemony and Socialist Strategy, Winston Moore and Paul,Cammack, trs. (London: Verso 1985) يحدث إرنستو لاكلو وشانتال موف هذا المبدأ بالنسبة للمجتمع ما بعد الحديث بتوسيع أفكار جرامشى الخاصة بكل من السلطة والمقاومة. وحيثما يختفي بالفعل الفرق بين الإنتاج بالمعنى التقليدى وإنتاج المعلومات، يتلاشى كذلك العداء بين العامل وصاحب العمل. وحيثما يمكن التعامل ذات مرة مع هذه الاستقطابات على أنها أمر مسلم به، حينئذ يصبح من الصعب إلى أقصى حد خلق الاستقطابات على امتداد الخطوط السياسية. ويجد لاكلو وموف أنه من الضروري التغاضى عن اعتماد جرامشى على ظهور العمل في صراع مع رأس المال والاتجاه بدلاً من ذلك إلى العمل الفكري الخاص بالإيجابيات والسلبيات خارج مستنقع التعادلات المعاصر. للاطلاع على تحليل مهم آخر للسلطة في المجتمع ما بعد الحداثي، انظر,Bonaventura de Sousa Santos “Law and Community: The Changing Nature of State Power in Late Capitalism,” International Journal of the Sociology of the Law (1980).8: 379- 397
- Michel Foucault, the History of Sexuality, vol. 1, An Introduction, Robert Hurley, tr. (New York: Patheon, 1978).
- Discipline and Punishment: The Birth of the Prison, Alan Sheridan, tr. (New York: Vintage.
- في The Imaginary Puritan: Literature an the Origins of Personal Life Berkeley: Univ. of California Press 1992)) أشرح أنا وتيننهاوس باستفاضة كيف أن الثورة الإنجليزية فشلت في إنتاج التحولات الأساسية التي تميز الثورة السياسية. ونحن نحاول تقديم الأسباب التي تدعم وجود تعريف وافٍ على نحو أكبر للسياسي، حيث نوضح أنه بينما لم يحدث التغير السياسي، بالمعنى الضيق، فقد كان التغير الثقافي عميقًا ودائمًا. وقبل أن تكتسب الطبقات المتوسطة الحديثة سيطرة سياسية، وقبل اكتسابها السيطرة على مجلسي البرلمان بفترة طويلة، اكتسبت طبقة جديدة من المفكرين الهيمنة على الثقافة الأرستقراطية حيث ترجمة النزعة البيوريتانية إلى ممارسات دنيوية (علمانية) تشكل الحياة العائلية والحياة الشخصية.
- قلت ذلك باستفاضة في Desire and Domestic Friction وقد بدأ هذا المقال كنسخة من المقدمة ثم تطور إلى بحث نظري في جدلى مع الأدب والتاريخ والنزعة النسوية الأكاديمية. وأحيل القراء إلى الكتاب للإطلاع على الأدلة التي تدعم الخط العام المختصر بالضرورة للأحداث في تاريخ الجنسانية الحديثة التي تشكل جزءًا من هذا المقال.
- في “The Mother Made Conscious’: The Historical Development of a Primary School Pedagogy,” History Workshop (1985), vol 20 بحثت كارولين ستيدمان السبب المنطقي وحللت العملية التي جرى بواسطتها مد تكنيكات تربية الأمهات لأطفالهن إلى خارج الأسرة المعيشية، وأصبحت، من خلال إنشاء النظام التعليمي القومي، الدعائم الرقيقة لثقافة مؤسسية جديدة ولكنها صارمة.
- انظر على سبيل المثال Peter Stallybrass and Allon White, The Politics and Peter Clark, Poetics of Transgression (London: Methuen, 1986) The English Alehouse: A Social History 1200- 1830 (London: Thomas Walter Laqueur, Religion and,Longman 1983) Responsibility: Sunday Schools and Working Class Culture 1780-1850 (New Haven: Yale University Press, 1976)
- Maria Edgeworth and Robert L. Edgeworth, Practical Education (London, 181) 2: ixالاقتباسات التي في النص من هذه النسخة.
- للاطلاع على مناقشة للنزعة الأبوية التي ظهرت لمعارضة نظام السلطة الأبوية في الكتابة البيوريتانية في القرن السابع عشر، انظر Leonard Tennenhouse, Power on Display: the Politics of Shakespeare’s Genres (New York: Methuen 1986) وخاصة الفصل الذي عنوانه Family Rites. عند مناقشة بديل نظام السلطة الأبوية الذي ظهر في نهاية القرن السابع عشر وبداية القرن العشرين في العائلات الأرستقراطية، يقابل راندولف ترومباخ مصطلح “الأبوي” بمصطلح “الحياة العائلية” الذي يشير به إلى الأسرة المعيشية الحديثة. وهذا التشكيل الاجتماعي تخوله السلطة العلاقات الداخلية للنوع والجيل وليس بواسطة التشبه بعلاقات السلطة الخارجية بين الملكة والرعية أو بين الرب والإنسان، The Rise of the Egalitarian Family (New York Academic Press, 1978, pp 119-163
Kathleen M. Davis, “The Sacred Condition of Equality- How Original were Puritan Doctrines of Marriage?” Social History: (1977) 5: 570 يقتبس ديفيز هذه القائمة من,John Dod and Robert Cleaver A Godly Forme of Householde Government (London, 1614)
- انظر
Brian Simon, Studies in the History of Education 1788- 1870(London: Lawrence and Wishart, 1690), pp 1-62
- Charlotte Bronte, Shirley, Andrew and Judith Hock, eds. intellats all (Harmondworth: Penguin, 1974), p. 114
اقتباسات النص من هذا الطبعة.
E.P. Thompson, pp. 680- 685.18