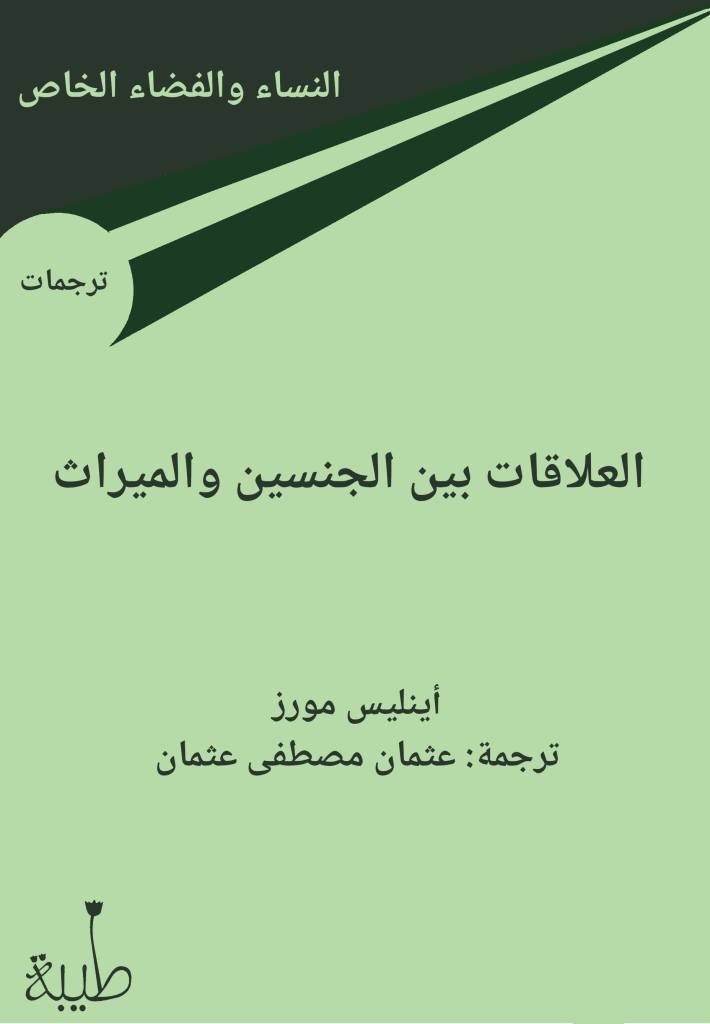العلاقات بين الجنسين والميراث:
الفرد والسلطة والمِلكية في فلسطين(*)
سوف أحاول في هذا الفصل أن أثبت أن التركيز على الجندر كمفهوم علاقات من شأنه أن يشيء ويغير فهمنا للعلاقات بين السلطة والملكية، وهي العلاقات التي كانت محورًا للكثير من المناقشات في تخصصى التاريخ والأنثروبولوجيا على حد سواء. وفيما يتعلق بالمرأة والميراث في الشرق الأوسط الإسلامي، تبدأ الكثير من الأدبيات بطبيعة الملكية التي تنطوي عليها تلك العلاقة. ويرى البعض أن حقوق الملكية للنساء تلقى حماية أفضل في حالة العقارات والمنقولات عنها في الأرض الزراعية (Pastner 1980).
ويشير الكتاب الذين يدرسون المدن العثمانية إلى أن الملكيات العقارية كانت متاحة أمام النساء بشكل أكبر من الممتلكات التجارية أو الزراعية ;(Jennings 1975; Gerber 1980 Marcus 1983) كذلك يرى من يكتبون عن المناطق الريفية أن استفادة المـرأة من الأرض الموروثة تكون أكبر إذا ما كانت ملكيتها فردية عنها في حالة كونها جماعية (Layish 1975; Perters 1978).
مثل هذه المفاهيم المادية حول تأثير طبيعة الممتلكات عادة ما يتم الربط بينها وبين القضايا المتعلقة بالعلاقة بين الملكية والسلطة. ويتمثل أحد أهم الدوافع وراء التركيز على إتاحة الملكية أمام النساء في الرد على الادعاءات القائلة بأن وضع المرأة بالذات في المجتمعات الإسلامية هو وضع «المقموعة» (Gerber 1980: 231) أو «المحتقرة» (Jennings 1975: 53). إن مثل هذه الدراسات باتخاذها لإتاحة الملكية أمام النساء كمؤشر على وضع مستقل نسبيًا إنما تسلم بوجود علاقة مباشرة وإيجابية، وفي كثير من الأحيان تبادلية أيضًا، بين الملكية والسلطة.
وقد أثرت تلك المفاهيم في توجهاتي عندما بدأت دراسة إتاحة الملكيات أمام المرأة في فلسطين. بيد أن مناقشاتي مع الفلسطينيات كشفت عن أن ميراث الملكيات يمكن أن ينطوي على معانِ شديدة التباين، تثير التساؤلات حول مركزية طبيعة الملكية الموروثة والعلاقة المباشرة، المزعومة، بين الملكية والسلطة. وسوف أتحول بالتركيز في هذه الورقة، مستلهمة في ذلك وايتهد Whitehead (1984). من الملكية التي يشتمل عليها الميراث إلى الأوضاع المحددة التي تتخذها المرأة لنفسها أو تجد نفسها فيها، وكذلك من الملكية كمورد مادى إلى الملكية كعلاقة اجتماعية. وحتى أستطيع القيام بذلك سوف أدرس الاستراتيجيات التي تتبناها النساء فيما يتعلق بميراث الملكيات، والتي تتراوح بين تنازلها عن حقوقها إلى المطالبة بنشاط بنصيبها.
وتعتمد هذه الدراسة على دراسة ميدانية أجريت في ثمانينات القرن الماضي في «جبل نابلس» بفلسطين وشملت مدينة نابلس نفسها وقرية صغيرة في المنطقة سوف أطلق عليها «البلد»، كان أهلها يعتمدون في الماضي على مزروعات المناطق الجافة ورعى الماعز، وأصبحوا يعتمدون مؤخرًا على تحويلات رجالها المهاجرين للعمل في الخارج. وسوف نقتصر في مقالنا على أكثر حالات ميراث النساء شيوعًا، أي ميراث الابنة والأرملة. وقبل أن نتحول إلى ممارسات الميراث، سوف نقدم نبذة مختصرة عن السياق القانوني.
لم يقتصر التركيز على طبيعة الملكية على الكتابات الأكاديمية، ولكننا نجده أيضاً، ولكن بشكل مختلف، في النظام القانوني نفسه. ففي منطقة «جبل نابلس»، كما في غيرها من المناطق التي كانت في الماضي جزءً من الدولة العثمانية، يجرى تنظيم انتقال الملكية من خلال نظامين تشريعيين مختلفين؛ حيث يجرى توريث الأملاك مثل العقارات المدنية والمباني والكروم وبساتين الفاكهة والمنقولات وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، أما الأرض الزراعية (ولكن ليس المزروعات) فهي ليست أملاكًا ولكن أرض “ميرى“، للأفراد حق الانتفاع بها والحيازة ولكن تبقى الملكية للدولة. وكان هذا الحق في الحيازة قابلاً للتوريث ولكن كان يطبق عليه القانون المدنى الخاص بانتقال الملكية.
وفي إطار النظامين كليهما، لا يتحدد الحق في الميراث على أساس طبيعة الملكية ولكن على أساس الجندر والعلاقة الزوجية وعلاقة القرابة ووجود ورثة يحجبون الحق في الميراث. فالأرملة وفقًا للشريعة الإسلامية يحق لها ثُمن ميراث زوجها لو كان له أولاد (ليس بالضرورة منها) والربع إن لم يكن له من ولد، بينما الأرمل في نفس الوضع يرث ضعف الأرملة، أي الربع والنصف من ميراث زوجته على الترتيب. أما في حالة عدم وجود أبناء ذكور فترث الابنة الوحيدة النصف، وإن كانت ابنتان أو أكثر فهم شركاء في الثلثين. وبالتالي فلو مات رجل وليس له أبناء ذكور، يذهب جانب كبير من ميراثه إلى عصبة الذكور، وهم في معظم الأحيان إخوته الذكور. ولكن لو كان له أبناء ذكور فيرثون هم أولاً وتتعصب بهم إخوتهم الإناث، فترث الواحدة منهن نصف ما يرثه أخوها الذكر.
وبينما كانت الشريعة الإسلامية هي التي تطبق على ميراث الأملاك، كان قانون «الانتقال» العثماني هو الذي يطبق على أراضي «الميرى». والمبدأ الأساسي في هذا القانون هو المساواة بين الجنسين وتوزيع الأرض على أساس الأجيال. فكان الورثة الأساسيون هم أبناء المتوفى، فإن لم يكن له من أولاد ورثة أهله، مع حصول الزوجة على الربع لو كان له أبناء وعلى النصف إن لم يكن له.
في حالة الملكيات الصغيرة، كانت أكثر ظاهرة لافتة للنظر في قصص ميراث النساء من ذوات الأخوة الذكور هو إحجامهن بشكل عام عن المطالبة بنصيبهن في الميراث. ولم يكن للتمييز القانوني بين «الملك» و «الميرى» في قرية «البلدة» بالنسبة للنساء، إلا أهمية عملية قليلة للغاية. كذلك لم تكن هناك من صلة بين استبعاد المرأة من الميراث ووجود شكل أكثر جماعية في ملكية الأرض. وبقدر ما أسعفت الذاكرة أهل القرية، فلم يكن المطالبة بانصبتهن هناك إلا القليل من الأراضي المشاع، ومع ذلك اعتادت النساء على عدم المطالبة بأنصبتهن في الميراث.
وقد أشارت نساء القرية إلى أن طبيعة الملكية (أي الأرض) ليست هي المهمة، ولكن العلاقات بين الأقارب. وعندما كان الأنثروبولوجي «جرانقفيست Granqvist» يجرى دراسة في قرية «أرتاس» بالقرب من بيت لحم في عشرينات القرن الماضي، وسأل عن السبب في عدم حصول المرأة على نصيبها في الميراث أُجيب «ولكنها عندئذ لن يكون لها حق في بيت أبيها» (1935: 256). وقد عبرت نساء “البلد” في الثمانينات عن شعور مشابه إلى حد كبير، وأكدن على أن الابنة تؤكد وترقى من رابطتها مع أخوتها بتركها نصيبها لهم، وهي رابطة على جانب عظيم من الأهمية بالنسبة للنساء. تميل المرأة بعد الزواج إلى الاستمرار في ارتباطها مع أقاربها وتشعر بقرب خاص مع بيت العائلة وكذلك باعتمادها على أقاربها الذكور في أمانها الاقتصادي. والمرأة، بعدم مطالبتها بنصيبها، تحسن من أوضاع أخوتها، وبالتالي من وضعها هي وتؤكد على التزاماتهم نحوها. وبما أن حقوق المرأة في الميراث معترف بها على نطاق واسع، فإحجامها عن المطالبة بهذه الحقوق يضع أخيها في موضع التزام أمام أخته. ولكنها، من ناحية أخرى، لو طالبت بنصيبها من الميراث، فستنفصم عرى القرابة مع أخوتها انفصامًا لا رتق له، وقد لا تصبح قادرة على طلب مساعدتهم أو دعمهم. وبما أن الدعم الذي تستطيع التعويل عليه من أقاربها، عادة ما يؤثر على وضعها في بيت زوجها، فمن شأن هذه المطالبة في نفس الوقت أن تقوض هذا الوضع أمام زوجها وأهله.
ولأسباب مشابهة أيضًا، لم تكن الابنة المنتمية لأسرة قليلة الملكية، في المدينة، تطالب بنصيبها في ميراثها من أبيها، ولازالت لا تطالب به. فمع كون بيت العائلة وورشتها أدلة على وجود راسخ في المدينة، لا تتوقف أهمية هذه الأملاك على أنها مجرد أشياء محورية في دخل الأسرة، ولكنها تغدو أيضًا رموزًا ذات معانٍ قوية. وفي أسر الحرفيين تنتقل المهارة والأدوات والورشة من الأب والابن، ويقى البيت، وهو عادة الملكية الوحيدة الأخرى، من نصيب الأبناء الذكور وزوجاتهم وأبنائهم. أما بالنسبة لصغار حرفيي المعادن وصانعي الحلوى والنجارين وصناع الأحذية ومن إليهم، فمن المستحيل التفكير في تقسيم الملكية، كما أن الأخوة لا يملكون من المال ما يكفي لشراء أنصبة الأخوات. والابنة في المدينة، مثل نظيرتها في الريف،، عادة ما تختار استراتيجية دعم وضع أخيها بتنازلها عن نصيبها له، ولنفس الأسباب: تحقق هويتها من خلال بيت أبيها واعتمادها عليه. الواقع أن اعتمادية النساء الاقتصادية كانت أكبر، حتى وقت قريب، في ظل وجود تقسيم أكثر صرامة للعمل في المدينة بين الجنسين.
ولكن بالرغم من الاستمرارية التاريخية القوية والأهمية الكبيرة للعلاقات مع الأخوة، إلا أن العلاقة الزوجية ازدادت رسوخًا مع مرور الزمن. لقد ذكر «جرانقفيست»، عندما كتب عن فترة العشرينات، أن الزواج كان مهمًا للمرأة حيث إن المرأة غير المتزوجة تكون هدفًا سهلاً للقيل والقال، ولكنه أكد على أن الأخ هو الذي يهُب للحماية والمساعدة عندما تدعو الحاجة. «الزوج– على أية حال– هو مجرد ثوب تضعه المرأة أو تخلعه عنها مرة أخرى، أو قد يقوم زوجها «بإلقائها عنه»، ولكن الأخ هو الذي ستجده دائمًا عند الحاجة» (Granqvist 1935: 235). على أن المرأة في «البلد» في الثمانينات، كانت تميل إلى التركيز بشكل أكبر على الدور المحوري للزوج كموفر للدخل. وقد أجبن عن تساؤلاتي عن السبب في عدم مطالبتهن بأنصبتهن في الميراث بأن الأخ يحتاج للأرض “لأن عليه أن يرعى زوجته وأبنائه، أما المرأة فليست بها حاجة إليها، حيث إن زوجها هو الذي يرعاها“. ومع ذلك، فبالرغم من اعتبارهم للزوج كمسؤول أساسي عن رعاية البيت، إلا أنهن لا زلن تعترفن بأهمية الأخ في أوقات الأزمات، فلا تقدمن على قطع الصلات معه بمطالبتهن بحقوقهن في الميراث، إلا فيما ندر.
كثيرا ما تبرر الابنة المنتمية لأسرة قليلة الأملاك عدم مطالبتها بنصيبها من تركة أبيها بأن الإرث نفسه أقل من أن يقتسم وأن الأخ بحاجة له حتى يستطيع رعاية بيته. فهل يعني ذلك أن الثراء يجعل حصول المرأة على نصيبها أسهل ؟
هذا هو الحال بالفعل، إلى حد ما. فالحقيقة أن الملكيات المدرة للدخل والعقارات في أسر الأثرياء، ككبار التجار وأصحاب المناصب العليا وكبار ملاك الأراضي، تنتقل للعصب وتبقى، بوجه عام، تحت سيطرة الذكور. وبالرغم من توفر ثروات كافية في تلك الأسر ينظر إلى إعطاء البنات جزءًا من تركة أبيهم على أنه تحسين لوضع الأسرة ككل. وبالتالي فالابنة عادة ما يخصص لها نصيب من الدخل الذي تدره تلك الأملاك. بيد أن ذلك قد يحدث بعد فترة لا بأس بها من الزمن وقد تحصل الابنة على أقل بكثير من حقها الشرعي.
أضف إلى ذلك أن من تهتم بشكل عملي بحقوقها المالية، عليها أن تواجه مشكلة اعتبار سؤال المرأة عن تركة أبيها أمرًا غير لائق. فها هي “خولة“، على سبيل المثال، وهي في أوائل الأربعينات من عمرها وكانت امرأة ناجحة في حياتها العملية لا تجد سهولة في الحصول على حقوقها في الملكية. فبعد موت أبيها في أوائل الخمسينات من القرن الماضي، وكان تاجر ملابس جملة ومن كبار ملاك الأراضي، بقيت أملاكه دون تقسيم. ولم تقسم الأملاك رسميًا إلا بعد ثلاثين سنة عندما ماتت أمها أيضًا. وفي ذلك الوقت كان قد مر على زواج خولة من رجل أعمال 15 عامًا وكان لها ابنتان في سن المراهقة، إحداهما تعانى من مشاكل صحية، كما كانت قد حصلت هي نفسها على وظيفة.
وعندما تم تقسيم تركة أبيها كان ثلاثة من أخوتها بالإضافة إلى أختين لا يزالون احياء. وطبقًا لما جرت عليه العادة، فقد تولى الأخـوة كل ترتيبات تقسيم التركة. بيد أن خولة، مدفوعة بقلقها على مستقبـل ابنتيها، والتي ركزت على أن ليس لهما من أخ يحميهما، كانت تريد أن تعرف تفاصيل ما يحدث، ولكنها وجدت صعوبة في طرح السؤال. «تعتبر الأغلبية، والمتعلمين منهم أيضاً، أن من العار أن تستقصى المرأة المعلومات عن نصيبها في الميراث. يقول الناس عندئذ “بتقصر أخوها» أي تقلل من شأنه. وهكذا صمتت أختاى، كانتا على خجل منعهن من السؤال. ولكني كنت قوية، ولأننى كافحت حصلتا على نصيبيهما». والواقع أن الأخوة استاءوا من فضول أختيها. وبعبارة خولة: «لقد ورثت بالكفاح، ليس في المحكمة، ولكن بقولي لهم «لن أوقع على شيء حتى تطلعوني على كل شيء». فهم لم يتعبوا للحصول عليه، على أية حال، ولكن والدي تعب وتركه كله لنا. ولازالت خولة تعتقد أنهم قد حصلوا على أكثر من نصيبهم بقليل، ولكن ذلك، كما تقول، «لا يهم، فهم أخوتي». وبعد أن ورثت عقارات في المدينة وأسهمًا بنكية باعتها جميعًا لتشترى قطعة أرض وتبنى عليها بيتًا لها. كان همها الأساسي تأمين مستقبل ابنتها الكبرى: «حتى يكون لها بيت جميل في المستقبل. أريد أن أطمئن على أنها في أمان».
وبالرغم من أن خولة أكدت على أن أخوتها عاملوها على نحو طيب إذ سمحوا لها بالدراسة في الخارج، في وقت لم تفعل ذلك إلا قلة من الفتيات، إلا أنها وجدت عنتًا في إقناعهم بتقسيم تركة أبيهم حتى تحصل على نصيبها. وقد كان تصرفها هذا مناقضاً للقاعدة غير المكتوبة والتي تقول بأن على المرأة أن تقنع بما تُمنح وليس لها أن تبحث عن نصيبها. وهكذا، فبالرغم من أن بنات الأسر الثرية عادة ما تمنحـن جزءًا من أنصبتهن في التركة، إلا أن المتوقع هو ألا يثيروا الموضوع من تلقاء أنفسهن. وقد أقدمت خولة على ذلك لأنها كانت قادرة على ذلك، إلى جانب وجود ضرورة ملحة دفعتها للقيام به، فهي، كامرأة عاملة في الأربعينات من عمرها ولها بيتها ودخلها الخاص، لم تكن شديدة الاعتماد على أخوتها وربما لن تحتاج إلى اللجوء إليهم في أوقات الشدة. ومع ذلك، فالعامل الأساسي الذي دفعها للتحرك هو احتياجها لتأمين مستقبل ابنتها.
تجد المرأة المسنة العزباء نفسها في وضع خاص، فيما يتعلق بالملكية والميراث. فبالرغم من أن معظم من استطعن تركن بيوتهن القديمة في نابلس، فإن هناك عدداً من تلك البيوت القديمة لا تزال تسكنها مسنات فقط. وأحيانًا ما تعيش المرأة وحدها، وفي معظم الأحيان تعيش امرأة مع ابنتها أو أختين معًا. «الست سلوى»، هي إحدى المسنات، في أوائل الستينات من عمرها، اللائي تعشن بمفردهن في المدينة القديمة في نابلس. تنتمى «الست سلوى» إلى أسرة حرفيين، فهي ابنة مالك ورشة صغيرة، بدأت في العمل كخياطة وهي لا تزال فتاة صغيرة. وفي فترة تالية تولت أيضًا مسؤولية رعاية طفل أحـد أخوتها ثم إزدادت مسؤولياتهـا عندما مرضت أمها. في ذلك الوقت كان أخوتها قد تزوجوا جميعًا وتركوا البيت. «تركت زوجاتهم أمي لحالها» بعبارة سلوى.
وقد تدهور وضع «الست سلوى» كخياطة عندما انهارت حرفة الخياطة الحرة بعد الاحتلال الإسرائيلي في عام 1967. بيد أن ما تسبب في هجرها لمهنة الخياطة بشكل نهائي كان مأساة شخصية، وهي موت ابنها بالتربية في الحرب الأهلية في الأردن سنة 1970، وعندما ماتت أمها بعد بضع سنين (وكان أبوها قد توفى قبل ذلك بعدة سنوات) قررت أن تعيش بمفردها في بيت الأسرة. بيد أن هذا الوضع لم يسعد أخوتها لخشيتهم أن يلومهم الناس بزعم عدم رغبتهم في رعاية أختهم. ولذلك انتقلت للعيش في بيت أخيها الأكبر لفترة من الزمن، ولكن «زوجته لم تحتمل الوضع» على حد تعبيرها. فقد شعرت «الست سلوى» بسوء معاملتها وأنها لم يكن لها إلا قليل من احترام الخصوصية. وبعد أن وقعت مشاجرة عادت إلى بيت الأسرة القديم والذي تفضله كثيرًا. وبالرغم من استمرار غضب أخوتهـا منها لفترة من الزمن ورفضهم الإنفاق عليها فإن الجميع قبل الوضع في النهاية وعادت مياه علاقتها مع أخوتها إلى مجاريها. ولم تفكر أبدًا في المطالبة بنصيبها في الميراث، ولكنها حصلت على سواري أمها الذهبيين.
وتشير مطالبة الست سلوى ببيت الأسرة وحصولها عليه إلى اختلاف بنية ممارسات الميراث المتعلقة بالمرأة المسنة العزباء عنها في حالة المرأة المتزوجة. تقع على الأخ مسؤولية شرعية تتمثل في الإنفاق على أخته غير المتزوجة التي ليس لها من أسباب رزق خاصة بها، ومساهمة الأخ في الإنفاق على أخته يصعب تمييزها، بمعنى ما، عن فكرة الوفاء التدريجي بنصيبها في الميراث. وإذا ما نشب توتر، فهو عادة ما ينصب على إعالة الأخ لأخته وليس على الميراث. على أن المرأة المسنة العزب عادة ما يكون لها حق انتفاع قوى في بيت أبيها. ومع تزايد شيوع انتقال الابن بعد زواجه إلى بيت خاص به، أصبح الحال الأنسب للجميع هو بقاء الابنة المسنة غير المتزوجة في بيت أبيها. وبالرغم من القرب الشديد الذي قد تكون عليه الروابط العاطفية بين الأخت وأخيها، ومن أن الأخت قد تكون كلمتها مسموعة في بيت أخيها أكثر من زوجته في السنوات الأولى من الزواج. إلا أن هذا الوضع يميل إلى التبدل بمرور الوقت عندما يصبح أبناء زوجة أخيها كباراً. وقد سمعت أكثر من مرة امرأة مسنة تحذر فتاة مترددة في الزواج من أنها قد ينتهى بها الأمر في بيت أخيها كخادمة لزوجته. وهكذا، فبالرغم من أن المرأة المسنة غير المتزوجة عادة ما لا تطالب بنصيبها في الميراث، إلا أن مطالبتها ببيت أبيها تكون شديدة القوة وعادة ما تكون ذات أهمية محورية بالنسبة لها.
في منطقة جبل نابلس، عادة ما تكون فرصة المرأة في الحصول على الذهب أكبر من فرصتها في الحصول على نصيبها في الأرض. لقد أخبرتني شابة عزباء قروية في منتصف العشرينات من عمرها وتعمل مدرسة في نابلس بأنها ترغب في التنازل عن حقها في الأرض لأخوتها لأنك ” لن تعرفي أبدًا متى ستحتاجين إليهم” ولكنها ستأخذ ذهب أمها. والواقع أنها كانت تتوقع أن تبيع أمها بعض الذهب في القريب وتعطيها المال لتشتبر به سيارة مستعملة لنفسها فتستطيع الذهاب لبيت الأسرة على نحو أكثر انتظامًا.
ومع ذلك فطبيعة الملكية ليست هي التي يدور عليها الأمر، ولكنها العلاقة بين المورِّث والوريث. فالذهب يورث في معظم الأحوال من الأم، ونظرًا للعلاقة العاطفية القوية التي تربط الأم بابنتها فمن المعتاد أن تعين الأم ابنتها فتهبها بعضًا من ذهبها أثناء حياتها. وقد يكون ذهب المرأة، في الحقيقة هو الملكية الوحيدة المتاحة في الأسر الأفقر، وبالتالي لا يمكن في كل الحالات أن يؤول للبنات، بيد أن الأم، في نابلس وفي المناطق الريفية على حد سواء، كثيرًا ما تهدى ذهبًا لابنة تشعر بمسؤولية خاصة نحوها أو بقرب خاص معها، ابنة أجلت زواجها لترعى أمها المسنة على سبيل المثال. وحتى لو لم تفعل ذلك في حياتها، كما حدث في حالة السـت سلوى، فهذه الرابطة الوثيقة بين الأم وابنتها تعطى المرأة حقًا خاصًا في تركة أمها، والتي عادة ما تتمثل في الذهب. بهذا المعنى يبدو حرمان المرأة من ذهب الميراث أصعب بكثير من حرمانها من أية نوعية أخرى من الملكية.
عندما تطالب امرأة متزوجة من أسرة قليلة الأملاك بحقها في التركة، فعادة ما يكون ذلك دليلاً على مرورها بأزمة شديدة. وفي بعض الحالات يكون الزوج هو الذي يضغط على زوجته للمطالبة بنصيبها، فلا تصدر في ذلك عن مبادرة منها. والحقيقة أنها قد تقدم على ذلك على خلاف رغبتها هي. وتروى القصة التالية حالة واحدة من بعض نساء «البلد» طالبن بنصيبهن:
أراد زوج هذه المرأة أن تحصل على أرضها لأنه تشاجـر أحد أخوتها. وتحت ضغطه شعرت أنها مكرهة على الإقدام على ذلك، وهو ما دمر حياتها. كان أخوتها على علاقة طيبة معها، واستمروا في تقديم الهداية لأخواتها الأخريات اللائي لم تطالين بنصيبهن، لكن في حالتها، وبعد أن دفعوا لها ثمن الأرض نقدًا، قطعوا علاقتهم معها. وكان لذلك أثره السيئ عليها فسقطت مريضة ولم تر تمام الشفاء من مرضها أبدًا. ولم يرعها زوجها حق الرعاية وأنفق أموالها، ثم تركها في النهاية لحالها.
وبالرغم من كثرة اللوم الذي يوجه للمرأة التي «تأخذ أملاكًا من أخواتها»، إلا أن المجتمع يتغاضي عن مطالبة الابنة بنصيبها في ظروف معينة. فلا تلام الابنة التي تطالب بحقوقها لو أساء الأخوة معاملتها وأهملوها ولم ينفقوا عليها. ومع ذلك، فحتى في ظل تلك الظروف، لا تقدم على تلك الخطوة إلا قلة من النساء. ومن ناحية أخرى. فالابنة التي ليس لها أخوة يختلف وضعها اختلافًا كبيرًا فيما يتعلق بتركة أبيها (انظر أيضا 67: 1960 Grangvist 1931: 76ff; Rosenfeld). ومن المقبول اجتماعيًا في جبل نابلس أن تطالب مثل تلك الابنة بنصيبها وعادة ما يفعلن ذلك. بيد أن محاولاتهن لا تكلل دائمًا بالنجاح. وتوضح ذلك قصة أم عبد الرحيم، وهي أرملة فقيرة تعمل عاملة نظافة في مستشفى نابلس.
مات أبو أم عبد الرحيم وهي طفلة، وكان من صغار ملاك الأراضي في قرية «ن».
ونظراً لزواج أمها بعد موت أبيها، فقد أخذها عمها في قرية «ن» هي وأختها. وعندما بلغت الثانية عشر من عمرها زُوجت لرجل من المجدل بالمنطقة الساحلية بفلسطين. وبعد بضع سنوات وعندما اندلعت المعارك في عام 1947/ 1948كان عليهم أن يفروا من المجدل فذهبوا إلى «ن». وفي ذلك الوقت كان عمها قد استولى على أرض أبيها. وتشدد أم عبد الرحيم على أنه «لم يرد أن يعطينا أي شيء منها، ولم يكن لدينا شيء. سمح لنا فقط بأن نعيش في البيت القديم». كانت صغيرة ومعها زوج لاجئ، فلم تشعر بأنها في وضع يسمح لها بتحدى عمها. وفي تذكرها لتلك الأيام، تؤكد أم عبد الرحيم على مدى صعوبة الوضع آنذاك. «ذهب زوجي إلى كل مكان بحثًا عن عمل. وعشنا لفترة قصيرة في وادي الأردن نعمل كمزارعين بالمشاركة، ثم عمل زوجي لعامين في الكويت، وبعد ذلك عشنا لفترة مع أبنائنا الثلاثة في الضفة الشرقية حيث عمل في تقطع الأحجار». وعندما لم يعد زوجها قادر على هذا العمل عادا إلى «ن» وحاولت أم عبد الرحيم وأختها أخيرًا الحصول على نصيبهما في أرض أبيهما. وتقول: «كان ذلك بعد عشرين سنة من وفاته. في البداية رفض عمي رفضًا قاطعًا. ولكن حاولنها إقناعه بواسطة آخرين، وفي النهاية، وبعد كثير من المشاكل، حصلت أنا وأختـى على ربع أرض أبينا، بالرغم من أننا يحق لنا أكثر من ذلك».
مثل هذه الحالات شائعة إلى حد كبير. فلو حصلت ابنة، ليس لها أخوة، نصيب من تركة أبيها، فعادة ما يكون أقل بكثير من حقها الشرعي. فأم عبد الرحيم، على سبيل المثال، لم يكن عليها فقط أن تنتظر لسنوات عديدة قبل أن تحصل على الأرض، ولكنها أيضًا لم تحصل على نصيبها كاملاً.
إن للابنة التي ليس لها أخوة أسباب وجيهة للمطالبة بأرضها. فقد تعتقد، وكثيراً ما تكون محقة في ذلك، أن أعمامها سيكونون أقل اهتماما برخائها وأقل قابلية للاعتماد عليهم في الإنفاق عليها مما قد يكون عليه أخوتها. وبالتالي، فبالرغم من أن زوجها هو الذي يستفيد في العادة من ميراثها، إلا أن حصول المرأة غير ذات الأخ على نصيبها قد يظل أيضًا استراتيجية حكيمة. ويقر المجتمع بالوضع الإشكالي لمثل تلك الابنة فلا تلام لمطالبتها بنصيبها، بينما تلقى اللائمة على الرجل الذي يحاول أن يحرم بنات أخيه من ميراثهم في العادة. ومع ذلك فمن الصعوبة بمكان أن تكون لها سيطرة فعلية على أملاكها. فلو كانت متزوجة فعادة ما سيتجاهل عمها، والذي يكبرها في العادة بسنوات عديدة، مطالبتها بنصيبها، ويتوقف حصولها على أي شيء إلى حد بعيد على وضع زوجها في المجتمع. أما لو كانت لا تزال عزباء، فيصبح عمها، ليس فقط حاجبها في الميراث، ولكن وكيلهـا الشرعي في الزواج أيضًا. وحتى يتحاشى أي مشاكل في المستقبل حول التركة قد يحاول تزويجها لابنه، فلا تخرج الأرض بذلك للغرباء. وكما لاحظ «جرانقفيست» في «أرتاس»، تستطيع الابنة التي لا أخ لها أن ترث، ولكن عليها أن تتزوج من العائلة «حتى يُمنع حصول غريب على أملاك وميراث العائلة»؛ والواقع أن هناك عددًا متفاوتًا من الفتيات من غير ذوات الأخوة تـزوجـن مـن أبناء عمومتـهـن (78 ;76: 1931). هذا النوع من تزاوج أبناء العمومة هو أيضًا أكثر أشكال الزواج القسرى الأكثر شيوعًا في باقي مناطق الضفة الغربية، للرجال والنساء على السواء. فقد يكون على الرجل أن يتزوج امرأة تكبره بعدة سنوات لمجرد الحفاظ على الأرض، وهو ما قد يؤدي به فيما بعد لاتخاذ زوجة ثانية.
ترملت أم ربحى عام 1976 عندما قتل الجنود الإسرائيليون زوجها عند نهر الأردن عندما كان يحاول العـودة من عمله في الكويت إلى أسرته في الضفة الغربية. ولكونها في السابعة والعشرين من عمرها آنذاك ولها ابن في التاسعة من عمره وثلاث بنات يصغرنه، لم يكد يكون هناك من شك في أنها ستمكث مع أبنائها في بيت زوجها.وبالرغم من أن علاقتها مع حماتها في حياة زوجها كانت تشهد بعض التوتر بين الحين والآخر، إلا أنها أشارت إلى أنها تربطها بحماتها علاقات أسرية قوية، فهي وزوجها ينحدران من نفس الجدود كما أن أخاها متزوج من أخت زوجها. وقد بذلت هي جهدًا كبيرًا حتى تسير الأمور على ما تحب. فقد ساعدت زوجها على الادخار حتى يستطيع بناء بيت منفصل عن بيت أبيه فأقرضته بعضًا من مالها ليصرف منه على الأرض كما كانت تزرع الأرض بنفسها. وعندما ترملت لم ير أحد أن عليها أن تترك بيت زوجها. وكان لحميها ما يكفي من الأرض وكان لابنها أن يرث نصيب أبيه فيها. واستمرت في زراعة الأرض واستمر أهـل زوجها في الإنفاق على البيت. وحتى تقلل من اعتمادها عليهم بدأت تعمل خياطة، كما كانت تتلقى مساعدات من أخيها في الكويت والذي كان في سعة من العيش وكان يرسل لها الكثير من الهدايا.
عند الأرملة، أكثر منه حتى عند الابنة، المهم فعلاً هو العلاقات الاجتماعية وليس الحصول على الأملاك. فالأرملة عادة ما يهمها الاحتفاظ بأبنائهـا أكثر من الاهتمام بالحصول على حقوقها في تركة زوجها. وعندما كان دخل الأسرة لا يزال يعتمد على الزراعة بشكل أساسي كانت أهمية عمل المرأة معترفًا بها وكان ينظر للأبناء على أنهم مورد رزق. وإذا ما تنازلت أرملة ريفية عن أبنائها، فلا يكون ذلك إلا لأن أهلها يطلبون منها العودة لبيت أبيها، خاصة إذا كانت صغيرة في السن حيث قد يخشون على سمعتها ويرغبون في زواجها مرة أخرى. وما لم تتزوج من أخي زوجها فقد لا يسمح لها أهل الزوج بالاحتفاظ بالأبناء، وقد تجبر قانونًا على التنازل عنهم.
وفي حالة أم ربحى لـم يثر موضوع زواجها من جديد حيث إن علاقات القرابة مع أهل زوجها كانت كثيرة ووثيقة، كما أن زوجها كان قد بدأ بالفعل في بناء بيت مستقل، والأهم أنها لم تكن شابة وكان لها ولد يرث أملاك أبيه. وفي مثل تلك الحالات، فإن تركة الزوج، ما لم يكن له أبناء زوجة أخرى، تبقى بغير تقسيم لفتر طويلة، وحتى لو تنازلت الأرملة عن نصيبها لأبنائها، فيبقى لها وضع مستقل نسبيًا تكفله لها سيطرتها عمليًا على الأرض. وفي الأسر التي تعتمد على الزراعة تستطيع الأرملة أن تقوم بجانب كبير من العمل بمفردها، كما تستطيع أن تطلب مساعدة أقاربها أو أهل الزوج من الرجـال في الأعمال التي تتطلب رجالاً للقيام بها. وبالرغم من أن ذلك قد يعني، عمليًا، أنها ستكون آخر من يتلقى المساعدة، فإنها ستحتفظ مع ذلك باستقلالية أكبر مما كانت لها في حياة زوجها. وليس على هؤلاء الرجال من التزام شرعي بالإنفاق عليها بمجرد أن يكبر أبناؤها، بيد أن العلاقة بين الأم وأبنائها عادة ما تكون على قوة كبيرة عاطفيًا وأدبيًا. ومن غير المعتاد في مثل تلك الظروف أن يطلب منها أهلها العودة، وإن فعلوا فمن غير المتوقع أن تستجيب لهم.
أما وضع الأرملة الشابة التي لها بنات فقط، فهو شديد الاختلاف وتكتنفه الكثير من المشاكل، فهو وضع ملىء بالتوترات والنتائج التي لا يمكن توقعها. فبالرغم من أن الأرملة نفسها تفضل في العادة البقاء مع بناتها ورعايتهن، إلا أن مستقبلها هي يبقى غير آمن، فسوف تتزوج البنات فتصبحن، في العادة، غير قادرات على الإنفاق عليها ورعايتها. وليس على أخوة زوجها المتوفى من التزام بالإنفاق عليها وقد يسلبونها وبناتها حقوقهن في التركة. وقد يحثها أقاربها على العودة لبيت أبيها ولكن ليس عليهم أيضًا من التزامات تجاه بناتها. وقد يضغطون عليها لتتزوج مرة أخرى، وهو وضع شديد المشقة عاطفيًا عليهـا وعلى بناتهـا. وتوضح خشية المرأة غير ذات الولد من مثل هذا المستقبل، حالات النساء اللائي تشجعن الزوج على الزواج من أخرى ليرزق منها بالولد حتى لا يصبح لأخوة الزوج حق في أملاكه وتجد بناتها أخوة أنصاف أشقاء لحمايتهن.
حتى الأبناء الذكور لا يضمنون دائمًا استطاعة الأرملة البقاء مع أبنائها، كما توضح قصة «نزهة». ترملت نزهة– وهي من أسرة تنتمى للطبقة المتوسطة الدنيا– سنة 1983، وكانت في السادسة والعشرين من عمرها، وأمًا لأربعة من الأبناء الصغار. وقد كانت على وفاق تام مع زوجها الذي كان يمتلك حانوتًا صغيرًا ويكبرها بخمسة عشر عامًا، ولكنها لم تكن على وفاق مع حماتها الأرملة والتي كانوا يعيشون معها. وعندما مات زوجها فجأة تصاعدت الأمور بسرعة. فبالرغم من أنها كان لها أربعة أبناء إلا أن أهل زوجها قالوا لها إنها ليس لها حقوق لأنها لا تزال شابة وقد تتزوج مرة أخرى فتذهب التركة لزوجها الجديد، على حد تعبيرهم. وبالرغم من أنها أكدت لهم على تكريس حياتها لأبنائها بتنازلها عن حقوقها في الميراث لهم، إلا أن ذلك لم يشفع لها. ورفض أهل الزوج مساعدتها وأرادوا أن تعود لبيت أبيها. وانزعج أبيهـا بدوره وطلب منها أن تعود لبيته، ولكن على أن تترك الأبناء خلفها، فهو على استعداد للإنفاق عليها، ولكن ليس عليه من التزام في رعاية أبنائها. ولتحاشي هـذا الوضع، حاولت نزهة في البداية أن تدير حانوت زوجها في منطقة السوق بدون مساعدة من أقاربها أو أهل زوجها الذكور، ولكنها لم تنجح في ذلك. ثم عادت لبيت أبيها والذي قبل في النهاية ببقاء الأبناء معها بعد أن هددت بالانتحار. ولكن لأن أبيها لم يعطهم شيئًا جعـل حياتهم جحيمًا انتهى بها الأمر إلى الزواج.
وحتى لو كانت حالة نزهة– وهي أم لأربعة أبناء أُجبرت على نحو ما على الزواج مرة أخرى– حالة استثنائية، إلا أنها توضح المشاكل التي قد يتعين على الأرملة في المدينة أن تواجهها. فبسبب التفرقة بين الجنسين في العمل، عادة ما يتدهور الوضع الاقتصادي للأرملة في الحضر بشكل كبير، بل قد يصبح أسوأ من وضع نظيرتها الريفية (صاحبة الأملاك). ففي ظل الاقتصاد النقدي في الحضر عادة ما لا تستطيع الأرملة القيام بعمل زوجها حرفيًا كان أو تجاريًا، ولو حتى بشكل جزئي. في نفس الوقت وباستثناء اللائي تعملن موظفات، فليس هناك أمام المرأة إلا القليل من الأعمال البديلة التي يكفي دخلها للإنفاق على أسرتها. ومن هنا، ففقد الزوج يعني حرفيًا فقد العائل، وقد يجبرها ذلك على الاعتماد على الصدقة والهبات. ومع النظر إلى الأرملة وأبنائها على أنهم عبء اقتصادي، يُلزم كل من له صلة نفسه بمن من هو ملزم بنفقته فقط، فيرفض أهل الزوج الإنفاق على المرأة ولا يرغب أبوها في الإنفاق على أبنائها. وفي ظل تلك الظروف يصعب عليها أن تصمد حتى يكبر الأبناء ويستطيعوا الإنفاق على البيت.
وبالرغم من أن الأرملة الريفية كان وضعها في السابق أقل اعتمادًا على الآخرين على الأقل بالنسبة لمن تستطيع أن تبقى مع أبنائها، إلا أن التغيرات الاجتماعية– الاقتصادية قد أثرت عليهن أيضًا. ففي حالة الأرملة «ذات الأملاك» والتي لها أبناء لا بتمثـل السؤال الأساسي فيما إذا كانت ستحصل على حقوقها الشرعية أم لا، ولكنه يتمثل بالأحرى في كيف تستطيع أن تدير هذه الممتلكات. فعندما كان الإنتاج في المناطق الريفية يتجه لتوفير احتياجات الاستهلاك المحلى فقط كان الأمر أيسر على المرأة الريفية منه على الحضرية، حيث كان تقسيم العمل على أساس الجندر أقل صرامة في القرية وكانت معظم السلع الاستهلاكية تنتج في البيت. ولكن تدريجيًا، أصبح من المستحيل الاعتماد على زراعة الأراضي شبه الجافة وحدها، كما أصبح سكان الريف أيضًا أكثر اعتمادًا على تحويلات العاملين في الخارج. والنتيجة أن وضع الأرملة الريفية أصبح أضعف بكثير وأقرب شبهًا بوضع الأرملة في الحضر. وأصبح فقد الزوج بالنسبة للمرأة الريفية أيضًا يعني فقد العائل، وأصبح الترمل مرادفًا للفقر.
اقترحت في هذا الفصل أن نحول تركيزنا من طبيعة الملكية الموروثة إلى وضع المرأة الوارثة. وتدل المادة التي قدمناها هنا على أننـا، حتى نفهم استراتيجيات ميراث المرأة، فمن المهـم أن تركز على شبكة معقدة من العلاقات الاجتماعية بين الجنسين: الوضع بالنسبة للأقارب من ناحية التراتب الاجتماعي والحالة الزوجية وتقسيم العمل. كما أن وجود أو غيـاب ورثة حاجبين أمر محوري في تحديد ما إذا كانت المرأة ستحجم عن المطالبة بنصيبها في الميراث أم لا. وأكثر المهتمات بالمطالبة بنصيبهن من البنات من غير ذوات الأخوة (وأمهاتهن المترملات). وتعتبر الابنة المنتمية لأسرة ثرية صاحبة أفضل فرص في الحصول على بعض ميراث أبيها، بينما تتمسك المرأة المسنة العـزب بحق انتفاعها ببيت أبيها.
هناك نقطة أخرى أثرناها في المقدمة، وهي تلك المتعلقة بالعلاقة المفترضة بين الملكية السلطة. فالمؤرخون، على وجه الخصوص، والذين يمتلكون– بفضل المصادر المتوفرة لديهم– معلومات عن الملكية أكثر من تلك التي تخص المرأة أو دوافعها، عادة ما يعتبرون الملكية مؤشرًا على وضع مستقل نسبيًا وتجسد للسلطة. وتشير المادة التي عرضناها هنا إلى تعددية معانى ميراث الأملاك، وتعضد رأينا بتعديل افتراض وجود علاقة إيجابية بين السلطة والملكية.
فالحصول على الحقوق في الملكية لا يدل بالضرورة على السلطة. فبعض النساء تحصلن على جزء من أنصبتهن بشكل تلقائي لأنهن من أسرة حضرية ثرية، ولأن إعطاء الأخ لأخته يعلى من شأن الرجل، ولكن لا يفترض أن تسأل هي عن حقوقها. وفي تلك الحالات يعبر حصول المرأة على أملاكها عن وضعها الطبقي. وقد ترث أخرى لأن زوجها ضغط عليها بشدة للمطالبة بنصيبها. مثل تلك الوارثات لا ينتظر أن تفقدن دعم ذلك الأهل، ولكن ينتهي بهن الأمر في وضع أضعف أمام الزوج وأهـله، وليس في ذلك أي تعبير عن السلطة. وعلى الجانب الآخر هناك نساء تحاولن أيضًا المطالبة بنصيبهن لأنهن تجدن أنفسهن في وضع شديد الضعف، مثل الابنة التي ليس لها أخوة.
وفي نفس هذا الاتجاه، فبينما لا تشير المطالبة بالحق، بالضرورة، إلى القوة لا يعني الأحجام عن تلك المطالبة، بالضرورة، التنازل عن كل حق فيها. وقد تختار الابنة تلك الاستراتيجية الأخيرة نظرًا لارتباطها العاطفي بأهلها أكثر فتشاركهم بذلك رخاءهم. فالمرأة، باعتمادها التام عليهم في أمنها الاجتماعي– الاقتصادي، قد يكون من الحكمة أن تفعل ذلك حتى تؤكد على التزاماتهم نحوها. إن عدم المطالبة بالحق في الميراث، ينظر إليها من الزاوية التاريخية، على أنها استراتيجية أفضل الممكن. ومنذ الخمسينات، ومع التزايد السريع في هجرة الرجال للعمل بالخارج وتهميش الزراعة، ازدادت مسؤولية الرجل كعائل واعتمـادية المرأة كمستهـلك. ومع التركيز على العلاقة الزوجية أكثر من علاقة القرابة، أصبحت المرأة تعرف بشكل متزايد بأنها زوجة أكثر من كونها ابنة أو أختًا. وتحتج النساء بأنهن لا تطالبن بحقوقهن في الميراث لأن الأخ عليه أن ينفق على بيته، ولكنهن تشرن أيضًا إلى أنهن تفضلن ذلك لأنه يمكنهن من استداعاء الأقارب للمساندة في مواجهـة الزوج. ولو كانت المرأة قد فضلت بالفعل العلاقة الزوجية، لكانت أخذت نصيبها من تركة أبيها وأعطته لزوجها الذي ستتحسن بذلك سلطته كزوج. بهذا المعنى، فالتسمك باستراتيجية الإحجام عن المطالبة بالميراث يمكن أن ينظر إليه على أنه أفضل خيار متاح في محاولة لإحداث توازن دقيق، تحاول فيه المرأة أن تهيئ أفضل مساحة ممكنة للمناورة في نظام جندر معين. بيد أن ذلك يجعل المرأة معتمدة على أقاربها الذكور الذين قد يتبين فيما بعـد أنهم لا يعتمد عليهم، وتقـل إمكانية هذا الاعتماد مع تغير أشكال اكتساب الرزق التي تشجع الاعتماد بشكل أكبر على روابط الزوجية. وهكذا، فتحويل التركيز من الملكية كمورد مادى إلى الملكية كعلاقة اجتماعية بين الجنسين تساعدها على النفاذ إلى تعقيدات العلاقات بين الملكية والسلطة والجندر.
عثمان مصطفی عثمان: مترجم وباحث.
(*) هذا فصل من كتاب
Women, Property and Islam: Palestinian Experiences, 1920-1990 by Annelies Moors. Cambridge Univ. Press.
نرجو من قرائنا الرجوع للكتاب للحصول على قائمة المراجع.