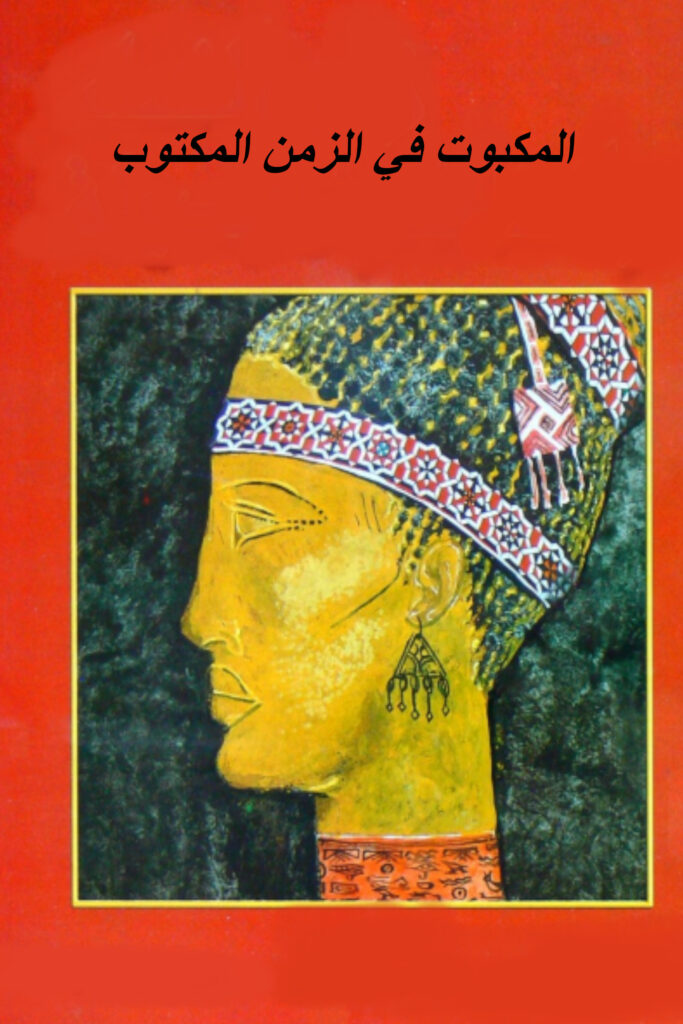المكبوت في الزمن المكتوب
1 – العتمات في ذاكرتي
أحاول الحفر في ذاكرتى، فلا أجد فيها إلا بضعة أوجه نسائية من الماضي البعيد والقريب، أنبش الكتاب لأصل إلى الأم “حواء“؛ فأكتشف أنها كانت شاعرة (١). إذ ينسب الثعلبي إليها ثلاثة أبيات في كتابه “قصص الأنبياء“، وهو يبدو أول من أوردها تبعًا لعبد الفتاح كيليطو (٢)، ولن يوردها بعده سوى سبط ابن الجوزى (القرن السابع/ القرن الثالث عشر):
دع الشكوى قد هلكها جميعًا بموت ليس بالثمن الربيح
وما يُغنى البكاء عن البواكي إذا ما المرء غُيب في الضريح
فأبك النفس وانزل عن هواها فلست مُخلدًا بعد الذبيح
إذا كان هذا القول من قبيل الأسطورة، فإن نسب الشعر إليها يحمل دلالة تميزها. كما أن ذكرها في تلك الحقب التاريخية المتباعدة، يجسد ما هو مستحب ومرغوب، أي الشعر من المرأة، اكتشفت وجهًا آخر لها لا يمت بصلة إلى صورتها الموروثة في أذهاننا: المرأة الغاوية، حمالة الخطيئة الأولى. يقدم لنا المشهد التاريخى المدون شلل الذاكرة، فيما يخص المرأة المبدعة. كأن التاريخ لا يتحرك، ووضع المرأة فيه يلفحه الجمود، فهل هو وعينا الخاطئ بالزمن؟ وهل يعود سوء فهمنا الزمن، إلى غياب صيغة الحاضر في لغتنا وقصورها على الماضى والمضارع؟ فأنا ألاحظ – دائمًا – انشدادنا نحو الماضى، كأننا به نبرر حقيقتنا، ونتخيل وجودنا. هل الماضى هو بالنسبة إلينا المرجعية؟ والحاضر الذي نعيشه، ماذا يشكل لنا؟
وأنا أبحث في هذا الموضوع، وجدت نفسى أغوص في الذاكرة، على أن أملى فراغاتها، لكنني في الوقت ذاته، وجدتني أنتقد مسارى، أفكارى وأدواتي أكتب الشيء ونقيضه، ليس لبلبلة في الفكر، إنما لأني أرفض في دخيلتى الاستسلام لما يقال عنا نحن النساء “امرأة مستلبة مقموعة، مقهورة…”، وأرفض الماضى المدون كمرجعية وحيدة تحدد ماهية وجودي، وأطمح وأعمل من أجل ابتكار حضورى الآن، بجهدى، وليس بمنة من ماضٍ لا يعترف بي، وحاضر يهمش كل من لا يملك القوة على الوجود. وكم أجدني أشبه، أحيانًا، بعض الرفاق من الرجال (باحثين، شعراء) في وضعيتنا في المجتمع، كعناصر خارجة عن السائد وبالتالي تُقصى عن المواقع الفاعلة في المجتمع. ألم يقل لى أحدهم: “أنا غير سعيد بالدور المطلوب منى في العائلة، الذكر المسؤول، صاحب السلطة، أنا تعبت!
2 – بعض مشاهد من ذاكرتي عن المرأة في التاريخ
عرفت منذ الطفولة أن الخنساء شاعرة الرثاء التي لا تضاهى، لكنهم لم يذكروا لي أنها شاعرة غزل، لماذا؟. فحين أعدت قراءة أشعارها وجدت غزلاً مواربًا ومديحًا لصورة رجولة تمثل الكمال والفتوة (۳). عرفت رابعة العدوية على أنها مثال المرأة التي تطهرت بتصوفها من عشق الجسد وحب الهوى والنزوع إلى الشهوات، وانتقلت إلى حب الله وتابت (٤). ولم يركزوا على نقطة جد مهمة وهي: أن رابعة “كانت حجة قاطعة بين معاصريها؛ إذ شكلت قطبًا في الأوساط الفكرية، فكان العلماء يحاورونها وينصتون إلى آرائها (٥). إذن… لم تجسد هذه التجربة – فقط – زهدها، إنما الأهم من ذلك أنها جسدت “فنًا من فنون السيطرة على النفس، أي مراسا ذاتيًا أتاح لها أن تتحرر من التبعية والخضوع؛ لكي تصبح سيدة نفسها، ومالكه زمامها (٦). كما لو أنها تسعى لبلوغ القوة في سيطرتها على نفسها، فتحولت ذاتها إلى سلطة معرفية (٧)، أى صارت المرجع الذي ينطق بالحقيقة. لكننا لا نوافق “على حرب فيما ذهب إليه بأن رابعة تنقلت بين شكلين من الاهتمام بالجسد. من لذة الجنس إلى لذة النص أو من “متع الأيروسي” إلى “متع اللوغوسى“. فمسارها يدل على أنها كانت متمردة على السلطة بشكل عام، التي لم تكن تقبل إلا الخطابات المندمجة في سياقها العام. غير أن تمردها قادها لأن تجعل من نص السلطة نصها، مما أخفي ظاهريًا ذاتها، لكن في حقيقة الأمر، هي انقلبت على هذه السلطة، وأسست أخرى خاصة بها. في هذه الحالة، أصبحت اللذة والسلطة لا تتناقضان، بل تتبعان بعضهما بعضا. كأن السلطة تسكن اللذة، وتصير تاريخها السرى. فهى تحتفل بالجسد، عن طريق الاستحواذ عليه من خلال افتتانه بالكلام، فيهيم داخل الخطاب، ولأن الجسد يبحث عن ما هو رغبة وجمال، عن اللذة، عندها يكون الخطاب تحقيقًا لها (۸).
إذن كيف نكشف عن هذا التراث المغيب و المنسى، أو المقروء من قبل بنية فكرية جامدة ومتسلطة؟ أثناء عملي في الكتاب الذي أعده عن الأدب النسائي عند العرب، عثرت على عنوان كتاب “شعر النساء“، وقيل إنه في سبعة أجزاء، ولكن لم يصلنا سوى نصف الجزء الأول. أين ذهب الكتاب؟ ولماذا لم يحفظه الرواة؟ هل لأنهم كانوا يسمون شعر المرأة بالضعف والعاطفية؟(۹). لو عدنا إلى كتاب “الأغانى” والجواري المغنيات“، لوجدنا عددًا لا بأس به من الشاعرات، اللواتي يمتاز شعرهن بالتحرر حتى الجنسي، من عصر الجاهلية وحتى العصر العباسي، في هذا الصدد، تورد الكاتبة قمر قيلاني هذه الواقعة: “كانت ليلى الإخيلية تتغزل بتوبة الحميري، فقال لها أحد الحاضرين: لقد بالغت في حبك لتوبة، وهو لا يستحق عشر ما قلته، فقالت له: هل رأيت توبة؟. قال: لا. قالت: لو رأيته لوددت من عذراوات قبيلتك كلهن أن يحملن منه!. فأي امرأة اليوم تجرؤ على مثل ذلك الغزل… وولادة بنت المستكفي لا نستطيع اليوم أن نروى أشعارها لابن زيدون.
فهل هي علاقة الأدب الذى كتبته المرأة بالحرية، هي التي أدت إلى تهميش هذا التيار؟. هل هو موضوع الحرية الفردية التي لم ينضب الحديث عنها في الأدب، ومنذ “أوديب” البطل الفردي، الذي أطلقته الأسطورة الإغريقية، فقيده سوفوكليس بفواجع الحرية!
إنها بلبلة الماضى وعبثيته، والحاضر هل هو على صورته؟
يذكر أدونيس في “ديوان الشعر العربي” (ثلاثة أجزاء) (۱۰)، فقط ست شاعرات هن: الخنساء، ليلى الاخيلية، ميسون بنت بحدل الكلبية، أم حكيم، ضاحية الهلالية، أم ضيغم البلوية. هل يعقل أن لا يكون في كل المراحل التاريخية التي درسها، إلا ست شاعرات يستحققن الذكر!
مشهد آخر تمثله جارية، وهى “تودد“، في زمن هارون الرشيد، التي كانت تتقن كل علوم عصرها، وتتفوق في إتقانها هذا، على كل رجالات ذلك العصر من الراسخين في العلم (۱۱). لافت النظر ضلوعها المعرفي، لكن لماذا هذا الضلوع يقتصر على الجارية؟. هل لتهميش معرفتها، أي سلطتها؟
أتيحت لي الفرصة، حين كنت أسكن البحرين، الاطلاع على قصة “مهرجان القيس” النسائي في مكة؛ حيث تحتل النساء المدينة في غياب الرجال الذين يغادون لبضعة أيام، فيتنكرن في ثياب الرجال، ويتبارزن بالأشعار والرقص، ويحتفلن بمدينتهن الخاصة. ويتضمن هذا الاحتفال، أناشيد تسخر من الرموز الرجالية في المدينة. ولم يختف هذا الاحتفال إلا في الستينيات!.
ربما علينا – في هذا المجال – مناقشة مقولة الحرية، وعلاقتها بالثقافة والإبداع. لا مجال هنا، للاستفاضة في هذا الموضوع، لكن الواضح بالنسبة إلينا، وبناء على ما أسلفنا ذكره من شواهد، أن الحرية “لا تتجلى كعلاقة تنظيمية للمجتمع، أو كشرط من شروط التقدم والاكتشاف والتطور والتغير الإيجابي نحو الأفضل، أو كضرورة من ضرورات النشاط الفكري الخلاق، أو النشاط الإبداعي المتميز، أو أخيرًا، كحق طبيعي من حقوق الإنسان الأساسية، كما يقول كمال أبوديب في دراسته من أجل الحرية” (۱۲).
جل ما ذكرناه حتى الآن، يخص المبدعات في الأدب، أما بالنسبة إلى النساء الأخريات، اللواتى كان لهن شأن في الشؤون العامة، فإن مكانهن في ذاكرتى معتم جدًا. حديثًا هناك بعض المحاولات لإبرازهن، من بينها، كتاب فاطمة المرنيسي: “السلطانات المنسيات، وكتاب ممتع وفطن لعبد الهادى التازى “المرأة في تاريخ العرب والإسلام، حيث اهتم بالنساء المغربيات المهمشات في المصادر، أو اللواتي حظين بذكر عابر، فرصد ٢٥٠ سيدة مغربية؛ وذلك انطلاقًا من العصر الذي ظهرت فيه طلائع الدولة المغربية الأولى، وانتهاء إلى منتصف القرن العشرين. هناك مصادر قديمة، لكنها غائبة عن ذاكرتنا، مثل: كتاب “الاصاب” لحافظ بن حجر، الذي ترجم لـ ١٥٤٣ امرأة، كان من بينهن الفقيهات والمحدثات والأديبات… وخصص الإمام النووي في كتابه تهذيب الأسماء، والخطيب البغدادى في تاريخ بغداد، والسخاوي في كتابه “الضوء اللامع، حيزاً كبيراً لترجمة أسماء النساء المثقفات… وترجم السيوطي، في كتابه “نزهة الجلساء“، لسبع وثلاثين شاعرة، وتتلمذ ابن عساكر على إحدى وثمانين امرأة، كما تتلمذ عليهن ابن الأثير والحافظ الذهبي، الذي أورد عددًا من أولئك السيدات الفاضلات (۱۳).
اللافت في هذه المصادر، أن كتابها يعدون من كبار الشخصيات الإسلامية، أمثال الشافعي وابن الكلبي وإسحاق الموصلى والمدائني وابن قتيبة والجاحظ والطبري وأبي الفرج الأصبهاني وابن منقذ وابن الجوزي، وابن بطوطة. اليوم كلما كان الكاتب مشهودًا له على الصعيد البحثى، تلافي دراسة وضع المرأة في المجتمع العربي، أو ربما اكتفي بإشارة عابرة. إنه مدخل سيئ لتناول التغيير الاجتماعي أو النقد الفكرى للمنظومات السائدة؛ ربما لأنه مدرك – تمامًا – أن هذا المفتاح المعرفي، هو الأساس الذي سيمكن من تشريع أبواب التكوينات الاجتماعية؛ لتشريحها علانية، ودون مخاتلة. واليوم نجد أن النساء هن المعنيات أكثر بكتابة الدراسات عن المرأة أو التراجم، كأنها مسألة فئوية تخصهن فقط. أما الرجل فإنه يدرس المجتمع بشكل عام، أو يطرح قضايا فكرية عامة للبحث، تطال الجميع. إنه وضع مقلق، أن لا يكون وراء المرأة الكاتبة، سوى المرأة!. كأننا عدنا إلى تقسيم العمل، الذي كان سائدًا بين الرجال والنساء: المرأة للداخل، والرجل للخارج. كأن الرجل للجميع، والمرأة للمرأة!. أي أن ذات البنية الذهنية، مازالت مسيطرة، وإن بأشكال جديدة.
عتمات أخرى تغطى ذاكرتى القريبة، فأنا بسبب إعدادى بحثًا حول التراجم المكتوبة، عن النساء، تبين لي أن هناك العديد من النساء الكاتبات، والصحفيات، والمؤسسات لجمعيات أهلية، مارسن وجودهن بشكل فاعل، في هذا القرن، وبالتالي، تحدين التقاليد الاجتماعية مثل روز اليوسف، مؤسسة مجلة روز اليوسف، التي تقول عن نفسها: “أنا صنعت من نفسي هذه السيدة. عنبرة سلام الخالدى، التي ترجمت الإلياذة” و “الاوديسة” و “الإنياذة” عن الإنجليزية، وكانت أول سيدة تلقى حديثًا نسائيًا من إذاعة القدس. وهناك ذكر للطبيبات الأوائل، مثل سنية حبوب وانستان بركات إلى د. سلوى نصار، عالمة الذرة الأولى في الشرق العربي، كما تعد تاسع امرأة، في هذا الاختصاص في العالم (١٤).
كما عرفت كثير من الأسماء الخليجية، التي أسست لدور مختلف للمرأة، كخيرية السقاف السعودية، التي تعتبر أول مديرة تحرير، في منطقة الخليج العربي، في جريدة الرياض، ود. فاتنة أمين شاكر، التي تعد أول مذيعة سعودية، قدمت برنامجاً نسائياً، بعنوان البيت السعيد، سنة ۱۳۸۱ هجرية (۱٥). أما هنا كسبانى كورانى اللبنانية، التي شاركت سنة ۱۸۹۲، في المؤتمر النسائى الدولى، الذي انعقد في شيكاغو، وقد مثلت نساء سوريا. ومريانا مراش السورية، التي أقامت صالوناً أدبياً في حلب، كان يؤمه عدد من رجال الدولة العثمانية وبعض القناصل. وملك حفني ناصف التي كانت أول فتاة مصرية، تنال الشهادة الابتدائية، عام ۱۹۰۰. وهند نوفل اللبنانية، التي هاجرت إلى الإسكندرية، وأصدرت مجلتها “الفتاة“، عام ۱۸۹۲. وكذلك لبيبة ماضى هاشم، اللبنانية التي هاجرت إلى مصر، وأصدرت مجلة “فتاة الشرق، عام ١٩٠٦، ثم أصدرت في الأرجنتين، مجلة “الشرق والغرب“، عام ۱۹۲۳ (١٦).
بالمقابل، هناك تعتيم في الكتابة الراهنة، عن الوجوه النسائية المؤثرة، والفاعلة في المجتمع، كما نفهم نحن هذا الأمر. إذ ليس من الضرورة، أن تكون شاعرة أو روائية، كي تذكر في التاريخ المكتوب. فاليوم تشارك المرأة في ميادين عديدة، ومتنوعة الاختصاصات والمجالات، لكنها على صعيد المكتوب، مغيبة إلا في كتابات نادرة، مثل دراسة د. خالدة السعيد عن المرأة والإبداع، التي تناولت فيه المرأة الناقدة، والنحاتة، والباحثة. (المغرب، نشر دار الفنك).
3 – الخيط الرفيع المنفلت بين المكبوت والمكتوب
أحاول ضبط هذا الخيط، ذلك لأن الكبت هو أسر وأسى، والكتابة أنس وتوسع للوجود أرجو أن لا تنتظروا منى أن أحل في هذه الدراسة، العقبات التي تقف في وجه حضور المرأة على الصعيد المعرفي. أنا أكتب من ذاتيتي كي أحسن علاقتي، لا بل لأغير علاقتي مع نفسي ومع الآخر. جل ما أستطيعه تفكيك الذاكرة التاريخية كـ Block واحد، ثم أحاول إعادة تركيبها وفقًا لمنظوري، الذي يتيح لى ممارسة وجودي، بقدر أغنى وأوسع.
لا يمكنني النظر إلى المسألة التاريخية، وتهميش المرأة في الكتاب التاريخي من زاوية إلغاء الآخر. فالورقة التي قدمت تطمح إلى ذاكرة بديلة. لا أومن بالبديل، بل بالكامل المتجدد. أى أومن بتجديد النظر، إلى هذه المسألة من زاوية وجودى كامرأة كاتبة. أفتح بذلك مجالاً للنقد، يجمع بين الواقع والممكن، ويؤسس لنظرة تغييرية للخطاب وللأشياء، والهدف خلق منطقة جديدة، تملأ الفراغ الذي ولده الخطاب المهمش للمرأة. لكن لا يمكننى الدخول إليها من فكرة الإلغاء، التي أعاني منها على كل الصعد؛ كفكرة الثورة التي تلغى ما قبلها، والتي أنتجت استبدادًا لا مثيل له، وفكرة التسلط، بحيث هناك – دائمًا – شخص واحد، أو عقيدة واحدة، يمتلكان الحقيقة. لن ألغى ذاكرة الرجل الذى كتب التاريخ، لأنه وللمفارقة هو – أيضًا – استبعد رجالاً كثرًا!. إذن برأيي هناك بنية فكرية، أدت إلى إقصاء المختلف، امرأة كانت أم رجلاً. إلا أن الإقصاء، مورس مضاعفًا للمرأة. علينا إذن كشف ميكانزمات هذه البنية. وأظن أن الكتابة، ما أقوم به الآن، من تعبير عن كينونتي ومعرفتي هي تفكيك لها؛ كي أبنيها بشكل مغاير، يسمح لآرائي أن تتجسد، ولخبرتي أن تتجلى.
من أجل ذلك، سأستبعد المدخل الذي يعتمد على مقولة الاستلاب والتحرر. أنهما مفهومان يعودان إلى الماركسية والفرويدية، وأعتقد أن المرحلة التي نعيشها، تفرض علينا فهمًا آخر لهذه المسألة. لقد فهم التحرر بشكل مختلف، عما أفهمه اليوم، كما بُنيت على هذا المفهوم قيم غامضة وسحرية. اليوم أفهم التحرر، بأن أصنع لنفسى دائرة قابلة للتوسع، أجعل أفكارى تتحرك فيها؛ كي تنتج – دائمًا – رؤية جديدة تخالف السائد، تكشف المكبوت، تنبش جذوره، أحيله مادة حية للتفكر والأصغاء فيصير كلامًا والكلمة من فعل كلم أى جرح – والكلام – الجروح، يعلمني التسامق على المنجز، ويكسبنى استعدادًا أكبر؛ لأفتح ممارسة وجودى على ذاتي، والآخر والعالم. فأجترح الممكنات، وأفتت المعيقات؛ كي أخرج من صورة صنعت لي إلا أني تأخرت عنها، وتقدمت عليها، لأكون أكثر معرفة وقوة. والتفكير – في هذا الاتجاه –يساعد على طرح مفهوم الإقصاء” بشكل مركب، ويعيد عن التبسيط، يأخذ – بعين الاعتبار – عالمنا المعقد والمتناقض. إنه يطال – دائمًا – الآخر الأضعف، أى يفرض علاقة سيطرة. فالبنية الفكرية الذكورية الموروثة، تقصى المرأة عن المجالات الحيوية للرجل، والراشد يقصي الطفل، والعاقل يقصى “المجنون“، والشمال يقصى الجنوب… أليست المعرفة هي المجال الحيوي للرجال!. ففي صلب هذه البنية، فكرة الاختلاف بين الرجل والمرأة، هي الجسد، وهو العقل. ألم يقل المعرى محذرًا، من تعليم النساء الكتابة:
ولا تحمد حسانك إن توافت بأيد السطور مقومات
فحمل مغازل النسوان أولى بهن من اليراع معلمات
ألم يقل – أيضًا – الفيلسوف كانط، أن المرأة تستعمل المعرفة، كما تستعمل الساعة؛ لتزين جسدها!. كأن الرجل هو مقتنى الحقيقة، في مقابل امرأة ليس في حوزتها، سوى الجمال والغواية. ألم يشككوا في تصوف رابعة؛ لأنها كانت جميلة!.
لا أؤمن بهذا الفصل، وما كتابتي إلا لتجاوزه، لأنه – في واقع الأمر – هناك علاقات قائمة بين كل الأطراف، أى ليس هناك من فصل. وهى في هذه الحال، علاقة سيطرة. لذلك فإن الكتابة بالنسبة إلىَّ، هى رسم جديد لهذه العلاقة مع الآخر، وتشكيل مختلف للقوة، التي تريد التحكم في اللعبة الحوارية المتداولة داخل مجتمعنا (الخطاب التاريخي). لا أود بناء ذاكرة بديلة؛ فأكون كمن يبنى أوهامًا؛ لأنها ستقصينى عن ماضٍ، هو جزء مكون من وجودى، من لا وعيى الجماعي. سيقودنى الإلغاء إلى نفي نفسى في واقع راهن، هو – أساسًا – مركب من صور تبادلية، بين أزمنة مختلفة، ومناطق فكرية متعددة. ثم لا يتسم الماضي بالثبات؛ حتى أستبدله بثبات آخر، فهو يعيش معنا، أى مع تبدلاتنا ومعاشنا الحي – الذي يتصف باستجاباته للمثيرات والتحديات والمتغيرات. حتى الحب لا يستعاد، بل يصير حبا آخر خلقا وإبداعًا. فالمعنى يتحرك ويتطور دائمًا، هذا إن لم نتحدث عن الفروقات الناتجة، عن اختلاف أجواء السرد.
أمام هذه الاستحالة، أجد نفسي مضطرة، إلى إعادة النظر، في توجهاتي وتصوراتي وأدواتي. لذلك؛ سأحاول اللجوء إلى بعض المؤشرات التي ستساعدني، في استجلاء مفهوم “الإقصاء:
أ – تاريخ الأقوياء: من القليل الذى وصلنا عن النساء المبدعات، نستطيع القول إنه دال على حرية في التعبير والتفكير، وحتى العيش. يمكننا إحالة ذلك إلى النهضة التي شهدتها المنطقة العربية، التي تميزت بالانفتاح على الثقافات والعادات المختلفة. ففي تلك الفترة، أي منذ الجاهلية، إلى أواسط الخلافة العباسية، كان العرب أقوياء، وفي طور التوسع؛ لذلك كانوا لا يخشون الانفتاح والتعبير الحر – لنلاحظ ما أكثر كتب الجنس والعشق في التراث، وما أعنى مرادفات الحب (تربو على المائة) – أما حين تضعف الأمم، فإنها تصبح محافظة، وتبتعد عن التساؤل. فالقوى لا يخشى الآخر، المعرفة والإبداع، أو تقديم آراء مخالفة للمعتقد السائد. أما الضعيف، فإنه يتقوقع على نفسه، ويعود القهقرى، ويصبح متشددًا في الحفاظ على التقاليد، وحرفيًا في تأويلها. من هنا إلى حد ما، كانت عتمات الذاكرة، وفجواتها المعرفية. إضافة إلى أن الرجل، بشكل عام، هو الذى كتب التاريخ، والذى يكتب هو الذي ينشئ، فمن امتلك الخطاب امتلك السلطة – كما يقول فوكو – لذلك فإن الصورة التي تبدو عليها الأمور هي هامشية المرأة. لكن من حقنا التساؤل، حول ما لم يكتب في الماضى والحاضر ومن إمكان وجوده. فهل تعرف اليوم، كل الكاتبات العربيات في الميادين المختلفة، وحتى في لغات مختلفة!. إن معرفتنا محصورة فقط، بهامش ما يقدم لنا. هناك طبعًا تفسيرات أخرى، تعتمد على تحليل ذكورية اللغة التي تحدد مسبقًا موقع المرأة ووظائفها في المجتمع (17)، وفي النظرية الاجتماعية والوضعية السياسية والاقتصادية والثقافية، للمجتمعات العربية.
أما بالنسبة إلى مسألة تغييب تراث المرأة الإبداعى، المدون في كتب التراث، فإننا نجد أن التأويل الذي جرى للخطاب التاريخي الذي أقصى المرأة، قد أجرى تفضيلاً، وأعطى أولوية، لمعنى على آخر. تلك الأولويات ترجع إلى إرادات القوة، وإلى السلطات التي توجد وراء كل تأويل؛ بحيث يصبح البحث عن المعنى، بحثًا عن استراتيجيات الهيمنة.
يتولد الفراغ الموجود في هذا الخطاب عن المصالح الإيديولوجية، كنتيجة للفئة السائدة، وللكبت من جهة، كما نفترض، من جهة أخرى، أن علاقات القوى المتعددة، التي تتكون وتعمل في أجهزة الإنتاج، والأسرة، والجماعات، والمؤسسات، تكون حاملة للانقسامات التي تسرى، في الجسم الاجتماعي بكامله.
كما أن الكتابة ارتبطت بمفهوم الاستمرار، واستخدم التدوين لقهر الإتلاف الذي يلحقه الزمان، والنسيان الذي يسببه التقادم؛ وذلك لترسيخ “المعنى الرسمى، وحفظه. لذا؛ ارتبطت النصوص المكتوبة – دائمًا – بالمؤسسات، التي تسعى إلى المحافظة والتقليد؛ حيث يكون النصر سلطة، تحاول تلك المؤسسات فرض نفوذها وسيادتها عن طريقه (۱۸). هكذا تصبح عملية القراءة، مجالاً للصراع، وبؤرة التناحر، بين إرادة القوة، وملتقى المنظورات المتباينة. لن يعود النص – أى النص التاريخي – والحالة هذه – حاملاً للحقيقة، لكنه لن يكف عن أن يكون مدار الصراع حولها.
لذلك؛ فإن قراءتنا المقوضة لميتافيزيقا النصوص؛ ستساعدنا على إبراز حياة الحقيقة داخل المجتمع، والسياسة التي تتحكم في قراءة النصوص وكتابتها، أي مجموع القواعد التي يخضع لها إنتاج النصوص، والاعتراف به، أو نشرها، وتداولها. ربما يساعدنا هذا المنحى، على الاقتراب قدر الإمكان، من طرح المسألة الإشكالية، التي كثيرًا ما تقف إرادة التحديد أمامها، حائرة، وهى كيف تحضر المرأة، وتغيب في الكتابة، التي بقيت زمنًا طويلاً، حكرًا على الرجل.
صحيح أن التاريخ البشرى، مبنى على الرغبة في الاعتراف بالذات، إلا أن هذه الرغبة، ترتبط بفكرة الحرية والمساواة بين الأفراد، على أساس الاعتراف المتبادل. يصطدم ذلك، بعلاقات ترتكز على الإقصاء والتهميش، ربما من أجل هذا الواقع الملتبس، نرى اليوم، أن ذات المرأة الكاتبة، تعيش شرخًا وانقسامًا، تفتح مجالاً، أمام تواجد ذات تهدم نفسها بنفسها – أي موروثها – وفي الوقت ذاته، تبدع ذاتها وتجددها، عبر زمن الكتابة.
ب – المعرفة وعلاقات القوة: يركز مفهوم الإقصاء بشكل ضمني، على بنية العلاقات الاجتماعية. صحيح أنه يعود في مرجعيته إلى موضوع عدم المساواة، لكنه يتجاوزها بإعطائه إياها معنى جديدًا، يعبر فيه عن القلق الجماعي بمواجهة التغيرات، التي هي في طور الصيرورة، أكثر من تعبيره عن ثبات في وضع المرأة. إن الإقصاء هو ظاهرة جماعية تخص النساء عامة، وليس كأفراد، وأساسها يجب البحث عنه، في مبادئ عمل المجتمع، يماثل فهم الإقصاء، البدء في مجابهته، لكن يقتضى ذلك، قلب العادات الممارسة في حقل التفكير.
ربما لو نظرنا إلى الموضوع، من زاوية علاقة المعرفة بالسلطة، لاتضحت لنا جوانب مختلفة. فالفن مثلاً، لا يمكنه إلا أن يشوش على النظام السياسي والاجتماعي. لذلك يسعى هذا الأخير إلى تهميشه وإقصائه بشكل عام (علينا أن نتذكر كم من الشعراء قتلوا أو همشوا؛ لأنهم عشقوا وتغزلوا علانية، فخرقوا المحظورات)، لكن إقصاء المرأة، تم بشكل مضاعف. ربما هذا يساعدنا على فهم كثرة توجه النساء في ما مضى، للفن عامة، والشعر خاصة – لم أجد في الكتب التي تسنى لى الاطلاع عليها. نثرًا – كأن فعل الكتابة عندها، يفهم كتعبير جنسي، أو يرتبط في اللاوعي الثقافي به.
في الحقيقة، إن ماهمشه التاريخ الأبوى، كما وصلنا، وليس كما بحثنا فيه، هو الجسد، الخيال، الرغبة، العواطف. أى كل الأشياء التي عجز الرجل الذي يمثل القوة، عن تملكها، والتحكم فيها. لقد دأب الخطاب الأبوى على اعتبار خطاب المرأة مجالاً قاصراً، وثغوره مقلقة، يلزم إخضاعه والسيطرة عليه. كان من نتائج هذا التقليد، اعتبار خطابها موضوعًا برانيا – لا يدخل في المتون – وبالتالي، لا يستحق التدوين.
تتميز هذه البنية الفكرية بمعايشتها وهم العقل، وكل ما هو خارج سيطرتها هو نافر عن العقل، وبالتالي، يجب إخضاعه. ربما نفهم عندها، لماذا تمت توصية عدم تعليم النساء الكتابة؛ حتى لا تكتب النساء نصوصًا تشى بالمكبوت وباللامقول؟. أى أن فعل الكتابة، حين تمارسه النساء تكون فكرته إقامة الحوار والتواصل بين الجنسين، في ثقافة أدرجت الحدود التي تفصل بينهما. فصارت تلك الحدود، ضمن ما يميزها عن ثقافات أخرى. ومن ناحية أخرى، ارتبطت الكتابة في الموروث الفكري العربي بالسلطة، التي تهمش ما دون المركز منها – سواء المركزية الفكرية أم المدينية. وفي حين اختلف استعمال الكتابة، واتسع نطاقها بين النساء، ظلت موضع شك وتخوف، على المستوى الاجتماعي، وظلت الأعراف السائدة، من إقصاء النساء، تمنع ما قد يترتب على الكتابة، من علاقات وحضور ساطع (۱۹).
في بنية يضيق هامشها، لمخالفة التقاليد عمومًا، تصبح كتابة المرأة تحديًا يكشف الحوار الآخر، وصور التواصل. وكذلك الأمر، تصبح الكتابة عن كتابة المرأة تحديًا مضاعفًا، البعض يهابه، والآخر لا يشعر بأهمية المواجهة من أجله. فطالما أن المرأة مقصاة عن محور السلطة، فإن كتابتها لا تشد الانتباه. هذا الموقف ينطبق على بعض النساء اللواتي، يهملن الكتابة عن المرأة؛ لأن النمط الذكورى السائد، يستبعدها ويهمشها، بالتالي، تنحو الكاتبة نحو ما يلفت النظر إلى كتابتها؛ كي تنتزع اعترافًا بها (۲۰)، إضافة إلى أن المبدأ الذكوري عندها، يتحول إلى مبدأ كونى نمطى مهيمن. يجب أن لا يغيب عن بالنا، أن دخولها المعرفة والكتابة تحديدًا، هو دخول إلى المحظور (21). فهى تسعى إلى الاعتراف بها؛ كى تفرض نفسها. من أجل ذلك، كانت فكرة الاعتراف، مربوطة – دائمًا – في النضال من أجل السلطة (۲۲).
يمكننا أن نضيف – أيضًا – أن المجتمع يتكون من عدة أنظمة صغرى: مثل نظام الأسرة، السياسة، العلم… إنها أنظمة تتوفر على شفرات أو دلائل للتواصل، فكل نظام منها، يقوم على لغة تواصلية خاصة به. ومن جهة أخرى، تشتمل هذه الأنظمة على تعبيرات، فترمز المرأة مثلاً لنظام الأسرة، وفي النهاية، يتم التفاعل المتبادل بين هذه الوسائط التواصلية، ورموزها. يمكننا ذلك، من فهم الأسباب التي حملت على وضع كتابة المرأة، خارج النظام الاجتماعي القائم، بشكل عام، أى خارج فضاء المعرفة؛ على أساس أن الرجل يمثل المعرفة، وهي الأسرة.
على العكس مما يجرى الآن؛ حيث إن المرأة تتعلم وتعمل وتبحث وتكتب، حيث تغير إحساسها بذاتها، الذي أصبح قويًا، كأقصى ما تكون الحدة والقوة. لكن على الرغم من هذا التحول، بقيت نظرة الناس إلي كتابة المرأة، كما كانت عليه في السابق تقريبًا؛ بحيث لم ترق إلى المستوى الذي يغدو معه مكان المرأة، في صلب النظام المعرفي.
لو عمدنا إلى دراسة المعانى التي يعطيها الناس للنظام الاجتماعي، المكون من رموز ودلائل، لاستنتجنا أن هذا النظام الاجتماعي، هو من يحدد المعنى الذي يعطيه الناس لما يحيونه ويعيشونه، وليس العكس. فلو ركزنا على جوانب حضور المجتمع، أي جوانب الإقصاء والتهميش التي تعكسها أقوال الناس، لوجدنا أن المرأة موجودة، في المجال الخاص وهو في المجال العام.
إذن.. للموروث الثقافي، دور في إقصاء المرأة، عن ميدان المعرفة عامة، والكتابة خاصة؛ فهو يقصى المرأة كذات، ويصبغ عليها جملة مواصفات فعلية. لذلك بقيت معارفها معلقة، على هامش الثقافة. لنذكر في هذا الصدد، أن هناك العديد من المقولات التي تنفي الوجود الأنثوى، على الصعيد المعرفي واللغوى، مثل مقولة ابن جني، الذي يعتبر أن التذكير هو الأصل، فكان ربما كتاب نوال السعداوى: الأنثى هي الأصل رداً عليه.
سؤالي الآن، لماذا معظم الكتابات عن إبداع المرأة وإنجازاتها، والتراجم التي اهتمت بسيرتها، تركز – فقط – على الأدب، بينما نلاحظ في الكتابات القديمة، تراجم لنساء من اهتمامات واختصاصات متعددة؟. هل هذا المنحى يبرره منطق خاف، مفاده أن المرأة في المجال المعرفي، تتفوق في المعرفة المبنية على العاطفة الرقيقة الصادقة (۲۳)، أي المعرفة الفنية من شعر غنائى ودراما ورقص (٢٤). وإذا كان الأمر كذلك، كيف نفسر وجود سلطانات حكمن في الماضي وفقيهات؟. واليوم تشارك المرأة في القطاعات الإنتاجية المختلفة (نائبات، وزيرات، قاضيات، باحثات، سيدات أعمال…). لكن يبدو أن البنية الثقافية للنظام الاجتماعي، مازالت قاصرة عن اللحاق بتغير وضع المرأة، ومازالت تأسر المرأة، ضمن صور جامدة لا تساير العصر، وأحيانًا نشك حتى في وجودها. كأن الواقع يمشى باتجاه مغاير، والكتابة أقرب إلى المحافظة، منها إلى التجديد.
لذلك أجد – من الضروري – تجاوز المجتمع، والسعى ما أمكن، إلى الحد من أثره فينا، وفق ما يقتضيه رأينا. وهذا أمر نتنبه له، لو درسنا علاقة الطليعة الفنية بالمجتمع، سنكتشف أنها تنزع نحو تجاوز المجتمع وإقصائه، عن طريق النص، أو اللوحة. وأعتقد أن هذه الطليعة التي تقاوم أثر المجتمع فينا، هي – أيضًا – من رحم حياة المجتمع ذاته.
أعتقد أن سؤالى الأولى، حول العتمات في ذاكرتي، وذاكرة جيلى، يرمى ليس إلى تأنيث الذاكرة، كما درج القول، بل أن نمارس وجودنا – الأنثوى طبعًا وأعتقد أن مقولة تأنيث الذاكرة، كأنها رد على المقولة التي ننتقدها تذكير الذاكرة. لا أود ممارسة رد فعل، بل أود أن أكون موجودة كامرأة، كذات، مثلما غيرى موجود. وكتابتي هي دخولى إلى حيز الذاكرة؛ إذ إنها تدخل معها كل المحذوف والمكبوت. وتأسيس ذاكرتى على هذا الوجود، سيجعل منها خزانًا للمستقبل، أي لوجود أنثوى مؤكد.
أجد في هذه الفترة، أن الذاكرة سؤال نوعى بالنسبة لى، ولربما لو أن ذاكرتي كانت مشحونة بوجود نسائى فاعل، لتأثرت عندها بها، فمضيت قدمًا بخطى أسرع، ولم أعش في بلبلة الماضى الذى يشوش حضوری، ويعمل على تهميشه. لكنى واعترف، أن ذاكرتي قبل مجهودي الفردي، في معرفة تراثنا الفكرى، ومكانة المرأة فيه، مزدحمة بوجوه نسائية غريبة أثرت في، طبعًا في مرحلة الدراسة، مثل سيمون دو بوفوار، وأنييس نين، وفرجينيا وولف، والأخوات برونتي، مدام دو ستایل، مدام دو سفينيه.. أو النساء العالمات لموليير، مرغريت دوراس، إيلين سيكسو، مارى كردينال… ولم أتأثر بكوليت خوري، أو غادة السمان، ليلى بعلبكي… لأني قرأتهن في مرحلة أخرى، متأخرة نسبيًا، هى مرحلة البحث. لقد أيقظت ذاكرتي، فقرأت فيها حجابًا وراءه حجاب، وتعلمت وأنا أمزقها – قدر الإمكان – أن الذاكرة لا تسلى، بل تكشف وتنبه، وتضيء الحيز الضيق في فضاء الكتابة للوجود الأنثوي، وحتى على أرض الواقع؛ مما يساهم في عبورنا إلى لب الذاكرة الصامتة، بل السالبة الوجود الحي والمتنوع للمرأة.
لكن من جهة أخرى، أجد أنه لا يمكننا تخيل مخطط، لتغيير الذاكرة من باب تأنيثها، فهذا مثال لما ينبغى أن تكون عليه الأمور. كأن هذا المنطق يقول لنا، إنه لا يمكننا النهوض، إلا باستدراك ما فات. يتطلب هذا الهدف مجابهة هذه المراحل السابقة واجتيازها. تبعًا لهذا المنظور، يتم التغيير وفقًا لتدرج المجتمع صعودًا نحو الأفضل، وفقًا لسيناريو تتقدم بموجبه المرأة إلى الأمام، مجتازة المراحل بخطى راسخة؛ وصولاً إلى الهدف الأخير. غير أن تجارب المجتمعات الغربية، التي نعتبرها متقدمة علينا، فيما يخص حقوق المرأة، ووجودها الفاعل في المجتمع، تقدم لنا نموذجًا يكشف الوهم الكبير الذي يصدر عن هذا الاعتقاد. إذ هي تقدمت وتراجعت في الوقت ذاته، كانت لها إنجازاتها، على صعيد الحقوق المدنية والسياسية، بقدر ما كانت لها انتكاساتها (مجتمع له ممارساته المعتمة كرفضه الضعيف، وعدم وصول المرأة فيه، إلى المشاركة السياسية الكاملة، أو إلى أعلى المناصب في الدولة) (٢٥). ذلك يكشف وهم الصيرورة التاريخية المتقدمة، نحو الأمام. إنها تدل على تمسكنا بمفهوم التغيير، بشكل سحرى، فهناك – دائمًا – ثم تراجع وتقدم.
إذن… لا يمكننا الآن تجاوز كل تلك المراحل. فبين اللحاق بالماضي العربي والغربي الذي هو – الآن – مصدر المعرفة – سيغيب عنا تحقيق وجودنا الفاعل في الحاضر. فبينما نلحق بالهدف – الموجود في الماضى – تتغير في هذا الوقت، أشياء كثيرة. أظن أنه لا يمكننا إلا تعديل أهدافنا، لأن الأشياء تتغير بفعل اشتغالنا على ذاتنا وعليها، بحيث إننا نتغير بتغير علاقتنا بذاتنا، بأهدافها، وبأدواتها. لذلك إن الذين يفكرون في التغيير، بعقلية التدرج نحو الأهداف، لن يصلوا إليها، خاصة أننا موجودون في حقل التقدم العلمي، وإن كنا غير منجزين له، ففي الفضاء الألكتروني، تنتقل المعلومة بسرعة الضوء. إذن لا بد في هذه المرحلة، من تغيير نظام العلاقات، وأنماط التفكير. أعتقد إذا كان الهدف تغيير وضع المرأة، فإن ذلك لا يتعلق بشكل طوطمى، بالعودة إلى كتابة مراحل التاريخ، من منظور أنثوى – ليس علينا المرور بها كلها؛ كي نحسن صورتنا وفاعليتنا – المسألة هى أن هناك واقعًا قائمًا، لا مجال للقفز فوقه. والأحرى بنا، أن نتعاطى مع الحاضر، بتحولاته الجارية، حتى لا يفوتنا، ونحن نتقدم نحوه ببطء. لا أود العودة إلى الوراء، تحت وطأة الوجود المسلوب.
طبعًا إنها ملاحظات، أسردها لأناقض نفسى، ولا أدعها تقع في سحر الوجود النسائي، الفاعل في الماضي. ملاحظات توقظ أسئلتى الراهنة؛ كى أهتم بوجودى الحاضر، فلا أدع الماضي يغويني كثيرًا، إلى درجة استبعاد حضور ذاتي.
لذلك أجد من الضرورة، أن نتحرر من خطابنا، وأن نطرح الأسئلة الصامتة التي تعاني فينا. إني لا أرغب في استبدال حقيقة بأخرى؛ لأنه ليس هناك من حقيقة ثابتة. كما لا أود أن أقع في وهم معرفة الذاكرة. لأنها ملتبسة ومعقدة وأغنى من إمكان سردها، بل أود أن يكون وجودى، انكشافًا للحاضر في حضوره.
ليس إن تبوأت سلطة ما، أغير حياتي. فلو قيض للمرأة، أن تكتب التاريخ في الماضي، فهل بالضرورة ستكون مختلفة عن الرجل الذى أقصاها، أم أن لبنية السلطة، صفات وآليات مشتركة، تكون وتشكل كل من يمارسها؟. كيف نفسر أن بعض النساء حين تتسنى لهن، فرص القيام بمهام السلطة، لا يدخلن نهجًا مختلفًا، أو علاقات مختلفة، بل هن – في أحيان كثيرة – أكثر تسلطًا وإقصاء للآخر – خاصة للمرأة؟!. مما يدفعنا إلى القول، إنه ليس كل ما في العادات ضاغطًا، وليس كل ما في التجديد تحرير (٢٦).
في النهاية، التحدى الذي نواجهه كنساء، هو إقامة علاقة جديدة بذاتنا وبالآخرين، من خلال ما يجمعنا بذاتنا وبالآخرين في الحياة اليومية، علاقة تحمل على تغيير ممارستنا اليومية، الاجتماعية، الثقافية، والسياسية. إنها علاقة نقدية، تدفع باتجاه إنتاج الذاتية، أى العمل على تنمية إمكاناتها؛ كي تكشف المحتجب، وتهتك الممتنع. لذلك لم أتكلم عن القهر ونقيضه التحرر، فكل شيء يجب إنتاجه. فلنسع في هذا الاتجاه بإلحاح؛ فنشارك في كل المجالات الممكنة، مساهمات إبداعيًا في العصر الذي نعيش؛ من أجل الارتقاء بحياتنا.
خاتمة
أقول كان هدفي من رواية “المكبوت في المكتوب“، فهم كيفيات التعامل مع الذاكرة؛ وذلك من خلال قراءاتي لبعض النصوص القديمة والتراجم الحديثة، فكان أن طبقت الموضوع على ذاكرتي؛ بحيث كنت أعبر عن تجربة حية، وعن تماس مباشر مع التاريخ، الذي أقصى المرأة، وحاضري الكتابي كامرأة، اللذين جعلان أطرح رأيًا وأنقده، أبرز موقفًا، ثم أكشف نقيضه؛ لأتبين هل قراءة التاريخ، من وجهة نظر المرأة، أمر ممكن؟. هل هو زعم مسوغ، أم أنه حمال أوجه؟. فلربما في ابتعادي عن القول المطلق، أتحرر من أوهامي المعرفية؛ بذلك تصير قراءتي أكثر قربًا. من خلق بيئة فكرية جديدة؛ تساهم في حضور فاعل للأنوثة في الكتابة، التي تبتعد عن الحضور الفحل، فتترك مجالاً للمختلف وللآخر!.
* نهى بيومي: أستاذة اﻷدب الفرنسي، كلية اﻵداب، الجامعة اللبنانية
** في سفر الخلق أو التكوين، نجد صورة معاكسة لحواء التي تحمل وزر الخطيئة الأولى “فمن المرأة ابتدأت الخطيئة وبسببها نموت جميعًا“.
1 – انظر: شوقي عبد الحكيم، موسوعة الفلكلور والأساطير العربية، دار العودة، بيروت ۱۹۸۲، ص ٥٨.
2 – عبد الفتاح كيليطو لسان آدم، ترجمة عبد الكبير الشرقاوي، دار توبقال للنشر ۱۹۹٥، المغرب، ص 35.
3 – انظر كتب الأغانى وكذلك كتب حسنى عبد الجليل يوسف، البديع في شعر الخنساء بين الاتباع والابتداع، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة ۱۹۹۳، الذى يقول: أما الصورة العامة التي قدمتها الخنساء للإنسان، فهى صورة الرجل الكامل الذى يستحق الوجود والحياة، وهو المحبوب الذي عاش في مخيلة الخنساء ولم تتغزل فيه لموانع اجتماعية. فكانت المراثى إطارها الذى قدمت من خلالها تصورها للفارس المحبوب ص 4.
4 – عبد الرحمن بدوي، رابعة العدوية: شهيدة العشق الإلهى، دار القلم، بيروت ۱۹۷۸.
5 – هناك الكثير من الشواهد التي تدل على موقع رابعة المعرفي، تذكر على سبيل المثال كتاب سعاد على عبد الرازق، رابعة العدوية بين الغناء والبكاء، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة ۱۹۸۲، التي تؤكد في مقدمته، أن اسمها ارتبط بالنظرية الروحانية. ونظرية الحب الآلهى، ونظرية الخلة، ونظرية الحج بالهمة.
6 – على حرب، الممنوع الممتنع، المركز الثقافي العربي، بیروت 1995، ص ١٦١.
7 – انظر: نهى بيومى، وراء الحقيقة مران الذات. جريدة الأيام، البحرين، ١٩٩٤.
8 – في هذا المجال، يتصدى عبد المنعم الحفني، في كتابه رابعة العدوية إمامة العاشقين. والمحزونين، دار الرشاد، القاهرة الطبعة الثانية ۱۹۹٦، لأطروحة عبد الرحمن بدوى فيدحضها قائلاً: “لم يعرف عن بائعات الهوى، أن من الممكن أن يتبن ويبلغن في توبتهن حد التصوف وهذه الدرجة الرفيعة فيه، حتى لتكون الواحدة صاحبة مدرسة فكرية! ص ١٢.
9 – ندوة أجراها د. محى الدين صبحي في مجلة الشاهد، عدد تشرين الأول ١٩٩٦، بيروت.
10 – أدونيس، ديوان الشعر العربي، دار الفكر، بيروت الطبعة الثانية ١٩٨٦.
۱۱ – عبد الله محمد الغذامى، المرأة والمتعة، المركز الثقافي العربي، بيروت ١٩٩٦، ص ٩٥.
١٢ – كمال أبو ديب، “من أجل الحرية“، ملحق النهار، عدد ٢٦٥، السبت ٥ نيسان ۱۹۹۷.
۱۳ – عبد الهادي التازي، المرأة في تاريخ العرب الاسلامى، نشر الفنك، الدار البيضاء ١٩٩٢، ص ١٤.
١٤ – إميلي نصر الله، نساء رائدات، الجزء الأول، مؤسسة نوفل، بيروت ١٩٨٦.
١٥ – ليلى محمد الصالح، أدب المرأة في الجزيرة والخليج العربي، ۱۹۸۳، دون ذكر لدار النشر.
١٦ – د. جوزيف زيدان، مصادر الأدب النسائى في العالم العربي الحديث، كتاب النادي الأدبي الثقافي، السعودية ١٩٨٦.
۱۷ – محمد نور الدين فاية، الهوية والاختلاف – أفريقيا الشرق، الدار البيضاء ۱۹۸۸
– عبد الله محمد الغذامى، المرأة واللغة، المصدر السابق.
۱۸ – عبد السلام بن عبد العالى، أسس الفكر الفلسفي المعاصر، دار توبقال الدار البيضاء، ۱۹۹۱، ص ١٣٥.
١٩ – سمية رمضان، رسائل الجسد عند نورا أمين وعفاف السيد“، مجلة إبداع، العددان العاشر والحادي عشر أكتوبر – نوفمبر، ١٩٩٦.
۲۰ – انظر المرأة الفلسطينية، سحر خليفة، في ۸ آذار (مارس)، يوم المرأة العالمي، في الجامعة اللبنانية الأمريكية، أشارت إحدى الطالبات، إلى صعوية تخصصها في قضية المرأة؛ ذلك أن هذا التخصص يعتبر ضيقًا، وفرص العمل فيه قليلة جدًا. مما يدلنا على مدى حيز الكتابة والبحث عن المرأة.
۲۱ – انظر كتاب عبد الله الغذامى، المرأة واللغة، المركز الثقافي العربي، بيروت ١٩٩٦، ص ٩.
۲۲ – تزيفتان تودوروف، الحياة المشتركة، سوى، باريس، 1995، ص 35.
٢٣ – يقول علامة الجزيرة، الشيخ أحمد الجاسر، عن المرأة السعودية: “المرأة عندنا تمسك بالقلم، تجيد بطبيعتها اللطف والرقة والنعومة. تتمتع بصفاء الذهن… ولهذا كثيرًا ما يأتي أدبها أوقع في النفس. النفس تميل وتطمئن إلى ما تبديه الفتاة من آراء؛ لأنها تحاول الدخول عن طريق العاطفة، إضافة إلى إيجادها الوسائل التي يستوعبها العقل بسهولة. ما أسعد شعبًا تؤرخه امرأة“. انظر كتاب ليلى صالح، ص ۳۰.
٢٤ – انظر “الثقافة النسائية“، الفيلسوف زيمل، المذكور في “مقاربات الحداثة وما بعد الحداثة“، حوارات منتقاة من الفكر الألمانى المعاصر، لـ محمد الشيخ وياسر الطائري، دار الطليعة، بيروت، ١٩٩٦، ص ١٧٦.
٢٥ – انظر – مثلاً – إلى كتاب فرانسواز اريتيه مذكر – مؤنث، أوديل جاكوب، باريس، ١٩٩٦.
٢٦ – باسكال بروكنر، غواية البراءة، غراسيه، باريس 1995، ص۱۷۰.