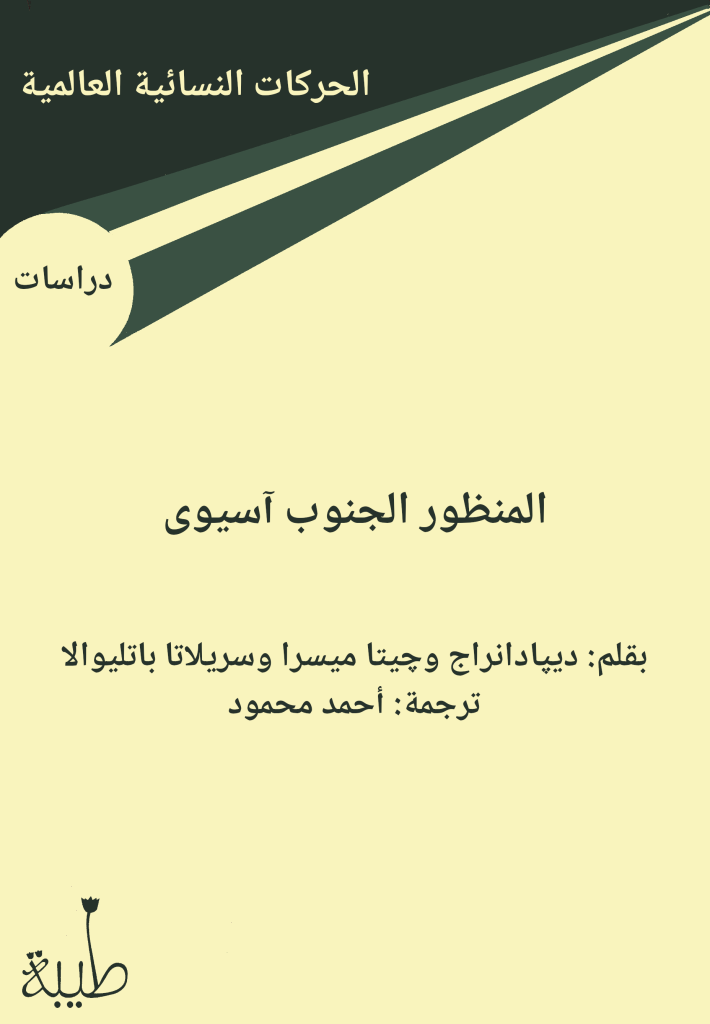المنظور الجنوب آسيوي(*)
نظرة شاملة
تسببت قوى عديدة تآكل ما حققته النساء من مكاسب على مدى العقود الثلاثة الماضية على نحو خطير. وأهم تلك القوى الفقر المتزايد نتيجة للاندماج الاقتصادي الكوني المتسارع «العولمة»، وتزايد الصراعات والقدر الأكبر من العسكرة، وظهور العديد من الحركات الأصولية المختلفة التي تعيد باتحادها مع عوامل أخرى خلق وتأكيد العلاقات الاجتماعية الإقطاعية والأبوية ومعايير الذكورة والأنوثة الجديدة. وليست هذه بالقوى المتوازية، بل المترابطة والمتداخلة التي تنتقص من مكانة المرأة الاجتماعية ووضعها المادي، خاصة في العالم الثالث، حيث أدت القيود إلى تعزيز الأبوية التقليدية أو غيرت شكلها، مما أدى إلى خلق أشكال جديدة من العنف الهيكلي أو المنظم ضد النساء، وحدوث ردة في المكاسب التي حققتها الحركات النسائية على امتداد العقود الماضية. وليست هذه تحديات جديدة، إلا أنها اتخذت أبعادًا وتعقيدات جديدة وقدرًا أكبر من الإلحاح في السيناريو الجيوبوليتيكي الراهن. ولذلك فقد حان الوقت كي تعيد الحركات النسائية التفكير في دورها وإسهامها في تغيير شكل مكافحة الفقر والعسكرة ونمو النزعة الأصولية.
لا يمكن للحركات النسائية أن تنجح في السيناريو الحالي ما لم تتولى هي قيادة الحركات في أنحاء العولمة الاقتصادية والتنمية المستدامة والصراع والسلام والأصولية وتغير طابعها الأساسي. وسوف يتعين علينا على نحو خاص خلق حركة كونية للعدالة الاقتصادية والسلام وحقوق الإنسان تقودها نساء محليات لتعبئة المهمشين على المستويات كافة على امتداد هذه الأجندة. وسوف يؤدي هذا إلى توسيع الفضاء السياسي للمرأة الفقيرة المحدود حتى الآن، ويمكن من إطلاق قدرتهن على تغيير نفس الأجندات التي تؤثر على كل بعد من أبعاد حياتهن.
يعني هذا أنه سوف يكون على الحركات النسائية على المستويات الكونية والقومية والمحلية ما يلي:
-
بدء عمليات الاستبطان والتحليل النقدي للاستراتيجيات السابقة والموقف والقيادة الحاليين.
-
بناء وقيادة الحركات ذات الأسس الجماهيرية المناهضة للفقر والداعية إلى المساواة والاستدامة، والمناهضة للعسكرة والداعية إلى السلام، والمناهضة للأصولية بأشكالها كافة والداعية إلى التعددية والتسامح والاحتواء وتحقيق كامل حقوق الإنسان للناس كافة.
-
لكي يتحقق ذلك، لابد لنا من تأييد وتعبئة النساء المحليات (أي النساء الفقيرات الحضريات والريفيات المحليات وغيرهن من النساء) بأعداد كبيرة وإعادة نشر أساليب زيادة الوعي الأساسي وبناء الوعي. ويمكن للحركات النسائية ذات الأسس الجماهيرية هذه مكافحة قوى الظلم الاقتصادي والعسكرة والقمع الاجتماعي وأشكال الشوفينية الإقليمية والدينية والطائفية والعرقية والجنسية وغيرها.
لا شك في أن الأثر العالمي للحركة النسائية وسعيها لتحقيق المساواة والعدل النوعيين إحدى علامات القرن العشرين البارزة. وبدءاً بالكفاح من أجل حق النساء في الاقتراع في عقوده الأولى، ومن خلال مشاركة النساء في حركات التحرير لإنهاء الحكم الاستعماري وقيادتهن لتلك الحركات، ولد كفاح النساء من أجل المساواة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية أثرا كافيا لجعل مفهوم المساواة النوعية مع حلول عملي. ومع نهاية القرن أمرا مقبولا من دول العالم من حيث المبدأ، وإن لم يكن على نحو انعقاد المؤتمر العالمي الرابع للمرأة في بكين عام 1995 كان هناك الكثير مما يمكن أن تحتفي به الناشطات والمدافعات عن قضايا النساء والباحثات اللائي كشفن اللثام عن الطابع المتواصل والمنظم لإخضاع النساء واستعبادهن. إلا أنه يبدو منذ ذلك الحين أن جزءا لا بأس به من المكتسبات قد ضاع؛ إذ يصعب في كثير من السياقات مجرد القول باقتناع إن هناك حركة نسائية على المستوى الكوني، وإن كان عدد من الحركات القومية والمحلية – التي تتمتع بقدرة كبيرة على التعبئة والتدخل– لا يزال منتشراً.
نحن نرى أن هناك قوى عديدة أدت إلى تأكل المكاسب التي حققتها الحركات النسائية على مدار العقود الثلاثة الماضية. وكانت أهم تلك القوى في السياق الجنوب آسيوي: زيادة الفقر نتيجة للاندماج الاقتصادي الكوني المتسارع (العولمة)، اتساع مجال الحرب والنزعة العسكرية، وظهور العديد من الحركات الأصولية التي تعيد، بمشاركة عوامل أخرى، خلق وتأكيد العلاقات الاجتماعية الإقطاعية والأبوية التقليدية. وهذا أمر شديد الوضوح في السياق الجنوب آسيوي بطريقة يعيد بها الأصوليون تأكيد أفكار الذكورة والأنوثة، وكذلك العفة والحياء، وهو أوضح ما يكون في الطريقة التي يجري بها بناء الهويات العرقية والدينية بشكل محوري حول أدوار النساء بغرض حماية سلطة الرجال ومزاياهم، وبخاصة سلطة الطبقات والطوائف المهيمنة ومزاياها.
وهكذا فإن التحديات المستقبلية المهمة التي تواجه حركات النساء العالمية هي الفقر والصراع والعسكرة، وظهور النزعات الأصولية من مختلف الأنواع. وليست هذه قوى متوازية بل قوى مترابطة ومتداخلة أسهمت في تآكل وضع المرأة ومكانتها، وخاصة في العالم الثالث، حيث عززت القيود الأبوية التقليدية أو غيرت شكلها، وأضعفت أمن المرأة وقدرتها على البقاء. وليست هذه بالتحديات الجديدة، غير أنها اتخذت أبعاداً وتعقيدات جديدة، وقدرا أكبر من الإلحاح في السيناريو الجيوبوليتيكي الراهن.
وبينما تؤثر هذه القوى على النساء كافة، ترى ناشطات الحركة النسوية والباحثات الجنوبيات أن النساء لم يكن في يوم من الأيام فئة أو طبقة أو جماعة اجتماعية منفردة. فقد كان التمييز النوعي في مجتمعاتنا يعمل باستمرار من خلال أشكال أخرى من الإقصاء والقمع، هي النزعة الاستعمارية والطائفة والطبقة والجنس race والإقليم والدين والعرق والتوجه الجنسي والعمر والحالة الاجتماعية والنقاط في دورة الحياة وهلم جرا. وبالنسبة للنساء في الجنوب، تعمل العلاقات النوعية من خلال البني الاجتماعية والمؤسسية الأخرى، حيث تحدد وضعهن ليس بالمقارنة بالرجال والنساء من جماعتهن الاجتماعية فحسب، بل كذلك الرجال والنساء من الجماعات الأخرى. وهكذا فإنك نادرًا ما ستسمعنا نتحدث عن «النساء» في حد ذاتهن، بل عن «النساء الريفيات الفقيرات» أو «العاملات الداليت» أو «نساء التاميل من الطبقة الوسطى الدنيا». ويشكل هذا الفهم الأساسي مفهومنا الخاص بالنوع والكفاح من أجل التحرر.
لذلك فإننا في هذه الورقة نوجه أنفسنا إلى التحديات التي تواجهها النساء الفقيرات والعاملات، ونبني تحليلنا على تجارب النساء الفقيرات في جنوب آسيا.
والأساس المنطقي الذي نعتمد عليه بسيط، وهو أن هؤلاء النساء من اللائي يجب عليهن التغلب على حياتهن، على الأعباء والآثار الضخمة للعولمة والأصولية والصراع. ففي قرى جنوب آسيا وأحيائه العشوائية نجد أن نساء الداليت أو القبائل أو الأقليات الدينية من اللائي يحملن العبء الأكبر في إصلاحات التعديل الهيكلي، ورفع الحواجز التجارية وقوانين الملكية الفكرية الجديدة، والأصولية الدينية والتفرقة الطائفية، والعنف المحلي والهيكلي (بما في ذلك العنف الجنسي)، وعسكرة أحيائهن، وقمع الدولة (كأن يكون ذلك من خلال الجيش أو السلطة أو حتى موظفي إدارة الغابات)، وقمع المؤسسات التجارية الخاصة (مثل ميليشيات أصحاب الأراضي وأصحاب المساكن في العشوائيات). وبالرغم من هذه الأعباء غير المتناسبة التي تتحملها النساء الفقيرات، فقد قيدت قدرتهن السياسية بسبب ما استُشعر من التهديد الذي يمثلنه للوضع القائم، أو اغتصبهن واحتواهن المتطرفون الدينيون والحركات المطالبة بالاستقلال السياسي أو الحق في إقامة دولة.
في هذه مهمة على قدر كبير من الإلحاح في ظل السياق السياسي الحالي، وبالتأكيد شبه القارة الهندية. وتقوم المنظمات الدينية الأصولية اليمينية – مثل جناح المرأة في جمعية «راشتريا سوايا مسيفاك سانج» (جمعية المتطوعين الوطنيين) RSS، والجماعة الإسلامية، وكشميري دوختريني ملت، وغيرها– بتجنيد للنساء اللائي كن خارج قاعدتها السياسية التقليدية على نحو متسارع. ووفرت التشكيلات السياسية وتشكيلات المجتمع المدني الأخرى قدرا قليلاً من المساحة أو القوة للنساء. فعلى سبيل المثال أضعفت النقابات المهنية المنظمة بشكل كبير، وحتى حين كانت أقوى مما عليه هي الآن، لم تكن المرأة في وضع يمكنها من اتخاذ القرارات ولم تكن قضاياها ضمن أجندة النقابات. وفي القطاع غير المنتسب للنقابات العمالية، نجد أن اتحادات العمال كذلك يسيطر عليه الذكور، ومطالبها لا تراعي النوع، وأدوار النساء فيها غير مهمة أو لا وجود لها. وتكافح الأحزاب السياسية انكماش عضويتها، وهي تتضاءل باعتبارها مواقع للمشاركة. وفي المجالس المحلية الهندية، حيث مشاركة المرأة مضمونة من الناحية القانونية من خلال نظام الحصص، لا تلقى المرأة تشجيعًا على تطوير دوائرها أو أجنداتها السياسية؛ بل على العكس من ذلك يجري تشجيع المرأة – أو في الغالب إجبارها– على الاعتماد على سلسلة من الرعاة، من قبيل مُلاك أرضها أو كبار زعماء الطائفة أو حتى المنظمات غير الحكومية. وبينما وفرت الحركات النسائية مساحات متعاقبة في كثير من المواقع، فلم يكن لديها في يوم من الأيام الموارد البشرية أو المادية الكافية لتغطية الخريطة، ولم تتمكن من منع تجنيد القوى الرجعية للنساء.
في ظل هذه الظروف السياسية والإفقار الشديد، سوف يتعين على النساء الفقيرات التعبئة سياسيًا بأعداد كبيرة ومنظورة، ودخول المجال السياسي من خلال كل ما يمكن من منتديات وجمعيات. فالطاقة الجماعية لمثل هذا النوع من التعبئة هي وحدها التي سوف تطلق قدرتهن التحويلية وتجبر حتى الأكثر تشاؤمًا من بين البُنى السياسية المحلية والكونية على إدراك وجودهن والاستجابة لهن.
في الوقت الذي وفر فيه الاندماج الاقتصادي الكوني فرصًا جديدة لبعض النساء الفقيرات، فهو بصورة عامة يزيد ملايين الفقراء فقرًا ويخلق جيوبًا جديدة من الفقر. إذ لا تزال غالبية نساء العالم يعشن إما في فقر مدقع أو عدم أمان اقتصادي دائم. وفي منطقة مثل جنوب آسيا، نجد أن الهموم السائدة للنساء الفقيرات (والرجال الفقراء) هي: الحصول على عمل على مدار العام وعلى الدخل المناسب الذي يضمن وجبتين متوازنتين على الأقل يوميًا، وما يقدرن على تحمل تكلفته من الرعاية الصحية والتعليم لأطفالهن، والمسكن اللائق وأسباب الراحة الأساسية، وحيازة آمنة للأرض الزراعية. ويعد عمل المرأة ودخلها في الأسر الأكثر فقراً أمرًا مهمًا للحفاظ على حياة أسرهن وسعادة أطفالهن ورفاهيتهن. وقد أدى الفقر والانحطاط البيئي والتقسيم النوعي للعمل داخل الأسرة، والوصول المنحرف إلى موارد الملكية العامة أو عدم وجوده إلى تفاقم الأعباء الواقعة على النساء فيما يخص جمع الوقود وغذاء الماشية وإحضار الماء. كما يؤثر الفقر على صحة النساء وعلى الفرص التعليمية بالطرق المباشرة وغير المباشرة؛ فالرحلات الطويلة للحصول على الحاجات الأساسية تستنزف مخزون النساء الغذائي المنخفض أصلاً وتزيد تكاليف الفرصة البديلة الخاصة بالتعليم والرعاية الصحية والمشاركة في حياة المجتمع. ويعني الغذاء والماء غير الكافيين والثقافات التي تفرض المعاناة الصامتة أن تصاب النساء بمجموعة من الأمراض المزمنة مثل السل والأنيميا والتهابات المهبل التي لا تُعالَج.
وفي مناطق كمناطقنا، حيث يعيش أغلب الفقراء في المناطق الريفية، تعمل غالبية الريفيات الفقيرات في الزراعة والري وعلف المواشي والنشاط الحرفي. ورغم إسهام النساء الحيوي في المجال الزراعي، فإن حصولهن على الأرض الزراعية باعتبارهن مستأجرات أو مزارعات بالمشاركة محدود. ومسألة إعطاء حقوق الأرض للنساء قضية مثارة باستمرار في بلاد كالهند؛ فبالرغم من حصول المرأة الهندية على حقوق متساوية في إرث أرض والديها المكتسبة ذاتيا، فالواقع هو أن الذكور من أفراد الأسرة يغتصبون هذا الحق. وفي حالة الأرض المملوكة لعائلة هندوسية مشتركة، ليس هناك اعتراف قانوني بحقوق النساء في أن ترثن نصيبا من الأرض. وقد تمتلك الأسر التي ترأسها النساء– وهي في ازدياد بسبب هجر رب الأسرة والجمع بين زوجتين والترمل– الأرض، ولكن في أغلب الأحوال سوف يسيطر الأقارب الذكور على الأرض. وترتبط حقوق الماء بحقوق الأرض، وبذلك يكون وصول النساء إلى الماء غير مناسب وهش.
يتفاقم الفقر الحضري أكثر وأكثر عند «اغتصاب» النخبة الريفية والحضرية لموارد الملكية المشتركة؛ وغالبا ما يكون ذلك بواسطة الهيئات الحكومية التي تعمل نيابة عنها. فعلى سبيل المثال نجد أن أراضي المراعي المحيطة بالمناطق الحضرية يجرى «تملكها» لبناء مشروعات إسكان للطبقة الوسطى. وبذلك تفقد النساء اللائي ينتمين إلى أسر المزارعين التي لا تملك أرضا أو الهامشية المنافع القليلة التي يمنحها الوصول المجاني إلى الوقود والعلف ومناطق الرعي في الاقتصاد الزراعي الخاص بمورد الرزق التقليدي. يضاف إلى ذلك النزوح الذي تسببه النزاعات المدنية والسياسية، والسدود والتعدين، وتطويق الغابات، فتكون النتيجة الهجرة على نطاق واسع إلى المدن التي تزيد من حجم مشاكل الفقر الحضري. وللهجرة والترحيل آثار أشد سوءًا على النساء الفقيرات من ناحية الأمن الاقتصادي والاجتماعي والشخصي والقدرة على البقاء. والقضاء على سبل العيش التقليدية و«فتح» قطاعات كاملة للإنتاج أمام الشركات المتعدية للقوميات نتيجة لبرامج « التحديث» التي تقودها العولمة أمر شديد الدمار بالنسبة للنساء.
وهذه بعض النماذج المدنية لكيفية تأثير الإصلاحات الاقتصادية على النساء الفقيرات في الهند:
-
في بلدة سيرسيلا الصغيرة بولاية أندرا براديش في جنوب الهند، كان هناك المئات من حالات انتحار نساجي الأنوال اليدوية. فقد وقع هؤلاء الصناع في فخ الديون بعد «تحديث» أنوالهم اليدوية التقليدية إلى تكنولوجيا الأنوال الآلية والإنتاج المتزايد كجزء من برنامج التحديث الذي تدعمه الولاية، ولم يستطيعوا تسويق إنتاجهم المتزايد، في الوقت الذي رفعت فيه الولاية أسعار الطاقة بناء على إصرار البنك الدولي. ولم يتمكن النساجون من دفع فواتير الكهرباء أو تسديد أقساط القرض. والمفارقة القاسية هي أنه لا يمكنهم بحال من الأحوال مسايرة التغيرات. وبعد أن أصيب المئات من النساجين بالاكتئاب أقدموا على الانتحار. وبالطبع اضطرت زوجاتهم بعد ذلك إلى الحفاظ على تماسك الأسرة بينما يطاردهن الدائنون. وفي بعض الحالات انتحرت أسر بكاملها معًا.
-
تشهد البلاد كذلك هجرة واسعة النطاق للشابات والفتيات من الاقتصادات الريفية المعرضة للجفاف أو التي دمرت لأسباب أخرى إلى المدن الكبرى للعمل في تجارة الجنس. وهذه الهجرة تحدث الآن خارج نطاق ما كان يفهم حتى ذلك الحين على أنه متاجرة في النساء؛ فلا يُدفع مال لعائلاتهن، وليست هناك سلاسل استغلال النساء في الدعارة بالمعنى المعتاد. فهؤلاء الشابات يستخدمن أقاربهن أو معارفهن في المدينة للهجرة من أجل العمل في تجارة الجنس. وحتى داخل المدن، تشكل بنات عمال المصانع الذين استغني عنهم في الصناعات المحتضرة، كصناعة النسيج، القاعدة الجديدة من العضوات الجديدات في أعمال الجنس. وفكرة «جلب» النساء إلى تلك المهنة في سبيلها بالفعل إلى التغير حيث تدفع القوى الاقتصادية الفتيات والشابات إلى المهنة برغبتهن. وبينما يوجد عدد متزايد من منظمات عمال الجنس في البلاد، فيجب حماية مصالحهن وتحسينها باعتبارهن عاملات ونساء، فإنه لا يمكنهن وقف المد.
-
كذلك في ولاية أندرا براديش بجنوب الهند، تطورت صناعة منتجات الألبان، التي هي من الناحية العملية صناعة «للنساء فقط» تطورًا كبيرًا في ظل «الثورة البيضاء» المخططة. وظهرت إلى الوجود تعاونيات منتجي الألبان واتحادات التعاونيات القوية التي تقودها النساء، حيث كانت لذلك آثار انتشارية على وضع النساء في تلك الأسر. فالآن تسمح حكومة الولاية والحكومة الاتحادية – أو أجبرت على السماح– للشركات متعددة الجنسيات مثل يونليفر بالدخول في سوق الألبان المميزة بعلامات تجارية. وبناء على وجود فائض في إنتاج الألبان، فإن المصلحة تكمن في منتجات الألبان المصنعة مثل الحليب المجفف والجبن. ويؤدي دخول الشركات متعددة– الجنسيات هذا القطاع إلى فرض المعايير الصحية الدولية (معايير فيتو) التي لا تسمح بالحلب اليدوي وتقضي بتجميد الألبان فور حلبها. وسوف يضيع هذا صناعة الألبان من أيدي آلاف الريفيات لتذهب إلى أيدي الفاعلين الكبار الذين يمكنهم التحكم في الموارد الخاصة بالاستثمار في هذه التكنولوجيا والبنية التحتية الخاصة بشبكة التوريد. فكيف يمكن للفقراء المشاركة في السوق العالمية التي يضع المعايير فيها– ويغيرها– الآخرون؟
تبين هذه الأمثلة أن المتأثرين أكثر من غيرهم بتغيرات السياسة الاقتصادية وإصلاحاتها – وخاصة النساء الفقيرات – ليست لهم القدرة على القيام بدور في اتخاذ هذا؟ وأنهم في أغلب الأحيان ضحايا له أكثر من مستفيدين منه. وفي حالة النساجين، نرى كيف أن معايير ما يعد إنتاجاً «كافيًا» لا يقررها المنتجون، بل قوى السوق الكونية والمؤسسات ذات النفوذ السياسي الأكبر، وكيف أنه يمكنهم الاستمرار في رفع العارضة وتغيير القوائم دون أن تنالهم أية عقوبة. أما الفقراء فهم ضحايا النموذج الاقتصادي الكوني الذي لا ينظر فيه إلى الفقر على أنه نتيجة للتفاوتات الهيكلية، بل على أنه نتيجة لعدم كفاءة الفقراء أنفسهم من ناحية التدريب والقدرات ورأس المال.
سوف يزداد القضاء على الفقر صعوبة في المستقبل في ظل عسكرة العالم غير المسبوقة والمثيرة في السنة الأخيرة. فالولايات المتحدة تنفق ما يزيد على خمسة تريليونات دولار على الدفاع، وهو ما يزيد على ميزانيات دفاع سائر دول العالم مجتمعة. ولم توسع السياسات الخارجية للحكومة الأمريكية بعد الحادي عشر من سبتمبر– مثل «الحرب على الإرهاب»- عسكرة العديد من أقاليم العالم فحسب، بل أعطت الدول الأخرى الموافقة والمشروعية كي تزيد إنفاقها الدفاعي وتقيد حقوق المواطنين المدنية والسياسية، وتشن حملات الإبادة الجماعية ضد الأقليات المنتقاة المتهمة بتنشئة الإرهابين وإيوائهم. وليس التحدي هو عسكرة المناطق بواسطة حكوماتها، بل بواسطة القوى الأجنبية التي تدخل تلك المناطق دون أن ينالها أي عقاب، حيث تفرض الخيارات المحلية أو تتجاهلها.
يتضح هذا بجلاء في جنوب آسيا، وهي إحدى أكثر المناطق انتشارًا للصراعات والعسكرية في العالم. وتخصص دول مثل الهند وباكستان نسبًا كبيرًا– من 14 إلى 15%- من ميزانيتها القومية للدفاع، حتى وإن كان غالبية سكانها يكافحون كي يدبروا معيشتهم التي تتسم بالقسوة والخشونة. وهكذا فبينما تحصل جيوش هذين البلدين على المزيد والمزيد من الأسلحة والمعدات الحديثة، نجد أن غالبية النساء المحليات فيهما يعانين من الأمية ونقص التغذية وضعف الصحة. وعلاوة على ذلك، فإنه منذ صنع الأسلحة النووية فقد البلدان قدراً كبيراً من سيادتهما، حيث تتدخل القوة الأجنبية الكبرى في كل خطوة يقومان بها وتراقبها. ونتيجة لذلك سوف يكون للأنظمة الأجنبية سلطة التأثير على السياسات والميزانيات القومية مما يكون له آثار ضخمة بشكل خاص على فقراء هذين البلدين؛ وهو ما نشاهده بالفعل في شبه القارة الهندية.
الصلات بين الصراع والفقر – أو بالأحرى بين السلام والرفاهية – معروفة جيدًا– ولكن الغريب أنها غائبة (باستثناء مستوى النفاق) من الخطاب الخاص بالفقر والخاص بالقضايا «الاستراتيجية» الدولية والسلام. وقد حان الوقت بالنسبة لحركات النساء، على المستويين الإقليمي والكوني، كي تكشف وتعزز الوعي واسع الانتشار بهذه الصلات على المستوى المحلي وتبني رأيًا عامًا قويًا ضد الحرب والصراعات الأهلية والعسكرة. ومن المهم كذلك بناء وعي بالأثر النوعي للصراع على النساء باعتبارهن مشاركات وضحايا، وكذلك بناء قدرتهن في عمليات السلام.
حين تفعل الحركات النسائية ذلك، سوف تواجه قوة حجاب مضادة أخرى، وهي التأييد في مجتمعاتنا للتعددية في ظل التاريخ الطويل من الصراع السياسي والعرقي والديني وانتشار الحركات الأصولية من كل الأنواع. وفي هذا الصدد كانت الحركة النسائية من زمن بعيد على المستويين الكوني والمحلي قوة تقدمية تدافع عن سياسات وثقافات التسامح والاحتواء والعلمانية والتعددية. وقد أيدت في كثير من بلادنا تبني وحماية حقوق الإنسان كافة من أجل المساواة في ظل القانون ومن أجل الحماية من سلطة الدولة والقوى الدينية الرجعية. ولكن أصوات النساء الآن خفتت في هذا المجال. فالنساء تستغلهن الحكومات، كاستغلال حكومة الولايات المتحدة لهن في «الحرب على الإرهاب»، بينما تسهم هذه الحرب نفسها في إقصائهن أو عزلهن من جديد في المجتمعات التي تحقق فيها درجة من القدرة على التعبير عن الرأي والمشاركة العامة، كالشرق الأوسط أو باكستان أو حتى أفغانستان.
إذا أخذنا دراسة هذه الحالة هذه الخاصة بالصراع العرقي – قد يسميه البعض حربًا أهلية– الذي دام عقودًا في سريلانكا وأفرز مجموعة كبيرة من الديناميكيات والآثار على النساء نتيجة للصراع والعسكرة، حتى وإن كانت النساء بمثابة عوامل سلام، نعلم أن النساء– وخاصة النساء الفقيرات– يعانين أكثر من غيرهن من «الضرر الملازم» الذي تسببه الحروب والصراعات. ففي سريلانكا، أدى الكفاح الطويل والعنيف من أجل فصل دولة التاميل وانتشار حالة القمع وانتهاكات حقوق الإنسان من قِبَل قوات الجانبين إلى ترميل آلاف النساء. وحتى إذا كان الأزواج أحياء فإنهم قد يكونون مشاركين في القتال أو مفقودين أو معتقلين أو عجزة. وفي أي من تلك الحالات يكون على النساء أن يصبحن الكاسب الأساسي للدخل في اقتصاد متقلب ويَعُلْنَ أطفالهن والعائلة الممتدة، وكل ذلك في أوضاع من عدم الأمان المادي الشديد. وتشير البيانات إلى تزايد أعداد الأسرة التي ترأسها إناث في مناطق التجارة الحرة السريلانكية والمزارع وبين العمال المهاجرين. ويعني القيام بهذا الدور ضمنًا التعامل مع قدر ضخم من الضغط الذهني، بما في ذلك الخوف المستمر من اعتقال المراهقين أو أي من أفراد الأسرة الآخرين أو «اختفائهم» (وهي الشفرة المستخدمة للدلالة على الخطف أو القتل على أيدي أفراد الأمن أو الجماعات المسلحة) واتخاذ قرارات بشأن المكان الذين ينتقلون إليه بعد تهجيرهم من «المناطق الأمنية» التي تزداد اتساعًا، ورغم قدرتهم على التكيف مع هذه الأدوار غير المألوفة، فإنهن لا يكتسين مكانة جيدة داخل الأسرة ولا يحصلن على اعتراف بذلك وتقدير له من المجتمع بصفة عامة. ولا حاجة إلى القول بأنه ليست هناك محاولة لدعمهن في السياسة أو موارد البنية التحتية. كما يجب التأكيد على أن الأرملة في الثقافات الجنوب آسيوية ليست مجرد امرأة توفي روجها فحسب، بل هي وصمة اجتماعية تتسبب في ضياع المكانة والإقصاء من الحياة الجماعية، وقدرًا أكبر من القابلية للتعرض للتحرش الجنسي والهجوم. والمهم هو أنه بينما قد تقتل الصراعات أعداداً أكبر من الرجال، فإن النساء هن اللائي يتحملن نتائج تلك الوفيات على نحو نوعي. ويبين هذا كيف أن «النوع والطبقة والجنس والأمة والعرقية والأصولية والعولمة تتداخل وتتصل مع النزعة العسكرية ومع بعضها البعض لتشكل شبكة من أشكال القمع التي يدعم بعضها بعضًا».
كما آثرت النساء دعم الحركات المسلحة بطرق عديدة تتراوح بين إعادة صياغة أدوارهن التقليدية – مثل «الأمومة» – وإعطائها أهمية سياسية جديدة وتقديمهن وعدًا لها بهويات جديدة «محررة» فيما يبدو خارج الأسرة. ففي الأيام الأولى من المقاومة التاميلية للهيمنة السنهالية وتفرقتها العنصرية، كان إسهام النساء كمروجات للدعاية أساسيا. فقد كن يستخدمن كمتحدثات في الاجتماعات العامة حيث كن ينظمن النساء باعتبارهن ضحايا الدولة السنهالية ويحرضن أخواتهن على تقديم أبناء شجعان كي يقاتلوا لاستعادة كبرياء الطائفة التاميلية. [نفس الخطاب يستخدمه الأصوليون الهندوس في تحريض الأمهات الهندوسيات على تربية أبنائهن كالمحاربين]. وكانت النساء التاميليات يحرضن على استخدام كل التكتيكات الممكنة لدعم التزام رجالهن بالقضية، بدءا من التشجيع حتى إهانة الكاره للقتال وإذلاله. وهكذا كان دورهن في الصراع تنشئة ورعاية الأبناء والأزواج في أوج الظرف القتالي المادي والنفسي؛ أي بناء هو نسخة الذكورة الخاصة بالمناضل.
وفيما بعد حين تحولت المقاومة إلى كفاح مسلح، انضمت النساء إلى المنظمات القومية التاميلية بأعداد كبيرة. وفي أوائل الثمانينات كانت الجماعات التاميلية القومية الكبيرة تتعامل مع إخضاع النساء في المجتمع على أنه جزء من أجندتها السياسية، حيث وعدت النساء بأنه في المجتمع المحرر الذي سوف يتحقق بعد النصر سوف تتمتع النساء بمكانة مساوية لمكانة الرجال. وضمت الجماعات النسائية المستقلة عضوات الجماعات المسلحة لمجادلة وتحدي البنى التقليدية للنساء في الأيديولوجيا الثقافية التاميلية، وأفكار التحرر. وقد وضع مفهوم «بودوماي بن» (المرأة الجديدة).
كان الاستثناء الوحيد من ذلك هو منظمة نمور تحرير تاميل إيلام، وهي الجماعة التي قضت فيما بعد على كل الحركات التاميلية الأخرى وتولت هي أمر الكفاح القومي. فهي لم تتناول مسألة المرأة، بل كانت أول من جندت النساء ودربتهن في القتال المسلح، حيث اعتمدت على قاعدة النضال وتحرير النساء التي وضعت من قبل. وهنا نرى البعد الآخر للنساء في الصراعات، وهو إيثارهن الدخول في الصراعات كمقاتلات. والحقيقة لا يعرفها الكثيرون هي أن 50 بالمائة من مقاتلي نمور تحرير تاميل إيلام ومعظم من يقومون بالأعمال الانتحارية من النساء (كالشابات اللائي اغتلن رئيس وزراء الهند الأسبق راجيف غاندي وحاولن اغتيال رئيستهم تشاندريكا كوامارتونجا).
ولكن بينما تحثهن منظمة نمور تحرير تاميل إيلام على التخلي عن أنوثتهن والاستعداد للموت من أجل الوطن التاميلي، لا تسمح بمناقشة وضع النساء التابع والخاضع، أو توفر دوراً متكافئًا داخل الحركة، أو تعد بمساواة مستقبلية في الوطن التاميلي الذي تعد بإقامته. والكوادر النسائية خاضعة للسيطرة الذكورية، ولا يُسمح لأية امرأة بالصعود إلى الدرجات العليا من قيادة المنظمة. ومن الواضح أنه حتى دخول الصراعات كمقاتلات فاعلات والتغاضي عن المفاهيم التقليدية الخاصة بالأنوثة لا يضمن بالضرورة تحولاً جوهريًا في العلاقات النوعية. وليس هذا أمراً تنفرد به سريلانكا؛ فنحن نرى أدلة من هذا الشكل المحدد للاستغلال لقدرات النساء في الأعمال القتالية والصراع المسلح في أنحاء العالم.
فماذا عن تحالف من أدوار النساء في السلم وعمليات حل الصراعات؟ تكثر في شبه القارة أمثلة مساهمة النساء في المظاهرات ضد انتهاكات حقوق الإنسان وحل الصراعات وحركات السلام. ومرة أخرى في سريلانكا، كانت «نساء من أجل السلام»، وهي الجماعات النسائية والمهنيات من كل الديانات والجماعات العرقية، أول من طالب بإنهاء الحرب وبدء التحرك من أجل تسوية يجري التفاوض عليها سلميًا. وطوال ما يزيد على عشر سنوات عملت الناشطات على تحرير المعتقلين السياسيين، وإلغاء تشريع «مكافحة الإرهاب»، والاحتجاج على الاعتقال غير القانوني و«الاختفاءات، وضمان تعويض المدنيين المتأثرين بالصراع. وقد فعلن هذا بمخاطرة شخصية ضخمة، وتعرضن لخطر الموت على أيدي الدولة والشرطة والجيش والجماعات المسلحة العرقية المتنافسة. وقد فقدت نساء كثيرات حياتهن من خلال الإعدام بلا محاكمة؛ وقد حدث هذا في دول أخرى كثيرة بجنوب آسيا.
من ناحية أخرى هناك الكثير من الحركات النسائية الداعية إلى السلام وحقوق المتأثرين التي جرى استمالتها واستغلالها. وطالبت «جبهة الأمهات التاميليات»، التي تشكلت كمنظمة مستقلة لا تمارس العنف في عام 1984، الدولة بإعادة أبنائهن ووقف انتهاكات حقوق الإنسان وبدء عملية التحقيق من أجل المحاسبة على خطف أطفالهن وقتلهم. وقد استعن بفكرة الأمومة باعتبارها قيمة عالمية تلزمهن بحماية الحياة في كل المواقف. وسمحت لهن السلطة الأخلاقية المتعارف عليها الممنوحة للأمهات بدخول المجال العام بدور نوعي مشروع. وقد أيدت منظمة نمور تحرير تاميل إيلام مطالبهن من الدولة السريلانكية، من باب تحقيق مصالحها الذاتية، إلى أن قضت جسديًا على الجماعات التاميلية الأخرى كلها وأصبحت لها السيطرة التامة على شبه جزيرة جافنا. وبعد ذلك انحسر الدور السياسي لجبهة الأمهات التاميليات، وتدهور بها الحال لتصبح مجرد منظمة للرعاية الاجتماعية في ظل نظام منظمة نمور تحرير تاميل إيلام الدكتاتوري والأبوي.
عانت جبهة الأمهات التاميليات في الجنوب، التي قامت استلهامًا لجبهة الأمهات التاميليات، من الاستغلال السياسي والتهميش بصورة أخرى. فهي لم تكن جماعة مستقلة، بل جرى تنظيمها في ظل حزب المعارضة الرئيسي، حزب الحرية السريلانكي الذي كان المتحدي الرئيسي للحزب الموالي للسنهالا الذي كان يتولى السلطة في ذلك الوقت. وكان من بين أعضائها الكثير من أمهات وزوجات أفراد الشرطة والجيش قتلوا في الحرب. وكانت مطالبهن السياسية هي إنهاء الصراع المسلح وإعادة الديمقراطية ووقف انتهاكات حقوق الإنسان والإعدام بدون محاكمة. وكانت جبهة الأمهات السنهاليات تعتزم العمل بطريقة غير منحازة باعتبارها «مراقبًا» على أي حزب يكون في السلطة، وأن تصبح مستقلة عن حماية الحزب وتطور تنظيمها. ولكنها عجزت عن منع استغلال حملاتها وأجنداتها للإطاحة بالحكومة القائمة. وحتى حين تحقق ذلك، ولكونها تعتمد على حزب الحرية السريلانكي في الحصول على الحماية السياسية والقيادة، فقد عجزت الجبهة عن تحويل نفسها إلى قوة سياسية مستقلة استقلالاً حقيقيًا.
تلك كانتا حكايتين تحذيريتين عن كيفية إفساد أدوار النساء واستغلالها في السلم والإعداد له. وفي المقابل فإنه في جنوب شرقي الهند، وهي المنطقة التي شهدت قيام حركات لتقرير المصير وعسكرة مكثفة لعدة عقود، عبأت النساء مجموعة كبيرة من الناس في حركتهن من خلال النجاح في بدء حوار مع كل من الجماعات المسلحة والجيش الهندي. فقد استطاعت «جبهة نساء تاجا» مقاومة إسكاتها بشكل أفضل من خلال إثارة قضايا انتهاك حقوق الإنسان في مجموعة متكاملة من المطالب التي تناولت الظروف المعيشية للمدنيين كافة الذين يعيشون في ظل الاحتلال العسكري، مثل الطعام المدعم والمدارس والمستشفيات وإجراء الانتخابات، إلخ. وبما أنهن يطالبن بحكم وإدارة كاملين ويتسمان بالكفاءة، فلم يكن بالإمكان وصفهن بـ «الانفصاليات المعاديات للقومية». ووجدت الجماعات المسلحة القومية كذلك أنه الصعب مهاجمتهن باعتبارهن مؤيدات للدولة بسبب التأييد الشعبي الواسع الذي يحظين به بين الناس. وبذلك استطاعت النساء توسيع دورهن ليتعدى كونهن «أمهات» إلى دور المواطنات المشاركات والفاعلات والديمقراطيات.
من الواضح أن دور الصراع على النساء على قدر كبير من التعقيد ويتنوع تنوعًا كبيرًا من ناحية السياق الثقافي والسياسي. إلا أن الأمر الواضح هو أنه يتطلب مستو معقدا من التحليل، والمراقبة والبحث الدائمين، واستراتيجيات التدخل المستدامة من جانب جماعات الحركة النسائية. ولكن مع انتشار الصراع في أنحاء العالم، من الواضح أنه سيتعين على الحركات النسائية إحداث قدر كبير من التطور في أطرها التحليلية وقدر أكبر من الفطنة والذكاء السياسيين عند وضع الحلول الاستراتيجية والتمكينية.
في غياب السلم واستمرار انتشار الفقر، تكتسب الأصولية– الدينية والعرقية– قوة دفع جديدة ونشهد في الوقت الراهن ما يصل إلى حد التقسيم الفعلي للعالم إلى أقاليم أصولية. ويعني هذا بطبيعة الحال أن أشكال الأبوية كافة تكتسب مواطئ أقدام جديدة وتتسم بالبراعة. فقد تحولت الممارسات القديمة إلى أشكال من الحرمان. فعلى سبيل المثال، تصبح المرأة الهندوسية عنوانا للمرأة «الحديثة» على عكس أختها المسلمة المتخلفة المضطهدة، وكذلك الحال بالنسبة للقيم التقليدية الخاصة بالعفة والحياء والتضحية بالذات والتفاني في خدمة الأسرة. فسوف تساعد في صنع قنابل بنزين لزوجها وأبنائها وإخوانها لإلقائها على أحياء المسلمات العشوائية المجاورة أثناء إعدادهن طعام العشاء كأية زوجة وأم هندوسية صالحة، ثم تذهب في صباح اليوم التالي للعمل كمعلمة في صورة «المرأة العاملة الحديثة».
بينما ركزت الحركات النسائية بقوة على العنف الأسري – وهو تركيز مشروع في ظل كون الأسرة أساسية وموجودة في كل مكان باعتبارها مؤسسة– تمثل طبيعة سياسة الهوية، بسبب تعقيدها المتأصل، تحديا أكبر بكثير لتفكير الحركة النسائية وتنظيمها. وفي باكستان، كان للصراعات بين الطوائف المختلفة من المسلمين والحركات الانفصالية في مناطق مثل بلوشستان والهجمات على نازحي ما بعد التقسيم (ويسمون «المهاجرين») آثار مرعبة على النساء في تلك الجماعات والمناطق. وفي بنجلاديش، أدت المذابح غير الملحوظة تقريبًا ضد الأقلية الهندوسية إلى تشريد وترميل مئات الآلاف من النساء الفقيرات. وفي سريلانكا خلفت الحرب الأهلية الآلاف من الأرامل أو حرمت النساء من أولادهن وبناتهن إما قتلاً في الصراع أو خطفا بالقوة لخدمة الانفصاليين التاميل.
الحروب منخفضة الكثافة على الحدود الهندية الباكستانية في الهند، وقمع الكفاح من أجل تقرير المصير في كشمير، والحروب القبلية كتلك التي بين الكوكي والناجا الشمال الشرقي، وعمليات الإحراق المتكررة بين الهندوس والمسلمين، ومذابح المسلمين والهجمات على المسيحيين الآخذة في الازدياد، كلها أمور لها أثر ضخم على حياة النساء المدنيات. وأثناء مذابح كوجارات، علق وزير الدفاع الهندي قائلاً إن العنف الجنسي ضد النساء لم يكن مستغربا ولا جديدا. وبعبارة أخرى فإنه من المعتاد بالنسبة للنساء أن يغتصبن أو تنتزع أجنتهن من أحشائهن حين تكون هناك مذبحة أو شغب أو حرب.
في الوقت الذي حلل فيها باحثو الحركات النسائية هذه القضايا، كان من الصعب ترجمة ما ارتأوه إلى استراتيجيات على الأرض. فقد لاقت فكرة الحركة النسائية القومية المتجانسة تحديا في ظل الوضع الطبقي والطائفي والديني الخاص للقيادات النسائية ومنظماتها. ولم يتحقق النجاح في التفاوض على سياسات الاختلاف وتراجعت جماعات كثيرة نتيجة لاستيلاء الأصوليين على القضايا التي كانت تثيرها وتشويهها. ففي الهند على سبيل المثال، كانت ناشطات الحركة النسائية يتبنين منذ فترة طويلة مجموعة مشتركة من القوانين المدنية (كانت تسمى من قبل «القانون المدني الموحد») تنظم أمور الزواج والطلاق والنفقة والميراث والتبني. في أوائل التسعينيات أعاد الأصوليون الهندوس عرض هذه القضية على أنها قضية بين الدولة والمقصورية الدينية والثقافية، وخيانة لجماعات بعينها، مما يهدد سلامة الأمة. وقد أعادوا صياغة القانون المدني الموحد على أساس المعيار الهندوسي المبني على ممارسات قلة من الهندوس أبناء الطائفة العليا والطبقة العليا، متجاهلين ذلك التنوع الكبير من القوانين العرفية بين الهندوس أنفسهم. كما أنهم تجاهلوا حقيقة أن القانون الهندوسي نفسه أعيدت صياغته بطريقة شديد الرجعية، حيث حد في بعض الحالات من المزايا التي كانت النساء يتمتعن بها في ظل القانون العرفي في بعض الحالات.
انسحبت الكثير من المنظمات النسائية التقدمية من النقاش الذي تحول إلى حقل الغام في ظل الطريقة التي كان الأصوليون يعرفون بها فكرتي القومية وحقوق الأقليات. ولم تعرف الجماعات النسائية كيفية التوفيق بين فكرة الحقوق الفردية والمساواة الخاصة بالنساء وفكرة حقوق الطوائف المحددة؛ حقوق من هي التي ينبغي تمییزها؟ ومع ذلك كان هناك درس مهم هذه التجربة، وهو أنه في المجتمعات التي تتسم بقدر كبير من التنوع كالهند – مع وجود مستويات مرتفعة من الاستقطاب على الخطوط الدينية والعرقية– يكون مفهوم «التماثل» على نحو أشد من استخلص من الإشكالية، وخاصة إذا لم تكن هناك رغبة في الإسهام في أجندة الأصوليين الخاصة بإنشاء دولة للهندوس. وأدى إدراك ذلك إلى ظهور أطر أكثر تعقيدًا ومجموعة متباينة المشترك من المواقف بين الجماعات النسائية. وتتراوح تلك المواقف بين القانون النوعي العادل والإصلاحات من داخل الطوائف (حتى وإن لم يضمن هذا العدالة النوعية المطلقة) ورفض الإجراءات القضائية الرسمية لمصلحة مجالس التحكيم القائمة على أسس طائفية.
وربما كان أصعب تحد مثله انتشار الأصولية هو استيعاب الجماعات الأصولية وإيديولوجياتها الضخم للنساء الفقيرات ونساء الطبقة العاملة. وكانت الجماعات النسائية التقدمية من بين أول من أدان العنف الطائفي والعسكرة وأشكال الأصولية ومشروعاتها كافة. ففي باكستان على سبيل المثال، قدمت الجماعات النسائية الاعتراض الوحيد على تطبيق الحدود (أي فرض قيود على تحركات المرأة وفرض عقوبات تعود إلى العصور الوسطى على جرائم كالزنا). وعبأت الجماعات النسائية البنجلاديشية والسريلانكية الجماهير ضد القوى المتزايدة لرجال الدين المسلمين والبوذيين، وتكافح الجماعات النسائية الهندية منذ زمن طويل ضد قوى الأصولية الهندوسية. ومع ذلك فقد جرى تعبئة أعداد مذهلة من النساء من خلال تلك الأجندات؛ بواسطة الأحزاب الأصولية مثل الجماعة الإسلامية وغيرها من الجماعات في باكستان وبنجلاديش، والأصوليون السنهاليون والتاميليون في سريلانكا، والمنظمات الأصولية الهنودسية مثل المجلس الهندوسي العالمي VHP وجمعية المتطوعين الوطنية RSS، وحين هدمت الجماهير الغاضبة مسجد بابري بالهند في ديسمبر من عام 1992، كان خمسون ألفًا من أفراد «كار سيفاك» (المتطوعين الدينيين) في الموقع من النساء.
هذه الظاهرة شاهد على الطريقة التي قدم بها الأصوليون للنساء أفكار «التحرر» الجديدة والقوة في المجال العام. وأصبح ذلك يتسم بالجاذبية في غياب الأنواع الأخرى من فضاءات التعبئة التقدمية التي تقدم للمرأة أجندة مختلفة. وسوف يتعين على الحركات النسائية ليس استعادة النساء بصورة عامة من تلك التشكيلات فحسب، بل كذلك ضمان عدم نجاح الأصوليين في تعبئة النساء الأكثر فقراً والأكثر تهميشًا.
نعتقد أن ثلاث استراتيجيات مهمة لابد أن تكون مرشدة للحركات النسائية في مواجهة تلك التحديات والتهديدات الضخمة؛ وهي تعديل الأطر المفاهيمية التي يتم منها تطوير استراتيجياتنا، وبناء قاعدة جماهيرية كبيرة وقوية، وإعادة صياغة هياكلنا للتعامل مع هذه المهام الهائلة.
1- تعديل أطرنا
الخطوة المهمة الأولى لرسم أي مسار مستقبلي للحركات النسائية هي بحث الأطر المفاهيمية– الضمنية أو الصريحة– التي شكلت تفكيرنا وعملنا حتى الآن وتحليليها. وفي ظل الواقع السياسي الحالي، قد نضطر إلى تعديل أطرنا لتوفير اتجاهات أكثر وضوحا لعملنا في المستقبل وقد يتعين علينا استخدام الأطر القديمة بشكل استراتيجي أكبر، مع إدراك ما لها من قوة ومن قيود.
ولنبحث سبب أهمية ذلك بالاستعانة بمثال ملموس. ففي جنوب آسيا استفادت الحركات النسائية من الإصلاح القانوني على نحو ضخم في محاربة التفرقة النوعية وعملت داخل إطارين أساسيين، هما إطار الحقوق وإطار المساواة الحقيقية الجوهرية. ويركز إطار الحقوق على المساواة الرسمية – أي الحقوق المتساوية في ظل القانون– على افتراض أن كل فرد/ مواطن مثل غيره. ويقول مؤيدو هذه الاستراتيجية إن الاختلافات النوعية استغلت الحرمان النساء من حقوقهن. ولكن هذه إشكالية في المجتمعات ذات الاختلافات الاجتماعية والاقتصادية الواسعة، وحيث قد يكون الحصول على الحقوق التي يكفلها القانون أمرًا صعبًا على معظم الناس. وهكذا فإن المطالبة بالتماثل في الحقوق والملكية– حق رسمي – يمكن أن يكون بلا معنى إذا كانت غالبية الناس في البلاد عمالاً لا يملكون أرضًا. ويصبح الحق المتساوي في الملكية بالنسبة للرجال والنساء مفيدا حين يضم إلى الكفاح من أجل إصلاح الأراضي.
ويعترف إطار المساواة الحقيقة الجوهرية بهذا الفرق، أي أن الأفراد قد يكونون مختلفين. فهو لا يقوم على المعاملة المتساوية في ظل القانون فحسب، بل على التأثير الفعلي للقانون. وهو يأخذ في اعتباره أشكال عدم المساواة الخاصة بالخلفية الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية للشعب ويسعى إلى القضاء على أشكال عدم المساواة القائمة عن طريق الإجراءات الإيجابية ومنها التشريعات التي تدعم المرأة. وليس مركز اهتمام التحليل هو التماثل أو الاختلاف بل الضرر الواقع. «حين تترجم المساواة أمام القانون على أنها كون الرجال والنساء سواسية، لا تؤيد المحاكم أي تشريع قُصد به التعويض عما سبق من تفرقة أو تأخذ في اعتبارها الاختلافات النوعية المميزة (كالحمل). ولا يمكن لمنهج التماثل التمييز بين المعاملة التفاضلية التي تفيد والمعاملة التفاضلية التي تضر».
المعضلة التي تواجهها ناشطات الحركة النسائية مع هذين المنهجين هي أنهما يمكنان الدولة باعتبارها الفاعل الأساسي في التحول الاجتماعي والحماية الاجتماعية. ويفترض هذا الحياد من جانب الدولة وهو ما ليس صحيحاً؛ فالدولة قائمة، في معظم الأحيان، على حماية ودعم نفس المصالح الطبقية والنوعية التي سوف تعرضها تلك التغييرات للخطر، ولذلك فغالبا ما تجد طرقا للسماح بتلك التغييرات من حيث المبدأ (مثل إقرار نسخ مخففة جدًا من قانون المرأة) بينما تبطلها عند التطبيق، كما كان الحال ف أنحاء جنوب آسيا مع إصلاحات الأراضي. كما أنها تحد من التركيز على بناء عمليات تغيير تحولية داخل المجتمعات المحلية، على الأرض. وبذلك فإن كل نصر قانوني أو سياسي تحققه الحركة النسائية قد يتبخر على أرض الواقع حين يبدأ الكفاح من أجل التنفيذ. وهذه التجربة لا ينفرد بها جنوب آسيا، وربما يكون هذا هو السبب في أنه ليس هنا نقد متزايد في أنحاء العالم على عدم نجاح منهج الحقوق.
لذلك فإن علينا استكشاف وخلق أطر واستراتيجيات ليست في المقام الأول ضمن نموذج الدولة باعتبارها الفاعل الأساسي أو الممكن للتغيير، ولا تقوم في الأساس على التدخل القانوني الرسمي، بل ترتكز على قوة النساء الفقيرات ودوائرهن في إحداث تحول أكثر جوهريةً. وبينما سيظل للدولة دور، فهي لن تكون الراعي وإنما شريك. ثانياً: بناء على فهمنا أن تجربة النوع والحرمان من الحقوق تخص الثقافة والموقع على وجه التحديد، لا يعود في مقدورنا افتراض وجود مبادئ أخلاقية «كلية» معينة ترشد إطارنا بل لابد من خلق عملية لتحديد موقعها بالفعل. ويتطلب هذا عملية جدل ونقاش واسعة من أسفل إلى أعلى. وهذا دور حيوي بالنسبة للحركات النسائية في المرحلة المقبلة.
2- تقوية القاعدة
لابد أن تعيد الحركة النسائية بناء نفسها باعتبارها قوة اجتماعية وسياسية. ولكي تفعل ذلك سيكون عليها تجديد حيوية استراتيجيات تنظيمها. ويأتي على رأس الأولويات تيسير ودعم ظهور منظمات قوية تقوم على أسس محلية للنساء الفقيرات وتمكينها من الوصول إلى فضاءات سياسية متعددة. ونحن بحاجة إلى تحريك من أسفل على مستوى القرية والبلدة والمدينة. ويعني هذا كذلك خلق فضاءات بديلة للنساء اللائي يتحملن عبء السياسات الليبرالية الجديدة، والترحيل، وفقدان المأوى وموارد العيش بسبب الصراعات المدنية والعنف العرقي والعنف الأسري ومع الدولة. وإذا أمكن تعبئتهن سوف نرى ثورة لا يصدقها أحد، كما حدث في بعض الأماكن.
تضع هذه المهمة مسئولية خاصة على ناشطات الحركة النسائية من الطبقة الوسطى اللائي لابد لهن من التخلي عن القيادة والتحكم في إبراز الأولويات والاهتمامات التي ربما كانت لهن فيما مضى. ولابد أن يتعلمن تيسير وتمكين ظهور القيادات المحلية والمنظمات المستقلة ومساعدتها على تكوين صلات مع كل من الحركات التقدمية الأخرى (مثل العمل والعدالة الاقتصادية وحقوق الإنسان) وكذلك الحملات مع والمنظمات التي تعمل على المستويات القومية والمتعدية للقوميات والكونية. ويمكن أن نجد العديد من الأمثلة الممتازة لتكوين تلك الصلات، بما في ذلك الدور الذي تقوم به المنظمات غير الحكومية بشأن قضايا الفقر الحضري في الهند، والاتحادات ذات الأسس الجماهيرية الخاصة بالفقراء الحضريين في جنوب إفريقيا وتايلاند التي تتفاوض تفاوضًا مباشراً مع الحكومات والمؤسسات المالية الدولية لضمان حقوقها في تسويات آمنة ومستدامة.
ويبرز هذا المثال كذلك أهمية المنهج الأكثر تقاطعًا الذي هو سبيل المستقبل والطريقة الوحيدة لمعالجة تحديات الفقر والصراع والأصولية الضخمة. ومن المأمول أن يواجه هذا المناهج القطاعية والضيقة القائمة على المشروعات التي عززتها الوكالات الممولة، مما قسَّم العمل بشأن العنف والدخل والبطالة والصحة والتعليم وإصلاح القوانين والحقوق الجنسية والإنجابية إلى أجزاء مستقلة.
نحن نعتقد أن التركيز القوي على بناء القاعدة سوف يخلق كذلك الظروف للنساء المحليات وتشكيلاتهن كي ينشئن حركات جماهيرية ضد الفقر والصراع والأصولية ويتولين قيادتها. وهي بإبرازها المقاربات الجديدة الديناميكية وخلقها المستحدثات على الأرض، سوف تجتذب الحركات وأشكال الكفاح الأخرى كي تنضم إليها. وسوف يساعد هذا على توسيع الحركات وتغيير طابعها وقيادتها ويولد مقارباتها، وبذلك تتغلب على أحد قيود الماضي حيث كانت النساء مشاركات في حركات العدالة الاجتماعية الكبيرة، دون أن يكن قائدات لها. كما سيغير هذا طابع التحالفات والشروط. ولذلك لن يكون خيار الشريك المتضمن قائمًا على الانتساب، بل على الطريقة التي تخلق بها المشاركة القيم وتضيف إلى الأثر الاجتماعي.
3- إعادة صياغة الهياكل
تقتضي عملية تولي القيادة وبناء منظمات نابضة بالحيوية والنشاط كي تتحرك قُدُمًا بالحركة الاستبطان بشأن ما تعلمناه من تجربتنا الخاصة بخلق البُنى البديلة واستداماتها. ونعلم أن المنظمات النسائية واجهت تحديات ومشاكل داخلية عديدة مع السلطة كما يتجلى في العمل الديمقراطي وتفويض السلطة، والتراتبات الخفية، وأساليب القيادة المشكوك فيها، وحل الصراعات، ونقص التأييد للقيادات الشابة، إلخ. وفي مجتمعات ما بعد الكولونيالية نجد أن لاتماثل السلطة لا يقوم على الطبقة والتعليم إلخ فحسب، بل كذلك على القدرة على الوصول إلى اللغات العالمية كالإنجليزية. ويُنقل هذا إلى المنظمات النسائية حيث يعني عدم القدرة إلى الوصول إلى الإنجليزية الاستبعاد من المناقشات والتطورات النظرية النقدية. ولابد من سد تلك الفجوات؛ وهي الفجوات التي بين «المفكرين» و«الفاعلين»، وبين المتحدثين الوطنيين والمتحدثين الإنجليز، وبين مستخدمي شبكة المعلومات وغيرهم.
إلا أن هذا الفجوات تصبح أكثر خطورة حين يكون التحدي الرئيسي هو بناء منظمات نسائية على أسس جماهيرية وقيادات محلية على المستويين القومي والدولي.
لذلك فلابد لنا من بناء حركات تعليم تقوم على مبادئ الاستبطان والافتراضات القائمة على الشك، والتضمين والوعي باختلافاتنا وتراتباتنا، وأن نكون متقبلين للتغيير بحق. ومن الصعب استدامة ذلك بدون عمليات دورية ومستمرة من التفكير يجري خلقها وحمايتها بشكل واعٍ. وحين نضمن ذلك، سوف تضمن النساء بدورهن أن تتغير حركتهن وتتطور وتظل نابضة بالنشاط والحيوية. وأخيرًا، فلابد أن نبني حركات مرنة ومنفتحة اتسعت دائرتها بالطرق الحقيقة والمرئية لتشمل كل هؤلاء المتأثرين بالجوع والحرمان والصراعات والكراهية.
أحمد محمود: صحفى ومترجم.
(*) Occosional Papers No. 2 (October 2002)
https://www.awid.org/publictions/Occosionl Papers/accasion12.html.
تم إعداد هذه الورقة كجزء من مشروع «اتجاهات مستقبلية»، وهو مشروع تم بالتعاون بين AWAD و Mama Cash، يهدف إلى الإجابة عن سؤال: كيف يمكن للحركات النسائية أن تكون منتجة؟
1- اتصال شخصي مع K.S.Gopal وهو محلل ومخطط للتنمية. حيدر آباد، الهند.
2- نفس المرجع.
3. طلبت وزارة الدفاع الأمريكية 379.347.000.000 دولارا أمريكيا للسنة المالية 2003 من فضلك انظر
www/defenselink.mill
4. C. Rammanogar Reddy, “The Road to Ruin”, in The Hindu, May 25, 2002.
5. C. A. Chamdraperuma, The Years of Terror: the JVP Insurrection 91987-89), Colombo: Laka House.
6. Kumudini Samuel, 1999, Women and Armed Conflict in Sri Lanka, unpublished monograph
7. Anuradha M Chenoy, 2002, Militarism and women in South Asia, New Delhi, Kalli for Women.
8. Sitraleg Maunaguru, 1995, “Gendering Tamil Nationalism; The Contruction of Women in Projects of protest and Comtrol” in pradeep Jegannathan and Qadri Ismail (eds.),
9. “Unmaking the Nation; The Politics of Identity and History in Modern Sri Lanka”, Colombo: Social Scientists Association. pp. 158-175.
10. Kumudini Samual, “(Gender Difference In Conflict Resolution; The Case of Sri Lanka”, in Skhelsblk, Inger & Dan Smith, eds. 2001. Gender, Peace and Confilct. London: SAGE.
11. يتم تحديدها حاليا بواسطة القوانين العرفية للجماعات الدينية المختلفة، مما يخلق اختلافات شاسعة بين حوق نساء الهندوس و المسلمين والمسيحيين و البارس
12. Vishwa Hindu Parishad (World Hindu Forum).
13. Rashtriya Seva Sangh (Hational Service League).
14. Ratna Kapu and brenda (Cessman, 1999, “On Women, Equality and the Constitution: Through the Looking Glass of Feminism”, in Nivedita Menon (Ed) Gender and Polities in India, Delhi: Oxford University Press.
15. Nivedita Menon, “Rights. Bodies and the Law: Rethinking Feminist Politics of Justice”, in nevedita Menon (ED) Gender and Polities in Indian, New Delhi, Oxford University Press, 1999.