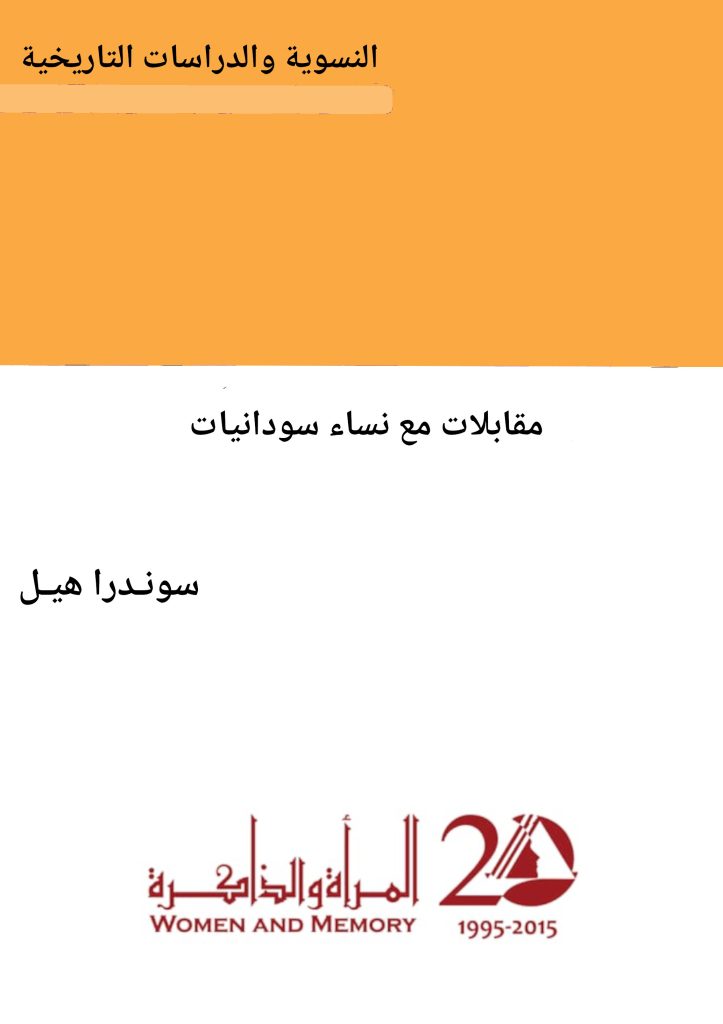المنهـج النسـوي والسيـرورة والنقد الذاتـي:
مقابلات مع نساء سودانيات *
أقوم في هذه المقالة بتحليل موقف منهجي وأيديولوجي معين، وهو موقف أكثر تعقيدًا مما توحي به عبارة آن أوكلي Ann Oakley التي تصف فيها عملية إجراء المقابلات (interviewing) مع النساء بأنها “تناقض منطقي” ( “contradiction in terms”).1 وهذا التعقيد هو نتاج تراكم تحولات في المنظومات الفكرية والاتجاهات الأيديولوجية. ليس الفكر النسوي المسئول وحده عن تشكيل صراعي بوصفي امرأة غربية بيضاء تتعامل مع قضايا الإمبريالية الثقافية، والتمركز العرقي (ethnocentrism)، والوفاء، والغدر، والتخلي، والاحترام، والحقيقة، في البحث الأنثروبولوجي من أجل النساء وعنهن. كانت هذه سيرورة (process) طويلة الأجل، ثمرة أعوام من التغير السياسي/ الشخصي، ونتيجة سنوات عديدة من “البحث الميداني” (“fieldwork”) في شمال السودان. بعد وصف سريع لهذه السيرورة، سوف أقوم بتحليل مقابلة/ قصة تاريخ شفهي حديثة أجدها تعطي أبلغ مثل على التناقضات، والمفارقات، والمعضلات، والمشاكل التي واجهتني. وفي النهاية، أكتب خلاصة هذه المقالة في شكل بعض الأسئلة عن مدى قابلية المنهجية “النسوية” (feminist” methodology”) للتطبيق حين نجتاز التخوم العنصرية والطبقية والثقافية. وآمل أن تتم قراءة هذه المقالة بوصفها قبل كل شيء– نقدًا لتناول “السيرورة النسوية” (“feminist process”) بطريقة واحدة لا تنوع فيها ونقدًا لسيرورتي أنا شخصيًا كذلك.
تمتد فترات إقامتي في السودان عبر تسعة وعشرين عامًا، وتشمل سبع رحلات تُكَوِّنُ معًا ست سنوات من الإقامة. وفي الرحلتين الميدانيتين الأخيرتين (عام ١٩٨١ بهدف استقصاء مشاركة النساء في القوة العاملة الحضرية، وفي عام ١٩٨٨ لبحث تأثير حكومة “التيار الإسلامي” على النساء) كنت استخدم أساليب التاريخ الشفهي التي نشير إليها نحن الباحثين في الأنثروبولوجيا، بالمقابلات الميدانية (field interviews).2 وعملية إجراء المقابلات – مثلها مثل العمل الميداني الأنثروبولوجي بشكل عام– جعلتني أتوقف في مواجهة للأمور. إن مسألة “المفارقات الظاهرية (paradoxes) والتوقعات” التي تكتنف تجربة الباحثين الميدانيين في مجال الأنثروبولوجي قد أخذت حقها من الرصد والتسجيل على مدى العقدين الماضيين، لذا ليس هدفي هنا أن أقوم بنقد منهج “الملاحظة بالمشاركة” (“participant Observation”) والتمركز العرفي المتأصل في مفهوم “ممارسة العمل الميداني في وسط الآخر“.3
وآمل عبر استكشاف تلك الأفكار تأكيد أن المعضلات التي لازمتني طويلاً هي معضلات أخلاقية وشخصية بقدر ما هي أكاديمية وسياسية، تمامًا كما أن احتكاكي طويلاً بالسودان له طبيعة شخصية بقدر ما هي مهنية.
كان لعدد من التغيرات في الأطر المعرفية صلتها وأثرها على تجربتي في إجراء الأحاديث والمقابلات مع النساء في السودان. ففي أوائل الستينيات، حين ذهبت إلى السودان للمرة الأولى وشرعت في بحث حول تأثير التغيرات الاجتماعية والسياسية في النساء السودانيات، كنت دون أن أدري – وبلا أي حرج أو تردد – متشبعة بأفكار التحليل النفسي الفرويدي ومتأثرة بالفلسفة الليبرالية وبشيء من الإيمان بمبدأ المساواة بين البشر ورثته عن والدتي. وقد أخذت “المقابلات” – التي كانت كلها غير رسمية في هذه الزيارة الأولى– شكل حوارات مع مئات من النساء والفتيات، على مدى ثلاثة أعوام 4، وكانت في معظم الوقت عبارة عن تفاعلات حارة تدخل في باب الصداقة، شعرت من خلالها – كما جعلنني أشعر – بأنني أنتمي إلى جماعتهن (an insider). في ذلك الوقت، لم يكن لأية محاولة للإيحاء بغير ذلك إلا أن تقابل بعدم تصديق من جانبي، فقد كان الأهالي السودانيون لا يفتئون يجبرون خاطري بقولهم إنني لا أبدو أمريكية، كما كتبت الجرائد المحلية مشيدة بشخصيتي ومعلنة إياي مواطنة سودانية شرفية. وبدا لي ذلك أبلغ علامات القبول. فلقد جُنبت بوصفي أمريكية (أي غير بريطانية) من التصنيف في فئة المستعمرين أو حتى من المستعمرين السابقين. ولم يكن في ذلك الوقت مفهوم “المستعمر الجديد” (“neocolonialist”) قد أصبح دارجًا، فكانت حياتي في مدينة الخرطوم – التي – زالت في ذلك الحين تعمل بوصفها مستعمرة – حياة هنيئة، أتمتع فيها بمجتمع نسائي – يحيطني بالقبول والرعاية ويعاملني معاملة خاصة. في ذلك الوقت لم أكن على وعي كامل بمكانتي المتميزة بوصفى شخصًا من الصفوة، غير أنه كان في هذه المنزلة المرتفعة ما يشكل تجربة جديدة بالنسبة إلى واحدة مثلي تأتي من الطبقة العاملة، فلم يسعني وأنا بالبراءة التي كنت عليها وقتها إلا أن أستطيب هذه المكانة وأنعم بها، فكان كل تفكيري منصبًا على رغبتي في البقاء هناك إلى الأبد، وكان جزء يتمنى أن أكون سودانية.
لم يكن قد مر على استقلال السودان أكثر من خمسة أعوام حين وصلت هناك، وكان خدر النشوة المصاحبة لعصر القومية والوطنية مستشعرًا في كل مكان. وعلاوة على ذلك، شهدت هذه الفترة نهايات الثورة الجزائرية، وكان اليسار الدولي والقوميون واليساريون في العالم الثالث يجهرون بأفكارهم عن الاشتراكية، والاشتراكية الغربية، والاستعمارية، والإمبريالية، ومؤتمر باندونج، وما إليه. وكانت تلك الأفكار تدور رحاها على مسرح إحدى أكثر بلدان العالم فقرًا، كنت في أوان الرحلة الثالثة والرابعة – (۱۹۷۱– ۱۹۷۲) و(١٩٧٣ – ١٩٧٥)- قد أمضيت عدة سنوات من الدراسات العليا في قسم دراسات وأنثروبولوجيا أفريقيا، حيث كنت من نشطاء الجامعة ومتأثرة تمامًا بالحركة الطلابية وحركة الحقوق المدنية وأفكار اليسار القديم والجديد. ومن ثم، وجدت نفسي – للمرة الأولى – مضطرة إلى التساؤل عن مدى حقي في إجراء العمل البحثي في السودان، وفي المشاركة في تشييء (to objectify) – الناس[أي استخدام أهلها بوصفهم موضوعًا/ شيئًا للبحث.] عبر استخدام منهج المقابلة لصالح مستقبلي المهني، أو التساؤل عن حقى – من الأساس – في أن أكون على أرض السودان، ووجدتني مضطرة أيضًا إلى التساؤل عن قيمة المؤسسة الأكاديمية في حد ذاتها.
كانت كل المجلات العملية الأكاديمية تتعرض – وقتئذ – للمراجعة وإعادة التقييم، فكان من الطبيعي أن ينطبق ذلك على “دراسات وأنثروبولوجية أفريقيا“. وكان يقال عن الأنثروبولوجيا إنها “وليدة الإمبريالية” (“the child of imperialism”) وعن الباحث الأنثروبولوجي إنه “إمبريالي متحرج” (“reluctant imperialist”).5 وأصبحنا مجبرين على التفكير من جديد بطريقة أخرى في تاريخ هذا المجال وفي مبرر وجوده6 الذي يحيط به الشك. وظهرت بلاد السودان بصفتها مضمارًا بارزًا في سياق هذا الاتجاه النقدي، كما هو مثبت في مؤلف مهم بعنوان الأنثروبولوجيا واللقاء مع الاستعمار Anthropology and the Colonial Encounter، الذي حرره واللقاء الباحث الأنثروبولوجي السوداني طلال أسد.7 أدت مثل هذه المؤلفات إلى قيام العديد منا بالتساؤل عن المستفيدين – في حقيقة الأمر– من خدماتنا، فبدأت النظرة الرومانسية إلى دور الباحث الأنثروبولوجي بوصفه “مواطنًا أصليًا هامشيًا” (“native marginal”) تختفي، وتحل محلها اتهامات بالعنصرية والاستغلالية.8 أمام هذه التطورات وجدتني مضطرة إلى مواجهة العنصرية غير المباشرة التي تكتنف تعلقي الرومانسي بالسودان.
بدا وقتئذ أن الأوان قد آن لإعادة اختراع الأنثروبولوجيا.9 وهي عملية أخذت أشكالاً عديدة: كتابة تاريخنا من جديد، وإبراز ضرورة أن نقوم بخدمة الناس الذين يمثلون مادة بحثنا، وتحدي النزعة النخبوية في المؤسسة الأكاديمية، و“التطلع إلى فهم” الفقراء الذين لا حول لهم بدلاً من المداومة على تشييئهم 10، ودراسة ثقافتنا نحن (أي القيام بالعمل الميداني داخل الولايات المتحدة نفسها)، وكذلك تحري قدر أكبر من الصدق في كتابة التقارير عن تجربة العمل الميداني. ولعل أكثر ما يعنينا بالنسبة إلى القضايا التي تناقشها هذه المقالة هو هذا الوعي الجديد بأهمية مفهوم الذاتية (subjectivity)، وكذلك إدراك أنه لا يصح تجاهل دور الباحث نفسه بوصفه مجردًا من التأثير؛ وهما مسألتان قد نجمتا عن حركة نقد المدرسة الوضعية (positivism). وعلى وجه الإجمال، أصبحت ثمة دعوة لا يستهان بها إلى عمل أنثروبولوجي ينزع بقدر أكبر نحو مراجعة الذات ونقدها، ونحو قدر أكبر من المسئولية الاجتماعية، ونحو تأكيد أن المعرفة بأكملها إنما هي مسألة ذات بعد سياسي.11
كان لكل هذه التطورات الفكرية تأثير مهم في خواطري بشأن أخلاقيات مناهج العلوم الاجتماعية، وهي خواطر سبقت – وهيأت – المسرح لظهور مفاهيم “السيرورة النسوية” والمنهج النسوي بوصفه جزءًا من مفردات لغة نشاطي الفكري والسياسي. في أوائل الستينيات من القرن العشرين، كان ما آمنت به طوال حياتي من مبدأ المساواة بين البشر ومن نسبية ثقافية (cultural relativism) يشكل دافعي إلى الالتزام باحترام مصادر معلوماتي في العمل الميداني، أو ما يطلق عليهم “المخبرين” (“informants”)، بما في ذلك الحرص على عدم كشف هوياتهم.12 أما في السبعينيات، وفي أثناء قيامي ببحث حول رد فعل أهالي النوبة تجاه ترحيلهم من مناطق سكناهم الأصلية، فكنت أحرص على إعلام الأشخاص الذين أجري معهم المقابلات بالغرض من بحثي بالكامل، كما أنني توقفت تمامًا عن الممارسات الآتية: (۱) “التحايل” (“tricking”) على الناس حتى يكشفوا ما بأنفسهم، (۲) تعمد إغوائهم في الحديث إلى أن تكشف أقوالهم عن تناقضات، (۳) استعمال “مخبر” حتى يعري أو يناقض “مخبرًا” آخر، (4) التلاعب بالناس بغرض الحصول على “الحقيقة” (“truth”) و“الوقائع” (“facts”). وبالرغم من كوني وقتها قد اضطررت إلى الحصول على إذن إجراء البحث من حكومة يحكم الشك نظرتها إلى أهالي النوبة، كنت مع ذلك أحاول تحري الصدق مع الجميع فيما يخص بحثي، وأفترض أن مسئوليتي الأولى تتمثل في خدمة مجتمع أهالي النوبة.13 برزت أمامي مشكلة إذ تنبهت إلى وجود قطاعات من “المجتمع النوبي” تتنافس فيما بينها، فيما آل إلى أول معضلة أخلاقية رئيسة أواجهها في بحثي من جراء “اكتشافي” أن هذا التشديد على عرقية نوبية (Nubian ethnicity) مهددة في وجودها – التي كنت معنية بتحليلها – كان وراءه – بشكل جزئي – نوع من التلاعب بمسألة الهوية العرقية النوبية من جانب الطبقة العليا النوبية، واستخدامها لهذه الهوية بغية تحقيق مكاسب سياسية/ اقتصادية لهذه النخبة. وتجدر الإشارة إلى أن معظم مَن كنت أجري معهم المقابلات كانوا ينتسبون إلى “الطبقة العاملة” أو إلى صغار المزارعين والتجار القدامى، بينما كان معظم النوبيين الذين قاموا باستضافتي، والذين كان واحد منهم كفيلي، وبالتالي المسئول أمام الحكومة عن سلوكي، كانوا ينتمون جميعًا إلى الطبقة العليا.
كانت الأسئلة المتعلقة بانتماء الباحثة إلى المجتمع محل الدراسة من عدمه تلازمني باستمرار في تلك الفترات من إقامتي لأغراض البحث في السودان في من السبعينيات من القرن الماضي. غير أنه ربما كان من أعمق تأثيرات حركة نقد المدرسة الوضعية في الستينيات والسبعينيات أنها جعلتني أرى أنني أنا – في حد ذاتي – أمثل جزءًا من المشكلة، فقد أدركت أن “نتائج” البحث متأثرة بوجود الباحثة أساسه، وبالتالي لم يكن ثمة إمكان للموضوعية.
وغني عن القول، أن الموقع الاجتماعي والتاريخي الذي كنت أحتله في مواجهة الطبقات والمؤسسات والدولة القومية (nation – state) السودانية كان له تأثيره العميق في مقاربتي لدراسات السودان، وبالتالي كانت أية ادعاءات من جانبي بالموضوعية قد اعتدلت حدتها إنْ كانت قد تواجدت أساسًا. فقد كنت أعرف أنه ليس بوسعي أن أكون “ملاحظة موضوعية“، إذ إن كل مقابلة – كل حلقة في مسلسل الملاحظة، كل شكل وجوهر في تجربة الملاحظة بالمشاركة – كانت متأثرة بالتجارب التي عشتها فعلاً، وبالأشكال التي يراني بها الآخرون، وبأن معظم ما لدي من معرفة قد نشأ عن معيشتي هناك وتأديتي بلا شعور للأدوار المخصصة لي داخل شبكة معقدة من العلاقات الاجتماعية (دور المدرِّسة، ولاعبة التنس الشهيرة، وموضع أسرار الناس، والباحثة، والوجه الاجتماعي المعروف). لم يكن وجودي بارزًا للعين فحسب، وإنما كنت أيضًا أعد أحيانًا شخصية مثيرة للشكوك، فلم يكن الأمر يخلو من تساؤلات العديد من السودانيين عن سر ما يبدو علي من ولع بالسودان إلى هذه الدرجة.14
أصبح الآن أمرًا معتادًا أن نتكلم عن لحظات التشاؤم أثناء العمل الميداني، حيث تتفاقم مشاعر العجز والقصور بفعل تشككنا المتواصل في أنفسنا وفي قيمة إسهامنا وفي صلاحية المعلومات والبيانات التي نجمعها، وفي مدى أخلاقية المسألة برمتها15. ومع ذلك، وبرغم كل الحساسية المكتسبة حديثًا – فيما يخص القضايا الأخلاقية والسياسية المتعلقة بعملية البحث – التي تأثر بها الباحثون الأنثروبولوجيون (أو الباحثات) الجدد ذوو التوجهات التقدمية (وآخرون غيرهم) في أواخر الستينيات من القرن العشرين، برغم كل هذا، استمرت لدينا تصورات تجعلنا نستحسن وجود قدر من المسافة بين الباحث وموضوعه، ونرى أنفسنا – نحن طلبة وطالبات العلوم الاجتماعية – أهل الخبرة والموثوقية في مجالنا، ونثق في وجود حقيقة – أو على الأقل بعض القواعد الكونية (universals) – “في مكان ما تنتظر أن نكتشفها“. وفي حين كنا نتكلم عن إدماج النظرية والممارسة، كنا نولي عنايتنا إلى البعد النظري، ونعده مستقلاً عن التجربة، والأيديولوجيا، والرأي، وأساليب البلاغة، والعاطفة.
في حالات معينة قدمت لي النظرية النسوية والمنهج النسوي والأيديولوجية النسوية طرقًا جديدة في النظر إلى العمل البحثي، بينما في حالات أخري كان العمل البحثي النسوي يقوم على استراتيجيات البحث المذكورة أعلاه. كانت المناهج أو الاستراتيجيات التي استجدت علي في أواخر الستينيات من القرن العشرين – والتي نمت إلى معرفتي من خلال النسوية – تتضمن رفع الوعي والنقد/ النقد الذاتي، والعمل التفاعلي في مجموعات صغيرة (small – group process)، وهي تشكل في مجموعها ما يشار إليه باسم “السيرورة النسوية” (“feminist process”). وفي الواقع، كان العمل على رفع الوعي منهجًا يساريًا على قدر كبير من النفوذ والتأثير عرف طريقه عبر اليسار إلى النسوية.
إن عدة تحديات لأساليب التفكير المتعارف عليها قد ظهرت؛ إما في تاريخ يسبق نشأة النظرية والمنهجية النسوية أو نشأت معها. فقد أخذ المشككون (skeptics) يطعنون في صحة المقابلات التي تُجْرَى وفق منطق التضاد الثنائي (binary oppositions)، كما طعنوا في التفكير بمنهج الشيء ونقيضه، ومن أمثلته: ذات/ شيء أو فاعل/ مفعول به (subject/ object)، منتمي/ خارجي (insider / outsider)، جماعة، الداخل/ جماعة الخارج أو جماعتنا/ جماعتهم (in-group/ out-group) الملاحِظ/ الملاحَظ (observer/ observed)، القاهر/ المقهور (oppressor/ oppressed). كذلك أثيرت الاعتراضات على السيرورة المستقيمة التي يجري عبرها تصوير أعضاء جماعة الخارج على أنها تسعى إلى استمثال جماعة الداخل، على طريقة تصوير “الشرقي” الصائر إلى غربي. ثم في تطور آخر له أهمية بالنسبة إلى المشتغلات بالنظرية والمنهجية النسوية، بدأت ظاهرة شروع الباحثة (أو الباحث) الخارجية في “كتابة ردها“، بوصفه رد الفعل تجاه استمرار أهل الغرب على مدى عدة قرون، في الدراسة والكتابة نيابة عن بقية العالم، وهي ظاهرة أعلنت بدء أوان محاولات تقويض “الاستشراق“، أوان ملاقاة نظرة الغرب على قدم المساواة، كما سيأتي قريبًا أو أن ملاقاة نظرة الذكور.16 وأثير السؤال حول من له (أو لهم) سلطة التكلم باسم أية جماعة بوصفه ممثلاً لهويتها وأصالتها، وكيف أثر التعريف الذاتي للهوية (self – identifications) كما أعربت عنها الجماعات التي تعامل بصفتها مختلفة – في تشكيل البحث وتحليلاته. جاء الاعتراف بوجود أبعاد متعددة للهوية والأيديولوجية يرافقه إقرار بأننا كلنا لدينا إنشاءات أو تأويلات للواقع تتشكل بوسائط اجتماعية (socially meliated)، تختلف فيما بينها.17
أخذ عدد معتبر من الباحثات النسويات يرفضن النزعات الوضعية والتجريبية، منددات بفكرة التركيز على المنهج (method) وإعطائه مكان الصدارة، مؤكدات في الوقت نفسه شرعية وأهمية مسألة كيف يتم عمل الشيء، ومعززات قيمة الوسائل أكثر من الغايات، السيرورة (process) قبل المحصلة (product). وقد وضعت رينات دويلي كلاين Renate Duelli Klein الإصبع على أهمية الذاتية الواعية (conscious subjectivity)، أو التجربة الذاتية لكل امرأة، والتي أضافت إليها مارشا وستكوت Marcia Westkott مفهوم التفاعل بين الذوات (intersubjectivity)، الأمر الذي يستدعي من الباحثة أن تعقد مقارنة بين عملها وتجاربها الشخصية بوصفها امرأة وعالمة، وتشارك المرأة – موضوع البحث – في ما توصلت إليه من نتائج وأفكار، لعل المرأة بدورها تحدث تغييرًا في البحث عبر إضافة رأيها الشخصي.18
كما تشدد رينات دويلي كلاين على أهمية “التصنع أو التظاهر” (“faking”)، وهي العملية التي تسعى الأبحاث التقليدية – عادة – إلى تجنبها، ويبتكر الباحثون الحيل للتخلص منها. و“التظاهر” هو إعطاء إجابات مستحسنة اجتماعيًا، ولي أن أضيف أنها إجابات “لائقة سياسيًا” (“politically correct”) (أيْ: إجابات تتصور الراوية أن المستمع ينشدها)، بدلاً من إعطاء إجابات “صادقة“. فتذكرنا رينات دويلي كلاين بأن التظاهر ما انفك يمثل للنساء وسيلة ضرورية من وسائل البقاء، وأنه يعد مسألة لابد من أخذها على محمل الجدية وإدراجها داخل أبحاثنا بوصفها ظاهرة للدراسة.
إن صفة الدينامية تسم الشيء الكثير مما تقتضيه المنهجية النسوية: السيرورة غير القابلة للقياس. فالمرأة (بوصفها “صاحبة المقابلة” “interviewee”، أو “الراوية” “narrator”، أو المؤرخة الشخصية لحياتها، أو كاتبة سيرتها الذاتية) لابد من تشجيعها دائمًا على أن تكون نفسها، ليس فقط بمعنى أن تكون صادقة وأمينة وإنما أيضًا بمعنى ألا تظل مجهولة الهوية، حتى تصبح الذات الفاعلة في حياتها، فتعبر عن مشاعرها، وتحكي عن تجاربها الشخصية، وتعيد اختراع نفسها، وتعيد اختراع التاريخ (ولاسيما أن تدفع بنفسها إلى داخل التاريخ)، وتأخذ بزمام المبادرة بالفعل. وعلى هذا النحو، فلن تكون إجاباتها ملائمة دائمًا لأسئلته، (أيْ الأسئلة التي يصوغها الرجل) ولا لأسئلتنا “نحن“.
إن هذه الطبقات المذكورة أعلاه المكونة من تحولات في الأطر المعرفية، ومن ثم في المنهجيات، شَكَّلَت “نموذجًا“، وخليطًا من عناصر شتى في ذهني، وكان هذا المثال الأعلى هو ما قاربت من خلاله عملية إجراء المقابلات في الخرطوم بالسودان عام ١٩٨٨. وقد أثارت لدى هذه التجربة فيما بعد أفكارًا حول نوع آخر من الإمبريالية الثقافية: فرض “السيرورة النسوية” على المقابلة العابرة للحدود الثقافية.
اتجاهات نسوية متباينة: مقابلة مع فاطمة أحمد إبراهيم 19
أناقش فيما تبقى من هذه المقالة أحد أمثلة صراعي مع المركزية العرقية، والإمبريالية الثقافية، والبحث الأكاديمي “النسوي“. إن بطلة/ راوية هذا الموقف هي فاطمة أحمد إبراهيم، وهي بطلة شعبية في السودان يشار إليها بوصفها “باسيوناريا السودان“(“the Sudanese Pasionaria”)[ بالإضافة إلى المكتوب في هامش ۲۰ عن الباسيوناريا (أي زهرة العشق)، تجدر الإشارة إلى أنها أيضًا كانت مناضلة ثورية شيوعية تولت فيما بعد زعامة الحزب الشيوعي الأسباني على مدى يقارب ثلاثة عقود بدءًا من الستينات من القرن العشرين.] بفضل دورها في الإطاحة بالنظام الديكتاتوري العسكري عام 1985، 20 وقد ظلت – بصفتها الناشطة القيادية في التنظيم النسائي الرئيس المسمى بالاتحاد النسائي على مدى ثلاثين عامًا – أكثر مناضلة سياسية بروزًا للعين، وكانت بوصفها عضوة في الحزب الشيوعي السوداني، تقف في طليعة جميع المبادرات الجماعية التي نفذت ضد شتى الحكومات القمعية، وقد دخلت السجن مرات عديدة، وقضت سنوات قيد الإقامة الجبرية في منزلها. كما أن زوجها الشفيع أحمد خليل، الذي كان نائبًا لرئيس الاتحاد العالمي لنقابات العمال، قد أعدم على يد الحكومة العسكرية السودانية في عام 1971، بسبب دوره المفترض في محاولة قلب نظام الحكم الديكتاتوري لجعفر النميري. وقد تم حظر نشاط الاتحاد النسائي أغلب فترة حكم النميري الممتدة من عام 1969 إلى 1985، مما أسفر عن نشاط سري ومحدود اقتصر عليه الاتحاد النسائي لعدة سنوات. وبعد الإطاحة بنظام النميري في عام 1985، عادت الأحزاب والمنظمات السياسية إلى وضع قانوني وعادت فاطمة للظهور باعثة الحركة من جديد في الاتحاد النسائي.21
كان إجراء مقابلة فاطمة أحمد إبراهيم يمثل هدفًا من أهداف ذهابي إلى السودان عام ١٩٨٨، ولذلك كنت أتوق إلى الحصول على موافقتها على أن أتولى كتابة سيرتها، وبخاصة أن الكتب التي تتناول التواريخ الشفهية للشخصيات السياسية من نساء الشرق الأوسط وإفريقيا تُعَدُّ قليلة إن وجدت أصلاً، ولذلك نجد أن تلك النساء المشهورات لم يكتب عنهن الشيء الكثير ولا حتى باللغة العربية. ومن هنا، كنت آمل أن أقدم إسهاما في دراسات السودان والدراسات النسوية عبر إلقاء الضوء على حياة ونشاط واحدة من أكثر نساء الشرق الأوسط المعاصرات شجاعة وشهرة. فضلاً عن أن فاطمة كانت تمثل بالنسبة لى مصدرًا مهما للمعلومات عن علاقة النساء بالشريعة الإسلامية وعن تأثيرات صعود التيار الإسلامي، كما شعرت كذلك أن بوسعها الإسهام بقدر عظيم في ما كنت أقوم به من تقديم العلاقة بين (النوع) والحركة الشيوعية/ الاشتراكية في السودان.
بعد سنوات طويلة من صمتٍ فرضته على نفسي (بسبب رغبتي في أن أتجنب الظهور بمظهر من يقدم على الخيانة أو الإقدام فعلاً على خيانة اليسار السوداني دون عمد من جانبي)، قمت أخيرًا بنشر مراجعة نقدية لعلاقة الحزب الشيوعي السوداني بالاتحاد النسائي، زعمت فيها بأن الحزب كان يسيطر على المحتوى الأيديولوجي للاتحاد، فيما أدى إلى تضييق نطاق حركة الأخير وإحباط العديد من المطالب النسوية.22 وبالرغم من أن مقالتي عن الحزب الشيوعي السوداني والاتحاد النسائي كانت قائمة على سنوات من المحادثات مع اليسار السوداني، فلم أكن قد أجريت أيَّ لقاء مع فاطمة، ولذلك كنت مع حاجة إلى سماع وجهة نظرها، لاسيما فيما يخص العلاقة بين الاتحاد النسائي والحزب الشيوعي. ربما كانت لدي رغبة في أن “يثبت” لى خطأ فكرتي عن هيمنة الحزب على الاتحاد وما نتج عن ذلك من ركود في قضايا النساء، وأعتقد أنني كنت آمل أن أسمع فاطمة تؤكد لي أن الاتحاد النسائي يمارس فعلاً النقد الذاتي، وأنه منفتح على الأفكار الجديدة ومستقل عن الحزب الشيوعي، فكان موعدي مع فاطمة لإجراء مقابلة معها يهيمن عليه انتظار من جانبي؛ ليس فقط أن تزودني بمعلومات قيمة بالنسبة إلى مختلف أغراضي البحثية، وإنما أن تنيرني علمًا بدور النساء في المجتمع النسائي. كنت آمل أيضًا أن تحفز تفكيري بشأن عدد من التناقضات الفكرية والسياسية، وأنها بتسكينها لبالي عن الدور القيادي لنساء العالم الثالث في تحرير النساء بشكل عام سوف تسهم في إعادة تعريف مفاهيم النسوية المعهودة لدي. باختصار، كنت أنتظر من فاطمة أن تكشف لي ليس فقط عن دورها بوصفها منظّرة مجددة في إطار الحركة النسائية السودانية، وإنما عن نجاح الاتحاد النسائي ونزاهته، مع أنني كنت – بالطبع – أتوقع أيضًا أن تعادل كفة أقوالها في هذا الاتجاه بنقد ذاتي وتقييم نقدي للمنظمة. ولكن فاطمة – كما يمكن أن نتوقع– لم تكشف لي إلا عن الجوانب التي وجدت في الكشف عنها أمرًا لائقًا استراتيجيًا، مما جعل من أسلوبها في عرض حكايتها أمرًا تمهلت أمامه.
كان للقائي بفاطمة فضل تسليط الضوء على عدد من القضايا المتعلقة باستخدام طريقة واحدة في مقاربة التاريخ الشفهي النسوي. فماذا نفعل – على سبيل المثال – حين لا تكون راوية التاريخ الشفهي “نسوية” حسب طرق فهم النسويات الغربيات لهذه الكلمة؟ ما المشاكل التي تبرز حين تستخدم الراوية أساليب في التواصل وفي العرض تترجمها المستمعة بوصفها أساليب “ذكورية“؟ أي كما في حالة فاطمة، ما المشاكل التي تظهر حين تكون الراوية “نسوية” من حيث الأيديولوجية والأهداف، ولكنها تستخدم منهجية أو مسارًا على النقيض من مذهب المستمعة (interviewer) في النسوية؟ وتزداد هذه المشكلة إزعاجًا إذا أخذنا في الحسبان كيف في مبادئ التدريس (pedagogy) النسوية الغربية، وفي المنهجية والنظرية النسوية، غلب أن تهيمن السيرورة على المحصلة.
كان قد قيل لي في وقت سابق أن فاطمة لن توافق على قبول مقابلة مع أمريكية، وبخاصة أن موقفها العدائي تزايد نحو أمريكا بعد أن قوبل بالرفض طلبها تأشيرة دخول للولايات المتحدة في عام 1985. ولذلك، جاءت موافقتها على المقابلة مثارًا لدهشتي وسروري. وكان لقاؤنا الأول عبارة عن محادثة غير رسمية؛ حيث منحتني فاطمة الإذن بأن أكون كاتبة سيرة حياتها. واتفقنا أن أطرح عليها بعض الأسئلة المبدئية لتكوين خلفية عامة، وأن أقوم بجمع المادة الحقيقية المطلوبة لكتابة سيرتها في رحلتي التالية إلى السودان. وحيث إنها وافقت كذلك على أن أجري معها أحاديث تتعلق بموضوع بحثي الجاري وقتها عن النساء وصعود التيار الإسلامي، فقد أعطيتها قائمة أسئلة واتفقنا على موعد للقاء في وقت آخر. عندما التقينا لإجراء المقابلة الرسمية، بدأت اللقاء بمحاولة أن أحكي لها عن نفسي بعض الشيء، متحرية الصدق – ما في وسعي– عن تجاربي في السودان، وعن مواقفي السياسية وآرائي النسوية. أردت كذلك أن أحكي لها عما أراه في مشروع بحثي من نقاط ضعف وثغرات، ولكنها لم تبد اهتمامًا. قد تكون قد تحرت عني عبر أصدقائنا المشتركين، وعرفت ما يكفي لجعلها على استعداد للحديث معي، وربما أيضًا كان حديثي قد أعطاها من المعلومات القدر الذي شعرت أنه يكفيها.
بدأنا إذن جلستنا، ولم أتمكن إلا من طرح سؤال واحد فقط بخصوص توقيت قيام الديكتاتور العسكري السابق جعفر النميري بفرض الشريعة الإسلامية في عام ۱۹۸۳، قبل أن تبدي في شيء من الاستنكاف إجابة تقليدية ليس فيها جديد، مفادها أن ذلك ما كان يمثل سوى فرصته الأخيرة للبقاء في السلطة، ثم اتخذت من السؤال مناسبة للانتقال إلى أجندتها الخاصة بأن خرجت بأسباب أخرى: “كانت تيارات المعارضة العامة قوية، لاسيما الإخوان المسلمون.. كان الإخوان قد فشلوا في ضم النساء التقدميات تحت مظلة الإسلام. وكان هذا هو السبب في فشلهم“. بهذه الإجابة، وبدون أن تلتقط أنفاسها، شرعت في مناقشة إنجازات الاتحاد النسائي، وهو الموضوع الذي هيمن على بقية المقابلة.
على صعيد المحتوي، كان من الممكن أن تصبح مقابلة من ثلاث ساعات تحكي لي فيها المرأة التي تُعَدُّ التجسيد الحي للاتحاد النسائي عن هذه المنظمة، بطريقة تنطوي على تجربة زاخرة بما هو مفيد. غير أنني في بعض المجالات وجدت صعوبة في مع التعامل أساليب فاطمة التي لم أكن مستعدة لها، ولاسيما في ضوء سيرورة العمل التي كنت معتادة عليها. فهي لم تكن تعطي إجابات مباشرة على أسئلتي، وكانت لها أجندتها الخاصة التي تتحرك وفقًا لها، وربما كانت أيضًا تتعمد إعطائي معلومات مضللة، كما كانت عن قصد أو من دونه تحاول التلاعب بعواطفي، وتبدو لها نبرة غير ديمقراطية أو نبرة وعظ وتعالٍ تجاه كثير من الشخصيات التي ذكرت أسماءها، من منافسات، وأخوات في المنظمة، ونساء من الطبقة العاملة أو الفلاحات. وفضلاً عن ذلك، بالرغم من أنني كنت قد سعيت إلى إرساء نيرة من النقد الذاتي أثناء نقاشي عن بعض الجماعات اليسارية والنسوية في الولايات المتحدة، لم يحدث أن صدر منها أي نقد ذاتي في أية لحظة. وجاءت إجاباتها تنزع إلى تعظيم إنجازات الاتحاد النسائي والحزب الشيوعي السوداني، بشكل استدعى إلى ذهني أسلوب الخطابة الذي تتميز به أدبيات المنظمتين. وفي حين كانت مطبوعات الاتحاد النسائي تزعم أنه صوت النساء العاديات، يتحدث باسمهن وإليهن، ظلت فاطمة تستخدم باستمرار “نحن” في إشارة إلى النساء المتعلمات عضوات الاتحاد، و“هن” في إشارة إلى النساء “المتخلفات“: “بالرغم من أننا [نحن نساء الجبهة المتعلمات] نعرف ما هي احتياجات النساء، من الأفضل دائمًا أن نستمع إليهن يَذْكُرنَها مع أنهن جاهلات“.
في الواقع، كما يبدو من هذا الاستشهاد، كانت فاطمة تفصل نفسها – في أكثر الأحيان– عن أغلب نساء السودان الأخريات، كذلك حين كنا نناقش حركة حقوق النساء عام 1965 ذكرت أنها كانت مع الاتحاد يؤيدان مبدأ الأجر المتساوي عن العمل المتساوي؛ بالرغم من أنه كان من المزمع تطبيقه فقط على خريجات الجامعة والمدرسات. وحين أقحمت جملة افترضت فيها “أننا” (هي وأنا وأية نسوية أخرى) لدينا موقف ناقد للذات تجاه الفشل في مد هذا الحق إلى نساء الطبقة العاملة والفلاحات، وأننا نرى هذا الموقف – بالطبع – مسألة اضطرارية يؤسف لها، ما كان منها إلا أن قابلت ما قلته بالتجاهل. وكانت فاطمة على العقيدة الآتية: “يجب أولاً أن نعلمهن [النساء العاديات]. وإن لم يقتنعن بذلك، فليس بوسعي أن أفعل ذلك نيابة عنهن“. وأشارت إلى لجوئها إلى الحيل حتى تدفع النساء للقيام بشيء ما، من قبيل أن تنظم لهن دروسًا في الحياكة والتفصيل حتى يتعلمن مبادئ القراءة والكتابة.
وبالرغم من تكرار إثارتها لذكر “قضايا المرأة” فلم يحدث أبدًا أن وضحت المقصود بالكلمة؛ حتى وهي تناقش الانشقاقات داخل المنظمة حول “قضايا المرأة” مقابل “السياسة القومية“، ولا وضعت أبدًا موضع السؤال هذا التعارض المفترض بين الشقين. وطبقًا لفاطمة، كان ثمة نساء داخل الاتحاد لا يجدن عمل المرأة في السياسة القومية أمرًا لائقًا، أما هي فكانت تنتمي إلى الفصيلة التي تحث على مشاركة النساء في الحركة السياسية القومية. وحين طلبت منها أن تعطي تعريفها “القضايا المرأة“، ما كان منها إلا أن تجاهلت السؤال.
اتخذت فاطمة – على الأقل خلال المقابلة – موقفًا غير نقدي إزاء الحزب، الشيوعي السوداني، من حيث علاقته بالاتحاد النسائي. وقررت عدم وجود تناقضات بين الحزب والاتحاد أو اختلافات حول قضايا النساء، وأن الاتحاد مستقل تمامًا، وأن نساء الحزب لم يخلطن – بالمرة – بين شئون الحزب وشئون الاتحاد. وألمحت إلى خلاف داخل الحزب غادرت في إطاره بعض النساء الحزب، ولكنها لم تشأ أن تشرح سبب الخلاف. وبينما كان من الممكن تفهم بعض أسباب مراوغتها فيما يخص الحزب الشيوعي، كنت قد اخترت بعناية الأسئلة التي أطرحها عليها؛ بحيث لا تتعارض مع اعتبارات استراتيجية في تنظيم الحزب.
وبالرغم من أن نشاط الحزب لم يكن محظورًا وقت المقابلة – وأن قياداته كانت معروفة للجميع – أغفلت فاطمة ذكر زميلاتها، حتى حين كنت أستحثها على ذكر أسماء أعرفها لكي أصل إلى فهم ديناميات النشاط والعلاقات داخل الاتحاد. فقد كانت تستخدم “نحن” في وصفها لإحدى المظاهرات أو الانتخابات أو لوفد ما، ولكن دون أن تفصح عن الهويات التي تشير إليها كلمة “نحن“. وحين نسبت لنفسها معظم فضل الزعامة في كل الأحداث الحاسمة، حتى وهي تحكي عن فترات كانت وقتها داخل السجن أو رهن الإقامة الجبرية، فقد كان في ذلك تقليل من شأن دور شخصيات أخرى بالغة الشهرة والأهمية. وحين سألتها إنْ كان ثمة كوادر جديدة صاعدة كانت إجابتها بالنفي ولغتها الجسدية لا تسمحان بأي اعتراض من جانبي، وتجاهلت فاطمة الملحوظة التي أبديتها عن وجود عديد من الوجوه الشابة كنت قد شاهدتها خلال مناسبةٍ عَقَدَهَا اليسارُ منذ فترة قصيرة. وأخيرًا، حين سألتها إنْ كان ثمة شريحة جديدة، لاسيما من بين العضوات الشابات في الاتحاد النسائي، تنادي بأفكار جديدة وتدفع المنظمة في اتجاه مختلف، ردت بأن وصفت الرعاية الفائقة التي تشمل بها الأعضاء الجدد، من قبيل حرصها على اصطحاب العضوات الشابات إلى بلدات أخرى حيث تلقي خطاباتها وتترك لهن حرية التعبير عن أفكارهن وآرائهن.
وفيما يخص “منافساتها“، وما يخص مسألة الانشقاقات داخل الحزب، لم تبد فاطمة إقرارًا بالاختلافات الشرعية أو تقبلها؛ بل فعلت ما وجدته يشكل هجومًا شخصيًا على منافساتها بالاسم، أو أبدت استخفافًا أو ذمًا في العضوات اللواتي لهن رؤية أخرى لقضايا النساء. فقد تحدثت بمرارة – على سبيل المثال– عن الأموال التي منحتها الحكومة السودانية وبعض الوكالات الأجنبية إلى عائلة البدري (التي يدير أفرادها جامعة الأحفاد للبنات ويُعَدُّون من الليبراليين المناصرين لحقوق النساء) من أجل دعم العمل في قضايا النساء، متهمة إياهم بالخطأ في اختيار القضايا واستراتيجيات العمل، وبالاستيلاء على أموال المنح لأنفسهم. وعلى المنوال نفسه، حكت كيف عارضت عضوتان في الاتحاد – في عام 1965 حين كان الاتحاد يضع البرنامج السياسي لحقوق النساء – الدعوة إلى منح المرأة فترة أربعة شهور كأجازة وضع مطالبتيْن بأسبوع واحد فقط، وحين حاولت أن أدفعها إلى الاستفاضة في شرح حجج العضوتين – وهن من النسويات المعروفات– لم تفعل فاطمة إلا العزف على لحن كثيرًا ما كررته عن أن مثل هؤلاء النساء لم يكن أكثر من مغفلات يسيطر عليهن الرئيس جعفر النميري.
كانت فاطمة تلجأ كثيرًا إلى هذه الطريقة من إطلاق النعوت في التعامل مع خصومها السياسيين، فقد استخدمت مثلاً لقب “الأخوات المسلمات” (أي عضوات في تنظيم الإخوان) للإشارة إلى أسماء بعينها لنساء ليبراليات، فيما يعني أنهن من التيار الإسلامي الأصولي أو من التيار السياسي الرجعي. وحين أبديت دهشتي إزاء استخدامها هذه النعوت في الإشارة إلى امرأة معروفة من أصحاب الاتجاهات الديمقراطية، لجأت فاطمة إلى المراوغة قائلة “بأنها لم تكن قد انضمت تمامًا إلى التنظيم في ذلك الحين“. وبتفكيك هذه العبارة، استنتجتُ أن فاطمة كانت تحاول الإلماح إلى أن تلك المرأة كانت من الأخوات المسلمات في سريرة نفسها حتى في ذلك الزمن، وإنْ لم تنضم صراحة إلى صفوف تلك المنظمة الأصولية إلا فيما بعد، بيد أن أيًا من الأمرين لا يبدو لي وارد الحدوث.
لا تقتصر المعلومات المضللة التي تعمدت فاطمة – فيما يبدو أن تعطيني إياها – على هذه الأمثلة فحسب، فقد حاولت أيضًا التعتيم على النواحي الإيجابية في دستور 1973 (في عهد النميري)، وسعت إلى تبرير اختيار الاتحاد للنضال في سبيل الحقوق السياسية، معطيًا إياها الأولوية فوق الحقوق الاقتصادية (إنْ كان يجوز الفصل بينهما)، بدعوى أن “غالبية النساء من ربات البيوت“. وقد أثار قولها استغرابي وبخاصة أني لم أكن أتوقع من أبرز نسويات السودان أن تدلي بمثل هذا القول عن دور النساء الاقتصادي في السودان، حيث كل امرأة من النسويات السودانيات وكل شخص من المهتمين (أو المهتمات) بالسودان لديه إلمام بوجود نسبة مرتفعة من النساء العاملات بالزراعة، واللواتي يوظفن في الصناعات المنزلية الصغيرة (cottage industries)، أو يعملن على مقربة من منازلهن، أو يقدمن خدمات شخصية، لا تدخل في الإحصائيات.
ولعل فاطمة قد افترضت أن لي آراءً ذات وجهة معينة، بوصفي قادمة من الغرب، في مسألة ختان الأنثى، ولهذا أثارت ذكر هذه المسألة عدة مرات – بنبرة دفاعية – رغم أنني أتبع سياسة عدم مناقشة هذا الموضوع إطلاقًا في الولايات المتحدة، وأيضًا في السودان إلا إذا دُعيت إلى ذلك. قالت فاطمة إن “الختان يمثل العَرَض وليس المرض“، وعادت مرة أخرى إلى ذكر التعليم بوصفه حلاً لمشكلة الختان على المدى البعيد، وأبدت نقدًا شديدًا تجاه جميع النساء والجماعات النسائية العاملة على استئصال هذه العادة (مثل عائلة البدري المذكورة آنفًا). وقالت إن المشكلة قد أحيطت بالمغالاة على أيدي “قوى خارجية” (أي نسويات من الغرب)، ما أبديت حوله اتفاقي معها، بوصفي – أنا نفسي – أدعو إلى ترك هذه القضية ليتناولها أهل السودان، لا أحد غيرهم. وقد ساقت فاطمة حجة تؤسس أولوياتها: “إذا نظرنا إلى نسبة النساء اللآتي يلقين حتفهن بسبب الختان أو أثناء الولادة نجدها نسبة بسيطة للغاية، ولكن إذا نظرنا إلى عدد النساء اللآتي يمتن من الجوع، نجد نسبتهن كبيرة للغاية، أي الأمرين أهم إذن؟“. وبالرغم من أنني أبديت ما يوضح موافقتي، لم تلتفت فاطمة إلى ذلك، بل واصلت كلامها، كما لو أنني كنت أبدي اعتراضي.
بدا لي موقف فاطمة – على وجه العموم – إزاء “الثقافة التقليدية“، سواء كان ذلك في كتاباتها أو كان خلال مقابلتي معها، بدا لي يحمل تناقضًا. فقد كرست الكثير من وقتها وجهدها لشجب مسألة الزار، وهو طقس يمارس لطرد الأرواح الشريرة ولا يبدو فيه ضرر. وحين عرضت أفكاري عن الزار، ذاكرةً أن بعض النسويات يرين هذا الطقس شكلاً من أشكال المقاومة وممارسة تعبر عن تضامن النساء، لم تبد فاطمة اهتمامًا.۲۳ وبينما أشارت خلال المقابلة – وكذلك في كتاباتها – إلى ضرورة أن يقوم الاتحاد النسائي بمكافحة العادات التقليدية من قبيل الزار، جاء موقفها مختلفًا تجاه الإسلام، الذي قد يَعُدُّه البعض أمرًا ينتسب أيضًا إلى “الثقافة التقليدية“. ففاطمة تحسب قرار الحزب الشيوعي السوداني والاتحاد النسائي في الخمسينيات بالتعايش مع التوجه الإسلامي، بوصفه استراتيجية بالغة الفاعلية، و“عملاً عبقريًا” أدى إلى إنقاذ هاتين المنظمتين. فلأنها تعد الإسلام شأنًا شخصيًا، تعتقد أنه “ليس ثمة تناقض بين نضال [النساء] ومقاصد الإسلام الحقيقية“، غير أن محصلة هذا الموقف أن الاتحاد النسائي لم يجعل من تغيير قوانين الأسرة والأحوال الشخصية هدفًا له؛ بالرغم من تقييدها للنساء، الأمر الذي تقرُّ به فاطمة بسهولة، وذلك لأن هذه القوانين “وثيقة الارتباط بالدين“.
غاب عن النقاش حول الثقافة الإسلامية أيْ مناقشة حول العناصر الموجودة في الإسلام – مثل بعض جوانب شرع الأحوال الشخصية – التي يمكن استخدامها لتحرير النساء في مقابل العناصر التي قد تستخدم في قهرهن. ولست بصدد الإيحاء بأن فاطمة ليست واعية بما يحيط دور المرأة في الإسلام من تعقيدات، وإنما فقط أردت الإشارة إلى أنها ترى – فيما يبدو – حكمة استراتيجية في تبني موقف غير ناقد علانية، وفيما يبدو، ينطبق على المقابلة معي شروط العلانية. تمثلت إحدى معضلاتي – سواء كان ذلك بالأمر اللائق أم لا – في كوني قد وضعت في خانة المستمعة فحسب، فقد بدا أنه ما من أثر يُذْكَرُ تَرَتَّبَ على كوني أختًا في النسوية، من بلد تموج بحركة نسائية نشطة، ويسارية، على دراية بالسودان وأتعاطف مع الحزب والاتحاد.
لقد تطلبت تجربة إجراء مقابلة مع فاطمة نوعًا من التفكيك له شقان: أحدهما شخصي يستند إلى تجاربي والآخر تحليلي. على الصعيد الأول، بدأت أخشى من اضطراري إلى فرض شيء من الرقابة على ذاتي وأنا أتولى الكتابة عن فاطمة أحمد إبراهيم، لئلا يصبح مسردي النقدي عن المقابلة بمثابة نوع من الغدر أو الخيانة. فكيف لي أن أتخذ موقفًا نقديًا من واحدة كنت دائما أكنُّ لها أجل الاحترام، وهي شخصية لها مثل هذه الأهمية في التاريخ السوداني؟ وفضلاً عن ذلك، كانت فاطمة ودودة ومهذبة وكريمة؛ إذ منحتني ساعات عديدة من وقتها من أجل ما قد يكون بالنسبة لها مشروعًا مجردًا، بعيدًا عن أرض الواقع، بينما تنهمك هي في العمل الحقيقي المعني بالإبقاء على حياة النساء، في سياق أوضاع الفقر في العالم الثالث.
لم ترَ هؤلاء النسويات السودانيات القليلات اللآتي ناقشت معهن أمر تلك المقابلة داعيًا لعذابي بشأنها، واستحثثنني على أن أستخدمها لإثارة النقاش حول الاتجاه الذي يأخذه الاتحاد النسائي. غير أنه كانت لي تجربة سابقة سودانيات قمن بتشجيعي على نشر رأي نقدي مبني جزئيًا على أساس من معلومات أعطينني إياها، ثم إذا بهن “يتخلين عني” إذ تم النشر بالفعل، فبدأت أفهم كيف يمكن أن يتم استخدام المرء بوصفه وسيلة لإخراج آراء نقدية في مسائل معينة إلى الحيز العلني دون أن يمثل دور الحث على النقد ضمانة ضد الهجر والتخلي. وحين يجد المرء نفسه في هذا الوضع يتولد لديه شعور بأن موقفه يوحي لا بعدم اللياقة السياسية وحسب، وإنما أيضًا بغدره بالسودانيين. ومع ذلك، أظل أرى في الاعتناء بمصالحي وبالأجندة التي لدي – وحدها – ما يحمل نوعًا من النزعة اللاأخلاقية على أفضل تقدير.
إن اتباعَ الأجندة الشخصية التي تخص المرء مسألةٌ قد تعني بالتأكيد انتفاء سيرورة التمكين والتأهيل لدى كاتبة السيرة/ المُأوِّلة/ المُيَسِّرة النسوية. وقد وجدت أن أحد الحلول الممكنة لهذه المعضلة يتمثل في الإقرار بوجود اختلاف بيني وبين فاطمة من حيث نوع الأجندة وشكل النسوية التي نعمل بها، ثم في السعي أيضًا إلى التخفيف من حدة النقد فيما يخص مضمون المقابلة عن طريق تولي عملية نقد ذاتي مباشر وضمني في آنٍ واحد. وفي الواقع، يحدوني الأمل أن تتم قراءة هذه المقالة بأكملها بوصفها تنطوي على نقد للذات، وكذلك بوصفها مراجعة نقدية لبعض جوانب النسوية الغربية، وعلى وجه التحديد هيمنة “السيرورة“. غير أنه من ضمن المشاكل الخطيرة التي تحيط بهذا التأمل الذاتي – وبخاصة مَن كان (أو كانت) ينخرط في حوارات ومساعٍ نحو إزاحة الغرب من نقطة المركز– هو أن الباحث (أو الباحثة) الغربي الأبيض يضع نفسه – مرة أخرى – في نقطة المركز، أما الراوي (أو الراوية) المنتسب إلى العالم الثالث فيتم تهميشه.
ثمة مجال مهم من مجالات نقد. الذات يتعلق بتوقعاتي وافتراضاتي “النسوية“، فلأنني أنا وفاطمة نسويتان لنا الخلفية العامة نفسها (أي أننا مدرّستان من الطبقة المتوسطة وناشطتان يساريتان)، ولأن أجندتينا تتساويان في خطوطهما العريضة – ألا وهي تحرير النساء وتيسير قيام الثورة الاشتراكية السودانية – لهذا افترضت – مخطئة – وجود قدر أكبر من الوحدة في القضايا الرئيسة. فالمحصلة النهائية لما أقدمت عليه فاطمة من إعطائي إجابات مستحسنة اجتماعيًا – أو لائقة سياسيًا من وجهة نظرها – وسواء كان ذلك محاولة منها أن تستخدمني في تلميع صورتها وصورة الحزب الإعلامية، أو كان ذلك بمثابة رؤيتها الصادقة للتاريخ، فالمحصلة هي عبارة عن مقابلة لم تقم فيها بأكثر من وصف للحظات المجد في تاريخ الاتحاد النسائي ووصف مبادراتها – هي – الإيجابية. والنتيجة أنه قد تم إعطائي صورة عن حياتها وتاريخها في النشاط العملي، تخلو من أية تناقضات، وأية أخطاء، وأية لحظات ضعف إنساني، باختصار سردية بطولية.24
كان مرامها – إذن – أن تقنعني بنبل قضيتها والدور الحيوي الفعال الذي لعبته فيها، وذلك لكي تحمل كتابتي عنها هذه الصورة على وجه التحديد، في حين كان هدفي أنا – بطبيعة الحال – أن أجري بحثًا ليست هي سوى إحدى مصادره. قد يبدو هذا التأويل الـمتشكك متعارضًا مع العقيدة النسوية التي يتمثل شعارها في العمل البحثي من أجل النساء، غير أن أي ادعاء آخر من جانبي لن يبدو لي سوى ادعاء كاذب. كنتُ أيضًا أبحث عن معلومات تساعدني على الإلمام بالدور الطليعي الذي أؤمن أن نساء العالم الثالث يمكنه نلعبه في تحرير النساء في كل مكان. وبصفتي ناشطة نسوية، أعتبر نفسي – أنا الأخرى – صاحبة قضية؛ بيد أنه كان ضربًا من التطاول من جانبي أن أتصرف على أساس أنني أشترك معها في القضية نفسها، الشيء الذي جعلني أنتظر منها أن تراه، وأن تشهد بدوري في تلك القضية.
فضلاً عن ذلك، افترضتُ أن لدينا – أنا وهي – “الجمهور” نفسه، وهو جمهور التيارات اليسارية والنسوية، ولكن الموقف كان أكثر تعقيدًا في الواقع من حيث الاختلاف في جمهور السامعين. فقد كان على فاطمة – أثناء تبادل الحوار بيننا – تأخذ بعين الحسبان سمعتها السياسية/ المهنية، كما فعلت أنا. فهي كانت تحمل على تأخذ كاهلها عبء توقعات الحزب منها، وكان عليها أن تأخذ بعين الحسبان مَن هم الذين سيطلعون على المقابلة، كانت كل واحدة منا مطالبة بأن تكون على وعي بما يمكن أن ينتظره الآخرون من هذه المقابلة: فلابد أن الاتحاد والحزب معًا يود – كلاهما – أن يخرج من هذا الموقف “صاغ سليم“، ولابد أن قراء بحثي يريدون تقييمًا نقديًا. كنا – أنا وهي – نتولى حماية السمعة السياسية الخاصة بآخرين، هي تضع في حسبانها رؤوس الحزب وأعضاء الاتحاد، وأنا أهتم بمراعاة بعض النسويات السودانيات من اليساريات اللآتي كان لي سنوات وأنا على ارتباط بهن.
في حالة هذه المقابلة، كان البعدان المتعلقان بالعمل التفاعلي وبالتفاعل بين الذوات – كلاهما – يمران عبر مفاهيم متباينة عن التواضع، عن السلطة المرجعية، عن تعرية النفس، عن معنى أن يكون المرء “صادقًا وأمينًا“، عن دور “التظاهر“، وعن الظرف الذي من المقبول فيه “استخدام” شخص آخر. فضلاً عن ذلك، في حالة الحوار بين شخص من الطرف المقهور وشخص يمثل الطرف القاهر – حتى ولو كان الشخصان من النسويات– قد ترجح كفة الأهداف “القومية” على تلك “النسوية“، ولو بصورة مؤقتة، كما أنه من المؤكد أن المحصلة قد ترجح كفتها على السيرورة.
فلعل لفاطمة العذر في أن تستخدمني، في أن تَعُدنَّي لا وجود لي، في أن تنظر إلى بوصفي شيئًا، قناةً تدفع عبرها قدمًا قضية قضت عمرها تعمل في سبيلها. وأنا، بالرغم من الذنب الذي أحمله بصفتي من البيض، وبالرغم من دوري الذي قد يعد – لا محالة – استعماريًا، لعل لي عذرًا في أن أشعر بأن عواطفي المؤمنة بالمساواة بين البشر، هي ومذهبي المعين في السيرورة النسوية، قد تم انتهاكهما على نحوٍ ما.
من الواضح أن خيبة الأمل التي ساورتني كان منبعها توقعاتي المبالغ فيها، وكذلك الفهم الذي لدي عن معنى “السيرورة النسوية“. ولعل منبعها أيضًا ما كان ماكثًا في نفسي من غطرسة بفضل نظرة الآخرين إليّ بوصفي منتمية إلى الداخل. لم تكن فاطمة سوى شخص غريب عني، وما كنت إلا كذلك بالنسبة إليها، ومع ذلك فقد أردت منها الاعتراف نفسه بي الذي وجدته من غيرها في الماضي، بوصفي لم أكن مجرد أية مستجوبة أو باحثة؛ بل واحدة تم منحها عضوية شرفية، وقضت ثلاثين عامًا تجري أبحاثها في السودان.
ثمة مسألة أكثر تعقدًا والتفافًا إلى حد ما، ألا وهي مسألة الوضع الطبقي. تنتمي فاطمة إلى طبقة متميزة إنْ لم يكن اقتصاديًا فعلى الأقل من حيث مكانتها الاجتماعية التقليدية. قفلعلها عَدَّتني من أصحاب الامتيازات بصفتي أستاذة أمريكية، وبصفتي بيضاء، وبصفتي المستعمر الجديد، الطرف المستغل، إلا أنني في الواقع أنحدر من الطبقة العاملة. من ناحية أخرى، كان انتسابي إلى اليسار الأمريكي له أثره، إذ إنه من الناحية السياسية الخالصة ظلت إحدى مشكلاتي الدائمة مع اليساريين (أو اليساريات) السودانيين تتمثل في ازدرائهم اليسار الأمريكي.
على الصعيد التحليلي، يمكن النظر إلى تجربتي في مقابلة شخصية من الشخصيات البارزة والمتميزة في السودان، بصفتها تجربة تلقي الضوء على العيوب الموجودة في بعض الأفكار النسوية الغربية حول المنهجية. إذ إن مسألة إيثار السيرورة على المحصلة قد تحدث تأثيرًا عميقًا في أعمالنا البحثية، أي في قدرتنا على خلق أي قدر من المسافة، فضلاً عن تأثيرها في تقييم حياة الراوية بوصفها منفصلة عن حياتنا، وفي اتخاذ موقف نقدي دون أن نعطيه صبغة شخصية. ربما يصلح الاعتماد على التماهي النسائي التفاعلي، وعلى سلطة التجربة المشتركة، في مواقف أو أوضاع بعينها، ولكنه من الجائز جدًا أن ثمة تناقضًا بين تولي عملية تيسير تكون فيها امرأة من النساء هي الراوية لقصة حياتها بنفسها – أي هي التي تحتل دائرة الضوء– وبين طبيعة السيرورة التفاعلية (the interactional process). وحتى نضع هذا الكلام في السياق السوداني، لا يصح للمستجوبة/ كاتبة السيرة، حين تتواجد فوارق طبقية و/ أو فوارق عنصرية، أو حين تمثل المستجوبة المستعمر وتمثل الراوية المستعَمر، أن تطالب “بوقت متساوٍ“، أو أن تنتظر الاعتراف نفسه بها.
فهل من المنطقي أن أنتظر – أنا النسوية الغربية البيضاء المستجوبة لامرأة سودانية – منها أن تراني وأن تعاملني كما أرى نفسي، في حين أنني قد أمثل بالنسبة إليها طائفة من فئات أخرى كثيرة؟ ومع ذلك، إنْ عدنا إلى السؤال المثار في مقدمة هذه المقالة، هل بوسع أية كاتبة سيرة أن تتجنب فرض واقع ما، انتهينا إليه؟ إنْ كنا ملتزمات بنظرية معينة، ومنهجية معينة، وكنا منخرطات في الممارسة العملية، هل من الصدق أن نكون أو أن نفعل شيئًا عدا ذلك؟ ومع ذلك، إنْ حاولنا – على الجانب الآخر – في موقف مثل الذي وصفته أعلاه، أن نتصرف بوصفنا أكثر من مجرد قنوات لنقل حكاية الراوية، أي بوصفنا – مثلاً – مؤولات، أو محاورات، أو حتى شريكات في الجرم، هل معنى ذلك أننا نمارس إمبريالية ثقافية؟ إن جزءًا كبيرًا مما تقوم به باحثات (أو باحثو) الأنثروبولوجيا “في الحقل الميداني” قد جرى التخطيط له أو سبق إعداده إلى حد كبير، بما في ذلك هذا المنهج بارز المكانة، الذي يشار إليه بـ “الملاحظة بالمشاركة“. ومع ذلك، فقد أعادت بعض النسويات تعريف المقابلة بوصفها شيئًا أشبه ما يكون بمنهج “الملاحظة بالمشاركة“، فالمستجوبة تهيئ – أو تخلق– موقف المقابلة، ثم تشارك فيه. تُعَدُّ الكينونة (being) والفعل (doing) مسألتين مهمتين بالنسبة إلى الراوية ومؤولتها النسوية على حد سواء، إلا أنه من الجائز أن ذلك القدر من المسافة الضئيلة – وإن ظلت مهمة– والتي هي مطلوبة في حالة منهج الملاحظة بالمشاركة المعتاد – يقي الباحثة الآخذة بمنهج التفاعلية والتفاعل بين الذوات في تأويلها لحياة امرأة غيرها، حيث يقيها من أن تكوّن افتراضات خاطئة عن المساحات المشتركة أو الهموم المتبادلة. وفي الوقت نفسه، تبقى الحميمية، و“الذاتية المشتركة” في سياق “المقابلة النسوية“، تبقى – في أغلب الأمر – مسألة اصطناعية مؤقتة، محبطة للتوقعات، ومن الممكن أن تؤدي إلى خلق توترات بين أشكال من النسوية مختلفة فيما بينها.
إن “حلمي بلغة مشتركة“25 هو حلم قد حطمته هذه المقابلة، غير أنه ربما كان ذلك مبعثه أننى على الرغم من استدعائي لشكل من أشكال “النسوية“، نسيت في الوقت نفسه شيئًا من الأنثروبولوجيا والسياسة والتاريخ.
* Sondra Hale, “Feminist Method, Process, -and Self-Criticism: Interviewing Sudanese Women,” in Women’s Words: The Feminist Practice of Oral History, eds. Sherna Berger Gluk and Daphne Patai (New York and London: Routledge, 1991), pp. 121-136
______________________________________________________
1 – Ann Oakley. “Interviewing Women: A Contradiction in Terms,” in Doing Feminist Research, ed. Helen Roberts (London Routledge and Kegan Paul, 1981) 30-61
2 – استخدم السودانيون مصطلح “التيار الإسلامي” عام ١٩٨١ لوصف الحركة الساعية إلى أسلمة الدولة السودانية، بما فيها تطبيق الشريعة الإسلامية.
3 – عبارة “تناقضات ظاهرية وتوقعات” مستعارة من المقالة الآتية:
John Middleton, The Study of the Lugbara: Expectation and Paradox in Anthropological Research (New York: Holt, Rinehart, and Winston, 1970)
4 – Sondra Hale. “The Nature of the Social, Political, and Religious Changes among Urban Women: Northern Sudan.” Proceedings of the Third Graduate Academy of the University of California, UCLA. April 11-12, 1965 (Los Angeles: UCLA Graduate Student Association, 1966) 127-40.
بالرغم من أن هذه المقالة ظلت لسنوات طوال تمثل الدراسة الوحيدة عن نساء شمال السـودان الحضريات، وبالتالي يتم الاستشهاد بها كثيرًا، فإنني كثيرَا ما استخدمتها بوصفها درسًا فـي المركزية الأوروبية.
5 – Kathleen Gough, “Anthropology: Child of Imperialism,” Monthly Review 19, no. 11 (1967): 12-27: Wendy James, “The Anthropologist as Reluctant Imperialist,” in Anthropology and the Colonial Encounter, ed. Talal Asad (London: Ithaca Press, 1973) 41-69.
6 – من أجل قائمة مراجع جيدة لهذه المراجعات النقدية، انظر/ انظري:
Peter Forster, “A Review of the New Left Critique of Social Anthropology.” in Asad, ed., Anthropology and the Colonial Encounter, 23-38.
7 – المصدر نفسه، انظر/ انظري أيضًا في المجلد نفسه:
Abdel Ghaffar M. Ahmed.” Some Remarks from the Third World on Anthropology and Colonialism: The Sudan,” 259-70.
8 – ظل باحث الأنثروبولوجيا رجلاً هامشيًا على مدى الجزء الأعظم من تاريخ الأنثروبولوجيا…. فكان في كل الأوقات تقريبًا يتبدى كما لو أنه هامشي بالنسبة إلى المجتمع. وبالنسبة إلى أفراد عائلته كان يمثل الشخص “الغريب الأطوار بينهم“
9 – هذا المصطلح مقترض من المصدر الآتي:
Dell Hymes, ed., Reinventing Anthropology (New York: Vintage, 1972).
10 – انظر/ انظري على سبيل المثال:
Laura Nader, “Up the Anthropologist-Perspectives Gained from Studying Up,” in Hymes, ed., Reinventing Anthropology, 284-311.
11 – مثلاً Bob Scholte, “Toward a Reflexive and Critical Anthropology,” in Hymes,Reinventing Anthropology 430 – 57. في عام 1968 تم نشر أوراق حلقة دراسـية عـن المسئوليات الاجتماعية في قسم خاص من مجلـة Current Anthropology 9, no.5 (1968) 391- 436. انظري في هذا القسم المصدر الآتـي علـى الأخـص:
Gerald Berreunan, “Is Anthropology Still Alive?” 391- 96، وأيضًا انظر/ انظري:”Bringing It All Back Home”Malaise in Anthropology,” in Hymes,ed., Reinventing Anthropology, 83- 98.
12 – كنت بحلول السبعينيات قد أصبحت على دراية بالموقف النقدي اليساري الداعي إلـى مبـدأ النسبية الثقافية (مثلاً Hymes, ed., Reinvertis Anthropology)، بيد أن هذا النقد أصبح فيما بعد أبلغ وأكثر إحكامًا على يد النظرية والأيديولوجية النسوية.
13 – بلغ هذا الاختيار الأخلاقي ذروة درامية حين عدت إلى الولايات المتحدة في ١٩٧٢، ووجـدت رسالة من وزارة الداخلية السودانية تطلب مني نسخة صوتية و/أو مفرغة كتابيًا من المقابلات التي أجريتها مع سبعة وستين رجلاً وامرأة من أهل النوبة. وقد تجاهلت هذا الطلب مخاطرةً بألا تسمح لي الحكومة السودانية بممارسة العمل البحثي بعد ذلك في السودان.
14 – أتناول هذه العمليات بشيء من التفصيل في رسالة الدكتوراه التي أعددتها، بعنوان:
The Changing Ethnic Identity of Nubians in an Urban Milieu: Khartoum, Sudan (Anthropology Department, University of California, Los Angeles, 1979), 35- 40.
15 – من الجائز أنه بحلول السبعينيات أصبحت الكتابة أو الحديث بشكل شخصي عن تجارب المرء في العمل الميداني من الممارسات المعتادة، مثل:
Paul Rabinow, Reflections on Fieldwork in Morocco (Berkeley, Calif.: University of California Press, 1977); Rosalie Wax, Doing Fieldwork: Warnings and Advice (Chicago: University of Chicago Press, 1971); Jean Briggs, Never in Anger (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1970): Peggy Golde, ed., Women in the Field: Anthropological Experiences (Berkley, Calif.: University of California Press, 1970); Middleton, The Study of the Lugbara; Powdermaker, Stranger and Friend: David Maybury-Lewis, The Savage and the Innocent (Cleveland, Ohio: World Publishing Company 1965)
،كما تمت مناقشته في مقالة نقدية كتبهـا
Dennison Nash and Ronald Wintrob, “The Emergence of Self-Consciousness in Ethnograptiy,” Current Anthropology 13 (1972): 527-42.
ولكن في عام 1954 حين قامت باحثة الأنثروبولوجيا لورا بوهانان Laura Bohannan بالكتابـة على نحو له صبغة شخصية، لم تشعر فقط أنها مضطرة إلى إخفاء شخصيتها واللجوء إلـى اسم مستعار، وإنما قامت كذلك بتحويل مسردها إلى عمل خيالي. ولقد كان لتجربتها هذه فـي طمس هويتها – بوصفها أمريكية وإغراق نفسها في ثقافة التيف Tiv النيجيرية إلى درجة أنها كادت “تفقد شعورها بنفسها” – وقع في نفسي أشبه بوقع رواية رعب، فقد كنت عبـارة عـن طالبة جامعية تبدأ دراستها في قسم الأنثروبولوجيا في الستينيات. انظر/انظري:
Elenore Smith Bowen, pseud., Return to Laughter (New York: Harper & Row, 1954).
16 – في عام 1950 أدخل ميشيل لاريس Michel Leiris مفهوم “مواجهة الكتابـة بكتابـة أخـرى“”writing back” في سياق مقالتـه:”L’ethnographe devant le colonialism,” Les Temps” Modernes 58. وقد تم إحياء هذا التقليد على أبلغ نحو على يد إدوارد سعيد في كتابه بعنوان الاستشراقOrientalism (New York: Pantheon 1978)، انظر/ انظري كذلك:
James Clifford, The Predicament of Culture: Twentieth Century Ethnography, Literature, and Art (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1988), 256.
وقد جرى في عهد أقرب استكشاف موضوع “مواجهة الكتابة بكتابة أخرى” علـى يـد جـايـــاتري سبيفاك من بين آخرين، انظر/ انظري:
Gayatri Spivak, In Other Worlds: Essays in Cultural Politics (London: Methuen, 1987); Bill Ashcroft et al., The Empire Writes Back: Theory and Practice in Post Colonial Literatures (London: Routledge, 1989); and Homi K. Bhabha, ed., Nation and Narration (London: Routledge, 1990).
17 – كتبت سهير مرسي عن هذا الموضوع بشكل مقنع وقوي، انظر/ انظري:
Soheir Morsy, “Toward the Demise of Antropology’s Distinctive Other Hegemonic Tradition,” in Arab Women in the Field: Studying Your Own Society, ed. Soraya Altorki and Camillia El-Solh (Syracuse, N.Y.: Syracuse University Press, 1988); 69- 90
18 – Renate Duelli Klein, “How To Do What We Want To Do: Thoughts about Feminist Methodology,” in Theories of Women’s Studies, ed. Gloria Bowles and Renate Duelli Klein (London: Routledge and Kegan Paul, 1983), 94-95 and 98: Marcia Westkott “Feminist Criticism in the Social Sciences,” Harvard Educational Review 49 (1979): 422 – 30.
وليس ذلك ببعيد الشبه عن عمل باولو فرير:
Paulo Freire, Pedagogy of the Oppressed (New York: Seabury Press, 1970).
19 – أجريت هذه المقابلة، التي تمت باللغة الإنجليزية، يوم ١٢ يوليه ١٩٨٨ في مدينـة أم درمـان بالسودان. جميع الاستشهادات تم أخذها من هذه المقابلة.
20 – Eric Roulean, “Sudan’s Revolutionary Spring.” Middle East Report 15 (1985): 4.
دولورس إيباروري جـوميز Dolores Ibarruri Gomez(۱۹۸۱– ۱۸۹5) المعروفة باسـم الباسيوناريا، اشتهرت بوصفها زعيمة ثورية في الحرب الأهلية الأسبانية، وكانت تمثـل الشجاعة وروح الإقدام.
21 – في يونيه ١٩٨٩ وقع انقلاب عسكري جديد أطاح بالحكومة المنتخبة ديمقراطيًا وحل مجلـس عسكري في مكانها، وتم حظر جميع الجماعات السياسية والنقابات المهنية، واعتبـار كافـة الاجتماعات السياسية خارجة عن القانون. انظر/ انظري:
Alan Cowell, “Sudan’s New Rulers to Press for End to Civil War,” The New York Times, 2 July 1989: 1; and Andrew Buckoke, “The Military Seizes Power in Troubled Sudan,”The London Times, 1 July 1989: 7.
كما جرى القضاء على اليسار خصوصًا، مما يعني بالطبع أن الاتحاد النسائي والحزب الشيوعي السوداني قد تم حظرهما من جديد.
22 – Sondra Hale, “The Wing of the Patriarch: Sudanese Women and Revolutionary Parties,” Middle East Report 16 (1986): 25-30.
تجدر الإشارة إلى أن نساء اليسار السودانيات تناقشن معـي، لـيـس حـول مسـائل نظريـة أو أيديولوجية، وإنما عن أهمية كتم الانتقادات الموجهة لليسار “داخل البيت“؛ وذلك إلى أن تقوى شوكة الحزب اليساري السوداني والاتحاد النسائي من جديد. ينبغي التنويه إلى أن النسـويات اليساريات في الغرب، قد نفذ صبرهن في هذا العقد الأخير على الأخص، إزاء العلاقة بـين الماركسية والنسوية، وإزاء نوع استجابة المنظمـات اليسـارية إلـى الأفكـار النسـوية. انظر/ انظري على سبيل المثال:
S. Rowbotham, L. Segal, and H. Wainwright, Beyond the Fragments: Feminism and the Making of Socialism (London: Merlin, 1979).
ومن أحدث الأعمال التي تتناول هذا الموضوع بالاستكشاف:
Promissory Notes: Women and the Transition to Socialism, ed. S. Kruks, R. Rapp, and M. Young (New York: Monthly Review Press, 1989).
وفي حين أن موقفي النقدي هنا يتفق مع خطوط هذه المدرسة، يجدر بي أن أعلق قائلة إنني ظللت لسنوات طوال من أنصار الاتحاد النسائي والحزب الشيوعي السوداني وأؤيدهما بشدة.
23 – Sondra Hale, “Women’s Culture/Men’s Culture: Gender, Separation, and Space in Africa and North America,” American Behavioral Scientist 31 (1987): 115- 34.
24 – في حين أن هذا النوع من المقاربة، المعنية بتقديم سردية بطولية، قـد يكـون متناسبًا مـع أغراضها بشكل يبرره ويشرعه، ليس الوضع كذلك بالنسبة لي. في ضوء هذا الإدراك، ناهينا عن الاختلافات الأخرى المتعلقة بـ “السيرورة“، فلابد لي من أن أعيد النظر فيما إذا كنت لا زلت راغبة في أن أكون كاتبة سيرة حياة فاطمة. وأعتقد أنها هي الأخرى قد تعيد النظر بعد أن تقرأ هذه المقالة.
25 – استعرت هذا التعبير من أدريان ريتش، في:
Adrienne Rich, The Dream of a Common To Language: Poems, 1974-1977 (New York: W. W. Norton, 1978).