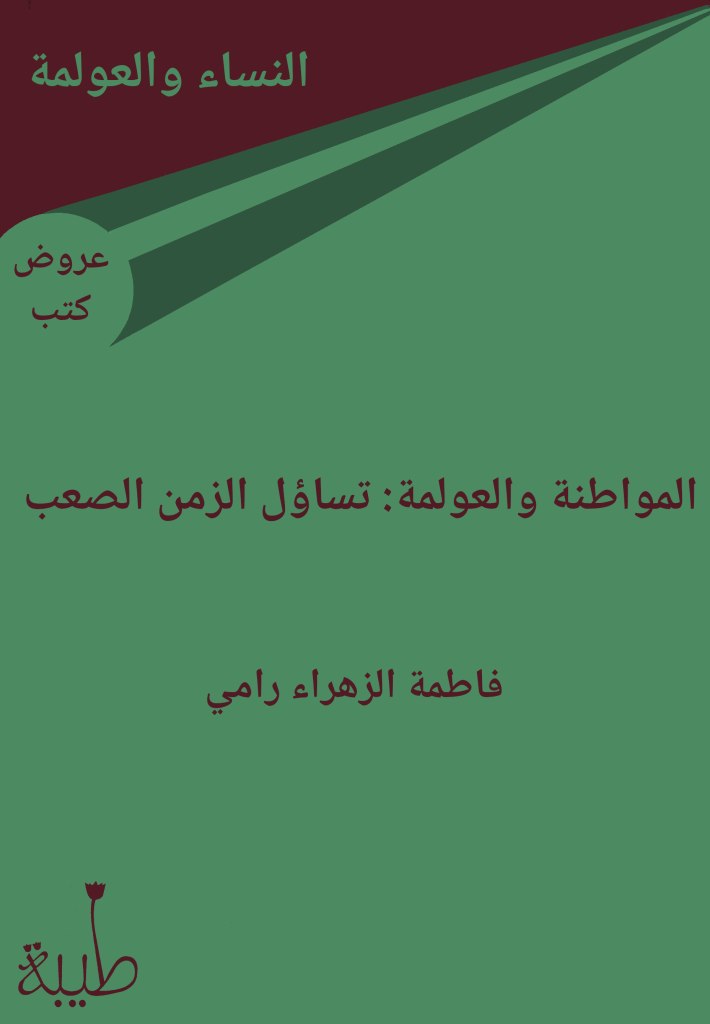المواطنة والعولمة: تساؤل الزمن الصعب
عرض : فاطمة الزهراء أحمد رامي*
في دراسة بحثية مستفيضة لرصد العلاقة القائمة بين مفهومي المواطنة والعولمة في الغرب ومصر، يقدم لنا الكاتب «قايد دياب» رؤيته الدقيقة في هذا الصدد في 430 صفحة مقسمة إلى: تقديم ثم خمسة أبواب ثم خاتمة. يبدأ الباب الأول ليشرح تطور مفهوم المواطنة في الفكر الغربي المعاصر. يليه الباب الثاني ليلقى الضوء على مفهوم المواطنة أيضًا ولكن في الفكر السياسي المصري. ثم يعرض الباب الثالث لمعوقات الممارسة السياسية للمواطنة في الواقع السياسي المصري. أما الباب الرابع فيتطرق إلى ظاهرة العولمة وإعادة النظر في مفهوم المواطنة في الفكر والممارسة الغربية. وأخيرًا يأتي الباب الخامس ليناقش القضايا والإشكاليات الناجمة عن العولمة والمواطنة المصرية.
يبدأ الكاتب مقدمته مشيراً إلى أهمية مفهوم المواطنة مما جعل من المصطلح نواة لكثير من النقاشات الفكرية والسياسية اليوم؛ ليس فقط في الواقعين المصرى والعربي بل في العالم أجمع خاصة بعد بزوغ ظاهرة “العولمة“. فعلى الصعيد الغربي، لم يعد التعريف التقليدي للمواطنة بوصفها «هي صفة المواطن الذي يتمتع بالحقوق ويلتزم بالواجبات في إطار الدولة القومية التي يحمل جنسيتها» كافيًا للمجتمعات الأوروبية بسبب تعرضها لأنماط مختلفة من التعددية الثقافية نتيجة تزايد أعداد المهاجرين إليها من شتى ثقافات العالم؛ بالإضافة إلى تنامي النزعات العرقية والقومية من داخل هذه المجتمعات نفسها. فما بين المواطنة القومية، والمواطنة القطرية، والمواطنة العالمية، والفردية أصبح مفهوم المواطنة بصورته التقليدية في حاجة ماسة للمراجعة .
أما على المستوى المحلي، فمفهوم المواطنة أضحى في بؤرة اهتمام المجتمع المصرى بنخبه كافة: الفكرية والسياسية، بسبب تنامي بمسألة حقوق الإنسان والمواطن إلى جانب ضرورة وجود مواطنة متساوية بين أطياف المجتمع المصرى بجميع تياراته الفكرية والسياسية والدينية. ويلخص الكاتب نقاط دراسته في هذا الكتاب متسائلاً عن معوقات الممارسة السياسية في مصر وأسباب الخلل بين النظرية والتطبيق. ثم ينتقل إلى تأثير مفهوم العولمة في المواطنة الغربية والمصرية وإلى أي مدى ستؤثر في القضايا المحورية لمجتمعنا المدنى مثل قضايا الهوية والتعليم والانتماء. ويختتم مقدمته مشيرًا إلى أنه لا يوجد حتى الآن نموذج أمثل للمواطنة في أي من تشريعات دول العالم، ولذلك فإن إرساء دعائم ثابتة وقوية لتدعيم مبدأ المواطنة في المجتمع المصرى هو من أهم الخطوات لاستعادة «عافيتنا الحضارية» إذ يعتبرها «تجسيدًا لمعنى خلافة الإنسان الله» رافضًا أي شكل من أشكال الوصاية الفكرية على المواطنين.
يأتى الباب الأول مفصلاً تطور مفهوم المواطنة في الفكر الغربي الحديث والمعاصر وينقسم إلى أربعة فصول. يشرح الفصل الأول منها شكل المواطنة عند اليونان والرومان. فقد أرجع مؤرخو الفلسفة الفضل في إرساء المفاهيم الأولية لعلم السياسة بمفاهيمه المتعددة للإغريق القدامي حيث ساد لديهم النظام السياسي والاجتماعي المعروف باسم دولة المدينة (The City State). فهذا النظام هو الوحدة الطبيعية للوجود الإنساني حيث يسود فيه عنصرا الحضارة الأساسيان: العدالة والقانون. ويضم هذا المجتمع ثلاث طبقات أساسية على شكل هرمي حيث تأتي طبقة العبيد والعمال الحرفيين في قاعدته، ثم طبقة الأجانب المتمتعين بمركز اجتماعي معقول، وأخيرًا طبقة المواطنين على القمة، وتختلف هذه الطبقة عن سابقتيها بأنها تؤمن لأصحابها صفة المواطنة؛ أي حقهم في المشاركة السياسية. وعلى الرغم من ذلك، فإن أثينا في عصور لاحقة كانت مثالاً للمدينة التي تضم مواطنين متساوين في الحقوق بغض النظر عن فروقاتهم الاجتماعية والاقتصادية، فقد كان المواطنون (Citizens) أحرارًا، متساوين، وأصحاب السيادة في اتخاذ القرار. ويظهر الفرق بين مفهومي المواطنة الإغريقية والمواطنة الحديثة في نظرة المواطن الإغريقي لصفة المواطنة كمرادف لمعنى المشاركة والمساهمة في الشأن العام كعضوية الإنسان في أسرته وليس فقط كمجموعة من الحقوق والواجبات القانونية كما هو الحال في عصرنا الحديث.
أما عن مفهوم المواطنة عند الرومان، فقد تغير بعد تصوير الإسكندر الأكبر للإنسان كفرد له ذاته المستقلة وكعضو في جماعة في الوقت نفسه. فأدى ذلك إلى ظهور الفكرة الرئيسية في مفهوم المواطنة ألا وهي الأخوة الإنسانية، والتي أدت بدورها إلى إلغاء الحواجز كافة المتسببة في تفرقة الناس إلى طوائف مختلفة وأصبحت صفة المواطنة تمنح لكل من يسكن مدينة ما وليس فقط كحق مكتسب بالميلاد، إلى جانب ذلك، فالتغيير كان شاملاً للفلسفة السياسية للرومان حيث اتجهوا إلى وضع قانون عملي ينص على فصل الفرد عن الدولة ولكن لكل منهما حقوق وواجبات محددة. وبسبب اتساع الإمبراطورية الرومانية ودوامها لأكثر من ألف عام فقد حرص الرومان على القضاء على النزاعات الداخلية وتدعيم مبدأ مساواة الجميع أمام القانون. ولكن ظل ترتيب حقوق وواجبات الأفراد في هذا الكيان المترامي الأطراف هو أهم مشكلة تواجه هذه الإمبراطورية، فقد نجح عامة الناس في المشاركة في الحكم بجانب النبلاء نتيجة كفاح طويل مما أدى إلى تحقيق أكبر انجاز سياسي للإمبراطورية الرومانية ألا وهو «نقل رعاياها تدريجيًا إلى درجة المواطنة الرومانية» مما شجع هؤلاء الأفراد مع مرور الزمن أن يظلوا متمسكين بهذه المواطنة لإطمئنانهم لعدالة القانون الروماني الذي يضمن لهم حقوقهم.
وينتقل بنا الكاتب إلى المرحلة التاريخية الثانية من تطور فكرة المواطنة في الفصل الثاني ألا وهي الفكر المسيحي وعصر النهضة. فيرى أن الدين المسيحى لم يأت بتطورات مباشرة لمفهوم المواطنة بل إن هذا المفهوم قد تأثر في الواقع بالفلسفة السياسية الغربية في العصور السابقة. ولكن الإسهام الواضح للمسيحية في الإعلاء من شأن هذا المفهوم يرجع إلى إعلانها فكرة الإخاء العام والتي تقضى بالمساواة الكاملة في الحقوق بين البشر بعضهم البعض واحترام الشخصية البشرية والتي حاول المسيح أن يوقظها في كل فرد عن طريق الفصل بين علاقة المواطن بالسلطة وعلاقته بخالقه، وعن طريق تأكيده على القيمة الروحية لهذه الحياة وأن كل إنسان يحمل بداخله عالمًا ما هو إلا صورة من مملكة الله نفسه. ولذلك فإن دور المسيحية هو دور إيجابي على الرغم من كونه غير مباشر في بلورة قيمة الحريات الفردية وحق كل إنسان في إدارة شئونه الخاصة.
أما عن تأثير عصر النهضة في صياغة مفهوم المواطنة بشكل أوضح فيأتي في أواخر العصور الوسطى حيث التغيرات الجذرية في الفكر الغربي نحو إرساء قيمة الحرية الخلقية من خلال حركتين أساسيتين: الأولى هي النهضة الأوروبية (Renaissance) والتي عززت من الحرية الفكرية، والثانية هي حركة الإصلاح الديني (Reformation) والتي ركزت على الحرية الدينية، ويظهر لنا من ذلك أن حرية الفرد سواء الدينية أو الفكرية هي الأساس الذي انطلقت منه الشعوب الغربية نحو نهضتها فاعترفت بحق الفرد ومكانته في مجتمعه واتخذته وحدتها الأساسية في البناء الاجتماعي. ولذلك اقترن المذهب الإنساني (Humanism) بهذه الفترة ليؤكد أهمية الطبيعة الإنسانية وحدودها ومصالحها ويرفض الفكر السابق للكنيسة ومؤسساتها والذي يقضي بعدم مساس الإنسان أو محاولته تغيير أو تبديل أي من حقائق واقعه بدعوى أن هذا جزء من الرضا بقضاء الله والانتماء إلى النظام الكوني الأشمل والذي يحقق للإنسان سعادته المادية والروحية.
ثم يأتي الفصل الثالث ليشرح مفهوم المواطنة وتطوره في الفكر السياسي الحديث في الفترة من أوائل القرن 17 حتى نهاية القرن 19. فنجد أن هذه الفترة قد أثمرت عن عدة رؤى مؤيدة لفكرة الديمقراطية وأن الدولة يجب أن تكون قائمة على إرادة حرة للجماعة التي تحكمها، ولذلك ظهرت نظرية العقد الاجتماعي والتي تقضى بأن السلطة الحاكمة لا تقوم إلا بعقد اجتماعي بين الأفراد منظمة حقوق وواجبات كل فرد تجاه هذه الدولة، لذلك فإن إرادة الناس واتفاقهم فيما بينهم على إقامة مجتمعهم المدني وخضوعهم للسلطة الحاكمة فيه يقوم أساسًا على رضاهم بها. ولعل من أبرز الدعاة الرئيسيين لهذه النظرية هم : [توماس هوبز] و [جون لوك] و [جان جاك روسو]. ورغم أن هؤلاء الفلاسفة الثلاثة قد اتفقوا على قدرة الدولة على فرض قواعد سلوكية معينة على الأفراد شريطة ألا تمارس هذه السلطة بطريقة تعسفية، فقد اختلفوا في تعريف طبيعة هذا العقد الاجتماعي بشكل أكثر تفصيلاً. فيرى [هوبز] أن الدولة هي ثمرة تخلى كل فرد عن حقوقه الأصلية في السلطة والتي وهبته إياها الطبيعة، بينما يزعم [لوك] أن الحكومة هي الامتداد السليم للعلاقات الإنسانية في حالة الفطرة، و يرى [روسو] أن هذه النظرية تعكس مبدأ أن القانون الذي يحكم حياة الناس ما هو إلا تعبير عن الإرادة العامة للمجتمع.
إلى جانب هذه النظرية، نجد أن مفهوم الدولة القومية كان حجر الزاوية الحقيقي بالنسبة لصورة الدولة الحديثة في الغرب منذ القرن 19 وتطور مفهوم المواطنة خلاله، فهذا المصطلح يؤكد حق كل أمة في أن تتشكل في دولة مستقلة حيث تكون هي الضامن الأول لحقوق المواطنين فيها عن طريق إرساء حكم القانون. وجاءت الليبرالية أيضًا داعيًة إلى إعلاء شان الفرد على حساب الجماعة وحماية ملكيته الخاصة من تدخل الدولة. وبالانتقال إلى القرن 18 تحديدًا نجد إسهامات عصر التنوير في بلورة مفهوم المواطنة في الغرب حيث طور فلاسفة هذا العصر مفاهيم عدة من أهمها تلك الخاصة بقيم المساواة وسيادة الشعب للحد من السلطة المطلقة للحاكم. فحماية الحريات المدنية عن طريق توفير ضمانات قانونية هي أساس الدستورية الحديثة؛ والتي استمدت كثيرًا من أفكارها من دعائم الثورة الفرنسية. أما عن القرن 19 فنجد أن مضمونًا جديدًا للمواطنة قد ساد من خلال ثلاثة مفاهيم كان لها أكبر الأثر في العصور اللاحقة ألا وهما: القومية، والليبرالية، والاشتراكية. أما الأول فقد ألقى عليه الضوء سابقًا، وأما الثاني فيؤكد الكاتب مجددًا أهمية الليبرالية في احترام حقوق وحريات الأفراد وإعلاء قيم العقلانية والمساواة أمام القانون والتسامح والقبول بالآخر رغم إلقائه الضوء أيضًا على المشكلات التطبيقية لهذه الفلسفة في كيفية توفيقها بين مبدأ التعددية وضرورة الحفاظ على كيان موحد للوطن في آن واحد. أما عن الاشتراكية فقد ركزت جهودها على إعادة التناسق والوحدة داخل المجتمع، فإننا إذا أخذنا الاشتراكية الماركسية كنموذج للمذاهب الاشتراكية جمعاء فسنجد أنها انتقدت النظام الليبرالى الرأسمالي بشدة متهمة إياه بإفراز أفراد منشغلين بأنفسهم فقط ومتحررين من مسئولياتهم الاجتماعية مما يخل ببنية المجتمع وتماسكه إذ تؤكد أن القيمة الحقيقية للمواطنة هي في إعلاء المصالح العليا للمجتمع على المصالح الفردية.
وينتقل بنا الكاتب إلى الفصل الرابع مناقشًا العلاقة القائمة بين المواطنة والديمقراطية في القرن العشرين. بما أن طموحات الإنسان طوال التاريخ تتركز أساسًا في إرساء قيمتى الحرية والعدل، فإن قضية الديمقراطية كانت من أهم القضايا الشاغلة للساحة الفكرية والسياسية في القرن العشرين خاصة بين نظريتي الماركسية والرأسمالية. ولكن، وبعد صراع أيديولوجي بين هاتين النظريتين، ثبت بالتجربة العملية فشل الأولى في ديمقراطيتها الاجتماعية حيث إن عدالة التوزيع لم تغن عن حرية التعبير والممارسة السياسية، بينما نجحت الليبرالية الديمقراطية نتيجة حرية الأفراد بها في الممارسة السياسية الحرة. ولكن، في ظل التحولات الكبرى التي تمر بها المجتمعات الغربية نتيجة التعددية الثقافية غير المتجانسة بها واتجاهها نحو العولمة السياسية، تواجه هذه المجتمعات تحديات في تحديد مفهوم المواطنة ومدى ولاء وإخلاص المواطنين تجاه مؤسساتها القومية. لذلك فإن القيم المشتركة التي تمنح الجماعة الإنسانية ترابطًا قويًا وانتماءً واحدًا هي السبيل الوحيد لتشكيل مواطنة حقيقية في المجتمعات الحديثة.
بعد طرحه لتطور مفهوم المواطنة في الفكر السياسي الغربي، ينتقل الكاتب في الباب الثاني الذي يحتوى على أربعة فصول إلى المفهوم نفسه ولكن في الفكر السياسي المصري. فيبدأ الفصل الأول مناقشًا للتيار الليبرالي كأحد التيارات الفكرية والسياسية الأساسية في الساحة السياسية المصرية ويرى أن الرؤية الصحيحة للمواطنة هي عن طريق اعتبار الفرد هو البنية الاجتماعية الأساسية في أي تقدم إنساني. نشأت الليبرالية المصرية مع ظهور طبقة كبار الملاك الزراعيين على يد «محمد على» منذ عام 1837 . وربما نجد للحركة جذورًا تاريخية أقدم من ذلك مع مجيء الحملة الفرنسية على مصر والتي أعادت صياغة وتكوين الفكر السياسي والاجتماعى المصرى من خلال نشأة الفكرة الديمقراطية؛ حيث سمح للمصريين بالمشاركة السياسية في حكم بلادهم بعد عزلهم عنها خلال العهدين التركي والمملوكي مما أدى إلى بعث القومية المصرية من جديد. ولعل من أبرز دعاة الليبرالية في مصر وقتئذ هما رفاعة الطهطاوى وأحمد لطفى السيد؛ حيث قدم الاثنان إسهامات واضحة في تحديد مفهوم المواطنة. فكرائدٍ أول للوطنية وباعث لمفهوم القومية المصرية أكد رفاعة الطهطاوى أهمية الحقوق والحريات المدنية والسياسية إلى جانب التربية السياسية السليمة للمواطنين وأيضًا حقوق أهل الذمة في المجتمع الإسلامي فأعلى من شأن مفاهيم المساواة والحرية للأفراد في ظل حماية القانون. أما عن أحمد لطفى السيد فأهمية إسهاماته في الفكر الليبرالى المصرى تكمن في عرضه لشكل علماني للفكرة متجردًا من أي نزعة دينية ودون أن يحاول التأصيل لها في التراث الإسلامي. عن وقد أدى ذلك إلى تدعيمه لفكرة المواطنة من خلال التأكيد على مفهوم القومية المصرية والديمقراطية السياسية والتعليم وتنشئة المواطنين سياسيًا.
أما عن متابعة الفكر الليبرالي في الممارسة السياسية المصرية فنجد أن ثورة 1919 كان لها أبلغ الأثر في ترسيخ فكرة المواطنة عن طريق وحدة عنصرى الأمة – المسلمين والأقباط، أما عن المرحلة اللاحقة لذلك فقد صدر دستور 1923 معترفًا بمساواة كل المصريين أمام القانون بحقوق ومسئوليات مدنية وسياسية واحدة دون تفرقة بسبب الجنس أو اللغة أو الدين. فهذا الدستور قد أكد مبدأين ليبراليين أساسيين هما: سيادة الأمة، وتأكيد الحريات العامة والحقوق المدنية وحتى بعد انقطاع استمر طوال ثورة يوليو 1952، ظل التيار الليبرالي المعاصر منذ منتصف السبعينيات يؤكد أن الديمقراطية السليمة والعدالة الاجتماعية لن يتحققا إلا باعتبار الفرد مصدر التقدم الحقيقي في المجتمع.
وينتقل بنا الفصل الثاني ليشرح التيار الديني بفرعيه الإسلامي والمسيحي وإسهامهما في تطور مفهوم المواطنة في مصر. فبالنسبة للتيار الإسلامي نجد موقفين مختلفين، الأول لعلماء المسلمين المتنورين؛ وخاصة من أتيح لهم الإقامة في أوروبا والإطلاع على مؤسساتها السياسية والإدارية وهؤلاء يرون أن الأخذ بأسباب الحضارة الغربية والعلوم الحديثة هو من أفضل السبل للإصلاح الشامل في إرساء قيمة المواطنة كعملية مشاركة فعالة في المجتمع، وبما أن الإسلام هو في الأساس داعم للمنظور الإنساني للوحدة الإنسانية والمساواة في الحقوق والواجبات فإن هؤلاء العلماء قد أكدوا المساواة الكاملة بين المسلمين وغيرهم بحيث يتمتعون جميعًا بالحقوق المدنية السياسية التي يكفلها الدستور وينظمها القانون، وبالنسبة لقضية أهل الذمة في الإسلام فإنهم يرون أن الذمة ليست مواطنة من الدرجة الثانية بل يجب معاملة أهلها على أنهم مواطنون حيث إنه انتهت الظروف التاريخية التي تأسس عليها عقد الذمة وبالتالي إمكانية انتهاء هذا العقد واستبداله بمفهوم المواطنة وقبول غير المسلمين كمواطنين لهم جميع الحقوق, ولكن على العكس، فإن أنصار التيار الإسلامي المتشدد لا يرحبون أصلا بفكرة المواطنة إذ يعتبرونها مفهومًا غربيًا مستوردًا لا يعكس الأسس الشرعية التي يجب أن يقوم عليها المجتمع الإسلامي. وربما يرجع ذلك إلى اقتران الغرب في الذاكرة الإسلامية بالاستعمار واستنزاف الموارد وتشويه الشخصية القومية. وبالتالي لا يصرحون بالمساواة التامة بين جميع المواطنين في المجتمع المسلم فهم مازالوا يتمسكون بصيغة أهل الذمة بأسلوب نقلى لا اجتهاد فيه وبأبدية الصبغة التاريخية لهذا العقد حتى إنهم يرون عدم جواز ولاية غير المسلمين على المسلمين وبالتالي رفض إمكانية المساواة. أما من حيث نظرة التيارين: المعتدل والمتشدد لفكرة الديمقراطية، فكما هو متوقع، يؤيد المفكرون الإسلاميون المستقلون هذه الفكرة منفتحين عليها بينما ترفض الجماعة المتشددة كلا من الديمقراطية والتعددية السياسية.
أما عن التيار القبطي، فقد بدأ في الظهور على الواقع السياسي المصري في فترة السبعينيات بشكل خاص کرد فعل عكسي لتعصب الأغلبية الإسلامية وظهور تيار الإسلام السياسي وأيضًا كتطور طبيعي في النشاط التاريخي والوطني للكنيسة الأرثوذكسية، فهذا التيار يهدف إلى تأصيل مفهوم المواطنة المصرية ومعالجة عوامل التوتر الكامنة في علاقة طرفي الأمة إلى جانب دراسة العلاقة بين الأقباط والقومية العربية. ويشير الكاتب إلى إسهامات «ولیم سليمان قلادة» كأبرز المفكرين الأقباط في هذا المضمار إذ يعتبره الكثيرون فقيه المواطنة الأول لمحاولاته الحثيثة في الحفاظ على الوحدة الوطنية المصرية ضد كل اتجاهات التطرف ومحاولات الوقيعة بين المسلمين والأقباط سواء النابعة من الداخل أو من الخارج. إذ يرى قلادة أن وحدة الشعب المصرى تقوم على وحدة الأرض والشعب والتنظيم السياسي. ويرى أن المواطنة هي نتيجة مزيج بين الحقوق المدنية المتمثلة في حقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق المواطن بشكل خاص وبين الحقوق السياسية التي تضمن للفرد المساهمة الإيجابية في ممارسة السلطة العامة في بلاده. ويستنتج قلادة أهمية التعددية الدينية في المجتمع المصري إذ أن احترام الآخر الديني هو الشرط الضروري لاحترام الآخر السياسي.
وينتقل بنا الكاتب في الفصل الثالث إلى التيار الاشتراكي «الماركسي» معترفًا بصعوبة تحليل هذه الحركة تاريخيًا في مصر إذ أنها ووجهت بكثير من التشويه المتعمد من قبل القوى السياسية المناوئة، فآثرت السرية والتكتم في شكل تنظيمات غير معلنة حتى أن كثيرًا من أدبياتها السياسية والفكرية لا يزال غير معروف بشكل واضح تمامًا حتى اليوم. ومن الجدير بالذكر أن الموقف الماركسي التقليدي من المواطنة كان سلبيًا إذ يعتبرها مفهوما ليبراليًا في الأصل ويركز على الحقوق المدنية والسياسية أكثر من الاقتصادية والاجتماعية، ويعني حماية حقوق الطبقات التي تملك أكثر من مراعاة مصالح الذين لا يملكون. وإذا رجعنا إلى الجذور التاريخية لهذه الحركة في مصر نجد أنها بدأت مع الأجانب الذين وفدوا إلى مصر صر في أوائل القرن العشرين من بلاد اشتد فيها الصراع بين العمل ورأس المال. لذلك بدأ نشاطهم بتأسيس النقابات العمالية الأولى في مصر، ثم بدأ ذلك اليسار العمالى في الالتحام بالعمل الوطني من خلال مشاركته في ثورة 1919، ومن بعدها تكون الحزب الاشتراكي المصرى عام 1921 فطالب بتحرير مصر من الاستعمار وبالتوزيع العادل للثروة وبتحسين أجور العمال. وقبيل ثورة 1952، صدر برنامج الحزب الشيوعى المصرى عام 1951 ليؤكد، ضمن مجموعة توصيات، ضرورة التحرر من الاستعمار الأجنبي، والقضاء على نظام الإقطاع والاحتكار الرأسمالي للأراضي الزراعية وضرورة إقامة ديمقراطية يكون الحكم فيها للشعب بجميع طبقاته، وتعزيز حقوق المرأة وجعل التعليم حقًا لكل مصري. ورغم ذلك، فقد اصطدم هذا التيار بجمال عبد الناصر الذي زج بالفصائل الشيوعية في السجن، ولعدم تحديدهم موقف واضح من ثورة يوليو، قامت معظم القيادات الماركسية بالانضمام فرادى إلى النظام الناصري بدعوى أنه يتحرك نحو تحقيق الاشتراكية. وفي علاقة التيار الماركسي بالمواطنة والديمقراطية فإنه ينحاز للطبقات الشعبية ويطالب بالعدالة الاجتماعية والاقتصادية في المقام الأول إذ يرى أن الديمقراطية السياسية هي رهن على تحقيق المساواة الاجتماعية. ومن كل ذلك يرى الكاتب أن اليسار المصرى يعمق من فكرة الديمقراطية الاجتماعية ويؤمن بأن الإنسان هو الوحيد القادر على تفسير العالم وتغييره لصالح أهدافه.
أما عن التيار الناصري، فيبين الفصل الرابع صعوبة تعريف هذا التيار لعدم انطلاقه من أدبيات فكرية وسياسية محددة. ولكن يمكن تعريفها بأنها الحركة التاريخية التي قادها الرئيس جمال عبد الناصر سواء بالسلب أو بالإيجاب طوال الفترة ما بين عامى 1952 و1970.
ويقدم الكاتب الناصرية كظاهرة هي سمة مشتركة بين الانقلابات العسكرية في العالم الثالث والتي تهدف إلى الاستقلال الوطني، أما الناصرية كممارسة فهى تطبيقات وتغييرات استحدثها عبد الناصر في محيط المجتمع المصري. وللناصرية إنجازات مهمة في بلورة مفهوم المواطنة من خلال تدعيم فكرة الجماعة السياسية رغم فقر مستواها في المشاركة الفعلية في العمل السياسي، لذا يطلق على المواطنة في المرحلة الناصرية مصطلح «المواطنة المبتسرة». ورغم ذلك، فقد ربحت قضية المواطنة على يد الناصرية عدة مزايا مثل: الاستقلال الوطني وتحقيق الهوية القومية من خلال تدعيم التماسك الاجتماعي بين المواطنين المصريين وإزالة التمايز بينهم كإلغائها لجميع الألقاب التي تذكرهم بالعهد البائد، وتمصير الاقتصاد. المزية الأخرى كما يراها الكاتب، هي تطبيق ديمقراطية اجتماعية مؤكدة أن الحرية السياسية والحرية الاجتماعية هما وجهان لعملة واحدة وهي أيضًا منتقدة للديمقراطية الليبرالية في فترة ما قبل الثورة والتي كانت تحمي مصالح القلة الثرية فقط. ربحت المواطنة أيضًا ضمان حقوق وحريات المواطنين في الدساتير الناصرية إذ أكدت مساواة المصريين أمام القانون في الحقوق والواجبات ومساواة المرأة بالرجل في الحقوق السياسية، كما دعمتمن مسألة الوحدة الوطنية أيضًا بحيث ألغي أي تمييز بين الأفراد قائم على أساس الجنس أو الأصل أو اللغة أو العقيدة.
وبعد سرده لتيارات فكرية مختلفة أثرت في التاريخ الحديث للساحة السياسية المصرية وفي مفهوم المواطنة، يذهب الكاتب في الباب الثالث ليبين معوقات الممارسة السياسية للمواطنة في الواقع السياسي المصري. ويبدأ الفصل الأول شارحًا لفكرة الدولة التسلطية. فبالرغم من أن الدولة تعتبر الضامن الأول لحقوق وحريات الأفراد في المجتمع إذ أنها تعطيهم صفة المواطنة من خلال منحهم جنسيتها لكن الدولة في العالم الثالث خاصة تكون في كثير من الأحيان العقبة الأساسية أمام نيل هؤلاء الأفراد لحقوقهم بسبب الحكم السلطوى الذي يظهر في احتكار السلطة ومركزيتها. فبالنسبة للنموذج المصري، فإن مصر دولة مركزية منذ قيام الدولة الفرعونية القديمة وقد كانت دائما المركزية هي النواة التي يتمركز حولها البناء الاجتماعي فيتحدد شكل الإنتاج والعلاقات الاجتماعية. ويرى أنصار الدولة المصرية أن أي تصدع في هذه الدولة دائمًا ما يصاحبه انهيار كامل في جميع الوظائف الاجتماعية، أما على الجانب الآخر، فيعتبرها البعض متسلطة على الفرد وخانقة للنمو الاقتصادي، فرغم أن الدستور هو القانون الأعلى في المجتمع السياسي وأن مبدأ سيادة القانون يضمن للأفراد حقوقهم وحرياتهم، فإن التاريخ الحديث المصرى – كما يراها الكاتب – يشهد سيطرة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية مثلما حدث في فترة النظام الملكي والتي اتسم حكمها بالاستبداد وعدم احترام قواعد الحياة الدستورية مما أظهر للمواطن العادي أن السياسة أمر ليس من عمله. في الحقبة الناصرية، فقد فرض حظرًا على تعدد الأحزاب مما أشعر المواطنين بأن التنظيمات الحزبية الموجودة هي مجرد جهاز سلطوي وأداة رقابية وليست قنوات اتصال بين الجماهير والسلطة السياسية. إلى جانب ذلك فالثقافة المدنية نفسها غير مرحبة بفكرة التعددية وقبول الاختلاف وحرية الاعتقاد والرأي، فكل هذه العوائق تحول دون تدعيم مفهوم المواطنة لدى الأفراد.
ثم ينتقل بنا الكاتب في الفصل الثاني إلى المسألة الطائفية وإشكالية الأقليات، فيرى أنه يندر وجود مجتمع متجانس من شتى الأوجه، فلابد أن ينطوي على أقلية ما سواء في الدين أو اللغة أو الأصل القومي أو حتى الطبقة السياسية أو الاقتصادية أو الثقافية. فمن أهم متطلبات المواطنة هو تصحيح علاقة الأقلية مع الأغلبية في المجتمع نفسه والتخلص من أي خطر طائفي قد يهدد الصالح العام. فالطائفية خطر داهم على أي مجتمع إذ غالبا ما يستخدم الدين كوسيلة لتحقيق أهداف دنيوية ويحرم المرء من حقه في المساواة وفي تعامله مع الدولة والمجتمع في إطار ديمقراطي.
وفي التجربة المصرية، فإن مصر من أكبر البلدان العربية المتجانسة إثنيًا ويتمتع مواطنوها بالمساواة الكاملة بحكم الدستور والقوانين الوضعية. ولكن لم يخل المشهد المصرى من لحظات توتر وصراع خاصة بين المسلمين والأقباط إذ يرى الكاتب أن اشتعال نار الفتنة يرتكز أساسًا على مظاهر التفرقة والشعور بعدم المساواة في الحقوق بين عنصرى الأمة، فمنذ الأربعينيات، ظهرت أمثلة مجحفة بحقوق المسيحيين في تولى المناصب والتعليم ثم في وقت الثورة لم يشغلوا الوظائف السياسية والإدارية والعسكرية والقيادية مما أدى إلى هجرة العديد منهم إلى البلاد الغربية وسموا «أقباط المهجر»، ويرون أن الهموم القبطية تعبر عن مشكلات المواطنة في وطن واحد يجب أن يؤمن بالديمقراطية وأسس الدولة الحديثة. ويعتقد الكاتب بأن مسألة الفتنة الطائفية هي من أخطر العقبات التي تعترض مسيرة المواطنة في مصر وتجب إزالتها من قبل الدولة والقيادات المسيحية والإسلامية إلى جانب المفكرين والباحثين.
يناقش الفصل الثالث أهمية التنشئتين السياسية والاجتماعية للأفراد في الإعلاء من قيمة المواطنة. فالتنشئة السياسية هي التي توجه الأفراد إلى تبنى نظام وسلوك معين، أما التنشئة الاجتماعية فهي مجموعة القيم التي تلازم الفرد طوال حياته والتي تصوغ سلوكه إزاء المجتمع من حوله. ويتشكل ذلك من خلال دور وسائل التنشئة، مثل: الأسرة والمدرسة ووسائل الإعلام والفنون والتي تجعل من الفرد كياناً أكثر إيجابية للمشاركة السياسية في الحياة العامة والتي تؤتى ثمارها من خلال التطور الديمقراطي في المجتمع. فبالنسبة للتعليم وأهميته يذكر الكاتب الدور الرئيسي الذي تلعبه المؤسسات التعليمية في تشكيل السلوك السياسي لدى الأفراد منذ الصغر وفي تطوير الشخصية والموضوعية في التفكير والفكر النقدى والمرونة العقلية. أما من جانب الأحزاب فأهميتها بالغة بالنسبة للتنشئة السياسية إذ تساعد مؤسسات المجتمع الأخرى في التنشئة الديمقراطية ويجب أن يتوافر لدى هذه الأحزاب منهج ديمقراطي أصيل ومرجعية أيديولوجية وفلسفية داعمة لهذا المنهج حتى ينطلق منها الحزب على أساس متين. ويجب أن تتجه نشاطات هذه الأحزاب إلى المجتمع أيضًا لا إلى داخلها فتصبح أقرب إلى نوادى سياسية عقيمة. أما عن دور الإعلام في هذه المنظومة فهو حيوى للغاية إذ يملك القدرة على تغيير اتجاهات وآراء الأفراد من خلال مقدرته العالية في الوصول إلى كل جزء من الوطن بإمكانات مبهرة تاركًا أكبر الأثر على معالم البناء الاجتماعي والثقافي للمجتمع. ولعل ارتباط الإعلام بالديمقراطية منذ انتشار الصحيفة ثم محطات الإذاعة في أوروبا وأمريكا الشمالية يؤكد أن قوة الإعلام من قوة الديمقراطية وأن الإعلام الحر هو الرئة التي تتنفس من خلالها الديمقراطية مما يجعلها تسمى بالسلطة الرابعة بعد التشريعية والتنفيذية والقضائية. لذلك يرى الكاتب أن التنشئة الجيدة للأفراد وتأكيد حقهم في المعرفة وحرية الرأي والتعبير دون تقييد هو من أفضل السبل لبزوغ رأى عام حى وناضج يؤمن بالمواطنة ويمارسها.
وينتهى الباب الثالث بالفصل الرابع مناقشًا مشكلة الهوية. فيبدأ الكاتب بتعريف المصطلح بأنه بحث كل جماعة عن هويتها داخل الجماعات الكبرى وعن الخصائص التي مساعدته تميزها. وقد انتشر استخدام هذا المصطلح مع فكرة القومية والبحث عن الهوية الثقافية لكل بلد كرد فعل عكسي تجاه النزعة العقلانية الكونية والتي أعطت شرعية لنظريات التوسع الغربي الذي يزعم للشعوب المتأخرة والمتخلفة ثقافيًا، فجاء مفهوم الهوية الثقافية كدليل على العمق الثقافي للجماعات المختلفة. وفي السبعينيات بدأ الحديث عن التعددية الثقافية في ظل عالم جديد مشجع للتعدد والتميز والاختلاف. إلى جانب فكرة القومية، فالهوية مرتبطة أيضًا بمفهوم الانتماء فهوية المجتمع تمنح أفراده مشاعر الأمن والاستقرار نتيجة انتمائهم إلى جسم أكبر. ولكن مسألة الهوية تتطلب الإجابة عن أسئلة مثل: من أنا؟ ومن نحن؟ ولمن يكون الولاء؟ والإجابات هذه الأسئلة هي التي تحدد الطابع العام للمجتمع، فإذا تباينت هذه الإجابات أصبحت هناك أزمة هوية. ففي مصر، مسألة الهوية الوطنية المصرية مقسمة ما بين فرعونية ومتوسطية وعربية وإسلامية ولكن يعتقد الكاتب أن المفهوم السوسيولوجي التاريخي للهوية هو الأقدر على إمدادنا بتصور صحيح لها. ويوصى برفض أشكال التعصب كافة لفرع واحد من الهوية دون الآخر مؤكدًا أن التطور والتفاعل للهوية هو من روافد غناها وليس من أسباب إلغائها.
يتخذ الباب الرابع العولمة والمواطنة الغربية موضوع البحث ويبدأ الفصل الأول بشرح لمفهوم العولمة. فقد احتل هذا المفهوم اهتمام المحافل العلمية ودوائر صناعة السياسات واتخاذ القرار على مستوى العالم خاصة في السنوات العشر الأخيرة من القرن العشرين وبالذات بعد سقوط الاتحاد السوفيتي. والعولمة هي مفهوم مركب ومنتشر في الحقول المعرفية كافة بحيث يمكن تعريفها بأنها الفعل أو التصرف الذي من خلاله يصبح الشيء كونيًا وشاملاً للعالم بأكمله. ورغم أن المصطلح نشأ من دون تصور مسبق متكامل له وأنه ما زال في طور الاكتمال فإنه من المتوقع أن يكون العامل الأساسي في توجيه مسار وآفاق الحضارة الإنسانية في الألفية الثالثة. ولعل من أهم تجليات العولمة النمو الاقتصادي والاعتماد المتبادل بين اقتصادات الدول واتساع نطاق التبادل التجاري ووحدة أسواق المال. ومن الناحية السياسية فالعولمة هي أبرز دليل على سقوط الأنظمة الشمولية واعتاد التعددية الحزبية نموذجًا للممارسة السياسية. وحتى في مجال العلاقات السياسية بين الدول فقد التزم الجميع بحدود القانون الدولى وأحكامه. وفي تجلياتها الاتصالية، أضحى التدفق الإعلامي والمعلوماتي الآن هو خير رابط بين البشر في شتى أنحاء العالم مؤديًا إلى أعظم ثورة معرفية في تاريخ البشرية. وللعولمة إسهامات ثقافية أيضًا في شكل توحيد القيم وأنماط التفكير بين مختلف الشعوب مما يزيد من مساحة التقارب والفهم المتبادل بين البشر. وبالرغم من أن سيطرة اقتصاد السوق الحرة على الاقتصاد وثورة الابتكار التكنولوجي واختصارًا للمسافات قد أديا إلى ظاهرة العولمة فإن نتائجها السلبية تتضح في تقلص سيادة الدولة وظهور العولمة المضادة من قبل بعض الجماعات المدافعة عن هوياتها. أما بالنسبة للعلاقة بين العولمة والمواطنة فلها جوانب إيجابية وأخرى سلبية: الإيجابية تظهر في سقوط الحواجز في مجال الاتصال، أما السلبية فهي في محو الهوية الثقافية لكل جماعة وفي سياسات التحرير الاقتصادي والتي أثرت سلبًا على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لبعض الأفراد في بلاد متعددة. ولكن يؤكد الكاتب أن المواطنة هي العضوية الكاملة في الدولة إذ تمنح المواطنين بعض الحقوق وتفرض عليهم بعض الواجبات.فالمواطنة هي أساس الشرعية السياسية وهي مصدر العلاقات الاجتماعية إذ يخضع الجميع للنظام السياسي نفسه. وفي ظل العولمة، أصبحت المواطنة تتخطى نطاق الدولة إذ ظهرت المواطنة الثقافية والبيئية والعالمية والسياحية لتؤكد اتفاقًا عالميًا عامًا وهو أن هناك حقوقًا إنسانية عالمية ينبغي تطبيقها بغض النظر عن تنوع المجتمعات واختلاف الثقافات.
وننتقل في الفصل الثاني إلى العلاقات بين العولمة والدولة القومية وظاهرة الاتحادات الإقليمية. فبالنظر إلى تأثير العولمة على مفهوم الدول القومية نرى أنها من أكبر المتضررين من صعود العولمة واتساع نطاقها إذ تضعف من الاستقرار الاجتماعي والسياسي داخل المجتمع من خلال فقد الدولة القومية لكثير مما كانت تباشره من وظائف وصلاحيات. فمن مظاهر الفشل وإضعاف الاستقلالية القومية ظهور حركات المعارضة التي تتبع الأساليب السلمية أو المسلحة والتي اكتسبت بعدًا دوليًا بفضل العولمة مشكلة بذلك تحديًا فعالاً لحكوماتها. ولذلك، فإن الدولة القومية في ظل العولمة أصبحت تواجه عدة قيود على قدراتها في صياغة سياساتها الداخلية والخارجية وفى تنفيذها وطريقة قيامها بذلك في ظل تعدد علاقات القوة في المجتمع السياسي.
وبالنظر إلى الناحية الاقتصادية، نجد أن العولمة هي عملة ذات وجهين إذ تضعف من شرعية الدولة وتقلص دورها الاجتماعي بينما تدعم جماعات معينة مثل رجال الأعمال وممثلي الشركات الأجنبية المرغوبين في سوق العمل العالمي على الجانب الآخر. ولكل ما سبق تأثيره البالغ على مبدأ المواطنة إذ أن المواطنة القومية الآن باتت تعيش حالة أزمة إثر ضعف الرابطة بين المواطن وبلده والذي يظهر جليًا في حالة المهاجرين يعانون من ضعف هذه الرابطة سواء في بلادهم الأصلية أو في الدول الجديدة التي هاجروا إليها مما يجعل البعض يرى الحل في مفاهيم مثل المواطنة العالمية أو مواطنة ما بعد القومية. ثم ينتقل الكاتب إلى مرحلة ما بعد الحرب الباردة والتي شهدت دعاوى قومية لتوحيد العالم وصهره في ثقافة كونية واحدة مما أدى إلى إقامة تكتلات اقتصادية وسياسية إقليمية للتكيف مع عصر العولمة إيمانًا منهم بأن المردود الاقتصادي للجماعة أكبر بكثير من الأداء الفردي للدول. ورغم أن هذا الفكر كان بمثابة ضربة قاصمة للبناء الأيديولوجي المستقر في المجتمعات ومضعفًا لهوياتها، لكن تجربة الاتحاد الأوروبي هي من أكبر التجارب اكتمالاً سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وهي في تحسن دائم. ويأتي ذلك من إيمان دول الاتحاد بأن التكامل الإقليمي الفعال والشامل والذي يستبدل مفهوم الانتماء المرتكز على الأمة بفكرة حقوق الإنسان المتخطية للحدود القومية سينتج مواطنًا أوروبيًا جديدًا ينظر للمواطنة من زاوية التضمين والتكامل الإقليمي وليس الإقصاء.
أما عن الفصل الثالث، فيشرح المواطنة العالمية وبروز المجتمع المدنى العالمي. فيرى الكاتب أن ظهور ثقافة سياسية عالمية جديدة هو من أبرز إيجابيات العولمة والتي ظهرت في أعقاب بزوغ المجتمع المدني العالمي خلال التسعينيات من القرن العشرين، فانتشرت بذلك منظمات غير حكومية تبنت قيمًا إنسانية جديدة وتهتم قضايا البشرية جمعاء مثل قضايا حقوق الإنسان، والسكان، والمرأة، والبيئة، والعنصرية إلى غير ذلك. وقد أدى ذلك إلى إمكانية تحقيق مواطنة عالمية بدلاً من المواطنة الوطنية ذات الهوية المحلية المحدودة دافعة البشرية بذلك إلى النظر إلى ذاتها ككتلة واحدة وذات مصير مشترك في ظل قيم إنسانية عميقة ومشتركة تتخطى الخصوصيات الحضارية، أما عن ظهور مجتمع مدني عالمي فيظهر ذلك في شكل المؤسسات المدنية القومية التي يتعدى نشاطها الحدود السياسية أو الجغرافية لتدافع عن قضايا ذات سات عالمية. ولكن لا يمكننا القول بأن مضامين العولمة كلها ذات طابع إيجابي إذ تواجهها عقبات عدة مثل الفروق الشاسعة بين الشمال والجنوب وتفاوت معدلات التطور بين الدول المتقدمة تكنولوجيًا وغيرها من الدول الناشئة صناعيًا إلى جانب انتشار موجات الإرهاب الذي تمارسه جماعات أيديولوجية مختلفة في العالم، لذا، فإن التقدم الفعلى نحو تحقیق مواطنة عالمية يعتمد على ضرورة تقوية المؤسسات العالمية كالأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية الدولية ووضع تصورات واضحة لشكل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي يمكن للمجتمع الدولى التمسك بها وتطبيقها. ورغم العقبات، تظهر تجليات المجتمع المدني العالمي واضحة في شكل المنظمات غير الحكومية والتي تجاوزت الإطار الوطني واخترقت الحدود الجغرافية القومية وأيضًا في شكل الحركات الاجتماعية والتي يلتف حولها مجموعات من البشر لهم اهتمامات مشتركة ويهدفون إلى تحقيق تغيير اجتماعي مؤثر من خلال التعبئة الشعبية. وهذه الحركات هي بالأساس مناهضة للعولمة الرأسمالية. لذلك كثيرًا ما ترفع شعارات مثل «الإنسان قبل الأرباح» و «عالمنا ليس للبيع»، ورغم أن هذه الحركات لم تمتلك بعد برنامج عمل محدد الأهداف لكنها قادرة على توحيد الرأى العام تجاه بناء سياسات تخدم المواطنين.
يحمل الباب الخامس والأخير من هذه الدراسة عنوان «العولمة والمواطنة المصرية» محللاً العلاقة بينهما إذ يبدأ الفصل الأول مناقشا للفكر المصري المعاصر وموقفه من ظاهرة العولمة. شأننا شأن كل دول العالم، فإن مصر تتعرض لتأثيرات هذه الظاهرة على الأصعدة كافة، ولكن يؤكد الكاتب أن العولمة تظهر في كل مجتمع حسب خصائصه الثقافية وتكوينه الاجتماعي وتتفاعل مع سياسات دولته. وبما أن المجتمع المصرى هو مجتمع مركب وصاحب إرث حضاري متنوع، فيشير الكاتب إلى المواقف المختلفة للتيارات الأساسية في الفكر السياسي المصرى من العولمة وآثارها على المواطنة المصرية وهي: اليساري والإسلامي والليبرالي.
فنجد أن التيارين اليساري والإسلامي يتخذان موقفًا متحفظًا وأحيانًا معاديًا للعولمة بينما تقف القوى الليبرالية موقف المشجع لها والمتفائل بها. فاليسار المصرى يرى أن العولمة تطوى في تأثيراتها مخاطر عديدة على الشعوب غير الأوروبية بوجه خاص من حيث آثارها السلبية المتوقعة على الاقتصاد المصرى ونسيج العلاقات الاجتماعية وحقوق المواطنين السياسية والمدنية والحضارية فيرون أنها مجرد تطور للرأسمالية المعاصرة تهدف إلى مضاعفة وتعميق الفجوة بين بلدان الرأسمالية المتقدمة المستقطبة وبلدان العالم النامي. أما التبار الإسلامي، فرغم اعترافه بالجانب الإيجابي للعولمة لاتساع التواصل الإنساني بين البشر من خلال الثورة المعلوماتية والاتصالية، لكنه غالبًا ما يرى أنها شكل من أشكال رغبة الولايات المتحدة للسيطرة المنفردة على باقي الدول معطية لنفسها الحق في وضع معايير حقوق الإنسان وحق التفتيش على الدول والتدخل بكل أنواعه بسياسة ازدواجية المعايير. بل ويرى بعض مفكرى هذا التيار أن العولمة في أساسها هي استكمال للمشروع الاستعماري الغربي للهيمنة الاقتصادية والسياسية على العالم. ويرى بعضهم أيضًا أن العولمة هي سلاح موجه ضد الإسلام بالدرجة الأولى إذ أن العولمة الغربية تريد أن تفرض نفسها كبديل للإسلام صاحب الدعوة العالمية، وأن العولمة تحمل في جوهرها الثقافة الغربية محاولة تعميمها على الساحة العالمية. وعلى العكس، فإن التيار الليبرالي متحمس للفرص التي تتيحها العولمة في مجالات الاستثمار الأجنبي والاستقرار السياسى وتكريس حقوق الإنسان وبناء الخبرات التكنولوجية والمعلوماتية. ويرى أنها نتيجة طبيعية لحركة التاريخ وأنها تدعم الاندماج والترابط في أوضاع الاقتصاد العالمي والانفتاح على العالم، ولكن يجب على مصر أن تأخذ بنظم صارمة للانضباط المالي والقانوني السليم وأن توفر مناخًا سياسيًا وتشريعياً يمكن المواطن من ممارسة حقوقه وواجباته السياسية والاقتصادية.
أما الفصل الثاني فيظهر لنا موقف الدولة المصرية من تحديات العولمة. فمن الناحية السياسية، فإن العولمة تطرح ضرورة انتقال الحكم إلى الشكل الديمقراطي الذي يحترم حقوق الإنسان وتتداول فيه السلطة بين الأحزاب السياسية في انتخابات حرة ونزيهة. وعلى المستوى المصري، فإن قضية الإصلاح السياسي الديمقراطي قد شغلت مساحة كبيرة في الحوار المصرى العام. ورغم أن القوى الغربية المتمثلة في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا تؤكد دائمًا ضرورة تحول الأنظمة السياسية في دول الشرق الأوسط نحو الديمقراطية معللة السبب في ذلك بأن غياب الأنظمة الديمقراطية في المنطقة هو ما أدى إلى التطرف والإرهاب المتسببين في اعتداءات 11 سبتمبر 2001، لكن الحزب الوطني الديمقراطي في مصر يرى أن عملية الإصلاح هي من صميم السيادة الوطنية وأن نتائج هذه العملية يجب أن تستند إلى التقاليد والخصائص والأدوات المصرية الخالصة. ويعتبر الحزب الوطنى أيضًا أن قضية المواطنة مهمة وحيوية للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، فيرى أن لتدعيم قيمة المواطنة، يجب على الدولة أن توفر مناخًا سياسيًا وتشريعيًا وإداريًا يمكن المواطن من أداء دوره في عملية التنمية، وأن تحدث من نظم الإدارة المحلية لتشجيع المواطن على المشاركة في تنمية مجتمعه المحلي. أما على الصعيد الاقتصادي، فالعولمة الاقتصادية تؤكد ضرورة الانفتاح الاقتصادي المتبادل والاندماج في الاقتصاد العالمي، لذلك فالاقتصاد المصرى متجه نحو الانفتاح على العالم الخارجي من خلال التحرير المتزايد للتجارة ونقل مركز القوة الاقتصادي من الدولة إلى القطاع الخاص. ولكن للعولمة انعكاساتها السلبية على مستويات التشغيل في سوق العمل المصرية في ظل سياسة خصخصة المشروعات العامة والتي أدت إلى تقليص العمالة الزائدة والزيادة في معدلات البطالة، فإن العولمة الاقتصادية تخدم مصالح صفوة محدودة العدد بشكل أكبر في عمليات الإنتاج والتراكم الرأسمالي.
يوضح الفصل الثالث شكل المجتمع المدني المصري في ظل التحولات في مفاهيم الهوية والانتماء، ويشرح لنا الكاتب أن في الفترة الأخيرة، شهدت مصر صحوة في المجتمع المدني من خلال المنظمات الأهلية والتي ترعى التنمية الاجتماعية والبيئية للمجتمع بجانب حقوق الإنسان والمرأة والسكان. وتعتبر مؤسسات المجتمع المدني الإطار الأمثل لإشاعة الثقافة المدنية في المجتمع وتربية المواطنين عمليًا على الممارسة الديمقراطية والتسامح والعقلانية، فالمجتمع المدني هو ساحة لتقييم التيارات الفكرية والسياسية عن نفسها. ويتمنى الكاتب من المجتمع المدني في ظل العولمة أن ينظر دائماً إلى الأمور نظرة كلية شاملة واعياً أن مشكلات المجتمع تقع في كل مترابط مع الأبعاد الإقليمية والدولية وليست محكومة فقط بالإطار القومي. ويرى أن العولمة الثقافية تعكس رغبة القوى الكبرى المتحكمة في العولمة في بسط هيمنتها على العالم ونشر ثقافة واحدة محددة من خلال السيطرة على القطاعات والشبكات الاقتصادية والثقافية والإعلامية. وبما أن الثقافة تعد تلخيصًا للصفات الإبداعية والاجتماعية والسلوكية والعقيدية التي تميز مجتمعًا عن آخر، حيث يعد البعد الثقافي من أكثر المؤثرات على هوية الفرد والجماعة معًا، فيحذر الكاتب من خطر التطبيق غير الواعي لثقافة العولمة وخطر الاختراق الثقافي الغربي السمات على حق التنوع الثقافي. فالعولمة لا تحترم مبدأ السيادة الثقافية وتسعى إلى تذويب الثقافات الإنسانية المختلفة واستبدالها بثقافة ذات طابع أحادي بقيم ومعايير موحدة. وبالنظر إلى الكيان الثقافى المصرى وخصوصيته نجد أن خطورة تأثيرات العولمة الثقافية عليه تكمن في نزوع المجتمع المصرى نحو الشكلانية والجمود خاصة أن ثقافة الصورة هي المعبر الحقيقي عن العولمة الثقافية، ونزوعه للاستهلاكية، وانحسار مستوى المشاركة نتيجة شعور الأجيال الشابة بالاغتراب وتراخى الولاء القومي. لذا، فيجب على قوى المجتمع توسيع ساحة العمل الأهلى وزيادة الإنتاج والمشاركة والإبداع بدلاً من الاستهلاك والتلقى والمحاكاة.
وأخيرًا يناقش الفصل الرابع قضية المواطنة المصرية وإشكالية الحماية الدولية للأقليات الدينية. إن هذه العلاقة – وفقًا لما يراه الكاتب – لا تتعلق بالدين بالدرجة الأولى ولكن تتدخل مباشرة في الشأن الداخلي للدول وهدفها إذابة الخصوصيات القومية فيها تمهيدًا لإحلال المجتمع العالمي بالمعنى الغربي – وخاصة الأمريكي – محلها والذي تتلاشى فيه الثقافات الوطنية وتسيطر عليه القيم والرؤى الغربية. فلقد كان التوظيف السياسي للأديان من أقوى المحددات للعلاقات الدولية منذ نشأة الإمبراطورية الرومانية حتى استبدالها «بالإمبراطورية الأمريكية» في عالمنا الحاضر. فلطالما استهدف الغرب الاستعماري محاربة العالم العربي الإسلامي من خلال تفتيت علاقاته الاجتماعية الداخلية وتفكيكها إلى هويات أكثر تنوعًا. ففي مرحلة الاحتلال البريطاني لمصر، رفع شعار حماية الأقليات الأجنبية والدينية لتأجيج الانشقاقات الطائفية. وفي حاضرنا اليوم، ترفع الولايات المتحدة الشعار نفسه مستخدمة إياه كمظلة للتدخل في شئون الدول الأخرى بهدف إقامة أنظمة ديمقراطية تتماشى مع اقتصادات السوق، ففي عام 1990، استصدرت إعلانًا من الأمم المتحدة ينص على متابعة الولايات المتحدة لشئون الأقليات بنفسها دون الرجوع للأمم المتحدة، ويحذر الكاتب من خطر تلك التدخلات على المواطنة، إذ يرى أن الخطاب عن الأقليات يرسخ فكرة تجزيئية للمجتمع، بينما تهدف المواطنة إلى مساواة الجميع في الحقوق والواجبات. وتظهر سياسة الكيل بمكيالين التي ينتهجها الغرب تجاه حقوق الأقليات الدينية في العالم، ففى الوقت الذي يدافع عن تلك الحقوق في المشرق لا يكاد يقيم وزناً لحقوق الأقليات المسلمة في بلاده. وعلى الصعيد المصري، فإن أزمة المواطنة هي نتيجة تراجع التيار الوطني الذي يحتضن الدينين في وطن واحد وظهور التيارات الدينية المميزة بين المواطنين على أساس الدين، فيؤكد الكاتب أن المرجعية الحقيقية في الوطن يجب أن تظل هي «الوطنية» و «حقوق المواطنة» وأنه يجب على الدولة أن تكفل للمواطن حقه السياسي المتساوى مع الآخرين للخروج من تلك الأزمة.
وفي نهاية دراسته البحثية، يلخص الكاتب في خاتمتها النتائج التي سبق ذكرها من خلال أبواب هذه الدراسة الخمسة. فيرى أن مفهوم المواطنة على الصعيد الغربي قد مر بعدة مراحل بداية من الإغريق القدماء وحتى تطوره بشكله الحديث في القرن العشرين ويناقش تأثير الظواهر الجديدة مثل التعددية الثقافية على تطور المفهوم، وأن مفهوم المواطنة في الفكر السياسي المصرى متباين عند التيارات الفكرية الرئيسية: الليبرالى والإسلامي والاشتراكي. ويحذر من الأخذ بالمواطنة كشكل بلا مضمون ويؤكد أهمية دور الدولة في ضان حقوق وحريات المواطنين في الممارسة السياسية والمشاركة المجتمعية. ويرى أن المسألة الطائفية في مصر هي نتيجة شعور الأقلية القبطية بتعرضها لتمييز في مجالات مختلفة لذا يحذر من الانجذاب للشعارات الطائفية سواء من قبل الأقباط أو المسلمين، بل على العكس، فإن الإصلاح يجب أن يقوم على أسس وطنية وعلمية وحضارية للحفاظ على وحدة مصر الوطنية. وينتقل ليؤكد ظهور صور جديدة للمواطنة في ظل العولمة والتي أضعفت من سلطة وصلاحيات الدولة القومية. لذا فإن تشجيع المشاركة الاجتماعية والسياسية للمواطنين هو من أبرز الحلول للقضاء على حالة الاغتراب التي يمكن أن يعيشها المواطن في علاقته بمؤسسات الدولة.
لقد قدم الكاتب «قايد دياب» من خلال دراسته البحثية المتعمقة تحت عنوان (المواطنة والعولمة: تساؤل الزمن الصعب) العلاقة القائمة بين مفهومين في غاية الأهمية في تشكيل المجتمعات في عالمنا المعاصر إذ أن المواطنة والعولمة قد شغلا الساحات الفكرية في الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ في مختلف دول العالم لخطورتهما في تشكيل العلاقة بين الفرد ومجتمعه. فعبر خمسة أبواب، عبر الكاتب عن المنظور التاريخي لمفهوم المواطنة في الغرب وفي مصر وكيفية تطور هذا المفهوم في ظل عصر العولمة وما تفرضه من تحولات عالمية. ويتسم أسلوب الكاتب بالوضوح من خلال تقسيم أبواب الكتاب إلى فصول ذات عناوين لمواضيع محددة مستخدمًا أسلوبًا لغويًا يتراوح ما بين المصطلحات الأكاديمية والشرح المبسط لها وإعطاء الأمثلة الموضحة لأفكاره بشكل أقرب للواقع.
*معيدة بقسم اللغة الإنجليزية / جامعة القاهرة.
د. قايد دياب. المواطنة والعولمة: تساؤل الزمن الصعب. القاهرة: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، 2007.