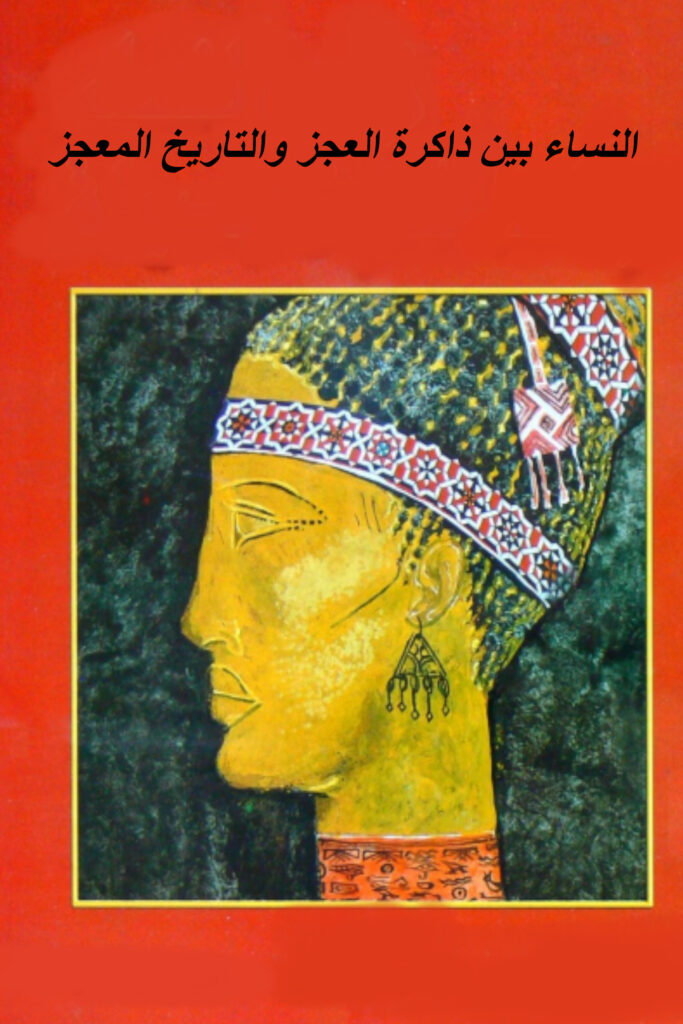النساء بين ذاكرة العجز والتاريخ المعجز
1- مقدمة
شغلتني كثيرًا صفحات الكتب والمجلدات(1) على رفوف المكتبة الجامعية، تلك التي يمكننا تصفحها دون عقبات وروتينية البطاقات، وانتظار عمال المكتبة ذلك الانتظار الممل. وتساءلت مندهشة، عن سبب إهمال تلك المصادر التي تعتبر الشاهد الأفضل على وجودهن (نساء الماضي)، وحركتهن. لقد تعرفت إلى النساء مع تسلل العناكب داخل الأغلفة وكونت أفكارى عنهن مع هؤلاء النساجات المحنكات الصامتات، في فوضى الرفوف، ووقع الانبهار، ودخلت عالمهن الرمادى!.
كنت شديدة الافتتان عندما أقرأ، أن الإمام مالكا تتلمذ على يد امرأة، ثم لا أتذكر، لا المرجع، ولا الصفحة من وطأة المفاجأة، ولكى أرد على استفزازات الحاضر والحاضرين، لكن من يسمعني؟!. ومن يصدق المرأة؟. ولماذا نكون – نحن النساء – في حاجة إلى تبرير المرأة ومكانتها، وما قدمته، وما أنجزته في محاولة – فاشلة – لدحض المكانة – الآنية – الدنيا؟!.
بعد الاطلاع على كتاب “بلاغات النساء” (۲)، بدأت أعيد النظر في إعجابي، وبدأت مظاهر الذهول تزول، وعرفت أن النساء وإن كن “مجتمعاً” فلم يمثلن أنفسهن، بل مثلن الغير أحسن تمثيل، ولم يكتبن عن تجاربهن الخاصة، بل ارتجلن أشعاراً، وبلاغات، عن الأخوة والأحبة من الرجال، ولم يكتبن عن بنات جنسهن؛ فلقد تركن الكتابة – بكل ما للقلم من سلطات – والملك والأفضية الأخرى – أفضية الحكم – للرجال.
النساء يتنازلن، منذ أقدم العصور عن المسؤوليات الكبرى، وذلك عن طيبة خاطر، كما تركت المرأة الأولى (في النيولتيك) السلطة للرجل، تلك التي لم تمارسها يومًا، كما مارسها الرجل بالعصا والمراقبة، وراح مستغلاً صفات الأنوثة، وركع أمامها مؤلها مواطن الخصوبة – مفاتيح الضعف والقوة – فيها ؛ إذ لم تكن رغبته – حينذاك – التقديس، بل كان يريد إبعادها عن الواقع والنشاط..
هل أواصل إعجابي، أم أتريث متسائلة، عن تسامح مجتمع المدينة، أمام تصرفات ومواقف بعضهن، التي تبدو اليوم “مخجلة“، وتعمر لها الأنوف والخدود !! كيف ننقل أخبار “صبى” (3) عن “الجنس“، وتعابير الشهوة الخانقة للأنفاس في فضاء العقل الضيق. والقلب المهموم، ومرارة الأحداث ؟!. ماذا يفيدنا كل ذلك، والنساء يعشن الضغط والتنكيل، بكل أنواعهما، ويواجهن العراقيل المرة المضنية؛ في سبيل تحسين أوضاع الأبناء، وعلى حسابهم الخاص، أولاً وأخيراً؟!.
لم أعد أبحث عن فلانة هنا، وأخرى هناك، بل أصبحت أهتم بالكثرة، بهن متجمهرات في الأحداث، وافدات ومدبرات. توقفت – من عناء البحث – عند “الوافدات على معاوية” (٤)، لقد كن كثيرات، وجريئات، لكن مازلت منزعجة، ولا أزال أتقلب حيرة، فلم أجد نساء أرخن، أو كتبن هواماتهن، مازلت أتقصى بولع روائح حبرهن، وتجسيدات وشمهن، وآثارهن على الورق المصفر، أو على الجلود الناضحة عرقًا وحياة… ماذا لو عثر الأثريون على مخطوط مقبور منذ ألف سنة، نقشته امرأة؟. قد يتغير التاريخ، وتقلب الكرة الأرضية ثانية، فالكتابة هي السلطة – الأولى والأخيرة – لتغيير النظرة.
لحد الساعة لا تزال أقلام “مذكرة” تنقل لنا أخبار النساء، ولسنوات متأخرة جداً، لا يزال – واليوم أكثر مما مضى – إبداع النساء يتعرض لضغوطات جنسية يموهها حبر المتعلمين..
أنقل موقف صاحب “الشعر النسوى الأندلسي” (٥)، الذي أنا مدينة له باستفزازه لى مما جعلني أكتب، وإلا لما تحرك قلمي، لأبين أن الكتابة والإبداع النسويين يطرحان إشكالات وعراقيل كبيرة. فلماذا يستفز، و يستنفر المجتمع المشورب، عندما تكتب الأندلسيات شعراً؟
أخذت الأندلسيات نموذجًا لأسباب عدة، منها:
– ما جاء في الكتاب من مواقف ذكورية صريحة.
– لكثرة الشاعرات من مختلف الطبقات والفئات.
– لامتزاج العناصر البشرية والتقاء الثقافات.
– لتنوع الأغراض الشعرية وظهور الجريء منها.
أبدأ من هذا الأخير، وهو ظهور غرض “الجنسية المثلية“؛ حيث يستشهد المؤلف بشاعرة مغربية أندلسية، وهي حمدونة، في قولها:
ومن بين الظباء مهاة أنس سبت لبي وقد ملكت فؤادي
لها لحظ ترفده لأمر وذاك الأمر يمنعني رقادى
إذا أسدلت ذوائبها عليها رأيت البدر في أفق الدادى (٦)
يعتبر هذا الشعر انتهاكًا لكل رواسب المجتمع التقليدى، وحساسيته اليوم. والموضوع – الغرض، لجرئ إلى حد الوقاحة، يستنكر هذا على الأندلسيات – النساء، مع العلم أن ظاهرة التغزل بالغلمان، كانت سائدة على مختلف العصور، وفي عز الحضارة الإسلامية في حواضر الشام وبغداد.
يقول في هذا الشأن: “وقد بلغ الغزل والمجون الشعر النسوى الأندلسي، دركاً من التهتك المزري، الذي لم يكن له سابق وجود لدى شواعر العرب، لقد شاع بين شواعر الأندلس “الغزل بالمؤنث” (۷).
كذلك يورد ميزة أخرى تميز بها شعر الأندلسيات عن شاعرات المشرق، ألا وهي ميزة الغزل الإباحي والمجون والشهوة: “في أحايين كثيرة نجد المرأة تطلب الرجل، وتبوح بمشاعرها وحبها بصراحة، متجاوزة بذلك حواجز التقاليد في المجتمع وموانعها… وأن هذه المعاني الإباحية، لم تكن معروفة لدى شاعرات المشرق” (8).
ثم يضيف قائلاً: “وهناك موضوع آخر تميزت به الشاعرة الأندلسية، عن أختها المشرقية، حيث أباحت لنفسها أن تتغزل في الرجل، كما يتغزل الرجل في المرأة سواء بسواء، وكان ذلك كله بسبب الحرية المبالغ فيها، تلك التي انجرت إليها المرأة في المجتمع الأندلسي، وكذلك بسبب ضعف الوازع الديني لديهن” (9).
ولست أدري أين يضع الكاتب، ليلى الأخيلية – المشرقية، وتغزلها في توبة، حتى بعد مماته، وإلى أن ماتت بعده.
يورد الكاتب، ميزة الإفحاش في الهجاء، ويرى أن تورط النساء الشواعر فيه، بسبب ضعف الوازع الديني وكثرة المثالب والفجور والمفاسد وقلة ضوابط الحد في المجتمع الأندلسي” (۹).
فنتساءل هنا هل الكاتب مهتم بالأدب، أم هو مقيم وقائم على الأخلاق؟!
في إضافة أخرى يقول، دائمًا عن غرض الهجاء: “هجاؤهن فيه فحش وبذاءة… وذكر للسوءات حتى ليتعفف الرجل من روايته” (١٠).
لهذا نجده يحذف “كلمات” تخدش حياء القارئ، بل حياءه… وهذا في زمن المطابع الحديثة.. ولماذا لم يحذفها النساخ؟.
بالإضافة إلى المميزات التي ذكرت سابقًا، استهوتني هذه الفترة، التي نراها مهمة ومناسبة لإشكاليتنا لسبب جوهري، سبقت الإشارة إليه، وذلك لكون الشاعرات الأندلسيات طبعن حقبتهن بكثرتهن واستعمالهن لغة جديدة، وسطوهن على أغراض جريئة وجديدة على الشاعرات قبلهن.
فالشاعرات الأندلسيات، كثيرات، وينتمين إلى طبقات مختلفة. فليست – فقط – ولادة بنت المستكفي ظاهرة القصر المشرقية، ولا بثينة بنت المعتمد بن عباد الإشبيلية… بل هناك شاعرات الطبقة الوسطى، وشاعرات العامة. وصاحب الكتاب (الشعر النسوى الأندلسي) يذكر منهن الكثيرات، ومن بينهن: مهجة بنت التياني القرطبية (والدها بائع تين).
كذلك لم تكن غايتنا حصر نساء حاكمات، يدرن في رحى السلطة، كما سعت فاطمة المرنيسي لتبيانه، وكان ذلك بشق الأنفس (السلطانات المنسيات) وكرد فعل، وكتبرير لمرحلة هستيرية (مرحلة اعتلاء بي نظير الوزارة في باكستان)، ومع كل اجترارات تلك المرحلة.
فالنساء دخلن أفضية السلطة السياسية، فوقعن ضحيتها، لقد افترست السلطة، بمختلف أنواعها، المرأة قتلتها، وأبعدتها..”، في غالب الأحيان، وعلى طول هذه النصوص، وفي محيط هذه النساء – الحجج، يجول الموت، كابن أوى جائع“. (۱۱).
حسب رأي كامبس (CAMPS)، فالموت يلاحق النساء، إذا ما اقتحمن مجالات لم تخصص لهن؛ بحيث تظهر الأميرات المضحي بهن، والمقتولات والمنتحرات لمصلحة الدولة هنا، بكثرة عن أي مكان آخر…” (۱۲). ويقصد هنا “شمال أفريقيا“.
يلتحق كامبس (CAMPS) بالمرنيسي، في كتابة: L’Afrique du Nord au Feminin حيث رسم لنا عشرين “لوحة” كما سماها، لنساء – ذرائع أو حجج، لكنهن شاهدات على الغير، فلم يكن المقصودات، والمؤسسات لتاريخهن، بل كانت اللوحات صماء، ولم تنطق ولم تنفعل حتى تم الانزلاق إلى تاريخ شخصيات رجالية غير معروفة. فقد بدت المرأة في الكتاب مطية سهلة لسرد تفاصيل عن التاريخ العام، فهو يحاول أيضًا تبيان حجم الجهل بأولئك الرجال. تغيب هنا معطيات التاريخ القديم لدى المجتمعات المغربية، فتغيب المعطيات حول نمط الحياة السائد، وعن العلاقات الاجتماعية، في ثقافة شفوية، غير مدونة في كليتها.
كان كامبس (CAMPS) يتكلم عن ظلال نساء، وعن معطيات، عبارة عن افتراضات تحيطها هالة من الشكوك، فكان – هذا لغياب تلك المعطيات التاريخية عنهن – يدخلهن في خيال وروحنة، ويشير إلى هذا مسبقاً ومحذرًا.
على الصفحات الأولى للكتاب. نجد خريطة لبلدان شمال أفريقيا، لكنها لا تحمل أسماء بلدان أو أمكنة، من بحار وجبال وصحار، بل أسماء نساء، باعتبارهن معالم جغرافية، وليست مواضيع تاريخية. فما أسهل أن نرسم المكان الجغرافي، ونعلمه، ونجسده، لكن ما أصعب أن نمسك بالخيوط الشفافة الحريرية المتداخلة، في حلقات التاريخ الحديدية، في ثقافة (يقرع الحديد بالحديد لا بالحرير)، ولا ترى للنساء دوراً في ذلك التاريخ – الوحش.
3 – تصورات العجز في ذاكرة النساء
عند الحديث عن النساء وموقعهن في التاريخ، تثار الذاكرة الجماعية، وتلتقي التصورات والأحكام حول تقييم النساء لمكانتهن، وأعمالهن. ومصدر ذلك الالتقاء هو المرأة كجسد، وفضاء طوبوغرافي. قبل ثلاث سنوات، تحدثت إلى أحد المسنين عن النساء المتصوفات، الزاهدات، ودورهن في مؤسسة الزاوية. وكان الرجل ممن درسوا بعشرات الزوايا (أحد سليلي شيخ مؤسس) رد على سؤاله بهدوء شدید: “یا بنیتى، إن النساء جغرافيا، والرجال تاريخ“. ثم أضاف قائلاً: المرأة كالبذرة، أو كالنبات الأخضر، تنمو على أى أرض زرعت عليها.. قالها الشيخ بوقار وتقدير.
لكن الكل يجمع – ويشترك – على أن معرفة المرأة بالتاريخ، ومساهمتها فيه، معدومة (التاريخ المكتوب أو المرويات)، وأقل من ذلك مهملة. هناك قول آخر، يسير في اتجاه التحقير والابتذال، يقول صاحب كتاب “نزهة المجالس“، نقلاً عن (Desparmet): إذا كان الرجل عقلاً، فالمرأة نفس. يسكنان الجسد. وإن طغت النفس على العقل، حلت الكارثة بالجسم” (13).
الجغرافيا هي الطبيعة؛ حيث تنتشر الأشجار والبحار والحيوانات والجماد. ولا تنطق هذه الكائنات بذاتها، لكن انطباعنا عليها، هو لغتها ولسانها. نحن نفكر عليها.. كما يفكر ويكتب المؤرخ على النساء. الكل يطلق هواماته وأحكامه القيمية على من لا يتكلم.
أما الرجل فهو التاريخ، والتاريخ مكتوب محفوظ، مبجل ومقدس، وهنا أعرج على أصل التاريخ والجغرافيا، بل على أصل الرجل والمرأة. فأصل الرجل إلهي، وأصل المرأة طبيعي: “لقد خلق الله في البدء السماوات والأرض، ثم خلق الرجل. وعندما أراد أن يخلق المرأة وجد أنه استنفذ كل العناصر والمواد التي كانت لديه، لذلك عاد إلى الكون الذي أوجده واستخلص منه المرأة على الشكل التالي: “أخذ من الشمس حرارتها، ومن الريح تقلباتها، ومن المحيط عمقه، ومن الغيوم دموعها، ومن الخمر نشوتها. ومن الماس قسوته… ومن الثعلب خبثه… ومن الزمن غدره… ومن الببغاء ثرثرته…” (١٤).
أما إذا تساءلنا، عن وضع المرأة الحالي، البائس، فإن أول عامل “بؤس” وإقصاء، وهو في ذات الوقت “المقيم” لها، يظل محكومًا بأفكار أزلية، نادراً ما تربط بالواقع. إنه “العمل“، وبالأخص أصل العمل. وأصل منتوجية ذلك العمل، عمل المرأة في التصورات الثقافية المختلفة. فلقد كانت ستكون المرأة سيدة على الرجل. لولا أنها لم تفعل ما فعلته.
“قيل إن امرأة ذهبت إلى الغابة لتجمع حطبًا، وعندما اجتمعت لديها كومة كبيرة منه، حزمتها، ثم صعدت فوق كومة الحطب تلك، لتوصلها هذه الأخيرة حتى مقر سكناها… عندما مشيتا قليلاً، طلبت المرأة من كومة الحطب أن تقف، نزلت من عليها، وخاطبتها قائلة: لقد تعبت من حملي، هيا اركبي فوق ظهرى. أمسكت كومة الحطب بظهر المرأة، ومشت هذه الأخيرة بها“.
هذا هو أصل شقاء المرأة، وأصل أعبائها وأحمالها، وأصل جسدها المنهك: “لماذا ألقت تلك المرأة، في غابر الأزمان، بكومة الحطب على ظهرها؟. لو لم يحالفنا الشقاء – نحن معشر النساء.. “هكذا يعلقن نساء اليوم على تعبهن طول اليوم، وجريهن المضني في سبيل ذلك..
وقيل إن عمل المرأة كان سيكون محرراً لها، وتاركا لها الوقت لممارسات أخرى. وكان سيكون لها الوقت الكافي لتهتم بنفسها دون منغصات، لو أنها نسجت “برنسها“، على أيام عديدة، ولم تسرع بإنجازه في زمن قياسي، في يوم وليلة. لقد نسجت النساجة برنسا في يوم واحد. وعندما قابلت أحد الفلاحين، سألها عما هي بصدد إنجازه، فردت محبطة العزيمة: لم أقم بعمل أي شيء سوى برنسٍ في يوم كامل، وهذا لا أعتبره عملاً، بل أردت أن أنجز العديد من البرانس، والملاحف والأغطية في ذلك اليوم!!. أما الفلاح فقد بادرها بالقول: أما أنا فبدأت بحرث الأرض، وضعت خط البداية، وسأواصل في الغد الخط الثاني، وهكذا إلى أن أنهي عملي، وسيبارك لى الله فيه.
فالرجل مهما عمل – على غرار الرجل الأسطوري الأول – اليوم، فأعماله مقيمة مباركة من الإله؛ لأنه قنوع منذ البداية، بينما المرأة، واليوم – بالذات – مهما عملت فكأنها لم تفعل شيئًا، لأنها غير مقتنعة بأهمية ما قامت به… تتواصل تعليقات النسوة اليوم. كلما ازدادت أعباء المرأة، ازداد التقليل من شأن تلك الأعمال والأعباء.
نرى كيف أن أكبر فكرة تقوم عليها مختلف المجتمعات، ألا وهي فكرة العمل، في ارتباطها بالنساء، تتميز بالعجز والتعجيز… فالمرأة تبقي تابعًا أمينًا – حتى بعد خوضها الأعمال الريادية، وغيرها من الأعمال المأجورة في الأمكنة العامة للعمل البدائي البيتي، كطبيعة ولدت بها، بينما يبقي الرجل مساعداً طيبًا، يرجى أن يدخل يده في ترتيب زاوية من مملكة عظيمة للمرأة، وهي البيت!!.
فإقصاء المرأة من مسك المحراث، له كل الدلالات الجنسية المعبرة، فالمحراث يباشر الأرض، كما يباشر الرجل المرأة. لذا وجبت المقارنة؛ إذ لا يمكن للمرأة أن تمسكه وتحرث به، والا لحدث شذوذ!!. ولتغيرت أقدار النساء، ولامتلكن زمام الأمور.
قد تكون أولى أشكال الكتابة، هي الخط على الأرض، بقلم الرجل، لكن في مجتمع يعتقد أن أصل الفلاحة فيه، امرأة، وفيه مارست النساء الكتابة، فما وضع النساء فيه؟.
5 – نموذج الكتابة وضياع المكانة: التارفيات نموذجاً
في زمن ليس ببعيد، كانت الترفيات يعشن لفترات طويلة، بعيدًا عن الرجال؛ حيث إن هؤلاء الأخيرين كانوا يقومون بتلك الرحلات الكبرى، نحو بلاد السودان (مالي حاليًا)؛ لاقتناء البضائع والأقوات لعائلاتهم، مقايضة، ولم تكن هذه الرحلات تخلو من مخاطر. فلمعرفة أخبار الغائبين من الأبناء والأزواج، يلجأن الترفيات (۱٥) إلى ما أسميتها بطقوس المناداة على الغائب. وهنا أشير إلى أن فعالية هذه الطقوس انتهت، بتغير نمط المعيشة، كما قد تختفي، لو لم نسارع بحفظها. وهناك نساء مختصات بتلك الطقوس، ومن بينها يوجد ما يطلق عليه بـ “إليكن“، تبتعد النسوة خارج “المدينة” إلى الصحراء، يحفرن في الأرض، ويضعن أعمدة كأعمدة الخيام، ويضعن عليها رداء أسود (لحافهن)، على شكل خيمة، ثم يحفرن في الرمل لوضع مرايا (اثنتان)، يدخلن تحت ظلام الخيمة، ثم ينظرن في المرايا، فيرين وضعية الرجال، صوتًا وصورة، فتحدث حالة الاطمئنان، كما قد تحدث حالات القلق على المسافرين…
فالتارفيات كثيرات البحث عن الرجال، ومكانتهن المتميزة، وخاصة البدويات منهن، ارتبطت بالرجل – علاقات مصالحة بين الجنسين – ولازلن يعشن بنبض الرجال، فكثيرًا ما نرى التارفية بصحبة رجل أو رجال كثيرين، في جلسة أنس، وكلام وضحك دون حرج، ودون مراقبة أو اكتراث.
إلى جانب هذا البحث الجسدي، الذي تقوم به المرأة عن الرجل، هنالك بحث آخر يصعب تسميته، قد يتأسس على قاعدة الجسد، وهو البحث بوسائل اللسان والقلم، بإبداع المرأة.
على غرار الرجال، عرفت المرأة في المجتمع التارفي كتابة “التيفيناغ“، حيث يكتب بهذه الكتابة كلا الجنسين، والمسنات أكثر دراية بآلياتها من صغيرات السن… كانت الترفية (١٦) تكتب أشياء خاصة بها مميزة، ومصنفة تحت فئات سنية ذات دلالات قوية، حيث تكتب أشعار (تسواى)، وتختص في أشعار الهجاء (تَرجمين)، وتثير وتثار بأشعار الحب (آهال)…
كانت “التفيناغ” كتابة مرنة، طيعة؛ بحيث تكتب من اليمين إلى اليسار، ومن اليسار إلى اليمين، كما يمكن أن تكتبها المرأة من أعلى إلى أسفل، ومن أسفل إلى أعلى، في كل اتجاه، حسب الرموز المتفق عليها، والمرسال المراد إبلاغه للرجل، لكن بقيت هذه الكتابة سراً بين الرجل والمرأة، في ظروف جد خاصة، قد تندثر – بعض ما تبقى منها إن وجد – بشيوع السر، وذيوع الحكاية… وهنا اشتركت النساء مع الرجال في التخلي عن تلك الكتابة، كذلك في إحيائها، إن وجدت الرغبة، ويتقاسم الطرفان المسؤولية.
علينا – الآن – البحث عن سر الشيوع والافتضاح، الذي أفقد تاريخ النساء نبضه واستمراره… ولماذا تبدأ الكتابة وتنتهى، في مواجهة تصوراتنا عن الجنس والجنسانية عموماً ؟!.
لكن يبقي حاضر النساء أجدى من ماضيهن، وأحق بالاهتمام، خوفاً من مصادرة الأشياء التي بين أيدينا.. ونعود إلى الحلقة العملاقة الصدئة من جديد.
* – مريم بوزید: باحثة في المركز الوطني للبحوث في ما قبل التاريخ والأنثروبولوجيا في الجزائر.
1 – كتب مثل: الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني، ومثل: تجريد الأغاني لابن منظور، وغيرها.
2 – ابن طيفور (أبي الفضل أحمد بن أبي طاهر): بلاغات النساء، دار الحداثة للطباعة والنشر والتوزيع، لبنان ۱۹۸۷.
3 – ابن طيفور، المرجع نفسه.
٤ – المرجع نفسه.
5 – بوفلاقة (سعد): الشعر النسوى الأندلسي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر ١٩١٥.
6 – بوفلاقه (سعد)، المرجع نفسه ص ۱۹۳ – ١٩٤.
7 – المرجع نفسه، ص ۱۹۳.
8 – المرجع نفسه، ص ٢٤٤.
9 – المرجع نفسه، ص ٢٤٩.
١٠ – المرجع نفسه، ص ۲۰۲.
11 – CAMPS (GABRIEL): L’ Afrique du Nord au Feminin، ed PERRIN، PARIS، 1992، P. 10.
١٢ – المرجع نفسه ص ۱۰.
13 – Desparmet: Le mal mogique، Alger، imprimerie Jules Carronel، Paris، Librairie Paul Geuthner 1932.
١٤ – الحفار الكزبرى (سلمي): في ظلال الأندلس، مطابع الألف باء، دمشق ۱۹۷۲ ص 103 – 104.
١٥ – هناك نساء معينات، من قبيلة معينة (إهضانارن)، يقمن بهذه الطقوس، بطلب ممن يرغبن في ذلك.
١٦ – وجدنا ظاهرة الشاعرات (كاتبات الشعر) المسنات في منطقة “إهرير“، علي بعد ۲۸۰ كم، عن مدينة جانت حيث الطوارق المستقرون.