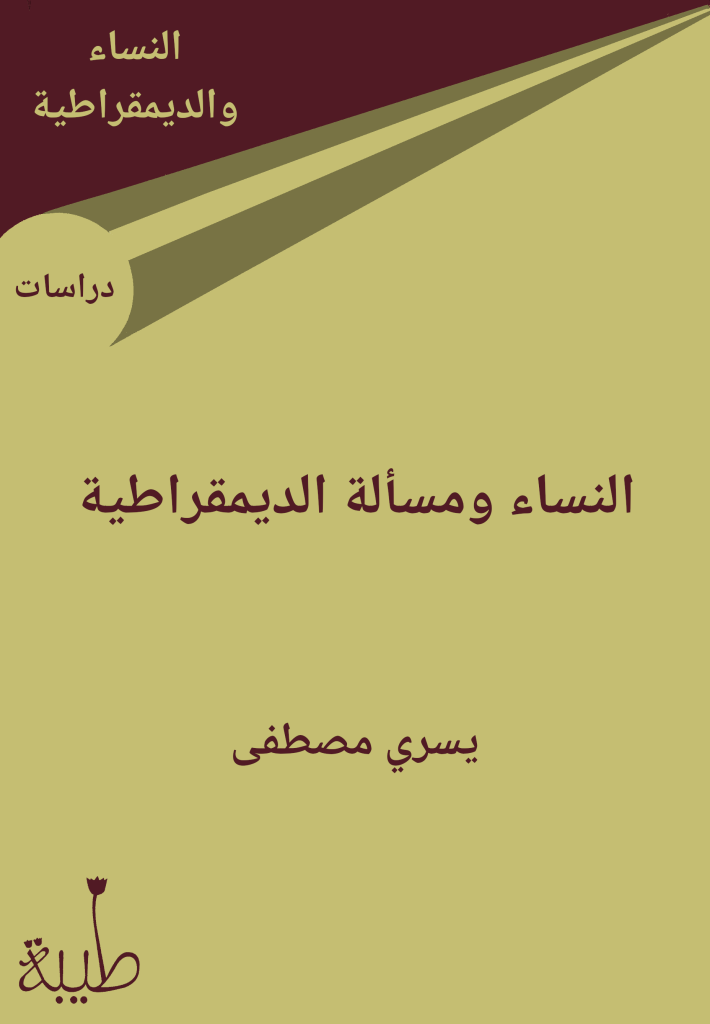النساء ومسألة الديمقراطية
يسرى مصطفى*
يبدو أننا لا نتحدث عن ديمقراطية واحدة ولكن عن ديمقراطيات ولا عن تحول واحد نحو الديمقراطية، فالديمقراطية شأنها شأن كل الرهانات السياسية والأيديولوجية، فلم يكن هناك طريق واحد للاشتراكية أو القومية أو حتى الدولة الدينية، فهناك دائما طرق وهناك دائما مشاريع. والديمقراطية بهذا المعنى هي في نهاية الأمر مفهوم نسبي يعكس التوجهات السياسية والأيديولوجبة للمطالبين بها، كما يعكس كذلك رؤية الجماعة السياسية لذاتها ولعلاقتها مع الأطراف الأخرى، سواء تلك المعترفة بالديمقراطية أو تلك الرافضة. عندما نتحدث عن علاقة حقوق النساء بعمليات المطالبة بالديمقراطية، فإننا نتطرق إلى المكون الأكثر خضوعًا لتوترات المطالبة بالديمقراطية، فقد يرى توجه ما أن المساواة بين الرجال والنساء شرط أساسي لأى تحول ديمقراطي، وقد ترى اتجاهات أخرى أن الديمقراطية هي في النهاية ديمقراطية سياسية، بل قد يرى اتجاهًا محافظًا لا يحترم حقوق النساء أن على الآخرين أن يكونوا ديمقراطيين ويقبلون فكره الرافض للمساواة بين الرجال والنساء.
كان على الكثير من المنادين بالتحول الديمقراطي في مصر والمنطقة العربية أن يأخذوا مسألة المساواة بين الرجال والنساء بعين الاعتبار، لأن فكرة المواطنة، التي هي أساس دولة القانون وركيزة الخطاب الديمقراطي، لا تقوم ولا تستقيم بدون إلغاء أشكال التمييز كافة ضد النساء. ومع ذلك فرغم أن الجدل حول التحول الديمقراطي شهد طفرة كبيرة منذ ما يقرب من عشر سنوات، أي منذ نهاية تسعينيات القرن الماضي، فإن حضور النساء في هذا الجدل كان ومازال خفيف الكثافة، وغالبًا ما كان حضورا على هامش الخطاب ويلبي مقتضیات تجميل المطالبة بالديمقراطية وجعلها أكثر جاذبية وخاصة بالنسبة للمجتمع الدولى. وقلما كانت المساواة بين الجنسين مكونًا أصيلاً من مكونات الخطاب المطالب بالديمقراطية.
وفي هذا المقال نسعى إلى مناقشة موقع المساواة في النوع الإجتماعي في عمليات المطالبة بالديمقراطية في مصر الآن. ولعل السبب الرئيسي لطرح هذه القضية لا يتعلق فقط بتحدى الاتجاهات الرافضة لهذه المساواة، ولكن لسبب آخر أقل طموحًا بالمعنى السياسي، وهو مقاربة تعقيدات الواقع. فعلى الرغم من مصداقية الرؤية القائلة بأن لاديمقراطية بدون تحقيق المساواة الكاملة بين النساء والرجال، فإن تحقيق هذا النمط من الديمقراطية هو سيرورة عليها أن تتعامل مع واقع تتسم فيه عمليات المطالبة بطابعها النسبي والمشروط، سياسيًا وثقافيًا، بشروط الواقع.
وفي هذا السياق نود إثارة بعض القضايا ذات الصلة بعمليات المطالبة بالديمقراطية، والتي قد تساعد في كشف تعقيدات الواقع الذي نعيشه، وتسهم في مراجعة استراتيجيات العمل المعنية بإدماج المساواة في النوع الاجتماعي في عمليات المطالبة بالتحول الديمقراطي.
ثمة ملاحظتان أساسيتان على الاتجاهات السائدة المعنية بحقوق النساء وقضايا التحول الديمقراطي: الأولى هي أن الكثير من العمل المرتبط بمناهضة التمييز ضد النساء لا يرتبط كثيرًا، على الأقل على صعيد الرؤية، بقضايا التحول الديمقراطي. أما الملاحظة الثانية فهى أن غالبية الخطابات التي تستدعى النساء في مطالب التحول الديمقراطي ترتكز، بالأساس، على فكرة المشاركة السياسية للنساء وتنتهى عندها في الأغلب الأعم. أما النظر إلى عملية التحول الديمقراطي بوصفها تغييرا في علاقات القوى وبنية السلطة بما في ذلك السلطة الأبوية فإنها لا تزال بعيدة عن مضمون المقاربات السائدة. وعندما أقول السائدة فإن هذا يعني أن هناك مقاربات أخرى أكثر وعيًا بمقتضيات تحول ديمقراطي يرتكز على مبادئ الحرية والمساواة، وبالتالي فإن هذه الملاحظات لا تعنى أي نوع من التعميم.
من ناحية أولى، منذ مؤتمر بكين وحتى الآن اتسعت دائرة الأنشطة حول النساء وحقوقهن، وساهم في تنفيذ تلك الأنشطة مؤسسات دولية وحكومية وغير حكومية وإعلامية، منها ما يعمل في مجال الخدمات ومنها ما هو تنموى، ومنها المنظمات الحقوقية. وقد أصبح مصطلح “المساواة في النوع الاجتماعي” من المصطلحات الشائعة. وهناك العديد من المؤشرات على أن الخطاب المتعلق بالمساواة في النوع الاجتماعي لم يكن خطابًا مكبوتًا، بل على العكس فقد كان ومازال منتشرًا وبشكل واسع أيضًا. ومع ذلك فإن معظم ما يقال لا يرتبط ارتباطًا مباشرًا بقضايا التحول الديمقراطي، بل إن الكثيرين من حاملي خطاب المساواة في النوع الاجتماعي قد يرون الديمقراطية مسألة سياسية قد تضر أكثر مما تنفع، وبالتالي فإن تحقيق مكاسب للنساء قد يتطلب عدم الخوض في قضايا سياسية شائكة ومنها الديمقراطية. كما أن الشائك في الديمقراطية ليس فقط طبيعتها السياسية ولكن كذلك ثقافتها التي تستدعى قضايا حساسة ثقافيًا مثل الحرية والمساواة.
ومن ناحية ثانية، شهدت السنوات الأخيرة جدلاً واسعًا ودعمًا دوليًا لمسألة تعزيز المشاركة السياسية للنساء، وبالتالي عدم “نسيان النساء” في المبادرات المنادية بالتحول الديمقراطى. وفي الحقيقة أن مسألة تعزيز المشاركة السياسية للنساء ليست سيئة في حد ذاتها، ولكنها تكون مبتسرة إذا تم النظر إليها بوصفها هدفًا في حد ذاته. والمشكلة الأخرى هي أنه في ظل غياب رؤية بنيوية تربط بين طبيعة مشاركة النساء وبنية السلطة في المجتمع، فإن هذه القضية تعالج في الغالب من منظور كمي، أي عدد النساء في البرلمان، عدد الأصوات النسائية في الانتخابات، عضوية المرأة في مجالس إدارات هيئات حكومية أو غير حكومية.
صحيح أن الخطاب حول النوع الاجتماعي كثيرًا ما يتعرض لمسألة الديمقراطية والقيم الثقافية السائدة المعادية للنساء، ولكنه يناقشها كمخاطر يجب التعامل معها بحذر أو القبول بالمجازفة. ولكن النقطة الرئيسية في هذا السياق، هي إلى أي حد يجرى الربط بين قضايا النساء وبنية السلطة في المجتمع؟ هذا هو السؤال الذي تمت مقاربته ثقافيًا ولكن في نطاق محدود وبالتالى لم يكن له أثر كبير على مطالب التحول الديمقراطي السائدة، بما في ذلك الرهانات الحقوقية. وفي هذا السياق تحليل هذا الواقع يتطلب التطرق لبعض القضايا المهمة والتي تؤطر الرؤية السائدة بشأن التغيير، ومنها الطبيعة المركزية لمطالب التغيير، والحساسيات الثقافية ومخاطر فقدان الشرعية.
تشكل قضية الديمقراطية موضوعًا أساسيًا لجميع القوى السياسية ومنظمات حقوق الإنسان، فهي مكون أساسي من مكونات خطابات نقد السلطة السياسية القائمة، أكثر من كونها ركيزة لعمليات تغيير واعدة. ولذلك فإن الديمقراطية، وانطلاقًا من كونها مجرد أداة لنقد السلطة، مطلب متفق عليه من كل القوى التي خارج السلطة وجميعها بالمناسبة ليست معنية بمساءلة ذاتها ديمقراطيًا، فالأحزاب السياسية شأنها شأن القوى الدينية لم تقدم حتى الآن نموذجًا لفضاءات ديمقراطية بديلة. ولأنها كذلك فإنها لا تطرح قضية الديمقراطية كمشروع لتغيير هيكلي في بنية السلطة، ولكن كوسيلة إحلال وتبديل. فنحن نريد تغييرًا يعطى للقوى الدينية أو القومية أو الماركسية مكانًا داخل البنى العليا للسلطة ولا يهم كثيرًا إذا ما كانت هذه القوى ديمقراطية من عدمه، فالإحلال وليس التغيير هو المحك. ويبطن مفهوم الإحلال معظم مسارات المطالبة بالديمقراطية التي نراها ونعيشها.
إن مسارات الإحلال هذه تنكر التفاصيل الخاصة ببناء مجتمع ديمقراطي، وتركز على بؤرة مركزية لتكون موضوعًا لعملية الإحلال المرتقبة. ولذا تنحاز غالبية القوى السياسية على اختلافها إلى رؤية شديدة المركزية بشأن التغيير في مصر، وهي رؤية ترتكز على مفهوم معين لطبيعة السلطة والتي تبدو وكأنها نقطة مركزية في قمة الهرم السياسي، إذا تم تغييرها، أو بمعنى أدق احتلالها، فإن سائر علاقات السلطة ستتغير بالتبعية. وبكلمات أكثر وضوحًا فإن القوى السياسية ترى أن مؤسسة الرئاسة أو الحكومة أو حتى النخبة الحاكمة هي صانعة بنية السلطة في مصر. وبالتالي فإن الرهان ينصب على تغيير هذه البؤرة المركزية. ومن ثم فسوف تحقق الديمقراطية مهمتها بمجرد تحقيق هدف الإحلال، وعندها تتوقف لتبدأ منازعات جديدة وإحلال آخر وهذه هي الديمقراطية.
لهذه الرؤية المركزية أثرها على وضعية النساء في عملية التغيير الديمقراطي. فمن ناحية أولى، تبدو قضايا حقوق النساء وتحقيق المساواة من القضايا الفرعية والتي لا ترتبط بعملية الإحلال لأنها ضمن التفاصيل الزائدة. كما أن المساواة في النوع الاجتماعي تتطلب تغييرًا في البني الثقافية والسياسية بل والمجتمعية، ومن ثم فإن تبنيها قد يؤدي حتمًا إلى مسارات غير تلك المخطط لها. إن ما نخشاه ليس صعوبة تحقيق المساواة، ولكن المساواة تعنى تغييرًا هيكليًا في بنية السلطة، والتي تعد هذه القوى ذاتها جزءًا منها. إن الأمر يتطلب تغييرًا أو على الأقل مراجعة الذات وهو ما نخشاه. هذه المسألة ذات أهمية كبرى في فهم لماذا يجرى تهميش قضية المساواة في النوع الاجتماعي في عمليات المطالبة بالديمقراطية، والإجابة ببساطة تتمثل في أننا بعيدون عن مسارات التغيير.
القضية الثانية التي أود الإشارة إليها في هذا الصدد تتعلق بالمخاطر المحيطة بعمليات المطالبة بالديمقراطية. تنطوي هذه العمليات على مجازفات سياسية وثقافية، أي مجازفة فقدان المشروعية، فبنية السلطة السائدة، والتي يجرى وصفها بأنها سلطة أبوية، هي في نهاية الأمر معادية لحقوق النساء. وهذا العداء يشكل جزءًا أصيلاً في بنية السلطة. ومع الأسف الشديد ومع فإن هذه البنية تؤثر تأثيرًا مباشرًا في عمليات المنازعات على السلطة في مصر، لأن بناء الشرعية السياسية يتطلب الاستجابة لمقتضيات بنية السلطة القائمة. وإذا لم تتضمن المطالبة بالديمقراطية رؤية واضحة بشأن تغيير بنية السلطة، فإنها لن تكون سوى آلية أخرى لإعادة إنتاج بنية السلطة القائمة بكل ما فيها من عناصر معادية لحقوق النساء بل ولقيم المساواة والحرية بشكل عام.
ويعتبر مصطلح الشرعية من المصطلحات المتداولة في الخطاب السياسي والديني ويجرى استخدامه بشكل مراوغ. فالسلطة تتحدث مثلاً عن “الشرعية الدستورية“، هذا في حين أن الدساتير معطلة بفعل قوانين الطوارئ والقوانين الأخرى المقيدة للحريات، ولكن في كل الأحوال تظل “الشرعية الدستورية” شبحًا سياسيًا تطلقه السلطات وقتما تشاء. فالقوانين ترسم حدود الشرعية كما تريدها السلطة أن تكون، وبالقوانين تصبح اللاشرعية هي الأساس وليس العكس، فالأحزاب المعارضة هي إما غير شرعية، أو لو كان معترفًا بها فإنها مهددة بأن تسقط في حيز اللاشرعية، وقد ظلت منظمات حقوق الإنسان غير شرعية بالمعنى السياسي، وقد تم الاعتراف بها في صيغة قانونية هي أقرب “للزواج العرفى” مع السلطة السياسية. ففي مقدور هذه الأخيرة، وبموجب القانون، أن تسقط هذه العلاقة إذا ما أرادت. ولذا فإن الأحزاب أو منظمات المجتمع المدني أو النقابات كلها كيانات مهددة في شرعيتها، وقد يكون كل ما تفعله هذه المؤسسات هو أن تسعى للحصول على الشرعية، أو تحاول البقاء داخل حدود الشرعية، أو تدفع ضريبة خروجها عن نطاق الشرعية. وعلى ما يبدو أن تاريخ هذه المؤسسات هو تاريخ البحث عن شرعية مستحيلة.
وإذا كان هذا هو الواقع على المستوى السياسي (ومن ثم القانوني)، فإن الوضع على المستوى الثقافى ليس أفضل حالاً. فتاريخيًا ثمة توظيف لمسألة الشرعية الثقافية والتي يلعب الدين فيها دورًا محوريًا. وفي سياق معادلة الشرعية الثقافية يجرى تصنيف الأقوال والأفعال بشكل ما إلى أفعال تعبر عن قيمنا وثقافتنا وأعمال دخيلة ووافدة. ولأننا نعيش عصرًا حديثاً، فإن تفعيل هذه المعادلة (أي الأصيل والوافد) يتم دائما بشكل انتقائي، فليس كل ما هو وافد يعد ضد قيمنا، بل فقط ذلك الذي يشكل تهديدًا للسلطة سواء كانت سلطة سياسية أو دينية. فعلى سبيل المثال يمكن لنا جميعا أن نوافق على شعار كأس العالم في كرة القدم والذي يقول “كلنا نتحدث لغة واحدة: كرة القدم“، على الرغم من أن كرة القدم لا تعبر عن شيء أصيل فينا، ولكن الوضع ينقلب إلى مشكلة ثقافية وسياسية إذا استبدلنا كرة القدم بحقوق الإنسان، فالانتقائية تقتضى أن نقبل كرة القدم ونتحدث بلغتها وتقتضي أن نرفض حقوق الإنسان باسم القيم والأصالة. وهكذا تتسرب كرة القدم والسلة وأنماط الاستهلاك إلى هويتنا بسلاسة، أما الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات فتصطدم بهوية تدافع عن ثوابتها بصرامة؟! وهكذا نجحت السلطات على مدى عقود من الزمان في توظيف الشرعية الثقافية (ومن ثم الدينية) لكي تكون مرشحًا (أو فلتر) يسمح بتمرير الآمن ويمنع ما يهدد علاقات القوى السائدة.
وفي تصوري، من منظور التحول الديمقراطي، أن الشرعية الثقافية أكثر خطورة من الشرعية السياسية؟ لماذا؟ فمن ناحية أولى فإن السلطة السياسية هي المحتكر الوحيد والأوحد لمسألة الشرعية السياسية ولا تسمح لأي جهة أخرى بأن تنازعها هذا الاحتكار. وبالتالي فإن علاقة هذا النمط من الشرعية بالسلطة السياسية يتسم بقدر من الشفافية، كما أن كل من خارج السلطة يستشعر ذلك، سواء على مستوى الأحزاب، المجتمع المدني، الإعلام إلخ. أما حماية الشرعية الثقافية فهي لا تتسم بالشفافية لأنها باتت استراتيجية أوسع من نطاق الحكومة تمارسها المؤسسات الدينية والمثقفون أنفسهم، بل وأطراف اجتماعية أخرى. ونتيجة لذلك فإن حيز اللاشرعية الثقافية يتحدد ليس فقط من قبل السلطة السياسية بل من قبل المجتمع ذاته.
وقد نجحت السلطات، من خلال إعلامها ومؤسساتها وفي مقدمتها المؤسسات التربوية، في خلق عقل جمعی مساند للسلطة. فالسلطة ذاتها التي نزعت المشروعية السياسية عن المجتمع، تسعى لتقديم هذا المجتمع بوصفه “مصدرًا” لشرعية ثقافية هي التي صنعتها وتصنعها وتعدلها كيفما تشاء. فالمجتمع ليس مجرد موضوع للقهر، بل أداة له كذلك. لنأخذ مثالاً على ذلك مسألة الديمقراطية، ففي حين أن علاقة السلطة السياسية والمجتمع تفتقر إلى القواعد والمبادئ الديمقراطية، فإن المجتمع، بموجب الثوابت والأصالة، بات أداة لنزع المشروعية الثقافية عن دعاة الديمقراطية. وهكذا تكتمل السلطة ويصبح رفض الديمقراطية عملاً ديمقراطيًا لأنه يعبر عن إرادة شعب بلا إرادة، ورفض حقوق الإنسان علامة على احترام حق شعب، لا يتمتع أفراده بالحقوق، في الحفاظ على أصالته.
والخطير في مسألة الشرعية الثقافية أنها تشكل نوعًا من الرقابة الذاتية على المبدعين والمثقفين والنشطاء، فمن يريد أن يحظى بالشرعية يجب ألا يستخدم كلمة ديمقراطية لأن الشعب يرفضها، ولا يجهر بالمساواة بين الرجال والنساء لأن هذا ضد قيمنا، ولا يفصح عن إيمانه بحقوق الإنسان لأن الكلمة سيئة السمعة في بلادنا. وهكذا تصبح مسألة الشرعية هي المطلب وليس الديمقراطية أو المساواة أو حقوق الإنسان. ولكن مع الأسف فإن مطلب الشرعية يظل مستحيلا لسبب بسيط وهو أن معايير الشرعية تحددها السلطات، أما المجتمع لم يكن يومًا مصدرًا للشرعية بل مجرد أداة لنزعها.
ولأن ركائز الشرعية المتنازع عليها وبها هي ركائز أخلاقية بالأساس، وبما أن الأخلاق في ثقافتنا ذات ركائز جنسية، وبما أن ثقافتنا ترى النساء بوصفهن كائنات جنسية بالأساس، فإن المنازعات حول الشرعية تتمحور حول النساء والجنس. وبهذا المعنى يجرى توظيف قضايا النساء في عملية المنازعات حول السلطة من خلال أنظمة أبوية ترى أن الحرية والمساواة ما هي إلا تهديدات لشرف المجتمع.
وفي الختام يمكن القول بأن عمليات المطالبة بالديمقراطية هي عمليات نسبية ومشروطة بشروط الواقع. وفي ظل واقع تلعب فيه السلطة الأبوية دورًا كبيرًا، فإن هذا ينعكس على أنماط المطالبة بالديمقراطية، والتي مازالت بعيدة عن مقتضيات تغيير بنى السلطة في المجتمع. ولأن تحقيق المساواة في النوع الاجتماعي لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال استراتيجيات لتغيير علاقات السلطة سياسيًا وثقافيًا واجتماعيًا، فإن أشكال المطالبة القائمة والتي لا تستهدف سوى تغيير رأس السلطة أو مركزها المتخيل، لن تلبي احتياجات المساواة في النوع الاجتماعي في عمليات المطالبة بالديمقراطية. بل إن استجداء الشرعية الثقافية لكثير من الفاعلين السياسيين، يفضي في نهاية الأمر إلى التضحية بحقوق النساء أو في أحسن الأحوال وضعها على هامش المطلب الديمقراطي.
* مدير برنامج دعم حقوق المرأة بوكالة التعاون الفني الألماني.