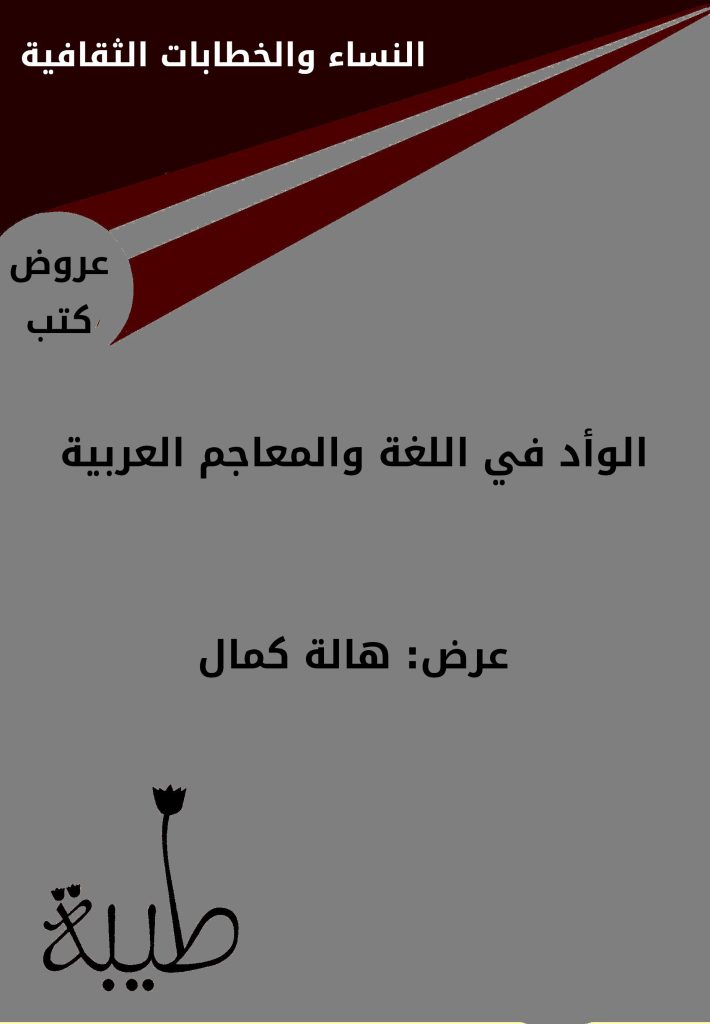الوأد في اللغة والمعاجم العربية
یأتی کتاب د. محمد فكرى الجزار وعنوانه“معجم الوأد: النزعة الذكورية في المعجم العربي ( في تحليل الخطاب المعجمي )” (۱) ليلقي بنقاط ضوء على نماذج للتحيز الجنسي في اللغة العربية, ويقع الكتاب في 147 صفحة من القطع المتوسط, ويتكون من أربعة أقسام, إضافةً إلى المقدمة والخاتمة.
ويتضح من مقدمة المؤلف أنه يستعين بمنهج اللسانيات الإثنولوجية (Ethno-Linguistics) جامعاً ما بين علوم اللغويات وعلم الاجتماع والإثنوجرافيا جنباً إلى جنب مبادئ علم النفس, في إطار صورة استعارية ترى البحث في اللغة بمثابة عملية تنقيب أركيولوجية. ويستهل محمد فكرى الجزار كتابه مشيراً إلى هشاشة وسطحية التحديث, الذي خضعت له المجتمعات العربية، في ظل مؤسسات اجتماعية خاضعة للسلطة السياسية، ومؤكداً دور الذهنية البدوية في الترسيخ لدونية المرأة، قائلاً:” في زعمي أن مركز الخلل الاجتماعي هو الذهنية البدوية التي لم تزل مستقرة في اللاوعي العربي، توجه السلوك وتضبط حركة الفكر، وتتحكم – عمومًا – بالوعي.
ولا شيء يمكنه أن يفضح هذه الذهنية ويكشف مجموع تعقيداتها والتباساتها من وضعية المرأة فيها، هذه الوضعية الدونية والمتخلفة والتي يستمد منها الرجل فوقيته / سلطته كذات، ووحدانيته ككينونة” (ص12- 13) (2). ويرى الكاتب أن تلك الذهنية البدوية بما تحمله من تمييز ضد النساء ترسخت، وامتدت لتتجاوز مجتمعات البداوة منتشرة بانتشار اللغة العربية، التي ظلت محتفظة بالقيم الثقافية والمعرفية البدوية.
ويؤكد محمد فكرى الجزار أهمية دراسة اللغة العربية دراسة لسانية إثنولوجية؛ حيث يرى أنها على المستوى اللغوي“قادرة على وضع لغتنا العربية في إطارها الإنساني” أما على المستوى الاجتماعي فهي تجعل المجتمع مركزاً للدراسة وتحرره من قيود اللغة؛ حيث” تعيد للذات اللغوية حق الفعل الإبداعي الحر في لغتها” دون تقييد اللغة بسلطة الماضي. أما على المستوى الثقافي، فإن علم اللسانيات الإثنية يمثل منهجاً يكشف عن” اللغة كأداة للوعي وحاملة له” (ص14- 15) ؛ فإذا كانت اللسانيات الإثنية في منهج البحث الذي يتتبعه المؤلف، فإن مادة بحثه لا تركز على لغة الحياة اليومية، وإنما يوجه اهتمامه إلى دراسة المعاجم العربية. ويعرف المؤلف المعجم باعتباره” كتاب التصورات الذهنية لجماعة إثنية ناطقة به في فترة زمنية، أهم ما تتميز به هو قابليتها للتحقيب الزمني” (ص15). ولكنه يتساءل عن مدى إمكانية تطبيق صفة الوثائقية على المعجم، حيث إن من خصائص الوثيقة ما يدل على سياقها الزماني، في حين خضع اللغويون العرب للوهم الأسطوري” بالأصل الميتافيزيقي للغتهم” (ص15)، وتجنبوا أية إشارات تاريخية.
ويرى المؤلف أن المعجم اللاتاريخي للغة العربية قد أدى إلى عدد من الظواهر، من أهمها سيادة التصورات الميتافيزيقية فيما يتعلق بأصل اللغة العربية، وفرض القيود على تطور اللغة باعتبار أي تغير لغوى خطأ، وميلاد اللهجات العامية جنبًا إلى جنب، ولكن أقرب إلى حياة الناس اليومية، وأخيراً أدى تحنيط المعاجم إلى رسوخ الثقافة البدوية حتى في الذات الحضرية العربية.
ويستنتج المؤلف من ذلك كله وجود بعد وثائقي في المعاجم العربية ؛ بحيث يرتبط سياقه التاريخي بمرحلة حضارية بعينها وهي الطور البدوي. ويشير الكاتب إلى خطورة فرض التصورات الذهنية البدوية على مجتمع لغوى ( كالمجتمع المصرى ) لم يمر تاريخياً بالطور البدوي، ويستخدم مع ذلك لغة قائمة على التصور البدوى للحياة، وهي ظاهرة تؤدى كما يرى المؤلف إلى حياة تحمل” فصامًا سيكولوجيًا ومعرفياً واجتماعياً بين شخصيتها الحضارية ومعجمها البدوي” (ص 18). وهكذا يفسر المؤلف أهمية الدراسة الإثنية للمعجم العربي؛ بغية الكشف عن العناصر البدوية المتغلغلة في اللغة العربية، مع التركيز تحديدًا على التصورات الخاصة بالرجل والمرأة.
يتناول القسم الأول من الكتاب المعجم” فوق – جنسي“، ويحلل فيه محمد فكرى الجزار نماذج لمفردات، وردت في معجم” لسان العرب” لابن منظور، مركزاً هنا على ما هو” فوق – جنسي” أي الخصائص المشتركة بين الرجل والمرأة، ومفردات المعجم الـ“فوق – جنسي” هي“إنسان – برية – بشر – خلق – وری…”، وحين يحلل المؤلف التعريفات المعجمية للفظ” إنسان“، كما ورد في لسان العرب لابن منظور، يكشف عن الخلط المنهجي، الذي وقع فيه ابن منظور ومن نقل عنهم، حيث اعتمدوا جميعًا أسلوب النقل والرواية، دون بحث ودراسة ومقارنة بين الكلمة العربية، وغيرها من اللغات السامية كاللغة العبرية والآرامية والسريانية والآشورية، التي تشترك جميعاً في أصلها السامي. ويؤكد المؤلف العلاقة بين الألفاظ والمعاني في التعبير عن العالم الاجتماعي، الذي تنتمي إليه، مشيراً إلى أن اشتقاق كلمة“الإنسان” من” الإنس” تم على أساس قاعدة ثنائية، تتضمن” الحضور – الغياب” ممثلة، كما يذكر المؤلف في” حضور الرجل في الصيغة المذكرة لكلمة إنسان وغياب المرأة عنها، ولا ينسى المعجم التنبيه على هذا الغياب قائلاً” ولا يقال إنسانة” (ص 32)، ويدلل محمد فكرى الجزار على تحيز اللغة وإلحاق المعنى المؤنث بالصيغة المذكرة ؛ بحيث يتخذ لفظ” إنسان” الصيغة المذكرة دون اشتقاق للفظ نفسه في صيغته المؤنثة، ومن هنا تعتبر المعاجم استخدام الصيغة المؤنثة“إنسانة” ( كما ترد في العامية ) خطأ لغوياً.
وفي هذا السياق، يؤكد المؤلف ضرورة تحرير اللغة العربية من النظرة الذكورية للعالم، ويبين أنه على الرغم من اقتصار المعجم على الصيغة المذكرة” إنسان“، إلا أن الوعي اللغوى الاجتماعي قد خرج عن قيود المعاجم المعبرة عن المجتمع البدوى، فنجد في العامية تعبيراً عن تواؤم اللغة مع الواقع الاجتماعي، الذي يعي الوجود المستقل للنساء لا باعتبارهن مجرد ملحقات بالرجال، ومن هنا قامت العامية باشتقاق الصيغة المؤنثة“إنسانة” وشيوع استخدامها على الرغم من عدم اعتراف المعجم بصحتها. إن الازدواجية اللغوية بين الفصحى والعامية إنما تعبر عن تحجر الفصحي، من خلال التقنين المعجمي لألفاظها النابعة أساساً من مجتمع البداوة بما فيه من مركزية ذكورية تكتفى بإلحاق النساء بالرجال، في حين تعكس العامية مرونة لغوية، تتشكل وتتغير بما يتلاءم مع الواقع والتطور الاجتماعي، من منطلق أن اللغة إنما هي نتاج للمجتمع ومرآة معبرة عن العالم الاجتماعي وتصوراته.
وحين يتناول المؤلف كلمة“الخلق” كما وردت في المعجم العربي، يعود فيؤكد أن“اللغة إشارة رمزية صوتية إلى واقع خارجها” (ص 35). ومن هنا يرى أن كلمة“الخلق” هي في الأساس ذات مرجعية طبيعية، فيعيب على ابن منظور اعتماده الاساسي على المرجعية الدينية، حين يستهل“مادة خلق” في معجمه بشرح ديني رابطًا الديني باللغوي.
أما كلمة“البرية” فيتم تعريفها في المعجم بأنها تشير إلى الخلق، ومشتقة من كلمة“برأ” فتنطقها قريش“بريئة” في حين ينطقها عامة العرب” برية” دون همزة اشتقاقًا من“البرى” أي التراب، ويوضح المؤلف أن اختلاف مصدر الاشتقاق بين العرب من ناحية وقريش من ناحية أخرى، إنما يرجع إلى اعتماد قريش على المرجعية الدينية وبالتالي اشتقاقهم الكلمة من فعل الخلق الإلهي” برأ“، بدلاً من أحد عناصر الطبيعة“البرى“.
وينهى المؤلف تحليله للمعجم” فوق جنسی” بكلمة” بشر“، التي يتم إحالتها في المعاجم إلى مرادفات أخرى، مثل:” خلق” و” إنسان” بما تحمله تلك الصيغ المذكرة جميعها من دلالة على الرجل أساساً وعلى المرأة إلحاقاً واستثناءً. ويتناول المؤلف” مادة بشر” في المعاجم، مركزاً على ثلاثة محاور: الصيغة المذكرة والدلالة المعجمية والتفاعل الاجتماعي ؛ فيرى محمد فكرى الجزار أن المعجم يؤكد“تذكير كافة الصيغ الدالة على النوع الإنساني، والتنبيه على عدم جواز تأنيثها” (ص39 -40).
أما من حيث الدلالة المعجمية، فإن الصيغة المذكرة ( البشر ) تشير إلى النوع الإنساني، في حين تشير الصيغة المؤنثة (البشرة) إلى جزء من الجسد الإنساني (الجلد) وهو ما يفسره المؤلف من منطلق تعبير اللغة عن مجتمع البداوة، الذي يرى في الذكورة قيمة وفي الأنوثة وظيفة. وحين ينتقل المؤلف إلى محور التفاعل الاجتماعي، نراه يقدم قراءة رموزية ذكورية للمحورين السابقين من خلال كلمة أخرى مشتقة من” مادة بشر“، وهي“مباشرة الرجل امرأته” بما يحمله ذلك من إشارة إلى التقاء الرجل بالمرأة، مع الاحتفاظ بموقع الرجل كفاعل وموقع المرأة كمفعولٍ بها (ص 41).
وينتقل محمد فكرى الجزار في القسم الثاني من الكتاب متناولاً المعجم“جنس – تمييزي“، والذي يشير إلى التمييز اللغوى بين صيغتي التذكير والتأنيث، مؤكداً أن ذلك التمييز أو الاختلاف، إنما هو اختلاف مزعوم يحافظ ويرسخ للمركزية الذكورية. وحين يعيب المؤلف على المعجم مركزيته الذكورية وتمييزه الوهمي بين المذكر والمؤنث.. فإنه لا ينفى الاختلاف البيولوجي القائم بين الرجال والنساء، مؤكداً أن الذكورة والأنوثة هي خصائص بيولوجية طبيعية، وإنما ما يميز تاريخ البشرية هو بعده الثقافي الذي استولى الرجل على صياغته” رافعاً اختلافه بيولوجيًا” عن ( المرأة) إلى مستوى التمييز القيمي. وكانت اللغة، في هذا الصدد، الأداة الرمزية المثلى لكل من الأيديولوجيا والعنف الذكوريين” (ص 59).
ويتناول المؤلف في هذا الفصل أربعة نماذج لمقابلات بين صيغ المذكر والمؤنث، يبدأها بالمقابلة بين” الذكر – الأنثى” ؛ حيث يكشف عن تعدد الصيغ الصرفية من“ذكر“، والتي تشير إلى الشدة والقوة والصلابة والشجاعة والمتانة والغلظة والصرامة وهي صيغ تحمل دلالات قيمية، في حين ترتبط الصيغ المشتقة من” أنثى” بالأرض المنبتة والبلد السهلة ؛ تأكيداً لدلالاتها الطبيعية التي أساسها اللين. ويخلص المؤلف إلى أن علاقة الذكر بالأنثى لا تتخذ شكلاً اجتماعيًا، بل ترسخ لعلاقة الرجل بالمرأة في إطار الفاعل والمفعول به، بما تحمله الذكورة من دلالات قيمية والأنوثة من دلالات طبيعية، تتطابق فيها الأنثى بالأرض.
وحين ينتقل المؤلف إلى ثنائية“مرء – مرأة” يعود ويؤكد انفراد الرجل” المرء” بالنوع الإنساني، في حين يتم اشتقاق المرأة باعتبارها“ملحقاً شيئيًا بهذا النوع” (ص 67). ويتبدى التمييز القيمي في دلالات الصيغ المشتقة من المرء والمرأة، حيث يشير محمد فكرى الجزار إلى أن المروءة هي قيمة يعرفها ابن منظور ؛ بوصفها” كمال الرجولية” مضيفاً إليها خاصية“الإنسانية” (ص 68)، بينما نجد أن كلمة” مراءة” المشتقة من“مرأة” تشير إلى اللذة والفائدة والطعام.
ويستشهد المؤلف بنزعة المعاجم إلى سلب المرأة دلالاتها القيمية، مستشهداً بإحدى نوادر ابن الأعرابي حين يربط بين الصدق والرجولة على لسان ابن منظور:”وحكى ابن الأعرابي أنه يقال للمرأة: إنها لإمرؤ صدق، كالرجل” (ص 69)، وذلك باستخدام صيغة التذكير ( امرؤ صدق ) بدلاً من تأنيثها ( امرأة صدق ) عند الإشارة إلى صدق امرأة، كما لو كانت قيمة الصدق حكراً على الرجال، وحين تمارس المرأة الصدق تتم الإشارة إليها لغويًا بصيغة المذكر !
أما بالنسبة لكلمة“رجل” فهي بلا مقابل، حيث ينفى المؤلف كونها مقابلاً لكلمة“امرأة“، التي تقابل كلمة” مرء” لغويًا. وكلمة” رجل” تحمل دلالات بيولوجية واجتماعية ؛ لتنتقل بالطفل الذكر إلى مرحلة الانتماء إلى السلطة الذكورية. ومن ناحية أخرى نجد أن كلمة“نساء” هي الأخرى بلا مقابل، وتأتي في صيغة جمع لا مفرد له، مع أن ابن منظور يعرف في معجمه النساء والنسوة والنسوان باعتبارها” جمع المرأة عن غير لفظه“، وهو ما يعقب عليه محمد فكرى الجزار بقوله إن ذلك التعريف ( أي أن“النساء“: هي جمع لكلمة“امرأة” ) إنما يقع في باب تزييف للظاهرة اللغوية الخاصة بوجود كلمة في صيغة الجمع، مع عدم وجود مفرد لغوى لها. ويفسر المؤلف غياب الاشتقاق هنا مع وجود المفرد بلا جمع ( امرأة )، ووجود الجمع بلا مفرد ( نساء ) بموقع المرأة في إطار السلطات الذكورية ببعديها الاجتماعي والثقافي، فهي امرأة فيما يتعلق بسلطة الرجل الاجتماعية عليها كامرأة ( من واقع سلطة الزواج أو القرابة )، في حين تنظر السلطة الثقافية للمجتمع الذكوري إلى المرأة، لا باعتبارها ذاتاً مفردة مستقلة، وإنما يتم الإشارة إليها في صيغة الجمع ( النساء ) الذي لا مفرد له (ص76).
أما الجزء الثالث من الكتاب فيتناول المعجم” تحت – جنسي” أو” النسالي” ؛ أي الذي ينظر إلى التدرج في المنظومة القيمية الاجتماعية، بالنظر إلى تحول الرجل إلى زوج ثم أب، وتحول المرأة إلى زوجة ثم أم. ويلاحظ المؤلف أن كلمة” زوج” تستخدم لكلا الجنسين ؛ أي إن الرجل” زوج” والمرأة” زوج، مستشهداً بابن منظور:” والزوج: المرأة، والزوج: المرء” (ص88). أما الكلمة التي ينفرد بها الزوج الذكر فهي كلمة“بعل” والتي يشرحها ابن منظور كالآتى:” وإنما سمى زوج المرأة بعلاً، لأنه سيدها ومالكها… وبعل الشيء: ربه ومالكه“، ويضيف المؤلف بعداً إضافيًا مشيراً إلى علاقة اللفظ بمجتمع البداوة، حيث كان عرب ما قبل الإسلام يعبدون إلهًا اسمه“بعل” (ص90)، كما يشير إلى تاريخ الكلمة في اللغات القديمة ؛ موضحاً أن” البعل” يجمع بين معاني الربوبية والزوجية والسلطة، فهو السيد والرب والزوج في اللغات السامية كالعربية والآشورية والسريانية والعبرية (ص92).
وحين ينتقل المؤلف إلى كلمة” الأب” في معجم ابن منظور، مشيراً إلى أن معناها هو الوالد، إلا أنه يلفت أنظارنا إلى أن مثنى كلمة الأب هو“الأبوان“؛ متضمنة كلًا من الأب والأم، كما يضيف جانبًا آخر بالنظر إلى اللغات السامية حيث يستخدم“الأب” في الصلاة المسيحية تعبيراً عن الرب أي الله. وهكذا تتداخل الربوبية بالأبوة، فالآب الإله هو رب الناس، والأب الوالد هو رب الأسرة. أما كلمة” أم” فتقترب من كلمة” الأمة” أي العبدة، بما يحمله ذلك من معاني العبودية والدنس.
ويرى المؤلف أن التمييز بين الأب والأم يمتد ليؤسس للتمييز الـ” تحت – جنسی” بين الابن والابنة ؛ حيث يشير إلى أن كلمة” ابن” هي امتداد لكلمة” أب“، في حين تأتى كلمة” ابنة” امتداداً يضاف إليه صوت التأنيث، مع الفارق في أن كلمة” ابن” هي أصل لغوى غير مشتق، في حين تتحدد علاقة الطفلة بوالدها، من خلال كونها صيغة مؤنثة للابن (ص 98).
ويختتم محمد فكرى الجزار هذا الجزء، متناولاً علاقة البنت والمرأة بظاهرة القربان البدوى ممثلاً في الوأد. ويعود المؤلف إلى عالم الأساطير الجاهلية مشيراً إلى أن كلمة” وأد“، مشتقة من الإله” ود” وهو إله القمر ( وأن كلاً من” ود” و“وأد” اسمان لصنم عبده عرب الجاهلية من قبيلتي كلب وقريش ) ؛ مما يوحي بأن وأد البنات في الجاهلية كان يتم من منطلق تقديمهن قرباناً للإله، عن طريق دفن البنت في رمال الصحراء المقمرة (ص 104).
ويحدد المؤلف الفارق بين الأساطير التفسيرية والتبريرية قائلاً” أن الإبداع الإنساني للأساطير ينزع منزعين حسب طبيعة الاجتماع الإنساني، فالمجتمع الحضري (المديني) يصنع أساطيره بهدف حيازة معرفة عن العالم الذي يقيم فيه باستقرار، أما المجتمع البدوى ( المرتحل وغير المستقر ) فإنه يصنع أساطيره لتبرير نظامه كمجتمع” (ص105).
وإذا كان الوأد هو قتل للإناث بتقديمهن قرابين للإله، عن طريق دسهن في رمال الصحراء، فإن تقديم القرابين من الذكور ممثلة في النذور لم تتخذ شكل الوأد، بل الذبح مع إمكانية افتداء الذبيح بقربان بديل من خارج النوع الإنساني مع” جواز استبدال القربان الحيواني بالقربان البشري في حالة الذكور، وعدم جوازه في حالة الإناث” (ص106)، بحيث تحل الإبل أو الخراف محل الذكور، بينما يظل الوأد مصير الإناث على سبيل القرابين، باعتبار الذبح والوأد ممارسة اجتماعية ذات أبعاد أسطورية، تختلف عن غيرها من الممارسات، التي كانت تتم لأسباب اقتصادية من قتل للأطفال“خشية إملاق“.
ويأتى القسم الرابع والأخير من الكتاب بعنوان” فوبيا الأنوثة أو الرجل المريض“، فيستهله المؤلف مؤكداً دور الرمز في حياة الإنسان وعلاقته التبادلية بالواقع، فهو من ناحية يعكس تصورات الناس عن حياتهم، وفي الوقت نفسه يفرض عليهم تصوراتهم تلك. ويرى أن العنف الرمزي هو” أخطر صور العنف، وأشدها فعاليات، وأكثرها خفاء، نظراً لتغلغل الرمز في حياة الإنسان، وعلى كافة أصعدتها الظاهر منها والباطن” (ص 113)، مشيراً إلى أن اللغة أصبحت أكثر المنظومات الرمزية الاجتماعية تشدداً” يوم نسى ( الإنسان ) أن المعنى اللغوى محض مجاز عن مقاصده، معتبراً إياه حقيقة يمكنها أن تخلق، بشروطها، مجازها… يوم تحولت اللغة إلى أداة للقولبة المجتمعية” (ص 114).
ویری محمد فكرى الجزار أن السيادة الذكورية هي وليدة الصدفة التاريخية، ومن هنا كان قلق الرجل على مكانته، والذي يصل إلى درجة فوبيا الأنوثة والخوف من فقدان تلك السلطة. إن خوف الرجل من فقدان سلطته الجنسية والثقافية المطلقة على المرأة هو الدافع، الذي يجعله يستخدم الرمز والثقافة والمعرفة لضمان تمتعه بالسيطرة المطلقة.
ويرجع المؤلف إلى الأساطير الإغريقية القديمة التي تفسر انتزاع الرجال للسلطة المطلقة، كما يستعين بنظرية فرويد في التحليل النفسي، والتي تعلى من قيمة الذكر على الأنثى باعتبارها تعاني نقص عضو الذكورة في الوقت الذي يخاف فيه الذكر من فقدانه، فيؤكد المؤلف بالتالي فكرة الرجل المريض الخائف من فقدان سلطته الذكورية. وينتقل محمد فكرى الجزار إلى سياق البداوة، متتبعًا بعض المفردات التي توضح طبيعة العلاقة بين الجنسين. ولعل كلمة” رحل” هي من الكلمات ذات الدلالات المتعددة التي تقدم صورة عامة لحياة البداوة ؛ فالرحل مرتبط بالترحال على ظهر الإبل، كما يتم استخدام الرحل للإشارة إلى العلاقة الجنسية بين الرجل والمرأة، إلى جانب معنی معجمی ثالث يعرف بالرحال على أنها هي المساكن، وتحديداً مسكن الرجل (ص 128 -130). ويخلص المؤلف – في نهاية هذا الجزء – من الكتاب إلى ضرورة البدء في” حركة معجمية صحيحة علميًا ومجتمعياً” بتخليص اللغة والمعاجم العربية من بداوتها (ص135)، ويستشهد بقول المتنبي:”فما التأنيث لاسم الشمس عيب / ولا التذكير فخر للهلال” (ص136).
ويختتم محمد فكرى الجزار كتابه بمجموعة من التوصيات (ص 142 -143)، ومنها:
التوقف عن التعامل مع لغتنا العربية بمنطق القداسة، وإدراك قيمتها الرمزية وإمكاناتها الإبداعية. والتوقف عن الإعلاء غير الموضوعي للعربية والبدوية في المعاجم القديمة، ووضع اللغة العربية في سياقها التاريخي والثقافي والمعرفي، ورفض الالتزام بالتأويلات التي يمتلئ بها المعجم العربي، ووضع تأولات نابعة من حياتنا المعاصرة، ومراجعة المعاجم اللغوية ومعاجم ألفاظ القرآن لتنقيتها من التصورات، التي تتناقض مع تصوير القرآن للكون. ومراجعة أبواب ومواد المعجم العربي بما فيه من تكرار، مع تخليص الخطاب المعجمى من التصورات الخاصة بواقع تاريخي ماض، ومراجعة قواعد النحو والصرف لتخليصها مما بها من تعقيدات لا مبرر لها، ومراجعة مناهج الدراسات اللغوية في المناهج التعليمية لتخليصها من ثقافة البداوة، وضرورة تشكيل لجنة من التخصصات المختلفة لمراجعة المعاجم الحديثة، وتشكيل لجنة من اللغويين لوضع معاجم متخصصة في الحقب الزمنية المختلفة. وأخيراً وضع معجم لغوى عصرى، يعتمد على اللغة السائدة والمستخدمة فعلاً واعتماده في المؤسسات التعليمية.
دلالات اللغة والجندر، اللغة والنظرة الذكورية
هالة كمال: مدرسة بكلية الآداب – جامعة القاهرة، عضوة مؤسسة بمؤسسة المرأة والذاكرة، وباحثة مهتمة بدراسات الجندر.
(1) د. محمد فكرى الجزار،” معجم الوأد: النزعة الذكورية في المعجم العربي ( في تحليل الخطاب المعجمي )”، القاهرة: إيتراك للنشر والتوزيع، 2002.
(2) كافة أرقام الصفحات المذكورة تشير إلى كتاب” معجم الوأد“.
د. محمد فكرى الجزار،” معجم الوأد: النزعة الذكورية في المعجم العربي ( في تحليل الخطاب المعجمي )، القاهرة: إيتراك للنشر والتوزيع، 2002.