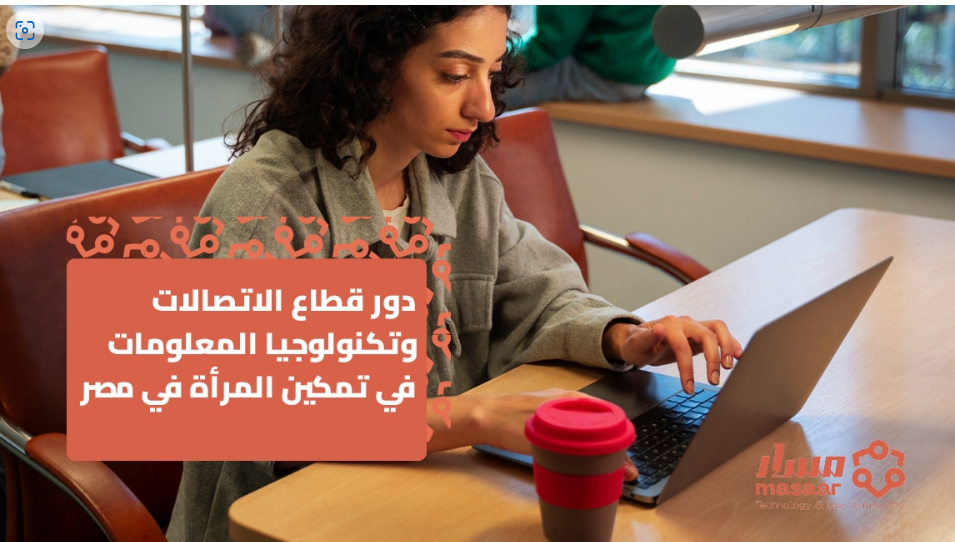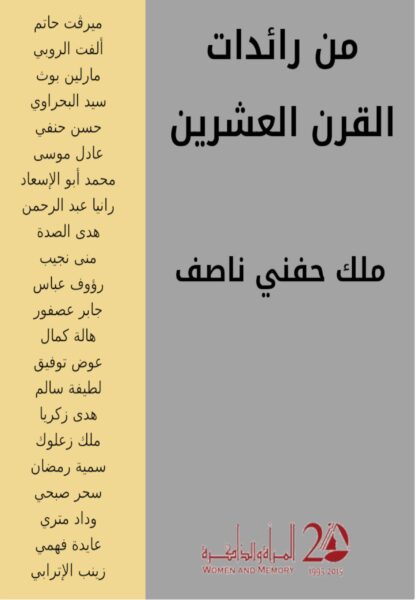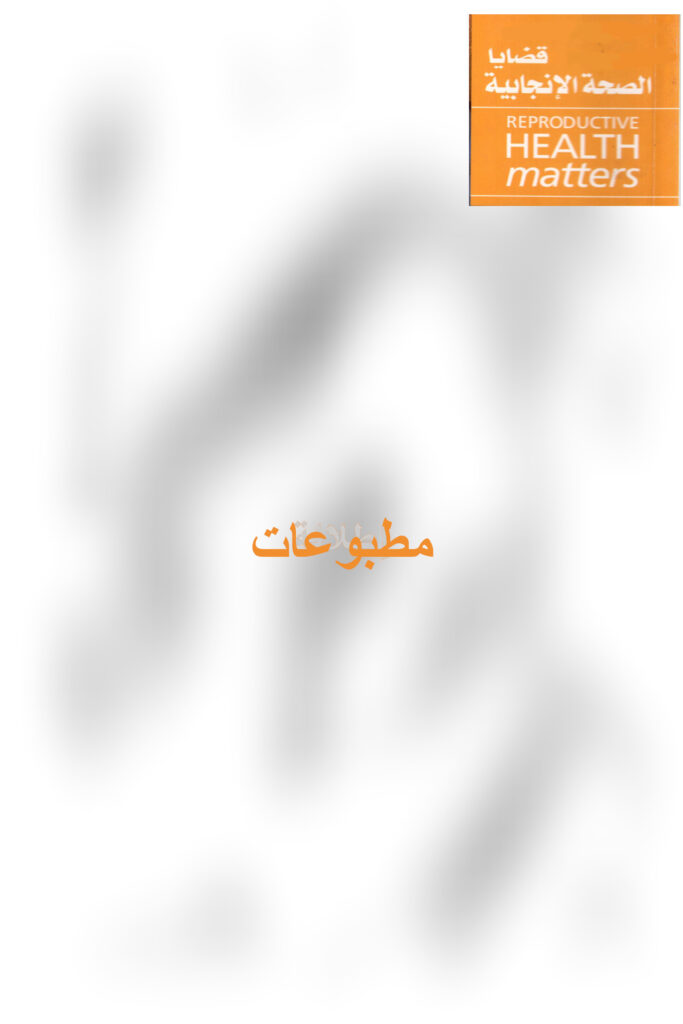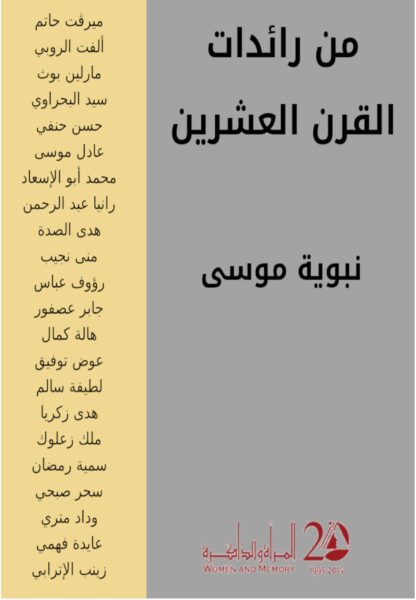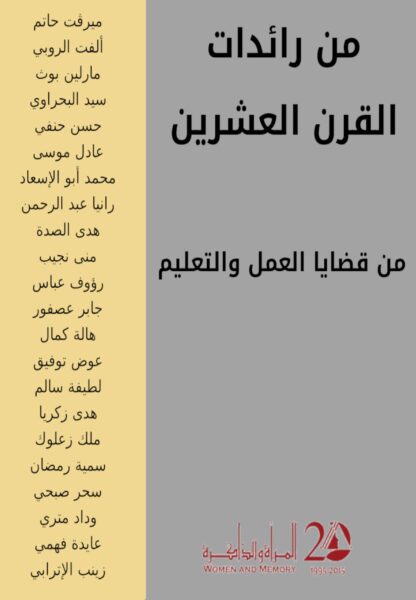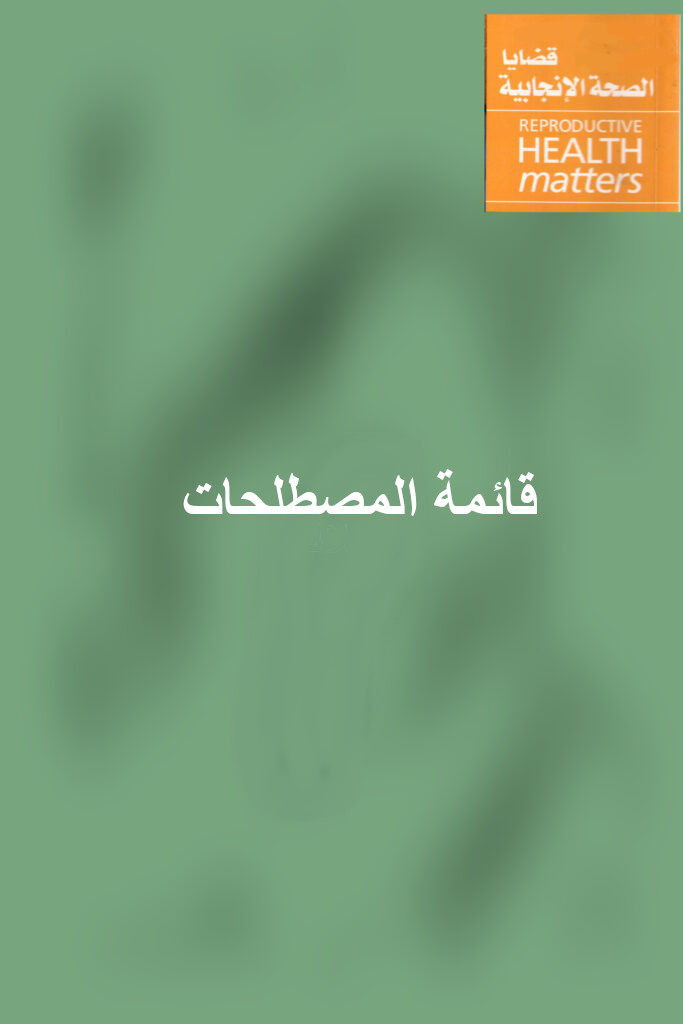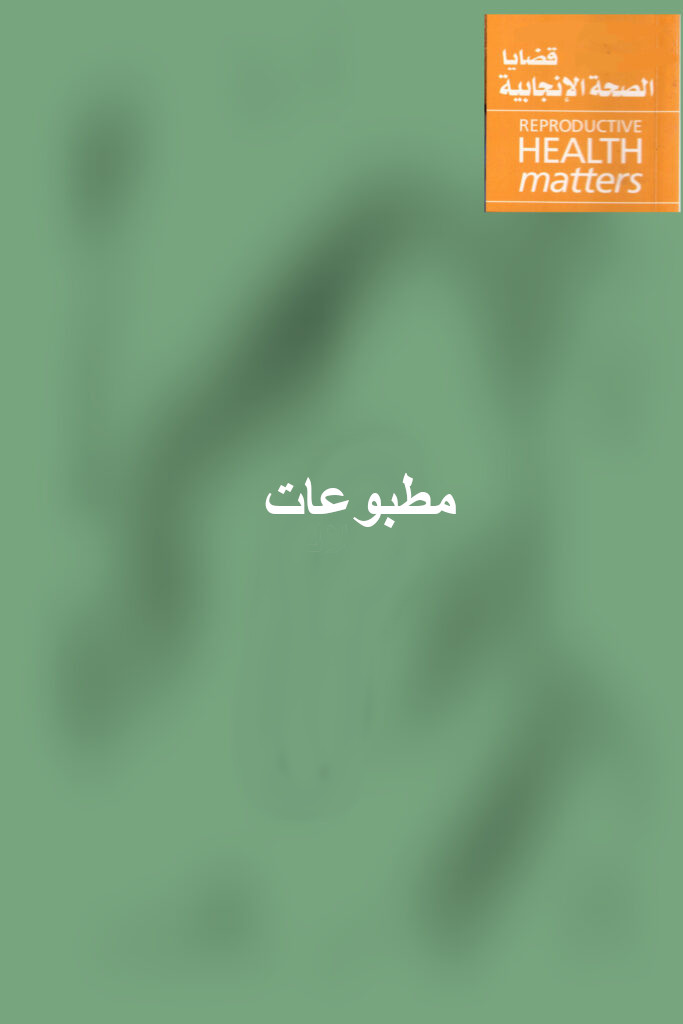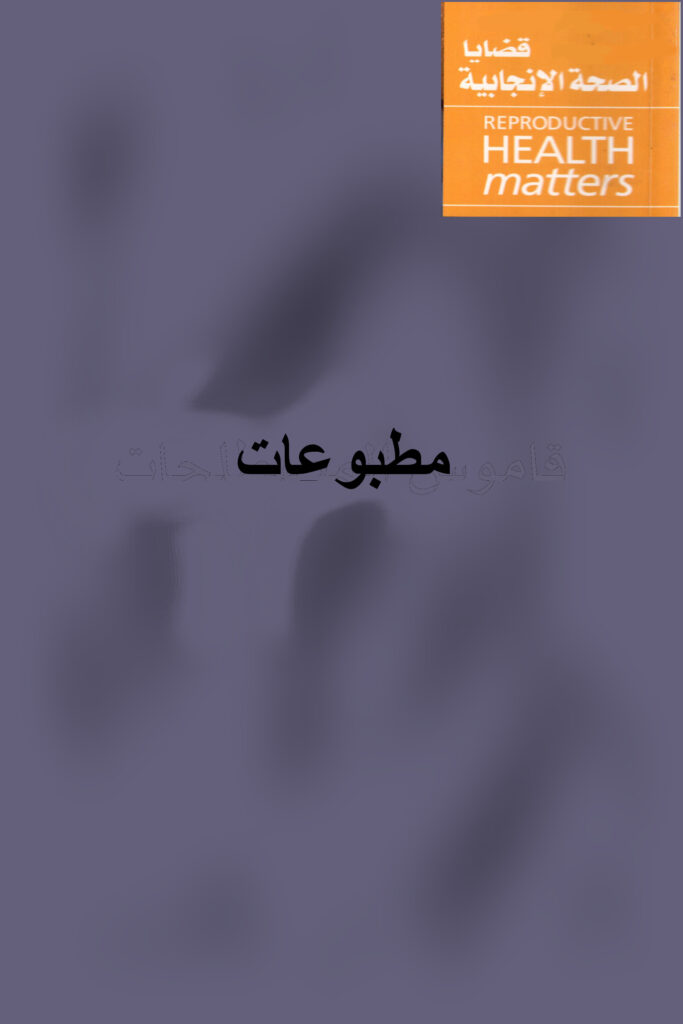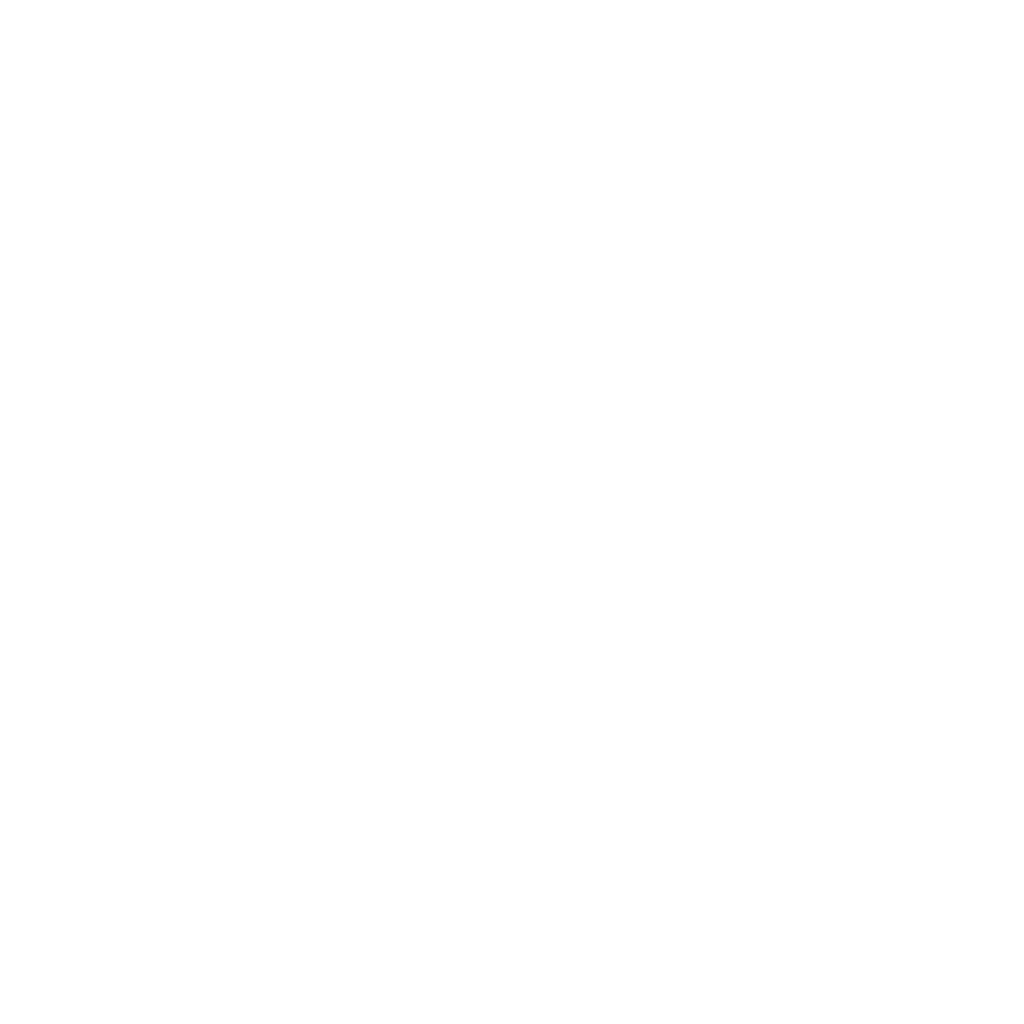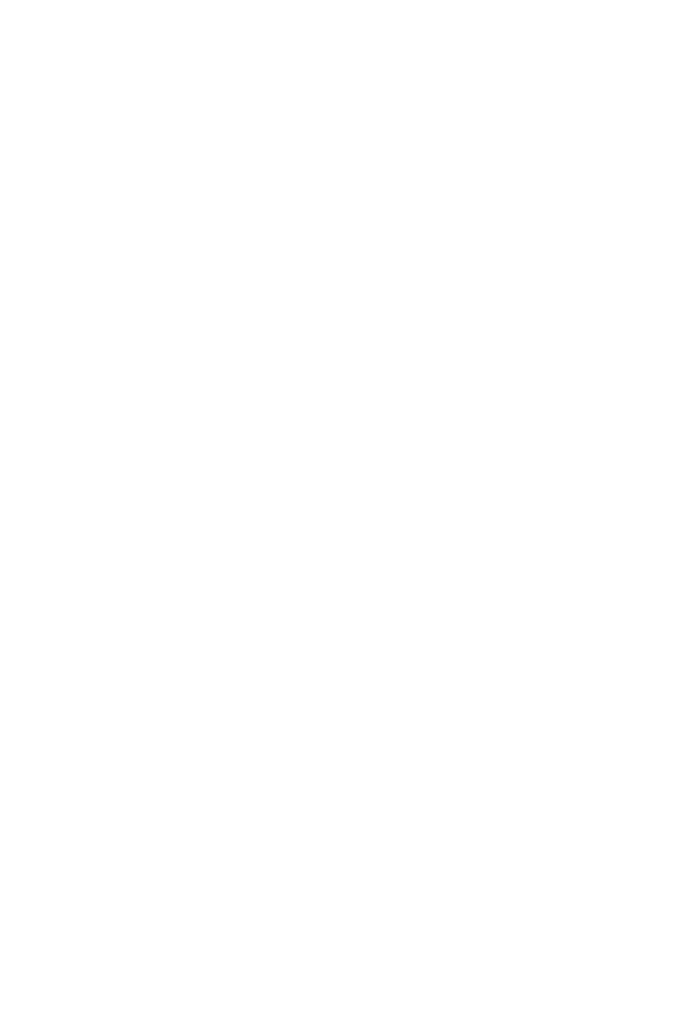انعكاس صورة المرأة بين الحياة – الأدب، والأصولية، والتغريب
بقلم:
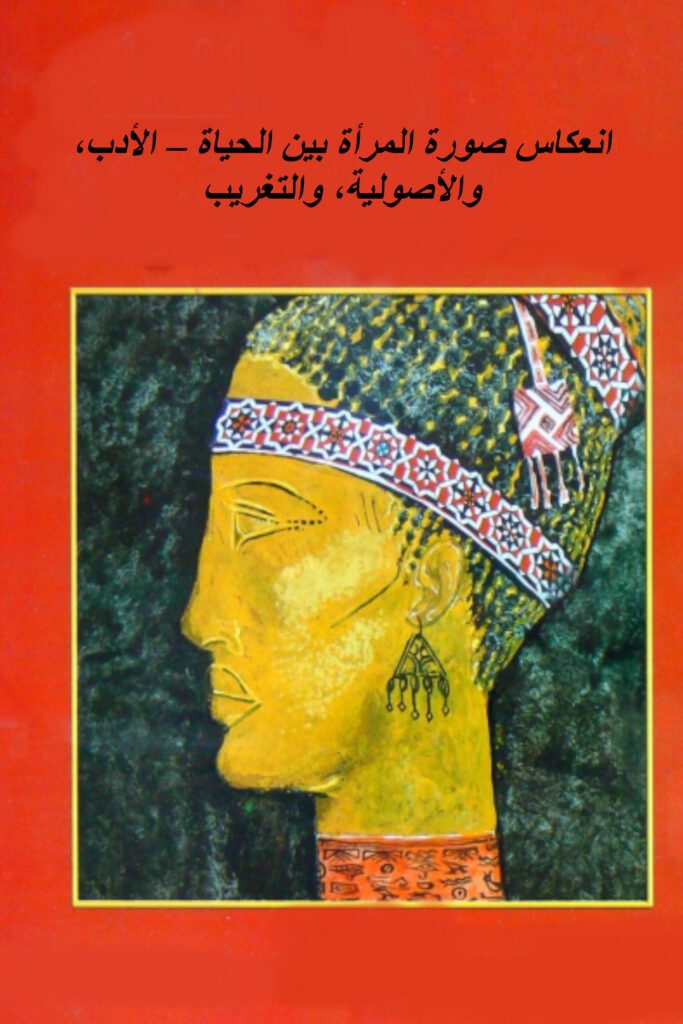
انعكاس صورة المرأة
بين الحياة – الأدب، والأصولية، والتغريب
إذا بحثنا في ما يُكتب عن النساء، نجد – في الغالب – تفاوتاً لافتاً، وأحياناً نجد اختلافاً صاعقاً، بين الكتابة التي تسعى إلى القيمة الأدبية، والكتابة التي تتوخى التنظير من أجل رسم نظم أو قيم يود الكاتب، بشكل مباشر أو غير مباشر، أن يطبع بها دور النساء في المجتمع. فلو نظرنا – مثلاً – إلى العصر اليونانى القديم، لوجدنا أن صورة المرأة في الأدب، تعكس غنى إنسانياً وفعالية خلاقة، كما في شخصيات انتيجون وجوكاستا وكليتمنسترا وإلكترا، ووجدنا الصورة “النظرية” التي تحاول رسم “طبيعة” المرأة، أو التي توجه إليها “النصح“، تعكس صورة مختلفة تماماً، كما في فلسفة أرسطو، التي تجعل التلقى صفة ملتصقة بطبيعة الكيان الأنثوي (انظر: Aristotle، Generation of Animals، Book 1، Chapter 21 ) وكما في قول بركليس، في خطبة الجنازة، واعظاً نساء أثينا: “إن أعظم مجد للمرأة هو أن يقل ذكر الرجال لها، سواء كان الذكر هذا، في معرض مدح أو نقد
(Thucydides، History of the Pelopponnesian War، p. 151).
ولو نظرنا إلى ما يوازى هذين الوجهين للكلام عن المرأة في العصر الحديث، لوجدنا تفاوتاً مماثلاً بين شخصيات النساء في الأدب والسير المكتوبة، ووصف فرويد لطبيعة الأنوثة بأنها فاقدة الرغبة، خرساؤها؛ لقلة فعالية متأصلة في طبيعتها. ونجد اقتران النظرية بالتوصية الاجتماعية التربوية، متجلية في ربط التحليل النفسي، بين سلطوية الأم أو عدم احترامها “لاسم الأب“، وانحراف الأبناء جنسياً، أو اختلال عقولهم (أنظر مثلاً: Y. O. Alanen 1958 and Wilfried Ver Eecke 1988) وهى توصية يتشابه مضمونها، مع مضمون توصية بركليس، لكنها تفوقها في قدرتها على التأثير لوصفها محاذير رهيبة تترتب على عدم الأخذ بها.
ولعل أصحاب هذه النظريات، يرون في سير كل من جورج صائد وإنديرا غاندي، وخديجة وعائشة، زوجتي النبي محمد، والأم تيريزا أو أية امرأة اتخذت في حياتها، مبادرات مستقلة، سيراً لنساء أخفق المجتمع في ترويضهن، أو خرقن النسق الطبيعي. والمجتمع – كما الأدب – يحفل بمثيلات هؤلاء على الرغم من دأب النسق الاجتماعي على إحباط تعبير عن حيويتهن، أو عما يدور في أنفسهن. والعمل على الإحباط هذا، يأخذ وجهات متعددة منها، الاستخفاف، ومنها الزجر أو الردع، ومنها التجاهل، وهو ما يقوم به – كتابةً – كثير من المنظرين والمؤرخين. ولعل المنظرين القائلين بانفعالية النساء، وقصورهن عن الفعالية، يعتبرون ما أنتجه الأدب من شخصيات نسائية، مخالفًا لحقيقة المرأة وطبيعتها، ناقضين بذلك الاعتقاد السائد، بأن العلاقة حميمة بين الأدب والحياة، وبأن أفضل الأدب، هو أشمله وأعمقه؛ من حيث إنسانية ما يصوره.
إلا أن المنهجية المعاصرة للبحث، في العلوم الإنسانية، جعلت عمل من يضع نظريات، لا تنسجم مع الواقع المعيش، أكثر صعوبة، مما كانت عليه في السابق. ذلك أنه في الأزمنة السابقة، كان بوسع المنظرين أن يكتفوا بحجج، يكفي أن تكون منسجمة في منطقها الداخلي، أو أن تكون مقنعة – إلى حد ما – أو مدعومة بشيء من البرهان الحسي. أما الأنماط الحديثة للعلوم الإنسانية، ومن ضمنها العلوم المتعلقة بالقانون، فتتجه نحو استنباط النظريات من الدراسات الحقلية، أو من الأمثلة الواقعية، ونحو رفض ما يكون غير منسجم، مع ما تظهره الوقائع المرصودة. ومع هذا ما فتئ كثير من المنظرين في عالمنا العربي، ممن تناولوا موضوع ما هو “أصلح للنساء“، وأكثر انسجاماً مع “طبيعتهن” يذهبون – بعيداً – في وضع نظريات قليلة الصلة بحيوات النساء، أو بالأصول التاريخية التي يدعون استلهامها. بل إن بعض هؤلاء، لا يتوانى عن تزوير تاريخ النساء، وتشويه الذاكرة الحاملة صورهن، أو لا يرى غضاضة، في القفز فوق ما يظهره الواقع، وفي تجاهل ما هو قائم على الأرض؛ من أجل نظريات تجيز له، ما هو غير جائز، وتعطيه وتعطى من ينتمى إليهم، في النوع البيولوجي، أو في النهج السياسي، أكثر مما يحق له، فيما لو اتخذ الصدق في النقل، غاية، أو لتمحيص الواقع المعيش أسلوباً. ومن بين هؤلاء، بعض الأصوليين الإسلاميين المغالطين لما يقوله التاريخ، عن أوائل المسلمات. ومن بينهم – أيضًا – بعض الباحثين في النسق الاجتماعي، المتسرعين في استلهام الحداثة الغربية، والنسج على منوالها.
وفي هذا المقال، الذي سأركز فيه على موضوع الزواج والطلاق، سأظهر – أولاً – التنافر، بين ما يعتبره بعض المنظرين التقليديين مدعى الأصولية، حال المسلمات الأوائل وما تصفه السير المكتوبة عن حيواتهن. وسأناقش – ثانياً – ما يراه بعض علماء الاجتماع، مسلماً به من حسنات محاكاة الأساليب الأسرية، التي ظهرت مع الحداثة (modernity) في الغرب.
وسأختم بتحليل أسباب تجاهل هذه النظريات للنصوص التاريخية، أو للواقع العربي الراهن، عل عملى هذا يسهم في لجم بعض المزورين والمستسهلين، من واضعي النظريات، حول ما هو الأصلح للنساء، أو الأسلم لأخلاقهن، أو الأكثر عدالة وإنسانية، من أجل تسوية أوضاعهن.
إن بعض المنحازين إلى النظرة “التقليدية“، التي تسعى إلى حد مسار حياة المرأة، في نطاق ما يحصل لها، وما تقوم به ضمن العائلة، دون أن يسمحوا لها، بممارسة ما منحه الإسلام لها، حتى في نطاق العائلة المحدود، يزعمون أن نساء العصور الإسلامية الأولى، كن متواريات وطائعات. وعندما يجابههم التاريخ، بغير ما يزعمون، يعمدون إلى مغالطة التاريخ، كما فعل توفيق الفكيكي، الذي ادعى أن ما ترويه كتب التاريخ المتعددة، من سيرة سكينة بنت الحسين بن على بن أبى طالب، هو تجن من أهل السنة؛ لتشويه صورة أهل البيت. يقول: “سكينة اسم تجنّى عليه التاريخ تجنياً، تعدى كل الحدود” (توفيق الفكيكي، آذار، ١٩٥٠، المقدمة وعنوانها “هذا الكتاب“)؛ وهو يرجع هذا التجني، إلى إيعاز من أعداء أهل البيت. وغايته في هذا القول، مغالطة ما قيل عن سكينة من قلة التشدد، في أمر الحجاب، ومن حبها الاستماع إلى الموسيقى والغناء، ساعياً – في الوقت ذاته – إلى التشكيك في ما ترويه المصادر عن استخدام سكينة، لما أعطاه الإسلام المرأة من الحقوق في تعاقب الأزواج، وفي وضع الشروط عليهم، عند عقد القرآن، بما في ذلك الاحتفاظ بحقها، في خلع نفسها من الزواج.
وينسج على منوال الفكيكي، عدد لا يستهان به من المتفقهين، فيتمسكون، فيما يختص بتصوير حياة المسلمات الأوائل، بتاريخ وهمي، ويبتعدون عن التاريخ الأصيل، كما يبتعدون عن النظر إلى الأوضاع المستجدة، وإلى ما يمليه المنطق السليم. ومن الأمثلة على التباعد، بين هؤلاء، والتعامل المنطقى، مع ما يجرى في الحياة المعاصرة، أن بعضهم يصر في تشريعه، على التعامل مع المرأة باعتبارها قاصراً عن المشاركة في الإنفاق على أسرتها، في الوقت الذي يتطلب المجتمع العصري منها، أن تسهم في مسؤولية الإنفاق على الأبوين، أو على الأطفال، وأحيانًا على الزوج، إن كان مريضاً أو عاطلاً عن العمل. فتبقى المرأة شرعاً، ملزمة بطاعة وتبجيل وخدمة الرجل، حتى عندما تجد نفسها معيلة له. وقد تناولت السينما المصرية، التناقض المخجل (۱)، الناضح بتخلف الوعى، واستبدادية الحكم الذي قد يقع؛ عندما تجد واحدة من صاحبات المركز المرموق، والرأى المسموع، نفسها مطلوبة إلى “بيت طاعة” (٢)، ابتُدع حديثاً، دون أن يأبه مبتدعوه التناقض بينه وبين الواقع المعاصر من جهة، وبينه وبين ما كان من أمر السلف المسلم، من جهة أخرى.
ومن علائم مغالطة بعض المشترعين لتاريخ الإسلام، أنهم يمنعون المرأة من تزويج نفسها، مع أننا نقرأ عن الصديقة خديجة، زوجة النبى الأولى، أنها كانت هي المبادرة في طلب الزواج من النبي. ويذكر المدائني، عن زواج سكينة بنت الحسين ابن على بن أبي طالب، من إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، أن سكينة هى التي اقترحت أن يتم الزواج بينهما. وقد ضاع حق المرأة هذا، في عصورنا المتأخرة، بل أصبحت وكالتها عن نفسها، في عقد الزواج، غير مقبولة عند بعض المتزمتين، من رجال الدين. ومثال على هذا، أن الشيخ خالد الكندارى، وهو مسؤول ديني، في مقاطعة فلوريدا، في الولايات المتحدة الأمريكية، رفض في الخامس من نيسان، سنة ١٩٩٦، تزويج بشرى جبر، وهي سيدة أنهت الأربعين من العمر، ولها مكانة علمية وأدبية مرموقة، إلا بواسطة وكيل، زاعماً “أن المرأة في الإسلام لا تزوج نفسها“. وهو بهذا، ينفي ما كان واقعاً، في حيوات نساء، تعتبرهن المسلمات قدوة تُحتذى.
وكانت المرأة المسلمة – قديماً – تشترط في عقد زواجها، الأمور التي ترى فيها تحقيقاً لراحة بالها، أو لهناءة عيشها، مثل اشتراطها على زوجها، عدم اتخاذ محظيات، أو تحديد مكان الإقامة الذي ترتضيه، كما فعلت سكينة. وقد وجد الباحث عماد أبو غازي (انظر بحثه ضمن هذا المجلد)، في دار الكتب المصرية، عقود زواج، ترجع إلى القرن الرابع الهجري، اشترطت فيها النساء، أن يمتلكن عصمة ضرائرهنّ، أو أن يمتلكن حق بيع وإعتاق الجواري، اللائي يمتلكهن الأزواج. وبعض هذه العقود، نص على طلاق الزوجة، إن تزوج زوجها بغيرها، أو إن غاب عنها مدة. وبين ما وجده أبو غازي، عقد ينص على أن الزوجة تصبح طالقاً بالثلاثة، إن غاب عنها زوجها، أكثر من ستة أيام!.
أما في الزمن الحاضر، وفي ظل بعض مدعى العودة إلى الأصول السابقة، فلا يتسنى للمرأة أن تشترط في عقد زواجها، إلا جعل عصمتها بيدها. وقد غدا هذا الشرط صعب التحقيق بسبب اعتباره غير مستحب، من قبل رجال الدين؛ وبسبب الضغط الاجتماعي الذي يقرن اشتراط الزوجة هذا، بعدم أهلية الزوج للثقة، أو بتسلّط الزوجة، أو بتواجد هذين الأمرين معاً، وكلاهما معيب العروسين.
وقد ثارت في مصر ثائرة السلفيين؛ عندما وضع سنة 1979 قانون الأحوال الشخصية، (رقم 44)، الذي يطالب بإخطار الزوجة (الزوجات) في حال زواج الزوج من أخرى، أو بإنباء من يطلبها للزواج، بكونه متزوجاً، من قبل إذا كانت هذه حاله، مجيزاً للزوجة السابقة الطلاق، دون حاجة لإثبات الضرر، والزوجة الثانية الأمر نفسه، إذا كان قد أخفي عنها زواجه بأخرى، لدى عقد القرآن (منى ذو الفقار (۱۹۹۷، ۱۷ – ۱۸).
وعندما عرضت المحامية – منى ذو الفقار – مشروعاً، تكون بموجبه وثيقة الزواج، متضمنه مساحة تضع فيها الزوجة شروطاً، قال شيخ الأزهر: إن وثيقة كهذه تخالف الشريعة الإسلامية. وعلّق مفتي الديار المصرية على المشروع، بأنه غير ضروري، وغير مرغوب فيه. وفي الرأى الأول، مغالطة للأصول التاريخية، وفي الثاني، استبدادية غير مبررة؛ إذا كانت الغاية استلهام الأصل، بدل اختراع أصول، لا ترجع إلا إلى رغبة “المشترع“، واستنسابه المصحوبين بتحيز فئوي، بعيد عن التجرد الديني، أو القانوني.
وكان الشرع في عصور الإسلام الأولى، يسمح للزوجة بالانفصال عن زوجها؛ عندما تصبح أوضاع الزواج مؤذية لها، حتى عندما يكون الأذى محدوداً. فمثلاً، يُروى عن عمرو بن العاص، أنه بينما كان يسير متدروشاً، في إحدى الليالي سمع امرأة تتذمر من رائحة فم زوجها، فما كان منه إلا أن رجع إلى بيتها، في صباح اليوم التالي، وطلقها منه. وكانت المرأة – في ذاك الزمن – قادرة على تحقيق الانفصال، عن زوجها، بمجرد أن تبدى عدم رغبتها، في المضى بالزواج. ولعل ما حصل من إبطال النبي محمد، زواجه من عمرة بنت يزيد الكلابية، عندما أبدت عزوفاً عنه في ليلة زفافهما، هو نموذج أراد الله ونبيه، أن يقتدى به المؤمنون، حتى لا تُظلم النساء بإجبارهن على البقاء مع من لم يعدن يرغبن، في البقاء معهم. ويبدو في كتاب معجم النساء، وهو الجزء الثاني عشر، من عمل شمس الدين بن عبد الرحمن السخاوي، وعنوانه “الضوء اللامع لأهل القرن التاسع“، أن تفهم الأهل والمجتمع، لحق الزوجة، بالعزوف عن مساكنة زوج، لم تعد تطيقه، بقى قائماً، على الأقل، إلى القرن التاسع الهجري. فقد روى السخاوي، ما حصل لزوج سعادة بنت الجمال أبى السعود محمد ابن البرهان ابن هيرة المكي، الذي منعته زوجته، من المجيء إلى المنزل، عندما لم تعد ترغب في مشاطرته العيش؛ ولم تفلح وساطة الأعيان، من أهل مكة، في إعادته إلى المنزل، بمن فيهم شريف مكة نفسه (الحالة ۳۸۸، في الكتاب المذكور للسخاوي).
ودلالة هذه الواقعة، تتعدى إظهار التفاوت، بين ما حصل لسعادة، وما يحصل للمعاصرات، ممن يجدن أنفسهن في حال، مثل حالها، فينعتن بالنشاز، ويجبرهن الشرع على الإقامة، في “بيت الطاعة“، على الرغم من أنوفهن. فتعامل السخاوي المتفهم، وغير المستهجن، مع الموضوع، وإشارته إلى أن أهل سعادة، لاموا أنفسهم؛ لأنهم كانوا قد ضغطوا عليها في الزواج، ولم يساعدوها على الزواج، بمن كانت ترغب في الزواج منه، يظهران أن إرادة المرأة ورغبتها في ذلك الزمن، كانا يلقيان من الاهتمام، ما لا يلقيانه، في عصر “بيوت الطاعة” الراهن هذا.
وفي الزمن الراهن، تمنع بعض فرق الإسلام الخلع (طلب المرأة إنهاء زواجها)، إلا في حالات معينة عظيمة الضرر لها. والشرع الجعفرى، يكاد يمنع تحقيق الخلع إطلاقاً؛ ما لم يرض به الرجل. بل يسمح مشترعون، بأن يرد الرجل زوجته المطلقة، قبل انتهاء عدتها، دون موافقتها!. ومصادرة حق المرأة المتزوجة، أو المطلقة، قبل انتهاء عدتها، في المشاركة في تقرير مصيرها، في إنهاء الزواج، أو في العودة إلى زوج سبق أن طلقها، يتم بإغفال ما تقوله المراجع، عما كان من حال المسلمين القدماء، وبالاستناد إلى حجج واهية، لا يدعمها منطق ولا تجربة.
وهذه الحجج، هى – في الغالب – مستوردة من النظريات الغربية، التي واكبت عصور التسلط الذكوري، أو مهدت له فهذه “النظريات“، هي أشبه بما كان في إنجلترا، حتى القرن الثامن عشر، من اعتبار المرأة ملكاً للرجل، يفعل ما يشاء في أملاكها، وفي حياتها، فلا يطاله قانون، حتى لو أزهق روحها؛ وهى لا تمت بصلة إلى الإسلام المتمسك، بكمال إنسانية المرأة، ويتمام حقوقها. ومن يستلهمون ما سبق من تخلف غربي، يتظاهرون باستلهام الأصول الإسلامية، وانسجاماً مع هذا التظاهر، يغالطون أو يتجاهلون ما دون وتنوقل، من أخبار نساء العصور الأولى، من الإسلام.
كذالك يبدو مما نقرأه في التراجم والسير القديمة، مثل كتاب “المردفات من قريش“، لأبي الحسن علي بن محمد المدائني، ومثل معجم النساء المذكور آنفاً، أن الزواج بعد الانفصال، أو بعد الترمل، كان أمراً طبيعياً ومقبولاً. فالمدائني تكلّم على ثمانٍ وعشرين امرأة، من بنات قريش المرموقات النسب، وأكثرهن من الفصيحات وقارضات الشعر، ومن بين هؤلاء، أربع – فقط – تزوجن مرة واحدة، وإحدى وعشرون تزوجن ثلاث مرات أو أربعا. والسخاوي، تحدث عن تسعمائة وثمان وثلاثين امرأة من الفقيهات، وثلاث وثمانين من المماليك، وثلاث وأربعين من الجواري المحظيات، وإحدى عشرة لم يحدّد وضعهنّ الاجتماعي، ومن هؤلاء، خمسمائة واثنان وثمانون ذُكر أنهن متزوجات، ومن الباقيات، تسع وستون ذكر أنهن لم يتزوجن. ومن المتزوجات، ثلاثمائة وخمس وأربعون تزوجن مرة واحدة، وستة وثمانون تزوجن مرتين، وثلاثون ثلاث مرات، وإحدى عشرة أربع مرات، وثلاث تزوجن خمس مرات، وأربع ست مرات (علياء الصعيدي، ١٩٩٦).
ومن بين المتزوجات ست مرات، أم الحسن ابنة التقى، محمد ابن البدر البلقيني. وكانت أم الحسن عند زواجها الأخير، في حوالي السادسة والستين من العمر، وهي فقيهة مجازة، جاورت في مكة، وتتلمذ عليها طلاب، في علم الفقه. ويصفها السخاوي بأنها “لها عقل وتدبير ومحبة في أهل الخير وتعفف واحتياط غالباً. ومثل هذا التقدير، لا يمكن أن نراه يطال امرأة معاصرة، تتزوج ست مرات، ولا تستنكف من الزواج، في عمر متقدم، كما فعلت أم الحسن. فالمجتمعات الإسلامية المعاصرة، كثيراً ما تعيب على المرأة، إعادة كرة الزواج، بعد طلاق، أو ترمل. وهي بذلك تبتعد عما نجده في الأصول الإسلامية، وتقترب من أصول أخرى، كالأصل المسيحي القائل: بقدسية الزواج ووحدانيته، والأصل اليونانى الأفلاطوني: الذي يزدري الجسد ورغباته. وغالباً، ما تطبق الأفلاطونية، على النساء فقط. فكأن الانتقائية الذكورية التي تحكم القيم، قررت أن جسد المرأة وحده مادى، وبالتالي، دونى وواجب قهره، وأن جسد الرجل من مادة أخرى، يجب تعزيزها، واحترام رغباتها.
وفي سير النساء المتأخرات، في الزمن، اللواتي قرأت عنهن، أو قابلتهن، أو قابلت من أخبرني عنهن، في بحثى الميداني (۳)، تندر من تزوجت مرتين. وكثير من الناجحات، في مجالات العلم والأدب، الموازيات لمن ذكرهن، كل من المدائني والسخاوی، کسلوی نصار وروز غريب وغيرهما (Shereen Khairallah، “The Sisters of Men”)، وجدن أن عليهن الاختيار بين الزواج، واهتمامهن العملى، ففضلن الخيار الأخير. ومن تزوجت منهن، عانت – في الغالب – حياة زوجية قاسية، أو انفصلت عن زوجها، وبقيت وحيدة، على الرغم من حصول الانفصال في شبابها. ولكثرة فشل الكاتبات والصحفيات في الزواج، تعلّق شيرين خير الله (Shereen Khairallah) على نصيب هؤلاء من الزواج، بالقول: “قليلات منهن نعمن بزواج سعيد. وأغلبهن انتهين، إلى الانفصال عن أزواجهن. وقد يكون سبب الانفصال، كون الرجال لا يرغبون في النساء المتعلمات، اللواتى قلما ترضى الواحدة منهن بالدور التقليدي المرسوم للمرأة ( Khairallah، 1996، 177 – والترجمة لكاتبة المقال).
وقد يظهر التفاوت في أمور الزواج والطلاق، بين ما كانت عليه عصور الإسلام الأولى، وما أُنتج في المجتمعات الإسلامية المتأخرة، في الزمن، من تقاليد وسلالم قيم، تدعى العودة إلى الإسلام وأصوله، لو قارنا بين سيرتين، تمثل كل منهما أحد الزمنين، هما سيرتا سكينة بنت الحسين بن على بن أبي طالب، و(نور) الهدى شعراوي. قد اخترت سيرة سكينة، من بين السير القديمة، لأفضليتها كقدوة للمسلمين؛ إذ إن كونها ابنة حفيد النبي، يقربها في الزمن والنسب، من الأصول الإسلامية. أما هدى شعراوی، فاخترت سيرتها؛ لأنها تتناول امرأة من العصر الحديث لها من النسب والمكانة الاجتماعية، ما يميزها عن معظم نساء عصرها، مما قد يجيز مقارنة مسار حياتها، بمسار حياة سكينة. ورب قائل، إنه لا يجوز مقارنة أية امرأة، بنساء أهل البيت؛ إلا أن عذرى في هذا، هو أنني أبحث في موضوع العادات الاجتماعية، المنقولة في الكتب، ولا أتناول موضوعاً، يمس الدين، من قريب أو من بعيد.
المثال القديم: سكينة بنت الحسين
تزوجت سكينة ابنة الحسين بن على بن أبي طالب – أول أمرها – من ابن عمها، عبد الله بن الحسن ولا ندرى، هل أُخذ رأيها في موضوع زواجها هذا، أم لا؟. ويمكن أن نستنتج من ارتباط أهل بيت الرسول، بأصول الدين، ومما عُرف عن شخصية سكينة، أنها لم ترغم على ذلك الزواج. وقد قُتل زوجها الأول، مع الحسين في كربلاء، فتزوجت – لاحقاً – من مصعب بن الزبير. وعندما أنجبت منه ابنة، أراد أن يسمى الطفلة اسماً قريباً من اسمه، إلا أنها رفضت الانصياع لإرادته، وأطلقت عليها اسم جدتها. وبعد مقتل مصعب، خطبها عبد الملك بن مروان، فأبدت أمها معارضة لهذا الزواج؛ لأن عبد الملك، هو قاتل ابن أختها، فامتثلت سكينة لرغبة والدتها. بعد هذا، تزوجت سكينة من عبد الله بن عثمان بن عبد الله بن حكيم بن حزام، وعندما مات، تزوجها الأصبغ بن عبد العزيز بن مروان، وبعده زيد بن عمرو بن عثمان، وهذان الأخيران انفصلا عنها؛ لعدم قدرتهما على الوفاء بالشروط الصعبة والمكلفة، التي وضعتها في عقد قرانها، من كل منهما. ثم تزوجها إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، وكانت هي المبادرة، في طلب هذا الزواج. إلا أن أهلها، عارضوا هذا الزواج، وعندما خُيّرت، اختارت الانفصال عن إبراهيم. وكان الانفصال على الرغم من إرادته. وعندما حاول ثنيها عن قرارها، وإقناعها بالبقاء معه قائلاً: “أنا خير الناس لك“، هزئت من قوله هذا، وأصرت على تطليق نفسها منه.
وكانت سكينة تحتفظ بعصمتها، في عقد القرآن، وتضع على زوجها شروطاً، بينها السكن قريباً من صديقة أثيرة لديها.
المثال الحديث: هدى شعراوي (۱۸۷۹ – ۱۹4۷)
أما هدى شعراوي، ابنة العائلة المصرية العريقة والثرية، فقد زُفت في سن الثانية عشرة، إلى على شعراوي، ابن عمتها، والوصي عليها وعلى أخيها، بعد وفاة والدهما، التي حدثت عندما كانت هدى في الخامسة من عمرها. وكان على متزوجاً، وله أولاد يكبرون هدى سناً. وقد وافقت والدتها على تزويجها منه، دون أخذ رأى الفتاة، وعندما سألت هدى، لدى رؤيتها الاستعدادات القائمة، في البيت، عمن سيتزوج، قيل لها إنها ابنة باشا، سبق لخادمة والدتها أن عملت عنده. وبعد الانتهاء من إعداد العدة للزفاف، وعقب إرسال الدعوات، لحضور الاحتفال بالمناسبة، دخل على هدى، اثنان من الباشوات، فأخبراها بأنها هي العروس، وطلبا إليها أن توكل أحدهما، في عقد قرانها، منبهين إياها، إلى أن أية معارضة منها للزواج، تغضب روح والدها، وقد تقضى على والدتها المريضة. فلم يبق أمام هدى المنتحبة، إلا التسليم، وهو ما نصحتها به والدتها – لاحقاً – قائلة: “اقبلى يا ابنتى بما قُسم لك، وليكن الله في عونك“. وقد كانت السنة الأولى، من زواج هدى شعراوى، بائسة؛ إذ إن زوجها لم يحسن معاملتها، فكان يمنعها من زيارة أهلها، ويراقب – عن كثب – علاقاتها الاجتماعية، وما تقوله لصديقاتها، أو يقلنه لها. ثم قررت والدتها فصلها عنه؛ لأنه أخل بالوعد الذي قطعه في عقد الزواج، بالتخلي عن زوجته الأولى، (أو محظيته، كما يُذكر في مذكرات هدى شعراوى، التي ترجمتها إلى الإنجليزية مارغو بدران). وقد دام انفصال هدى شعراوى عن زوجها، ثماني سنوات، أنكبت فيها على العلم والنضال، من أجل الوطن ومن أجل حرية أبنائه وبناته، مركزة على موضوع تحرير النساء، من رق الجهل والتقاليد البالية، التي لا تفيد عملياً، ولا تُقبل منطقياً أو إنسانياً. لكنها قررت بعد هذه السنوات، أن ترجع إلى زوجها؛ لأن شقيقها كان قد قطع على نفسه عهداً، بألا يتزوج من خطيبته، إلا بعد عودة هدى إلى زوجها. وتقول إن زوجها أحسن معاملتها، بعدما عادت إليه. وعلى الرغم مما قاسته، في سنى زواجها الأولى، ومن التزامها بالمطالبة بالتحرر والعمل من أجل الوصول إلى مجتمع يأذن باستقلالية فردية، ويسير على طريق المساواة بين الجنسين، إلا أنها لم تتوان عن محاولة إعادة كرة الزواج الذي يرتبه الأهل بمعزل عن إرادة الأبناء، أصحاب العلاقة، فعملت على تزويج ابنها، من ابنة أخيها!. لكن وفاة الأخيرة، حالت دون إتمام هذا الزواج.
ومن يقرأ سيرتى سكينة وهدى، لابد أن يصدمه التفاوت بين الأوضاع الاجتماعية، والقيم التي سادت في عصر كل منهما. فالأولى، نعمت بحرية تمارس فيها هواياتها الأدبية والفنية، والثانية ناضلت حتى في مجال تثقيف نفسها؛ إذ منع مربيها، سعيد أغا أستاذ اللغة العربية، من تعليمها النحو ( د. نبيل راغب، ۱۹۸۸، ٦۷ – ٦٨)، وكان عليها المناورة من أجل الحصول على بيانو تعزف عليه (المرجع ذاته، ص۷۱).
وسكينة، ملكت أمر نفسها، في الزواج والطلاق، وكان رأى الأهل تمنيا منهم، أن تنصاع إليه، أو أن تحجم عنه. أما هدى، فقد خضعت لإرادة والدتها، وتقرر عقد قرانها، دون إرداتها، أو معرفتها. بل إن ذهابها إلى محل تجارى لشراء حاجاتها كان مسألة معقدة، ناضلت من أجل تحقيقها (راغب، ص ۸۸ – ۸۹). والقيم التي حكمت العلائق الأسرية، عند كل منهما، تبدو متفاوتة، بين نسب يمكن سكينة، ويمنحها المكانة المرموقة دون أن يقيدها، أو يطلب منها التضحية بحقها، ونسب يجلب لهدى أبهة فارغة مفعمة بالقيود، حتى إنها كانت تغبط الفلاحات لتمكنهن من العمل، ومن الخروج من المنزل، وتغبط من هن دونها مكانة، لكون القيود التي تضيق عليهن، أقل من تلك التي تكبلها. فقد دفعت التقاليد المتبعة والقيم السائدة هدى شعراوى إلى تفضيل أسرتها، على نفسها، فرضخت لزواج غير متكافئ، ولا رغبة لها فيه إكراماً لوالديها، ورجعت إلى زوجها من أجل سعادة أخيها. وبشكل عام، فإن معاناة هدى شعراوي بسبب عدم الاعتراف برغباتها، وبحقوقها كامرأة وكإنسانة، لا يبدو أن سكينة خبرت ما يماثلها.
ولو تذكرنا، أن التقاليد التي عانت هدى شعراوى من جورها، هي تقاليد تدعى أنها مستمدة من الأسس الدينية الإسلامية، ولو وعينا أن حقوق هدى في الزواج والطلاق، وغيرهما، هي حقوق ينبغي أن يصونها الإسلام لها، كما صانها لسكينة، لأدركنا مدى التحوير والتزوير، اللذين لحقا بتقاليد الإسلام وشرائعه، في الزمن الفاصل بين المرأتين.
هذا التباعد بين الواقع، وتعامل كثير من المختصين في الشأن الاجتماعي، الذي نجده لدى مشترعين ومتفقهين، نجد مثيله عند بعض علماء الاجتماع، المطالبين بالحداثة. فكثير من الدارسين للمتغيرات الاجتماعية في العالم العربي، يرون أن العلائق الزوجية السائرة، باتجاه محاكاة الأنماط الغربية، تسير نحو تحول إيجابي، دون أن يستعرضوا أوضاع النساء الحياتية، أو يسائلوهن للتأكد من صحة هذه الفرضية. وفي هذا السياق، يرى الباحثان أدوين تری بروثرو ولطفي دياب (Edwin Terry Prother and Lutfi Diab)، أن وجهة تحول نمط العلائق الأسرية، بين العهد العثماني وعهد الانتداب الفرنسي والإنجليزي، الميممة شطر النموذج الغربي، الذي أصبح في زمن الانتداب، متوافراً للمشاهدة، وبالتالي، للمحاكاة، تبتعد بالعائلة العربية، عن السلطة الأبوية، وعن التزاوج بين الأقرباء، وأحياناً عن تعدد الزوجات (Prothro and Diab 1964، 6 – 7). وترى بث بارون (Beth Baron)، الباحثة في العلائق الزوجية في مصر، ما بين القرنين التاسع عشر والعشرين، أن المتغيرات من تطور اقتصادي ملموس، ومن تحول اجتماعي، ومن إصلاح قانونی، تضافرت – جميعها – لتعيد قولبة العلاقات الزوجية، محولة إياها من علاقات محكومة بالسلطة الأبوية، إلى علاقات متكاملة قائمة على الحب، وعلى حرية الخيار، مما يشكل نواة لتكوين أسر عصرية (Beth Baron، 1991، 285 – 287). وهى – في هذا القول – تسلّم بأن التحول المذكور، وهو تحول نحو النسق الغربي في الحياة الأسرية، هو تحول نحو الأفضل، أى الأكثر سعادة، والأقرب إلى العدالة. كذلك يصر هشام شرابي، وهو المفكر العربي المقيم في أمريكا، على أن التحول من الأسرة الممتدة، إلى الأسرة النووية، هو تحول نحو حرية أكبر، ونحو تعامل ديمقراطي، ومساواة في الحقوق، تحظى بها الزوجة المعاصرة، خاصة في المدن، مما لم يتوافر لها في الماضي، ولا يتوافر لها في الأرياف (Hisham Sharabi، 1988، 30- 32).
والموقف المتطلع نحو “التحديث“، الحامل معنى “التغريب“، شبيه بالموقف السلفي، في إدارته أذناً صماء، ناحية واقع النساء الموصوف في السير المكتوبة، والكامن في أحوالهن المتوافرة للملاحظة. فعلى الرغم من التباين الظاهر في النموذج الذى ينطلق منه، والغاية التي يذهب إليها كل من المنحيين “السلفي” و “المتغرب“، يجتمع المنحيان على تعيين الكتاب المنظرين أنفسهم، مقررين عن المرأة، بغض النظر عما يمكن رصده أو قراءته عن واقع حياتها. فبروثرو ودياب (Protho & Diab) وشرابی (Sharabi) لم يتطرقوا إلى دراسات ترصد الواقع، بشكل علمي دقيق. وبارون (Baron) قارنت بين قرنين من الزمن، فوجدت أن كثيراً من أوضاع النساء، في القرن العشرين، تفضل ما كانت عليه أوضاعهن، في القرن التاسع عشر. إلا أن ما لاحظته، لا يكفي لاعتبار المنحى، الذى نحته الحياة الأسرية في مصر، في هذا القرن، أفضل من كل ما سلف، في القرون التي سبقت التاسع عشر، وهو بالتالي، لا يكفي لاعتبار التحديث أو التغريب، أفضل الحلول المرجوة.
فالداعون إلى تحرير النساء، ينادون بتبنى الحداثة المشتملة على تفضيل النظام الرأسمالي، والنمط الغربي الليبرالي، والوطن – الدولة، والعائلة النووية، وكان التحرير المنشود، لا يتم إلا من خلال هذه الرزمة، التي قد تكون الصدفة لعبت دوراً، في تزامنها في الغرب، مع حصول المرأة، على بعض حقوقها. وهم يغفلون البحث عن إمكان الحصول على حق المرأة، في الحرية والمساواة، عن طرق أخرى غير طريق التحديث، ويغفلون أيضًا – النظر في الاختلاف بين المجتمعات؛ مما قد يؤدى إلى تحرير النساء، عن طريق الحداثة، في مجتمع ما، بينما يبقى التحديث النساء في مجتمع آخر مقيدات، بل قد يزيد القيود التي تسربلهن، أو يمنع عنهن ما يساعدهن إزاء تلك القيود.
فمثلاً، ظهر لى في بحث سابق (٤)، أن التي تعيش نمط الريف أو البداوة، تكون أقدر على اختيار الانفصال عن زوجها، أو على التأقلم مع الوضع المستجد، بزواج زوجها من أخرى، من ابنة المدينة العربية، السائرة على طريق الحداثة، عندما تواجه الوضع نفسه. وقد تبين لي في البحث عينه، أن المرأة العربية ابنة المدينة، وإن تعلّمت واستقلت اقتصادياً، لا يكون لها ما للمرأة الغربية، من استقلالية اجتماعية ونفسية؛ بسبب وقوعها شرعاً، تحت وصاية أقربائها أو أنسبائها من الرجال، ولأسباب اجتماعية أخرى، راسخة في النسق العربي؛ وهي – في الوقت ذاته – تخسر ما كان لها في الريف أو البداوة، من دعم عائلة منشئها، ومن مساندة ذوى القربي، في الملمات (انظر نجلاء حمادة، ۱۹۹۷).
وفي السيرتين اللتين لخصتهما، في القسم السابق من هذا البحث، ما يصب في ما ذهب إليه البحث المذكور، فهدى شعراوي، وهى ابنة المدينة العربية المتأثرة بالحداثة والتغريب، غبطت الفلاحات من بنات بلدها، على تقاليد مجتمعهن (البعيد عن التأثر بالحداثة الغربية)، التي تتيح لهنّ التمتع بحياة منتجة ومنطلقة، خارج جدران المنازل. وسكينة بنت الحسين، التي عاشت في كنف التقاليد العربية، تمكنت من امتلاك القرار، في تسيير حياتها، أكثر مما فعلت هدى شعراوي، التي تطعم مجتمعها المديني بالحضارة الغربية. وقد يعترض قائل، بأن الحداثة هي ما أتاح لهدى شعراوى، مجال الثقافة، وهى ما منحها فرصة الاقتداء بالحركات النسوية الغربية. وفي مواجهة هذا الاعتراض، أقول إن مسألة ارتباط تعليم النساء بالحداثة، خاصة في طبقة هدى شعراوى الاجتماعية، تستدعى تدقيقاً قبل الجزم بها، إلا إذا عنينا بالعلم أو الثقافة، تعلم اللغات الأجنبية. فالثقافة العربية والقرآنية، كانت متداولة في بيوتات ومجتمعات بعيدة عن التغرب والتحديث وعلى سبيل المثال، يمكن مراجعة سيرة زينب فواز، الأديبة القادمة في أواخر القرن الماضى، من جنوب لبنان حيث درست الأدب على فاطمة الأسعد، زوجة الإقطاعي في منطقتها، إلى سوريا، ثم إلى مصر. أما في مجال هذا البحث، وهو وضع النساء في الزواج والطلاق، فإن هدى شعراوى، قاست من حداثة ناقصة، منعتها من حقوق أعطاها الإسلام للنساء، كالزواج بمن ترغب، والطلاق عندما تشقى في زواجها، دون أن تحقق لها الحداثة، ما تحقق للغربيات من استقلالية، ومن دعم قانونی واجتماعي.
ولو قارنا بين حياة اللبنانيات المتأثرات بالحداثة، اللواتي كُتبت سيرهن في كتاب شيرين خير الله (Shereen Khairallah)، وما نجده في ما يرويه المدائني والسخاوي، لوجدنا أنه على الرغم مما حققته النساء المميزات، اللائى تذكرهن خير الله، في حقول العلم والسياسة والصحافة والأدب والتربية، فإن من تكلّم عنهنّ الكاتبان المذكوران، حظين باعتراف أكبر، بحقوقهن في السعادة الزوجية؛ تلك الحقوق التي اقتضت من كثيرات، إعادة كرة الزواج، مرات عديدة، عندما لم يجدن ما ينشدنه، في كنف الزوج الأول.
والمنادون بالحداثة نمطاً أسريًا من أجل المرأة، يركزون على اكتساب النساء في الحداثة، حق اختيار الشريك. وهم في ذلك يتجاهلون ما حصل (هدى شعراوى مثلاً)، وما يزال يحصل في ظل الحداثة عندنا من زواج بالإكراه، ومن استمرار منع النساء، من إنهاء زواج لم يعدن يرغبن فيه، كما يتجاهلون ما تمتعت به كثيرات من نساء الزمن القديم، اللواتي قرأنا عنهن، من تقرير مصائرهن في الزواج والطلاق. وقد ذكرت أعلاه أمثلة على هذا. ومن الأمثلة الكثيرة في هذا المجال، ردّ والد الخنساء (تماضر بنت عمرو)، عندما طلبها منه دريد ابن الصمة: “لتماضر في نفسها ما ليس لغيرها، وأنا ذاكرك لها وهي فاعلة“. وقد رفضته الخنساء لكبر سنّه (إميلي نصر الله، ١٩٨٦، ٦٧)، بعد أن أرسلت جاريتها لتراقبه عن كثب!.
ودعاة الحداثة، يعددون ما تعطيه الحداثة المرأة، من علم وقدرة على العمل، خارج المنزل، مغفلين – ليس فقط – ما قد يوازى هذه الأمور، في مجتمعات لم تمسها الحداثة، كتثقيف البنات بدافع ديني، وكعملهن في الأرض، وفي مجالات أخرى (فحتى الملكات، لم يخل منهن التاريخ العربي القديم، وأروى الصليحية، الملكة اليمنية إحداهن)، بل مغفلين – أيضًا – ذكر ما تخسره النساء، مع الحداثة. فهنّ يخسرنّ المساعدة في الواجبات الأسرية، التي يتمتعن بها ضمن الأسرة الممتدة؛ مما يرهقهن من حيث كثرة المسؤوليات واستمراريتها، دون هوادة؛ ويخسرن نسبة كبيرة من صحبة النساء الأخريات، بحيث يزداد اعتمادهن على أزواجهن، من أجل الرفقة والترفيه. ولأن أكثر الأزواج، يفضلون الخروج من المنزل، ورفقة الرجال في المقهى، أو في أمكنة أخرى، فكثيرًا ما يتسبب هذا الاعتماد في مشاكل بين الزوجين؛ إذ إنه يسربل الرجل، ويؤدى إلى شعور المرأة بالوحدة، وبتقصير زوجها في أدائها حقها.
ولا يلزمنا – بالضرورة – اتباع الحداثة والتغريب؛ من أجل الحد من زواج الأقرباء، فالطب يحذرنا من مغبات هذا الزواج (5). وقد قرأنا أن العادات العربية في زمن البداوة، كانت تستحب تزويج أبنائها، من حارة غير حارتهم والحديث النبوي الشريف، يدعو إلى هذا التباعد في نسب الزوجين، بقوله: “اغتربوا لا تضووا” (٦)، (جمهرة اللغة، لابن دريد ص ۹۱۳). وقد قيل الكثير عن فراسة العرب، وعن عنايتهم بأمور النسب، حتى إنهم عرفوا دور الأم في الوراثة (من علائم هذه المعرفة، الفخر بالمخول، إلى جانب المعمم)، في الوقت الذي اعتبر أرسطو، أن مساهمة الأم لا تتعدى توفير المادة في صنع الجنين، وأن الصفات تنحدر كلها من الأب (Aristotle، Generation of Animals، Book I. Chapter 21).
ولم يصبح زواج أبناء العم عند العرب تقليداً شائعاً إلا في زمن الملكية الزراعية، من أجل المحافظة على وحدة الممتلكات. لهذا فإن سبب هذا النوع من الزواج، هو تسلّط القيمة المادية. وإذا صح القول، إن الإفراط في وضع القيمة في حيّز المادة، هو من تأثير المجتمع الاستهلاكي، الذي يصدره إلينا الغرب؛ فإن التغرّب قد يعزّز نمط زواج الأقرباء، بدل القضاء عليه.
أما السلطة الأبوية، فهي قائمة في الحداثة، وفي ما قبلها، لكن النظام الأبوي في القبائل، قد يكون أرحم بالنساء، من النظام الذكوري في المدن. ففي مجتمع العشيرة أو العائلة الممتدة، تحد سلطة كبار السن في العائلة، من سلطة الزوج، ومن قدرته على التحكم في زوجته. وهؤلاء الكبار يقيمون – عادة – سلوك الزوج، وسلوك الزوجة، فيجبرونه على التعامل معها، بقدر من العدل والإنسانية، ولا يبخلون عليها بالمكافأة المعنوية، على التزامها بالتقاليد، وعلى بذلها وتضحيتها، في سبيل المجتمع، الذي تولد فيه، أو الذي تنتقل إليه بالزواج. فالمُتوقع من سلطة الشيوخ، هو تحقيق عدالة ما، قائمة على تقييم الأفراد، بحسب عطائهم للمجموعة، وبحسب سلوكهم الخلقي. أما ضمن العائلة النووية في المدينة، فالمرأة – غالباً – ما تكون تحت رحمة حاكم مطلق، هو زوجها، مهما كانت صفاته العقلية أو الخلقية. وهذا الحاكم، كثيراً ما يكافئ زوجته، أو يعاقبها، على أمور لا فضل لها فيها، ولا حيلة لها حيالها، كالجمال والشباب، فيكون بذلك جائراً عليها، أو على نفسه، ويكون حكمه أكثر بعداً، عن تعزيز القيم الخلقية، في المجتمع، عما تكون عليه الحال، في ظل حكم مشايخ العشيرة وكبارها.
ولعل التقييم الموضوعي، يجد في كل من الأصالة والحداثة، حسنات وسيئات. وما ألفت إليه – هنا – من نواقص في الحداثة، ومن إيجابيات، تحلت بها المجتمعات العربية الريفية، أو البدوية المحتفظة بأصالتها – يرمى إلى إبراز تحيّز المنحى المتغرب، المذكور في هذه الفقرة من البحث، وقصور هذا المنحى عن الإحاطة بالجوانب المتعددة للموضوع، والمتوافرة لمن يرصد الأمور، كما هي في الواقع المعيش، أو لمن يعمل الفكر في الموضوع، دون انحياز، ودون موقف مسبق.
لو حاولنا تعليل أسباب ما تشير إليه، أو تكشفه هذه الدراسة، من تقصير المشترعين والمنظرين، في الرجوع الصادق، إلى الوقائع التاريخية المدونة، المتناولة لحيوات النساء، ومن عزوفهم عن تقصى الواقع، الذي تعيشه المرأة، وعن أخذ رأيها، في أمور تقرر مصيرها، لوجدنا أن بين هذه الأسباب، ما هو عام في التنظير لموضوع المرأة، وأن بينها ما قد يكون خاصاً بالمجتمعات التي تألف الاستبداد، ولا تأنس إلى التعامل الديمقراطي. وقد نجد – أيضًا – بين هذه الأسباب، ما يرجع إلى الخوف من خطر داهم، أو يعود إلى غياب الجرأة والثقة بالنفس.
في الغرب، كما في الشرق، أمثلة على ما أشرنا إليه، في بداية البحث من خلفية مغرضة، ترافق التنظير عن النساء، فتزور الواقع. هذه الخلفية تشبه الخلفيات، التي جعلت الأمريكي الأبيض، يدعى في القرن الماضي، أن من تكون بشرتهم سوداء، لا يقدرون على تعلّم القراءة والكتابة، وتشبه غرضية العرق الحاكم في جنوب أفريقيا، في وضع منهاج دراسي، يضع سلماً للقيم ينص على تقييم الإنسان الأسود، حسب تفانيه في خدمة الأبيض، وطاعته.
وقد استمر تدريس هذه القيم، إلى الماضي القريب.
وفي موضوع النساء، كان ولا يزال الكثير من المنظرين والمشترعين (انظر مثلاً مرتضى مطهری ۱۹۹۱ – ۲۷۳، ومحمد مهدى الأصفي ۱۹6۸، ۲۱۸ – ۲۲۰) يدعون أن الرجل يتميز باتباع العقل، والمرأة يغلب عندها اتِّباع العاطفة. كأن النساء هن في الغالب من يقوضن دعائم الأسرة في سبيل نزوة طارئة، وهن من لا يثنيهن مشيب أو مسؤولية عن الانطلاق وراء الأهواء، من ميسر، أو جنس، أو رغبة داهمة في السفر، واكتشاف أمكنة جديدة. ولعل التفاوت في هذه الأمور، ليس في طبيعة الرجال، أو في طبيعة النساء. فقد يطلق الإنسان العنان لأهوائه، إذا اطمأنّ إلى أنه مصنّف في صفوف العقلاء، كما أنه قد يكبح الميل، ويسعى إلى التعقل، إذا عرف أن ما يطاله من القول، يضعه في مصاف الأكثر عاطفية، والأقل تعقلاً. وإذا صح هذا، يكون نهج المجتمع الذكوري، في ما يطال المرأة من نظريات سياسة، ذكيًا وفاعلاً؛ من أجل تحقيق استكانتهن، وإبعادهن من سلوك سبيل الهوى. إلا أن التبرير السياسي، لا يبيض صفحة من يسلكون في علوم الشرع والاجتماع، مسلك تمويه الحقيقة أو تشويهها.
ومن ناحية أخرى، نرى في هذا البحث، أن فريقاً من الأصوليين، وآخر من المتغربين المبهورين بالحداثة، يختلفون في أمور كثيرة، لكنهم يتفقون على إطلاق النظريات والآراء، في الموضوعات المتعلقة بالنساء، وفقاً لمقتضيات السياسة، أو حسب آراء مسبقة تتفق مع أهوائهم. فكأن ما تفتقر إليه مجتمعاتنا من الديمقراطية، يتخطى السياسة، شاملاً التشريع وعلم الاجتماع؛ لينعكس تباعداً بين الواقع المعيش، والآراء “النخبوية“؛ أو كان الرجل المشرقي، والباحث الغربي أو المتغرب، وكلاهما يأنس إلى ما اعتاده من التحكم والسيطرة، يستنكفان النظر، إلا من علٍ إلى أحوال “الرعية“، ولا يصغيان، إلى وصف واقع حياتها وأوضاعها، خاصة عندما يكون صوت “الرعية” أنثوى النبرة، خافت الجرس؛ بحيث يتطلب الاستماع إليه، إصاخة، وعناية، وحساً إنسانياً مرهفاً.
وبعيداً عن الأسباب السياسية، أو السلطوية، أو المصلحية في هذا التقصير، أو التغاضي، يبدو أن لكل من الفريقين المذكورين، خوفاً من الآخر، يجعله مسيراً بالرغبة في إضعاف موقف “عدوة“، أكثر مما هو مدفوع إلى دراسة الواقع؛ من أجل الإصلاح. فالأصولي يخشى المد المتسارع والكاسح الآتى من الغرب، والمعجب بالتقدّم الغربي، يخاف من ركود أو تقهقر عن الركب؛ يسببه التمسك بالأصول القديمة.
ودعاة التقليد أو العودة إلى “الأصول“، في مجتمعنا ينطبق عليهم، إلى حد بعيد، ما يقوله بول كونرتون (Paul Connerton) في كتابه “كيف تتذكر المجتمعات” (How Societies Remember). فالتذكر عندهم انتقائي، يركز على الشكليات ويؤدى إلى رجوع فاقد الحيوية، ومفتقر إلى التعددية، التي ميزت المجتمعات الحية التي يريدون بعثها (انظر: Connerton، 1994، 4). وكثيراً ما تنطبق على هؤلاء المتذكرين مقولة إريك هوبسبوم (Eric Hobbsbaum) في كتابه “اختراع التقاليد” (The Invention of Tradition)؛ إذ يرى أن التقاليد، التي لا ترمى إلى غاية عملية (كمعظم الشكليات، التي يتمسك بها كثير من الأصوليين)، كثيراً ما تنبع من محاولة الوقوف، في وجه تسارع وتيرة التغيير، إما بواسطة العودة إلى تقليد قديم من بين تقاليد عدة، كان يعد في الماضى النمط الوحيد، أو النمط الوحيد المقبول، وإما باختراع تقليد، وإضفاء صفة القدم عليه (Hobbsbaum، 1983، 3- 7). وقد يكون الدافع الرئيسي لهؤلاء، نابعاً من الخوف المشروع، من ضياع الهوية القومية، وفقدان ما يميز أبناء القوم، عن سواهم من الأقوام. وهذه الغاية، إلى جانب ما ذُكر عن الغايات السلطوية الذكورية في التنظير عن النساء، وبالإضافة إلى ما يصفه تحليل كونرتون وهوبسبوم من انتقائية التقليد، أو اختراعه من أجل الوقوف في وجه التغيير، تعلل الجنوح إلى “أصول” بعينها، أو إلى “أصول” تبالغ في التطرف في تقييد النساء، من جهة وفي مخالفة النمط الغربي، من جهة أخرى.
أما المنظرون المتغربون، فقد يصح فيهم ما يقوله ميشال فوكو (Michel Foucault) حول الأحداث الفكرية التي تولّد مسالك، تُعتبر في عصر ما، مستحبة أو ذات قيمة، لا لقيمة في ذاتها، ولكن لكونها منسجمة مع حدث (event) يحكم العصر (Foucault 1970). فالمنظرون المتغربون قد تحدوهم الرغبة في اللحاق بركب السلطة وهو – في هذا الزمن – الركب الغربي. وقد يكونون مدفوعين بالغيرة على شعبهم، وبالخوف عليه من البقاء في التخلف. فكون أمتهم الآن في موقع غير متقدم، يجعلهم يرغبون في “اللحاق” بالسباقين. وقد يشنجهم الخوف الداهم، فيخلطون بين السياسة والخير، أو بين المصلحة والقيمة المطلقة، فيرون في مرحلة التفوق السياسي، والمادى الغربي تفوقاً في المطلق، فيتماهون بها. وقد يصح في هؤلاء، ما يقوله إدوارد سعيد، في الثقافة الاستشراقية، التي تنظر لما ينسجم مع استعمار الغير للشرق، وتؤثر نظرياتها في مثقفين مشرقيى الأصل والهوية (والهوى أيضاً)، لكنهم مطبوعون بنتاج الحضارة الغربية، بما في ذلك النتاج الاستشراقی (انظر: Edward Said، 1995- first published 1978، 22).
وما وصفناه من إعاقة وتشويه للنظريات في العلوم الاجتماعية، التي قد تكون أساس صلاح المجتمع وعدالته، وقد تكون علة ظلمه وظلمته، قد يعتبر برهاناً ملموساً على ما يقوله نيتشه، من استحالة الخلق مع الخوف، وما يتحدث عنه من ضرورة الجرأة والبراءة والشغف المتفاني من أجل تطوير الإنسان، ومن أجل أي عمل خلاق (Friedrich Nietzsche، Beyond Good and Evil، First Translated into English 1973، Paragraph 264). فلو وافقنا نيتشه، لأدركنا أن المطلوب من أجل علوم اجتماعية، تنبثق من الواقع، وتقدر على تطويره، هو جرأة وصدق في البحث والاستنباط.
وفي العلوم الاجتماعية، خاصة ما عنى فيها بموضوع النساء، على المرأة أن تسهم مفصحة عن واقعها بنفسها، ومدلية بدلوها في وضع المعادلات والنظريات. فهي أدرى بحالها؛ وقد يحد ابتعادها عن السلطة، وارتباطها بالعلاقات الشخصية والإنسانية، من رغبتها في تمويه الحقائق، أو تشويهها، على الأقل في هذه المرحلة، التي لا تزال لا تضطلع فيها بالسلطة. وينبغى ألا ننسى في مجال النظر في ما يعوق الباحثين، أن هيمنة الأنظمة الاستبدادية على المجتمع، وهي المعزّزة الخوف، والقامعة للجرأة والصدق والبراءة، تعوق الجنسين، في استقرائهما الماضي أو في التعبير عنه. يقول بول كونرتون: “يبدأ استعباد الرعايا في الأنظمة الاستبدادية؛ عندما تؤخذ منهم ذاكرتهم. وعندما تريد سلطة كبيرة، أن تحرم بلداً صغيراً، من وعيه القومي، تستخدم لبلوغ غايتها، أسلوب النسيان المنظم” (Connerton، p. 14 تعريب الكاتبة).
وغياب الاستبداد من شأنه أن يحد من سلطة المتسلطين على الشريعة الإسلامية، والقامعين رأى الآخرين ولتعبيرهم عن تجاربهم. والنساء يقعن في طليعة هؤلاء المقموعين. والوقوع في قبضة أنظمة استبدادية، يضعف النفوس ويقلّل الثقة بالنفس، مما يهيئ المفكرين والمحللين، أو المشترعين للخضوع لوجهات النظر الغربية، التي تملك السلطة المعنوية والعسكرية، كما المادية، ويقال إنها تملك السطوة السياسية أيضاً. فلو أُتيح للناس، رجالاً ونساء، التداول في موضوعات الشريعة، وحقيقة أصولها، وأوضاع الواقعين تحت سلطتها، ولو اتخذنا حيال التغريب موقفاً، فيه من الإباء والموضوعية، ما نجده في الموقف الذي يعبر عنه جلال أمين (7)، لما تعاملنا مع التراث، ولا أخذنا عن الغرب، إلا ضمن ما يصفه أمين، بالاعتبار الجمالي، الذي “مداره أن من أهم عناصر الجمال، الاتساق والانسجام، بين مكونات العمل. والتلقائية، وعدم الاصطناع والتكلّف” (جلال أمين، ۱۹۹۷، ١٦۰). وهذه العناصر تلزمها الجرأة والبراءة، والبعد عن الخوف، وعن تسييس الوقائع والنظريات.
– ابن دريد، كتاب جمهرة اللغة. تحقيق رمزى بعلبكی: بیروت، ۱۹۸۷.
– أبو الحسن على بن محمد االمصادر العربيةلمدائني. المردفات من قريش. في الجزء الثاني من نوادر المخطوطات، تحقيق عبد السلام هارون، بيروت: دار الجيل، ۱۹۹۱
– إميلي نصر الله، نساء رائدات من الشرق ومن الغرب. الجزء الأول، بيروت: مؤسسة نوفل، ١٩٨٦.
– توفيق الفكيكي. سكينة بنت الحسين، (حديث الشهر) النجف: مطبعة الزهراء، جمادى الثانية ١٣٦٩ هـ (مارس) آذار المصادر١٩٥٠م.
– جلال أمين. شخصيات لها تاريخ. لندن – بيروت: رياض الريس للكتب والنشر، ۱۹۹۷.
– الدكتور على عبد الواحد وافي. بيت الطاعة وتعدد الزوجات والطلاق في الإسلام. سلسلة مع الإسلام، رقم 7، مؤسسة المطبوعات الحديثة، ١٩٩٦.
– د. نبيل راغب، هدى شعراوى وعصر التنوير، (تاريخ المصريين ۱۲ ورئيس التحرير عبد العظيم رمضان). القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ۱۹۸۸.
– نجلاء حمادة. القيم والهوية الذاتية للبدوية وابنة المدينة. دراسة مقارنة للمتغيرات في العائلة العربية المعاصرة، (باللغتين العربية والإنجليزية). سلسلة المرأة والتنمية رقم ٢٤. صادرة عن بعثة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا ESCWA، ۱۹۹۷.
– محمد مهدى الأصفي. العلاقات الجنسية في القرآن الكريم. النجف: مطبعة النعمان، ١٩٦٨.
– محمد بن عبد الرحمن السخاوي. الضوء اللامع في أهل القرن التاسع، الجزء الثاني عشر. وضع سنة ١٤٩٧.
– المحامية مني ذو الفقار. المرأة المصرية في عالم متغيّر، (دراسة تحليلية)، رقم ٦، رسائل النداء الجديد. القاهرة: مطبعة وهبة، ١٩٩٦.
– مرتضی مطهري. نظام حقوق المرأة في الإسلام. تعريب حيدر الحيدر. الطبعة الثانية. بيروت: الدار الإسلامية، ١٩٩١.
– Alanen, Y.O. “The Mothers of Schizophrenic Patients”. Acta Psychatric Scand, V. 33
(supplement 124), 1958.
– Aristotle. Generation of Animal. Books -II. Trans. D.M. Balme. (Clarendon Aristotle
Series, 1972) Oxford: Oxford Classical Texts, 1965.
-Baron, Beth. Women in Middle Eastem History. Ed Nikki Keddie and Beth Baron. New
Haven: Yale University Press, 1991.
– Connerton, Paul. How Societies Remember: Series of Themes in Social Science. Eds.
John Dunn, Jack Goody and Eugene A. Hammel. Cambridge University Press 1994. (first
published, 1989).
– Foucault, Michel. Truth and Power. A television interview conducted by Alexandra
Fontana and Pasquale Pasquino, 1970.
– Hobbsbaum, Eric. “Inventing Tradition”. Introduction to The Invention of Tradition. Eds
Eric Hobsbawm and Terrence Ranger. Cambridge Universtiy Press, 1983.
– Nietzsche, Friedrich. Beyond Good and Evil, Penguin Books. Trans., com. & int. R J.
Hollingdale. (this translation first published 1973).
– Prothro, Edwin Terry and Najib Lutfi Diab. Changing Family Patterms in the Anab East.
Beirut: American University of Beirut, I974.
– Said, Edward. Orientalism: Western Conceptions of the Orient. Penguin Books, 1995
(first published by Routledge & Kegan Paul, 1978).
– Saidi, Aliya Ramzi. “Marriage Patterns of Urban Muslim Women in NnthFiflenth
Century”. (Diss. American University of Beirut, December 196.
– Shaarawi, Huda. Harem Years: The Memoirs of an Egyrin Feminist Trans and int.
Margo Badran. London: Virago Press, 1986.
Thucydides, The History of the Pelopponesian Wars, Penguin Classics. Trans. Rex
Warner and M.L. Finley. Advisory Editor Bctty Radice.
– Ver Eecke, Wilfricd. “Phenomenology and Paternal Metaphor”. Phenomenology and
Psychoanalysis “The Sixth Annual Symposium of the Simon Silverman Phenomenology
Center”. 1988.
* – نجلاء حمادة: أستاذة بقسم الدراسات الحضارية، الجامعة الأمريكية في بيروت.
1 – حدثت لدينا منذ أيام، حادثة تظهر الانفصام بين وضع عصري، يحمل النساء أكبر المسؤوليات، وموقف يدعى سلفية دينية، تتظاهر بأن الإسلام ينظر إلى المرأة، نظرته إلى قاصر أو إلى ناقصة عقل. فقد أيقظنا بواب العمارة، راجياً من ابنتى الطبيبة، أن تسعف ابنه الصغير، الذي بدا بين الموت والحياة. وبعد أيام، من تماثل الصبي للشفاء، طلبت الطبيبة من البواب، أن يشرح لها ما ينبغي عمله، عندما تنقطع الكهرباء، ويكون شخص ما، عالقًا في المصعد. فما كان من البواب، إلا أن أجابها: “هذا العمل يتطلب تركيزاً، لا تقدر عليه امرأة. سأشرحه لأخيك، فهو القادر على استيعابه“!.
2 – إلى جانب ما يظهر – بوضوح – من ابتداع “بيت الطاعة“، الذى لا تعرفه المجتمعات العربية المسلمة القديمة، ولا المجتمعات المحتفظة حتى الآن بتقاليدها العربية، فإن المشترعين والقضاة أنفسهم، الذين يحكمون في أخذ النساء إلى “بيت الطاعة“، يشعرون بخطأ ولا إنسانية ما يفعلون، من ذلك ما يقوله أحمد أمين: “ظللت أحكم بالطاعة، وأنا لا أستسيغها ولا أتصورها. كيف تؤخذ المرأة من بيتها بالبوليس، وتوضع في بيت زوجها، بالبوليس كذلك؟. وكيف تكون هذه حياة زوجية؟. إنى أفهم قوة البوليس، في تنفيذ الأمور المادية، كرد قطعة أرض إلى صاحبها، ووضع محكوم عليه في السجن… أما تنفيذ المعيشة الزوجية بالبوليس، فلم أفهمه مطلقاً، إلا إذا فهمت حباً بالإكراه، أو مودة بالسيف. ولهذا كنت أصدر هذه الأحكام بالتقاليد، لا بالضمير… وكنت أشعر شعور من يمضغ الحصى، أو يتجرع الدواء المر. (منقول عن جلال أمين، ١٩٩٧، ٨٤).
3 – هذا الإحصاء مأخوذ من رسالة ماجستير لعلياء الصعیدی
(“Aliya Saidi، Marriage Patterns of Urban Muslim Women in the Ninth/ Fifth Century”، الجامعة الأمريكية في بيروت، ١٩٩٦).
وقد كنت بين الأساتذة المشرفين على الرسالة.
4 – قمت في الفترة الواقعة بين صيفي ۱۹۹۲ – ۱۹۹۳، بدراسة حقلية تناولت علائق كل من، خمس وثمانين امرأة، بضرائرهن (من تشارك – أو تشاركن – كلا منهن في زوجها). وقد نُشر بعض ما توافر عن هذه الدراسة، سنة ۱۹۹۷، والبعض الآخر في طريقه إلى النشر، في الولايات المتحدة ضمن مجلد تعده سعاد جوزف، عنوانه “Intimate Selving Self: Gender and Identity in Arab Families”. وأقوم الآن بتكليف من “نور – دار المرأة العربية” بدراسة استقصاء من أجل وضع كتاب، يضم سير نساء من لبنان وسوريا، تتنوع مسارات حياتهن، وتتعدد البيئات والطبقات الاجتماعية التي ينتمين إليهما.
5 – من دواعي العجب، تقاعس القسم الطبي عن توعية الناس، حول مغبة تكرار زواج الأقرباء، على الرغم مما تشهده مجتمعاتنا من أمراض، تتوارثها العائلات التي تتزوج فيما بينها، وعلى الرغم مما لا يمكن لذي نظر أن لا يراه. من تفوق ذرية زواج التباعد، في الغالبية العظمى من الحالات، في الصحة والذكاء.
٦ – حديث نبوي شريف، ورد في كتاب جمهرة اللغة، لابن درید. تحقیق: رمزي بعلبكي، بیروت ۱۹۸۷.
7 – إنني أتفق مع جلال أمين، حول رأيه في التغريب عندما يقول: “إن احترام الأمة لتراثها، هو احترام لنفسها، والعبث بالتراث، هو تحقير للذات، واستخفاف بها. والتغريب فيه شيء كثير من هذا العبث“. (جلال أمين، ۱۹۹۷، ١٦0).