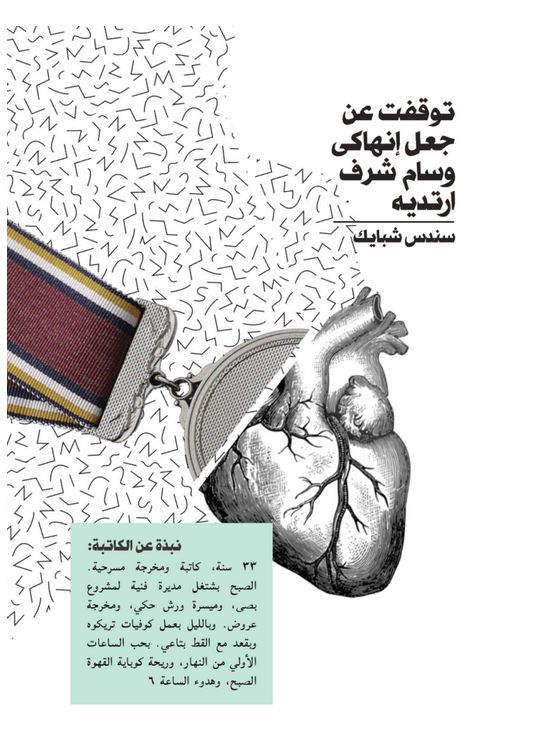نبذة عن الكاتبة:
٣٣ سنة, كاتبة ومخرجة مسرحية. الصبح بشتغل مديرة فنية لمشروع بصى، وميسرة ورش حكي, ومخرجة عروض. وبالليل بعمل كوفيات تريكوه وبقعد مع القط بتاعي. بحب الساعات الأولي من النهار، وريحة كوباية القهوة الصبح، وهدوء الساعة ٦
البدايات وخلق القصص
صداع نصفي…
“بدخل الحمام عشان أغسل سناني وأنام بلاقي معجون السنان خلص بقعد علي طرف البانيو أعيط“
(ليلة في مارس ٢٠١٦)
في 2006، شاهدت بالصدفة البحتة أول عرضٍ لمشروع بصى. كان العرض عبارة عن مجموعة من القصص والتجارب الحقيقية لسيدات، لكنها كانت تجارب خاصة جدًا؛ تجارب عن موضوعات كانت, وما تزال, مسكوتًا عنها. في بداية العرض صُدمت صدمة “أنثى” ولدت في مجتمع كمجتمعنا، ظنت لسنوات أن ما مرت به لم يمر به أحد غيرها. وفجأة, في ساعة واحدة, شاهدت أغلب ما كنت أظنه تجاربي, ومشاكلي, وجروحي أنا الخاصة، لكنها تُحكى على لسان أكثر من ٢٠ فتاة لا أعرفهن.
خرجت من العرض بخليط غريب من المشاعر, وليلتها كتبت لأول مرةٍ في حياتي تفاصيل أول تجربة إساءة جنسية تعرضت لها وأنا طفلة. كتبت القصة كاملة بكل تفاصيلها، تفاصيل حاولت طوال سنواتٍ تناسيها أو إنكارها.
بعد ذلك، فكرت أن أكتب عن العرض في إحدى المجلات الشبابية، لذا أجريت مقابلة سريعة مع واحدة من مؤسسات المشروع, وهي ناز خان, وانتهت المقابلة بحضنٍ وبكاء.
تجربتي مع الحكي الشخصي
في ۲۰۰۷، وقفت على المسرح لأشارك قصتي على المسرح. اخترت عدم ذكر اسمي كصاحبة القصة, قصتي التي كانت وما زالت أكثر قصة مؤلمة شاركتها في بصى، لكن أكثر قصة مشاركتها غيرت حياتي.
كانت المرة الأولى التي أفهم فيها تأثير البوح بمشاركة قصة كتمتها داخلي لسنوات. كتابتها كانت مؤلمة جدًا، لكنني شعرت بعد الانتهاء منها بإحساس غريب من الارتياح، شعرت بالإفراج أو كأنما حررت جزءًا ما داخلي.
وفي لحظة ما أثناء ثاني ليلة للعرض, أحسست بشيء غريب في صدري، كأنما ثقل ارتفع عنه فجأة. ثقل كان مرتبطاً بإحساسي بالخزي والعار والخجل من جسمي, ورغبتي الدائمة في تغطيته، كرهي غير المفهوم لجسمي, وكرهي للرجال.
استمرت مشاركتي في عروض بصى، كل سنة أشارك تجربة مؤلمة أخرى كنت أنتظر فرصةً لأحكيها, وللبحث عن طريقة للتصالح معها؛ فرصة لتحرير جزءٍ آخر بداخلي. كل سنة أنتظر لحظة معينة على المسرح أرى أثناءها في عيني شخص آخر بين الجمهور ما معناه: “وأنا كمان“.
في ۲۰۰۸، كتبت قصصي وقصص فتيات وسيدات أخريات، وساعدت على إخراج العرض.
وفي صباح يوم ما في ۲۰۱۱ ، وبدون أي خطة, قررت ترك عملي كصحفية والتخلي عن حلم أكثر من ١٠ سنوات. فقدت الأمل في الميدان, والتغيير، والحلم بحياة مختلفة. وفقدت الأمل في المصداقية وقوة الصحافة عمومًا . كل ما تبقى معي هو أمل واحد فقط؛ أمل في الحكايات وقدرتها على إنقاذي أنا شخصيًا قبل دعم أي شخص آخر.
ولذلك عند سؤالي عن سبب استمراري في العمل ببصى، أقول أنه اختيار لأسباب أنانية جدًا. عملي في بصى أصبح هو آليتي الخاصة للتعامل مع واقع مرارته تزداد سوءًا مع كل دقيقة. أحكي وأكتب الحكايات للتكيف والتعامل مع ألمي الشخصي قبل آلام الآخرين، لأن تجارب الآخرين في الحكي أيضًا تمكنني وتمدني بالقوة والصبر. هناك أسباب أخرى، لكنني أفضل دائمًا مشاركة سببي الشخصي. ليس المجد أو البطولة في التجربة, ولا رغبة في إثبات شجاعتي للآخرين.
أستيقظ كل صباح لإدارة مشروع يوثق شهادات، وييسر ورش حكي وعروض مسرحية من أجل النساء والرجال, لمشاركة تجاربهم/ ن الشخصية في المجتمع, تجارب يشاركوها/ نها لأول مرة؛ تجارب مؤلمة وشجاعة.
في بداية بصى كنا نجمع نحو ٣٠ قصة لعرضٍ مسرحي واحد فقط كل سنة، ومع مرور السنوات, تطور المشروع واتسع نطاق عمله ليتجاوز العمل مع مجموعات شبابية فقط، وأصبح يتضمن مجموعات مختلفة؛ سيدات عاملات في منازل، وسيدات مررن بتجربة السجن، وأخريات معرضات للإتجار الجنسي. أصبحنا ننظم ورش وعروض مختلفة على مدار العام في القاهرة وغيرها من المحافظات.
طورنا ورش الحكي وأصبحت مصممة لخلق مساحاتٍ آمنة لكي تشارك المجموعات المختلفة تجاربها، ويتدرب أفرادها على حكى قصصهم على المسرح. واتسع نطاق القصص نفسه وأصبح يشمل موضوعات وقضايا اجتماعية أخرى بجانب التحرش والاعتداء داخل المنزل وخارجه، مثل الزواج المبكر، والاغتصاب، والختان، وغيرها.
اخترت عملي بالرغم من أنه يتضمن كتابة تلك الشهادات وتحريرها, والمرور على سطور تضم تجارب مؤلمة أكثر من ۱۰ مرات، إضافةً إلى الإجهاد النفسي والعاطفي الناتج عن تيسير مساحاتٍ آمنة للحكي, ومساندة المشاركات أثناء حكيهن وبعده.
اخترت عملي وآمنت به مع أنني أتساءل طوال الوقت إذا كان بمقدرتي، أو بمقدرة أي شخص, العمل بصفة مستمرة في مجالٍ كهذا. فمع مرور الوقت والتجارب العملية، اكتشفت مدى بشاعة وضع الفتيات والسيدات في بلدنا وكيف يحتجن للدعم، وأدركت عدد القضايا وحجمها التي بحاجة لمواجهة أكبر من قدرة وحجم كل الجهود الحالية.
بعد كل مرحلة كنت أظن فيها أنني كما يُقال “قابلت الوحش“. تأتي ورشة أخرى، مجموعة أخرى، سيدة أخرى، لتسرد حكايةً أخرى، في عرضٍ آخر.
تساؤلات عن علاقتي بالعمل
“شعور مستمر بالغثيان وألم غير معتاد في مناطق غريبة من الجسم… “مالك ؟” “مفيش … الحكاية … صوتها لسة في ودني, والصور مش بتفارق دماغي” “اخرجي من الحكاية” “بحاول …” “
(من صباح ثاني يوم بعد عرض لشهادات عن الاعتداء الجنسي والاغتصاب)
مع الوقت، أصبحت أحلامي وطموحاتي أكثر تواضعًا. صار كل طموحي أن تنجح ريهام في إقناع زوجها “اللي بيضربها” أن تأتي للورشة. لأن حضورها حسب وصفها “بيقويها ويصبرها“، و“بيحسسها إنها مش لوحدها“، وأنها “تقدر“.
دائمًا أسأل نفسي كل صباح “هتختاري شغلك ده النهاردا؟“، وإلى الآن ما زالت الإجابة “نعم“، حتى بعد سماع قصص مرعبة عن تأثير الإرهاق النفسي في الكثيرين.
“فلانة فجأة لمت هدومها وهجت“
“فلانة نصف جسمها اتعرض للشلل“.
من سنتين تقريبًا حضرت جلسة psychoeducation (التثقيف النفسي الاجتماعي) وفهمت لأول مرة مصطلح empathy fatigue (تعب التعاطف/ الإرهاق الناتج عن ممارسة إحساس التواجد مع أشخاص آخرين)، ومصطلح secondary trauma (الصدمة الثانوية), التي قد تحدث عند تقديم الدعم لشخصٍ يعاني الصدمة.
مع مرور الوقت وزيادة الخبرة، فهمت أن الغثيان ليس مجرد empathy fatigue ,لكنه مرتبط بأن القصة ضغطت عليّ بشكل شخصي. مصطلح آخر فهمته trigger (إثارة), والمقصود منه هو أن تثير قصة أو كلمة أو موقف ما إحساسًا ما عندي أنا بشكل خاص نتيجة تجربة/ تجارب في حياتي يُحتمل ألا أكون تعاملت معها بشكل صحي، أو حتى تعاملت معها بشكل صحي, لكن ما يزال ذكرها يسبب ألمًا أو أعراضًا معينة متعبة.
وجدتني أمام قرار آخر وجب علي أخذه؛ قرار خوض رحلة علاج نفسي للتعرف على ذاتي واكتساب وعي أعمق بها وبمشاكلي, واكتشاف أشكال التعامل غير الصحي مع الواقع اليومي, للتعرف والتعامل مع صراعاتي الخاصة التي قد تثيرها الحكايات أو التعاملات داخل سياق الورشة وخارجه.
كان, وما زال, قرار الالتزام بجلسات مع معالج نفسي صعب جدًا. ليس فقط بحكم طبيعة مجتمعنا وثقافتنا التي ما تزال تتفه وتقلل من الإرهاق والمرض النفسي، لكن لأن الاعتناء بالنفس كمفهوم ما زال يُعتبر “غريبًا” عنا، بل ومرفوضًا, رفضًا ضمنيًا حاسمًا في الأفكار والثقافة التي عُززت داخلنا, سيداتٍ وفتيات؛ مثل ثقافة “التضحية“. و“الإيثار“. دائمًا ما يمارس المجتمع والأهل والمحيطون تعظيمًا وتشجيعًا وتهليلاً للأم أو الزوجة أو الفتاة التي تضع احتياجاتها جانبًا أو تتناساها تمامًا في سبيل الآخرين، وفي سبيل جعل احتياجاتهم الأولوية الأولى عندها .
“دي ضحت بعمرها عشانكم“
وحين أقرر ألا أتبني الفكر نفسه، أصبح حينها أمًا أو زوجة أو ابنة غير صالحة، وأنانية, وغير بارةٍ بأهلي. أعتقد أن تلك الثقافة ربما تكون أحد الأسباب وراء ردات الفعل تجاه أفعال هدفها الاعتناء بالنفس وتلبية الاحتياج الشخصي قبل احتياجات الآخرين. أشعر بالذنب كل مرة أدفع فيها تكاليف جلسة علاج نفسي، أو كتاب عن الاعتناء بالنفس، أو خلافه. أشعر بنظرات التأنيب في عيون أقاربي وفي صوت أمي إذا قررتُ عدم الذهاب للقائهم يوم الإجازة.
“ليه مش هتيجي ؟“
“مرهقة ومحتاجة أقعد لوحدي“
“مرهقة من إيه؟ وبعدين هو حد بيقولك تعالي اشتغلي؟! تعالي اقعدي معانا على الكنبة … نفسي أقعد معاكي، وأختك ما شفتیهاش من شهر“
ولذلك أحيانًا ما يكون قرار الالتزام بالاعتناء بالنفس صراعًا، وليس مجرد قرار؛ صراعًا مع من حولي ومع نفسي بشكل أساسي؛ صراع مع صورتي أمام نفسي … هل عندي الاستقلال الكافي والقوة الكافية للتخلي عن كثير من الأفكار والمعتقدات المرتبطة بالمرأة؟ هل أنا بالشجاعة الكافية لعدم الاكتراث بآراء الآخرين؟ هل أنا قادرة على التمسك بقناعتي الشخصية بأن الاعتناء بنفسي في سبيل مواصلة عملي، ليس فعلاً أنانيًا؟
فشلت لسنوات في كسب تلك المعركة. كنت أضع خطط عمل مرهقة جدًا دون وضع المساحات الزمنية الضرورية للراحة في الحسبان. دائمًا ما أقلل من حجم ضغط العمل وإجهاده، وبالتالي نادرًا ما أسمح لنفسي بأخذ إجازات. وبالرغم من رفضي للأفكار التي ذكرتها أعلى، فإنني دون وعي مني وجدتني أخلق لنفسي نظامًا قمعيًا آخر بديلاً عن النظام الذي وضعه المجتمع.
أصبح العمل لساعات طويلة، وتجاهل احتياجات الجسم من راحة ونوم يدعوان للفخر، بل تمادى الموقف حتى صرت أؤمن بأنَّه لا مفر من إتمام العمل إلا إذا ضحيت بنفسي.
مؤخرًا بعد مواجهتي الشخصية لتلك الحقيقة المؤلمة، بدأت أقرأ عن تجارب أخرى مماثلة لمواساة نفسي.
رفيقات العمل
لم أكن علي دراية أو وعي بمفهوم الاحتراق الوظيفي/ الإجهاد النفسي (أو أي كان المسمى), أو بحال أغلب المؤسسات والمشروعات التي تعمل على قضايا السيدات. كنت أتصور أنني وحدي أعاني مشكلة قلة الخبرة والمعرفة الكافية التي كنت ما زلت أظن أنها مهمة لممارسة عملي، لكن مع احتكاكي بمؤسسات ومشروعات أخرى، اكتشفت أنها أزمة عامة.
في اجتماع حضرته مؤخرًا لمجموعة كبيرة من العاملات بمشروعات ومؤسسات تدعم المرأة، لاحظت شيئًا لم ألحظه من قبل. جمع بيننا شغفنا وإيماننا بعملنا, والإجهاد النفسي المستمر، وأداؤنا لعملنا أثناء استراحات الاجتماع كلها، والسهر لساعاتٍ متأخرة لإنجاز المهام المؤجلة بسبب حضورنا الاجتماع, وتصورنا بأن ما نفعله سواء كان ( دعمًا نفسيًا – اجتماعيًا – توعويًا … إلخ)، هو جزء من وجودنا, بل سبب وجودنا كله. جمع بيننا تصور أغلبنا بأنه لا يوجد حياة, وأنه لا يوجد سبب للحياة إذا توقفنا عن فعل ما نفعله. لوهلة, يبدو في ظاهر ذلك شيء نبيل وسامٍ، لكن بعد فترة لاحظت بشيء من الألم أبعاد الأفكار المذكورة. إذا كنت أنظر لعملي كجزء من كياني لا يمكن الاستمرار في الحياة بدونه، فمن المنطقي ألا يصبح التوقف عنه – ولو بشكل مؤقت – أو أخذ قسط من الراحة, خيارًا من الأصل. لا عاقل يختار التخلي عن جزء من ذاته. إذا كان عملي هو هويتي, فالراحة ليست مجرد خیار غير محبب, هي خیار غیر متاح أساسًا.
استمعت في أحد الأيام لواحدةٍ تشكو تأثير المجتمع الأبوي القمعي التي تعيش وتعمل فيه، وبعدها في وقت الاستراحة، توقفت للحظات لأشاهد المجتمع الموازي القمعي الذي ربما نكون خلقناه بغير دراية أثناء سعينا لمحاربة مجتمعاتنا. نشكو من القهر، لكننا مع ذلك نجحنا في خلق بيئة عمل غاية في القسوة والحدة، بيئة عمل قاهرة لا تسمح لنا بالراحة ولا الاعتناء بالنفس.
كنت أحيانًا أقول لمنى صديقتي إنني أشعر في أوقات كثيرة بأنني حوَّلت حلمي لوحش يطاردني.
لم أكن أعلم أنني لست وحدي من خلقت صومعة القمع البديلة، أدركت أنني وكثيرات أخريات ضللنا الطريق في رحلتنا للخروج، وبنيناه معًا بغير وعي. لحظتها شعرت بأنه يمكننا وصف مفهوم الاعتناء بالنفس بأنه “نسوي“، ففكرته الأساسية هو ألا نقوم بـ “التضحية” أو تجاهل احتياجاتنا، مفهوم يضعنا, ويضع احتياجاتنا, ومشاعرنا وكل ما يخصنا, في الأولوية، ويطرح فكرًا يقوم على أهمية الاعتناء بذواتنا أولاً قبل الاعتناء بالآخرين.
لكن هناك أشياء أخرى لم أخترها أشياء تجعلني أشعر بالضعف وقلة الحيلة والغضب.
منها الإحساس المؤلم أحيانًا بالوحدة الشديدة. أشخاص قليلة في حياتي عندهم قدرة ورغبة وفضول كافٍ لفهم طبيعة الإجهاد النفسي الذي أتعرض له أنا وغيري في المجال. كيف أشرح لأمي أنني ليس عندي الطاقة الكافية لرؤية أحد؟
كيف أشرح أن ما أعانيه ليس مجرد إرهاق جسدي؟ كيف أشرح أن الأنشطة المتعلقة بالعناية بالنفس، ليست رفاهية ولا “دلع“، لكنها ضرورة وإلا سأستيقظ يومًا ما وأجد نفسي نزيلة في مستشفى العباسية, أو ممسكة بعلبة بنادول وأنا أفكر “يا ترى هروح فين لو بلعتها؟” هذه الافتراضات ليست مجرد افتراضات, لكن كيف أشرح ذلك أيضًا؟
أحيانًا ما تأتينا الوحدة من الاختيار نفسه، أو كوني اخترت سلكًا وظيفيًا غير معتاد ولا مفهوم بالنسبة لأغلب الأهالي والأجيال الأكبر، “يعني إنتي بتشتغلي إيه بالظبط؟” ، “هتكتبي إيه البطاقة ؟“، “ليه بتشتغلي جمعة وسبت؟“. الحقيقة أن ما أفعله ليس مفهومًا لأشخاص آخرين في المجال نفسه “يعني إنتي بتشتغلي إيه ؟ بتطبطبي علي الستات وتقوليلهم معلش؟“.
أغلب لحظات الإنجاز، ولحظات الفشل والانهزام, يشوبها إحساس بالوحدة. ليس هناك سوى عدد محدود من الأشخاص المدركين لما أفعله, هم فقط من يقدروه وتخرج عنهم كلمات مثل “برافو“، أو يواسوني بجمل لطيفة مثل “أزمة وتعدي“.
ومع ذلك، كلها أعراض جانبية لحياة اخترتها, ومع مرور الوقت, ومع إدراكي لهذه الأعراض، أقرر أنها جزء من الاختيار، وعلي قبولها واختيارها.
حتى مع قبولي لها طوال السنين الماضية، تحوَّل أغلب العمل المتعلق بالمجتمع المدني أو الفنون التعبيرية, لنشاطٍ مشبوه. في الحقيقة لم يتحول، كان هكذا منذ البداية، لأن ما كنا نقوله دائمًا عندما نسافر إلى محافظات هو أننا “طلبة جامعة” أو “مدرسين رسم“. لكن حجم القلق والخوف كان معقولاً نسبيًا, أو على الأقل بالنسبة لي.
إلا أنني أدركت مؤخرًا أنني أمام خطر آخر وسط موجة التضييق على المشاريع والمبادرات، فجأة، أصبحت مضطرة للتعامل مع نصائح أصدقائي: “بلاش تروحي الشغل الأسبوع ده“.
“أمال أروح فين؟ النادي؟“
متى أصبح الذهاب لمكان العمل فعلاً يحتاج إلى الشجاعة؟
اتضح لي بمرور الوقت أن المشي في الشارع يحتاج إلى الشجاعة، الذهاب لمشاهدة فيلم مستقل يحتاج إلى الشجاعة, الوجود في أماكن عامة يحتاج إلى الشجاعة.
لم أختر تحويل حياتي إلى معركة, ولم أختر أن أتعايش مع توتر مستمر في خلفية حياتي، ولم أختر, ولا قررت, أن أكون شجاعة، وغيري الكثير .. لم يختر أيٌ منهم أن يكون شجاعًا.