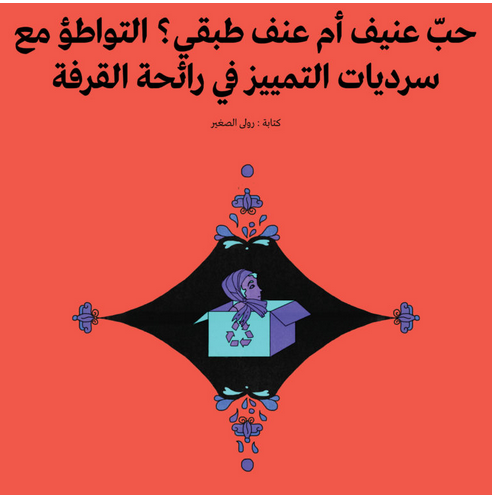رولى تعمل على قضايا العمل والهجرة والجندر. تحلم بدبلجة برامج الأطفال. تكتب أحيانًا وتعيش فى حالة أزمة وجودية دائمة.
قد تكون الكتابة فعل اختزال، لأنها تتمحور حول نمذجة واقع أو رغبات واحتياجات فردية ومجتمعية بواسطة لغوية، أو قد تكون فعل تخيُل وخلق. من خلالها، بإمكاننا تأريخ حيوات وجعل أشخاص ما أبطالاً أسطوريّين.
كما بإمكاننا الانتقام من الأعداء وتحجيمهم وتحويلهم إلى نكرة. بإمكاننا تجريدهم من إنسانيتهم أو إعطائهم ملكة الطيران … الكتابة تقرّر كلّ ذلك في سلطتها التمثيلية. قد تسمح لنا بأن نجد أصداء لأنفسنا في طيات التاريخ، أو أن نتخيلها في المستقبل، أو قد تمحينا تمامًا كأننا لم نوجد قط. سواء كنا نساء كويريات، عاملات جنس، عابرات, عاملات منازل ريفيات ومهاجرات, نساء ملونات, سمراوات أو سوداوات، تم تجاهلنا ومحونا عدا من كتابات نادرة وأخرى لم تر العالمية. إلى أن أتى يوم كانت سياسات التمثيل ملزمة بإضافتنا كالبهارات إلى الطبخة، أو كوسيلة لتحقيق مصير البطل الأساسي في تنافسيته مع شخصياتنا، فالغاية تبرر الوسيلة. وإن ساهمت شخصياتنا العرضية في تطوير البطل، فلا بأس بإضافتنا. ووجدت شخصيات غير نمطية طريقها إلى الفضاء العام المدوّن غالبًا بلغات بلاد الشمال.
لكننا لا نرضى بهذا القليل، ونبحث كنساء ملونات وجنوبيات وفقيرات وكويريات وعابرات ولاجئات عن قصصنا بين رفوف المكتبات وسطور النصوص وأبيات الأشعار في بلداننا. نبحث عنهن لنجد أنفسنا، لنعرف أن لدينا سلالة وتاريخًا مكتوبًا بأقلام عربية, تدوّن حيوات من مناطقنا الزاخرة بالحميمية. نبحث عنه حبرًا على ورق، نظرًا لأن حكايا جداتنا أو تاريخنا الشفهي لا يثمّن في ظل الوضع الراهن كما تثمن الكتابة، ويتم إقصائه على أنه ثرثرة نساء. نبحث عن الشرعية عن “أدلة” طالما طُلب من النساء إحضارها لأن عبء البرهان يقع دومًا على عاتق الأقل سلطة. كأن غياب البرهان ليس حجّة كافية على الاستضعاف التاريخي والتسكيت! خلال بحثنا عن أنفسنا في وجوه شخصيات رئيسية في روايات كتبتها أقلام متمحصة في حيواتنا، غالبًا ما نجد رغبة تلصصية في “كشف المستور” أو التعبير عن “الجرأة” أو نزعة استشراقية ذاتية “منقذة” مؤمنة بوجوب ملء كل خانات الهويات في الكتابة على سبيل “التنويع” … هويات قد لا تعنينا أصلاً. نبحث عن صور هاربة من النمط السائد، تخفف من الظلم التمثيلي ولو قليلا، ونأمل أن نجدها بأقلام النساء. هكذا بحثت – للكتابة فى هذه الاصدارة – عن نساء أحببن نساء, جهرن بحبهن أو أخفينه، لكنّه ترك آثارًا مكتوبة. فوجدت كتاب “رائحة القرفة” لسمر يزبك 3 على كل لائحة للكتابات الكويرية من المنطقة، كأنه منشور كلاسيكي. احتُفي به لدى صدوره باعتبار أنه يفتح “عوالم مغلقة وممنوعة من الإشهار” كما ذكر غلافه والمراجعات الأدبية المتبنية لكويريته، أو خروجه عن النمط وعن المألوف. أمسكت الكتاب وقرأت الغلاف بتأن أكثر؛ هو عن “علاقة سيّدة دمشقية بخادمتها“، حيث “تتحوّل هذه العلاقة إلى لعبة قوية في يد الخادمة وتجعل منها المبرّر الوحيد لشعورها بإنسانية مفقودة“. قرأت الجملة، فانبعثت منها رائحة – لا للقرفة – بل للقرف. لم يكن “الحكم على الكتاب من الغلاف” من باب التهور، من الواضح أن الجملة التسويقية الملخصة له تعتمد سردية السلطة؛ سيدة برجوازية تمارس الجنس مع خادمتها وتفتخر أو تشكو أنه يمنح الأخيرة الإنسانية!
وأحيان أخرى تكون الكتابة عن الجنس بين النّساء فجّة وواضحة، أو جريئة كما يحلو للتقدميين تسميتها، في حين أنها لا تتعدى مساهمة سطحية في تسليع رغبات النساء لقرّاء رجال يتخيلون أجسادنا وعواطفنا متنفسا لإرضاء تلصصهم الجنسي. وإن لم تُرضِ هذه الكتابات نظرة المتفرّج المحدقة، قد ترضي الذوق الأخلاقي الرافض لهذه العلاقات باعتبارها غير شرعية ومنتهية بالدمار أو الموت أو الجنون. كأن لسان حال الكتب يقول: إن لم يكن هناك مكان للنساء الكويريات بين طياتها، فليس لهنّ مكان على سطح الأرض في مجتمعاتنا. توجد علاقات كويرية استغلالية، ويوجد الاغتصاب بين النساء، ويوجد جنس فج يسلي المتلصص أكثر من تسليته أو إشباعه لممارسيه, ويوجد دعك مؤخرة أفلاطوني ، كما يوجد السمج والباعث على الغثيان، وآخر مرغوب وعدم مصرح به. کله موجود، المجحف ألا يوجد في خيالات الروائيين ولا يخلد في كتاباتهم غير هذا.
لم تكن “رائحة القرفة” مختلفة. فقد اشتهرت بكون إشكاليتها الأساسية علاقة حب بين سيدة وخادمتها. قيل إن الرواية شجاعة في تصوير الحقائق بالتصريح لا التلميح، حقائق تتمثل في العوالم السحاقية الدمشقية المغلقة – على ما يبدو – تصوّرها الكاتبة “دون خجل“، كما تقول القراءات الاحتفائية. بيد أن الخجل الذي يحتفي القارئ بانعدامه لدى الكاتبة منسوب إلى عدم إخفائها ما كُني بعلاقات الحب المثلية بين النساء، أو علاقة استغلال من الخادمة تجاه السيدة، لا الخجل الذي يجب أن يكتنفنا حين نسطح العنف الجنسي والاقتصادي بثوب تسويقي من المساحقة، أو حين نشرع لفكرة “الاستغلال العكسي” كالعنصرية العكسية، أو كره الرجال كمقابل لكره النساء، وغيرها من الترهات. “من كانت عليا؟ خادمتها حقًا؟ من هي؟ تعرف أنها كانت سيدة هذا المكان، ولا تذكر متی انقلبت الأدوار بينهما“. يحملنا الكتاب لنستكشف الأسئلة الخاطئة، إذ أن الأسئلة الخاطئة موجودة رغم أنف الصوابية السياسية.
لا شك في أن سمر يزبك تمتلك قلمها وأنه يستجيب لها لتصوير أدق اللحظات التلصصية في بيئات محرومة وأخرى مرفهة. لا شك أن معرفتها بالتفاصيل السياقية لتواريخ أحياء دمشق فائقة. لا شك في أن امتلاكها لملكة اللغة كامل. لا شك في أن شخصياتها معقدة ومتعددة المستويات، وأن كتابتها شيّقة. الشك هنا في قدرتها على إيفاء كل صاحب حق حقه عند تصوير العلاقات بين النساء، والعتب هنا هو في تصويرها لعلاقة استغلال سيدة لخادمتها على أنها علاقة حب.
كُتب هذا الحبّ المتوهم بطريقة ملحمية؛ بين حنان الهاشمي (امرأة في منتصف العمر من أغنياء دمشق) وعليا التي لا نعرف لها كنية واسم عائلة … فتاة نكرة اشترتها حنان لتخدمها، بل أنكى، بدا كأنه حب من طرف واحد، ظلمت فيه حنان. هكذا – بطريقة عرضيّة – تمرُ الرواية على كون إحدى “العشيقتين” قد اشترت الثانية من أبيها كأننا في سوق نخاسة، وأنّ الثانية انتقلت إلى بيت سيدتها طفلة. يتجاوز الكتاب هذه الأحداث ليقول لنا إن عليا تقوم باستغلال سيدتها، وذلك في سبيل الحصول على “الإنسانية“. إذ تقول المُسلّمة الضمنية للكتاب والجملة التسويقية على غلافه ألا سبيل للحصول على الإنسانية لعليا سوى من خلال مجامعة سيدتها. وهي مُسلّمة طبقية بحتة، نظيرة المُسَلّمَة الذكورية التي يتشدق بها الرجال الذي يقومون بـ “الاغتصاب العلاجي“، حين يقولون إن النساء المثليات يستمدن “السواء” الجنسي من أيورهم. عليا فاقدة للإنسانية – على ما يبدو – وجسد حنان الهاشمي مركبة تحملها إليها، أو وعاء تتشكّل إنسانيتها من خلاله. يتجلّى الانحياز للطبقة المرفهة واضحًا بتصديق الكتاب لهذه الفكرة المثمنة للجنس مع من هم أغنى منا وأعلى مرتبة كتسلّل طبقيّ وتحرّكية اجتماعية نحو الأفضل. وياليت ذلك الأفضل قد تُرجم إلى حساب مصرفي عامر بالأموال أو بحافظة نقود مكتنزة، في صفقة تجارية واضحة نستبدل فيها كدحنا المادي – الجنسي بمقابل مادي – مالي. لكن الطبقة المرفهة تعتبر أن ممارسة الجنس معها في حد ذاته مكافأة كافية، إذ أنها تعبر بنا من واقعنا المهمش إلى الحصول على اكتفاء “وجداني” وملذات تكمل أرواحنا وشخصياتنا الناقصة، فنستمد “الإنسانية” من أيور وفروج البرجوازية.
ألبست الرواية شخصيّة عليا ثوب سندريلا، وأطنبت فى إقناعنا بأنّ عليا تتحوّل – كأنما بسحر – إلى ملكة تتربع على عرشها أثناء الليالي، قبل أن تعود خادمة في وضح النهار. (ص ۱۷) لكننا لسنا في حكاية خيالية تكون فيها حنان جنية طيبة وعليا سندريلا فقيرة, تتشاركان ليلة احتفالات قبل أن يأخذ الواقع مجراه، بل نحن في بيت لزوجين يستغلان نفوذهما في اضطهاد الخادمة بكل الطرق الممكنة. “من كانت عليا؟ خادمتها حقًّا؟“، تتسائل حنان الهاشمي مرات عديدة كأنها تُشرك القارئ في التفكير في هذه المعضلة التي حيرتها. في حين أن الإجابة واضحة: حقًا كانت خادمتها. هي خادمتها المحبوسة في الحيّز الخاص وفي أمية شاء سيداها أن يفرضاها عليها، إذ مُنعت عليا من الخروج من منزل أسيادها كما مُنعت من قراءة الكتب، (ص 29) فذلك لا يليق بخادمة. انتبهت عليا بعد سنين من العمل لدى حنان أنها لم تملك سوى ثياب الخدمة: هي لم “تملك سوى بنطلون من الجينز الأزرق، وقميص أبيض اللون. وعدا ذلك فكل الأثواب المحشوة بها خزانتها هي للنوم أو للخدمة في المنزل“. (ص ۳۰) لا عجب، إذ أن سيدة عليا رسمت حدود حياتها في الخدمة المنزلية والجنسية.
لم تسمح عليا في طفولتها للصبيان بـ “دعك مؤخرتها“، في حيّ الرّمل المدقع في الفقر والمتربص بفرص اضطهاد نسائه وأطفاله. ولم تكن الأمور الجنسية تغيب عنها، حين طعنت مغتصب أختها الكبرى المشلولة، ومغتصبها هي, في سن العاشرة. لن أفترض هنا أنها كانت طفلة غشيمة حين اشترتها حنان. بل كانت عليا فطنة وقد دعكتها الحياة وتعلمت كلّ فنون الدفاع عن النفس ونجت في كثير من الأحيان من العنف الجنسي المسلّط عليها كطفلة بين حاويات الزبالة. لكنّها لم تنج من حنان الهاشمي وزوجها أنور “التمساح المتفسخ“. لا أفترض هنا أن عليا قيدت إلى الجنس معصوبة العينين غافلة، ولا أنها كانت “منبهرة بعوالم سحرية” تختفي فى فرج سيّدتها. بل قيدت عليا إلى كل ذلك عارفة، لكن معرفتها لا تعني نجاتها، ولا تعني سلطتها. فـ “المعرفة [ليست] سلطة” ما لم نمتلك السلطة نفسها، وهذا ما غفل عنه رجال كفرانسيس باكون، صاحب المقولة، وفريدريك نيتشه الذي ظن أن وجوده مستمد من تفكيره. هؤلاء عاشوا ضد الجدليات المادية التاريخية، ناسین امتيازاتهم, ومفكرين أنهم قد استمدوها من ذكائهم الخاص؛ أن تفكيرهم نتاج عبقريتهم لا تجاربنا المشتركة وموقعياتنا المختلفة، وأن سلطتهم الفكرية تترجم بالمادة، أي أن الفكرة تسبق المادة أن امتيازاتهم المبنية على ظهور غيرهم خوّلت لهم نشر أفكارهم. ليست المعرفة سلطة – إذن – في غياب السلطة نفسها، رغم أنف الليبرالية التي تخبرنا أننا متى كنا ذكيات سننجح في امتحان الرأسمالية ونعيش حيوات لائقة أو كريمة، وأن فشلنا هو نتيجة تقاعسنا وغبائنا ، أو أننا متى درسنا سننجو من الاستغلال الجنسي على عكس الفتيات الأميات، كما يقول لنا طه حسين في دعاء الكروان. قد تجعلنا المعرفة قادرات على أن نتوقع المآسي التي ستطأنا، قد تسمح لنا بأضغاث ثانية نغمض فيها أعيننا احتسابًا كي لا تُدنس بالمصاب، أو نحاول امتصاص المرارة والمضي قدمًا كي لا ننكسر. لا أكثر. فنفعل ما علينا أن نفعله، ما يخوّل لنا سياقنا أن نفعله، لنحمي أنفسنا، أو مواردنا أو عائلاتنا. نُعنّف ولا نبلّغ، أو نُغتصب ونسكت. ولا لوم علينا ولا ادعاء أن المعرفة تحمينا من كل ذلك. كون عليا لم تطعن حنان الهاشمي حين قادت الأخيرة أصابع الخادمة “إلى حيث ترغب” في حوض الاستحمام، وحين عبثت بجسدها وقتلتها عنوة ثم طردتها حين اكتفت، ليس دليلاً على وقوع عليا في الحب الملحمي العنيف الذي تحاول الرواية جاهدة أن تُبلغنا إياه فنستفرغه. يجوز أن عليا تستهويها النساء، ويجوز أنها قد تستمتع بالممارسات الجنسية بينها وبين سيدتها، لكن ذلك لا يجعل الممارسة رضائية بطريقة آلية.
تبلغ الناجيات في أحيان كثيرة أنهنّ لمن أنفسهن إن أحست أجسادهنّ بأي مسحة متعة عند الاغتصاب، فخلق ذلك عندهن صراعًا بين القابليات النفسية والجسدية المتضاربة، وصرن يشككن في سوائهنّ ويستحين من الجهر بأن ما حصل لم يكن مرغوبًا. وفي حالة عليا, موازين القوى لم تكن لصالحها، وهي تعرف جيدًا أن “كل ما عليها فعله هو بسيط – الطاعة” (ص ٤٤) في علاقة المخدومية مع حنان. وبالتّالي، فإن أقل ما يقال عن تصوير هذه العلاقة كـ “لعبة” في يد الخادمة الطفلة إنّه مستفز، إن لم يكن مسطحًا للعنف ومشرعًا له. نجت عليا إذن من الشوارع لكنها لم تنجُ من المنزل، ذلك أنّ الشارع – رغم قسوته على النساء والفقراء والأشخاص الكويريين – كان أكثر أمانًا عليها من بيت مخدوميها. فالفضاء الخاص الذي نطلب فيه الأمان غالبًا ما يكون أكثر الأماكن خطرًا علينا.
هوس حنان الهاشمي بعليا كذلك فوقيّ ومتسلّط ، تفكّر أن غطاء رأسها البالي “مصدرًا للجاذبية“، على سبيل الحلوى المغلفة أو الدجاجة غير المنتوفة أو البطيخة غير المقطعة. حنان تكشف الحلوى طبعًا لأنها تقدمية لا تريد خادمة طفلة محجبة، رغم أن حنان نفسها تستخدم وشاح رأس على ما يبدو، لكنّ رمزيته تختلف، فتجد حنان حجاب عليا جذابًا كثمرة استوائية، بينما غطاء رأسها اعتيادي لا يسيل اللعاب. تارة تخبرنا أن وجه عليا “منحوت بدقة وجمال أكثر ممّا يحتاجه وجه خادمة“، وأنها معجبة بنظراتها التي لا تشبه نظرات الخدم التي “تتراوح بين الحزن البليد والأسى الصبور“، وتارة أخري أنها سمراء هزيلة وسافلة و “متسولة قبيحة“. (ص ١٤) في النهاية، هي “خادمة لا أصل لها ولا نسب“. (ص ٢١) كل هذا في مقارنة مع حنان، مركبة الخدم تجاه الإنسانية المفقودة.
يطغى “طعم الخيانة المباغت” على حنان الهاشمي، وقد قبضت على عليا متلبسة بالجنس اليدوي على “التمساح المتفسخ“. وحاولت إقناع القارئ في مونولوجاتها الطويلة أنّ عليا غدرت بها وبحبّهما. كون الفتاة “متسولة قبيحة“، يؤمن الراوي العليم وحنان سويا، أنّ عليا لا بد وأن تكون قد أغرت الحيوان. فإن لم تنتصب قطعة لحمه الرخوة رغبة في زوجته، كيف تنتصب لخادمة بشعة لو لم تكن بذلت كلّ فنون المكر فى سبيل لحمة متهدلة لرجل عجوز؟ أسئلة عبقرية فعلا تطرحها الرّواية، إذ لا احتمال آخر يرد لتفسير المعضلة، سوى ذكر عابر لبرطمة عليا بسخرية بعد طردها كلمات أمّها: “ظلّ راجل ولا ظلّ حيطة“. ذلك الرجل – الحائط، أنور، كان جاثما على صدرها بثقل, كزوجته، ويخال أثناهما أنهما بريئان. وفي حين تصبغ الرواية علاقة حنان وعليا برومانسية مفتعلة وحب مزعوم، تعتبر العلاقات الجنسية بين النساء شيئاً من اثنين؛ إمّا “شغفًا وانجرافًا حارقًا” إن كان بين نساء من ذات الطبقة, أو قابلاً للكب. تلخص حنان علاقتها بعليا، بعد دائرة مفرغة من إيهامنا بوجود مشاعر ما ، عندما تقول لنفسها: “هي مجرد أصابع, استبدليها بغيرها” (ص ٢٢), معيدة عليا إلى مكانها الحقيقي، حيث تستغل الطبقة العاملة وتُذكر يوميًا أنها قابلة للاستبدال. هذه الرواية ليست عن نساء يحببن نساء، بل نساء يستغللن أخريات. فليس أنور التمساح المتفسخ الوحيد في الرواية، بل تجاريه حنان في تفسخه.
في فعل الكتابة الروائية, ي/ تتملص الكاتب/ ة أحيانًا كثيرة على أساس مسلّمات ضمنيّة، أهمها أنه/ ا محايد/ ة ومعصوم/ ة من تبرير الأحداث، لأنّ الفنّ لا يبرر وهو ينقل تجربة واحدة فريدة، ولا يتحدث بالضرورة عن تجارب الجميع، وذلك لسببين: الكتابة الإبداعية كمخرج لنسب الكاتب/ ة وكالته/ ا الفكرية في مضمون النص إلى “الالهام“، أو الكتابة الواقعية كأن يقع التملص من خلال لوم “حقائق الحياة“. لا تقتصر أسطورتا سيطرة الإبداع على المضمون والتزام الكاتب/ ة بالحقائق على تحصينه/ ا من النقد، بل تتجاوز ذلك إلى نشر قيم سياسية ومجتمعية تعيد صبنا في قوالب جاهزة، قائلة شيئًا من اثنين: هذه تجربة واحدة فريدة من وحي الخيال ليس الكاتب مجبرًا على تبريرها أو تمثيلها بطريقة غير نمطيّة، أو هي تجربة واقعيّة ينقلها الكاتب بأمانة … في “صه“. الإشكالية في رائحة القرفة ليس كونها تتناول شخصيات أو علاقات قد تكون مثلية، وليس الغضب الناجم عنها متعلقًا بتفكير طهراني عن هكذا علاقات، أن لا استغلال فيها. على العكس تمامًا، لسنا ملزمين كأشخاص كوبريات أو فقيرات أو ملونات بإنتاج قصص حب بريئة ونظيفة تعجب الذائقة العامة وتكون خالية من العنف والابتزاز واللابطولة. ومن الممكن والضروري أيضًا الكتابة عن علاقات كويرية استغلالية. اللغط هنا في أمرين: تصوير رائحة القرفة لعلاقة استغلال على أنها علاقة حبّ، واحتفاء الجمهور بهكذا كتابة تحرّرية، والأنكى اعتبارها حليفة للكويريين ومصوّرة لعوالمهم. باختصار، ليست الكتابة تحرّرية ما لم تحرّرنا.