دعوى سحب الجنسية من نوال السعداوي حلف المليونير والعسكري والشيخ
اعداد بواسطة:
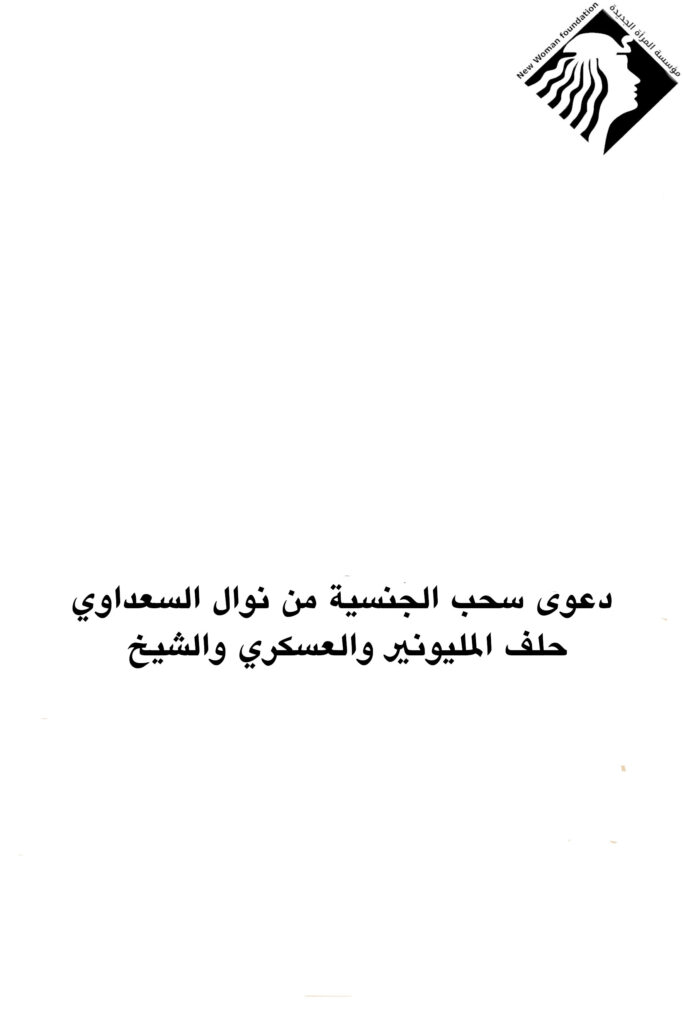

ما هي الدلالات التي يمكن استخلاصها من واقعة أن يرفع أحد المحامين التابعين للتيارات الإسلامية دعوى قضائية ضد الدكتورة نوال السعداوي، طالبًا فيها “سحب الجنسية المصرية” منها، بسبب – كما يزعم – إزدراءاتها المتكررة للدين الإسلامي وثوابته العقيدية؟!
والحق أن التاريخ المصري “والعربي” الحديث (وربما القديم) لم يشهد امرأة لاقت كل ذلك العنت الذي لاقته نوال السعداوي سواء من جهة المجتمع التقليدي، أو من جهة الجماعة الفكرية الثقافية، أو من جهة التيارات الدينية المتشددة.
فالمجتمع التقليدي، ذو العقلية الجمعية الجامدة، صدمته الكثير من الآراء الفكرية للسعداوي، لاسيما منها ما يخترق المتفق عليه، وما يكسر “التابوهات” المستقرة، وما يشرح العقائد الجامدة.
والجماعة الفكرية الثقافية لم تستطع أن تفرق أو تميز بين أمرين: الأول هو الاتفاق أو الإختلاف مع آراء السعداوي (وبعض هذه الآراء يثير الإختلاف بحق)، والثاني هو “مبدأ” التضامن مع الكاتبة إذا واجهت مساءلة قانونية أو قضائية أو واجهت حملة تكفيرية، تأييدًا لحرية الرأي، بصرف النظر عن الاختلاف مع هذا الرأي نفسه.
لقد كان عسيرًا، في بعض الحالات، أن تجتمع الجماعة الفكرية الثقافية (المصرية بخاصة) على هذه الصيغة المبدئية الناصعة التالية: “نحن مع حرية الفكر (مهما كان) كمبدأ، أما صواب هذا الفكر أو خطؤه فله مجال آخر هو مجال السجال الفكري والنقدي المفتوح“.
وكان من نتيجة ذلك العسر في الاتفاق على ذلك المبدأ الناصع البسيط أن انقسمت الجماعة الفكرية المصرية، غير مرة تجاه نوال السعداوي في معظم الحالات التي تعرضت فيها لحملات قانونية أو دينية: إذ خلط بعضهم بين الشخص والنص، فطبق موقفه من الشخص (الكاتبة) على موقفه من النص الواقع تحت المساءلة، وخلط بعضهم الآخر بين “المبدأ” وبين الرأي في النص، فطبق الرأي في النص على المبدأ (أنا مختلف مع النص، فلتذهب حرية النص إلى الجحيم) وبين الخلطين ضاع النص، وحريته، وصاحبه.
والشاهد أن هذا الفشل في التمييز بين حرية النص وبين رأينا في النص، ومن ثم هذا الانقسام الثقافي لم تصطل بنار السوداء نوال السعداوي وحدها، بل أن نار السوداء طالت حالات عديدة في تاريخنا القريب، منذ حالة “في الشعر الجاهلي” لطه حسين، مرورًا بنجيب محفوظ في “أولاد حارتنا” ونصر حامد أبو زيد، وأحمد الشهاوي، وأحمد عبد المعطي حجازي، وغيرهم وصولاً إلى كاتب هذه السطور في قضية قصيدة “شرفة ليلى مراد“.
أما الجماعات الدينية المتشددة، فقد وضعت نوال السعداوي – منذ سنوات عديدة – هدفًا من أهداف سعيها الإيماني العميق، ومنصة من منصات إنطلاق الجهاد الإسلامي من أجل “غسيل المخ” للجماعة المصرية حتى لا يكون هناك خروج عن القفص الحديدي المرسوم، فلا يكاد يمر عام أو عامان إلا وتواجه نوال السعداوي بلاغًا إلى النائب العام أو قضية أمام المحاكم أو حملة إعلامية تكفيرية في الصحف والمجلات والتليفزيون (الذي يفسح المجال واسعًا أمام تكفير المفكرين والمبدعين والمختلفين) وفوق منابر المساجد.
نعود الآن إلى السؤال الذي بدأنا به: ما هي الدلالات التي نستخلصها من واقعة أن يرفع أحد المحامين – المنتمين للتيارات الدينية المتشددة – دعوى قضائية ضد السعداوي يطالب فيها بسحب الجنسية المصرية منها، بسبب إزدرائها الثوابت الإسلامية – كما يزعم؟
سبع دلالات عجاف
وعندي أن دلالات هذه الواقعة كثيرة وعديدة، لكنني سأقتصر منها على سبع دلالات بارزة. الدلالة الأولى: هي أن الجماعات الدينية المتشددة انتقلت – بدعوى رفع الجنسية عن السعداوي – إلى طور خطر من أطوار ملاحقتها للتنوير والتنويرين، وهو طور غير مسبوق في الصراع الفكري بين الظلام والنور في تاريخنا الحديث، هذا التطور يعني تأكيد رغبة المتشددين الإسلاميين في المطابقة بين الدين والمواطنة بحيث يغدو معيار المواطنة هو الدين، لا العقد الاجتماعي بين المواطن والدولة، وبهذا المعيار الديني للمواطنة يصبح المختلف عن الدين الإسلامي كالمسيحي واليهودي وغيرهما، غير مصرى، بل ويصبح المسلم الذي يجتهد في الإسلام برأي، غير مصرى، ويصبح المتهم بالغض في الدين الإسلامي غير مصري.
وهكذا يكتمل مثلث الرعب: في البدء كان عقاب مزدري الإسلام هو إلغاء حريته، ثم صار في الخطوة الثانية: إلغاء حياته، وها هو يصبح في الضلع الأخير من المثلث: إلغاء مواطنته أو مصريته، وبين الأضلاع الثلاثة (سحب الحرية، سحب الحياة وسحب الجنسية) فإن على المثقف أن يقبع مكتوف العقل والقلب واللسان والقلم!
الدلالة الثانية: هي أن تراث النضال الوطنى المصرى الحديث قد أهدر إهدارًا، وهو ذلك التراث الذي بلورته الثورة الوطنية المصرية عام 1919 في شعارها الجامع والمانع “الدين لله والوطن للجميع“، وهو إهدار يتعارض مع الدستور، الذي يؤكد على مفهوم حق وعلى كفالة حرية الرأي والتعبير والاعتقاد بصرف النظر عن اللون والدين والجنس (النوع).
جوهر الخطورة، إذن، في هذه الدعوة هي انطلاقها من المنطلق الديني الضيق القائل: “الوطن فرع في الدين، والدين أصل، على عكس المنطلق المدني الحديث القائل: “الدين فرع في الوطن، والوطن أصل“.
الدلالة الثالثة: هي أن هذه الدعوى إلى سحب الجنسية المصرية من نوال السعداوي (وغيرها) هي دعوة مدعومة بالدستور والقانون، فعلى الرغم من وجود بنود هي الدستور المصري تبيح حرية الرأي والاعتقاد، وتحظر التمييز على أساس اللون أو الدين أو الجنس (النوع)، فإن فيه بنودًا أخرى، أكثر أساسية تدعم الحجر والكبت والقمع، وتثبت المطابقة بين الدين (الإسلامي) والمواطنة، بحيث يغدو غير المسلمين (أو المسلمون المتجاوزون دينيًا) مواطنين من الدرجة الثانية أو رعايا لا تحق لهم الجنسية المصرية.
إن المادة الثانية من الدستور المصري التي تنص على أن مصر دولة إسلامية، وأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، هي مادة تدعم موقف هؤلاء المتشددين، لأنها بإختصار تشرط الوطن بالدين (أي تجعل المسلم الأندونيسي أكثر استحقاقًا للمواطنة من القبطي المصري، أو الشيوعي المصري).
كما أن القانون يدعم هؤلاء الغلاة الضيقين ثلاث مرات: مرة بقانون الحسبة الذي يتيح لأي شخص أن يرفع دعوى قضائية ضد أى مبدع أو مفكر، لأن هذا المبدع أو المفكر أساء إلى شخص المدعى من حيث أساء إلى دين هذا المدعي، ومرة بالشرط الذي يذيل كل بند دستوری يساند الحرية، بقيد يقول: “في حدود القانون والنظام الاجتماعي وثوابت المجتمع والحياء العام“.
ومرة بانقسام النظام القضائي نفسه قسمين: واحدًا يؤسس أحكامه على القوانين المدنية الوضعية، وواحدًا يؤسس أحكامه على المرجعية الإسلامية، بحيث يمكن أن يصدر حكمان قضائیان متضادان (في دائرتين مختلفتين) لقضية واحدة. وعلى هذه الشيزوفرانيا القضائية” يلعب محامو التيارات الدينية المتشددة.
الدلالة الرابعة: هي ازورار التيارات المتشددة من أن يفكر “المرء” بعقله، مجتهدًا، أو مناوئًا أو معارضًا للثابت والمتكلس والتقليدي والمتخلف، وينقلب هذا الازورار إلى كراهية ورعب سافرين، إذا كان هذا المرء المفكر “امرأة“.
هنا يصبح التفكير أو المقاومة العقلية شيطانًا رجيمًا: لأنها بذلك تخترق الهيمنة الذكورية للرجال الذين هم ملاك المعرفة السماوية الوحيدون، ووسطاء الله إلى عباد المؤمنين، ولأن المرأة “ناقصة عقل ودين” كما تقول قاعدة المتشددين الدينية، ولأنها نصف شهادة ونصف وريث وليس لها ولاية، ولأن تمرد المرأة أخطر من تمرد الرجل، لأن هذا التمرد لا يثور فقط على لاهوت الاستبداد السياسي، ولاهوت الاستبداد الديني، ولاهوت الاستبداد الاجتماعي، بل يضيف إلى كل ذلك الثورة على لاهوت الرجل نفسه ولعل بعض كتب نوال السعداوي (مثل: المرأة والجنس، الرجل والجنس، الأنثى هي الأصل) تؤكد ذلك.
الدلالة الخامسة: هي أن هذه الدعوات الظلامية القامعة، مدعومة بخوف السلطة السياسية من هذه التيارات الدينية المتشددة. إن السلطة السياسية التي تفتقد إلى “الشرعية الشعبية” تحاول اختلاق شرعية دينية، فتنافق التيارات الدينية بل أنها تزايد عليها في كثير من الحالات (كما حد في واقعة آراء فاروق حسني في الحجاب)، ثم أنها تحرص على جلب شرعية دينية على معظم تصرفاتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ثم هي تقيم دستورًا مزدوجًا يأخذ بيد دينية ما يعطيه بيد مدنية، ويطلق يد البرامج الدينية في الإعلام والتليفزيون، مما يوفر مناخًا مناسبًا للدعوات الدينية المتطرفة.
الدلالة السادسة: هي أن هذه الدعوات الدينية الكابحة التي ترفع ضد المفكرين، مدعومة بانقسام المثقفين المصريين أنفسهم تجاه مثل هذه الدعوات – على النحو الذي شرحنا منذ قليل – مما يغري المتطرفين بإستثمار هذا الانقسام والمضي قدمًا في سلسلة هجومهم الأسود والإنتقال فيه إلى مراحل أشد سوادًا.
إن المثقفين – في منظور التيارات المتشددة – هم خصم ضعیف هش متشرذم: بعضهم لا يكاد يختلف – في الجوهر – عن المتشددين، وبعضهم يخلص “ثأرات شخصية” أو ينفس “أحقاد ذاتية” على حساب القضية الفكرية المبدئية. وبعضهم لا يميز بين “المبدأ” والتقييم الفكري أو الفني للنص، ولا يفرق بين الشخص والنص وبعضهم يؤثر السلامة.
ولا يبقى بعد كل ذلك إلا نفر قليل ينافح عن حرية الفكر والاعقاد والاجتهاد، كمبدأ ثابت، وكحق أصيل من حقوق الإنسان.
وأمام هذا المشهد المتشرذم البائس للمثقفين، لماذا لا يتأكد المتشددون أنهم أمام خصم منهزم من داخله؟
الدلالة السابعة والأخيرة: هي أن دولتنا – في جوهر الحال – دولة دينية، لا دولة مدنية كما نتصور. فالدولة الدينية ليست هي بالضرورة الدولة التي يجلس فيها الشيوخ على سدة الحكم السياسي، بل هي الدولة التي تسيرها معيار المرجعية الدينية، التي يقاس عليها كل سلوك: سياسي أو اقتصادي أو ثقافي أو إبداعي، وهذا هو حال مصر التي تسرها الفتوى لا القانون. فإذا أضفنا لمناخ المرجعية الدينية النصوص الدستورية الداعمة المرجعية الدينية، واستشارة المؤسسة الدينية الرسمية في التعيينات للمناصب القيادية والسياسية الحساسة، كنا في دولة دينية بيضاء من غير سوء.
صحيح أن لدينا علامات كثيرة على الدولة المدنية الحديثة (برلمان، مدارس، جیش، قانون، دستور، فصل بين سلطات، قضاء، أحزاب وجمعيات…وغيرها) لكنها جميعًا شكل مفرغ من المضمون المدني، وممتلئ بالمضمون الديني (فالبرلمان نفسه – وهو أعلى تجسيد للدولة المدنية – يسير بمنهج المرجعية الدينية).
ثم أن هذه الدولة الدينية هي في خدمة دولة العسكر، وكلتاهما في خدمة دولة رجال الأعمال. دولتنا الراهنة، إذن، هي دولة حلف المصلحة المقدس بين المليونير، العسكري والشيخ.














