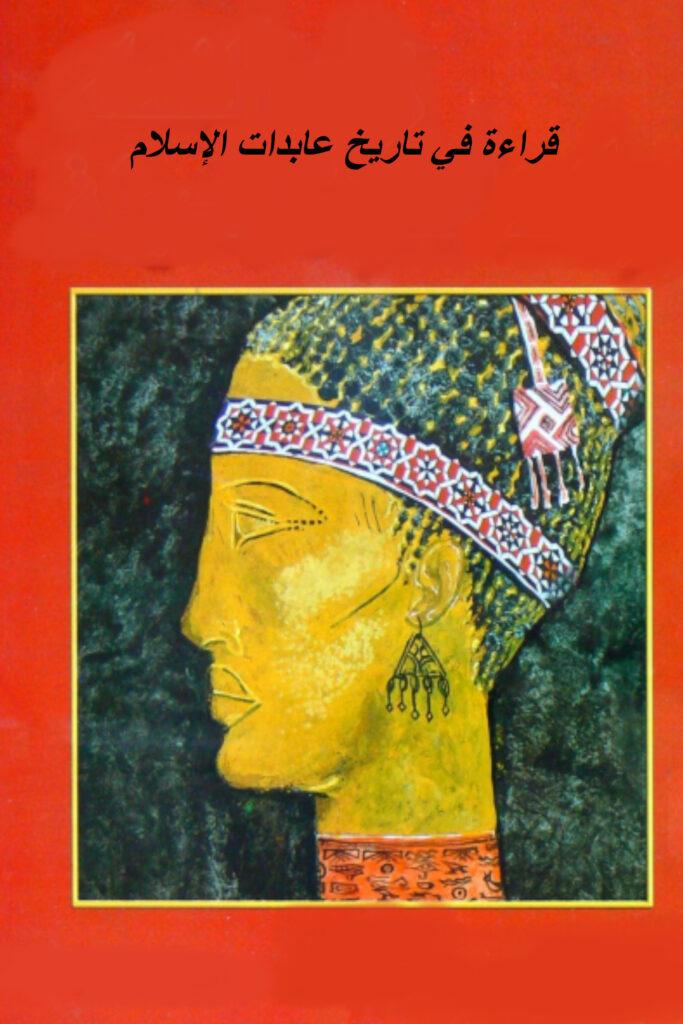قراءة في تاريخ عابدات الإسلام
تعریف
موضوع هذه الورقة هو الرائدات الأوليات، من النساء العابدات والزاهدات، في القرون الأولى من الإسلام، واللاتى – في العادة – لا نعرف منهن غير رابعة العدوية، على الرغم من أن قارئ التاريخ، يكتشف أنها لم تكن الزاهدة المتعبدة الوحيدة بين نساء المسلمين، بل هي مثل كثيرات غيرها من المتعبدات والشيخات في الأمصار كافة – سواء في الجزيرة العربية، أو في العراق، وفي الشام، وفي فلسطين، وفي مصر، وفي اليمن، أو في بلاد فارس، وفي خراسان وفي نيسابور. وقد وردت أخبار وتراجم هؤلاء العابدات في مصادر التاريخ الأولى، من خلال سير وتراجم الأولياء والصالحين والصوفية، أو في كتب وصف المقامات والأضرحة والمزارات والخطط، وأيضاً كتب ذكر الوفيات وقواميس الأعلام والأعيان (۱). إلا أن هؤلاء العابدات المسلمات، يشكلن قطاعاً منسياً أو مهمشاً – إلى حد ما – في كتب التاريخ القديمة، وإلى حد كبير، في الأبحاث الحديثة عن علاقة المرأة في الإسلام، بالزهد والعبادة والتجربة الدينية الروحية. فلم يهتم المؤرخون القدامى إلا بتدوين أقل القليل عن حياتهن – على الرغم من إضفاء المديح والثناء – وأغفلوا كثيرًا من التفاصيل الدالة عن نشاطهن التعبدي أو نشأتهن، ولم يفردوا لذلك إلا صفحات أو سطورًا مبتسرة وإشارات مؤجزة إلى آثارهن. ويلزم التنبيه إلى أنه غالباً ينقص هذه التراجم تواريخ محددة للميلاد أو الوفاة، وما نعرفه هو ظهور طائفة العباد والزهاد (نساءاً ورجالاً) في التاريخ الإسلامي المبكر في العراق والشام، خاصةً منذ القرن الأول الهجري، الذين اهتموا بإذكاء الحياة الروحية والإكثار من العبادة (الصلوات والصيام والذكر والدعاء والتسابيح)، ومارسوا التقشف الشديد، والتواضع في العيش، وكرهوا الترف والإسراف؛ تقرباً إلى الله وابتغاء وجهه. كما عرفوا بجماعات التوابين والبكائين؛ لأنهم اتخذوا من طلب التوبة وكثرة البكاء أسلوباً لهم في التعبد، وسيطرت عليهم عاطفة الخوف من المعصية والحزن والندم (۲). واستمر هذا الإتجاه في تطوره وتعمقه، حتى بدأت تتضح معالم التصوف فيما بعد، كمذهب معروف، اجتمعت عليه وارتبطت به جماعة معينة، كانت لهم أفكار واعتقادات محددة، نرى بذورها في خطرات وأسلوب الوعظ والدعاء لهؤلاء النساء والرجال، الذين تغطى أخبارهم الفترة الممتدة من القرن السابع الميلادي إلى القرن الثاني عشر.
أحاول هنا إلقاء الضوء على “عوابد النساء” خاصةً؛ كظاهرة تاريخية – روحانية واجتماعية – وتحليلها متسائلة: ماذا نستشف من هذه التراجم والأخبار المتناثرة، عن ملامح الحياة في المجال العام لبعض النساء المسلمات، في ذلك الوقت، وعن صورتهن في التاريخ كما وصلتنا؟. وبماذا تتسم الحياة الروحية التي عشنها في هذه القرون؟ كيف عبدن الله؟ وكيف كان تحركهن داخل المحيط الأسرى والمجتمعي، وقد اتخذن التعبد والولاية وسماً لهن؟. وما تعليقنا على موقف المؤرخين القدامى أو المحدثين ومنهجهم ومقاصدهم في التأريخ لهذا الموضوع؟
الإطار المعرفي
يقع أي نشاط تعبدى أو وعظى النساء، تحت الوصف العام الموجود بكتب تاريخ الأولياء والعباد الصوفية “الذين علموا فعملوا بحقيقة العلم“؛ أى تأكيد الدافع العرفاني للعبادة، إلى جانب عدم الانقطاع عن المعاملات، أو التواصل مع الجماعة، كما أشار إلى ذلك أبو نعيم الأصبهاني، في مقدمة “حلية الأولياء” (ص ٢٤، ج ١ – ٢). كما وصف الغزالي في “إحياء علوم الدين” هذه العبادة، بمجاهدة النفس، أو إجهادها، ومراقبتها، ومحاسبتها؛ خوفاً من المعصية، ورغبة في الصلاح ونيل المغفرة، وأطلق على العباد مجتهدين ومجتهدات، وبين المواظبة الدؤوب على قيام الليل المتصل والصوم الكثير والذكر والدعاء والإصرار على الرزق الحلال الخالص، والتوكل على الله، وكيف تهون في أعينهم الدنيا، وتعظم في أرواحهم الآخرة ولقاء ربهم (ج 4، ص ٣٧٠). كما نذكر في هذا الصدد الحديث الشريف الذى رواه البخاري ومسلم عن أبي موسى: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): “كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء، إلا أسية امرأة فرعون، ومريم بنت عمران” (۳). وفي تفسير الحافظ ابن حجر، لهذا الحديث، أن المقصود هنا هو “لم يُنبأ من النساء إلا فلانة وفلانة“. ومعنى ذلك أنها في منزلة النبوة: “لأن أكمل النوع الإنساني الأنبياء، ثم الأولياء والصدّيقون والشهداء. فلو كانتا غير نبيتين للزم ألا يكون في النساء ولية، ولا صديقة، ولا شهيدة. والواقع أن هذه الصفات في كثير منهن موجودة“. وقد اختلف سائر الأئمة والفقهاء حول هذه المسألة بالذات: إذا كان من النساء من نُبيء، أو هل ذكر الإيحاء لبعضهن في القرآن، معناه ثبوت نبوتهن، إلا أنهم أجمعوا وأقروا، بأن المرأة تكون ولية وصديقة وشهيدة، كدرجات روحانية، في مجال العبادة، والقرب من الله.
إذا كان الأمر كذلك، فهذا يدفعنا، الآن عند التفكر في التاريخ الإسلامي الممتد، إلى التساؤل: أين هؤلاء الوليات والصديقات والشهيدات، وأين اندثرت أصواتهن؟. وهذا التساؤل – في حقيقة الأمر – جزء من الاتجاه الحديث، في دراسات تاريخ الأديان، وهو الاهتمام بـ ( أ ) الدور التاريخى المنسى للنساء، في الحياة الدينية للمجتمعات، بصفة عامة، كممارسة العبادات والشعائر، أو دراسة وتعليم الفكر والعلوم الدينية مثلاً، أو تأثيرهن ومساهمتهن، في المجال الروحاني/ الصوفي، لدى كل تراث، ثم المحاولة أيضاً. (ب) تقصى سمات مميزة لروحانية خاصة بالنساء (أو ما يطلق عليه روحانية نسوية)، سواء في السلوك أو التعبير، وهل لزم الحاجة – تاريخياً – إلى هذه الروحانية المنفردة؟.
بالنسبة إلى الشق الأول من الموضوع – وهو كما قلنا التنقيب عن تاريخ النساء المهمل في التراث الديني – يتبادر إلى الذهن سؤال عن الكيفية من ناحية، وعن قيمة هذا الاتجاه البحثى أو الغرض منه، من ناحية أخرى. تضع “جون أوكونر” في مقال لها، عن هذا المجال الجديد، إطاراً عاماً للبحث فيه، يتمثل فيما يمكن أن نسميه “الإعادات الثلاث” (٤): إعادة القراءة، وإعادة الفهم والتصوير، وإعادة البناء والتشكيل. الخطوة الأولى: هي إعادة قراءة المواد والمعلومات التاريخية المتاحة، الخاصة بحضور أو غياب النساء، من ساحة النشاط الديني التعبدي، كلامهن أو صمتهن. ورصد المساهمات التي قمن بها، والأدوار التي لعبنها في هذا المجال. وسوف تنتج عن كل هذا، اكتشافات تاريخية معينة، عن ملامح حياة النساء الاجتماعية، والتجارب الدينية الخاصة بهن، وكيف نظرن إلى علاقتهن بالله (سبحانه)، وبرجال المجتمع من أزواج وأبناء وعلماء وفقهاء. الخطوة الثانية: هي إعادة التفكر في هذه الاكتشافات؛ لاعتبار النساء عناصر فعّالة نشطة في المجتمعات الأولى، ولدراسة دور الدين في حياتهن. أو هل كانت العبادة والزهد والتصوف تعبيراً عن الاستقلالية، والاعتداد بالنفس، والثقة الإيمانية، وتأكيداً على قيم المساواة والعدالة في الرسالات الإلهية، في مجتمعات ساد فيها – أحياناً – التفاضل والتراتب في العلاقات بين الجنسين؟. فنلمس مثلاً في حياة العابدات/ الصوفيات في الإسلام مستوى معينا، من الشعور والسلوك التحرري، الذي ولا شك استمددنه من جوهر رسالة الشريعة، التي أكدت على المساواة والتكامل، في القيمة الإنسانية والنفسية والروحية. هل يمكن أن نعيد الفهم والإدراك للخلط الذى تم بين تلك المبادئ المرجعية الأصلية، وعناصر التفاضيل والهيمنة التي تنامت على الرغم من ذلك في المجتمعات الإسلامية على مر العصور؟ ومن هنا، يتضح لنا أمران: أن الماضى أغنى مما كنا نتصور، في عناصره الإيجابية، التي نستطيع الإفادة منها من ناحية، ومن ناحية أخرى أن نشأة القيم السلبية لها مسببات سياسة واجتماعية وثقافية، كان من الممكن – تجنبها – ويمكن إصلاحها عندما نفهمها.
أما الخطوة الثالثة، في برنامج “أوكونر” البحثى، والتي تمثل خلاصة المشروع ككل فهي: مرحلة إعادة تكوين صورة جديدة عن الماضي، بناءً على هذه المعلومات والتحليلات، ثم توظيف نموذج مختلف للتفسير والتقييم، مثل الأخذ – في الاعتبار – تطور أدوار النساء والرجال في المجتمع والأسرة، والتفاعل بينها، ومدى تشكلها وتأثرها بقيم ثقافية أو دينية معينة، وهو – في نهاية الأمر – ما نعنيه بوجهة نظر المرأة، أو المنظور النسوى في التحليل التاريخي، ومن الممكن استخدام هذا المنظور، في الأبحاث والدراسات الدينية، (أى الأبحاث المتعلقة بدور النساء، في الحياة الدينية والروحية، دلالة هذه الأنماط ودوافعها وارتباطها بنظرة المجتمع إلى النساء، في تصوفهن وتدينهن، ثم نظرة هؤلاء العابدات إلى أنفسهن).
يتضح – مما سبق أن – هذه الخطوات، تشكل إطاراً نظرياً عاماً، أو منهجاً جديداً، بدأ الحديث عنه، منذ أوخر السبعينيات، في حقل الدراسات التاريخية للأديان وتراثها (٥). اتفقت الآراء أنه على النساء الباحثات أنفسهن، تبنّى هذا المشروع التاريخي؛ حيث تكون المرأة ليس – فقط – موضوعاً للدراسة، ولكن أيضًا القائمة بها. وتحاول الباحثة “كارى بوريسن” شرح ما يطلق عليه الآن “النسوية الدينية“: “في العشرين سنة الأخيرة قامت الدراسات النسوية بالتركيز على التاريخ الدينى والفكرى، مستخدمة المعيار الجنساني (human genderedness) كمادة تحليلية رئيسية، من حيث دراسة التفاعل بين الجنس البيولوجي للإنسان، والدور المجتمعي الثقافي المعيَّن من قبل الجماعة ثم كيفية التعبير عن ذلك وتمثيله” (٦). وذلك بهدف التوصل في النهاية إلى صورة أكمل وأشمل لماضي البشرية، و تبنّى منظور موسع يأخذ في الاعتبار التوازن وتصحيح المسار التاريخي، الذي اتسم بالميل إلى نموذج واحد فقط للإنسانية، هو النموذج الذكوري.
لن نلمس فائدة هذا الإطار النظرى، إلا إذا قمنا بتطبيقه فعلاً، على بعض من تراثنا التاريخي. ويجدر الإشارة هنا إلى عملين ظهرا مؤخراً، أحدهما بالعربية، لسامى مكارم “عاشقات الله” (١٩٩٤)، والآخر بالفرنسية سنتعرض له بعد قليل. يقدم الكاتب سامي مكارم سير سبع من العابدات الوليات، جمع مادتها من المصادر الرئيسية التي ذكرناها (انظرى هامش 1)، واهتم – خاصةً – بإبراز دورهن في وضع الأساس لنظرية الحب الإلهي، في التصوف الإسلامي فيما بعد، هذه النظرية التي أصبحت منذ القرن الثالث للهجرة، بعد أن داخلتها عناصر فكرية أخرى، مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمفهوم التحقق الصوفي، كما نراه عند أبي يزيد البسطامي، وسرى السقطى، وأبى الحسين النورى، والجنيد والشبلي.. إلخ” (۷). فهو في عرضه، لأقوال الوليات ووعظهن، يهدف إلى الكشف عن وجود خط معرفي يصل هذه الأقوال بالتصوف الإسلامي، في مرحلة نضجه الفكرى والفلسفي، ويتوقف عند عبارات وتيمات معينة، ليلفت النظر إلى أنها تحمل في طياتها البذور الأولى، لنظريات الحب الإلهي، والأنس، والخلة، والوجد، وفناء الذات، والبقاء في الله.. إلى آخره. كما يرجع سامى مكارم إلى العابدات، نشأة ما يسمى بالعرفان الإسلامي؛ حيث إن أفكارهن التي رددنها تمثل في نظرة “تكاملاً معرفياً، وتؤلف – أساساً – من الأسس التي بنيت عليها الحركة الصوفية في القرون التالية” (۸). وهذه – بالفعل – هى النتيجة التي توصل إليها الباحثون والباحثات (أمثال على سامى النشار، ومارجريت سميث، وعبد الرحمن بدوى) (۹)، عند دراسة سيرة رابعة العدوية – أول من انتقل بالروحانية الإسلامية، من مرحلة الزهد الوعظى والتقشف فقط، إلى مفهوم العشق الإلهى الخالص. لذا، يحاول الكاتب – هنا – تطبيق هذه الأطروحة على عابدات أخريات.
وعلى الرغم من أهمية الكتاب في لفت النظر إلى وجود هؤلاء “العاشقات” وفي التأكيد على الدور التاريخي لهن “كصوفيات” بالفعل وإدراجهن في التسلسل الفكري الفلسفي للحركة الصوفية، إلا أن القول بأن “هؤلاء العابدات تميزن ببعد عاطفي وشعوري قد يكون راجعاً إلى الطبيعة الأنثوية التي تجعل من الحس عند النساء أكثر رهافة على الإجمال مما هو عند الرجال“ (١٠)، يكاد يعود بنا إلى ترسيخ المفهوم الثقافي القديم الذي يقسم الطبيعة البشرية تقسيماً جامداً إلى طبيعة النساء بخلاف طبيعة الرجال، وذلك لتقسيم الأدوار الاجتماعية ولتبرير تحجيم الدور العام للنساء أو التقليل من شأن البُعد الفكري لصوت النساء عبر التاريخ. كما كنا نود للكتاب أن يتناول بالتحليل حركة العابدات في محيط الجماعة في ذلك الوقت وطبيعة وضعهن داخل الأسرة والمجتمع الإسلامي؛ حتى نفهم أكثر مقدار السلطان الروحى ومساحة الحرية الاجتماعية والأسرية التي كانت في متناولهن.
أما الكتاب الفرنسي بعنوان “النساء الصوفيات” (۱۱). لكاتبين عربيين أيضاً، فيقدم مسحاً عاماً وتقييماً للمصادر الرئيسة المعروفة لدينا سواء المنشورة المحققة أو المخطوطات كنوع أدبي/ تاريخي اختص بسير الصالحين والأولياء والصوفية، ويتضمن قائمة بالأعمال التي تضم خاصةً أخبار وروايات النساء في تسلسلها الزمنى بدءاً من الجاحظ حتى المناوى، من حيث تبويبها وتصنيفاتها وعدد النساء فيها وموقع أخبارهن في كل مجموعة. ثم ينتقل الكتاب إلى الجزء الرئيسي، وهو عرض وترجمة (إلى الفرنسية) للجزء الخاص بالعابدات في آخر کتاب بالعربية في هذه السلسلة وهو “الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية” (ق۱۷)، لعبد الرؤوف المناوى ووضعه في سياق هذا النوع من الأدبيات لمقارنة الشخصيات النسائية التي أوردها أو حذفها ببعض الأعمال الأخرى. وقيمة “النساء الصوفيات” (الفرنسي) تكمن في التنبيه إلى موقع أخبار النساء في هذا التراث، حتى نتمكن من وضع كل مجموعة في السياق العام للمقارنة والتقييم، وقد ينقصه مزيد من التحليل المتعمق لمغزى ومضمون هذه السير والروايات، ولكنه في حد ذاته يمثل مرجعاً حديثاً ومصدراً لمعلومات صحيحة ودقيقة، عن كتب سير الأولياء العربية. كما أشار الكاتبان إشارة سريعة إلى أهمية هذا التراث، في الكشف عن مكانة النساء في العصور الوسطى، ونظرة المجتمع وثقافته التي يمثلها هؤلاء المؤرخون إليهن (۱۲).
أي على الرغم من أن كلا من الكتابين قد ركزا على تجميع وانتقاء (أو ترجمة) مواد تاريخية خاصة بالعابدات دون التفسير المتعمق أو التنظير، فهي إضافات محمودة على طريق إحياء تراث النساء في مجالات المعارف الدينية والروحية والعبادة، والاهتمام بكشف هذا التاريخ ودراسة دلالاته من منظور جديد.
نعود إلى الشق الثاني من الموضوع المطروح، وهو – كما ذكرنا في البداية – يتعلق بروحانية النساء، فالمقصود بها الآتى: هل نستبين من الأقوال والأشعار التي وصلتنا خطاباً متفرداً ومختلفاً عن أقوال الصوفية من الرجال؟. هل بوسعنا أن نستشف ذلك من خلال الاستخدام اللغوى، أو التركيز على تيمات معينة دون غيرها؟. هل هناك في التصوف تعبيرية نسوية خاصة؟. وقد أدى هذا النوع من التساؤلات النقدية، إلى ظهور العديد من الدراسات الغربية، حول موضوع “كتابة الجسد“، و “الروحانية الجسدية“، التي رأى الباحثون أنها تظهر بوضوح، في كتابات وأدبيات القديسات المسيحيات، والراهبات في العصور الوسطى، بأوروبا دوناً عن أعمال القسيسين والقديسين، من رجال الكنيسة وعلمائها، كنوع من الرغبة في استخدام لغة مختلفة وتأنيث للتجربة الروحية (۱۳). وفي رأيى هذه الفكرة بالذات، غير واردة بالنسبة إلى الصوفيات المسلمات، فعند الاطلاع على آثارهن لا نستطيع أن نجزم، بوجود نظرية مماثلة تقضى باختلاف جوهري، في الصور والأساليب البلاغية عن تعبيرات الصوفية من الرجال، فلا نلمس في اللغة أو الأسلوب الوعظى، والمناجاة والدعاء والتهجد، تأكيداً للفروق النوعية (مثلاً ما يسمى بالهوية أو الطبيعة الأنثوية)، بسبب التوجه بالخطاب إلى الخالق الأعلى، من موقع العبد/ الإنسان في سعيها وسعيه إلى الله (عز وجل)، ويلزم ذلك تخطى حدود الجسد والفروق الدنيوية بين ذكر وأنثى لأن الحد الفاصل هنا بين الخالق والمخلوق، وأي تراتبية تكون بين الله والبشر، بطبيعة الحال وليس بين طبقات البشر وأجناسهم.
وهناك مثال واضح على ذلك في حالة “فاطمة النيسابورية” (توفيت ٨٤٩ م) من خراسان، وهي من شهيرات الصوفيات، التي قيل عنها في كتب التاريخ إنها هجرت حياة الترف كابنة لأمير بلخ وسلكت طريقة الصوفية، خاصةً عندما عرضت نفسها زوجة للصوفي المعروف أيضاً، أحمد بن الخضروية. وهى عادةً تُذكر في المعاجم منفصلة عن سيرة زوجها، فقد عُرفت باجتماعاتها مع كبار صوفية العصر، أمثال ذي النون المصري، وأبي يزيد بسطامي، في حلقات ذكر وجلسات مساعة واستفسار في أمور التعبد والعرفان. وروى عنها عبد الرحمن جامي الفارسي، في كتابه “نفحات الأنس” (ق ۱٥)، أنها قالت لذي النون الذي رفض منها هدية، أرسلتها إليه لكونها امرأة: إن الصوفي الحقيقى لا ينظر بعين الاعتبار، إلى الأسباب الثانوية في هذه الحياة (أى المصدر الدنيوي للهدية)، ولكن إلى العاطى الأوحد للكل سواء، والمتعال عن الجميع – الله عز وجل (١٤). وفي رواية أخرى مشهورة وردت في “تذكرة الأولياء“، لفريد الدين عطار (ق۱۳)، أنها اعتادت أن تحادث أبا يزيد بسطامي، في أمور الطريقة والمقامات والأحوال حتى أتى يوماً، لاحظ فيه بسطامى أنها تضع “الحناء” بيديها وسألها عن سبب ذلك، وهنا قالت له إنها كانت تجالسه لأنه لا يلحظ منها غير الروح، أما الآن وقد بدأ ينظر إليها كامرأة ذات زينة، فقد حرمت على نفسها الاجتماع به، ومن ثم امتنعت (١٥). ونفهم من هذين المثلين أن المتعبدات والصوفيات غالباً، لم يلتفتن إلى طبيعتهن المغايرة عن طبيعة الرجال، أو إلى فروق في الدرجات والأدوار (حتى يأتى التنبيه من السياق الخارجي المحيط)، بل نجد نظرة شمولية إلى الإنسان أولاً وأخيراً، وتعريف لهويتهن الإنسانية في مقابل الحق (سبحانه وتعالى) فقط، دون التقيد بالتعريف بالاجتماعي الدنيوي المحدود. أما تعليقات وإشارات الصوفيين من الرجال حولهن، فهي التي تنم عن منظور ينحصر في هذا الإطار الجنساني الضيق، وإدراك قوى للفروق النوعية، وعدم قدرة على تجاوزها وتجاهل ما توحى به، من تفاضل وعدم تساوٍ ولقد غضب أحمد بن الخضروية، من فاطمة لمحاوراتها وأحاديثها مع بسطامی، فشرحت له أنه كزوجها قطعاً قريب من نفسها، ويثير فيها عشقها وهواها، بينما يتقارب بسطامي معها على نهج الطريقة والمقامات وشئون الروح، كما يستطيع بسطامي الامتناع عنها، في أي وقت بينما يحتاج أحمد إليها دوماً. أى أنه في إصرار فاطمة على الارتقاء، ببسطامي وزوجها إلى مستوى آخر من التفاعل والتعامل بين الرجال والنساء، هو انتقال من مقياس التشكل الإجتماعي والثقافي المحدود للجنسين – والذي يمكن أن يكون غير عادل ومنقوص – إلى مقياس يمحى هذه الفروق ويساوى بين الجنسين فيضعهما على أرضية واحدة مشتركة متدنية بالمقارنة بالخالق سبحانه وتعالى.
ولا تشعر معظم العابدات – رغم أنهن زوجات وأمهات وأخوات – أن هذه الأدوار الأسرية، تشكل مرجعية لذواتهن أو قيمتهن الإنسانية، فها هي “حسنة العابدة“، التي يقال إنها تركت نعيم الدنيا وأقبلت على العبادة، تصوم النهار وتحيى الليل، وكانت جميلة، فلما قيل لها تزوجى قالت: “هات رجلاً زاهداً، لا يكلفنى من أمر الدنيا شيئاً، وما أظنك تقدرين عليه، فوالله ما في نفسي أن أعبد الدنيا، ولا أتنعم مع رجال الدنيا، فإن وجدت رجلاً يبكي ويبكيني، ويصوم ويأمرني، ويتصدق ويحضنى عليها، فيها نعمت، وإلا فعلى الرجال السلام” (16). فهى ليست بحاجة إلى زوج بالضرورة لمجرد الإحساس بالجدارة، أو اكتساب مكانة اجتماعية معينة. النظرة إلى الزواج هنا، تقترن عندنا بشعور الثقة الإيمانية، والاكتفاء بذاتها وعبادتها وقربها من الله (سبحانه وتعالى)، والاعتداد بالنفس إذا لم تجد رجلاً صالحاً بمقياسها، يرقى إلى مستوى روحى معين حددته هي، وليس حسب أية معايير مجتمعية أخرى. كما نلحظ أيضًا أن “الدنيا” هنا وما تقترن به من لهو ولعب وحب للزينة والشهوات، ترتبط في قولها هذا أو تتساوى بشخص الرجل، عندما لا يكون زاهداً أو عابداً، بقدر كاف ترضاه، وهذا وضع معكوس للتيمة التي ألفناها في بعض الكتابات الدينية والصوفية بالعصور الوسطى (سواء المسيحية أو الإسلامية) (۱۷)، التي لجأ كُتابها من العلماء والفقهاء إلى تسوية المرأة بالدنيا وإغراءاتها المادية في مقابل الزهد والترفع الروحى، واستخدمت هذه الفكرة على المستوى المجازى أو الواقعي. وعلى المنوال ذاته، نقرأ عن امرأة من الموصل سميت “ألوف“، جاءها من يخطبها فردت على رسوله إليها : “قل له ما يسرني أنك لى عبد، وجميع ما تملكه لي، وأنك شغلتني عن الله عز وجل طرفه عين (ج ۲ ص ۳۸۲).
أما العابدات المتزوجات بالفعل، فقد كانت نظرتهن إلى رباط الزوجية، أنه مسئولية روحية أولاً وأخيراً، وشركة في العبادة، فنقرأ عن “عمرة“، من البصرة وزوجة حبيب أبي محمد العجمي، التي كانت توقظه في الفجر للصلاة والتعبد: “قم يا رجل فقد ذهب الليل وجاء النهار، وبين يديك طريق بعيد وزواد قليل، وقوافل الصالحين قد سارت، قدامنا ونحن قد بقينا” (ج2، ص ٢٦٢)، مثلها في ذلك مثل امرأة رياح القيسي، وكانت تصر على إيقاظه ليحيى الليل بالصلاة والتهجد: “قم يا رياح… مضى الليل وعسكر المحسنون وأنت نائم، ليت شعري من غرني بك يا رياح!”، فيتضح من الترجمة المروية أنها كانت أعلى منه درجة في الإيمان والزهد، وعتبت عليه مرة أنه حمل هم شأن من الشئون الدنيوية فقالت له: “أراك تغتم لأمر الدنيا، غرني منكم شميط“، (شميط بن العجلان الذي زوج رياح القيسي لها)، ثم خلعت هدية من خمارها وقالت: “الدنيا أهون على من هذه” (ج ۲، ص ۲۷۰). أما “رابعة بنت إسماعيل الشامية“، زوجة أحمد بن أبى الحوارى، فقد حكى عنها زوجها قيامها الليل كثيراً حتى قال لها يوماً: “قد رأينا أبا سليمان وتعبدنا معه، ما رأينا من يقوم من أول الليل“. فقالت: “سبحان الله، مثلك يتكلم بهذا؟. إنما أقوم إذا نوديت“. وعندما يجلس معها إلى الطعام، كانت تذكره – أى تدعوه دوماً للذكر والتذكر – فقال لها مرة: “دعينا يهنينا طعامنا“، وردت عليه: “ليس أنا وأنت ممن يتنغص عليه الطعام، عند ذكر الآخرة (ج ٢، ص ٤٦٤). كما نقرأ عن “أم الدرداء“، من عابدات الشام و “معاذة بنت عبد الله العدوية“، من البصرة وكلتاهما متزوجتان، ذاع صيتهما في الصلاح والحكمة والاجتهاد، الأولى زوجها أبو الدرداء، وكان لها مجلس ذكر يأتي إليها العابدون، يذكرون الله عندها ويسألونها الدعاء، والثانية زوجة لأبي الصهباء، وكانا معاً يتعبدان: “هذا أبو الصهباء لا ينام ليله، ولا يفطر نهاره، وهذه امرأته معاذة ابنة عبد الله، لم ترفع رأسها إلى السماء أربعين عاماً” (ج ٢ ص ٤٦٠، ص ٢٥٢).
ومحصلة التدبر في مثل هذه النماذج أن ندرك أن لعبادة النساء في التاريخ الإسلامي أبعاداً وجوانب متعددة، وسواء كان هناك اختلافات، لغوية وأسلوبية في أقوالهن أم لا، أو تكثر – كما رأينا – الإشارات إلى التساوى في المكانة الروحية والقيم الإنسانية والاجتهاد التعبدي (لدرجة الشعور بالتفوق أحياناً)، علينا أن نتساءل من جديد: ما تفسير هذه الاختلافات إن وُجدت أو انعدمت؟. وما معنى أن تتصوف المرأة، فتتوجه إلى الله (عز وجل)، بكل جوارحها ونفسها وحياتها حتى توسم بالتعبد والولاية؟. ما الدوافع وما النتائج والمكاسب؟. تذكرنا سعاد عبد الحكيم في مقال لها عن تصوف المرأة أن: “الصوفي يُسقط عن الكائن أثوابه المعارة كلها، بحيث يتبدى عارياً للأعين، هذا الوجود العارى هو قيمته الحقيقية، قيمته خارج كونه رجلاً أو إمرأة، غنياً أو فقيراً، حاكماً أو محكوماً، وبعد أن تسقط الأثواب المعارة كلها.. لا يبقى إلا عبودية الإنسان، فالعبودية هي حقيقة الإنسان، وفيها التفاضل، وعليها بني الصوفي سلم تقويمه” (۱۸). سعت عابدات الإسلام إذاً إلى عبادة الله، خروجاً عن مدار التشكل الجنساني والاجتماعي (الدنيوي). وبحثاً عن الضمير الخالص في كل منا سواسية. وتستشهد الكاتبة بنصوص للشيخ الأكبر ابن عربي، مثالاً على نظرة الفكر الصوفي إلى هذا الأمر، فها هو يقول: “الإنسانية تجمع الذكر والأنثى، الذكورية والأنوثية عرضان ليسا من حقائق الإنسانية” (۱۹). وهى في رأيى عبارة ذات أهمية كبيرة في مقابلتها بين فكرتي “عرض“، و “حقائق” أى أن التصوف في مخاطبته الإنسانية كجوهر، كحقيقة، كروح تتطهر توقاً إلى خالقها – من شأنه أن يمكن المرأة المتعبدة من الاستعلاء الروحى على المستوى الدنيوي، الذي يتشكل فيه البشر إلى أنثى وذكر، وتتحكم فيهم ممارسات اجتماعية ومفاهيم ثقافية قد لا تكون دائمًا عادلة، ويعزز شعورها بالجدارة، حسب معايير “حقيقية“، وليست “عرضية“.
وتذهب سعاد عبد الحكيم إلى أبعد من هذا عندما تصرح: “أن التصوف عبودية وكسر للنفس بشتى الرياضات، والمرأة تستقبل منذ تفتحها من الوسط المحيط وعبر التربية أنواع القيود. التصوف تأنيث علوى وتفريغ للقلب عن الأكوان، ووقوف بين يدى الرحمن” (٢٠). وهذا تفسير يشابه ما طرحته بعض الباحثات في الغرب، من أن التجربة الصوفية تأتى بيسر وطبيعية إلى النساء، باعتبار أنهن قد تخلين مسبقاً عن مزاعم الهيمنة والسيطرة في المجتمع الذكوري، وعن جزء كبير من ذواتهن (۲۱). إلا أن هذا التفسير عندما يربط بين معاناه المرأة القهر والإذعان في حياتها الأسرية والمجتمعية، وتحويل هذه المشاعر إلى تجربة التصوف والخضوع الإلهي، فيه حط من شأن زهد وتصوف النساء؛ حيث إنه لا يرقى بذلك إلى التصوف الخالص، للرجال الذين يسعون إلى حياة الروح والعبادة لأجلها، وليس بغية الخلاص والهروب من ظروف خارجية معينة، أو بدافع من أزمات نفسية وشعور بالقهر وفقدان السلطة. ولماذا نستكثر على النساء اعتبار عبادتهن تجسيداً لدرجة رفيعة المستوى، من الإيمان والنضوج والحكمة الروحانية/ الكشفية التي كفلتها لهن الحياة الإسلامية، مثلهن في ذلك مثل الرجال؟
لكي نستطيع الإجابة على بعض الاستفسارات، التي طرحناها حتى الآن يجب أن نتدبرها في ضوء معلومات تاريخية محددة، ملتفتات إلى التفاصيل التي قد تبدو عابرة – أكثر من الصورة العريضة. فهكذا يمكننا أن نلحظ، “أنماطًا معينة من السلوك، والتفكير في الروحانية النسوية، التي يمكن أن تحمل بذور التوعية والتحرر والتمكين للنساء والرجال معاً“، وهذا رأى ورد للباحثة “جوديث مارتن“، التي تتساءل في عنوان مقالتها : “لماذا تحتاج النساء إلى روحانية نسوية؟ (۲۲). وهى ترى أنه من حق النساء في المجتمعات الدينية المختلفة أن “يتوفر لهن السبيل إلى طاقة الدين المحررة (نفسياً وفكرياً)، الكامنة في نفوسهن“، وأن الوعى بتراث النساء الروحى، والدينى يهدف في النهاية إلى تحقيق التوازن التاريخي، والتساوى بين جناحي البشرية. وكما تقول باحثة أخرى أنه على الرغم من علمنا أن أدب سير القديسين والصالحين والمتصوفة (hagiography)، قد قام بكتابته المؤرخون من الرجال، ويعكس بالتالي نظرتهم إلى العابدات، ثم يحدد طبيعة التمثيل التاريخي لهن، إلا أننا يمكن أن نعتبر هذه الكتابات، مصدراً هاماً لبعض المعلومات والنتائج عن تجارب النساء الدينية، لو تعلمنا أن نقرأ بين هذه السطور التاريخية القليلة، ونستشف الكثير من المسكوت عنه في الماضي (۲۳).
ما يرد ذكره هنا هو نماذج لبعض التفصيلات المختارة من كتاب “صفة الصفوة“، لأبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزى، (۱۱۱٤ – ۱۲۰۱م)، الذى قال إنه كتبه مراجعة وتحسيناً لكتاب “حلية الأولياء“، للأصبهانى الذى سبقه، والذى “لم يذكر من عوابد النساء إلا عدداً قليلاً” (ج١، المقدمة ص ١٥). ولذا نجد بالفعل أنه قد أورد أكبر عدد من التراجم الزاهدات والعابدات المعروفات حتى وقته – وهو يطلق عليهن إما عابدات وإما مصطفيات. أول ما نلحظه في هذه التراجم هو ظاهرة تواجد وإقامة هؤلاء العابدات بالمساجد، في مكة والمدينة وبيت المقدس والموصل والكوفة وبغداد والبصرة وغيرها فترات طويلة تمتد إلى أيام وأسابيع، وظهورهن الواضح كجزء من الحيز العام لهذه الأماكن، فها هى “أم حيان السلمية“، من البصرة كانت “تقوم في مسجد الحى كأنها نخلة تقصفها الرياح يميناً وشمالاً” (ج ٢، ص ٢٦٤)، بل اعتادت النساء الجهر بالعبادة مثل الدعاء والتهجد بصوت مسموع، أثناء الطواف مثلاً أو البكاء المشهود والمناجاة… إلى آخره، مثل “نقيش بنت سالم“، (ج ۱، ص ٤٩٢) من مكة، فكان الناس يشاهدونها ويسمعونها، في الحرم تدعو وتناجى ربها، وكذلك “ملكية بنت المنكدر“، بالمدينة، و“حكيمة المكية“، بمكة. ثم نقرأ عن نساء يعتكفن بالمسجد ولا يفارقته إلا لقضاء حاجة أو لبعض الزاد، والبعض لهن أماكن أو ركن مخصص (حفش) بالمسجد للاعتكاف والتعبد، وقد قيل عن امرأة تسمى “بالسوداء” إنها “مستوطنة المساجد“. كما يحكي الرواة عن مشاهدتهم في “بيت المقدس نسوة كثيرة، عليهن مدارع صوف وخمر، معتكفات بالمسجد لا يتكلمن بالنهار” (ج ۲، ص ٤٢٨). وهناك أيضًا إشارات إلى رؤية إحداهن في “متعبد لها“، وكأنه محراب أو مصلى خاص، أو مكان آخر غير المسجد للعبادة، مثل “عجردة العمية“، وابنة “أم حسان الأسدية“، من البصرة (ج2، ص ٢٥٨ – ص ٢٧١)، كل منهما تتعبد في “محراب لها“، و“فاطمة بنت عبد الرحمن بن عبد الغفار الحراني“، من مصر التي كانت “لا تنام إلا في مصلاها بلا وطاء” (ج۲، ص ٤٨٦). ونفهم أن هذه الأماكن كانت في الغالب، أماكن مفتوحة لسائر العباد والزوار والمتبركين بهن، يأتون من بلاد أخرى في بعض الأوقات للتحقق، بأنفسهم من صحة الروايات وأسباب ذيوع شهرة هؤلاء العابدات. كما كانت بعضهن يتخذن لبس الصوفية المعروف، مثل الجبة أو مدرعة من شعر أو خمار من صوف.
عدد كبير من النساء كن يعتكفن ليلاً ويعقدن الحلقات أو المجالس نهاراً، لمقابلة من يتردد عليهن من الزهاد والمريدين، فيسألون عن أمور روحانية شتى ويتلقون الوعظ والإرشاد، ويحفظون أقوالهن ويشاهدون أحوالهن ليتناقلوها بعد ذلك، ونرى جموع الرجال تقصدهن خصيصاً لسؤال الدعاء، والتبرك ومراقبة صلواتهن ونهج العبادة والتأمل والاجتهاد، ثم النقاش في أمور الدين والتعبد. هناك مثل “رابعة العدوية“، وحواراتها المشهورة مع الصوفيين أمثال سفيان الثورى، ومالك بن دينار، والحسن البصري. و“شعوانة الأبلية” (ج2، ص ۲۷۹)، في فارس التي كان لها مجلس مشهور يرتاده العباد، وكانت محط أنظارهم واهتمامهم، عُرفت بكثرة البكاء وسيطرت عليها عاطفة الخوف والمحبة والاشتياق إلى الله (عز وجل). ثم “أم الدرداء“، – المذكورة سابقًا – التي روى عنها، أنها كانت تحب مجالس الذكر المعقودة في بيتها، وتقول لزوارها: “طلبت العبادة بكل شيء، فما وجدت أشفي لصدرى ولا أحرى أن أدرك منه ما أريد، من مجالسة أهل الذكر“، كما كانت “تحضرها نساء متعبدات يقمن الليل كله، حتى إن أقدامهن قد انتفخت من طول القيام“. أما “حفصة بنت سيرين“، من البصرة (ج۲، ص ٢٥٣)، فكان إذا شق على العباد شيء في القراءة، يسألونها ويستشيرونها كيف تقرأ، وكذلك “أم عيسى بنت إبراهيم الحربي“، بغداد التي كانت “عالمة تفتى في الفقة“، و “أمة الواحد بنت المعاملي“، دأبت “تفتى مع أبي على بن أبي هريرة“، وحفظت الفقه على مذهب الإمام الشافعي، والنحو وغير ذلك من العلوم (ج ١ ص ٦٤٠ )، و “مسكينة الطفاوية“، التي كانت تسافر من مقرها بالبصرة، إلى الأبله خصيصاً لتحضر مجلس “عيسى بن راذان” (ج ٢، ص ٢٦٨) فهي من “المواظبات على حلق الذكور“.
وكل هذا يفيد بأن الزهد والعبادة قد تحولا على أيدى هؤلاء النساء إلى علم، فكن بمثابة معلمات روحيات لم يعتزلن الجماعة كلية، بل كان لهن اتصال واضح ومتكرر وبأشكال مقبولة اجتماعية وغير مستهجنة أو مستغربة بالمريدين والزوار والأئمة الذين كانوا حريصين في كل وقت على الانتفاع و “التأدب” بكلام الوليات – كما يرد كثيراً في تعليق المؤرخين القدامي. و“الأدب” في التصوف هو “أن تعامل الله جهراً وسراً على وجه الصدق والإخلاص“، فيصير المرء “أديباً“، (حلية الأولياء، ص ۸). ومن هنا كان الاهتمام بمنزلة الأدب الروحي وقيم الصدق والإخلاص والتقوى والإحسان وخلافه، وشرحها وتطبيقها. فكان كثيراً ما يتوجه جموع العباد ليسألوا عن تعريف دقيق لمعنى إحدى هذه القيم والمقامات الرفيعة وفهمها، واثقين في علم وتفقه الزاهدات في هذه الأمور. وفي بعض الأحيان كان مجرد مراقبة سلوكهن التعبدي وبكائهن وورعهن قدوة ومشهداً للمعتبرين.
والأمثلة التي تشير إلى هذا الظهور في المجال العام والاتصال بأئمة وفقهاء العصر كثيرة. مثلاً “مضغة“، أخت بشر بن الحارث، من عابدات بغداد، وقد قال عنها ابن الحارث وهو نفسه من مشاهير الزهاد: “تعلمت الورع من أختى” (ج ۱، ص ٦٣٨)، ونقرأ أنها كانت تتردد على منزل الإمام أحمد بن حنبل، تجالسه وتجادله في أمور العبادة و“جوهرة البراثية” أيضًا من بغداد، يقول لنا الرواة، إنهم كانوا يزورون زوجها عبد الله بن أبي جعفر البراثي الزاهد، فكان هو يجلس على جلة (فرش) خوص، وجوهرة تجلس بحذائه على جلة أخرى مستقبلة القبلة (ج ۱، ص ٦٣٦). ومن عابدات اليمن “خنساء بنت خدام“، التي ذُكر أن طاوس بن كيسان، ووهب بن منبه كانا “يعظمان قدرها” (ج ۱، ص ٥١٠)، كما نقرأ عن “عائشة المكية“، أنها كانت من العابدات “ممن صحب الفضل بن عياض من التابعين” (ج ۱، ص ٤٩٣)، وهو أصلاً من خراسان ثم انتقل إلى الكوفة ثم مكة. وسفيان الثورى، بالكوفة الصوفي المشهور الذي اعتبره الأصبهاني، “عالم الأمة وعابدها“، فقد نشأ الزهد التعبدي على يده في الكوفة، معروفة لقاءاته المتعددة برابعة كما قلنا وزياراته لكثيرات من العابدات في وقته، مثل: “أم حسان الكوفية” (ج2، ص ١٠٩)، وهو الذى أكد لنا ابن الجوزي أنه كان ينتفع ويتأدب بكلام رابعة (المقدمة، ص ١٦)، و“فاطمة النيسابورية“، المذكورة سابقاً التي قال عنها نو النون المصري في كتاب ابن الجوزي، إنها كانت تتكلم في فهم القرآن وإنها “ولية من أولياء الله عز وجل وهي أستاذي” (ج ٢، ص ٣٣٤). و“أمة الجليل بنت عمرو” (ج ۲، ص ٢٦٤)، عندما اختلف العابدون في معنى الولاية، أجمعوا على أن يذهبوا إليها، وكانت منقطعة من طول الاجتهاد، ثم يقول الراوى: “وأنا يومئذ مع أصحابنا فاستأذنوا عليها، فأذنت فعرضوا عليها اختلافهم“. أى أن ذكر كثير من العابدات يرد مرتبطاً بمشاهير الزهاد المعاصرين، حيث كانت تتم اللقاءات وحلقات الذكر والدعاء وتبادل الشرح والتعريفات، دون أية إشارات من الرواة، إلى أن مثل هذا السلوك غريب أو غير مقبول. وهذه النماذج إنما تنفي فكرة الفصل بين الجنسين التي تأصلت في أذهاننا كظاهرة تاريخية قديمة جامدة وثابتة.
أما السيدة “نفيسة ابنة الحسن حفيدة الإمام على بن أبي طالب” (76۲ – ۸۲۳)، والتي انتقلت إلى مصر من الحجاز، وأقامت بها حتى توفيت، فنقرأ في سيرتها عن تردد الصوفية والأئمة عليها يسألونها الدعاء ويجالسونها مثل: بشرين الحارث، والإمام الشافعي، الذي كان “يعتقدها ويزورها“، وكان يصلى بها. ولما توفي أمرت بجنازته فأدخلت إليها، “وصلت عليه مأمومة في جماعة من النساء“. ولها مواجهة مشهورة مع أحمد بن طولون، عندما استغاث الناس من ظلمه وتوجهوا إليها يشكونه. وقفت في طريق ركبه ذات يوم ومعها رقعة مكتوب عليها تظلمات الناس، فأوقفته حيث ترجل وخاطبته، متهمة إياه بالقهر والعسف وقطع الأرزاق. وقيل إنه عدل وصلح حاله بعدها لفترة طويلة. وروى عنها أيضًا السخاوي في “تحفة الأحباب“، (بالهامش) كيف أنها كانت ولية عابدة وأيضاً عالمة، “تقرأ القرآن وتفسره” (ص۱۲۹)، وكان الإمام الشافعي عندما يحضر هو وأصحابه إلى زيارتها للتبرك والذكر: تأدبوا معها غاية التأدب” (ص ۱۳۱).
وهكذا استطاعت العابدات والوليات في التاريخ الإسلامي أن يحققن – من خلال إطلاق الطاقات الروحية الكامنة في نفوسهن – تحرراً إنسانياً على ثلاثة مستويات: الأول كما رأينا التحرر النفسي من التبعية أو العبودية لغير الله، والانفصال عن معايير اجتماعية وثقافية معينة لتعريف الذات والهوية، والرغبة في الاستقلالية (إلا عن الخالق)، والثقة والاعتداد بالنفس وبإنسانيتهن وذلك من خلال تعاملهن مع الله (سبحانه وتعالى) أولاً وأخيراً، تخطياً لمدار الذكر والأنثى حتى يرتفعن إلى مكانة تسقط فيها صور البشر الشكلية والبيولوجية. وكما ذكرنا سابقاً بدلاً من التأكيد على هوية أنثوية، منفصلة كان الإصرار على عبور كل المسافات الفاصلة بين إنسانيتهن (أو أنثويتهن) والله (عز وجل)، مما جعل خطابهن الروحي مبنياً على القرب الهائل من الله والحب الإلهى السامي، فنجحن في خلق نموذج وحدوى للعبادة يُدني البشر إلى الخالق، ويخلق التقدير المتبادل والتوازن بين الجنسين.
وثانيًا: استطعن أن يوجدن مساحة كبيرة من حرية الحركة والسفر والزيارة، والتعلم والمشاركة في الحياة الدينية، وأن ينتهجن أنماطاً من السلوك والمعيشة، فيها قدر كبير من التحرر من القيود التقليدية على تحركات النساء، والاختلاط بالحياة العامة. والزاهدات اللاتي اخترن الاعتكاف والوحدة معظم أوقاتهن، فهذا خيار فيه شجاعة وإرادة وينم عن عدم الحاجة دائمًا إلى سياق إنساني / اجتماعي يبرر وجودهن مادام العيش مع الله (سبحانه)، هو أهم مقاصدهن. المتزوجات منهن عشن واقع الزواج والأسرة، ولكن بقين خارجه في الوقت ذاته، العابدة الزوجة لا ترى تناقضاً أو صراعاً بين وجودها الظاهر والباطن، فهي تتحرك في مدار الهيكل الأسرى، منتمية إليه وليست جزءاً منه؛ موازنة دقيقة بين الخارج، وحياة الروح في الداخل، وهكذا تخلق نوعاً من الجدلية والتفاعل بين البُعدين، فالنظرة إلى الوجود شمولية وهي تمارس حباً سامياً شاملاً لا يعترف بتناقض أو ازدواجية. ونموذج “امرأة رياح القيسي“، حقاً يدعو إلى التأمل: فهى المتعبدة المحبة لله، تنظر إلى السماء تذكر الله وترتعد فرائصها، كانت إذا صلت العشاء تطيبت وتزينت وتسأل رياح: “ألك حاجة؟“، فإن قال: نعم، كانت معه، وإن قال لا، “قامت فنزعت ثيابها، ثم صفت بين قدميها حتى تصبح“، أى أحيت الليل بطوله بالصلاة والمناجاة. (صفة الصفوة، ج۲، ص ۲۷۱).
وعلى المستوى الثالث، تدل بعض تصرفات العابدات على التحرر السياسي والاقتصادي. فنموذج “السيدة نفيسة“، مثال على الجرأة، أو الرخصة التي يمكن للولية والصديقة، أن تكتسبها في تعاملها مع السلطة. كما هناك أمثلة كثيرة – لم يتسع لها مجال هذه الورقة – على تمسك الزاهدات بسبب تقشفهن، بالحصول على رزق حلال يطمئنن إلى مصدره الشريف، مثل التكسب من عمل أيديهن (من غزل أو بيع أو تجارة)، ورفض بشدة الهبات والمساعدات المالية، التي يقدمها بعض الأفراد دون مقابل، كإصرار إحداهن مثلاً، وكانت تغزل على سراج لها، انطفأ فأكملت الغزل على نور سراج آخر لا تملكه – على ألا تتكسب من الجزء المغزول على السراج الأخير، الذي لا يحق لها. ففي الاصطبار على شظف الحياة، والتمسك بالعيش على مواردهن القليلة، دون الاعتماد على من ينقذهن بالمال والجود فيه تخلص من التبعية الاقتصادية أيضًا للبشر.
من المشكلات التي نصادفها، في تاريخ سير هؤلاء العابدات، أن ذكرهن غير مدرج في كتب التاريخ الرسمي، التي تسلسل أحداث الدول والملوك والخلفاء. ولكن جاءت في كتب تراجم الصوفية والأولياء، منفصلة عن السياق والخلفية السياسية المحددة، وفي أغلب الأحيان كما ذكرنا غير مصحوبة بتواريخ الميلاد أو الوفاة. ومن هنا تنشأ صعوية ربط هذه السير بظروف أو سياقات تاريخية واجتماعية محددة. المشكلة الأخرى، تكمن في كم المادة التاريخية الموجودة عن النساء، وليس في نوعية السرد نفسه أو محتوى المادة. فلا توجد فروق جوهرية في نوعية الروايات أو أسلوب تقديم التراجم لدى الرجال أو النساء، ولكن نلحظ قلة عدد العابدات بالنسبة إلى الذكور والاختصار الشديد في تراجمهن، خاصة إغفال أسماء عناوين الكتب والآثار التي تنسب إليهن. فيقال مثلاً فلانة لها كتاب في النحو أو الفقه أو أن لها شعرًا كثيرًا، ثم السكوت عن أية تفاصيل أخرى. ولا نعرف هل يعكس هذا فعلاً ندرة عدد النساء الزاهدات، على مر العصور الإسلامية، أم عدم الاهتمام بالتدوين الكامل لمجموعهن وأعدادهن الحقيقية وآثارهن. هناك مثلاً حالة “أم هانئ الأنصارية“، الصحابية التي يرد ذكرها في “حلية الأولياء“، دون الإشارة إلى أى أثر شعرى لها، بينما نجد مخطوطًا بدار الكتب به قصيدة صوفية منسوبة إلى “أم هانئ المدنية رضى الله عنها” (٢٤). وغير واضح هل “أم هاني الأنصارية“، هي “المدنية” أم هما شخصيتان مختلفتان؟. ولكن هذا يعكس الهاجس الذي يتملكنا عن إمكان وجود مثل هذه الآثار الشعرية أو الصوفية في الماضي لنساء عابدات وصوفيات. ثم ربما ضاعت ولم تجمع أو أن سجل التراجم منقوص ولا يذكر دائمًا الآثار المكتوبة.
هناك نوع آخر من المصادر الذي نجد فيه بعض المعلومات، عن حياة النساء الدينية في القرون، التي تلت مثل كتب وصف الخطط والمزارات والمقامات والأضرحة والقبور، مثل “تحفة الأحباب“، المذكور سابقاً للسخاوى (ق۱٥)، الذي يصف فيه الكثير من المقامات وقبور الصالحات والشيخات والرباطات الموجودة بمصر، التي تملكتها وأدارتها النساء. مثل رباط “بنت الخواص“، الذي كان من أجل “الأرامل والعجائز ومجالس الوعظ والمقامات المشهودات ومواقف الزهد“، وأدارته هذه المرأة التي “كانت من الفضلاء، وزاهدة تلبس المرقعة الصوف” (ص ۱۷۹).
إلا أن من مثالب التأريخ لهؤلاء النساء في المصادر الأولى، التي ذكرناها (الأصبهاني، الغزالی، ابن الجوزي، الشعراني) هو الموقف السلبي، الذي نستشفه أحياناً في تعاملهم مع الموضوع على الرغم من المديح والثناء الظاهرين فعلى الرغم من أننا لا نلمس في تفاصيل السيرة والأخبار المروية نفسها استغرابًا لهذا السلوك أو إشارات أنه المفروض أن يقتصر على الرجال مثلاً، نجد أن ابن الجوزى في مقدمته يكتب أن “ذكر العابدات مع قصور الأنوثية، يوثب المقصر من الذكور” (المقدمة، ص ١٥). فغرضه تعليمي يستهدف الرجال أولاً، وهو رأى يعكسه أيضًا الغزالي، فيعتبر العابدات نماذج اجتهادية تعبدية يُحتذى بها. فعند مطالعة أحوال هؤلاء النساء يقول المرء لنفسه: “يانفس استنكفي أن تكونى أقل من امرأة، فأخسس برجل يقصر عن امرأة في أمر دينها ودنياها” (ج ٤. ص ۳۷۸). أي أن الغرض الأساسي تحفيز الرجال حتى لا يكونوا أقل شأناً من النساء.
ولا يزال حتى موقف بعض المؤرخين المحدثين غامضاً، مثل عمر رضا كحالة، في موسوعته “أعلام النساء” (١٩٥٩). مثلاً والتي يستمد مادتها من تلك المصادر الأولية. فنلاحظ أن عند عرضه لترجمة “السيدة نفيسة” يضيف كلمة “ربما“، عندما يكتب عن صلاة الإمام الشافعي بها، على الرغم من عدم وجود نبرة الشك هذه في التراجم الأصلية. كما يضيف أن الإمام الشافعي كلمها “من وراء حجاب” ( ج ٥، ص ۱۸۸). ومثل هذه التفصيلات أو الإضافات الصغيرة، تعكس التردد في التأكيد على ظهور النساء الملفت، في الحقب التاريخية الماضية.
وتعزو الكاتبة سعاد عبد الكريم، عدم حضور النساء الصوفيات في التاريخ المدون، إلى ذاتية المرأة وميلها إلى الانعزال، مما لم يشجع المؤرخين على تدوين كل شيء عنهن (ص ١٥). ولا أعتقد أن هذا يشكل عذراً مقبولاً لتقليص حجم الوجود التاريخي للنساء، وليس صحيحاً – كما رأينا – أن المرأة الصوفية العابدة كانت انعزالية تماماً، في نشاطها التعبدي أو راهبة. وبدلاً من :ذاتية المرأة“، (لأن لها إيحاءات سلبية وتستحضر التقابل بين ذاتية التصوف النسائي وعاطفيته، والتصوف الذكوري الفلسفي أو الفكري)، أفضل أن أرى في تصوفها تفجيراً لكل الطاقات الإنسانية الممكنة – عاطفة وفكراً وعملاً. ففي الواقع يبدو لنا أن المرأة المسلمة في هذه الحقب لم تمل إلى “ذاتية منعزلة” بطبيعتها ولكن إلى ممارسة التصوف في الحياة العملية، (أكثر من التنظير)؛ فهؤلاء المتعبدات قد عشن فعلاً الحياة الدينية والصوفية بأبعادها، دون انطواء أو رهبنة أو انكفاء على الذات، يبرر عدم الاهتمام التاريخي والثقافي بهن
نختتم هذه القراءة في تاريخ عابدات وصوفيات الإسلام بالتنويه، إلى إننا نأمل أن تكون هذه بداية مزيد من الدراسة في مجال التراث الديني والروحى للنساء، لإبراز الأدوار الفعالة التي لعبنها، وإستكشاف الفرص المتاحة لهن والممنوعة عنهن، والبحث عما إذا كانت التجارب الدينية والروحية قد أكسبت النساء في الماضى قدراً من السلطة أو النفوذ المؤثر في المجتمع، ثم تقصى تأثيرهن في تشكيل أو تكوين المعارف الدينية، والنشاط التعبدي على مر العصور.
وتلخص لنا الباحثة “أورسولا كنج“، الأبعاد التي يمكن أن يتضمنها أي مشروع لقراءة تاريخ النساء في مجال النشاط والعلوم الدينية – من وجهة نظر المرأة، كالآتي: البُعد الأول يرتكز على الجانب الوصفي البحت، الخاص بالكشف عن السير والأخبار والآثار والمساهمات، استرجاع أصوات النساء في بعض المصادر التاريخية المهملة وإبرازها. والبُعد الثاني هو البُعد النقدي/ السلبي، أى تقويض الأطر والافتراضات التقليدية التي من شأنها، أن تحجب عنا المغزى الكامل للمادة التاريخية تحت الدراسة. أما البُعد الثالث: الذي يليه وهو المتعلق بالمنظور النقدي/ الإيجابي، فهو إعادة بناء تجارب النساء في الماضي، وتفسير معناها ودلالتها بالنسبة إلينا في الحاضر، وإعادة فهم هذه العناصر التراثية وصياغتها لربطها بالوقت الراهن. أما البعد الرابع: لهذا المشروع التاريخى فهو الرؤية المنهجية الجديدة، التي تشجع على ذاتية وتعاطف الباحثة، وتضع في الاعتبار موقعها بالنسبة لموضوع البحث واهتمامها الشخصي به (٢٥).
وفي النهاية، كان الهدف من هذه الورقة عرض وإبراز أصوات منفردة مستقلة، لنساء في التاريخ الإسلامي المبكر، لعلنا نصل إلى فهم أعمق عن علاقة المرأة في الإسلام، بين الروحانية أو العاطفية الدينية من ناحية، والتحرر النفسي ومن ثم الاجتماعي من ناحية أخرى، وعن وسائل إثبات الوجود والجدارة، والتفاعل مع البشر على أرضية المساواة، التي اعتمدتها النساء في ظل الإسلام.
* أميمة أبو بكر: أستاذة مساعدة بقسم اللغة الإنجليزية، كلية الآداب، جامعة القاهرة؛ لها دراسات عن الأدب الصوفي. وهي عضوة في ملتقى المرأة والذاكرة.
1 – من أشهر هذه المصادر العربية: “كتاب البيان والتبيين“، للجاحظ (ق 9 م) طبعة القاهرة، ۱۹۸۳ – ١٩٨٤، و“حلية الأولياء“، لأبي نعيم الأصبهاني (ق ۱۱) القاهرة: مطبعة السعادة، ۱۹۳۲، ۱۰ أجزاء، و“إحياء علوم الدين” للغزالى (ق۱۱) طبعة القاهرة، ١٩٢٩ – ٤ أجزاء، “وصفة الصفوة“، لأبي الفرج ابن الجوزى (ق۱۲) الإسكندرية: دار ابن خلدون، ١٩٩٤ – جزءان، “وفيات الأعيان“، لابن خلكان (ق ۱۳) بيروت: دار الثقافة، (دون تاريخ)، و“الطبقات الكبرى” لعبد الوهاب الشعراني (ق ١٦) القاهرة: دار الفكر العربي، (دون تاريخ)، و“الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية” للمناوى (ق ۱۷) طبعة القاهرة، ۱۹۳۸ – تحقيق محمود ربيع. وكذلك: “تحفة الأحباب وبغية الطلاب في الخطط والمزارات والتراجم والبقاع المباركات“، لمحمد شمس الدين السخاوي (ق ١٥) القاهرة، مطبعة العلوم والآداب، ۱۹۳۷.
2 – يتتبع على سامى النشار في “نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام“، (القاهرة: دار المعارف، ۱۹۸۰، الطبعة الثامنة)، ج۳، تاريخ ونشأة هذه الطوائف والجماعات في الأقطار الإسلامية المختلفة، وتطور أفكارها وفلسفاتها، مستعرضاً أهم أعلام ورموز هذه المدارس الزهدية والصوفية في بداياتها خاصة. انظري الباب الثالث والرابع والخامس.
3 – ورد في عبد العليم أبو شقة، “تحرير المرأة في عصر الرسالة” (القاهرة: دار القلم، ١٩٩٥، الطبعة الرابعة)، ج ۱، ص ۳۱۲ – ۳۱۳.
4 – June O’Connor، “Rereading، reconceiving، and reconstructing traditions: Feminist research in religion،” Women’s Studies، 17 (1989) 101 – 123.
5 – سأورد هنا عدداً محدوداً فقط من الكتب في هذا المضمار كأمثلة:
– Judith Plaskow & Joan Arnold، Women and Religion (1974).
-Pat Holden، Women’s Religious Experiences: Cross Cultural Perspectives (1989).
– Sharma Arvind، Women In World Religions (1987).
– Sharma Arvind، Today’s Woman in World Religions (1994).
– Kari Borresen & Kari Vogt، Women’s Studies of the Christian and Islamic، Traditions (1993).
– Ursula King، Women and Spirituality : Voices of Protest and Promise. (1989).
– Ursula King، Religion and Gender (1995).
– Rita Gross، Feminism and Religion (1996).
6 – Kari Borresen، p. 277.
7 – سامی مكارم “عاشقات الله” (بيروت: دار صادر، ١٩٩٤) ص ١٧.
8 – المصدر السابق. ص ۱۹.
9 – على سامي النشار في “نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام” (ج ۳)، “ومارجريت سميث“، في “رابعة العدوية: المتصوفة“، وعبد الرحمن بدوى في “شهيدة العشق الإلهي“.
۱۰ – سامی مكارم، ص ۲۰.
11 – Nelly et Laroussi Amri، Les Femmes Soufies (France: Editions Dangles، 1992).
١٢ – المصدر السابق، ص ٤٥.
۱۳ – انظرى أعمال باحثة العصور الوسطى “كارولين ووكر باينم“.
(Caroline Walker Bynum)
ومقال:
Karma Lochrie، ” The Languge of Transgression: Body، Flesh، and Word In Mystical Discourse،” In Allen Frantzen، ed. Speaking Two Languages (Albany: State University N. Y. Press، 1991).
١٤ – ورد في :
Annemarie Schimmel، Mysical Dimensions of Islam (Chapell Hill: Univ. of North CarolinaPress، 1997)، p. 427: ” Women in Mystical Islam ” Women’s Studies Int. Forum، vol. 5، no. 22 (1982)، 145- 151.
-
– فريد الدين عطار، “تذكرة الأولياء ” ق (۱۳)، ترجمة:
A. J. Arberry، Muslim Saints and Mystics (London: Routledge & Kegan Paul، 1966)، p. 174.
١٦ – أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي، “صفة الصفوة” (الإسكندرية : دار ابن خلدون، ١٩٩٤)، ج۲ ص ٢٦٦. سائر الأمثلة المأخوذة من هذا المصدر ستذكر من الآن فصاعداً بين قوسين في نص الورقة.
17 – Schimmel، p. 428.
۱۸ – سعاد عبد الحكيم، “المرأة بين الصوفي والتصوف” في “عاشقات الله“، ص ۱۲.
19 – المصدر السابق، ص ۱۲.
20 – المصدر السابق، ص ١٤.
21 – Nancy Falk & Rita Gross. Unspoken Worlds: Women’s Religious Lives in Non – Western – Cultures (San Francisco: Harper & Row، 1980).
22 – Judith Martin. “Why Women Need a Feminist Spirituality،” Women’s Studies Quarterly، 21 (1993)، 106 – 120.
23 – Kari Borresen، p. 42.
٢٤ – دار الكتب المصرية، ٤٧٨ مجاميع (فهرست التصوف)، ميكروفيلم ۱۰۱۲۷.
25 – Ursula King، Religion and Gender (Oxford: Blackwell، 1995)، p. 27، 28.