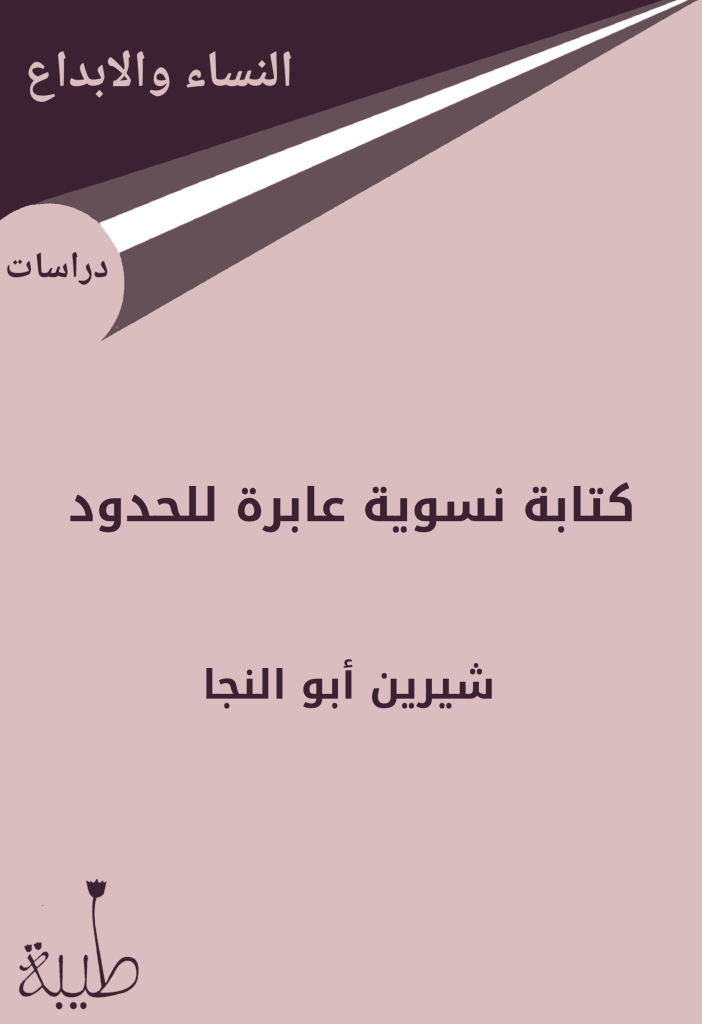كتابة نسوية عابرة للحدود
شيرين أبو النجا*
الحدود: “يقول أبي بأن الله عندما خلق الأرض وما عليها فصل بين النساء والرجال، وشق بحرا بكامله بين النصارى والمسلمين، ذلك بأن النظام والانسجام لا يتحققان إلا إذا احترمت كل فئة حدودها، وكل خرق يؤدي بالضرورة إلى الفوضى والشقاء. غير أن النساء كن مشغولات باختراق الحدود، مهووسات بالعالم الموجود خارج الأسوار، يتوهمن أنفسهن طيلة النهار متجولات في طرق خيالية. وخلال تلك الفترة كان النصارى يجتازون البحر تباعا زارعين الموت والفوضى” (1). كان ذلك الحين لا يزال المغرب يرزح تحت نير الاستعمار. ولكن يبدو أن الأمر لم يتغير كثيرًا، فلا زلنا مغرمين بالحدود والتقسيم والتصنيف، نطمئن عندما نرى عنوانا يندرج أسفله ما نريده، لنتمكن في النهاية من رصد سمات مشتركة لجنس أدبى أو لجيل معين. فى الجامعة أيضًا يطلبون مني أن أحدد التخصص وألا أحيد عنه، فإذا كنت قد حصلت على الدكتوراة في الشعر لا يجوز أن أنتهك الحدود وأدرس الرواية. وإذا كانت المرأة تكتب فكتابتها توصف بالضرورة أنها “نسائية” بغض النظر عن خواء هذا المصطلح من أية دلالة. حافظ التاريخ العربي دائما على تلك الحدود التي اختلفت أشكالها، وصلتنا أخبار المحاربين والأبطال والملوك والشعراء، وسقطت سهوا أشياء بسيطة، مثل الفقراء والنساء، فكان لابد أن تبدأ الأبحاث المكثفة التي ترصد أسماء أخرى كثيرة بجانب الخنساء، شاعرات أخريات وفقيهات، ومحاربات، وكاتبات، وملكات، ومغنيات، وعالمات وطبيبات. وكان بالتالى لابد لكل مقال أو بحث أو حتى ورقة في مؤتمر تتناول الكتابة النسوية أن توجد لنفسها أصلاً وفصلاً وتاريخًا وجذورًا وبداية تستمد منها مشروعية الوجود. لذلك لم يكن غريبا أن تتناول رواية “الباب المفتوح” للراحلة لطيفة الزيات والتي ظهرت عام 1966 الصراع بين الحدود، بين الحضور والغياب، هو الصراع بين تواجدها كامرأة في العام والقيود المفروضة عليها في الخاص ليتواشج كل ذلك مع الإستعمار الإنجليزي الذي يتحول إلى سند آخر يدعم القيود على النساء، باختصار، كانت بطلة “الباب المفتوح” تحاول اختراق الحدود لتشارك فيما يحجبه الباب. أوضحت “مليكة المقدم” الكاتبة الجزائرية الصراع نفسه في روايتها “المهاجرون الأبديون”، حيث كان الاحتلال الفرنسي ذريعة لتشديد القيود على النساء. تساهم هذه الحدود في اشعال صراع على “الوجود” الذي تحوله سياسات المجتمع إلى الشكل المناقض: “الغياب”. كانت إحدى أشكال إعادة التواجد هي الكتابة، وكان الحل السريع لهذه المحاولة هو جمع هذه الكتابات وحفظها في خزانة حملت لافتة “كتابة المرأة” أو “أدب المرأة” وفي أحسن الأحوال “الكتابة النسائية”. خزانة ضيقة تبطن ولا تظهر، تصنف وتقسم وترسم حدودًا تمنع الفتنة. انعكست هذه الحدود على المشهد النقدي مباشرة، فكان في البدايات هناك الاحتفاء والاحتفال بأي كتابة نسائية بغض النظر عن جودة العمل ومستواه الفنى وهو ما أثار حفيظة الكتاب من ناحية وأغرى العديد من المؤسسات الغربية بترجمة العديد من تلك الأعمال التي كان بعضها ليس إلا مزج ما يقترب من الخواطر مع خطاب يتناول الجسد بشكل صادم لم يعتده المجتمع العربي من قبل. وهكذا ولدت الكتابة النسائية طفلاً منبوذًا. كان الناقد الذي يحتفى بمثل تلك الأعمال يرى أنه من الواجب أن “يشجع” تلك الكتابة وأن يربت على كتفها بحنان، وقد أنجزت الشاعرة والباحثة “ظبية خميس” بحثًا حصرت فيه الأوصاف النقدية التي تستخدم للحديث عن تلك الكتابات فهي على سبيل المثال لطيفة، رقيقة، حنون، ناعمة، هامسة، أنثوية بحق، تموج بالمشاعر الجياشة، إلى آخره من تلك الصفات التي لا يمكن أن نسمعها عندما ما يتعرض الناقد للحديث عن عمل لأديب مبدع. ولتكتمل الصورة النمطية لهذا النوع من الكتابة، سادت فكرة أن المرأة دائما ما تخوض في “هموم الذات الأنثوية”، أما الرجل فهو بالطبع يخوض في هموم المجتمع وما يؤرقه من سياسات فاسدة، وبذلك تم تكريس الفصل بين كتابة المرأة وكتابة الرجل عبر الخطاب النقدي الذي عاد ليصرخ الآن مرة أخرى أن كتابة المرأة ليست منفصلة عن المجتمع. كان من الطبيعي إذن أن ترفض الكاتبات هذا المصطلح الذي أصبح سيء السمعة بشكل أو بآخر، وقد أوضحت الباحثة “رشيدة بنمسعود” خلفية هذا الرفض في كتابها “المرأة والكتابة” (2). وهكذا ترسخت الحدود بشكل أكثر رسوخًا بين العمل الإبداعي والسؤال النقدي، بين الأدب وأدب المرأة.كيف نعبر الحدود التي تفصل بين أدب المرأة والأدب؟ كيف يمكن للسؤال النقدى أن يتجاوز الأسلاك الشائكة التي صنعها بنفسه في البداية، والتي تضع أدب المرأة في خانة ضيقة وتؤشر عليها في محاولات دائمة لإيجاد سمات مشتركة أو حتى أي جماليات متميزة. ليس من الصالح الأدبي الاحتفاء بهذه المنطقة المسورة، لأن الفصل يعرض نفسه فعليا بجميع الأشكال في الخطاب الديني والمجتمعي والسياسي، ولا يمكن أن يتبعهما الخطاب النقدي. كيف يصيغ النقد رؤية للنص النسوى تجعله عابرًا للحدود النقدية الجامدة؟
أولا: “أدب المرأة” كمصطلح إشكالي:
لنعيد النظر في هذا المصطلح الذي لا يحوى أي دلالة سوى تلك المرتبطة بجنس بيولوجي بحت تمامًا مثل كلمة “الرجل”. ساهمت العديد من الأدبيات في إضفاء دلالات على هذا المصطلح عبر إطلاق جملٍ يقينية حاسمة تشبه لغة البيانات السياسية التي لا تضيف للمعنى، فقط تضيف مزيدًا من الرطانة التي لا تصف الواقع بقدر ما تعيد إنتاج صور عقلية، من قبيل: المرأة مقهورة، المرأة مقموعة (وهو ما يكرس المرأة الضحية في تجاهل تام لكل استراتيجيات التكيف وآليات المقاومة التاريخية واليومية)، وهناك الحديث عن “وضع المرأة” و “قضايا المرأة” وأخيرًا “أدب المرأة”. لنفكر في الأمر بشكل مدرسي قليلا: بالتأكيد هناك اختلاف بين نساء “علوية صبح” اللبنانية في روايتها “مريم الحكايا” وبين نساء “حنان الشيخ” اللبنانية أيضًا في رواية “مسك الغزال”. كما أن الاختلاف واضح بين امرأة “ليلى أبو زيد” المغربية في رواية “عام الفيل” وبين امرأة “سلوى بكر” المصرية في “كل هذا الصوت الجميل”. ويتضح الاختلاف المعرفي والأنطولوجي في سردية “الخباء” لميرال الطحاوى و”المهاجرون الأبديون” “لمليكة المقدم”. إذا أشرنا لكل هذه الأعمال بمصطلح “أدب المرأة” فإننا نلغى بمنتهى البساطة عامل الطبقة والعرق والمكان والخبرات الشخصية والظرف السياسي والمؤشر التقتصادي. فامرأة مرحلة ما بعد الاستقلال المغربية في “عام الفيل” لا تشبه نظيرتها المصرية في “الباب المفتوح”. ففي رواية “عام الفيل” لعبت الطبقة الدور الرئيسي في صناعة الأحداث ولم يكن مصير تلك المرأة مشابها لمصير امرأة “صبيحة خمير” التونسية في رواية “غدا يأتى المستقبل”، يمكن أن نطرح الأمثلة إلى ما لا نهاية لنؤكد أهمية العديد من العوامل التي يتم إغفالها عبر اختزال الأمر كله في عامل الجنس البيولوجي.
ثانيًا: موقع الذات:
إذا اتفقنا أن الرواية النسوية تموضع الذات في علاقتها بالطبقة والنوع والتاريخ فهذا يعني أنها تنتج مفاهيم مغايرة وبديلة للذات المتعارف عليها، تلك الذات المتماسكة الكاملة العارفة التي تنتج الإبستمولوجيا الخاصة بها في تسلسل زمني مرتب لا يحوى فجوات أو ثغرات. إنها الذات التي تطرح قصتها كاملة غير منقوصة، متعمدة التعتيم على الفجوات والانقطاعات التي تعكس المسيرة الحقيقية للذات المتشرذمة بالضرورة. تؤكد شارى بنستوك في مقالها الشهير أن هذا يرجع إلى يقين الكاتب من سلطته على النص وقدرته على السيطرة عليه وتقول: “ليس غريبًا أن الذين يتمسكون بهذه الفكرة هم الذين يمثلون السلطة في ظل القانون الرمزي وليس غريبًا أن الذين يساءلون هذه السلطة هم الخاضعون لها…النساء” (3). الرواية النسوية لا تدمر الذات ولكنها تضعها في سياق، بمعنى أنها تعترف بأيديولوجية الذات في علاقتها بالسياق ومن هنا يتم إنتاج بدائل. الذات النسوية لا تلتزم بهذا الثبات بل هي توظف فضاء النص للمراجعة والتفاوض مع كل الثوابت وهو ما يخلخل هيمنة ذات أبوية استمدت قوتها من أعراف وتقاليد وتضامن دائم من القارئ. ويتجلى هذا أكثر ما يتجلى في تقنية البوليفونية، أي تعدد الأصوات في النص، مما يدفع القارىء إلى إعادة النظر في الرؤية الأحادية. إنها الرغبة في إزاحة الحدود وخلق مساحات استيعاب مغايرة، كما تقول الناقدة النسوية الايطالية تيريزا دي لوريتيس: “إن الفاعل يشتبك في السرد مع مواقع ذوات أخرى ومع الرغبة” (4)، هو إذن ليس فنا من أجل الترف أو “الفضفضة” بمقدار ما هو تعبير عن رغبة دفينة في هدم الحواجز واختراق الحدود الأبوية الصارمة من أجل التواصل وبهدف تحويل الغياب إلى حضور.
وتعد إعادة قراءة التاريخ أحد أشكال التفاوض مع الذات الأبوية المهيمنة كما فعلت رضوی عاشور في ثلاثية “غرناطة” وأتاحت لسليمة فرصة إعادة قراءة ثقافة بأكملها، والقراءة هنا كانت بالمعنى الحرفي والمجازي. وبشكل مختلف قليلاً وعبر استخدام تقنية العثور على صندوق يحوى مفردات التاريخ قامت أهداف سويف في “خارطة الحب” باعادة قراءة التاريخ ومثلها فعلت سلوى بكر في “كوكو سودان كباشي”. لم تهمل بثينة خضر مكی السودانية تاريخ النهر وساكنيه أيضًا في “صهيل النهر”. قد تكون العائلة بكل ثقافتها وسياساتها هي الدافع الأول لإعادة النظر في كل الثوابت مثلما فعلت منصورة عز الدين في “متاهة مريم” وحنان الشيخ في “حكايتي شرح يطول” وآسيا جبار في “أخت شهرزاد” والعديد من الروايات الأخرى التي اتخذت من العائلة والقبيلة- كما في “الخباء”- مرتكزًا لإعادة التفاوض مع ثقافة اعتنقت فكرة “لاتعلموا بناتكم الكتابة”. أنتجت هذه الروايات ذاتا إما متمردة أو متفاوضة أو حتى منتقمة من العائلة مثلما ظهر في “العربة الذهبية لا تصعد إلى السماء”، وذلك في محاولة لنحت مساحات أخرى مغايرة لما هو مهيمن وسائد. لم تتجاهل الرواية النسوية موقع الذات في الحروب والانتفاضة ومراحل ما بعد الاستقلال، فقد كان الخطاب القومي التحرري دائما ما يخذل النساء بل ويهمش وجودهن ويبدأ بتصفية كل حساباته معهن. وبالطبع تمثل رواية “عام الفيل” قمة هذا الغبن، وتعددت أشكال الخذلان في “مريم الحكايا” والتي لخصتها ابتسام، المناضلة السابقة، في قولها: “هل رآنا المناضلون مومسات مستوردات في علب ثورية جاهزة…؟ هل حين ينهزم الإنسان، ينهزم في السياسة والحب وفي كل الأحلام؟ لماذا نحن النساء صدقنا ثم انكسرنا ونحن نحاول أن نكتشف مساحات أخرى وفضاءات جديدة لأحلامنا وأجسادنا ومشاعرنا؟ هل حصدنا خيبات مضاعفة عن خيبات الرجال، الذين صدقنا أنهم متحررون ويريدون الحرية لنا ولهم، وهم في الحقيقة لم يكونوا سوى… نماذج كاريكاتورية لهارون الرشيد الثوري؟” (5)، وهناك “أروقة الذاكرة” لهيفاء زنكنة الكردية حيث يتعمد الجلاد أن ينتهك جسد المرأة لإشعارها بالعار، و”سيرة الرماد” لخديجة مروازي المغربية، و”الغلامة” لعالية ممدوح العراقية. وقد جاءت قمة الخذلان في رواية “تاء الخجل” لفضيلة الفاروق الجزائرية حيث تحولت النساء إلى حلبة الصراع بين السلطة وبين جبهة الإنقاذ الاسلامية، ظهر استغلال كل أطراف الصراع لجنس المرأة البيولوجي، حتى العائلة التي تقرر دائمًا التخلى عن النساء بسبب انتهاك الجزء البيولوجي الذي تختزل فيه النساء.
ثالثًا: الأرضية المعرفية التي تنبع منها الرواية النسوية:
كيف يسافر النص النسوي ليعبر الحدود ويتضامن ويتواصل ويتصل دون أن يهجر المحلى والآني؟ كيف يحدد اختلافه على أساس مغاير لفكرة البيولوجي؟ هل هو الموقع الجغرافي أم هي اللحظة التاريخية؟ كيف يكتب “في” و “ضد” المحلي؟ كيف يوظف العولمى لصالح المحلي؟ كيف يهزم بهذا التواشج المقولات الغوغائية التي تضعه في خانة “الكتابة المستوردة”؟ يعبر النص النسوى الحدود موظفًا آنية ومادية الصراع، بمعنى أنه يقيم متصلاً بين الشخصي والعام. وهو المتصل الذي يخلخل الرؤية الثابتة السائدة وينتج مواقع متعددة ومتنوعة للصوت السردي. فامرأة “عام الفيل” تتماثل مع امرأة “المحبوبة” لتوني موريسون وامرأة “اللون القرمزي” لأليس ووكر، معاناة ما بعد الإستقلال (كل المناطق التي كانت ترزح تحت نير الاستعمار ثم حصلت على استقلالها، أو حتى تلك التي لا زالت تعانى منه) أو انهيار الأحلام ما بعد التحرر هي العامل الذي يضمن للذات النسوية استمرارية مستمدة من مواقع مختلفة، استمرارية تستمد مصداقيتها من توحد الصراع وليس من اللون مثلاً أو العرق أو الدين أو القومية. فامرأة “أطياف” لرضوى عاشور تماثلت مع امرأة “الفصل الأخير” لليلي أبو زيد في مواجهة فساد استشرى وانتشر في ثنايا المجتمع، وهو الفساد الذي يؤشر على إنهيار الحكومات الوطنية كافة في مرحلة ما بعد الاستقلال، إنها الاستمرارية التي تخلق “مجتمعات متخيلة” على غرار مجتمع بندكت اندرسون هذا الصراع ضد الأبنية والأنظمة المستغلة هو الذي يحدد التشابه والتضامن في النص النسوي، فقد سافرت فتاة “الرواية” لنوال السعداوي من مصر إلى أسبانيا لتدرك أنها تصارع نظامًا أبويًا مستغلاً بأكمله في كل مكان، أما نساء فاطمة المرنيسي في “نساء على أجنحة الحلم” فقد وجدن في أسمهان المهمشة ضالتهن وأحلامهن أكثر من أم كلثوم. انضمت أيضًا أسماء هاشم القادمة من جنوب مصر للتضامن على أساس الصراع في “المؤشر عند نقطة الصفر”، فقد روت مأساة فتاة من أسوان منعتها الأعراف والتقاليد من الحب خارج القبيلة، تمامًا كالبنجالية مونيكا على في رواية “بريك لين” التي تشردت فيها الأخت لأنها أحبت من خارج القبيلة. حتى كارول شيلدز الكندية في روايتها “إلا إذا” وجدت ما يصل بين ابنة الراوية التي هجرت المنزل لتجلس على الرصيف ترفع لافتة مكتوب عليها “الإحسان” وبين المرأة السعودية التي أشعلت النار في نفسها. هكذا تتغير المواقع وتتعدد وتتشكل بفعل عدة عوامل ما يمكن النص النسوى من تجاوز موقع جغرافي ينهل منه خبرته ليتواصل مع خبرات أخرى مغايرة سياسيًا وجغرافيًا، وبهذا تتحكم سياسات الجيوبوليتيكس في الصوت السردي وتأخذه بعيدًا عن المفهوم البيولوجي. الأمر ليس مقتصرًا على ثنائية قامع ومقموع، فأشكال القوى والهيمنة متعددة وهي تتقاطع لتموضع النساء بشكل مختلف على مدار التاريخ، وهي في الوقت ذاته تصر على فاعليتهن المعارضة، وهو ما يعني أن الطبقة واللون والجنس والنوع لا تؤدى إلى النتائج نفسها في المكان نفسه. ومن هنا يصبح النضال السياسي في انطلاقه من المحلى والشخصى هو السمة المؤكدة التي تضفى على النص نسويته، على هذا الأساس تشابهت نساء حنان الشيخ في “إنها لندن يا عزيزي” مع نساء عالية ممدوح في “المحبوبات”. والأمر لا يقتصر على الأدب فقط بل إن هذا التواصل هو ما حكت عنه سهى بشارة في سيرتها الذاتية “مقاومة” حين تواصلت الشيوعية والإسلامية على أرضية النضال المشترك ضد الصهيوني، وهو حديث يطول إلا أنه ليس موضوع الورقة.
رابعًا: تقنيات عبور الحدود:
في شهادة لها نشرت بمجلة “مشارف”، تقول الكاتبة الكردية هيفاء زنكنة: “أتوق إلى كتابة تختفى فيها الحدود الفاصلة ما بين نمط أدبي وآخر. فضاء تلتقى فيه الأجناس الأدبية، بلا خطاب سياسي مباشر أو إلقاء للمواعظ أو إطلاق للأحكام الأخلاقية على الآخرين”. إن الرغبة في إزالة الحدود الفاصلة بين الأنواع الأدبية هي رغبة في إزالة العلاقة المتوترة بين النوع الأدبي والجندر التي تحدث عنها دريدا حين قال إن النوع يتضمن “معنى الاختلاف الجنسوى بين الذكر والأنثى، بين النوع الأدبي والنوع الجنسي”. عبر انتهاك النوع توسع الكاتبة من الفضاء المتاح لها، فاذا يمكن أن نسمى النص الذي كتبته رشا الأمير اللبنانية بعنوان “يوم الدين”، هل هو رواية كما يشير الغلاف، وكيف نفسر التحليل الأدبي لشعر المتنبي الذي يموج به النص؟ وماذا عن أحلام مستغانمي الجزائرية التي كتبت عن الكتابة في “فوضى الحواس”، وماذا عن ميرال الطحاوي التي جعلت من الخباء أرشيفا لثقافة بدوية كاملة، وماذا عن رجاء عالم السعودية التي قالت كل ما تريده في الهامش دون أن تقوله في المتن في رواية “حبى”؟ وماذا عن “تقارير السيدة راء” لرضوى عاشور، هل هي رواية أم سيرة حياتية؟ لقد استوعبت الكاتبات معنى مقولة جاك دريدا حين أكد أن مقاربة النوع تعنى نهايته، ففتحن النص على مصراعيه لكل الأنواع، منتهكات بذلك كل الحدود التي تحدد استجابة المتلقى وتستبعد أية ردود فعل غير مرغوب فيها. تنتشر الذات النسوية في جنبات النص مفسحة مكانًا لأصوات أخرى ونصوص سابقة، وبذلك تطرح نفسها كنوع أدبي يستعصى على التصنيف، نوع أدبي يكتب ويقرأ العالم من خلال رؤية تستوعب ما قد يبدو متناقضًا أو متشظيًا أو ملغيًا من الذاكرة، نوع أدبي لا يدل على شيء ولكنه يدل على نفسه ويشير إليها عبر اللغة. هي نصوص كتابة كما يقول رولان بارت وليست استكتابًا. اللغة فيها غاية، ليست وسيطًا تعبيريًا بل هي في حد ذاتها فعل لازم غير متعدٍ، هي الفعل المتمرد نفسه الذي يساءل خطاب تصنيف الأنواع ويهدم الحدود عبر امتصاص نصوص مختلفة. ولذلك ليس غريبًا أن نجد الكاتبة تكتب عن نفسها ككاتبة، كما فعلت رضوى عاشور في “أطياف” وفضيلة الفاروق في “تاء الخجل” ونوال السعداوي في “الرواية” وعلوية صبح في “مريم الحكايا” وسحر الموجي في “دارية” وليلي الجهني في “فردوس اليباب” وسمية رمضان في “أوراق النرجس”.
أخيرًا: السؤال النقدي:
لا يقلل التواجد الأدبي لذات أنثوية أدبية عابرة للحدود من حدة الخطاب النقدي العربي بشكل عام الذي يحمل في ثناياه الاتهام بالعمالة والتبعية، فهو خطاب مغرم بالانحراف دائمًا عن جوهر الموضوع، عن النص وأدبيته، عن تفكيكه وقراءته. هو خطاب لا يرى سوى أن النص الأنثوى هو إلهاء عن محاربة الإمبريالية ووسيلة لتجاهل الطبقية، خطاب لم نسمعه حينما كتب نجيب محفوظ “بداية ونهاية” أو حينما صدرت “أصوات” لسليمان فياض. وهما روايتان تموجان بعالم النساء وتقومان عليه.
ورغم أن كل هذه النصوص التي ذكرت كأمثلة وغيرها تقدم ذاتا نسوية جديدة على مستوى فاعليتها واشتباكها مع ذوات أخرى، وعلى مستوى مفهوم الحرية- ذاك المفهوم الذي تغير كثيراً منذ أواخر القرن الماضى وتغير معه مفهومي الأنوثة والذكورة- وعلى مستوى الانتهاك المستمر لحدود الجنس الأدبي، وعلى مستوى إعادة قراءة التاريخي والسياسي، إلا أن الخطاب النقدي المشتبك مع هذه النصوص لا يزال محتفظاً بحدوده الصارمة التي لم تعد ملائمة للحيز الأدبي الحاضر الذي تشكل فيه هذه النصوص جزءًا لا يستهان به يتفاعل مع القارىء ويؤثر فيه ويتأثر به.
*أستاذة بقسم اللغة الإنجليزية، جامعة القاهرة وباحثة مهتمة بقضايا الجندر.
1) فاطمة المرنيسي، نساء على أجنحة الحلم. الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، 1998، ص 9.
2) رشيدة بنمسعود، المرأة والكتابة. الدار البيضاء: أفريقيا الشرق، 1994.
3) Shari Benstock. “Authorizing the Autobiographical”, in Rolyn R. Warhol and Diane Price Herndl (eds.) Feminisms. USA: Rutgers UP, 1991, p. 1041
4) Teresa de Lauretis, Alice Doesn’t: Feminism, Semiotics, Cinema. Bloomington: Indiana UP, 1984, p. 68.
5) علوية صبح، مريم الحكايا. بيروت: دار الآداب، 2003، ص 80.