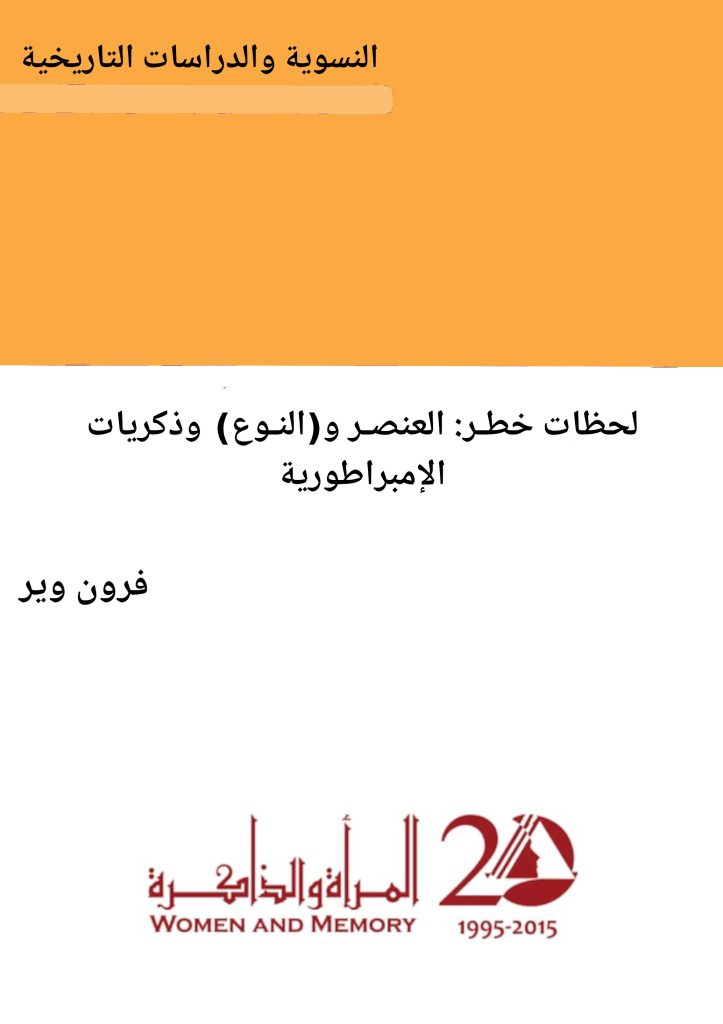لحظات خطـر: العنصـر و(النـوع) وذكريات الإمبراطورية*
أن نُعبر تاريخيًا عن الماضي لا يعني أن نتعرف عليه “كما كان حقيقة“، وإنما يعني أن نمسك بذكرى تومض في الخاطر عند لحظة من لحظات الخطر.1
أخذت هذا المقتطف الوجيز من مقالة وولتر بنجامين Walter Benjamin بعنوان “أطروحات في فلسفة التاريخ” (“Theses on the Philosophy of History”) وقمت باستعارة صوره المفعمة بالحيوية، بوصفها وسيلة تقديم لمقولتي بشأن العنصر وعلاقته بـ (النوع) في الذاكرة التاريخية، لقد اجتذبتني على الفور هذه العبارة لأن فعل الإمساك بذكرى ما ينقل شيئًا من إلحاح الضرورة الذي شعرت به وأنا أقوم بكتابة ما بعد حدود المسموح به Beyond the Pale.2 كما أن عبارة “لحظة خطر” أثارت اهتمامي هي وإمكانات اختطافها لاستخدامها في استكشاف الأمور التي تشغلني بشأن سياسات العنصر و(النوع) المعاصرة، والتي تمثل منطقة مشحونة بتوترات من نوع أو آخر.
ينشأ هذا المقال من حرصي على فهم الكيفية التي تم بها في الماضي إنشاء فئات الاختلاف العنصري ((racial والعرقي (ethnical) والثقافي؛ وبخاصة بين النساء، وذلك في سبيل استكشاف كيفية استمرار إعادة إنتاج هذه الفئات في إطار صراعات سياسية وأيديولوجية أحدث زمنًا.
ويتضمن هذا المشروع بالضرورة النظر في الطرق التي قد تعامل بها – حتى الآن – التأريخ النسوي (feminist historiography) مع قضايا الاختلاف. وبعبارة أخرى، هل قام “تاريخ النساء” بتزويد النسوية بأدلة نظرية أو تاريخية تكفي لفهم معنى الأفكار والتصورات المتعلقة بالاختلاف العنصري والثقافي، في الوقت الحالي؟ تتمثل إجابتي عن هذا السؤال في أن النظريات النسوية المتعلقة بكتابة التاريخ كانت – حتى عهد قريب جدًا – تميل إلى التركيز على قضايا (النوع) وارتباطها بالطبقة، مما كانت نتيجته إغفال قضايا العنصر. فعلى سبيل المثال، كتبت جون سكوت Joan Scott في عام 1988:
إن تحقق الإمكان الراديكالي في تاريخ النساء يأتي عبر كتابة تواريخ تركز على تجارب المرأة مع تحليل الطرق التي يُنشئ بها (النوعُ) السياسة والسياسة (النوعَ). وعندئذٍ لن يكون التاريخ النسوي تعديدًا للأعمال العظيمة التي قامت بها النساء، وإنما كشفًا لعمليات (النوع)، التي غالبًا ما تدور في صمت وخفية، والتي تمثل – مع ذلك– قوى حاضرة ومحدِّدة في تنظيم معظم المجتمعات. بهذا المدخل يمكن لتاريخ النساء أن يواجه بشكل فاصل سياسة الكتابات التاريخية القائمة، ويبدأ بصورة حتمية في إعادة كتابة التاريخ.3
لا أعني بذلك أن سكوت نفسها قد أغفلت مسائل “العنصر” في نقدها لسياسة الكتابات التاريخية القائمة أو وصفها الإجمالي لـ “الإمكان الراديكالي في تاريخ النساء“، وإنما بالأحرى يمكن لعبارتها الوصفية “العمليات التي غالبًا ما تجري في صمت وخفية” أن تطبق بالقدر نفسه على أنواع أخرى من العلاقات الاجتماعية إلى جانب (النوع)، ولم يكن لزعمها إلا أن يزداد قوة لو كانت قد أشارت صراحة إلى “العنصر” والعرق بوصفهما أنواعًا أخرى من “القوى المشكلة” في حياة النساء.
ومع أنني أكتب عن التاريخ البريطاني بالتحديد، وألتفت إلى التأثيرات حديثة العهد نسبيًا لحركات الاستعمار والتحرر من الاستعمار، فإنني أقصد من كتابتي – في خطوطها العامة – نوعًا من الإسهام في الجدالات النسوية التي تدور أيضًا في الولايات المتحدة. فما فتأت النساء البريطانيات والأمريكيات على مدى مائة وخمسين عامًا يتواصلن، ويتبادلن الأفكار، ويقمن بالتنظيم عبر الحدود القومية. وقد تطلعت النسويات في بريطانيا، السود والبيض على حد سواء، نحو الولايات المتحدة أملاً في الاستنارة بشأن كيفية فهم ومناقشة العلاقات بين العنصر و(النوع)، وهي علاقات شكلت جزءًا متأصلاً من عملية تأسيس حركات النساء هناك. كما كان عدد متنامٍ من الكتب المتعلقة بهذه القضايا لنسويات أمريكيات – أفريقيات – مثل بل هوکس bell hooks، وأنجيلا ديفيز Angela Davis، وجون جوردون June Jordan ونسويات بيض مثل أدريان ريتش Adrienne Rich – كان بمثابة حبل إنقاذ بالنسبة إلى الكثيرات منا. ولكن هذه الأعمال مجموعها لا تتعرض كثيرًا لمناقشة العلاقات المحددة بين النساء السود والبيض في بريطانيا، حيث نصارع من أجل فهم آثار تجربة ما بعد الإمبريالية ومن أجل تكوين سياسة في هذه الظروف، كما أنها أيضًا لا تخاطب مشاعر الصمت وعدم الارتياح والغضب التي أفصحت عن وجودها في سياق التفاعلات السياسية بين النسويات السود والنسويات البيض في بريطانيا، بفعل ورطة ما بعد الاستعمار.
قبل المضي في مناقشة “الإمكان الراديكالي” في تاريخ للنساء يتعرض للعنصر، كما يتعرض (للنوع) وللطبقة، من المهم أن نقر بأن التسيد العنصري (racial domination) يمثل نسقًا يتولى مَوْقَعَة (positions) أو إنشاء (constructs) الجميع، وإنْ تعددت الطرق. فالتركيز على التصورات المتعلقة “بالبياض” ومختلف إنشاءات هوية العنصر الأبيض، بوسعه أن يهيئ سبلاً جديدة للفكر والفعل أمام أولئك الذين يعملون على فهم أنساق التسيد العنصري ونقضها4. بيد أنه في مجتمع معتاد على وجود أيديولوجية سائدة عن تفوق العنصر الأبيض، غالبًا ما يكون من الأسهل على مَن يقعون في فئة “البيض” أن ينظروا إلى أنفسهم بوصفهم محض “طبيعيين” (“normal”)، وبالتالي دون هوية معنصرة (racialized identity) أيْ دون هوية يدخل عامل العنصر في تشكيلها.
أصادف على مقربة من باب بيتي مثلاً بسيطًا يبين هذه العملية، إذ توجد في الحي الذي أسكنه صالة ناجحة للتدريب الرياضي مخصصة للنساء، وهي تعرض شعارًا تجاريًا لها على هيئة رسم تخطيطي لجسد أنثى تتمتع باللياقة البدنية والصحة والقوة. وبالرغم من أن الصالة تقع في حي يتميز بتعدد أعراق ساكنيه، فإن الشكل المرسوم يظهر – لسبب غير مفهوم – بلون من البمبي الفاتح بصورة قاطعة، وهي درجة لونية يطلق عليها “لون اللحم” في علب ألوان الأطفال. ولا يسعني في كل مرة أشاهد الرسم إلا أن أتعجب إزاء ما تدل عليه هذه العلامة من وجود ارتباط بين الشكل الرياضي للمرأة واللون الفاتح للبشرة. وفي الوقت نفسه، لا يساورني الشك في شعور إدارة هذه الصالة بالغضب لو أن أحدًا ألمح إلى أنهم يقصدون عدم تشجيع اشتراك النساء من ذوات البشرة البنية. وفي حين أنني لا أود إعمال فكري بشأن عمليات الفكر اللاواعي الكامنة وراء هذا المثل، يظل المثل مفيدًا في تسليط الضوء على إحدى طرق تجاهل رموز “العنصر” التي من شأنها إثارة المرارة والاستياء، لا يشير اللون الفاتح للصورة المذكورة صراحة إلى نوع من الازدراء للمرأة السوداء، ولكنه مع ذلك ينجح في تعزيز الافتراض أن كون المرء أبيض اللون في هذا المجتمع إنما يعنى كونه طبيعيًا، مشيرًا ضمنًا إلى أن ما عدا ذلك ليس إلا غير طبيعي، أو غريب، أو مجرد غير مرئي.
وتعنى الاستجابة المشكلة التي تطرحها الصورة أن نبتعد عن موقف يُعرِّف “العنصر” بوصفه شأنًا يهم فقط ذوى اللون الأسود، شيئًا لا ينقض بأثره على حياة البيض، وهي لا تعني الدعوة إلى أن يشرع الناس في عَدِّ لونهم الأبيض خصيصة إيجابية أو حتى حيادية، وكذلك لا تعنى أن يقعوا في فخ تشييء البياض(reifying whitenes)، فتفوت عليهم بذلك العمليات التي تلعب دورًا في الإبقاء على البياض، وتجديده، بوصفه موقعًا للذات (subject position). من المهم أيضًا حين نتكلم عن الإنشاء الاجتماعي للبياض، أن نقر بكونه يقينًا لم يكن أمرًا غير ظاهر لأعين أولئك المعرِّفين بأنهم من السود. فكما كتبت بل هوكس:
إن الناس السود، منذ عهد العبودية، يتبادلون في الأحاديث بينهم نوعًا من المعرفة “الخصوصية” بالبياض، يلتقطونها من تدقيقهم عن قرب في الناس البيض. وهي إذ تُعَدُّ خصوصية بوصفها سبيلاً للمعرفة لم تتم تغطيته بصورة كاملة في المادة المكتوبة، فإن الغرض منها كان يتمثل في مساعدة الناس السود على إيجاد طريقة للعيش والبقاء في مجتمع قائم على أساس تفوق الجنس الأبيض.5
خطر ببالي أيضًا أنه يمكن قراءة علامة صالة التدريب بوصفها مجازًا عن طريقة النسوية المعاصرة في تعاملها الاعتيادي مع الاختلافات بين النساء، وفيما بين النساء، إذ من المفترض في النسوية أن تروق للنساء في كل مكان، ملهمة إيانًا الحركة نحو فعل جماعي لتحسين حياتنا وتغيير المجتمع. وبدلاً من ذلك، تم استبعاد عدد كبير من النساء أو تركهن على جانب الطريق، شاعرات بأنهن غير مرحب بهن، غیر مرئيات، غير ممثلات في أختية ((sisterhood اتضح أنها خاصة بالنساء “البيض“، في حين أن “العنصر” لم يكن – بالطبع – هو القضية الوحيدة التي تقسم النساء خلال العقد الماضي، لكنه برز للنسويات – بلا ريب – بوصفه لغزًا من أشد الألغاز تعقيدًا. فكما تشرح إليزابيث ف. سبلمان Elisabeth V. Spelmen، في كتابها امرأة لاجوهرية Inessential Woman:
لأن النساء يعشن في عالم يوجد فيه تمييز ليس فقط على أساس الجنس، وإنما كذلك على أساس العنصر والطبقة وأشكال أخرى من القهر، فإن بعض الاختلافات بين النساء تحمل معها اختلافات أو فوارق في الامتياز (privilege) وفي القوة/ السلطة (power)، وقد تصبح مثل هذه الاختلافات بمثابة إشكالية بالنسبة إلى النساء اللآتي يتمتعن بمزايا، حيث تشكل مصدرًا للشعور بالخوف والخجل والذنب. في مثل هذه الظروف تُعَدُّ “مشكلة الاختلاف” في حقيقة الأمر مشكلة الامتياز، أي الامتيازات المتاحة لبعض النساء لا لكل النساء.6
وتكمل إليزابيث سبلمان شارحة كيف حاولت بعض النسويات تنظير قضايا الاختلاف بطرق تزيد مشكلات الامتياز والاستبعاد تعقيدًا، فتشير إلى أن اللغة المستخدمة في مثل هذه النقاشات كثيرًا ما “تكشف عن وجود تلك الامتيازات التي نقصد أن نجعلها محل سؤال، فما الذي أفصح عنه على وجه التحديد حين أقول عبارة مثل “لابد أن تأخذ النظرية النسوية في حسبانها الاختلافات بين النساء، أو لابد أن تتضمن النظرية النسوية مزيدًا من تجارب النساء من عنصريات وطبقات مختلفة “؟“. إن نقد إليزابيث سبلمان للغة التي تستخدم كثيرًا في النقاش حول هذه المسائل– أي مفردات من قبيل “تتضمن” أو “تأخذ في الحسبان” – يبين كيف أن العديد من النسويات يهتممن بمسائل الاختلاف من باب الاختيار لا من باب أنه أمر ضروري أو وجوبي. ولعله من الحلول اليسيرة بالنسبة إلى النساء اللآتي يشغلن موقعًا ممتازًا في التراتبية الطبقية أو العنصرية أن يفترضن أن مهمتهن هي دعوة النساء الأخريات إلى الانضمام إليهن في العمل السياسي النسوي، على أساس أنه يمكن تحقيق التساوي أو التكافؤ (parity) بمجرد الإقرار بأنهن – أي النساء الأخريات– “مختلفات” بشكل ما. من وجهة نظري، بقدرة البحث في إنشاء البياض – وبخاصة الأنوثة البيضاء/ أنثوية المرأة البيضاء (white femininity) – أن ينقل هذه الجدالات بعيدًا عن الهوس بالاختلاف، نحو مفهوم أقل رواجًا وهو مفهوم “الارتباط العلائقي” (relational connectedness)، حيث يتم إنشاء التصورات بشأن ما يكوِّن الأنوثة البيضاء في إطار يتصل بالتصورات عن الأنوثة السوداء، والعكس صحيح، في حين أن العناصر المختلفة في هذا النسق الخاص بهويات العنصر و(النوع) ليس لها معنى باطني أساسي، إذ تعمل هذه العناصر على التفريق وعبره؛ أي خلق الاختلاف والتمايز (differentiation). فضلاً عن ذلك، تُعَدُّ تعرية هذه الإنشاءات المختلفة وإيجاد العلاقة بينها، مهمة تؤدي إلى فهم أكثر نفعًا للعلاقات الاجتماعية التي تكشف كلاً من العنصر و(النوع).
حتى نتوصل إلى فهم الكيفية التي يتم بها التعبير عن التصورات بشأن الأنوثة السوداء والأنوثة البيضاء في الوقت الحالي، من المفيد أن تتأمل الكيفية التي تم بها إنتاج هذه الفئات في الماضي. ويقتضي ذلك تبني منظور التاريخ لا يأخذ في الحسبان (النوع) والطبقة فحسب، وإنما أيضًا أيديولوجيات الاختلاف العنصري. وذلك على وجه التحديد – وعلى أصعدة عديدة – ما برحت تفعله النساء السود والنساء من عنصريات أخرى عند استحداثهن سياسة نسوية تعكس أولوياتهن. إذ شهدت السنوات العشرة الأخيرة طائفة متنامية من الأعمال التي تبحث في الإنشاءات التاريخية لصورة/ هوية المرأة السوداء (black womanhood)، بعضها يتولى – بالضرورة – مناقشة الصلات بين أيديولوجيات الأنوثة المنحرفة/ الخارجة عن المألوف (deviant) والأنوثة المعيارية، بين الأنوثة السوداء والأنوثة البيضاء. فعلى سبيل المثال، تذكر هازل كاربي Hazel Carby في كتابها إنشاء (تعريف) المرأة من جدید Reconstructing Womanhood، حول الأديبات الأمريكيات من أصل أفريقي، تذكر الآتي:
من الضروري أيضًا أن نضع سرديات النساء السود في سياق الخطاب السائد المتعلق بجنسانية الأنثى البيضاء، حتى نتمكن من استيعاب وتحليل الطرق التي قامت من خلالها النساء السود، بوصفهن كاتبات، بمخاطبة الشفرات الأيديولوجية السائدة، واستخدامها، وتحويلها، وأحيانًا إفسادها.7
في مقال لها حول الصور الممثلة لجنسانية الأنثى السوداء في “ساحة السوق الثقافي” (“the cultural marketplace”)، تركز بل هوكس على تأثير عنصرية القرن التاسع عشر في تشكيل النظرة المعاصرة إلى النساء السود في الولايات المتحدة. كما أنه في سياق التاريخ البريطاني أقدمت أيضًا النسويات السود على تفكيك مجموعة الصور المخيَّلة عن النساء السود عبر نظرة إلى علاقات العنصر والطبقة و(النوع) ترى قصورًا في أي نقاش عن صور النساء والرجال غير البيض إنْ تم بدون اعتبار الأفكار المتعلقة بالعنصر. وتزعم براتيبا بارمار Pratibha Parmer على سبيل المثال– أن تمثيل النساء الأسيويات في بريطانيا أمر لا يمكن فصله عن العلاقات الاجتماعية والسياسية التي تدعم العنصرية:
يتم تعبئة صور بعينها للنساء الأسيويات لخدمة مزاعم معينة. فالتصورات التي تكاد تكون بديهية عن جنسانية المرأة الأسيوية وأنوثتها، قائمة على أيديولوجية بطريركية عنصرية ومحكومة بها، وإنْ كانت تعريفات المرأة تختلف حسب عنصرها، فإن أيديولوجية الأنوثة يتم إنشاؤها – في كل الأحوال– على هيئة تناقض بالنسبة إلى كل النساء: هن في آنٍ واحد أمهات يقمن بخدمة الزوج والأطفال، وهن أيضًا موضوعات رغبة الرجل الجنسية.8
إن ما تطلق عليه بارمار “تصورات بديهية” يلخص خطابًا بأكمله يتعلق بالأنوثة الأسيوية، تم إنتاجه عبر عدة مئات من سنوات الاحتكاك الأوربي بشبه القارة الآسيوية. ويعطي استعمالها هذه العبارة سندًا لفكرة أن الافتراضات والتحيزات الخاصة بالاختلاف الثقافي راسخة الجذور في الثقافة السائدة، إلى حد أنها تبدو بديهية أو حتى “طبيعية“.
إن الإقرار بأن حياة النساء الملونة محكومة – لا مناص – بتعريفات العنصر بالإضافة إلى (النوع)، أمر يمكن تطبيقه أيضًا على حالة النساء الواقعات في فئة “البيض“. وبكلمات أخرى، يجدر بأية مؤرخة نسوية (أو مؤرخ) ترغب في تبني منظور عن العنصر و(النوع)، أن تستخدم أمثلة النقد الذي تقوم به النسويات السود بوصفه نموذجًا يحتذى به. وإذا تركنا جانبًا لبرهة، الصعوبات النظرية أمام التعرف على تأثيرات العنصرية إذ تجتمع مع تبعية وضع المرأة، في حياة النساء من عنصر غير الأسود، تظل هناك مشكلة إيجاد الأدلة التاريخية المطلوبة للشروع في إنشاء تاريخ للتصورات التي تتعلق بالمرأة البيضاء، في بريطانيا على الأقل. ويأتي ذلك أساسًا بوصفه نتيجة لصمت تاريخ النساء والتاريخ النسوي عن مسألة العنصر، حتى في سياق الإمبراطورية البريطانية،9 بالتزامن مع فشل أغلب تواريخ العنصرية والمستوطنين السود – في بريطانيا – في التعرض لقضايا (النوع). فبالرغم من أنه كان للناس السود وجود في حياة النساء البريطانيات البيض منذ أوائل الحركة المناهضة لعبودية الحقبة الاستعمارية وعبرها حتى عهدنا هذا، فقد اقتصر اهتمام النسويات البريطانيات بهذا اللقاء – بشكل عام – على حكايات عن النساء الإنجليزيات بوصفهن مسافرات جسورات، ورائدات، ومبشرات، وزوجات للموظفين البريطانيين في المستعمرات (memsahibs) – أي النساء بوصفهن شخصيات تثير الاهتمام، رائدات للمساواة الجنسية يرهصن بالاستقلال النسوي. كما أنه كان يتم تسليط الضوء على مسلكهن وطبيعتهن الخارجة عن مألوف المرأة، وعلى سياستهن الجنسية المغامرة، بخلفية غرائبية غائمة المعالم. وفي الوقت نفسه، تتمحور الكتابات – في الحالات التي تناقش فيها الكتابات التاريخية مسألة العنصرية – حول خصوصية حياة السود واستحداث نوع من الفكر يتناول مسألة الاختلاف العنصري بصفة علمية مزورة، إن إغفال ما يخص (النوع) في هذه التواريخ ينقل بعدًا آخر من أبعاد لامرئية النساء السود، هذه المرة عبر مسارد زودنا بها كتاب من الرجال والنساء البيض، بل وأيضًا من الرجال السود.
إن هذا الغياب – الذي كان محل اعتراض ونقاش بصورة أكثر عنفًا في السياق الأمريكي– يكمن وراءه الفشل في إدراك أن التسيد العنصري نظام يعمل جزئيًا بالاقتران مع (النوع) والطبقة أيضًا.
لا يعني هذا الأسلوب الجديد الذي اقترح تبنيه في الكتابات التاريخية النسوية مجرد إضافة تاريخ السود أو تاريخ العنصرية جنبًا إلى جنب ما هو معروف بالفعل من تاريخ النساء أو إدراج (النوع) داخل المسارد الموجودة عن العنصر والطبقة، إذ إن تطبيق منظور يشمل العنصر والطبقة و(النوع) على الأبحاث التاريخية، لا بد أن يكون ناجعًا في إحداث تحول في التفسيرات القائمة على العنصر والطبقة فقط أو الطبقة و(النوع) فقط. لقد تزامنت حركة مناهضة العبودية – التي عانى تاريخها من آثار هذا الانقسام في جهود الكتابة التاريخية – مع حقبة من التغيرات الاجتماعية الصاخبة في بريطانيا. ظلت حتى الآن الدراسات المعنية بجهود النساء في تأیید حركة إلغاء الرق مقتصرةً على طراز بحثي محدود، قوامه “إسهامات النساء” في هذه الحركة.10 بيد أنه يظل بإمكاننا استخدام الدلائل التي تقدمها هذه الدراسات، بالإضافة إلى غيرها من المواد البحثية؛ لإعمال التفكير في الديناميات المتغيرة للعلاقات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية داخل بريطانيا، وكذلك التفكير في مسألة نمو هويات قومية (منوَّعة gendered) في أواسط القرن التاسع عشر. وكما تزعم كاثرين هول Catherine Hall:
إبان الجدل الدائر حول العبيد أو السود المحررين، انشغل الرجال والنساء الإنجليز بإنشاء هوياتهم الشخصية بالقدر نفسه الذي انشغلوا فيه بتعريف هويات الآخرين، وكانت تلك الهويات مشكلة دائمًا تبعًا للطبقة والنوع، كما كانت لها خصوصيتها العرقية. فضلاً عن ذلك، كانت القدرة على تعريف أولئك الآخرين تمثل جانبًا مهمًا من نصيبهم الشخصي من القوة/ السلطة.۱۱
ومع ذلك، تعكس لغة المنشورات التي كتبتها النساء ضد العبودية – بالرغم من اعتمادها صبغًا معروفة وشعارات طنانة – طريقة رؤية نساء الطبقة الوسطى على الأخص، للصلة بين هوياتهن “العنصرية” (“racial”) والجنسية والسياسية، وبالتالي تعكس طريقة فهمين وإنشائهن لإنجليزيتهن، أو اسكوتلنديتهن، أو ويلزيتهن، أو أيرلنديتهن، بالنسبة إلى الجماعات الأخرى من الناس.
وقد أزعم أيضًا أن تبني منظور تاريخي يأخذ في الحسبان العنصر والطبقة و(النوع) أمرٌ أساسي لتحليل شبكة العلاقات الاجتماعية، بالغة التعقيد، القائمة في المجتمعات الاستعمارية. إذ لا تسهم بالضرورة مصادر التوثيق المعتادة التي تصف كيف كانت النساء تقضى أوقاتهن في هذه المجتمعات في تحليل كيفية قيام هذه المجتمعات بإعادة إنتاج نفسها، في حين أن تفصيص العلاقات الاجتماعية التي كانت تربط النساء البيض بالرجال البيض وكذلك بالنساء والرجال السود، من شأنه أن يلقى ضوءًا أقوى على آليات القوة والتسيد في ظل الاستعمار، وهو مجال يشرع مؤرخو (أو مؤرخات) الاستعمار في استكشافه. تشير آن لورا ستولر Anne Laura Stoler إلى محدودية المقترب القائم على التوثيق الاجتماعي، في مقالتها المستفيضة، بعنوان “ممارسة الشهوات والقوة الإمبريالية” (“Carnal Knowledge and Imperial Power”)، قائلة:
إن العلاقة بين إملاءات (النوع) والتخوم العنصرية، بصفتها سطحًا نقديًا مشتركًا (interface critical) بین الجنسانية والنظام السياسي الأوسع، هي مجال لم ينل حتى الآن قدرًا متوازنًا من الاستكشاف. فكما توضح – على سبيل المثال – بعض الدراسات الحديثة في التاريخ الشفهي لنساء المستعمِر، خبرت النساءُ الأوروبيات من طبقات مختلفة تجربة الاستعمار بشكل اختلف فيما بينهن، كما اختلف عن الرجال. ورغم ذلك، فلا زلنا لا نعرف إلا القليل، نسبيًا، بشأن استثماراتهن المتمايزة في ممارسة عنصرية (racism) كن يتشاركنها. ۱۲
يُعد مقال أن لورا ستولر مثلاً مواتيًا للدلالة على حجم الفائدة من البحث في “السطح النقدي المشترك بين الجنسانية والنظام السياسي الأوسع“، في سياق المجتمعات الاستعمارية. كما يشير أيضًا هذا المقتطف إلى احتمال أن بعض أوجه هذا السطح المشترك يسهل إهمالها لحساب أوجه أخرى، إذ إن إقرار الكاتبة بالتنوع الذي ميز حيوات النساء الأوروبيات لا يتماشى مع اقتراضها أنهن جميعًا كن يتقاسمن عنصرية مشتركة، وموحدة الشكل، حتى على الرغم من اختلاف استثمارات البعض منهن في هذه العنصرية عن استثمارات البعض الآخر. إن “العنصرية” في رأبي تُستخدم بوصفها مصطلحًا واسعًا معممًا من شأنه أن يحجب رؤية المواضع المتناقضة التي وجد العديد من النساء أنفسهن فيها، ولذلك تبدو أشكال المعارضة والمقاومة التي ابتكرها عدد لا يستهان به من نساء الاستعمار – على وجه التحديد – من أجل فصل أنفسهن عن مختلف أشكال التسيُّد العنصري – مسألة أكثر إثارة واستحقاقًا للاهتمام، ويجعل استكشاف هذه المنطقة المشروع المعني بمحاولة تحليل “العلاقة بين إملاءات (النوع) والتخوم العنصرية” أكثر ثراءً.
تأتي إشارة آن ستولر إلى التاريخ الشفهي في صميم الموضوع هنا، حيث تهيئ فرصة لبحث العلاقة المعقدة بين أنواع الذاكرة المختلفة، وبالتالي بحث العمليات التي يتم عبرها استدعاء ذكرى تواريخ معينة.13 أولاً، إن التاريخ الشفهي للحياة في ظل الاستعمار – الذي تم جمعه من تجارب النساء البريطانيات، على سبيل المثال – يثير أسئلة تتعلق بأن النساء تتذكر بطريقة مختلفة عن الرجال. ففي دراسة عن “الذاكرة الاجتماعية” يلحظ جيمس فنتريس وكريس ويكهام James Fentress and Chris Wickham أن: “قصص حياة النساء تعطي مساحة لتاريخ الحيز العام أصغر من المساحة التي يعطيها له الرجال أو مختلفة عنه، لسبب بسيط وهو أنه كان للنساء علاقة أقل بالحيز العام، أو حدثت هذه العلاقة بطرق خلقت لهن منظورات من نوع مختلف“.14 ثانيًا، من المستحيل ألا تتعكر الذكريات الشخصية أو تتأثر على نحو ما بفعل الذكريات الجمعية، والأهم هنا بفعل التصورات الثقافية المختلفة عن الفترة الاستعمارية، سواء في الأدب أو السينما أو التليفزيون. كما أن مختلف العمليات التي تكوين ذاكرة تاريخية اجتماعية للإمبراطورية، تكشف لنا كيفية اختراع الماضي من جديد بحيث يتسق مع الحاضر، أو الحاضر ليتسق مع الماضي.
في أثناء صنع فيلم تسجيلي تليفزيوني عن دور النساء البيض اللآتي عشن في ظل “الراج” (Raj)[الراج هو لفظ يطلق على الاستعمار البريطاني في الهند.]، بعنوان هیلدا و دارجیلینج Hilda & Darjeeling، وجدت – أنا ومعاونتي ماندي روز – أن الأسئلة التي وضعناها بهدف الكشف عن تعقيدات العنصر والطبقة و(النوع) في المجتمع البريطاني الاستعماري، قد جاءت بنطاق مبهر من الأجوبة التي أقنعتنا بطبيعة التناقض في “العنصرية” نفسها. فقد بدأنا سريعًا نرى أن النساء الخمسة اللآتي أجرين معهن مقابلات (interviewees)، واللآتي من البداية اخترناهن بسبب علاقة النقد والتفكير التي تربطهن بتجربتهن الاستعمارية، كن جميعًا يرين أنفسهن ضد التحامل العنصري، وفي بعض الحالات خاليات منه، كما كُنَّ صاحبات موقف منتقد للعديد من جوانب القوة الاستعمارية، إلا أن إحدى المناقشات الجماعية (المصورة) انتهت إلى نزاع حاد، حين أعربت واحدة من المجموعة عن رأي ما عَدَّته الأخريات رأيًا “عنصريًا“.
وبالرغم من أن إحدى العبارات التي كانت المشتركات يكررنها وهن يصفن حيواتهن شديدة التنوع هي: “هذه كانت طبيعة الأمور” (“that’s just how it was”)، يبقى من المهم أن نتعرف على الطرق التي يتولى التاريخ الشفهي – من خلالها – تقديم تفسيرات للماضي تتشكل – في حقيقة الأمر – بتأثير الإدراك التالي على وقوع الحدث (hindsight). فكما تزعم لويزا باسیرینی Luisa Passerini في دراستها عن الفاشية الإيطالية والذاكرة الشعبية: “قبل كل شيء، تلجأ الذاكرة إلى حيل وقفزات عبر الزمن“.15 وفي إطار بحثها المتعلق بالفترة بين ۱۹۱۹ و ۱۹۲۱ وبین 1943 و 1945، تواصل قائلة:
إن القفزة الذهنية من عند لحظة كبيرة من لحظات التوتر الاجتماعي والهوية الجمعية إلى لحظة أخرى مثيلة، لا تُعَدُّ بأية حال مجرد وسيلة لالتزام الصمت عن الأعوام العشرين المحبوسة بين هاتين النقطتين البارزتين. وإنما هي فعليًا نوع من التفسير التاريخي في حد ذاته، طريقة لاسترداد شيء ما من قلب الهزيمة، إذ إن ما حدث فيما بعد – بالنسبة إلى الذوات التي تمكنت من مواصلة الحياة – أمر يرتبط، بصورة لا فكاك منها، بما حدث وقتذاك.
إن هذه السيرورة في تفسير وقائع الماضي لها أهمية مركزية في نقاشي حول الذاكرة التاريخية والاستعمار. فإن كان لا يزال من الممكن تجميع تاريخ شفهي للمجتمعات الاستعمارية يشارك فيه السود والبيض، الرجال والنساء، فكيف يمكن للمؤرخين (أو للمؤرخات) إذن أن يغطوا تأثيرات قرابة أربعين عامًا من التعبير السياسي والثقافي عن عواقب الاستعمار فضلاً عن الأثر الأقل أهمية – كما نقر – للنسوية؟ فعلى سبيل المثال، صار الإقدام على تأييد رأي أو أسلوب تصرف مما يُعَدُّ “عنصريا“، صار له اليوم تبعات مختلفة تمامًا، إذ أصبحت الرؤية التي تتكون بعد زمن من الحدث أو التجربة تولد مشاعر قوية مثل الإحساس بالذنب، والندم، والغضب، والخجل، والشعور بخسارة، ولا تقتصر هذه المشاعر ل على عداد المستعمرين السابقين فحسب.
على الباحثات (أو الباحثين) في التاريخ الشفهي – وهن يقمن بجمع أجزاء الشواهد المتناثرة التي توضح كيف واصلت المجتمعات الاستعمارية المختلفة بقاءها– أن يبحث أيضًا في الدور الذي لعبته السينما والتليفزيون والأدب في تشكيل الذاكرة الفردية والذاكرة الجمعية عن الماضي. ثمة تقليد ثري بشكل خاص، يمتد خلفًا إلى القرن السابع عشر، يخص الكتابة الخيالية عن الاستعمار، ولا يزال مستمرًا اليوم في أعمال کتاب مثل روث براور دجابغالا (Ruth Prawer Jhabvala).16 ومن بين هذه الأعمال توجد أنواع أدبية تلقى رواجًا لدى النساء من القراء. وقد اكتشفنا خلال نقاشاتنا مع الأشخاص الأربعين الذين أجرينا معهم المقابلات الخاصة يفيلم “هيلدا و دارجيلينج” أن رواية السرادقات البعيدة Far Pavilions، وهي من تأليف م. م. كاي Kaye M. M.، كانت رواية أثيرة قرأتها معظم النساء المشتركات في المقابلات، كما أنه على صعيد أقل إغراقًا في الخيال، فإن رباعية الراج Raj Quarter، التي كتبها بول سكوت Paul Scott ونشرت أولاً في عام 1971 ثم أنتجها التليفزيون عام ١٩٨٤، عَدَّتها المشتركات توصيفًا عادلاً جدًا للحياة في الهند تحت الحكم البريطاني خلال السنوات التي انتهت بالاستقلال.
تزامن البث التليفزيوني لعمل سكوت تحت عنوان جوهرة في التاج Jewel in the Crown مع عرض عدد من الأفلام ذات الإنتاج الضخم، التي تجري أحداثها على خلفية الإمبراطورية البريطانية. فقد انتشرت في الثمانينيات من القرن العشرين أفلام مثل الحرارة والتراب Heat and Dust، ممر إلى الهند Passage to India الخروج من أفريقيا Out of Africa، العبث الأبيض White Mischief. وبينما لا يعنيني هنا بحث أسباب هذا الانتشار، تلعب مثل هذه التصويرات الثقافية دورًا مهمًا في تشكيل الذاكرة الاجتماعية الخاصة بالناس بوصفهم أفرادًا وكذلك بالثقافة السائدة ككل. كما أجد أنه من المفيد هنا التفكير في الدور الذي يلعبه “الحنين إلى عهد الإمبراطورية” (“Imperialist Nostalgia”)، وهو تعبير استخدمه ريناتو روزالدو Renato Rosalto لمناقشة “الظاهرة العجيبة التي تتمثل في حنين الناس إلى ما قد تولوا تدميره بأنفسهم“.17 وقد كتب روزالدو مقاله بإيعاز من غضبه إزاء الاستقبال الحماسي الذي كانت تلقاه أفلام تُظهر المجتمعات الاستعمارية البيضاء وكأنها تتسم باللياقة والنظام المرتب“، وحيث:
كانت الإشارة إلى الانهيار القادم لهذه المجتمعات لا تظهر إلا بشكل هامشي من شانه الا يثير استياءً أخلاقيًا، وإنما طريقة استقبال عبر نظرة رثائية، حتى فئات الجمهور الأمريكي الواعية سياسيًا لم تسلم من الاستمتاع بأناقة مظاهر السلوك التي تحكم علاقات التسيُّد والتبعية بين “العنصريات البشرية“. وفيما يبدو جعل خلقُ جو من الحنين إلى الماضي التسيدَ العنصري يظهر بريئًا وطاهرًا.
إن التعبير الثقافي عن الحنين إلى عهد الإمبراطورية، الذي ينعكس في الأفلام والمسلسلات ذات الميزانية الضخمة، من شأنه أن يؤدي حتمًا إلى تقليب ذكريات أولئك الذين خبروا الحياة في ظل الإمبراطورية القديمة، مما يترك بالضرورة أثره على المادة التي تجمع من التاريخ الشفهي، لاسيما حين تتعلق بعهد الحكم البريطاني للهند أو شرق أفريقيا بصفتهما الموقعين المختارين لأحداث العديد من تلك الأعمال الدرامية، ويحدث أحيانًا أن يستجيب الأشخاص للأسئلة عن تجربتهم الاستعمارية بعقد مقارنات مباشرة، منددين غالبًا بتلك التصويرات الخيالية بصفتها زائفة على نحو ما أو غير واقعية. فعلى سبيل المثال، قادتنا تجربتنا في محاولة استكشاف العلاقات الجنسية بين النساء البيض والرجال الهنود، إلى استخلاص أن تصويرات الرغبة بين عنصريات مختلفة أو الممارسة الجنسية المخترقة للحاجز العنصري (transgressive sex)، الموجودة بكثرة في الأدب والأفلام المتعلقة بعهد الاستعمار، لا تتقابل بالضرورة مع تجارب الحياة اليومية للنساء اللآتي أجرينا معهن المقابلات. وفي المقابل، فإن أولئك الذين لم يتسنَ لهم (أو لهن) أن يتعرفوا على طبيعة المجتمعات الاستعمارية – المتسمة “باللياقة والنظام” – إلا من خلال تلك الأشكال وليدة الخيال– لن يسعهم إلا استنتاج أن “هذه كانت طبيعة الأمور“.
بينما تشمل العلاقة بين التصور (representation) والتجربة جدلاً معقدًا ليس له أهمية خاصة هنا، يعيدني هذا النقاش الموجز حول تعقيدات الذاكرة التاريخية إلى العبارة المقتبسة من والتر بنجامين التي بدأت بها مقالي. ما دور العنصر في “لحظات الخطر” هذه بالنسبة إلى النساء في حياتنا المعاصرة؟ وما ذكريات ما بعد الاستعمار التي تلقي الضوء عليها؟ كيف يمكن للتاريخ النسوي أن يبدأ في تحليل التصورات التاريخية عن الإمبراطورية، المنتجة في الحاضر، وبالتالي يبدد الخطر، محولاً التوتر نحو أغراض بنَّاءة بدرجة أكبر؟ وبادئ ذي بدء، كيف للمؤرخات النسويات – في ضوء أوجه القصور في التواريخ الموجودة حاليًا – أن يقمن ببناء إطار لاستكشاف “العلاقة [النقدية] بين إملاءات (النوع) والتخوم العنصرية” في الماضي، على سبيل استعارة عبارة آن ستولر مرة أخرى؟ لقد تعرضت لهذه الأسئلة بقدر من التفصيل في كتابي ما بعد حدود المسموح به؛ حيث أتفحص ثلاث لحظات أو فترات من القرن التاسع عشر من تاريخ بريطانيا لها أهميتها، وأنوي هنا أن أقدم ملخصًا للأسباب التي اجتذبتني نحو تلك السرديات بالتحديد، وأن أصف الموضوعات التي تتكرر بصورة هيأت لي أن أربط بين مختلف خيوط المادة التاريخية التي تصادفني.
يتمثل الموضوع الأول في الصلة بين النسوية ونضالات الجنس الأسود ضد التسيد العنصري (racial domination)، ويتخذ هذا المحور نقطة بداية له الحركة المناهضة للعبودية، التي امتدت عبر الفترة بين العشرينيات والستينيات من القرن التاسع عشر، وكانت تمتلئ بتيارات الراديكالية والإصلاح الاجتماعي والسياسي، إن بزوغ حركة حقوق النساء الأمريكية من قلب الدعوة إلى إلغاء العبودية (abolitionism) هو ما أوجد الحافز على تتبع هذا الخيط؛ على الرغم مما يتراءى البدء من وهن شواهد هذه الصلة في السياق البريطاني مقارنة بمثيله الأمريكي، إذ إن تواجد مناصري إلغاء الرق من البريطانيين على مبعدة كبيرة من موقع تواجد العبودية، وكذلك ندرة وجود احتكاك بينهم وبين السود من الناس، قد جعلا لحركتهم قوة دافعة من نوع مختلف عن ذلك الذي كان لنظيرتها في أمريكا الشمالية. إضافة إلى ذلك، كان للقوى الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المعينة، في كل بلد منهما، تأثيرها في تركيبة حركات مناهضة العبودية وكذلك في الصورة المتكونة عن الدعوة إلى إلغاء الرق بوصفه نشاطًا سياسيًا أو أخلاقيًا. غير أن اكتشافي لوجود حفنة من النساء الراديكاليات في بريطانيا سعين إلى الربط بين وضعهن الشخصي بوصفهن نساءً وبين العبيد السود في منطقة جزر الكاريبي أو في الولايات الجنوبية من أمريكا، هذا الاكتشاف كان دعامة كافية للبدء في استكشاف الصلات الأوسع بين حركة تحرير السود وحركة المطالبة بحقوق النساء. فعلى سبيل المثال، اعتمدت النسويات الأوائل لغة تدور حول الأسر والحرية في صياغة دعوتهن من أجل المساواة الجنسية، مستخدمات استعارات لغوية تميزت برنين أشد إلحاحًا وبالغ الاختلاف عن تلك المعاني المخففة والبلاغية التي اكتسبتها – بالضرورة – تلك الاستعارات بعد قيام العالم الغربي بإلغاء العبودية القائمة على أساس عنصري. إن هذا النوع من الصلة بين هذين النضالين المتوازيين ضد التسيد، يمكن أن نستفيد من استكشافه وتتبعه على مدى تاريخي النسوية والنشاط السياسي للسود حتى الوقت الحالي، واضعين في الحسبان بطبيعة الحال أنه لا هذا النضال ولا ذاك بالمتجانس التكوين، وأن حياة النساء السود تجعل مشكلة الانفصال الظاهري بين النضالين هذا النوع من الصلة تزداد تعقيدًا.
المحور الثاني هو تطور النسوية داخل مجتمع عنصري – أي مجتمع شكلته عوامل التسيد على أساس العنصر و(النوع) والطبقة. وقد ظهرت لهذا الموضوع أهميته في نقاشي حول الإمكان الكامن في النسوية بصفتها حركة سياسية راديكالية، حيث رجعت الشواهد التاريخية التي كشفتها أن العديد من المشاكل المرتبطة بـ “العنصر” والنسوية ما هي إلا مواريث مباشرة من عصر الإمبراطورية. لقد بدأت النسوية تظهر وتتطور خلال النصف الأخير من القرن التاسع عشر، وبدا من المناسب التحري بشأن القوى التي أثرت في النسوية بوصفها حركة، على الأخص فيما يتعلق بتأثيرات الإمبريالية. وقد مثلت النشاطات السياسية لامرأتين إنجليزيتين كانتا قد انخرطتا في حركات الإصلاح الاجتماعي في الهند المستعمرة – وهما آنيت أكرويد Annette Aekroyd وجوزفين باتلر Josephine Butler – فرصة غنية لاستكشاف الكيفية التي قامت بها نساء من الطبقة الوسطى يرين أنفسهن من النسويات في بريطانيا، بإقامة روابط نظرية وعملية مع نساء يعشن في ظل نظام مغاير من التسيد الذكوري، شَكَّله حكم استعماري يقع مركزه على بعد آلاف الأميال. وكانت أكرويد قد سافرت إلى الهند بهدف إنشاء مدرسة للفتيات الهنديات، بناءً على دعوة من حركة براهمو سوماج (Brahmo Somaj)، وهي حركة هندية للإصلاح معنية بنشر التعليم في أرجاء البلاد. وتعطي كراسات أكرويد ويومياتها الوافرة إمكانات عديدة للتبصر في دوافعها من الذهاب هناك، وردود فعلها تجاه الناس الذين كانت تصادفهم وإحباطاتها بخصوص المشروع نفسه. كما تقدم فرصة نادرة لقراءة أفكار واحدة من الناس نشأت منذ طفولتها في ظل سياسات راديكالية، وقد انخرطت أيضًا في طرق تفكير إمبريالية، كما قامت بوضع نفسها في عالم فرض أسئلة على قدر من الصعوبة والتعقيد أكبر من قدرتها علي إيجاد الأجوبة. أما باتلر فإنها – علي الجانب الآخر – لم تذهب فعليًا إلي الهند، ولكنها وضعت جزءًا كبيرًا من طاقتها في شن حملات لصالح المومسات الهنديات اللآتي كن يقدمن خدماتهن لجنود الإنجليز. وقد كان من المُجْدي والدال القيام بمقارنة حياة امرأة بحياة الأخرى، واستطلاع دوافعها للعمل مع نساء الإمبراطورية أو بالنيابة عنهن، والنظر في طرق تعاملها مع الاختلاف الثقافي وكيفية تفسيرها للعلاقة بين تبعية النساء والتسيُّد الاستعماري، وأخيرًا كيفية تعريفها للأنوثة في حد ذاتها.
إن النسويات الإنجليزيات اللاتي يكتبن عن وضع النساء الهندوسيات والنساء المسلمات في الهند، قد كشفن بعض الطرق التي يحددن عبرها موقعهن بالنسبة إلى المرأة غير البيضاء وغير المسيحية، وكشفن كذلك عن كيفية إسهامهن في إنشاءات باقية للأنوثة الأسيوية بوصفها أنوثة سلبية، خرساء، خانعة، مجنيًا عليها. وقد قمن من خلال ذلك أيضًا بتعريف بعض أوجه أنوثتهن هن، المستمدة من موقعين بوصفهن نساءً إنجليزيات، مسيحيات، زوجات وبنات. لم تكن هناك حاجة لأن تتولى تلك النساء وصف أنفسهن، أو حتى النظر إلى أنفسهن بوصفهن “بيضًا“، فالعلاقة المعقدة التي تربطهن بالثقافة الإمبريالية السائدة أتاحت لهن الشعور بانتمائهن إلى نظام عنصري وثقافي متفوق دون أن يحتجن إلى اتخاذ موقف مؤيد صراحة لفكرة تفوق الجنس الأبيض. ومن المهم في هذا السياق القيام باستكشاف المعاني المختلفة لصفتي الإنجليزية والبياض، والنظر في تأثير (النوع) في الأيديولوجيات القومية التي دمجت الاثنين معًا. وتكشف هذه الدراسة لحالة آنيت أكرويد وجوزفين باتلر التناقض الذي يواجه العديد من النسويات من العصر الفيكتوري، حيث في حمية رغبتهن في النهوض بالنساء من ثقافات أخرى وتخليصهن من الأعراف والعادات البطريركية المستبدة، كُنَّ – في الواقع – يقمن بمساندة المشروع الإمبريالي لتحرير الأهالي البدائيين (heathen peoples) من أجل تنويرهم. وقد بقي هذا التناقض قائمًا يمثل مصدرًا للتوتر على مدى تاريخ النسوية الغربية.
أما الموضوع الثالث الذي أوليته اهتمامي، فهو توظيف النساء البيض – بشكل إيجابي أو سلبي من ناحيتهن – في أشكال مختلفة من التمييز العنصري. وهنا، نجد في حملة معينة ضد الإعدامات بدون محاكمة (lynching) مثلاً ساطعًا على تواطؤ النساء البيض، حيث تكشف تلك الحملة كيف يمكن أن يجري نشر نوع من الرعب المرتبط بالعنصرية، باسم الدفاع عن شرف المرأة البيضاء. ففي عام ١٩٨٣، جاءت الكاتبة والناشطة الأمريكية أيدا ب. ولز Ida B. Wells إلى بريطانيا بدعوة من كاثرين إيمبي Catherine Impey، محررة جريدة تكرس نفسها لإبادة التحامل العنصري. وأعقبت ذلك سلسلة أحداث فوق العادة في تاريخ السياسة البريطانية المناهضة للإمبريالية، بانطلاق المرأتين في حملة ضد الإعدامات بلا محاكمة في الجنوب الأمريكي، مسافرتين في أنحاء البلاد تلقيان المحاضرات وتجريان المقابلات. وقد جاءت أيدا ولز إلي البلاد مرة أخرى في العام التالي لتقوم بجولة أوسع نطاقًا. وينطوي تحليل أيدا ولز الثوري لممارسات الإعدام خارج القانون بصفتها شكلاً من القمع الاقتصادي والسياسي على قوة نابعة جزئيًا من اقتناعها بأن القتل الاعتيادي للرجال السود كان يأخذ شرعية بفضل حكايا الاغتصاب والاعتداء الجنسي على النساء البيض. ويتمثل صلب حجتها في أن إمكان هذه الشرعنة وُجدت فقط بفضل الإنشاء الأيديولوجي للمرأة البيضاء الطاهرة – فيما هو تطوير وامتداد لصورة شخص سيدة المستعمرة في عهد الاستعباد – التي تقابلها صورة الرجل الأسود ذي الطبيعة المتوحشة. والمرأة البيضاء الطاهرة ابتكارٌ نشأ في زمن أقرب عهدًا بوصفه رد فعل على تحرر السود في عصر إعادة البناء (Reconstruction Era)[عصر إعادة البناء هو الاسم الذي يطلق على فترة ما بعد الحرب الأهلية في تـاريخ الولايات المتحدة الأمريكية (١٨٦٥– ۱۸۷۷)، وهي فترة تميزت بجدالات سياسية واجتماعيـة حـول سياسات تخص تحرير العبيد وتعديل الدستور وبناء الدولة بشكل عام.]. وفي متابعة لهذا الخيط، أمكن أيضًا لأيدا ولز تقديم الدليل على أنه في الحالات التي وجدت فيها علاقات برضا الطرفين من الرجال السود والنساء البيض فيما سبق الإعدام، كثيرًا ما كانت المرأة هي الطرف المبادر إلى إقامة العلاقة.
يكشف الاستقراء الدقيق في أوراق الحملة البريطانية عن تفجر خلافات جدية بين بعض النساء اللاتي ادعين علنًا تأييدهن للحملة، وهي خلافات تتعلق كلها بمسألة الاستقلالية الجنسية للمرأة، وقد استدعى تحليل هذه الصراعات سبر نطاق من تعريفات مختلفة، (وأحيانًا نسوية) للأنوثة، دارجة وقتذاك، الأمر الذي كشف بدوره عن مواقف متباينة من فكرة تفوق الجنس الأبيض، منها ما هو مقرر ضمنًا ومنها المعلن صراحة.
يرتبط الموضوع الرابع بالموضوع الذي سبقه، حيث يتعرض لبعض الطرق التي سعت عبرها النساء البريطانيات إلى مناهضة ما عددنه تحاملاً عنصريًا او استغلالاً للسود من قبل البيض، ويهيئ هذا المحور محلاً بالغ الأهمية لفحص علاقة هؤلاء النساء بمختلف إنشاءات الأنوثة البيضاء القائمة، وانعكاسات رفضهن أو تنصلين من هذه المُثل. إن ضلوع كاترين إمبي وأخريات من نساء بيض الترمن بالكشف عن إنشاء المرأة البيضاء المثالية ودوره في شرعنة الرعب المرتبط بالعنصرية قد ساعد – بلا شك – على منح الحملة صبغتها الثورية، ومثلما كانت النساء البريطانيات يحتجن أيدا ولز لتزودهن بالتحليل والشواهد المستمدة من التجربة المباشرة، كانت أيدا في حاجة إلى دعمهن حتى لا تواجه بالرفض والنبذ بوصفها امرأة أمريكية من أصل أفريقي، حانقة وغير عاقلة، قد جرؤت على انتهاك حرمة النساء البيض.
يتمثل الموضوع المحوري الأخير في البحث عن روابط أو تقاطعات بين أنساق التسيُّد المختلفة، وهو موضوع ألمحت إليه سابقًا، ويمكن إعطاء الأمثلة عليه من خلال مناقشة الإعدام خارج القانون. إن إنشاء ماهية المرأة البيضاء يتضمن – في هذا السياق – العمل على إبقاء النساء البيض في حالة معينة من التبعية للرجال البيض، فيتم تشكيلها في صورة ضحية بريئة، هشة بفعل طهارتها الأخلاقية، في حاجة إلى الحماية من الرجال (السود) بواسطة الرجال (البيض). ويهيئ هذا النمط من التسيد العنصري إنشاءات للذكورة والأنوثة السوداء تضع الرجال السود في صورة وحوش مفترسة تهدد سلامة النساء البيض. ثمة نمط مشابه يمكن تبينه في مسارد أحدث زمنًا عن الإجرام في باطن المدينة، فيمكن القول بأن النساء – وبخاصة البيض منهن – يتم إبقاؤهن في حالة خوف بوصفهن ضحايا محتملات لعنف الذكر الأسود، مما يؤثر في حقهن في استخدام الحيز العام. كما أن الأساليب الفاشستية في المراقبة الأمنية تكفل أن يتعرض الرجال السود للمضايقات إن لم يكن للإزالة قسرًا من الحيز العام، باسم الحفاظ على القانون والنظام. ۱۸
وفي ضوء ما نراه من التكرار المستمر في بعض إنشاءات الذكورة والأنوثة – التي هي إنشاءات معنصرة – يصبح من المهم أن نضع أيدينا على تلك اللحظات المؤسِسة حيث يتم – إنتاج هذه الإنشاءات، وكذلك على النقاط الزمنية المحورية حيث يتم إعطاؤها – هذه الإنشاءات – حيوية إضافية، ثمة حركتا تمرد رئيستان وقعتا في أواسط القرن التاسع عشر، وكانتا سببًا في التعجيل بوقوع جدل حاد حول أمن النساء البيض في الإمبراطورية، وكلتاهما تسجل علامة مهمة في تطور الأيديولوجية الإمبريالية، كما كان لهما تأثيرهما فيما أعقب من سياسة حكومية، وفي العلاقات الاجتماعية داخل المستعمرات، تتمثل الأولى في الانتفاضة القومية الأولى في الهند عام 1857، والمعروفة أيضًا باسم التمرد الهندي (Indian Motiny)، إذ طبقًا للاعتقاد الشعبي، ثم ذبح آلاف من النساء والأطفال الإنجليز على أيدي المتمردين الهنود الخارجين عن السيطرة. أما الثاني فهو انتفاضة خليج مورانت (The Morant Bay Uprising) الذي وقع في جامايكا عام 1865. وقد أشارت کاثرین هول Catherine Hall – التي كتبت عن الأخير في سياق نقاش عن تشكيل الهويات العرقية والهويات (النوعية) في الطبقات الوسطى الإنجليزية – إلى أن شبح التمرد الهندي كان يطارد العديد من المعلقين على حركة التمرد في جامايكا، كما ظهر على الأخص في القيام باستحضار الأخطار المحيقة بالسيدات الإنجليزيات من قبل الرجال السود الذين لا تحكمهم ضوابط أو قيود.19 وقد كان مصير هذين التمردين السحق الوحشي على أيدي القوات الإنجليزية، في الوقت الذي كانت الرغبة في الانتقام لشرف النساء البيض وفي حماية حياتهن تقف – بشكل جزئي – وراء إجازة هذه الممارسة القمعية.
في الجزء الأخير من هذه الورقة، أريد أن أحكي عن قصتين معاصرتين تعيدان ترميز وتنشيط تلك البني الأكثر قدمًا والأشد عمقًا، للمشاعر المتعلقة بالنساء البيض والإمبراطورية. وآمل من خلال ذلك أن أجعل فكرة “لحظات الخطر” واضحة بشكل ملموس، وأن أبين بالأمثلة كيف يمكن لذكريات الماضي أن تحدث تغييرًا في الأشكال التي تفهم بها أحداث تقع في الزمن الحالي.
تدور الحكايتان كلتاهما حول نماذج رهيبة من العنف المقترف ضد النساء على أيدي رجال من بلاد كانت فيما مضى مستعمرة من الإنجليز. وفي الحكايتين ثمة أهل يخوضون معركة ضد لا مبالاة الجهات الرسمية وضد بيروقراطية لا متناهية. في ضوء هذه المكونات، لا يبدو مثيرًا للعجب أن الإعلام البريطاني قد تولى متابعة هاتين الواقعتين بذلك القدر من التفصيل والاهتمام، وفي بعض الحالات بشكل يتسم بعدم اللياقة. كما لقيت هاتان المأساتان اهتمامًا أطول أمدًا بعض الشيء، على يد صحفيين قاموا بتأليف كتب عن ضلوعهم الشخصي في التحقيقات، وهي أعمال يمكن العثور عليها في أي مكان، بدءًا من فهرس الكتب النسوية إلى أكشاك الجرائد والكتب في المطارات، مصنفة تحت باب “جرائم من الواقع” (“True Cime”). 20
تخص السردية الأولى امرأة إنجليزية شابة بيضاء، إسمها جولي وارد Julie Ward، وقعت في غرام أفريقيا، مثل سائحة مقدامة. وبعد سفرها إلى شرق أفريقيا مع مجموعة رحلات سفاري عن طريق البر، أقامت مع بعض المغتربين في نیروبی، مقتصدةً في الإنفاق كي تقوم برحلات استكشافية داخل البلاد وتمارس هوايتها في تصوير الحيوانات البرية، وفي عشية اليوم المقرر لعودتها إلى إنجلترا، اختفت جولی وارد. وظهر فيما بعد أنها قتلت في ظروف غامضة وهي تقود سيارتها بمفردها عبر محمية للحيوانات المتوحشة، وتدور الحكاية حول المحاولات التي قام بها والدها لإثبات أنها قد اغتصبت وقتلت بواسطة حراس المحمية، من أجل العثور على المذنبين، مواجهًا مظاهر من اللامبالاة السياسية والغموض في مستعمرة بريطانية سابقة، تعمل على حماية صورتها بوصفها واحة للسائحين. وإذ وقعت وفاة جولي وارد في عام ١٩٨٨، فإن والدها لا يزال حتى اليوم يسعى إلى تحقيق العدالة رغم مرور أربعة أعوام. وقد طالب في يونيو من عام ١٩٩٢ بإجراء تحقيق جديد بعد قيام المحكمة العليا في نيروبي بتبرئة اثنين من حراس الحديقة من تهمة القتل.
بدون أن أقصد التقليل من قدر المأساة التي كابدتها جولي وارد هي وأولئك الذين يعرفونها، يستحق الأمر النظر عن قرب أكثر في بعض عناصر السردية التي أعارتها الصحافة اهتمامها. لدينا امرأة بيضاء – اتفق الجميع على أنها شخصية محبوبة وجذابة – تسافر بمفردها في البرية الأفريقية، التي وصف طبيعة أرضها أحد الصحفيين الذين كتبوا عن الحالة، قائلاً إنها “مكان ذو توحش طبيعي بدائي“.21 وقد ثبت على الفور عدم صحة الزعم الغريب من قبل الشرطة المحلية بأن الحيوانات المتوحشة قد التهمت جسدها (الأبيض)؛ وذلك بالعثور على جزء من ساقها، المغطاة ببنطال من الجينز، على مقربة من بقايا متفحمة لشعلة نار. إلا أن تقرير الطبيب الشرعي الأول الذي جاء فيه أن الساق قد فصلت عن بقية الجسد بواسطة آلة حادة، قد تم تغييره على وجه السرعة تحت ضغط من أطراف كينية رسمية كي يبقى إمكان موتها بأيدي الحيوانات المفترسة واردًا لأطول فترة ممكنة. وقد قام جوني وارد، والد جولي – الذي كان حاضرًا في الموقع بعيد اكتشاف الأجزاء الأولى من بقاياها – بوصف معركته مع السلطات الكينية، بالتفصيل الدقيق، في كتابه إن الحيوانات لبريئة The Animals are Innocent. وكان لدوره في مواجهة عدد لا نهائي من المسئولين بالأدلة التي كان قد أعدها بمساعدة محامييه، الفضل في إتاحة الفرصة لوسائل الإعلام أن تقدم تكهنات عن الأفعال الماكرة التي يقوم بها بلد مستقل من أفريقيا السوداء، يقاوم تدخل رجال الإنجليز البيض الذين يحاولون تعليمهم كيف يديرون شئونهم. وقد قام مايكل هيلتزك Michael Hiltzik – وهو صحفي في جريدة لوس انجلس تايمز Los Angeles Times كتب تقريرًا مثيرًا عن التحقيقات في جريمة قتل جولي – بتخصيص عدة فصول من كتابه لتناول تاريخ الحكم الاستعماري في كينيا، محاولاً وصف صورة العلاقات الاجتماعية على الصعيدين الطبقي والعنصري في نيروبي. واستحضاره لرواية الخروج من أفريقيا Out of Africa لكارين بليكسن Karen Blixen في سياق توصيفه للطبيعة في كينيا إنما يمثل تأكيدًا جديدًا على كون تجربة الاستعمار تعمل بالفعل بوصفها عدسة تتم من خلالها رؤية الجريمة الغامضة المتعلقة بمقتل جولي، حتى بعد قرابة ثلاثين عامًا من الاستقلال.
تمثل زانة ونادية محسن محور السردية الثانية، وهما أختان من برمنجهام في إنجلترا، تم اصطحابهما حين كانتا في الخامسة عشر والرابعة عشر من عمريهما في أجازة إلى اليمن الشمالية، مسقط رأس والدهما المهاجر إلى إنجلترا، ليتم هناك تزويجهما كرهًا إلى صبيين لا يكبرانهما إلا قليلاً، ثم تصبحان عمليا سجينتين في منطقة جبلية نائية. وفي هذه الأثناء، اختفى الأب بالمال الذي حصل عليه في مقابل الزواج، بينما ظلت والدتهما – وهي ليست من أصل يمني– تحاول بلا جدوى دفع المسئولين البريطانيين إلى إرسال من ينقذهما. وكانت جريدة الأوبزرفر The Observer، وهي صحيفة أسبوعية ليبرالية تنال احترامًا بفضل تغطيتها للشئون الدولية، هي التي وضعت هذه في بؤرة الاهتمام الإعلامي، وأرسلت صحفية ومصورًا بهدف العثور على الشابتين وإخراج قصتهما إلى النور بعد سبع سنوات من اختفائهما. وكان المقرر أن الصحفيين قد تلقيا تعليمات بألا يحاولا إنقاذ الفتاتين وإلا يعرضان نفسيهما للقتل، ومع ذلك فإنهما منذ اللحظة الأولى لالتقائهما بهما، داخلهما الاقتناع بأنه من واجبهما انتزاع الفتاتين من مثل هذه الثقافة “المتخلفة” وهذه البيئة المعادية. والأختان من ناحيتهما قامتا بالتوسل إلى الصحفية آيلين ماكدونالد Eileen Macdonal من أجل أن تأخذهما من هناك، فسردتا تفصيلات مؤلمة عن الخديعة التي أدت إلى زواجهما بالإكراه ثم إنجابهما أطفالاً، ومن الواضح أن آيلين ماكدونالد قد أخذت هذه المهمة على عاتقها بوصفها حربًا شخصية، فقد نشرت كتاب يحمل تقريرًا عن تجاربها في السفر عبر اليمن الشمالية وعن محاولاتها مع الديبلوماسية البيروقراطية التي أسفرت في النهاية عن قيام زانا بزيارة إنجلترا. ويستطرد كتابها عرائس للبيع؟ Brides for Sale? شارحًا مظالم النظام البطريركي، ساعيًا إلى اتخاذ وجهة نظر الفتاتين طول الوقت. وتنظر الكاتبة إلى اليمن الشمالية بوصفها بلدًا يحمل للنساء آفاق حياة كئيبة وغير مجزية، تضطر فيه المسافرات من نساء غربيات للانصياع إلى تقنينات مقيدة على صعيد الملبس والمسكن والمسلك، في سبيل تجنب جذب نوع غير مرغوب فيه من الانتباه. بيد أن الكتاب ينتهي بنغمة حائرة؛ إذ تتم إعادة زانا بالطائرة إلى إنجلترا حيث يجتمع شملها مع أمهما، ولكنها بدلاً من أن تعبر عن امتنانها لإطلاق سراحها، تبذل جهدها في محاولة إقناع منقذيها بالتحول إلى الديانة الإسلامية، قائلة إنها لا تريد أن تكون امرأة بريطانية.22 مما يترك لدى القارئ انطباعًا بأن المهمة قد أتت بما لم يكن في الحسبان، وأن الفتاتين على الأرجح سوف تبقيان في اليمن، عن اختيار منهما. وينتهي الكتاب في مرارة قائلاً: “لوالد زانا أن يبتهج، فإن المجتمع اليمني قد احتضنه: إنهم في جانب وبريطانيا في الجانب الآخر“.
تختلف هذه السردية التي استخلصتها من أصل أكثر طولاً وتعقيدًا بصورة ملموسة عن تلك المتعلقة بمقتل جولي وارد، وذلك على عدة أصعدة، فالفتاتان حاصلتان على المواطنة البريطانية ولكنهما ليستا من أهل البيض، كما أن والدهما هو الذي يمثل دور الشخصية الشريرة في هذه القصة، كذلك كان الموقع الذي دار فيه أكبر جزء من وقائع العنف والخداع يتمثل في مجتمع المهاجرين داخل برمنجهام، أي في مستعمرة داخل ورشة عمل الإمبراطورية القديمة، وليس – كما في القصة الأخرى – في مجتمع ما بعد استعماري يسعى إلى إثبات استقلاليته عن السيطرة البريطانية. وعلى خلاف جولي وارد، فإن زانة ونادية محسن قد بقيتا على قيد الحياة لتتمكنان من وصف تجاربهما المرعبة ومن تخيل نفسيهما تقدمان على الهرب إلى وطنهما السابق، حتى وإن كانت قد تكونت لديهما مشاعر متناقضة تجاهه، على أن بيت القصيد لا يكمن هنا في محاولة الربط بين مصائر الشابات الثلاث، وإنما في النظر إلى الكيفية التي يمكن للتحليل النسوي أن يؤول بها ما قد يكون لهاتين السرديتين المتعلقتين بالثقافة والصراع من معانٍ رمزية في المجتمع البريطاني المعاصر؛ وهو لابد أن يكون تحليلاً نسويًا من النوع المتيقظ للعلاقة التاريخية بين “إملاءات (النوع) والتخوم العنصرية“.
كما قد ذكرت، فإن البلدين المتورطين في “لحظات الخطر” هذه، ينتمي كلاهما إلى المستعمرات البريطانية السابقة، مما يعطى صلة مباشرة مع الماضي الإمبريالي كما يعني عدم إمكان تحرر أي البلدين من تداعيات تربطه بالاستعمار. فمن خلال النظر إلى صورة الأنوثة البيضاء المنتَجة في هاتين السرديتين، من الممكن أن نرى
كيف تؤثر الذكريات الاجتماعية المتعلقة بهذا الماضي في طريقة قراءة السرديتين في الوقت الحالي. بيد أنها ليست سيرورة بسيطة ومستقيمة الخط، وإنما هي مسألة “الإمساك” بتلك الصور الشظوية إذ تطرأ لنا، حتى نفهم لماذا تستمر هذه السرديات في وساطة قضايا سياسية مهمة. إن جولي وارد، وهي بمفردها عرضة للمخاطر، داخل سيارتها الجيب المتعطلة، قد وقعت طبقًا للادعاء فريسة لرغبة الرجال السود الخارجة عن السيطرة، وتلك ملحوظة أصدرها القاضي في أثناء محاكمة حراس المحمية المتهمين باغتصاب جولي وقتلها، مشيرًا إلي أن أحد المذنبين المحتملين الذين أفلتوا من المحاكمة، “مولع بالنساء البيض“.23 إن تاريخ الأفكار والتداعيات الذي يخيم على هذا الثنائي – الرجل الأسود والمرأة البيضاء – لا يجعل من السهل تجريد هذه الحادثة من معانيها المشكلة بأبعاد عنصرية وأساطيرية. على أن هشاشة وضع جولي تزداد تعقيدًا بفعل إقدامها على قيادة سيارتها عبر محمية الحيوانات، وهي وحيدة بلا صحبة، إذ يوحي ذلك بشيء من التهور، بالاستعداد للوثوق في أهالي البلد في حالة نشوء خطر. تجد هنا صورة الأنوثة البيضاء مكانها إلى جانب تلك الصور المتكررة في القصص الخيالية عن عهد الاستعمار، والتي تمثلها تمثيلاً نموذجيًا شخصية أدلا كويستد Adela Quested في رواية ممر إلى الهند A Passage to India حيث ينتهي بها حب استطلاعها لأراضي الهند الممتزج بنزوع للثقة في الغير، إلى كارثة من نوع آخر.24 بيد أن كينيا هي أرض رحلات السفاري، لا أرض الآلهة الغربية، وهي بلد يتم تناول صورته في منشورات الدعاية السياحية وفي خلفيات صور أزياء الموضة، بوصفه – ويا للعجب – خاليًا من سكان وثقافات إنسائية، فيما عدا أولئك الذين ترفعهم أزياؤهم المحلية إلى منزلة الأشياء المحاطة بالغرابة والغموض التي تحظى بها الحيوانات البرية الهائمة في المحميات. تهيئ كينيا المشهد الخلفي المثالي لإنشاء صورة للمرأة البيضاء بوصفها مستكشفة، في إيحاء بالقوة والاستقلالية، بلمسة تجمع خصائص الذكورة مع الأنوثة (androgyny) إلى غرابة الأطوار أيضًا، في حين تبدو هشاشة وضعها أكثر بروزًا بفضل مجاورتها للأسود والخراتيت ومحاربي الماساي. وينبع جزئيًا هذا الإنشاء من حكايات أبطالُها شخصياتٌ من عهد الاستعمار مثل أيزاك دينسن Isac Dinesen وبيريل مارکهام Beryl Markham،25 ويتم إنعاشها بصفة مستمرة من خلال مقالات مصقولة موجهة إلى النساء من خلال مجلات مثل فوج Vogue 26 وآل Elle وأيضًا من خلال موضوعات السفر والسياحة على صفحات ما يسمى بالصحافة “الراقية” (quality” press”). وبالمصادفة، أفردت إحدى جرائد يوم الأحد صفحاتها لموضوع من هذا النوع في الأسبوع نفسه الذي انتهيت فيه من كتابة هذه المقالة، بالتزامن (وأعتقد أنه من باب المصادفة الحقيقية) مع صدور تقارير الحكم النهائي في جريمة قتل جولي وارد. والموضوع عنوانه “الجنون بكينيا” “Wild about Kenya”، وتم افتتاحه بالعبارات الآتية: “لا زالت كينيا قادرة على تقديم التجربة الأفريقية الأصيلة؛ مراسلتنا أنجلا بالمر تتذوق شيئًا من سحر الحيوانات“. وتشير الفقرة الأولى – على نحو مباشر – إلى صورة كينيا التي تلطخت كمرفأ للسياح، مع حرص على تجنب ذكر فيض الاعتداءات الذي تعرض له السياح مؤخرًا على يد العصابات المحلية، فتذكر:
مسكينة كينيا، بمجرد أن يأتي ذكرها لا يلبث أن يقول أهل السخرية والتشاؤم إنها قد انتهت تحت اجتياح سائحين معبئين في ميني باصات مطلية بنقوش جلد الزراف لا ينتهون من دفع عدسات التصوير المكبرة في وجوه الحيوانات المنذهلة. ليس مستغربًا أن تثير هذه الصور ثائرة خبراء كينيا القدامي، وأولهم سيدة اسمها بريم روز ستوبز، وقد كانت مزارعة أرستقراطية في عهد الاستعمار وتمثل حاليًا قوة ذات شأن في عتاد شركة أبركرومبي وكنت، خبراء السياحة الأفريقية. 27
وتواصل المقالة فتحكي عن رحلات سفاري من مستوى أرقى توفرها السيدة ستوبز، تحفل بمشاهدات لطيور وحيوانات نادرة، أما البلد نفسها وسكانها فلا يحظون بذكر، ولكننا نجد الصورة المتوقعة بالطبع لكاتبة الموضوع على ظهر جمل، في حراسة اثنين من رجال الماساي، ويقول عنوان الصورة: “ركوب الطبيعة المتوحشة: الكاتبة تبتعد بقدميها عن الدواب الزاحفة المثيرة للخوف“creepy crawlies”. إن هذا النوع من الكلام الذي يحمل معنيين ويتضمن إنشاءً لأهالي البلد بوصفهم نوعًا أو جزءًا من حياة الطبيعة المتوحشة – أحيانًا مثيرة ومستحقة للحماية وأحيانًا مثار للتهديد والخطر – لهو بالغ الدلالة في هذه القراءة لقصة جولي وارد. إذ إنه في حين تقوم أدبيات الرحلات والموضة بإنشاء الماساي بوصفهم ناسًا بربريين يضيف وجودهم مزيدًا من الإبهار إلى طبيعة المكان، ترسم لهم التقارير الصحفية عن حادثة جولي وارد صورة أكثر شؤمًا بصفتهم أناسًا يعيشون خارج مجال الحضارة، لا تمسهم في شيء متطلبات نزعة العقلانية الحديثة، وبالتالي متطلبات العدالة. وقد انتقد القاضي – وهو يصدر حكمه في القضية بعد محاكمة استمرت ۱۸ أسبوعًا – المخبرين الموفدين من لندن للتحقيق في القضية قائلاً إنهم “نسوا أنهم يتعاملون مع شباب من رجال قبائل الماساي قادمين من البرية“. 28 كما قامت جريدة التايمز، بمناسبة انتهاء المحاكمة، بإرسال أحد محرريها بهدف الوصول إلى “الحقيقة“. والصحفي الذي كان معه مترجم، ويزعم أنه متعاطف مع المتهمين، وجد أنه الصعب الحصول على “إجابة مباشرة“:
قال لي المترجم: “هم يقولون إنهم لا يحبون النميمة، وهذه هي الحقيقة، فالحديث في شئون الآخرين يُعَدُّ أمرًا يدني من قدره“. جدار من الصمت؟ الماساي يضمون الصفوف لحماية واحد من جنسهم كما لو أنهم يتبعون أحد قوانين المافيا؟ لا عجب في أن رجال الشرطة القادمين من لندن لم يتعرفوا على طريقهم وسط الأحراش.29
حيث يهيم الأفارقة البهيميون في أرجاء طبيعة متوحشة، فإن وجود الحيوانات يساعد أيضًا على إبراز بعض جوانب أنوثة المرأة البيضاء. فالكتاب الذي نشره والد جولي – والذي يحمل عنوان إن الحيوانات لبريئة، في إيحاء ضمني بأنه لابد إذن من أن الناس هم المذنبون – يحمل غلافه صورة كبيرة لجولي تبتسم في سعادة، وهي تحمل قردًا شمبانزي بين ذراعيها، وقد كتبت دونا هاراويي Donna Haraway في إسهاب حول مثل هذه الصور ونطاق المعاني المعقد الذي يوحي به هذا النوع من المزاوجة بين المرأة البيضاء والحيوان الرئيس (primate): 30 إن وضع هذا العنوان إلى جوار الصورة – التي أصبحت صورة جولي التقليدية في الصحف – يفلح في الإيحاء بما تكنه المرأة الإنجليزية من انبهار بريء وغير ضار بالحيوانات البرية وبقدرتها على الاقتراب منها، فيلعب دوره بوصفه نذيرًا يذكّر بأن هذه الثقة المتساهلة هي الشيء الذي أصبح محل خيانة وغدر في لقائها مع الرجال المتوحشين الأحراش.
إن صور الأنوثة البيضاء التي قمت بتحديد معالمها في سردية جولي وارد يتم إنشاؤها أساسًا بالنسبة إلى الرجال السود والحيوانات وطبيعة الأرض. وإذ ألتفت الآن إلى السردية الثانية، أود إظهار كيف أن تمثيل الشقيقتين – زانة ونادية محسن – يتضمن كذلك مقارنات مباشرة بين أنواع مختلفة من الأنوثة. لقد أشرت في كتابي – ما بعد حدود المسموح به – إلى أنه على الصعيد التاريخي كثيرًا ما كانت المكانة التي تفرد للمرأة داخل ثقافة ما تتخذ مؤشرًا يدل على الدرجة النسبية من التحضر، وأشرت إلى أن صورة المرأة البيضاء المسيحية تظهر في ضوء إيجابي على خلفية صورة الأنثى الشرقية، التي هي دائمًا مسلمة، مغتصبة الحقوق وخانعة 31. لهذا الخطاب أثره العميق في طريقة تناول قصة الأختين في الصحافة البريطانية، فالفتاتان – مهما كان – قد تعرضتا عمليًا للاختطاف وتم نزعهما من بلد من المفترض أن النساء فيه قد نلن حريتهن، وحبسهما في بلد آخر حيث أجبرتا على الحياة أشبه بالجواري لدى رجال. ولست هنا بصدد القول بأن أي انتقاد للرجال اليمنيين يدخل في باب التمييز العنصري، وإنما لابد أن يتنبه التحليل النسوي إلى تأثير هذه الحكايات في تغذية الأفكار العنصرية القائمة فيما يخص الثقافات الإسلامية.
إن صورة الأنوثة البيضاء المحررة في هذه القصة تقدمها الصحفية آيلين ماكدونالد، التي تزودنا من خلال مسردها عن عملية الإنقاذ برؤية ذاتية كاشفة تلقائيًا عن الاختلاف العرقي والثقافي بين النساء. وتُذكِّر حكايتها بحكاية آنيت أكر ويد صاحبة ممر إلى الهند منذ أكثر من مئة عام، من حيث إن كلتا المرأتين بدأتا من منطلق الرغبة في تحرير نساء شرقيات من بطريركية رجال عشيرتهن، وكلتاها على الطريق وجدتا نفسيها تنفران اشمئزازًا من بعض عناصر ثقافة تستعصي على فهمها 32. وتعد المخاطرة التي أقدمت عليها آيلين ماكدونالد رمزًا يشير إلى نوع من النسوية، فقد تم إدراج كتابها في قائمة الكتب المرشحة لقراءات نادي الكتب للنساء (Women’s Book Club)، وهو عبارة عن نظام معروف واسع الانتشار في بريطانيا ترسل من خلاله الكتب النسوية بالبريد بعد اختيارها من قائمة معينة.
ومثلها مثل عديد من المعلقين على مجتمعات غير مسيحية – بمن فيهم آنيت أكرويد – ركزت آيلين ماكدونالد على الملابس بوصفها علامة دالة على الاختلاف الثقافي، معبرة في وضوح عن ضيقها بالقيود المفروضة على طراز ملابسها أثناء زيارتها لليمن الشمالية:
ظللت أشعر بعدم الراحة أمام نظرات الرجال المحملقة. لم أكن ارتدي ملابس كاشفة بالمرة، فبناءً على نصيحة وزارة الخارجية بإحضار ملابس ثقيلة، كان معي زوجان من بناطيل القطيفة السميكة وبنطال من القطن. هذا هو ما كنت أرتديه، بالإضافة إلى حذاء برقبة طويلة، وذلك في حرارة تقترب من ٣٢ درجة مئوية. كما كنت أرتدي قميصًا طويلاً مزررًا حتى الرقبة وأضع نظارات شمسية. من الطبيعي أن أتخيل أنها ملابس مقبولة من الجميع.33
بيد أنها قد اكتشفت – فقط فيما بعد – أن الناس ظلوا يحدقون فيها؛ لأن قميصها كان مدفوسًا داخل بنطالها. وتواصل شكواها قائلة: “لقد سئمت من قيام الرجال بلمسي وبالتحديق في وبالزعق في، كما لاحظت أن النساء تدير رأسها في الاتجاه الآخر في إيماءة من يرى أمرًا فاضحًا“، ولعل مقاطع من هذا القبيل تدعو القارئ – المفترض أنه بريطاني– أن يشارك الكاتبة نفاذ صبرها على مجتمع يبدو أنه يقر المعاملة غير الإنسانية للنساء على يد الرجال، التي يرمز إليها هذا الإلزام بارتداء الحجاب والملابس التي “تشبه الخيام“. كما تتولى آيلين ماكدونالد في مناسبات مختلفة عبر كتابها، لفت الانتباه إلى الملابس التي كانت الأختان ترتديانها، على سبيل تسجيل انتقالهما من ثقافة “غربية” عصرية إلى أخرى إسلامية “متخلفة“، فقبل أن تحزم الابنة الكبرى زانة ملابس العطلة في اليمن، أخبرها والدها أن “اليمن منفتح على الفكر الغربي عن الملابس“، وحين وصلت إلى تعز لتقيم عند أقارب لها ووجدتهم يتكلمون عنها باستمرار في خفية منها، فسَّرت ذلك بصفته إحدى علامات الفضول أمام رؤية “فتاة غربية في قميص وجونلة ضيقة“،34 ولكن في الصباح الذي أعقب الليلة العصيبة، أول ليلة لها بوصفها امرأة متزوجة، “أخذوا من زانا ملابسها، وأشارت حماتها إلى كومة من الملابس العربية وغطاء الرأس“،35 وحين رأی الصحفيان البريطانيان الفتاتين لأول مرة بعد ذلك بعدة أعوام، شاهدا “الفتاتين مغطاتين من الرأس إلى القدم في لباس عربي، ووجهاهما مستران بالحجاب“36. وكان أول مشهد لزانة عند عودتها إلى إنجلترا هو مشهد “فتاة في ملابس عربية بيضاء، تتضمن حجابًا“.37 وبعد ساعات من التئام شملها مع أمها، وفي وجود آيلين ماكدونالد، أعلنت الفتاة: “أريد العودة إلى تعز والحصول على عمل. سوف أقوم بزيارة إنجلترا حين أرغب، ولكنني لست متأكدة من أنني أريد أن أصبح امرأة بريطانية على أية حال، أنا لا أحب الجونلات الضيقة القصيرة، هذا شيء مثير للقرف” 38.
إن تأكيد المرأة الإنجليزية على الملابس بوصفها مؤشرًا على خضوع النساء يستدعي عددًا لا حصر له من سرديات الرحلات التي تسجل لقاءات أوربيين و“الشرق“. وهذا التقرير الذي تكتبه آيلين ماكدونالد بوصفه مسردًا فاضحًا عن مهمتها الصحفية هناك، والذي يحفل بملحوظات ذاتية تعطى جوًا وإثارة، ينجح هذا التقرير في تعزيز التصورات عن تخلف الثقافات العربية، وذلك عبر تكرار بعض الصور النمطية عن الذكورة والأنوثة. ومما يجدر بإثارة الاهتمام أن نقارن بين موقفها وموقف آنيت أكرويد التي جرحت حساسيتها الفيكتورية بسبب الملابس التي ترتديها زوجة راعيها الهندي: “لقد كانت تجلس كأنها مخلوق وحشي لم يعرف أبدًا معنى الكبرياء ولا التواضع – ظهرها في اتجاه زوجها، حجابها مسدل على وجهها – تمثل في جملتها منظرًا مؤلمًا – لها سلوك طفلة عبيطة مدللة، هكذا بدت لي، وأنا أرقبها تلعب بخواتمها ومصاغها“.39
يبدو واضحًا جليًا من البداية أن آيلين ماكدونالد ليس لديها وقت للرجال العرب، الأمر الذي له – مرة أخرى – أثره في تأكيد موقعها الشخصي بوصفها المرأة البيضاء المستقلة والمتحررة. كما أنها تعبر في – أكثر في موضع – عن غيظها من الافتراضات التي يعقدها اليمنيون بشأن علاقتها بالمصور، بن جيبسون، الذي يصاحبها: “كان الحديث كله يوجه إلى بن، ونظرات مندهشة يرمونه بها حين أتحدث كما لو أنه من المفروض أن يلزمني بالصمت. كان الكل يفترضنا رجلاً وزوجته، بالرغم من اختلاف لقبنا العائلي. أنْ نقوم بالسفر معًا دون وجود رابطة زوجية أمرٌ يفوق قدرتهم على التصور.”40
ويذكرني هذا النوع من التعليق – المصحوب بعداء مكشوف تجاه الرجال العرب– يذكرني مرة أخرى بملحوظات آنيت أكرويد التي لها نزعة أكثر صراحة نحو إصدار الأحكام. فهي بعد حضورها اجتماعًا في مكان مكشوف في كلكتا كتبت الآتي:
لا أعتقد أن عدد النساء الموجودات في هذا الجمع قد بلغ حتى ثلاثة، ومن المؤكد أنني كنت السيدة الوحيدة. وبوصفها النتيجة طبيعية لندرة ظهور النساء، كان الناس ينظرون إلىَّ في اندهاش عميق، فأدركت – للمرة الأولى – كم هي غير متحضرة مفاهيمهم عن النساء، لقد قرأت ذلك في أعينهم، ليس تمامًا في أعين أولئك الذين كانوا ينظرون إلىَّ في وقاحة، إذ إن الوقاحة تعبير لا تجهله الحضارة! وإنما في نظرة العجب الفارغة التي كان معظمهم يتفحصونني بها.41
وقعت آیلین ماكدونالد ورفيقها في المشاكل حين حاولا تصوير النساء رغم أنهما كانا قد أحيطا علمًا بأنه لا يُعَدُّ من اللائق بالمرأة أن تسمح بالتقاط صورتها لاسيما لشخص من الغرباء، وإذ كانت مهمتهما تتضمن إعداد “مقالة عامة عن نوع المجتمع الذي تعيش فيه الفتاتان“، فقد اضطر الصحفيان الجريئان إلى استخدام السرعة والحيلة، ليختطفا الصور المناسبة من وجهة نظرهما. ويُستدخل القارئ في المحاولات التي أجرياها لإقناع مختلف مرافقيهما بأنهما ليسا إلا سائحين بريئين أو طالبين في مدراس الفن أو حتى طبيبين، أو أي شيء سوي صحفيين. ولتبرير هذا النوع من الخداع – بحجة تتبع أثر الأختين (في البدء ليس لتحريرهما وإنما لإجراء مقابلة معهما)- يتم تمثيل الرجال اليمنيين بصفتهم أطرافًا متواطئة على إخضاع نساء اليمن جميعًا، ويتم إنشاء صورة الذكورة العربية، في مجتمع مهاجري اليمن داخل برمنجهام كما في اليمن نفسه، بوصفها ذات معايير مزدوجة، غير عقلانية، ميالة إلى العنف وبالغة السيطرة على المرأة. كما يصور کتاب آیلین ماكدونالد الرجال اليمنيين بوصفهم مثارًا للسخرية، ففي أحد المقاطع – على سبيل – المثال تحكي الكاتبة عن موقف مشحون بالتوتر تم الخروج منه عن طريق توزيع كمية من القات، الذي تصفه بـ “المخدر الخفيف الذي يمضغه الكل من الوزير إلى الفلاح، والذي جئنا به معنا، وحين وزعناه بدأ المضغ المتواصل، مما جعل الرجال يبدون بأوداجهم المنتفخة وكانهم نماذج من بوبيي[شخصية رجل في أفلام الرسوم المتحركة الأمريكية يأكل السبانخ فتنتفخ عضـلاته ويمتلئ بالقوة.] (Popeye).42
تبرز هذه الإشارات إلى القات – بوصفه عاملاً يفسر المسلك غير العقلاني للرجال – بغتة في الكتاب مرات متكررة، وفي هذا المقتطف الأخير تصف آيلين ماكدونالد بنبرة بالغة الاشمئزاز رحلة في الجبال بصحبة مرافق:
أصبحت قيادته السيارة أقل كفاءة، مع الله بدا ممتلئًا بحبوب الفول، قطع منحنى في الجبل أو اثنين في سرعة تلوح الرقاب، بتأثير من القات على الأرجح. ظل يضع مزيدًا من الأوراق داخل فمه، دون أن يلفظ تلك التي لا تزال في فمه. من حين إلى آخر، كان بيصق خارج النافذة، لقد شاهدنا في كل أنحاء اليمن سائلاً أحضر جف على أرض الطريق، هو نتاج الهواية الرئيسية التي يقطع بها الشعب أوقات فراغه.43
تتمثل المفارقة الساخرة في كتاب آيلين ماكدونالد في أنه كان مفترضًا أن ينتهي بعودة الأختين شاكرتين إلى طراز الحياة المتحررة في برمنجهام، بعد إنقاذهما على يد امرأة إنجليزية من حياة الذل والخضوع لرجال غير متحضرين. وبدلاً من ذلك، نجد توقعات يائسة أن حياة المرأتين ليس لها إلا “الضياع“، في هذا البلد أو في ذاك، حيث إن معايشتهما لثقافتين على هذا القدر من الاختلاف سوف تؤدي إلى تدمير فرصهما في السعادة في ظل أي منهما. وتبرز هذه النهاية نوعًا من التعقيد الغائب عن السردية الأصلية، حيث – أخيرًا – يُعترف بشكل غير مباشر بأن الحياة بالنسبة إلى امرأة مسلمة من الطبقة العاملة في بريطانيا ليست بالضرورة أفضل كثيرًا من الحياة في قلب مجتمع إسلامي.
لكي تبقى النسوية متيقظة لصور الأنوثة هذه، المتعددة الطبقات والموروثة عن الماضي، فإنها تحتاج إلى إعادة إنشاء تواريخ الأفكار والتصورات عن النساء، من منظور لا يسجل فقط أبعاد (النوع) المتغيرة في حد ذاتها، وإنما يسجل أيضًا المفاهيم المتشابكة المتعلقة بالاختلاف العرقي والثقافي والطبقي، إذ إن الخطر الذي ينشأ عن إغفال العمليات الصامتة الخفية في كثير من الأحيان، التي تحدث في إطار التسيد العنصري على امتداد تواريخ النساء، إنما يشكل تهديدًا لقدرة النساء على البقاء بوصفهن حركة سياسية. والسياسة النسوية المجهزة للتعرف على الطرق التي تقوم عبرها صورة الأنوثة بتنشيط قضايا سياسية معاصرة، تقدر أيضًا على مجابهة أنواع أخرى من الأخطار.
تلعب التصورات المتعلقة بالثقافات العربية على سبيل المثال – التي ناقشتها بإيجاز من خلال سردية الأختين زانة ونادية محسن – دورًا في تعزيز الصور النمطية التي تؤثر في حياة المسلمين المهاجرين أو المستوطنين في بريطانيا، وهي تظهر باستمرار في الخطابات المتداولة في الساحة العامة حول العنصرية والاختلاف الثقافي. ومما لا شك فيه أن بعض تلك الأفكار عن بربرية الرجال لعرب قد وُظفت لتأمين تأييد القوات الإنجليزية والأمريكية، أثناء حرب الخليج، حين بلع النفور من أنواع معينة من العروبة مدى جديدًا. وعلى غرار ذلك، فإن المفاهيم الخاصة بالذكورة السوداء التي يتم إنشاؤها بالنسبة إلى الأنوثة السوداء والبيضاء، تسهم في تشكيل تصورات عن الرجال السود بصفتهم نهابين، ميالين إلى الإجرام، أو متمردين عصاة، سواء داخل حواري بريطانيا، أو في جنوب أفريقيا، أو في جنوب مركز لوس أنجلس.
إنْ كان للنسوية أن تناضل من أجل إثبات شرعية منظوراتها النقدية فلابد لها من أن تكون قادرة على التدخل في جدالات السياسة المعاصرة مستخدمة منظورًا مستفيدًا من التاريخ ومناهضًا للعنصرية، فذلك أمر يتوقف عليه مستقبل النسوية، في بريطانيا على الأقل.
* Vron Ware, “Moments of Danger: Race, Gender, And Memories of Empire” in History and Feminist Theory: Studies in the Philosophy of History, Beheift 31 (1992), 116- 137.
** تستخدم المترجمة تعبير “البياض” مقابل whiteness إذ فضلاً عن أن اللفظة الأولى هي المقابل اللغوي الحرفي للثانية، فإن الاثنتان لهما الوقع نفسه غير المألوف كل واحدة داخل لغتهـا. ولا تقصد المؤلفة بالبياض الإشارة إلى بياض لون البشرة في حد ذاته وإنما إلـى إنشـاء شعوب أوروبا (وبالتحديد بريطانيا الاستعمارية) لهويتها العنصرية، عبر تصوراتها عن الأنثى البيضاء على الأخص مقابل الذكر أو الأنثى في عنصريات أخرى من الشعوب المستعمَرة.
1 – walter Benjamin, Illuminations (London, 1977).
أود أن أشكر بول جيلوري على قيامه بإرشادي نحو بنجامين وعلى النقاشات المفيدة التي دارت بينا في غضون كتابتي لهذه المقالة.
2 – Vron Ware, Beyond the Pale: White Women, Racism and History (London and New York, 1992).
3 – Joan Scott, Gender and the Politics of History (New York 1988).
4 – انظر/ انظري هذا إلى مقالتي من حيث دخولها في حوار مع كتابات حديثة أخرى معنية استكشاف البياض، مثل:
David R. Roediger, The Wages of Whiteness: Race and the Making of the American Working Class (London and New York, 1991); Ruth Frankenberg, White Women Rece Matters: The Social Construction of Whiteness (University of Minnesota Press forthcoming 1993); and bell hooks, Black Looks: Race and Representation (London 1992), especially chapter 11, “Representations of Whiteness in the Billack Imagination”
5 – Hooks, 165.
6 – Elizabeth V, Spelman, Inessential Woman: Problems of Exclusion in Feminist Thought (London, 1983), 161-162
7- Hazel V. Carby, Reconstructing Womanhood: The Emergence of the Afro-American Woman Novelist (New York and Oxfond, 1987), 20-21.
8 – Pratibha Parmar, “Hateful Contraries: Media Images of Asian Women” in “Critical Decade: Black British Photography in the 80’s,” Ten 8 2 (1992), au 3, 54.
9 – بالرغم من دراسة آنا ديفين الكلاسيكية عن الإمبريالية والأمومة، التي تناقش الروابط بين الأيديولوجيات العنصرية والسياسة الاجتماعية تجاه النساء الإنجليزيات، انظر/ انظري مقالتها:
Anna Davin. “Imperialism and Motherhood,” History Workshop Journal 5 (Spring 1978).
۱۰ – انظر/ انظري على سبيل المثال:
L. Billington and R. Billington Women in the British Antislavery Movement, 1820-1860″ in Equal or Different: Women’s Polifics 1800- 1914 ed. Jane Randall (New York and Oxford, 1987).
وذلك رغمًا عن أن هذه المقالة تحاول فعلاً أن تتعرض للعلاقة بين حركة إلغاء الرق والنسوية. من ناحية أخرى، فإن كتاب كلير ميدجيلي الماثل للنشر يمثل جهدًا يعتد به للخروج عن النظرة المحصورة في دور النساء في حركة مناهضة العبودية:
Clare Midgeley, Women Against Slavery (Routledge, London, 1992).
11 – Catherine Hall, White Male and Middle Class: Explorations in Feminism and History 11 (Cambridge, Eng, 1992), 209.
12 – Anne Laura Stoler, “Carnal Knowledge and Imperial Power” in Gender at the Crossroads of Knowledge: Feminist Anthropology in the Postmodern Era, ed. Micaela di Leonardo(Berkeley and Oxford, 1991), 55.
13 – James Fentress and Chris Wickham, Social (Oxford and Cambridge, Mass., 1992), 89. 90 Memory
14 – المصدر نفسه، ص 140- 141.
15 – Luisa Passerini, Fascism in Popular Memory: The Cultural Experience of the Tarin Working Class (New York and Cambridge, Eng., 1988), 67- 68.
أدين لباربرا تايلور بفضل إرشادي إلى عمل لويزا باسريني.
16 – Asia in Western Fiction, ed. Robin W. Winks and James R. Rush (Manchester, Eng. 1990).
17 – Renato Rosaldo, Culture and Truth: the Remaking of Social Analysis (Boston 1989), 68 – 87.
18 – لقد استفضت في شرح هذه النقطة في سياق كتابي ما بعد حدود المسموح به، انظري ص 4 -11، للتعرف على مسرد أكثر تفصيلاً عن الإنشاء الاجتماعي للإجرام عند السود، انظري المقالة الآتية:
Paul Gilory, “Lesser Breeds Without the Law” in There Ain’t No Black in the Union Jack: The Cultural Politics of Race and Nation (Chicago, 1991).
19 – Hall, 282- 285.
20 – Michael A. Hiltzik, A Death in Africa: The Murder of Julie Ward (London 1991).
كان مؤلف الكتاب يشغل وقتها مركز رئيس مكتب جريدة لوس أنجلس في نيروبي. كذلك فقد قام جون وارد والد جولي وارد بتأليف كتاب عنها بعنوان:
The Animals are Innocent: The Search for Julie’s Killers (London and New York 1991).
أما القصة الأخرى فقد نجم عنها كتاب ألفته آيلين ماكدونالد التي كانت تعمل صحفية في جريدة الأوبزرفر Observer في لندن.
Eileen MacDonald, Brides for Sale? Human Trade in North Yemen (Edinburgh, 1988).
21 – Hiltzik, 4.
22 – MacDonald, 207 – 211.
23 – صحيفة الجرديان Guardain عدد 30 يونیه ۱۹۹۲.
24 – السيرة الذاتية التي كتبها أيزاك دينسن Isak Dinsen قد خلدها الفيلم الذي يحمل عنوان الخروج من أفريقيا، بطولة روبرت ردفورد ومريل ستريب؛ كذلك كتب ستانلی كروتش Staney Crouch مقالة مديح وتأبين للطيارة بيريل مارکهامBeryl Markham مطلقًا عليه صفة “خلاسية Mulatto بالطبيعة وليس بالدم” (المترجمة: الخلاسي هو شخص مولد من عرق زنجي وآخر قوقازی).
Stanley Crouch, “African Queen,” in Notes of a Hanging Judge (New York and Oxford, 1990), 146.
ومن المقرر إنتاج فيلم ضخم الميزانية عن حياة بيريل ماركهام الحافلة بالأحداث.
25 – Jenny Sharpe, Allegories of Empire (University of Minnesota Press, forthcoming 1993).
26 – انظر/ انظري على سبيل المثال الموضوع المنشور في مجلة فوج (النسخة التي تصدر في بريطانيا)، عدد ديسمبر ۱۹۹۱.
27 – جريدة الأوبزرفر Observer عدد ۲۸ یونیه ۱۹۹۲، ص 44 – 47.
28 – صحيفة الجارديان، عدد ۳۰ یونیه ۱۹۹۲.
29 – صحيفة التايمز، عدد السبت The Times Saturday Review ۲۷ یونیه ۱۹۹۲، ص 6.
30 – Donna Haraway. “The Promise of Monsters,” in Cultural Studies, ed. L. Grossberg et al. (New York and London, 1992), 307.
31 – Ware, 11-17.
32 – المصدر نفسه، الجزء الثالث، ص ۱۱۷.
33 – MacDonald, 86 – 87.
34 – المصدر نفسه، ص ۲۸– ۲۹.
35 – المصدر نفسه، ص ۳۲.
36 – المصدر نفسه، ص ۹.
37 – المصدر نفسه، ص 204.
38 – المصدر نفسه ص207.
39 – Ware, 139.
40 – MacDonald, 76.
41 – Ware, 146.
42 – MacDonald, 11.
43 – المصدر نفسه، ص ۸۸.