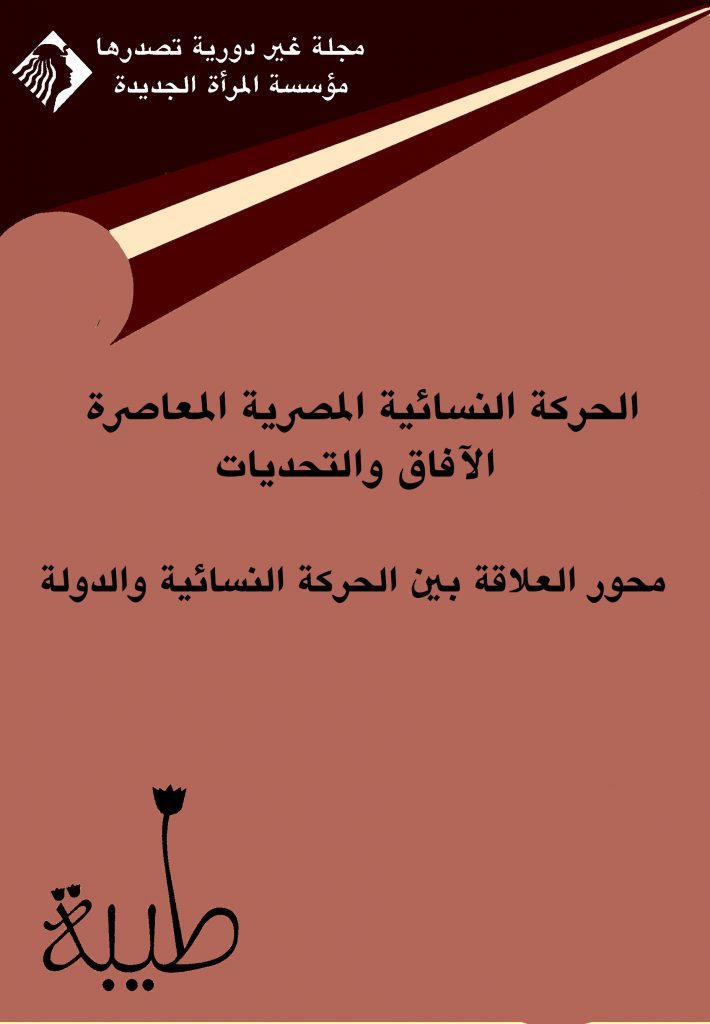المرأة والديموقراطية
إلى أي حد يمثل الانتقال إلى الديموقراطية في مصر أو غيرها من الدول العربية بابًا واسعًا لانتصار قضايا المرأة وتأمينا أفضل للنضال من أجل تشريع واحترام حقها في المساواة؟ ينطوى مفهوم الديموقراطية بذاته وفيما يتعلق بقضايا المرأة بصورة خاصة على غموض أصيل. فقد عاش“النظام الديموقراطي” طويلاً في أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية بدون التفات يذكر لقضايا المرأة. وظلت الديموقراطية قليلة الحساسية لحقوق المرأة وقتًا طويلاً من الزمن. وبالمقارنة، فقد كانت بعض النظم الشمولية والتسلطية أقرب كثيراً لقضايا المرأة وأكثر انتصارًا لحقها في المساواة. ولكن هل يعني ذلك أن نضال المرأة ذاته محايد تجاه الديموقراطية؟ وهل يقودنا هذا الحكم العام إلى اعتبار الديموقراطية بعيدة عن قضايا المرأة. لا يمكن مناقشة هذه الأسئلة بصورة سكونية. فبينما تشكل الديموقراطية والشمولية أنظمة سياسية بالمعنى الواسع للكلمة، فإنها تشتمل أيضًا على عمليات وميول تاريخية تنساب في الواقع الاجتماعي والثقافي بصور معقدة وعبر حقب زمنية متتالية. ولكل من هذه العمليات مضاعفات ونتائج معينة تجاه قضايا المرأة. ومن المحتمل أن يبدأ نظام تسلطى أو شمولي ما بموقف أكثر رقيًا من قضايا المرأة، ولكنه يقود موضوعيًا إلى خسارتها للمعركة السياسية والثقافية الضرورية لتشريع واحترام حق المساواة. ويمكننا أن نشهد العكس في عدد كبير من النظم الديموقراطية. إن بناء نماذج عقلية حول“الجدلية الاجتماعية والثقافية” فيما يتصل بحقوق المرأة هو بكل تأكيد أمر مفيد، بشرط أن نفهم دائمًا العمليات التاريخية ككتاب مفتوح وليس كنظام مغلق بأي حال. وسوف نقدم في هذه الورقة نوعًا من المخطط الذهني الأولى لعلاقة الديموقراطية والتسلطية بقضايا المرأة، كما أننا سنطرح رؤية المتغيرات تؤثر وتتشابك مع الاعتبارات السياسية المحضة لإنتاج خرائط المواقف من قضايا المرأة عمومًا. كما أننا سنطبق ما نتوصل إليه من افتراضات على حالة مجتمعاتنا العربية الإسلامية وخاصة حالة مصر.لا يمكن إطلاق قوانين عامة على العلاقة بين الديموقراطية وحقوق المرأة حتى في المجال السياسي البحت بدون أن ندخل في الاعتبار التاريخ السياسي والاجتماعي لكل دولة أو نظام ديموقراطي على حدة. ومع ذلك لا يمكن تجنب الانطباع بأن النظام الديموقراطي كان تاريخيًا قليل الحساسية لحقوق النساء، وأيضًا أن الديموقراطيات الغربية حرمت طوال حقبة تاريخية ممتدة فئات محرومة وضعيفة كثيرة بما فيها النساء من حقوقهم المشاركة ومن مزايا المواطنة المتساوية. وتعبر السيدة فرين جينوالا من برلمان جنوب أفريقيا عن هذه الحقيقة بالكلمات المعبرة التالية“إن بذور الديموقراطية كامنة في مبدأ شرعية السلطة في صنع القرارات التي تؤثر على حياة الناس ومجتمعاتهم وبلادهم والتي تتفرع عن الاختيار الذي يقوم به هؤلاء الذين يتأثرون بها. ولقرون عديدة فرضت حدود هذه الشرعية واستبعد كثيرون من عملية صنع الاختيار: العبيد، هؤلاء الذين لم تكن لديهم ملكية أو تعليم رسمي، أو لم يعدوا“متحضرين“، أو الذين لم يشكلوا جزءاً من الثقافة أو الدين السائد في المجتمع، الملونون، هؤلاء الذين شكلوا جماعة عرقية أو عنصرية خاصة، السكان الأصليون في بلاد تم غزوها وإلحاقها بأسلحة متفوقة، وبصورة ساحقة النساء(1).
وتكفى نظرة واحدة إلى“كتيب المعلومات” الذي قدمته لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع النساء لمؤتمر بكين وخاصة الجدول التاريخي حول التطور القانوني والمؤسسي للدول وتواجد النساء في البرلمانات الوطنية لاكتشاف ضالة تمثيل المرأة السياسي في الدول“الديموقراطية“. وتكشف الأرقام المتاحة للاتحاد البرلماني الدولي عن حقيقة مفارقة للانطباعات الشائعة. فمثلاً تحظى النساء بأكثر من نصف مقاعد“البرلمانات” في اثنين من أكثر الدول فقرًا وتخلفًا هما رواندا وبوروندي، بينما الولايات المتحدة تهبط إلى مقام الدولة الـ 63 في جدول الدول من حيث تمثيل النساء في البرلمان(2). إن المتوسط العالمي لعدد النساء في البرلمانات لا يزيد عن 13 %، وتزيد هذه النسبة في البلاد الاسكندنافية إلى 35.9% وتهبط إلى قرب الصفر في البلاد العربية (3). كما أن التقاليد التاريخية لتمثيل النساء في البلاد الاشتراكية ذات الطابع الشمولي وخاصة الاتحاد السوفيتي السابق كانت أرقى وأعلى بكثير مما كان متاحا للبلاد الديموقراطية الغربية. وقد استمرت هذه التقاليد جزئيًا حتى بعد التحول بعيدًا عن الاشتراكية والشمولية.
وحتى بعد أن تم تعديل موقف الديموقراطيات وخاصة الديموقراطيات الغربية من النساء خلال العقدين الماضيين لا تزال الهوة كبيرة للغاية في التمثيل السياسي للنساء. ولذلك تطالب المنظمات الدولية والحركات النسائية برؤية جديدة تمامًا للعلاقة بين النساء والديموقراطية. ويقول رئيس مؤتمر نيودلهي للاتحاد البرلماني الدولي“إنه إذا كانت السياسة مغروسة في المجتمع وتعكس القيم الإنسانية فإن مناقشاتنا ألقت الضوء بوضوح على أن تنمية الشراكة في السياسة يعتمد على تنمية الشراكة كأسلوب اجتماعي عام. ولهذا يؤكد الاتحاد البرلماني الدولي أن ما يجب تطويره في المجتمعات الديموقراطية هو شيء لا يقل عن عقد اجتماعي جديد يعمل فيه الرجال والنساء على قدم المساواة وبصورة تكاملية بما يؤدي إلى إثراء متبادل لكل منهما انطلاقًا من اختلافهما.. إن الأمر يتعلق بالديموقراطية ذاتها“(4).
وتؤكد الدراسات العلمية هذا المعنى؛ فتقول إحدى الدراسات الرائدة في بحث العلاقة إن“النساء كانوا دائمًا على هامش الديموقراطية“(5).
ومع ذلك فلا يمكن عزو هامشية النساء في النظم الديموقراطية إلى مفهوم الديموقراطية ذاتها. فأولاً لا يمكن عزل العلاقة بين الديموقراطية والنساء عن نتائج ومؤثرات النظام الاقتصادي. فقد همش النظام الاقتصاد السياسي للرأسمالية النساء طويلاً ومن ثم حرمهن من القوة اللازمة للنضال من أجل حقوقهن، كما أن الأيديولوجيا المحافظة التي تبنتها الرأسمالية خلال الردح الأطول من عمرها ساهمت بدورها مساهمة أساسية في إطالة أمد التهميش الذي عانت منه النساء ولا يزلن. وتعد الثقافة وفي قلبها الأيديولوجيا السائدة المحددات للعلاقات بين النساء والرجال ومكانة النساء في المجتمع ومن ثم في المجال السياسي والفضاء العام ككل. ومن ناحية ثالثة فلا يمكن إهمال الأبعاد غير الطبقية في التمايز الاجتماعي والسياسي وخاصة التمايزات القائمة على الثقافة والعنصر والمناطق الأصلية والانتماء القومي. وأخيرًا فإن نمط السياسة ذاته لعب دوراً جوهريًا في إطالة أمد التهميش واستمراره.
ويلزمنا تعقد الظاهرة بإلقاء بعض الضوء على العوامل الوسيطة المحددة لموقف النظم الديموقراطية من قضايا النساء وعلاقات الجندر بوجه عام.
فالاقتصاد السياسي يحدد العلاقة بين النساء والرجال ومكانة المرأة في المجال العام من حيث أنه هو المحدد الرئيسي للتكوين الطبقى والأنماط الرئيسية للتنظيم الاجتماعي وداخلها علاقات الجندر. فالأشكال المحددة من عدم المساواة وتوزيع عبء العمل داخل وخارج الأسرة، والمستويات التعليمية المحققة وأنماط الملكية والعلاقة مع الأرض ورأس المال وأدوات الإنتاج الأخرى وطبيعة ومستوى التكنولوجيا المستخدمة وغيرها من العوامل المحددة اقتصاديا، تعين دور المرأة في المجتمع بالارتباط الحميم مع الأوضاع والمكانات الطبقية التي تحشر فيها النساء أو فلنقل أغلبية النساء، كما تحدد مستويات التمكين التي تحصل عليها النساء في التفاوض الاجتماعي سواء في المجال العام أو الخاص. وقد أبقى النظام الرأسمالي لفترة طويلة على الضعف المتأصل للنساء أو غالبيتهن بالنظر إلى هذه المتغيرات كلها (الحرمان من الملكية، أوقات العمل الطويلة في الأعمال الأبسط التي تخصص للنساء، أعباء العمل المنزلي الطويل فضلاً عن العمل في الخارج، أنماط التطور التكنولوجي التي ظلت عديمة الحساسية للنساء أو محايدة تجاههن… إلخ). ويمكن القول بأن الرأسمالية أنتجت تحيزًا منهجيًا وطبقيًا ضد النساء أكثر من الرجال الأمر الذي ترتبت عليه مضاعفة صعوبات تمثيلهن في الحياة السياسية وفي مؤسسات الدولة والمجتمع. وتشير الدراسات المتاحة إلى أن هذا التمييز التاريخي يعاد إنتاجه في ظل عملية إعادة الهيكلة القائمة للسياسة والاقتصاد معا بتأثير العولمة (6). وتؤكد جنيفر روكني أن الوضع الطبقي للنساء وليس نزعة العداء للمرأة هي العائق الأساسي لدخول المرأة للكونجرس الأمريكي والمؤسسات التمثيلية الأخرى. وبتعبير آخر فإن الوضع الطبقي الغالب للنساء في نظام طبقي صارم ونظام سياسي يتطلب إنفاق فيض من الأموال لدخول معترك المنافسات الانتخابية هو المسئول الأول عن الهامشية التي تعاني منها النساء الأمريكيات في النظام الديموقراطي الأمريكي، بالرغم من أن الحصار المضروب حول تمثيل المرأة من النواحي القانونية والمؤسساتية قد انداح كثيرًا بالمقارنة مع عقود قليلة خلت.
الثقافة والأيديولوجيا السائدة تسهم أيضًا إسهامًا كبيرًا ومستقلاً إلى حد ما عن الاعتبارات الاقتصادية السياسية في تهميش المرأة وإدامة أجل الأسرة وعلاقات الجندر البطريركية. ولا أدل على دور الثقافة والأيديولوجيا من حقيقة أن قطاعًا كبيرًا من النساء يمثلن أكثر الفئات رفضًا للتغيير التقدمي في علاقات الجندر وحق المساواة. وتقول سريلاثا باتليلاوا“لقد فشلنا في فهم أن كثيرات من النساء اللائي اكتسبن مكانة في المجال السياسي الرسمي هن من أكثر المدافعات عن الأيديولوجيات الأبوية والمهيمنة والنخبوية والأصولية“. وتقول إحدى الناشطات“إن الأيديولوجيات الأبوية تسيطر على القوانين والأعراف والممارسات الاجتماعية.. مما يدعو للتساؤل حول ما إذا كان المجتمع نفسه ديموقراطيًا حتى عندما تكون الدولة كذلك“(7) وبوجه عام استندت الثقافات والأيديولوجيات المعادية لحقوق المرأة وتمثيلها السياسي على مقولة مركزية ومشتركة بين مختلف النظم الثقافية هي أن الاختلاف البيولوجي للمرأة يجعلها أقل قدرة على التركيز والمشاركة في الشئون السياسية (8) وبالمقابل فإن بعض الأيديولوجيات المميزة للحركة النسوية وخاصة تلك التي تؤسس نضالها على سياسات الهوية تفشل في إحداث اختراق بقدر ما تعمق ثقافة الاختلاف ومن ثم التفوق. ويقول ويليام كونواللى“تتأسس الهوية في علاقة مع سلسلة من الاختلاف التي تصبح معرفة اجتماعيًا… وينغرس في هذه العلاقة الضرورية سلسلة ثانية من الميول التي تحتاج هي ذاتها إلى استكشاف والتي تموه على الهويات الراسخة بأشكال ثابتة والتي تعاش ويفكر بها وكأن بنياتها تعبر عن النظام السليم للأشياء. وعندما تتعزز هذه الضغوط، فإن صيانة هوية ما يتطلب تحويل بعض الاختلافات إلى الآخر (وية)، إلى شر، أو إلى متشابهات كثيرة. فالهوية تتطلب الاختلاف حتى تكون، وتحول الاختلافات إلى الأخروية من أجل تأمين التأكيد على الذات“(9) ولا شك أن الثقافة تتغير وأن الأيديولوجيات التي تبرر الهيمنة والتمييز أو الإخضاع والبطش تتلون بأشكال جديدة كما أن من المحتم أن تضفر بقيم سامية أو عليا تستطيع إبهار المستهدفين بالتمييز أنفسهم. والمشكلة تتمثل في كيفية إيجاد ثقافة تحرير للذات المضطهدة أو المهمشة يكون بوسعها – من وجهة نظر هذه الفئات وخاصة النساء – المحافظة على بعض إن لم يكن كل هذه القيم الغالية التي تتلفع بها الأيديولوجيا المهيمنة. ويمكن تصوير المشكلة في ظل النظم الديموقراطية بصورة أكثر وضوحًا. فالديموقراطية المؤسسة على قاعدة رأسمالية تمنح كثيراً من النساء بعض القيم من أجل المحافظة على حد أدنى من أسباب القبول بالخضوع للثقافة التمييزية السائدة وخاصة بعد تبرير هذا الخضوع بحيل تخاطب قيمًا عقيمة بالفعل لدى قطاعات واسعة من النساء.
ويلعب نمط السياسة الديموقراطية ذاته دوراً في تأسيس التمييز ضد المرأة وتلوين تهميشها بأشكال وتبريرات وآليات شتى. وقد أشرنا بالفعل إلى حاجة السياسة في المجتمعات الديموقراطية الحديثة إلى إنفاق قدر طائل من المال. ولكن دور المال ومن ثم الطبقة يضاف في الحقيقة إلى طائفة واسعة من الإعاقات الهيكلية. فالسياسات الانتخابية بذاتها تميز تلقائيا ضد النساء بحكم أنها تتطلب إنفاق قدر كبير من الوقت سواءً في بناء الشعبية وتقديم الخدمات وبناء الصورة من خلال وسائل إعلام قليلة الحساسية نحو النساء وقادرة على إعادة إنتاج الأيديولوجيات البطريركية. وتقود هذه العوامل حتى الأحزاب الحاكمة والقوية إلى العزوف عن وضع النساء ضمن قوائمها الانتخابية، وخاصة عندما تشتد المنازعات الانتخابية والسياسية. ولا شك أن نمط السياسات الحزبية وجمود مؤسسات التمثيل والقوانين الانتخابية القائمة غالبًا على مبدأ التمثيل بالأغلبية والتي تسود في معظم المجتمعات الديموقراطية بين أهم الإعاقات الهيكلية التي تؤبد التمييز ضد النساء وتهميشهن. وتتجسد تلك العوامل كلها في بنية الدولة أو طبيعتها ذاتها بغض النظر عن درجة انفتاحها الديموقراطي، مما يشكل حائطًا منيعًا يحول دون تجاوز خطوط التمييز وواقع الهامشية الهيكلية للنساء. ولذلك صارت قضية الدولة باعتبارها أداة إنتاج التمييز والتهميش وفي حالات كثيرة القمع والبطش في مركز الخطاب النسوي على مستوى النظرية والممارسة معًا(10).
ومع ذلك تبدو الديموقراطية بالنسبة لأكثرية النشطاء من أجل تمكين المرأة أحد أهم أهداف النضال. ولا شك أن هذا الهدف يجعل إعادة تعريف الديموقراطية جانبًا رئيسيًا من النضال النظري. ويبدو أن الارتباط بين الديموقراطية وحقوق النساء صار مقبولاً بصورة عامة بالرغم من رسوخ هذا الإرث التاريخي للديموقراطية. وتقول إحدى الناشطات من أجل حقوق المرأة إن“الديموقراطية هي الطريقة الوحيدة لتحرير النساء من العبودية” وتؤسس المنظمات الدولية للحاجة لإعادة تعريف الديموقراطية. فيقول بيان الاتحاد البرلماني الدولي المعلن في القاهرة في سبتمبر عام 1997 الديموقراطية ذاتها تفترض الشراكة بين الرجال والنساء. وكان نفس الاتحاد قد أعلن في ياوندي أن مفهوم الديموقراطية يكتسب مغزى حقيقيًا وديناميكيًا عندما يتخذ القرار في مجالات السياسة والتشريع الوطني بصورة مشتركة بين النساء والرجال وباهتمام متساو لمصالح وميول نصفى المجتمع“(11). ولكن المسافة بين إعلان تعريف حساس للجندر للديموقراطية وممارسته بالفعل لا تزال واسعة للغاية حتى في المجتمعات الديموقراطية. أما الصعوبة الأكبر فهي في تثبيت ما يمكن أن تكون القوى الديموقراطية قد حصلت عليه بالفعل من مكاسب جزئية. وهذا هو ما يلزمنا بفهم الجوانب الديناميكية في العلاقة بين الديموقراطية والنساء وخاصة في العالم الثالث والعالم العربي بوجه خاص.
ماذا تبنت الحركة النسوية مبادئ الديموقراطية بالرغم من أن النظم الديموقراطية فشلت طويلاً في إنصاف النساء؟
لقد أشرنا إلى مقدمات ضرورية للإجابة على سؤال لماذا لم تنصف الديموقراطية النساء لفترة طويلة في التاريخ. فغالبية النساء ينتمين إلى الطبقات الدنيا والوسطى، ولا يملكن موارد كافية للترشيح والمشاركة في المؤسسات التمثيلية، والأعباء الملقاة عليهن كانت وظلت حتى الآن أكبر من الرجال بما لا يترك لهن غير فرص ضئيلة للعمل في المجال العام، هذا فضلاً عن فشل الأحزاب السياسية ونمط السياسة التقليدية في ترشيح أعداد كافية من النساء على قوائمها السياسية، وهو ما يعود أيضًا إلى استمرار هيمنة ثقافة وأيديولوجيات محافظة تنكر حق النساء في المساواة وقدرتهن على تولى الوظائف التمثيلية العامة وتنمية الحضور في المجال العام. ويبقى أن نشير إلى جانبين إضافيين أولهما بنائي وثانيهما حركي يتعلق بالديناميات التاريخية.
فمن الناحية الفكرية يتسم مفهوم الديموقراطية بغموض أصيل. والواقع أن تعريف الديموقراطية ذاتها مضطرب ومتعدد إلى درجة تؤدى إلى الاختلاط والتشوش. غير أن هناك ثلاثة مستويات للتعريف أو لفهم المصطلح. الأول يتعلق بالمبادئ العامة التي تحكم النظام الديموقراطي. وكانت المقاربة الشائعة لهذه المبادئ مبثوثة في الفكر الدستوري الحديث الذي انطلق من مفهوم العقد الاجتماعي. وقد تطورت هذه المبادئ بفضل المقاربة الحقوقية الأرقى والتي أرست مبادئ أشمل ومعايير أعلى وقواعد أكثر إحكامًا وتفصيلاً. غير أن الدور المتعاظم لهذه المبادئ في تعريف وتطور النظام الديموقراطي قد استغرق وقتًا طويلاً للغاية، قبل أن تحقق الانتصار الأخلاقي والمعنوي. ويصدق ذلك لا بالنسبة لحق المرأة في المساواة فحسب بل بالنسبة لمبدأ المساواة ذاته وفيما يتعلق بالأجناس والقوميات والأديان وغيره من الاعتبارات. لقد نظرت النظم والأحزاب المحافظة للديموقراطية باعتبارها أسلوبًا للإبقاء على مؤسسات قومية بما فيها مؤسسة الأسرة البطريركية والتي استمرت في الجوهر حتى في النظم الديموقراطية الحديثة حتى نهاية الحرب العالمية الثانية. ولعل الحكمة الشائعة تصدق هنا. فالديموقراطية هي النظام الذي يرتكز حول مبدأ الحرية ولكنه أهمل مبدأ المساواة طويلاً. وتأكد تفوق فكرة الحرية بالمعنى الاقتصادي نظراً لتلازم الاقتصاد والسياسة ونظراً لهيمنة النظم الرأسمالية في المجتمعات الديموقراطية. بينما تعلقت الاشتراكية بمبدأ المساواة أكثر من مبدأ الحرية. ولكن بناء الاشتراكية تاريخيًا تم من خلال أنظمة شمولية وإن كانت متعلقة بالحداثة. وكان هذا النموذج الحداثي المتعلق بالمساواة أكثر إبهاراً لشعوب ومجتمعات العالم الثالث نظراً لأن أوجاعها تركزت بسبب الاستعمار على الحرمان من هذا المبدأ في العلاقة بين المستعمِّر والمستعمَّر وفيما بين الهويات القومية المختلفة.
أما المستوى الثاني الذي تسيد تعريف الديموقراطية لفترة طويلة فهو بعدها الإجرائي وخاصة فكرة حكم الأغلبية. وفي ظل هذا المفهوم للديموقراطية تركزت السياسات التقليدية في ترشيح شخصيات قابلة للفوز، ومن المنطقي أن يكون أغلبها من الرجال. كما أن سمو فكرة حكم الأغلبية حجب دور وثقل الأقليات، بما في ذلك المرأة التي تقارنها الدراسات السوسيولوجية والسياسية بوضع الأقليات. وأدى حجب الأهمية الخاصة للمبادئ الحقوقية والديموقراطية في النظم السياسية المعاصرة إلى بقاء النظم والثقافات والقواعد التقليدية بدون تحدٍ حقيقى. فقد ظل من الممكن أن يتحمس أكثر الناس للنظام الديموقراطي حتى لو أنه يتضمن إنكارًا لحقوق أساسية بما فيها حقوق المرأة، دون أن يشعروا بأي تناقض في هذا الحماس. وأخيرًا فإن المستوى الثالث للديموقراطية هي الضمانات الأساسية التي تحول دون احتكار السلطة بمعنى المناصب العامة وأيضًا احتكار طبقة أو جماعة عرقية طائفية أو دينية أو ثقافية.. . إلخ. ولم تبدأ عملية وضع هذه الضمانات والنص عليها في الدساتير والتشريعات أو في القواعد السياسية والدستورية العرفية إلا منذ عقود قليلة أو في بعض الأحيان منذ سنوات قليلة. وحتى في الولايات المتحدة ظل الأفارقة الأمريكيون والسكان الأصليون محرومين من حق الاقتراع العام حتى استقرار تشريعات الحقوق المدنية بدءًا من عام 1964. ومع ذلك تحدث الأمريكيون لقرون وبفخر عن نظامهم“الديموقراطي“. إن هذا المفهوم التمييزي بل والعنصري للديموقراطية لم يعد مقبولاً على الإطلاق، ولم يعد من الممكن الحديث عن نظام ديموقراطي يحجب حق المساواة أو يكسل عن تأكيد الحاجة لإدماج جميع المواطنين بغض النظر عن اللون والجنس، بل وبغض النظر عن الجنسية ذاتها. ومع ذلك فإن الإرث التاريخي لقرون طويلة من التمييز لا يزال يظلل الممارسة السياسية والثقافية حتى في بعض أكثر البلاد تقدمًا.
وفضلاً عن ذلك كله فإن التقاليد الثقافية والتي تبدأ من الأسرة والفرد والجماعة المحلية تختلف اختلافات كبيرة بين شتى البلاد من نفس مستوى التطور الاقتصادي والاجتماعي وتنعكس هذه الاختلافات بالضرورة في المجال السياسي. وهذا هو ما يفسر الهوة الشاسعة التي تفصل بين الدول الاسكندنافية من ناحية والولايات المتحدة من ناحية ثانية. بل وقد تفسر الهوة العجيبة فيما يتعلق بالمشاركة السياسية للمرأة بين بلاد بالغة الفقر مثل دول أفريقيا جنوب الصحراء وبعض البلاد الأكثر ثراءًا في العالم مثل سويسرا وألمانيا. إذ تلعب المرأة دورًا أكبر في الحياة الاقتصادية والاجتماعية في المجموعة الأولى بالمقارنة بالمجموعة الثانية. كما أن تاريخ التمييز والفصل بين الرجال والنساء يعد أحدث في دول أفريقيا جنوب الصحراء بالمقارنة مثلاً بالدول العربية.
هذه هي بعض العوامل المشتركة التي أدت إلى فشل الديموقراطيات التاريخية في إنصاف النساء.
غير أن موقف الديموقراطية من النساء يتحول بصورة ديناميكية ربما أكثر من أي نظام آخر الحديث عن ويهمنا أن نتحدث عن هذا التحول بالذات في العالم الثالث، لأن الانتقال إلى الديموقراطية فيه يعد إنجازًا حديثًا، بالمقارنة بالدول الغربية المتقدمة، وإن كان يستحيل الانتقال الديموقراطي في العالم الثالث بدون أخذ الإرث التاريخي للديموقراطيات المبكرة والمتقدمة في الحساب. ويمكننا أن نصور هذا التحول انطلاقا من نموذج افتراضي أولى يشتمل على ثلاثة مراحل.
المرحلة الأولى يتم فيها الانتقال إلى الديموقراطية. وفي هذه المرحلة يسمو معنى حكم الأغلبية على غيره من معاني ومستويات الممارسة الديموقراطية. والواقع أن المرحلة الأولى من الانتقال تطلق بين عوامل أخرى كل التعصبات الكامنة في الثقافة وربما في الأيديولوجيا المهيمنة بما فيها التعصب ضد النساء. وتزداد شدة هذه الميول التعصبية وخاصة ضد المرأة في بعض الحالات عن حالات أخرى. فالمجتمعات التي تخوض تجربة الانتقال في سياق أزمات اجتماعية واقتصادية حادة، وتلك التي تتجذر فيها الميول التعصبية والتمييزية في الثقافة وفي التفسيرات الشائعة للدين، وتلك التي لم تعرف نمواً كبيرًا للحركات النسوية وذات التراث الثقافي المعادي لعمل المرأة في المجال العام تنطلق فيها الميول التعصبية بدرجة أكبر من غيرها. وتندرج غالبية المجتمعات العربية تحت هذه الفئة من الدول والمجتمعات. وبالمقارنة فالمجتمعات الأفريقية جنوب الصحراء مثلاً لا تعرف تراثًا طويلاً للثقافة المعادية لعمل المرأة أو حضورها في المجال العام، وهي أقل تأثراً بالأيديولوجيات التي تنكر المساواة، ورغم شيوع أزمات اقتصادية واجتماعية مستفحلة بما فيها أزمات البطالة فإن التعصب ضد المرأة بعد أقل حدة. غير أن الفئتين من المجتمعات تعكس عوامل تمييزية وتعصبية متشابهة إلى حد ما. فالكتل الانتخابية الكبيرة والتي عادة ما تصوت في الانتخابات العامة تصويتا كتليا ليست المنتمين للأحزاب السياسية وإنما الأبنية الاجتماعية التقليدية مثل العائلات والعشائر والجماعات الطائفية والثقافة وغيرها من أوعية التنظيم والممارسة السياسية الكوميونية أو الإثنية. وفضلاً عن ذلك فإن التكاليف المالية للانتخابات العامة تميز بالضرورة ضد الفقراء والمهمشين ومن بينهم النساء. وفي أغلب الأحيان يؤدى تعاظم الأزمة الاقتصادية إلى أعباء إضافية على النساء ويشغلهن عن المشاركة في المؤسسات التمثيلية وفي المجال السياسي بوجه عام. كما أن البطالة المرتفعة عادة ما تؤدي إلى صعود ميول معادية لعمل المرأة عمومًا والتمييز لصالح الرجال في التوظيف وهو ما ينعكس على الحضور السياسي للنساء. والواقع أن إطلاق الميول التعصبية في هذه المرحلة يحجب هذا الحضور حتى في ظل مستويات عالية من التعليم والتصنيع والتطور الاقتصادي. ولا أدل على ذلك من انهيار نسب تمثيل النساء في الهياكل السياسية في أوربا الشرقية بعد ثورة 1989 الديموقراطية (12).
أما في المرحلة الثانية، فإن التركيز ينتقل من إجراءات الديموقراطية بما فيها من عمليات انتخابية وسياسية بيروقراطية إلى المبادئ الأساسية وخاصة المعايير والقيم الحديثة للديموقراطية بالمقارنة بإجراءاتها الشكلية. وتعكس مؤسسات قيادية معينة هذه المبادئ وعلى رأسها النظام القضائي والحركات الاجتماعية بما فيها الحركات النسوية ذاتها فضلاً عن الهياكل المدنية الحديثة والأحزاب التقدمية. وبوجه خاص تبدأ الحركات النسائية في التغلب على الارتباك والتمزقات التي قد تعاني منها بشدة بسبب انطلاق التعصب في المرحلة
الأولى، كما تتمكن من التغلب على المشكلات التقليدية التي تعاني منها مثل ضعف قاعدة الموارد وضآلة قاعدة النشطاء التطوعيين، والعزلة في المجال المدني والسياسي. كما تنتج الميول التعصبية ردود أفعال قوية توقظ ملايين من النساء على الإفلاس الأخلاقي للأيديولوجيات التعصبية والثقافات المتقادمة حيثما تشتمل على هذه الميول التعصبية. كما أن الديموقراطية تتميز عن كافة النظم السياسية البديلة بتوفيرها لأدوات الممارسة السياسية الحرة والتي تمكن من النضال المباشر – حتى في ظروف التمييز الهيكلي – ضد الشروط والظروف المجحفة بحقهن في المساواة أو في الحضور السياسي المباشر. وإضافة لذلك فإنه“بالرغم من العيوب الواضحة في الديموقراطيات الأولى والراهنة، في الأزمات الاقتصادية والحروب الأهلية والحروب بين الأمم والمحن الأخرى للزمن فإن الديموقراطيات أظهرت قدرًا متناميًا على التأقلم والقوة وأصالة الممارسة الديموقراطية(13). ومن ناحية أخرى فإن الجدل الاجتماعي الذي تطلقه النظم الديموقراطية يمكن النساء من استثمار الاستقطابات والتوازنات السياسية لصالح قضاياها. ولكن تواجه النساء والحركات النسوية في نفس الوقت مشاكل جمة، عادة ما تتمثل في التناقضات الداخلية بين شتى تيارات العمل النسوى، وأسبقية الانتماءات السياسية والإثنية على الانتماء النسوى المشترك في المجال السياسي خلال هذه المرحلة، فضلاً عن قلة الخبرات في التعامل مع المجال السياسي والتشريعي بوجه عام. ومن هنا تبدأ النساء في اقتحام المجال السياسي بشكل أفضل ومن خلال الهياكل المدنية أولاً والحزبية ثانيًا، وقد يبدأ بندول التوازن في العودة للعمل في صالح قضايا النساء. ولكن يستمر العمل النسائي أقل ثقلاً من أن يفرض تغيرات شاملة في الفضاء السياسي.
وبوسعنا أن نفترض المرور إلى مرحلة ثالثة لم تنجزها بعد سوى حفنة من الدول الديموقراطية وخاصة في شمال أوربا وبدرجة أقل في كندا. وخلال هذه المرحلة تبدأ الحركات النسائية في اكتساب صلابة وولاء أكبر وأوسع بين جماهير النساء بغض النظر ولو جزئيًا عن الانتماءات الحزبية بل وربما على انقسامات الهوية الأخرى مثل الطائفة والثقافة والمنطقة والعشيرة والقبيلة وغيرها. بل وتبدأ الأحزاب السياسية في خطب ود النساء. وقد يبدأ انفضاض واسع من جانب النساء عن الأحزاب المحافظة العلمانية والدينية لصالح هيكلية للممارسة السياسية تقوم جزئيا على النوع وليس الأحزاب أو الانتماءات الأيديولوجية العامة. بل ويتشجع المجتمع على الأخذ باستراتيجيات جديدة غير محافظة للتقدم وفلسفة جديدة للسياسات العامة. بل وقد يرتفع منحنى التعلم حتى لدى القوى المحافظة مع تجربة وفشل السياسات والرؤى القديمة والتقليدية. ومع نضوج التنظيمات النسائية وتوظيفها للحريات العامة في توسيع وتعميق دعوتها السياسية والمدنية يتحقق عائد جماهيري أفضل بما في ذلك إمكانية تحقيق انتصارات انتخابية. ومن ناحية أخرى فإن رسوخ النظام الديموقراطي وتخطيه للأزمات الثقافية والاجتماعية والسياسية الملازمة لنشأته الأولى يقود قطاعات متزايدة من المجتمع السياسي إلى المطالبة بل والممارسة الفعلية لنمط جديد من السياسة. وقد تنتقل وظائف وفعاليات كثيرة من النطاق التشريعي للدولة إلى المجال المدني والتعاوني حيث تلعب التوافقات على المستوى المحلى والقطاعي دوراً أكبر وأثقل في تحريك المجتمع إلى مسارات جديدة وغير مألوفة ثقافيًا في النمط القديم من السياسة بما في ذلك السياسة الديموقراطية. وبذلك تتفتح الحركات النسوية على احتمالات جديدة للنصر. ويمكن القول بأن ديناميكية الحياة الديموقراطية تتخذ منحنى جديدًا حيث تشتد أزمة النمط التقليدي والبيروقراطي للسياسة ويتعاظم الطلب على نمط جديد للسياسة الديموقراطية بحيث يتغير معنى الديموقراطية ذاته، فلا تكتفى بالأطر التمثيلية ويتسع الفضاء العام والسياسي لاستقبال فعاليات وأوعية جماعية جديدة للفعل الاجتماعي والثقافي والسياسي.
وتظهر أرقام الاتحاد البرلماني انفجارًا كبيرًا في تمثيل النساء في هذه المرحلة الثالثة بتأثير بروز نمط جديد للسياسة في الدول الديموقراطية، بل وربما في العالم كله.
إن الانتقال من النظم الشمولية والتسلطية يشتمل على انخفاض واضح في تمثيل النساء (حالة أوروبا الشرقية)، وزيادة التمثيل بنسبة كبيرة بعد التوصل إلى نمط جديد من السياسة الديموقراطية سواءً في الدول المتقدمة (حالة اسكندنافيا) أو الفقيرة والمتخلفة (حالة أفريقيا).
غير أن الانتقال إلى نمط جديد من السياسة في سياق نضوج مفهوم وممارسات الديموقراطية ينهض أساسًا على بزوغ ودور نمط جديد من الناشطية النسوية تنتقل فيه الممارسة من الاهتمام الصرف بقضايا التنمية إلى العمل على تعبئة النساء في المجال السياسي، مما يؤدي إلى تثبيت وتنمية حضور المرأة في هذا المجال مما ينعكس على عملية التمثيل.
وبطبيعة الحال يمكن الاعتراض على هذا النموذج من زوايا متعددة. فأولاً لا يوجد في التاريخ الحقيقي نمو خطى أو تقدمي بالضرورة من مرحلة إلى مرحلة أعلى. فقد تعصف الأزمات بالنظام الديموقراطي في البداية. وقد تتفجر أزمات اقتصادية وسياسية بل وثقافية في أية مرحلة بما يقود المجتمع إلى ردود فعل نكوصية أو رجعية من حيث الأجندة الاجتماعية. وفي الولايات المتحدة على سبيل المثال انتصر رد الفعل الأصولي عاصفا بكثير من الإنجازات التي تحققت في عقد الستينيات، وفرض من جديد أجندة اجتماعية رجعية ومعادية لحقوق المرأة. ومن ناحية أخرى فإن كل مرحلة قد تشهد اتجاهات متناقضة لا ينجح المجتمع في حسمها وتظل تصاحبه عبر حقب زمنية طويلة. ويتعاظم هذا الاحتمال بالذات في دول العالم الثالث وعلى رأسها الدول العربية الإسلامية بسبب الامتداد الزمني الخارق لأزمة احتجاز ديموقراطي وردة ثقافية وصعوبات اقتصادية واجتماعية وانتشار مذهل للأيديولوجيات الأصولية.
إذن فالنموذج الذي نتحدث عنه افتراضي بحت. وقد يتحقق أو لا يتحقق على الإطلاق. ولكنه ذلك يظل مفتاحًا لإدراك تفوق الديموقراطية على غيرها من النظم على المدى الطويل، فحتى عندما يأخذ النظام التسلطي أو الشمولي بأيديولوجيا حداثية مناصرة للمرأة وللتحديث الاقتصادي والاجتماعي بما في ذلك مبدأ المساواة فإن إنجازه يظل سطحيًا إلى حد كبير لأنه يفرض على المجتمع من أعلى، والتمسك بهذا النوع من الإنجازات يتجاهل الحاجة لتأسيس ثقافي وسياسي للحقوق الأساسية على المستوى المجتمعي. كما أن هذا النموذج عادة ما يجلب رد فعل مضاد للنزعات التقدمية والحداثية أسوأ مما تجلبه الصعوبات الاعتيادية في مجتمع ديموقراطي. فالأيديولوجيا الأصولية في الولايات المتحدة لا تنازع مبدأ المساواة في الواقع وإنما تنازع نمط الأسرة التي ظهر في أعقاب الثورة الثقافية التي اندلعت مع ثورة الشباب والنساء والأقليات فيما يعرف بحركة الحقوق المدنية وحركة مناهضة الحرب والحركة النسوية منذ منتصف الستينيات. وفوق ذلك يظل الإنجاز الحداثي والمساواتي سطحيًا أو حتى مسرحيًا ومشهديًا في ظل النظم التسلطية والشمولية بوجه عام وفي العالم الثالث والعالم العربي بوجه خاص. ولا يمكن مقارنة معركة ديموقراطية حقة لتنظيم النساء للنضال من أجل الحق في المساواة والحضور السياسي بمكاسب جاءت من أعلى وبصورة“أبوية” عبر زعيم أو نظام حداثي اجتماعيًا وإن كان تسلطيًا أو شمولياً في الميدان السياسي.
عاني العالم العربي كله تقريبًا من أزمة احتجاز ديموقراطي ممتد وظاهر بكل آلامه منتصف وتضاعيفه منذ منتصف السبعينيات على الأقل. ومع ذلك فإن النضال من أجل الديموقراطية والإصلاحات السياسية والدستورية يشكل منذ ذلك الوقت بؤرة الحياة السياسية في معظم الدول العربية. وفي سياق هذا النضال تغيرت الحياة السياسية والثقافية العربية بدرجات متفاوتة من القوة والعمق.
وبوجه عام تنقسم البلاد العربية إلى ثلاثة فئات أساسية. الأولى تشهد استمرار نظم الحكم التسلطية التقليدية والحديثة بدون تغير يذكر حتى الآن، مثل سوريا وليبيا والمملكة السعودية مع غالبية دول الخليج. أما الفئة الثانية وهي التي تعدها“التيار الرئيسي” لأنها الأكبر عددًا ومن حيث عدد السكان والمساهمة في الحياة السياسية والثقافية العربية فقد شهدت تأسيس نموذج التعددية المقيدة. فيتم الاعتراف بالتعددية السياسية والتي تأخذ بالنمط الحزبي أو أنماط بديلة (مثل حالة الكويت)، فضلاً عن انتخابات دورية على كل المستويات وإن كانت من نمط الانتخابات التسلطية من حيث استمرار إغلاق الطريق على عبر تداول السلطة، مع الاعتراف والتقنين الجزئي لحرية التعبير، وغيرها من الحريات العامة مع استمرار ترسانة من القوانين المقيدة للحريات. أما الفئة الثالثة فهي تلك التي تحركت بصورة أقوى على طريق الإصلاحات الديموقراطية، وهي تكاد تقتصر في الوقت الراهن على حالة المغرب التي أنجزت فتحًا ولو محدوداً لقنوات تداول السلطة انتخابات تتسم بقدر أكبر بكثير من النزاهة عما يتم في البلاد العربية الأخرى. ولكن هناك عدة بلاد عربية مرشحة للانتقال الديموقراطي ولو عبر عملية تدرجية وخاصة الجزائر ومصر والسودان واليمن (وربما العراق التي تمثل حالة خاصة بسبب الاحتلال). لقد عاشت هذه البلاد خلال السنوات القليلة الأخيرة حالة حراك قوية تجعل الانتقال الديموقراطي ممكنًا ولو بالمعنى الشكلي للكلمة.
وهذه الإمكانية هي التي تحتم مناقشة العلاقة بين النساء والانتقال الديموقراطي في العالم العربي. ففي المرحلة الأولى للانتقال تطلق الميول التعصبية كما أكدنا في النموذج التجريدي الذي شرحناه في القسم السابق. كما أن أداء النساء اللائي تختارهن النظم التسلطية يعد بائساً بالنظر إلى عدم استنادهن إلى تاريخ من العمل النضالي وإلى منظمات نسائية قوية فضلاً عن سيادة السياسات التسلطية بوجه عام(14).
وبكل أسف فإن أحد أهم الميول التعصبية المعادية للمرأة ترتبط على نحو وثيق بإساءة تفسير التعليمات الدينية على يد كثرة من المشتغلين بالتعليم والخطابة الدينية في المساجد. يقول الفقيه والعالم فاروق حسن إن“التاريخ أقام مفارقة. احتكر رجال دين ذوو تعليم بسيط الحقيقة الدينية طوال قرون، ومن ناحية حشر رجال الدين هؤلاء شبكة جنونية من الخرافات والأفكار المتطرفة. ومن ناحية أخرى استخدموا هذه الشبكة كغطاء مرن للملاءمة والسلطة السياسية“(15).
غير أن رجال الدين التقليديين لم يمثلوا في الحقيقة مشكلة كبرى أمام إرادة زعماء ونظم سياسية حداثية وإن تسلطية. والواقع أنهم لم يشكلوا بالضرورة أيضًا تحديًا كبيرًا أمام الدولة الديموقراطية إلا حيثما صاروا جزءاً من دعوة أصولية تهاجم الدولة الحديثة باسم الشرعية الدينية وتستهدف تطبيق صورة مشوهة عن هذه الشرعية. وما يحدث في العالم العربي والإسلامي خلال ربع القرن الماضي يحدث أيضًا في الديموقراطيات القديمة والحديثة على السواء في شتى النظم الثقافية الأخرى. تقول ميشيل سوينسن“إن الأصوليين الذين خاضوا الصراع ضد الحداثة لأكثر من قرن حاولوا الاستيلاء على النصوص الدينية المقدسة وقراءتها كتعاليم تستهدف تحطيم أعدائهم السياسيين.. وهم الآن يوجهون جام سخطهم ضد الديموقراطيين“الكفرة” وأنصار قضية النساء والأنسانويين وضد المسيحيين من التيار الرئيسي وضد الأديان الأخرى“(16). وفي كل النظم الثقافية تقريبًا يحيط بالتيارات الأصولية مركب أو تجمع عملاق للمصالح والرؤى المعادية لحقوق المرأة وللحركة النسوية وكافة الحركات الهادفة إلى استقرار حق المساواة والحرية والحقوق الأخرى للإنسان والمواطن.
ويخوض الأصوليون الإسلاميون في كل مكان تقريبًا نفس المعركة ضد الحركات النسائية. وحتى بعد أن يكونوا قد اقتربوا من فهم الضرورة المبدئية للانتقال الديمقراطي والدولة المدنية فإن معركتهم ضد حقوق المرأة في التمثيل السياسي تظل حامية الوطيس. وفي أغلب الدول العربية يشكل أنصار الإسلام السياسي المتشدد غالبية من المعارضين. وثبت أن بوسع هذا التيار أن يحرز انتصارات انتخابية كبرى في المراحل الأولى من الانتقال الديموقراطي وأن يوظفوا هذه الانتصارات لوقف نمو حركة المرأة وتمثيلها السياسي. ففي الجزائر عارضت الحركات النسائية بفزع استمرار الانتخابات التي كانت بدأت بنهاية عام 1991 وانتصرت فيها الجبهة الإسلامية للإنقاذ خوفًا من العصف بحقوق النساء التي كان نظام جبهة التحرير قد اعترف بها كتعبير عن التقدير لدور المرأة في التحرير(17), في الكويت، أفشلت التيارات الإسلامية لفترة طويلة كافة المبادرات التشريعية لمنح المرأة حق التصويت في الانتخابات العامة. وفي العراق تراجعت حقوق المرأة بصورة فظيعة في الدستور الجديد والتشريعات بنفس الطريقة التي شهدناها في الكويت وبلاد أخرى أي بتوظيف الحجج الشرعية وتعبئة العداء للمساواة والمرأة بصورة عامة، بالرغم من الحماس الظاهري للديموقراطية بعد سقوط نظام صدام حسين وقامت قوات الغزو الأمريكي بدعاية واسعة حول تحويل العراق إلى“نموذج رائد للديموقراطية في العالم العربي“. وفي عمان لم تفز سوى سيدتين بمقاعد في المجلس الاستشاري في انتخابات عام 2000. ولم تفز أية سيدة في انتخابات المجلس البلدي المركزي في قطر عام 1999، ثم فازت مرشحة واحدة في انتخابات عام 2003. وفي البحرين رشحت 31 سيدة أنفسهن في المجلس البلدي ولم تفز حتى واحدة منهن عام 2002، ولم تنتخب سيدة واحدة في انتخابات عام البرلمان في نفس العام، بالرغم من منح النساء حق التصويت(18). بالرغم من تقدم ستة للترشح، وحتى في مصر أسفرت أول انتخابات برلمانية بعد إطلاق الحراك السياسي الواسع الذي قادته حركات الإصلاح – عام 2005 – عن نجاح أربع نساء فقط، بسبب فشل الأحزاب الكبرى وعلى رأسها الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم في وضع النساء على قوائمها الانتخابية. وتدل كل هذه التجارب الأحدث على ما ندعيه من أن المراحل الأولى من الانتقال الديموقراطي تطلق عوامل التعصب ضد المرأة بأكثر مما تطلق القوى المناصرة لحق المرأة في المساواة وإنهاء كل صور التمييز ضد النساء.
يعني ذلك أن المرحلة الراهنة من الانتقال الديموقراطي تشهد ميلاً عامًا نحو تراجع التمثيل السياسي للنساء في المؤسسات النيابية. وقد يترافق مع ذلك نكسات في المشهد التشريعي والاجتماعي بالنسبة للنساء. وغالبًا ما تشارك نسبة يعتد بها من النساء في الدفع نحو هذا المشهد، كما أشرنا من قبل.
غير أن التقدم على طريق الانتقال الديموقراطي أو مجرد ثباته لفترة معقولة من الزمن أمام الأزمات السياسية والهجوم المضاد الذي تشنه القوى التسلطية والشمولية يقود إلى تحسن واضح لمستوى الحضور السياسي للنساء. وقد شهدنا ذلك بالفعل في الكويت حيث تم الاعتراف بحق النساء في التصويت (19). أما أفضل مستويات التقدم في التمثيل والحضور السياسي للنساء فتتحقق في المغرب التي تعد أكثر الدول العربية تقدما على صعيد الديموقراطية، وهو أيضًا البلد العربي الذي نضجت فيه حركة نسوية قوية نسبيًا، بفضل النضال الطويل للنساء والطبقة العاملة والمثقفين التقدميين. وقد انعكس النضج والقوة النسبيان للحركة النسوية حتى على التيارات الرئيسية للإسلام السياسي التي تقترب من الاعتراف بحقوق المرأة أكثر من نظيراتها في أي بلد عربي آخر.
وفي مصر تحقق بعض التقدم في تمثيل النساء ولو عن طريق ضرب نماذج للنجاح الانتخابي لعدد محدود للغاية من السيدات في انتخابات عام 2005. وأهمية هذه النماذج تكمن في أن هؤلاء السيدات لم يتمتعن بتأييد أي حزب أو عائلة كبيرة بالرغم من مؤشرات التخلف الأشد التي عانين منها في أوساطهن الريفية، وإنما نجحن في منافسة انتخابية ضارية بفضل تاريخ طويل من العمل المدني والاجتماعي، كما بفضل الإرادة الحديدية التي تمتعن بها.
ولكن وجود بوادر مبكرة لإمكانية حدوث انقلاب في اتجاهات تمثيل وحضور المرأة العربية في الميدان السياسي بعد مرحلة أولى من الانتقال الديموقراطي لا يعني التقليل من التحديات الكبيرة التي تواجههن حتى في هذه المرحلة. وفي مقدمة هذه التحديات تأتي قضية الوعى المنخفض للنساء أنفسهن بإمكانية انتزاع حقوقهن السياسية والاجتماعية دون التضحية بالضرورة بالأمن والرفاه الشخصي في عائلة سعيدة والانتماء إلى جماعة إنسانية منسجمة وقادرة على النضال المشترك ضد الفقر وضروب التمييز والقهر سواء الذي يتقمص سلطة الدين أو الأيديولوجيات التقليدية والرجعية الأخرى (20).
لم تصنع النظم الديموقراطية شرعيات مبكرة لتمكين النساء سياسيًا، بل كان الأمر العكس، حيث طال القمع السياسي النساء لعقود بل وقرون أحيانًا. ولا زالت حتى أكثر المجتمعات ديموقراطية تواجه تحدى التمثيل العادل للنساء في المجال السياسي. وقد أدى ذلك في بعض الأحيان إلى صدور تشريعات تحت الأحزاب على ترشيح حد أدنى من النساء إلى جانب الرجال على قوائمها الانتخابية، من أجل ضمان تمثيل النساء تمثيلاً عادلاً.
ويزداد الإجحاف بالحقوق السياسية والتمثيلية للنساء في الدول الفقيرة الأقل تطوراً وخاصة الدول العربية والإسلامية التي تشهد بالإضافة إلى الظلم الشامل الموروث للمرأة نمو حركات أصولية وأيديولوجيات تقليدية معادية لحق النساء في المساواة. وتعكس المرحلة الأولى من الانتقال الديموقراطي تحيزات القوى الصاعدة في المجتمع السياسي بتأثير سلسلة لا تنتهى من أزمات الاحتجاز السياسي والاجتماعي. ومع ذلك تظل الديموقراطية نظامًا متفوقًا حتى بالمقارنة بالنظم التسلطية والشعبوية والشمولية التي أخذت على عاتقها تحديث العلاقات الاجتماعية والاعتراف بحقوق المرأة أو بعضها على الأقل، وذلك لأن هذا الاعتراف تم من أعلى ودون أن تتمثله القوى الاجتماعية والسياسية المختلفة في الواقع الاجتماعي. وتتعاظم المشكلة بسبب ما تعانيه هذه المجتمعات وخاصة المجتمعات العربية الإسلامية التي تواجه أزمات هوية وصراعات سياسية تشعرها بالاستهداف والإهانة والتبعية في النظام الدولي، وكثيرًا ما تفسر رغبة الأنظمة الحداثية التسلطية في الاعتراف بحقوق المرأة وكأنها نوع من التبعية العمياء للغرب وليس توقا للانطلاق إلى التقدم الاجتماعي، ولكن أسوأ ما تفعله النظم التسلطية والشمولية فهي مصادرة حق العمل المنظم لكافة القوى الاجتماعية ومن بينها المرأة، ورغم المخاطرة بحكم قيمي في هذا السياق، فإن هذا الكاتب يرى أن من الأفضل لقضية المرأة أن تخوض نضالاً ممتدًا لكسب معركة الاعتراف السياسي والاجتماعي من أدنى عن أن تحصل على حقوق اسمية من أعلى دون أن تتم عملية تغير ثقافي وسياسي تثبت هذه الحقوق في عقول الناس وفي الساحة السياسية.
ومع ذلك تبدو المشكلة الأعمق هي أن قضية الحق في المساواة واقتلاع كل صور التمييز ضد المرأة تتسم بقدر كبير من الممانعة والعناد، وقد تستغرق وقتًا زمنيًا طويلاً للغاية حتى في الديموقراطيات الناضجة. وتبدو المشكلة كما يلي. إن كسب المعركة السياسية عن طريق مبدأ حكم الأغلبية ومن ثم السياسات الانتخابية يبدو متعذرًا(21).
ويلقى هذا الواقع ظلالاً كثيفة من الشك حول استراتيجية التمثيل السياسي للمرأة من خلال السياسات الانتخابية التقليدية. ولهذا السبب يطور الفكر التقدمي تصوراً بديلاً عن مفهوم وعمل النظام الديموقراطي. وبادر أنتوني جيدنز بطرح مفهوم الديموقراطية التداولية، وبادر لاكلاو وموفي بطرح مفهوم الديموقراطية التعددية بما يوسع مفهوم الممارسة السياسية لتشمل الأقليات والنساء وجماعات الهوية المستقلة(22).
ولا شك أننا نحتاج في مصر والعالم العربي إلى تطوير استراتيجية خاصة تناسب ظروف ومستوى تطور الجماعة السياسية والثقافية الوطنية والإقليمية. وقد يكون هذا هو أكثر القضايا إثارة بالنسبة لمستقبل الحركة النسائية.
محمد السيد سعيد: كاتب وباحث.
(1) Hon. Frene Ginwala. Women in Parliament: beyond numbers, IDEA Institute, April 1998, updated 2002.
(2) IPU. Women in Politics. https://ipu.org/wmn-e/studies.htm.
(3) International Women Democracy Center. Fact Sheet’ Women political participation’. IDEA website
(4) IPU. New Delhi Declaration (new Delhi, 1997).
(5) Heidi Hudson. Gender, Development and Democracy. https://www.Iss.co.za/Pubs/ Monograph/no 27/ gender response.html.
(6) Jane Johnson. Some Consequences of Economic and Political Restructuring and Re-adjustment. Social Politics Number 3. Spring 1996. And, Leo Panitch”Globalization Begins (and Ends) at Home: Bringing the state back In”> in Marjorie Griffin and Stephen Mcbride (eds). Global Turbulence: social Activists’ and State Responses to Globalization. Burlington. VT: Ashgate, 2003.
(7) Kumari Jayawardene. Democracy and Women’s Rights. Awakened Women Magazine. November 6, 2005
(8) Stanford Encyclopedia of Philosoh. Identity Politics. Http://plato. Stanford.edu/ identitypolitics. And, Bell Hooks. Yearning: Race, Gender and Cultural Politics Boston, South End press. 1990.
(9) William Commoly Identity./ Difference: Demoeratie Negotiations of Political Paradoxes. Minnneapolis, University of Minessota Press, 2002, p> 64
(10) Katherine Tate. From Protest to Polities. Cambridge, Massachussetts: Harvard University press, 1993.
(11) IPU. An Approach to Democracy, https://ipu/wmn-c/approach.htm
(12) UNESCO.https://unesco.org/courier/2000_06/uk/dpss22.htm.
(13) https://www.cedemocracy. Org/campfinance.html.
(14) Women Renaissance.https://www.sarde.net/sd/renaissance/renaissance%208/gender.html.
(15) Farooq hassan. The Islamic Tepublic, Aziz publishers. 1984. P.4
(16) Michele Swenson. Democracy Under Assault: theopolitics, incivility and violence on The right. http:/www.theopolitics.com/?p=2.
(17) فالنتين مغدم. جنس الديموقراطية: الربط بين حقوق النساء وإحلال الديموقراطية في الشرق الأوسط.
https://www.alwatan.com.kw/arb/default.aspx?isu-200407000000207
(18) ابتسام الكيلاني. أوضاع المرأة السياسية في مجلس التعاون الخليجي.
https://www.alwatan.com.kw/arb
(19) Frida Ghitis. Women in Kuwait: Free at Last. A stop Towards Democracy in the Middle East. https://fridaghitis.blogspot.com/2005.
(20) Elizabeh Fernea. The Challenges for Middle Eastern Women in the 21st century. The Middle East Journal. Vol. 44, No. 2. Pp 185- 193.
(21) UNESCO. Unfinished Democracy. https://unesco.org/courier/2000.
(22) Susan Heckman, Radical Plural Democcracy: A New Theory for the Left? Accueil: printemps-ete 1999. https://pages.globetrotter.net/charro/HERMES4/heckman.htm.
تقييم نقدى للتاريخ الحديث وتحديات المستقبل
الحركات النسائية المصرية
تقييم نقدى للتاريخ الحديث وتحديات المستقبل
میرفت حاتم
ساهمت ثورة 1952 في صعود دولة نشطة في مصر، ألزمت نفسها بلعب دور هام أولاً في السياسة وثانيًا في الاقتصاد في المجتمع المصرى. وقد كانت لهذا تداعيات خطيرة فيما يخص النساء المصريات اللاتي برزن كمشاركات ناشطات في مختلف قطاعات المجتمع (بما في ذلك الصناعة والتعليم والمهن) يطالبن بحقوقهن السياسية؛ بمعنى الحق في التصويت والحق في الترشيح للهيئات التمثيلية. في القسم الأول من الورقة أرغب في فحص الحملة الناجحة التي قادتها نساء الطبقة المتوسطة بين 1954 – 1956 من أجل المساواة في التمثيل السياسي، وكيف ساهمت تلك الحملة في حفز الدولة للسيطرة على باقي المكونات الاقتصادية والاجتماعية في برنامج عمل الحركات النسائية كقاعدة لنظام جديد لنسوية الدولة، وفي مقابل الحقوق الاقتصادية والقانونية الجديدة شلت الدولة حركة المجموعات النسائية وقدرتها على العمل بشكل مستقل. وفي القسم الثاني من الورقة أناقش كيف أسهم الانفتاح الاقتصادي في مصر في تفكيك قبضة الدولة القوية على كل المجموعات والمؤسسات في المجتمع خالقا فضاء عامًا جديدًا للنساء ليشكلن منظمات غير حكومية يمكنها صياغة برامج عمل وأدوار جديدة للنساء في مجتمع متغير. وفي الختام سأناقش بعض الدروس المستفادة من هذين النموذجين من علاقات الدولة بقضية النوع الاجتماعي.
1 – المزايا والمخاطر لنسوية الدولة (1956 – 1979) (*) :
كانت المواجهة الأولى الكبرى بين المجموعات النسائية الناشطة وحكومة الضباط الأحرار الذين أطاحوا بالنظام القديم حول المساواة في التمثيل السياسي للمصريين. هذا المطلب له تاريخ موغل في القدم بدأ في أوائل العشرينيات عندما انتقدت إحدى الشابات الوفديات (منيرة ثابت) دستور 1923 لإنكاره على النساء الحق في التصويت وفي الترشيح للهيئات العامة (1) أثناء العشرينيات كان صوتها صوتًا وحيدًا في دعم الحقوق السياسية للنساء، أما الاتحاد النسائي المصرى الذي ترأسته هدى شعراوي فلم يدعم هذا المطلب لأن عضواته كن يعتقدن بأهمية إعطاء أولوية للمطالبة بالحق في التعليم وإصلاح عدم المساواة في قوانين الأحوال الشخصية. لكن هدى شعراوى في عام 1936 – عندما طالبت مصر بمزيد من الاستقلال السياسي من بريطانيا العظمى– غيرت موقفها من حقوق النساء السياسية، وانتقدت عدم منطقية إنكار الحق في التصويت على النساء المتعلمات والمثقفات من الطبقات البرجوازية والطبقات المتوسطة في الوقت نفسه الذي يتمتع فيه الرجال الأميون بتلك الحقوق(2). وقد أصبحت هذه حجة شائعة استخدمتها النساء المنظمات في الأربعينيات لإبراز ازدواجية السياسيين المصريين الذين ادعوا أن النساء المصريات لم يكن مستعدات بعد لممارسة الحقوق السياسية.
دخل الكفاح من أجل الحقوق السياسية مرحلة جديدة في الخمسينيات؛ فقد ساهمت وفاة هدى شعراوي 1947 في صحوة الاتحاد النسائي المصرى، والذي كانت لحمته قد تقوضت بالصراعات بين عضواته حول التوجه المستقبلي للاتحاد. وقد شكلت درية شفيق – التي كانت تمثل جيلاً جديدًا من النسويات المصريات – منظمة جديدة باسم بنت النيل. 1949 نظمت نساء الطبقة الوسطى الصغيرات المتعلمات حول هذا المطلب الهام. وباستخدام استراتيجية أكثر مواجهة عن الاتحاد النسائي انخرطت بنت النيل في عديد من الاحتجاجات، ينتهى ذلك باقتحام البرلمان عام 1951 للاحتجاج على استبعاد النساء من عضويته. في عام 1954 أعلنت درية شفيق وعدد من عضوات منظماته إضرابا عن الطعام في نقابة الصحافيين احتجاجًا على استبعاد الضباط الأحرار للنساء من عضوية الجمعية التأسيسية التي كانت تقوم بصياغة دستور جديد لحكومة ما بعد 1952(3).
شغلت تلك الأفعال اهتمام الرأي العام وحشدت عددًا كبيرًا من النساء ورجال الطبقة الوسطى في الحملة من أجل المساواة السياسية للنساء. وقد أسهمت هذه العملية في خلق مناخ سياسي جعل من الصعب على الدولة تجاهل آراء النساء حول القضايا الاجتماعية والسياسية الهامة. ورغم اختلاف النساء والرجال حول التكتيكات التي استخدمتها بنت النيل (4)، فقد نجحت درية شفيق في تحريك الرأى العام بما يتجاوز النقطة التي وصلت إليها النسويات الأوائل عبر تكتيكاتهن القائمة على المطالبة بشكل ديبلوماسي. وقد أوضح هذا النشاط – بنفس القدر من الأهمية – حماس النساء أو مجموعة منهن – لقضية المساواة وقدرتهن على حشد عدد واسع من النساء حولها.
بحلول عام 1956 – وحكومة جمال عبد الناصر على أهبة الاستعداد للإعلان عن دستورها الجديد – بدأت مجموعات النساء المتنوعة والمنظمة جيدًا دورة جديدة من الحشد. في يناير 1956، وقبل أيام قليلة من الإعلان عن الدستور، شكلت ممثلات 20 جمعية نسائية اتحادًا“لتركيز جهود مختلف المنظمات النسائية من خلال تشكيل منظمة كبرى تعمل كرابطة اتصال بين عضوات الجمعيات“(5). كانت المنظمات العضوة في هذا الاتحاد جمعيات تطوعية كانت مطالبة بالاقتصار في عملها على الأنشطة الاجتماعية. ورغم أن الاتحاد كان من المفترض أن يكون لا سياسيًا حيث إن القوانين الجديدة حظرت الاشتغال بالسياسة، فإن تشكيله في تلك اللحظة التاريخية كان مصمما لإعادة الحشد باتجاه قضية المساواة النوعية.
في نفس الأسبوع ألقت أمينة السعيد رئيسة تحرير حواء – أولى المجلات النسائية التي تصدر عن دار نشر كبرى، والعضوة المنتخبة حديثًا في نقابة الصحافيين– محاضرة ساندت فيها منح النساء الحق في التصويت. (6) حتى ذلك الوقت كان لأمينة السعيد (التي تعتبر من المهنيات الرائدات اللاتي ينتمين إلى الطبقة المتوسطة مثلها مثل درية شفيق) موقف نقدي من درية شفيق، وكانت في الوقت نفسه من مؤيدي النظام، بل وإحدى النساء اللامعات اللاتي يقدمهن النظام باعتبارهن مثلا يحتذى. وقد أدت تلك المحاضرة التي كانت بمثابة رد فعل قوى على الأخبار بأن دستور 1956 لن يعطى النساء حقوقهن السياسية، إلى نقلها إلى صفوف منتقدي النظام.
وفي مواجهة المؤشرات على تنامي السخط بين هذا القطاع المؤثر والواضح في المجتمع، وفي محاولة لمنع استخدام المشاركة السياسية من قبل نقادها، منح دستور 1956 النساء الحق في التصويت وفي الترشيح. إلا أن الدستور وضع أيضًا قيودًا على ممارسة النساء لهذه الحقوق:”كل الرجال الذين لهم الحق في ممارسة حقوقهم السياسية ينبغي أن يسجلوا أنفسهم في قوائم التصويت. كما أنه من الضروري أيضًا تسجيل أولئك النساء اللائي يطلبن ذلك الحق“. أوضحت المذكرة التفسيرية للقانون أن القانون قد راعي“مبدأ المساواة بين الرجال والنساء للتسجيل في التصويت كجزء من اعترافه بأهمية الدور الذي لعبته النساء في الحياة العامة لفترة طويلة من الزمن والتأثير الواضح له على تطور الدولة. على أنه في ضوء التقاليد المصرية السائدة قد ترك أمر تسجيل النساء للاختيار وفقًا لقرار كل امرأة” (7).
كان على النساء لكي يسجلن أن يتقدم بطلباتهن إلى الدولة لتدرجهن في كشوف التسجيل وهو أمر أضر بالنساء الريفيات اللاتي كانت الأمية تنتشر بين قسم كبير منهن. هذه المعوقات البيروقراطية لم تشجع العديد من نساء الطبقة الوسطى على التصويت، وأدت إلى تحييد التأثير العددي والانتخابي للنساء. الأهم أن الدولة من خلال وضع اشتراطات للتسجيل أصبحت قادرة على شق الحركة النسائية. وتم تصوير موضوع المشاركة السياسية للنساء باعتباره محل اهتمام أقلية ضئيلة من النساء ذوات الأوضاع المتميزة والمنعزلات عن أغلبية النساء الأميات اللاتي لم تكن الصلة بين الحقوق السياسية والقضاء على الفقر واضحة لهن. من جانب آخر فإن نساء البرجوازية والطبقة المتوسطة، رغم إدراكهن للقيود التي وضعت على ممارسة النساء للحقوق السياسية، فإنهن لم يتخذن موقفًا نقديًا منها. وبسبب قدرتهن على التعامل مع المعوقات البيروقراطية التي وضعتها الدولة فإنهن لم يهتممن بالمشاكل التي وضعتها على النساء الأخريات. وركزت حملتهن من أجل المساواة السياسية على سخافة إعطاء الحقوق السياسية للرجال الأميين وإنكارها على النساء المتعلمات وقد يوضح هذا لماذا لم يعارضن وضع قيود على النساء الأميات.
وحيث إن منح الحقوق السياسية للنساء قد أعطى الحكومة المصرية سمعة باعتبارها حكومة تقدمية، فقد أمدها ذلك التصور بحافز جديد لتلعب دوراً نشطًا في الاقتصاد. وبناء على تردد رأس المال الخاص في الاستثمار في الاقتصاد أخذت الدولة القيادة في التطور الاقتصادي؛ فقامت بتأميم الشركات الخاصة والأجنبية مشكلة قطاعًا عامًا وفر التوظيف والعديد من الخدمات الاجتماعية بما في ذلك التعليم والصحة والتأمينات الاجتماعية. وقد حظرت التمييز على أساس الجنس في أماكن العمل لتشجيع مشاركة النساء في قوة العمل. وللتوفيق بين عمل النساء داخل وخارج الأسرة اشترطت الدولة توفير دور الحضانة في أي منشأة توظف أكثر من 100 امرأة، كما منحت القوانين النساء أجازة أمومة 3 أشهر مدفوعة الأجر. وسهلت للأمهات العاملات الحصول على أجازة بدون أجر أو العمل نصف الوقت لرعاية أطفالهن دون الخوف من فقدان وظائفهن.
بإدماج النساء في قوة العمل ومنحهن حقوقًا جديدة لم يتمتعن بها من قبل، أصبحت النساء شركاء في مشروع نسوية الدولة، بمعنى التزام الدولة بتوسيع حقوق النساء مقابل مشاركة النساء في الملكية التنموية كمدرسات عاملات في مصانع ومهنيات في مجال الرعاية الصحية.
وبينما ساعدت نسوية الدولة على تأمين العديد من الحقوق للنساء، واستخدمت الأيدولوجيا النسوية للحصول على شرعية على المستوى الوطني والدولي، فإنها قامت بصياغة العقد الاجتماعي الخاص بها. ففي مقابل الإدماج الاجتماعي والاقتصادي في التنمية كان على النساء القبول بتحكم الدولة في برامجهن وفي عملهن من خلال“منظمة جماهيرية ثانوية للنساء“(8) تنتمى إلى الاتحاد الاشتراكي العربي (الحزب السياسي الذي سيطرت عليه الدولة). وقد أدى اعتماد النساء المصريات على الدولة – المساندة لهن شكليا – إلى ترك القوانين البطريركية القديمة كما هي خاصة في الأسرة. فخلال فترة الثلاثين عامًا تلك التي شهدت تغيرات اجتماعية واقتصادية وسياسية كبرى تركت الدولة قوانين الأحوال الشخصية القديمة – التي لم تمنح النساء والرجال حقوقا متساوية في الطلاق وحضانة الأطفال – دون أن تمس تقريبًا. واستمر اعتبار الزوج/ الأب المسئولين اقتصاديًا حتى في الأسر التي كانت تعتمد على دخل كل من النساء والرجال، واستمر العمل المنزلي مسئولية النساء العاملات. الأسوأ أن نسوية الدولة أسست لممارسات بطريركية جديدة في المجال العام. ورغم أن قوانين العمل التقدمية التي وفرت الحماية للنساء ضد التمييز في قطاع الدولة فإن النساء المؤهلات القادرات نادرًا ما كان يتم ترقيتهن للمواقع البيروقراطية المهمة حتى يبلغن الخمسينات، أي حين يصبحن على وشك الإحالة للمعاش.
بدلا من ترك المنظمات النسائية المستقلة تتطور، قامت الدولة باحتواء وإدخال النساء الناشطات في الحكومة (مثل كريمة السعيد وهي عضو نشط وبارزة في نقابة المعلمين وعائشة راتب التي كانت من أوائل الخريجات من كلية الحقوق والتي قاضت الحكومة المصرية في 1951 لعدم تعيينها وكيل نيابة). كما أنها بدأت تنمى النخبة السياسية الخاصة بها من النساء لإجهاض أي صحوة للمنظمات النسائية التي تستجيب لاحتياجات وأولويات النساء. إن اختيار أولئك النساء ليصبحن وزيرات أو عضوات في البرلمان وطول فترة ممارستهن للنشاط السياسي، كانت أموراً تحددها الدولة. ونتيجة لذلك فإن العديد من النساء البارزات في تلك الفترة لم يكن يرين أنفسهن ممثلات لجمهور النساء اللاتي انتخبتهن بل باعتبارهن يعملن تحت رعاية الدولة.
لقد تناولت الدولة مسألة النساء العاملات بشكل مختلف. ففي الوقت نفسه الذي كانت تدفع فيه باتجاه الأجور المتساوية للنساء المتعلمات، فإن الحل الذي قدمته لمشكلة الفقر في الريف في نهاية الخمسينيات والستينيات كان رفع أجور الرجال في الطبقة العاملة. ورغم أن هذا استجاب لبعض احتياجات الأسر الريفية التي تنتمى للطبقة العاملة، فإن سياسة الأجور هذه لم تتصد لمبدأ الأجور الأقل للنساء الفقيرات بل أكدت الدولة اعتماد نساء الطبقة العاملة على الرجال كجزء من طريقة الحياة (9) وهكذا حافظت سياسات الدولة على معيار مزدوج في استجابتها لمشاكل النساء العاملات ونساء الطبقة المتوسطة. وقد صدقت النساء من الطبقة المتوسطة – بدرجة كبيرة – ادعاءات الدولة أن افتقاد النساء العاملات للقوة سببه الجهل والفقر، وليس انخراط الدولة في إعادة إنتاج شروط عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية.
2 – التحرر الاقتصادي المحدود و/ أو خلق فضاء عام جديد للمنظمات غير الحكومية النسائية:
في عام 1974 بدأ الانفتاح الاقتصادي في المجتمع المصرى وصاحبه انفتاح سیاسی مقيد بداية من عام 1976 ونتج عن ذلك إعادة تعريف العقد الاجتماعي القديم الذي كانت الدولة قد عقدته مع نساء الطبقة المتوسطة أثناء الخمسينيات والستينيات. وافقت الدولة على مضض على إعطاء نساء الطبقة المتوسطة بعض حريات التعبير السياسي في مقابل تقليل التزام الدولة بهدف العدالة الاجتماعية والذي كان حتى ذلك الوقت قد أخذ شكل الحق في العمل والخدمات الاجتماعية الأساسية مثل التعليم والصحة في مقابل رسوم زهيدة. إلا أن الدولة لم تنسحب تمامًا من المجال السياسي بل استمرت في ممارسة التحكم فيما يتعلق بعدد الأحزاب والمنظمات النسائية التي تسمح بها وطبيعة هذه الأحزاب والمنظمات التي لها بأن تعمل، ومن خلال تأليب قسم من المجتمع ضد قسم آخر مثل استنفار المجموعات الإسلاموية ضد المجموعات العلمانية في محاولة من الدولة في أن تسيطر على الأجندات النسائية.
وكجزء من جهودها لتقسيم المجموعات النسائية، شجعت الدولة التوسع في عودة المنظمات الخيرية التي ترعاها النساء البرجوازيات لتقديم الخدمات والأنشطة المدرة للدخل للمحتاجين الذين لم تعد الدولة راغبة في إمدادهم بها (10). وهكذا بعد ثلاثين عامًا من عدم التركيز على مثل هذه الأنشطة الاجتماعية بدأت وزارة الشئون الاجتماعية في دعمها بشكل شديد؛ فالوزيرة تحضر فعالياتهن الاجتماعية، والإعلام المملوك للدولة يغطي تلك الفعاليات بشكل منتظم وبارز. إنهن يقمن بدور الحلفاء المخلصين للدولة ويستمتعن بالقبول والتأييد الرسمي ونادرًا ما ينتقدن سياسات الدولة. إن النساء البرجوازيات، مثلهن مثل أزواجهن من رجال الأعمال، ساندن انسحاب الدولة من المجال الاجتماعي الذي يتركهن بدون قضايا اجتماعية لها قيمتها (كمحو الأمية والرعاية الصحية للنساء والأطفال والأيتام) تشغل أوقات فراغهن وتحسن صورتهن الاجتماعية(11).
وقد ساهم انسحاب الدولة من الأنشطة التنموية في تزايد أعداد المنظمات غير الحكومية التي تمولها الجهات الدولية، والتي تهدف إلى تقديم الخدمات الاجتماعية والأنشطة المدرة للدخل، وتؤثر عبرها على نمط التنمية في مصر (12). حاليًا يوجد ما يزيد على 15000 من مثل هذه المنظمات غير الحكومية (13)،تتركز 70% منها في القاهرة، تقدم منها 119 فقط خدماتها للنساء. وفي الريف يسيطر الرجال على المنظمات التي تقدم خدمات للنساء (14). وقد ساعدت أنشطة هذه المنظمات على دعم عملية تحول اقتصادي وسياسي طويلة ومؤلمة ومخلخلة للقطاعات الأضعف بين الطبقات العاملة. كما أنها أمدت المهنيين – نساء ورجالا – من الطبقة المتوسطة بمصادر للتوظيف في هذا القطاع المتنامي. وقد كرست نتائج ذلك العلاقة الفوقية بين قيادات تلك الجمعيات وجمهورها، والتي كانت سمة مميزة لأداء الجمعيات الخيرية القديمة التي كانت تعمل في مجال تقديم الخدمات الاجتماعية.
وعندما اندفع الممولون والمنظمات غير الحكومية المرتبطة بهم إلى الأنشطة المدرة للدخل في الريف في صعيد مصر، ركزوا بشكل مفرط على إمداد النساء بماكينات الخياطة. ويعتقد بعض ممثلوا تلك الجمعيات المجتمعية – والتي تعمل مع النساء الريفيات – أنه ربما كان من الأفضل العمل على تطوير مهارات النساء في تصنيع الأغذية – وهو أمر موجود أصلاً في المنزل – و/ أو بيع الخضر. إن ذلك يساعدهن على تنمية مهارات هامة في مجال الأعمال الصغيرة وثيقة الصلة بالأدوار التي يلعبنها في اقتصادياتهن المحلية بالفعل. وفي وقت أزمة اقتصادية، ازدادت فيه أهمية شراء المنتجات الغذائية مقارنة بالملابس، فإن التنوع الذي جلبته تلك الأنشطة كان أقل حساسية للنوع الاجتماعي. ويبقى التحدى أمام الجهات الدولية والمحلية هو أن تخرج من تحيزاتها النوعية في تحديد ما الذي تستطيع أو لا تستطيع النساء الريفيات القيام به، والذي في غالبية الحالات، لم يكن حول ما هي الأنشطة التي يمكن للنساء الريفيات عملها، بل كان متعلقًا برؤية محدودة لتلك المجموعات.
ومن بين المنظمات غير الحكومية المنخرطة في تقديم الخدمات الاجتماعية في العالم العربي، 25.8% هي منظمات دينية (مسيحية أو إسلامية). وقد ساهم هذا الدور في تدعيم قدرات تلك المجموعات الدينية على الحشد السياسي لقطاعات كبيرة من المجتمعات التي لا تحصل على الخدمات الضرورية. وقد ساهم صعود الإسلام السياسي في إثارة الجدل مجدداً حول الأدوار التي يجب أن تلعبها النساء في المجتمع. وقد دعمت نساء الطبقة الوسطى المجموعات الإسلامية من خلال قبولهن وتبنيهن للزى الإسلامي، وللتعريفات الأكثر محافظة لأدوارهن الاجتماعية في المجتمع. وقد دفع ذلك بجدل جديد حول المواقف الإسلامية من حقوق النساء. في البدايات الأولى لهذا الجدل في الثمانينيات كان هناك تأييد معلن من الإسلاميين لعودة النساء إلى المنزل. وقد تغير ذلك في التسعينيات حيث أخذ العديد من الشخصيات الإسلامية العامة – ومن بينهم زينب الغزالي– في القول بأن النساء يمكنهن القيام بأدوارهن في الحياة الخاصة والعامة بما يسمح لهن بالقيام بالأخيرة(16). وفي كتابات حديثة تدعو أميمة أبو بكر – منظرة نسوية إسلامية – إلى ضرورة التفرقة بين موقف الإسلام من إلى النساء وحقوقهن، وبين الطريقة التي يفسر بها المفسرون الذكور تلك الحقوق. وتجادل بأن الله والرسول قد استجابا باستمرار بشكل إيجابي المخاوف المؤمنات عبر القرآن، وأنه من الممكن للنساء المسلمات أن تطورن وتجادلن لصالح تفسيرات دينية أكثر تعاطفًا مع النساء.
ولمواجهة تأثير المنظمات غير الحكومية الإسلامية، دعم الممولون الدوليون تشكيل مجموعات المناصرة والتي تسعى لتطوير مجتمع مدنی علماني يطالب الدول العربية بديموقراطية أعمق. وللأسف، فإن عدد تلك المنظمات ظل صغيرًا، فلم تتجاوز نسبة منظمات حقوق الإنسان 6.7%،والمنظمات النسائية 7.7% من إجمالي المنظمات غير الحكومية (17).
لقد عارضت الدولة المصرية بل – كانت معادية – تشكيل المنظمات غير الحكومية من نساء الطبقة الوسطى، وكانت تنظر إليهن كنقاد محتملين لها، وترى نشاطهن كمصدر للمواجهة بين الدولة والمجموعات الإسلامية. وتعود بدايات الجهود لتشكيل المنظمات النسائية غير الحكومية المستقلة إلى 1977 من خلال تجمع مجموعات غير رسمية من النساء في شكل حلقات لمناقشة قضايا النساء. وسرعان ما بدأت بعض اللجان الرسمية تتشكل في نقابة الصحفيين (1979)، والأحزاب السياسية مثل الاتحاد النسائي التقدمي بحزب التجمع التقدمي الوحدوي (1983)، ولجنة أوضاع المرأة العربية في اتحاد المحامين العرب (1984)، والتي كان ينظر إليها باعتبارها“الامتداد الطبيعي لاهتمام الاتحاد بمناقشة حقوق الإنسان“. ولأن تلك اللجان الرسمية كانت إضافة إلى الجمعيات والأحزاب السياسية الموجودة بالفعل، فقد استنهضت النقاش حول قضايا واهتمامات النساء دون أن تحتاج إلى إذن رسمي من الدولة.
لقد استخدم القانون 32 الذي صدر عام 1964 للتضييق على المنظمات غير الحكومية النسائية، بمطالبتها بعدم قبول التمويل الأجنبي، ولا جمع التبرعات، أو حشد التمويل بدون موافقة مسبقة من وزارة الشئون الاجتماعية. كما وضع القانون إجراءات إدارية معوقة أمام أولئك اللاتي سعين للحصول على موافقة الوزارة(18).
كانت أولى المنظمات الدفاعية النسائية هي“جمعية تضامن المرأة العربية” برئاسة نوال السعداوي، الطبيبة والكاتبة النسوية المعروفة. في البداية رفضت الدولة الموافقة على تشكيل الجمعية، لكن نوال السعداوي نجحت في حشد ضغوط من الشخصيات العامة (الذكور) حتى حصلت على موافقة الوزارة عام 1982. وقد نجحت الجمعية – من خلال التمويل والمجلة التي أصدرتها (نون) وتنظيمها العديد من المؤتمرات الدولية – في إشعار المجتمع المصرى بتأثيرها في فترة الثمانينيات. ولسوء الحظ كانت سيطرة نوال السعداوي واضحة على الجمعية، وسادها خطاب نسوى ليبرالي غربي ركز على الحقوق الفردية للنساء فی الحب والزواج (19).
من جانب آخر ظهرت منظمات غير حكومية نسائية خلال الثمانينيات، منها“رابطة المرأة العربية“، وهي منظمة غير حكومية شبه حكومية، لها روابط عديدة مع الحكومة المصرية من خلال رئيستها د. هدى بدران (1987)(20)، والمرأة الجديدة 1984 التي تبنت خطابا يساريا، واهتمت بمشكلات الفقر وما يؤدى إليه من تهميش نساء الطبقة العاملة (21). وانضم إليها في التسعينيات جيل جديد من المنظمات النسائية غير الحكومية، ومثلها منتدى المرأة والذاكرة، الذي اهتم بـ“قراءة الثقافة العربية من منظور حساس للنوع الاجتماعي” (22) وعقدت العديد من المؤتمرات التي ناقشت الدور الذي لعبته الرائدات المصريات في تقدم مجتمعهن، واهتماماتهن النوعية.
وفي ظل الانتقادات الوطنية والإقليمية والدولية للقانون، عينت الحكومة المصرية الدكتورة ميرفت التلاوى وزيرة للشئون الاجتماعية وجعلتها مسئولة عن صياغة قانون جديد يحكم عمل المنظمات غير الحكومية. الأمر الذي تمخض عن صدور القانون 153 (1999) والذي وضع أساسًا“للإدارة التفصيلية لجميع جوانب عمل المنظمات غير الحكومية“. وقد حظرت المادة 11 من القانون تأسيس الجمعيات“التي تهدد الوحدة الوطنية“، أو“تنتهك النظام العام أو الأخلاق العامة” أو تعمل بأنشطة“سياسية أو نقابية“(23) وقد تم إلغاء القانون بسبب الإجراءات، وتم استبداله بقانون آخر 84 لسنة 2003 يتضمن العديد من مواده المقيدة لعمل الجمعيات.
وقد شاركت نساء الطبقة العاملة في تلك الجهود من أجل تنظيم النساء بالتركيز على نقاباتهن كوعاء لتمثيل مطالبهن المتعلقة بقضايا الحياة اليومية. فبينما كان الرجال يهيمنون على النقابات، اعتصمت العاملات في شركة غزل المحلة تضامنا مع زملائهن الرجال، بالإضافة إلى مطالبهن الخاصة بأن تشمل أجورهن أيام الأجازات الأسبوعية، وأن تزيد أجورهن وفقًا للطبيعة الخاصة لعملهن، وتحسين نوعية الوجبات التي تصرف لهن أثناء العمل (24). وبالرغم من التعامل الفظ للبوليس، استمرت العاملات في الحشد والحركة العمل إلى أن شكلن لجنة شئون النساء في الاتحاد العام للعمال. وقد دافعت اللجنة عن إنجازات النساء العاملات في الصناعة المصرية في مواجهة الحملة شديدة الشراسة التي حاولت إلغاء مكتسبات النساء في مجال التوظيف في هذا القطاع (25).
مرفت حاتم: أستاذة العلوم السياسية في جامعة هوارد بالولايات المتحدة الأمريكية، وعضوة مؤسسة المرأة والذاكرة.
(*) يعتمد هذا الجزء من الورقة على دراسة ميرفت حاتم:
“The Paradoxes of State Feminism in Egypt”, Women and Politics Worldwide, Barbara Nelson and Najma Chowdhury, eds. (New Haven: Yale University Press, 1994), pp. 326- 245.
(1) منيرة ثابت، ثورات في البرج العاجي (القاهرة: دار المعارف، 1950) صفحات 19، 13.
(2) هدى شعراوى،“واجب المرأة بعد المعاهدة” المصريات، 15 فبراير، 1937، صفحة,19.
(3) درية شفيق، المرأة المصرية (القاهرة: مطبعة مصر، 1955)، صفحات 205، 208،255- 61.
(4) إنجي أفلاطون، النسوية اليسارية المعروفة كانت متضمن هؤلاء النقاد، انظر نولة درویش“صفحات من نضال النساء المصريات” طيبة، (يناير 2002) صفحة 37.
(5) الأهرام، يناير 1956، صفحة 3.
(6) مقابلة مع أمينة السعيد في القاهرة في ديسمبر 1989.
(7) مجموعات المهتمات بشئون المرأة المصرية، الحقوق القانونية للمرأة المصرية (1988) ص 16.
(8) Mervat F. Hatem,”Egyptian Discourses on Gender and Political Liberalization: Do Secularist and the islamist Views Really Differ?” Middle East Journal 48, 4 (Autumn 1994), pp. 665- 666.
(9) سعد هجرسي، الإصلاح الزراعي (القاهرة: مكتبة عين شمس، 1970)، ص 238- 239.
(10) ماجدة مهنا،“قرينات الرؤساء في مؤتمرات التنظيمات العربية” الأهرام، 1 نوفمبر
1989, ص5.
(11) أليس الملاخ،“حوار تساهم في حماية البيئة“،الأهرام، 23 مارس، 1990، ص11؛ سهير الكيال،“سوق خيرية من أجل اليتيمات“، حواء، 24 يناير 1987، ص12.
(12) Mervat F. Hatem,”In the Shadow of the State: Changing Definitions of Arab Women’s”Developmental” Citizenship Rights”, JMEWS: Journal of Middle East Women Studies 1.3 (Fall 2005), pp. 20-45.
(13) فهمية شرف، دور المنظمات غير الحكومية في المتابعة المتكاملة للمؤتمرات العلمية: تقويم ورؤية مستقبلية (نيويورك:2000)،ص61.
(14) Shahida El- Baz in Nawal Ammar and Laila Lababidy,”Women’s Grassroots Movements and Democratization in Egypt”, Democratizaion And Women’s Grassroois Movement, Jill Bystydzienski and Joti Sekhon, Eds. (Indianapolis: Indiana University Press, 1999), p. 155.
(15) Leila Iskandar, Presentation at the Conference on Educating Girls. Washington DC, 1984.
(16) نفس المرجع.
(17) Mervat F. Hatem,”Egyptian Discourses on Gender and Political Liberalization: Do Secularist and the Islamist View Really Differ?”, pp. 673- 674.
(18) أميمة أبو بكر“النسوية، قضية الجندر والرؤية الإسلامية” في أميمة أبو بكر وشيرين شكري، المرأة والجندر (دمشق:دار الفكر، 2002).
(19) نفس المرجع ص 7.
(20) Janine Clark,”The Economic and Political Impact of Economic Restructuring on NGO–State Relations in Egypt”, Economic Liberalization, Democratization and Civil Society in the Developing World, Remonda Bensabat Kleinberg and Janine A. Clark, eds. (New York: St. Matin’s Press, 2002). P. 171.
(21) For an elaboration of the themes discussed in the journal of this association titled Nur see?
(22) Ammar and Lababidy), pp. 150- 170.
(23) درویش، ص. 47.
(24) ملتقى المرأة والذاكرة :
Hoda Elsadda, Letters from Memory (Cairo ,1998).
(25) Human Rights Watch,”Egypt” in Human Rights Watch Report 2000 (New York: Human Right Watch, 1999), p. 347.
(26) فردوس بهنسی،“هموم امرأة عاملة:حوار مع عاملة نسيج” المرأة الجديدة، العدد الثاني ( يوليو 1986) ص 34- 37.
(27) انظر الخطاب الذي كتبته عائشة عبد الهادي في كتاب إيمان محمود مصطفى، امبراطورية النساء العاملات (القاهرة: الزهراء للإعلام العربي 1990)، ص 116- 123.
على ورقة مرفت حاتم
تعقيب
على ورقة مرفت حاتم
عماد أبو غازي
استمتعت جدًا بورقة د. ميرفت حاتم وأتفق تمامًا معها في تأكيدها على حقيقة التحولات الإيجابية في وضع المرأة وحقوقها ومكتسباتها في الخمسينيات والستينيات فيما يتعلق بحقوق الترشيح والانتخاب وتوليها مناصب سياسية، كما اتفق معها في أن تلك الحقوق والمكتسبات كان لها ثمن باهظ فيما يتعلق بحرية حركتها وتنظيمها المستقل.
هذه حقيقة أوافق عليها تمامًا لكن لدى بعض الملاحظات الأساسية على المقاربة التي دخلت بها د. ميرفت حاتم إلى هذه القضية، حقوق المرأة السياسية مقابل حركتها المستقلة.
1. النقطة الأولى:هل كان الأمر يتعلق بالحركة النسائية أم أنه ثمن دفعه المجتمع كله بعد انقلاب يوليو؟
يبدو الأمر في الطرح المقدم كما لو كان الأمر يتعلق بالمرأة وحرياتها في التنظيم المستقل, لكن واقع الحال، في تصوري، أنه كان هناك نظام يصادر المجتمع كله لصالح بناء دولة شمولية، دولة تستبعد الأجندة المستقلة للمرأة بنفس القدر الذي تستبعد به الأجندة المستقلة للطبقة العاملة وللمثقفين ولكل القوى السياسية في المجتمع، فالأمر لم يكن مصادرة للأجندة المستقلة للمرأة؛ إنما كان مصادرة الحريات السياسية للمصريين، مصادرة الديمقراطية التي دفع المصريون ثمنًا لها كفاح استمر قرابة قرن ونصف، فجاء نظام يوليو العسكري ليعصف بكل هذا، والثمن الذي دفعته المرأة هو جزء من ثمن دفعه المجتمع ككل في مرحلة الخمسينيات والستينيات، وكان من الطبيعي أن هذه الدولة الشمولية تحاول أن تقدم أو تتبنى بعض المطالب التي طالبت بها الحركة النسائية قبل انقلاب يوليو والحركة العمالية والحركات الشعبية عمومًا، في محاولة لتثبيت وجودها وفي إطار مقتضيات الصراع الدولي والصراع الداخلي.
2. النقطة الثانية الواضحة في أكثر من موضع في ورقة د. ميرفت، أنها تتكلم كما لو كان الموضوع صفقة، أن الحركة النسائية أخذت حقوقًا سياسية في قانون الانتخابات مقابل تخليها عن حق التنظيم المستقل الذي انتزعته في العشرينيات من القرن الماضي، بينما في تقديري أن الموضوع فرض قوة.. دولة غاشمة تفرض وضع استبدادي بوليسي على المجتمع كله، بما فيه مصادرة استقلال الحركة النسائية، ولم يكن الموضوع محل اختيار، لم يكن مطروحًا على الحركة النسائية أن تختار بين التخلى عن استقلالها التنظيمي والحصول على حق الترشيح والانتخاب في المجالس النيابية. كان حل التنظيمات النسائية المستقلة أو إخضاعها للتنظيم الواحد للدولة أمراً مفروضًا بقوة الواقع الجديد الذي خلقه نظام الضباط الأحرار، وكان حق المرأة في الترشيح والانتخاب نتاج نضال طويل سابق، وكان لابد أن تقدم الدولة هذا التنازل حتى تستطيع أن تفرض سيطرتها على المجتمع من ناحية، وحتى تجمل صورتها في الداخل والخارج من ناحية أخرى.
3. الأمر الثالث هو الطابع الأبوى للدولة ونسوية الدولة. الطابع البطريركي للدولة والطبع الأبوى هو في كل جوانب المجتمع وليس فيما يتعلق بقضايا المرأة فقط، والذي انهار عام 1974 لم يكن نسوية الدولة فقط / الدولة لم تتراجع عن تعليم المرأة فقط ولا عن الخدمات الصحية للمرأة فقط ولا عن توظيف المرأة وعمل المرأة فقط، ولكن تراجعت عن دورها في تقديم الخدمات تدريجيًا للجميع. هو تراجع في الخدمة التعليمية، هو انخفاض ميزانية التعليم نسبيًا، انخفاض المخصص النسبي للتعليم، انخفاض مخصصات الثقافة، انخفاض الرعاية الصحية على مستوى المجتمع ككل. بالطبع المرأة تضار أكثر. بمعنى أن المرأة والفئات المهمشة تضار أكثر من تراجع الدولة عن دورها في الخدمات، لكن لم يكن الموضوع تخليًا عن نسوية الدولة على وجه التحديد، بل منطق جديد أو أسلوب جديد تتعامل به الدولة. تقدم هامشًا ضئيلاً جداً من حرية الحركة للأحزاب، تسمح بقيام مؤسسات مجتمع مدني. وفي الوقت نفسه هذا الهامش نتاج ما حدث بعد هزيمة 1967، وظهور حركة سياسية جديدة خلقت وضعًا جديدًا في المجتمع. لم يكن من الممكن أن تستمر الدولة بصورتها التي كانت موجودة في الخمسينيات والستينيات بعد هزيمتها المروعة في يونيو 67، وبالتالي كان لابد لها أمام تناسى حركات الاحتجاج الشعبية في أوساط الطلاب والعمال والمثقفين أن تقدم تنازلات في جوانب القضايا الديمقراطية والحريات،ومع هامشية هذه التنازلات إلا أنها كانت تسمح بقدر من حرية الحركة. وكما قال هاني شكر الله في تعقيبه:”لم يكن من الممكن – في السابق – أن نتكلم مثلما يحدث اليوم“. لكن في النهاية الموضوع كله مرتبط بسياسات الدولة تجاه المجتمع ككل وليس تجاه الحركة النسوية فقط.
من جانب آخر، المجتمع نفسه تحدث فيه تحولات؛ يسوده تدريجيًا خطاب دینی سلفی معادٍ للمرأة ومعادٍ لحقوقها حتى ولو ظهرت في داخل هذا الخطاب الديني محاولات لتحسين صورة هذا الخطاب تجاه المرأة أو تقدم صورة في تقديرى أنها صورة غير حقيقية ولا تعكس رؤية الخطاب الديني للمرأة ولا قضاياها. فنحن أمام مجتمع تنمو فيه أفكار وقوى معادية للمرأة ليس بفعل الدولة وحدها؛ ولكن بفعل نمو التيارات السلفية في المجتمع بشكل أساسي وسيادة أفكارها في قطاعات أوسع من المجتمع. والقضية في النهاية هي قضية صراع بين أطراف مختلفة. وهنا أيضًا لا أرى أن الدولة توقع بين الجمعيات النسائية“العلمانية” والجمعيات النسائية الإسلامية. هل توجد أجندة مشتركة قابلة للتحقق بين الجمعيات النسائية العلمانية أو المدنية والتي تتبنى قضايا المرأة وحقوقها وبين ما يمكن أن نسميه بالجمعيات النسائية الإسلامية؟ إذا كانت هناك أجندة مشتركة، فهذه الأجندة ستفرض نفسها مهما حاولت الدولة الوقيعة.
ملاحظة أخيرة صغيرة فيما يتعلق بالاتحاد النسائي المصري، أن الاتحاد لم يكن اهتمامه في بدايته في قضايا الأحوال الشخصية والتعليم فقط كما تشير الورقة المقدمة من الدكتورة ميرفت، بل كانت له مواقفه السياسية في النضال الوطني والديمقراطي في مصر، وكانت للاتحاد آراء واضحة من قضايا المفاوضات والاستقلال، كما اتخذ مواقف حازمة من الانقلابات الدستورية، ونشير هنا إلى نضال الاتحاد النسائي وموقفه في مواجهة الانقلاب الدستوري الذي قام به إسماعيل صدقى باشا سنة 1930 والذي أسهم، مع نضال باقي القوى والتيارات الليبرالية في المجتمع، في إسقاط حكومة صدقي ودستوره الاستبدادي، وكانت للاتحاد كذلك مواقفه الجذرية في القضايا العربية وعلى رأسها قضية فلسطين.
وإذا كانت الدكتورة ميرفت حاتم ترجع مطالبة السيدة هدى شعراوي رئيسة الاتحاد بحقوق الانتخاب والترشيح للمرأة إلى ما بعد توقيع معاهدة 1936، فإن حقيقة الأمر أن هذه المطالبة قد بدأت 1924 بعد عام من تأسيس الاتحاد، وليس سنة 1936، وجاءت هذه المطالبة في البيان المشترك الصادر عن اللجنة التحضيرية للسيدات الوفديات والاتحاد النسائي المصري، والذي تضمن المطالبة بتعديل قانون الانتخاب باشتراك النساء مع الرجال في حق الانتخاب، ضمن مجموعة المطالب الإصلاحية في مجالات عدة من بينها التعليم والأحوال الشخصية. وبغض النظر عن متى بدأت المطالبة بحق الانتخاب والترشيح في أجندة الاتحاد النسائي المصري، فإن الاتحاد منذ لحظة ميلاده سنة 1923 ولد في خضم صراع سیاسي من أجل الاستقلال والديمقراطية، وطبع هذا الصراع نشاط الاتحاد بطابعه.
ورغم أن الملاحظة الأخيرة لا تمس صلب المداخلة المطروحة إلا أننى حرصت على إبرازها لما استشعره من اتجاه متصاعد بين مجموعات“نسوية” وباحثات مهتمات بقضايا المرأة إلى تقزيم دور الاتحاد النسائي المصرى ودور الرائدة هدى شعراوي.
عماد أبو غازي: أستاذ وثائق ومكتبات، كلية الآداب بجامعة القاهرة والمشرف العام على المجلس الأعلى للثقافة، ومنسق اللجان الخاصة بالمجلس.
جدول أعمال للتغيير
النساء والدولة: جدول أعمال للتغيير
أميرة سنبل
يركز هذا العرض على صياغة جدول أعمال للتغيير، كما يبرز العديد من القضايا والمناقشات الخاصة بتاريخ المرأة المصرية عبر تاريخ العديد من الدول التي قامت في مصر وخاصة الدولتين العثمانية والحديثة. ومع تعاقب الدول التي تكونت في مصر وتطورها اختلفت القوانين والثقافات والمؤسسات التي هي جزء لا يتجزأ من سياق التاريخ وتطور أوجه الهيمنة. وسوف يتناول هذا العرض تطور هذه الكيانات والتعريف بالنوع الاجتماعي والقيود المتزايدة التي تعاني منها المؤسسات الخاصة بالمرأة مع زيادة مركزية الدولة. وقد اتخذت الدولة العثمانية الخطوة الأولى في هذا الصدد، وجاءت الدولة الحديثة لتبرر ذلك وتوضحه.
إن حقوق النساء اليوم تواجه تحديًا كبيرًا على مختلف المستويات. بالرغم من أن المرأة قد استعادت مكانها في كثير من الميادين مثل العمل وأنشطة السوق والقانون، إلا أن الحريات المدنية والقانونية للنساء لا تزال موضع جدل وما زالت تتعرض للهجوم من قبل المجتمعات الأبوية (البطريركية) سواء المتحررة منها أو المحافظة. أخذ هيمنة الدولة ومع والأسبقية التاريخية في الاعتبار يمكننا صياغة جدول أعمال أو آلية للعمل.
يعد القرن التاسع عشر فترة حساسة في تاريخ تطور العالم وما شهده من تحولات. ولم يشهد هذا القرن فقط ميلاد الثورة الصناعية وظهور الصراع الاجتماعي للحصول على المساواة بين الطبقات المحرومة، بل شهد أيضًا تكوين الدولة القومية وبلورتها ككيان سیاسی مهیمن انتشر في جميع العالم واستمر وجوده حتى يومنا هذا. وبينما كانت الإمبراطوريات تحارب لاستعادة مجدها القديم والطبقات الارستقراطية تكافح من أجل التمسك بما عفا عليه الدهر، أرست الدولة القومية دعائم قوتها الراسخة عن طريق الكيانات الاجتماعية والتعليم وتوجهات الهيمنة والمركزية السياسية والاقتصادية والإمبريالية والحرب. وقد أضفت الدساتير والقوانين الصبغة الشرعية على هذه الأساليب، وعلى ذلك فلا عجب أن دراسة هذه الدول وأنظمتها قد سيطرت على الإنتاج الفكري على مدى القرنين الأخيرين. فبينما اعتبر بعض المفكرين تكون الدول أحد الإنجازات البشرية العظيمة، يراها الكثيرون مرحلة من التطور الإنساني بدأت في التلاشي والانقضاء.
ومن القرن التاسع عشر أخذ الكثير من المفكرين قضية الدولة القومية أمرًا مسلمًا به فقاموا بدراسة تطورها في أوروبا ووضعوا نماذج للدولة المثالية بناء على تجارب أوروبا الغربية، حيث اتخذت الدولة القومية شكلها النهائي.
ويشير هذا العرض إلى نموذج جديد للنظام الأبوى يناسب بناء الدولة القومية وتأثير هذا النظام الجديد على المرأة المسلمة. وبما أن الدولة قد أصبحت المحرك للقوى العاملة والمشرع للقوانين والمتحكم فيها، فقد امتدت سلطتها القانونية إلى التفاعلات الاجتماعية لتصبح المحدد المباشر للعلاقات الأبوية التي تشكلها وتدعمها القوانين والإجراءات القضائية وسيطرة سلطات الدولة. ويناقض هذا النظام الأبوى الجديد للدولة النظام القديم حيث كانت التقاليد هي التي تحدد كيف ينظم كبير العائلة العلاقات بين أفرادها والمسئوليات التي يتحملها كل منهم وكذلك يحدد مدى سلطته داخل الأسرة. وقد أصبحت الدولة في العصر الحديث المشكل الحقيقي للثقافة والمشرع الأساسي للقوانين التي تنفذ مباشرة بواسطة الحكومة المركزية. وحيث إن الدول القومية والملكية التي تسيطر على العالم الإسلامي اليوم ما هي إلا انعكاسًا مباشرًا أو غير مباشر للقوى الإمبريالية الغربية، فإنها لم يعد باستطاعتها الاعتماد على شرعيتها التقليدية بسبب الهيمنة. وعلى ذلك فإن النتيجة الطبيعية هي التقليد الأعمى للغرب، فإذا لم يتم تقليد النظام الغربي بكل جوانبه الإيجابية فسوف يؤدي ذلك إلى تأكيد النظام الأبوى القديم وتقويته. ومن أجل التحديث مع الاحتفاظ بالعلاقات التقليدية لابد وأن تتمسك الدولة بنظام أخلاقي صارم قائم على مبادئ إسلامية محددة مع الأخذ من القانون الأوروبي ما يتماشى معها ويناسب هيمنة الدولة الجديدة.
وبالتالي فإن التشجيع على القيام بإصلاحات قانونية تقوم على تأسيس قواعد قانونية وقواعد معيارية ومحاكم تطبق القوانين الأوروبية وتستخدم الإجراءات القضائية الأوروبية الحديثة قد أصبح مبادرة عالمية مشتركة. وفي الوقت ذاته تم تأسيس محاكم شرعية يتم فيها تطبيق القواعد القانونية الشرعية المأخوذة من المصادر الدينية لتناول قضايا الأحوال الشخصية.
وقد تدخلت الدولة بصورة مباشرة في شئون الأسرة عن طريق اختيار المذهب الحنفي كمصدر رئيسي للقانون دون غيره من المذاهب الأخرى التي كانت تطبق في مصر قبل ذلك مثل المذهب الشافعي والمالكي، وأيضًا عن طريق اختيار القوانين وتنسيقها وتنفيذها من خلال مجموعة من القضاة الذين تم تدريبهم في مدارس خاصة للقضاة أنشأتها الدولة. وقد أوجد هذا التدخل معنى جديدًا لمفهوم الأسرة، والعلاقات الأسرية الداخلية، كما منح المجتمع الأبوى الذكوري سلطات جديدة ومزيدًا من التحكم في الزوجة والأبناء عما كان موجودًا في السابق. وقد أوجد ذلك نقاشًا حول فئات قانونية جديدة مثل الأسرة والاختلافات البيولوجية وتقسيم العمل طبقًا للنوع الاجتماعي وإمكانية وجود حوار حول بعض القضايا الإسلامية.
إن بعض القوانين الجديدة التي رأتها الدولة ضرورة لتحقيق حاجتها إلى السيطرة على مواطنيها وقوتها العاملة مثل قوانين الجنسية والتأمين الاجتماعي بما في ذلك معاشات العمال، قد ثبت أنها عقبة أمام الحراك الاجتماعي للمرأة وحقوقها القانونية وحرية حصولها على العمل والتعليم وقدرتها على الاستثمار والقيام بدور فعال في الاقتصاد القومي الجديد. وقد حدث ذلك في نفس الوقت الذي كانت الدولة تركز فيه على تعبئة رجالها في جيوشها وتنظيم القوى العاملة الصناعية والإنتاج الرأسمالي الزراعي والخدمات الحكومية وكذلك المؤسسات التعليمية والمهنية والمالية. وفي الوقت الذي بدأت فيه الدولة والاقتصاد في تعبئة النساء تحولت الفجوة بين الجنسين والتي كانت بالفعل موجودة قبل ظهور الدولة القومية إلى هوة سحيقة هي أحد معالم عملية التحديث والإصلاح.
وكجزء من عمليات الإصلاح القانوني للدولة تم تطبيق القواعد القانونية الغربية في المحاكم المصرية وخاصة تلك التي تعود إلى عصر نابليون والتي أصبحت لغة عالمية مشتركة، كما تم استخدام نفس الإجراءات القضائية المطبقة في فرنسا في المحاكم المصرية الجديدة. أما عن المحاكم الشرعية فقد تكونت لجان حكومية لوضع القوانين التي يتم تطبيقها في هذه المحاكم. وقد وقع الاختيار على المذهب الحنفى كمصدر للقوانين المطبقة فيما عرف فيما بعد بمحاكم الأحوال الشخصية. وقد تمت الاستعانة بالمذهب المالكي عند الحاجة، إلا أن قواعد المذهب الحنفي التي يتم تطبيقها في المحاكم الشرعية الجديدة تختلف عن تلك التي طبقت فيما قبل، كما أن الإجراءات القضائية المستخدمة في نظر القضايا تختلف أيضًا. فقد قامت اللجان باختيار قوانين موحدة للتطبيق في أنحاء الدولة ونتج عن ذلك ظهور مجتمع أبوى تزيد فيه سلطة الأب والزوج والعم والخال ويتلاشى فيه ما كانت تتمتع به النساء من حقوق فيما قبل.
والجدير بالذكر إنه بالرغم من أن الإجراءات القضائية كانت مطبقة في المحاكم من قبل فإنها لم توفر للمحاكم الشرعية الحديثة ما يمكن أن تستخدمه من إجراءات، كما أن قانون الأحوال الشخصية الجديد هو نتاج مشاورات اللجان التي شكلت من علماء المذهبي الحنفي والمالكي كما كان معظم أعضائها محامين تلقوا تعليمهم في الخارج. هذا بالإضافة إلى أن المستشارين الذين قاموا بالإشراف على هذه العملية كانوا من الإنجليز. ولا يزال يوصف هذا القانون بالقانون الشرعي وله حجيته الشرعية المقدسة. أن تقسيم المحاكم إلى محاكم قومية وأخرى شرعية أو محاكم الملة لغير المسلمين تفصل الأولى في القضايا المدنية والجرائم وتعنى الثانية بقضايا الأحوال الشخصية معتمدة على مصادر دينية، كانت له عواقب وخيمة على النساء يتمثل أهمها في صعوبة الطعن فيما وضع في إطار ديني مقدس يستحيل المساس به أو تحديه.
وفي عام 1938 أصدرت محكمة الاستئناف حكمًا يغير هذا الفصل: وكان نص هذا الحكم“أن المصريين تجمعهم جنسية سياسية مشتركة وكلهم رعايا لجلالة الملك، إلا أن الطائفية تختلف؛ فبينهم من هو من الأقباط الأرثوذكس أو من الأقباط الأرمن أو الأقباط اليونانيين. ولكل من هذه الطوائف تم تكوين مجلس ملِّی خاص بها طبقًا لجنسيتها الطائفية“(1).
وباختصار فإن العلاقة بين الجنسين قد وضعت تحت سيطرة الدين أي سيطرة علماء الدين؛ مما جعل من الصعب على أية سلطة أخلاقية تغييرها. وقد اختلف ذلك كثيرًا عما كان الوضع عليه فيما قبل عندما كانت القواعد الدينية التي تحكم الزواج تقتصر على بعض القضايا مثل من يحل له تزوج من ومن يحرم عليه تزوج من، وضرورة أن تنتظر الأرملة أو المطلقة لشهور عدتها الثلاثة للتمكن من الزواج مرة ثانية، وإنه لابد من وجود شهود على الزواج ولابد من إعلانه إعلانًا عامًا، وأيضًا ضرورة أن تكون العروس غير متزوجة وأن يقوم الزواج على مبدأ الإيجاب والقبول وغير ذلك من القضايا. وكما سوف أقوم بالتوضيح في الجزء الثاني من هذا العرض فإن الجوانب الأخرى التي تتعلق بالزواج كان يمكن مناقشاتها وتحديدها بناءًا على رغبة الطرفين مثلها مثل غيرها من المعاملات الأخرى مثل البيع والشراء وإقامة الأوقاف.. . إلخ. أما المحاكم الشرعية الحديثة فما هي إلا أداة تستخدمها الدولة للسيطرة عن طريق تنفيذ مجموعة من القوانين قام باختيارها وتجميعها عدد من علماء الدين قامت الدولة بتعليمهم وتوظيفهم. وتتمثل وظيفة المحاكم الشرعية الحديثة في النظر في قضايا حضانة الأطفال والإرث والأوقاف والأحوال الشخصية والتي تدخل جميعها في نطاق الدين. وتقوم محاكم الملة بنفس الوظيفة فيما يتعلق بغير المسلمين.
ومن الجدير بالذكر أن فكرة وجود قانون الأحوال الشخصية لا علاقة لها بالشريعة فما هي إلا فكرة أوروبية ظهرت في إيطاليا في القرن 13 للتفريق بين قوانين الملكية وغيرها من القوانين التي تتعلق بالعلاقات الإنسانية. فمن الطبيعي أن يجد المصلحون المصريون الذين عنوا بالقضايا الخاصة بالملكية وغيرها من أمور التجارة في القرن العشرين هذا التقسيم مقبولاً. إن قانون الأحوال الشخصية كما طبق في القرن العشرين قد أوجد نظامًا قام بتعريف أنواع العلاقات التي تميز البشر وطبيعتهم كأفراد داخل أسر.
وبالرغم مما يدعيه التيار التحرري من أن القوانين الحديثة قد أكدت على الحرية الشخصية وشجعتها، فإن ما يحدث يخالف ذلك إذا ما نظرنا إلى القنوات التي تم من خلالها فهم المجتمع وتنظيمه والتعامل معه من الناحية القانونية. إن الكفاح من أجل حرية العقيدة والخطاب والحركة هو جزء من إنجازات الثورات الأوروبية، إلا أن هذا الكفاح لم يأتِ بنتائج مثمرة في تاريخ مصر. إن تعريف قانون الأحوال الشخصية بناءًا على التوصيفات الطبيعية لكون الفرد ذكرًا أو أنثى، قاصراً أو رشيدًا وبناءً على الحاجات الاجتماعية مثل مسئولية الدولة أن تحافظ على كيان الأسرة أو الحاجة إلى وجود قاعدة أخلاقية تضفى على الأسرة القدسية وتحافظ عليها، يجعل من هذا القانون نظامًا غير عادل يخضع المرأة لسيطرة الأب والزوج والأخ والعم والخال. وقد عرفت إحدى المحاكم مصطلح الأحوال الشخصية على أنه:
كل ما يفرق بين شخص وآخر فيما يتعلق بالصفات الطبيعية أو الأسرية والتي يضع القانون، طبقًا لها المبادئ القانونية الخاصة بحياة الفرد الاجتماعية مثل كونه ذكرًا أو أنثى، زوجًا أو أرملاً، مطلقًا أو أبًا، أو ابنًا شرعيًا، أو ما إذا كان مواطنًا كامل المواطنة أو لم يصل إلى هذه المرحلة بسبب صغر السن أو السفه أو الجنون، أو ما إذا كان يتمتع بأهلية قانونية كاملة أو يخضع للوصاية لأسباب قانونية (2).
الفرق بين الجنسين قد يحدد القوانين ولكنه لا يمنح حقوق الإنسان. ويمكن وضع قوانين تحكم الملكية والتجارة بناءً على حرية الفرد وحقوقه الطبيعية، ولكن عند الحديث عن المرأة فإن الحقوق الطبيعية لا تعنى الحقوق التي يجب أن تحصل عليها كإنسان، بل الحقوق القائمة على الفروق البيولوجية. وهذه الفروق البيولوجية ترى كنقيصة تحرم المرأة من الحصول على حقوق المواطنة الكاملة مثلها مثل السفيه أو القاصر الذي يحتاج إلى“وصی“.
ولقد أصبحت مؤسسة الزواج في بؤرة اهتمام النظام الأبوى الجديد. سوف نناقش هنا العلاقة بين الدولة وتأسيس مؤسسة الزواج وسيتم تأجيل مناقشة التغيرات التي طرأت على الزواج في العصر الحديث وما قبله إلى جزء لاحق في هذا العرض. وقد عرف قانون الأحوال الشخصية المصرى الزواج على أنه“عقد بين الرجل والمرأة تكون المرأة بموجبه محللة للرجل ويتمثل الغرض منه في تكوين أسرة وإنجاب أطفال“. وفي السابق كان الزواج يعتبر مؤسسة يتم من خلالها التصديق على العلاقة بين الرجل والمرأة ووسيلة لإنجاب أطفال شرعيين، أما في العصر الحديث فقد نظر إلى الزواج على أنه وسيلة لإقامة أسرة“نووية“. وقد وضعت القوانين من قبل الدولة للحفاظ على تماسك هذه الأسرة، ولا يعني ذلك غياب الأسرة“النووية” في فترة ما قبل العصر الحديث. فعلى العكس كان هناك العديد من الأسر“النووية” التي كانت تتكون من الزوج والزوجة والأبناء الذين عادة ما كانت تربطهم بعشيرتهم روابط وثيقة حيث كانوا يعيشون جميعًا بالقرب من بعضهم البعض في نفس الحي في المدن الكبيرة أو في نفس المدينة الصغيرة أو في بيت عائلة واحد يجمعهم جميعًا.
إن تكرار حالات الطلاق والزواج للمرة الثانية ووجود الإماء كأحد معالم بيوت الأسر الثرية، يعني أيضًا أن الأسرة كانت ممتدة بصورة أكثر مما عليه الأسر“النووية” الحديثة. وبالتالي فإن مصطلح Family باللغة الإنجليزية يعني عائلة بمعناها الواسع الذي يشمل الأخوات والإخوان وأولاد الأخت وأولاد الأخ وبنات الأخت وبنات الأخ ومن تعولهم الأسرة من غير أفرادها. ولم تعتبر كلمة أسرة كوحدة اجتماعية إلا في القرن العشرين عندما أصبحت خاضعة للقانون كأسرة“نووية“، وعلى ذلك فلابد من فهم كلمة أسرة بكل ما تحمله من إيحاءات في العصر الحديث وليس بناء على ما كانت تشير إليه في الماضي.
إن وضع الأسرة في مركز نظام قانوني يعني الاعتراف بالزوج كرئيس قانوني للأسرة له سلطات على الزوجة أو الزوجات والأبناء القصر. إن تفسير هذا القانون وتبريره كان قائمًا على فكرة تقسيم العمل بناء على النوع الاجتماعي الذي يعتمد على الاختلاف البيولوجي بين الرجل والمرأة والذي أصبح مقبولاً كأساس للنظام القانوني. وقد أصبح هذا التقسيم للعمل أيضًا تيارًا اجتماعيًا سائدًا بين مفكرى مصر الحديثة، وقد تم تأكيده في الكتب الدراسية والمناهج المدرسية. أصبح هذا التيار سائدًا بشكل جعله مقبولاً كنظام وصفه الله في القرآن والأحاديث النبوية وكتابات الفقهاء، بالرغم من أن مفهوم الأسرة الذي ظهر في العصر الحديث يخالف المفهوم الصادق والحقيقي الوارد في القرآن والسنة والفقه وفي أي كتابات ظهرت قبل العصر الحديث حيث يطبق فكرة تقسيم العمل بناء على النوع الاجتماعي والذي يعتمد على الاختلاف البيولوجي بين الرجل والمرأة. مما أدى إلى إيجاد نظام أبوي ذكوري تستخدم فيه الدولة سلطتها وسطوتها للحفاظ على الأسرة التي تمثل نواة النسيج الاجتماعي. إن هذه الفلسفة التي تؤكد على الاختلاف البيولوجي قد حملت الأم مسئولية سعادة الأسرة واعتبرت الأب مصدرًا للتمويل المالي والحماية. وقد أدى هذا التقسيم داخل الأسرة إلى جعل المحاكم تحكم على المرأة بناء على مدى طاعتها لزوجها وليس كمساوية له. ويجدر بنا الإشارة هنا إلى أن تلك العلاقة بين الأزواج وتكوين الأسرة“النووية” كان يوجد فقط في قوانين الأحوال الشخصية للمستعمرات الإنجليزية والفرنسية القديمة. وعلى سبيل المثال يعرف قانون الأحوال الشخصية في الجزائر، (التي كانت سابقًا مستعمرة فرنسية) الزواج على أنه“عقد بين الرجل والمرأة طبقًا للشريعة الإسلامية من بين أهدافه تكوين أسرة تقوم على المودة والرحمة والتعاون بين الطرفين ويهتم في المقام الأول بحفظ الأنساب“. وهناك صيغ مماثلة تعرف الزواج في سوريا والعراق والأردن. وعلى العكس يعرف الزواج في الكويت على أنه“عقد بين الرجل والمرأة تكون المرأة بموجبه محللة للرجل ويتمثل الهدف منه في تحقيق التعايش والعفة والقوة الوطنية“. أما القوانين الليبية فتعرف الزواج على أنه ميثاق شرعي يقوم على المحبة والمودة والرحمة والطمأنينة يحلل العلاقة بين الرجل والمرأة اللذين لا يحرم زواجهما. ولم تكن الكويت وليبيا خاضعتين للاستعمار الإنجليزي أو الفرنسي ولم تخضعا لتأثيره، لذلك كان تعريفهما للزواج أقرب ما يكون لتعريف الإسلام للزواج.
ولقد أصبحت القوانين الأوروبية النموذج الأول الذي تمت صياغة القوانين في المستعمرات الأوروبية على شاكلته مصحوبة ببعض التوجهات الفلسفية لتنظيم العلاقات الاجتماعية والعلاقة بين الجنسين وهذا الأمر لا يثير الدهشة. وقد لجأ المصلحون المصريون إلى القانون الأوروبي بغرض الاستعارة منه كما فعلت دول أخرى في هذا العصر. وتم تطبيق مبدأ القياسية وتجميع القوانين وتنسيقها في النظام القانوني بما في ذلك المحاكم الشرعية الجديدة ونتج عن ذلك فلسفة بطريركية جديدة تناسب أوروبا في القرن التاسع عشر حازت إعجاب دعاة التحديث في مصر الذين صاغوا التوجه القانوني بتنظيم العلاقة بين الجنسين على غرار أخلاقيات الطبقة البرجوازية الأوربية التي تعتبر الأسرة“النووية” التي يحكمها الذكر أمرًا مسلمًا به. أما القانون النابليوني فقد وصف على أنه يعتمد في الأساس على فكرة حقوق وسلطة الزوج كرئيس للأسرة، ووجوب احترامه من قبل الزوجة والأبناء. ويعتبر الزوج أفضل من لديهم القدرة على إدارة ماليات الأسرة، وعلى ذلك وبصفته رئيس الأسرة تكون له حقوق تفوق تلك التي يحصل عليها الزوجة به والأبناء (3).
إن تأثير هذه السلطة الذكورية الجديدة على النساء يظهر جليًا في قوانين الوصاية فعلى سبيل المثال تحرم القوانين الجديدة المرأة من الوصاية على أبنائها وممتلكاتهم (ولاية النفس والمال)، وقد يتم اختيارها كوصية على المال من قبل الأب أو الجد(4). وأفضل مثال لذلك القضية التي رفعتها إحدى الأمهات في 1974 تطالب بعد فترة حضانتها لابنتها حتى تتزوج الابنة وهو أمر يجيزه المذهب المالكي، بينما يقضى المذهب الحنفى بأن وصاية الأب على الابنة تبدأ في الثانية عشرة. وقد دفعت المرأة في هذه القضية بأن الاقتصار على المذهب الحنفى كمصدر للقوانين أمرًا يتنافى مع الدستور لأن الدستور لم ينص على أن المذهب الحنفي هو المصدر الأوحد للقوانين الشرعية، ولكنه أشار إلى أن الشريعة هي المصدر الأساسي للقوانين في مصر (البكرى مجلد 2234)(5) ولقد رفض القاضي هذه القضية على أساس أن المشرع (واضع القانون) مكلف من قبل الدولة وله الحق في اختيار أى المذاهب يطبق. وعلى عكس ذلك ففي الفترة التي سبقت العصر الحديث كان القضاة بما في ذلك الحنفيون منهم يعطون الأم الوصاية على أبنائها اليتامى وممتلكاتهم بصرف النظر عن رأى المذهب في هذا الأمر.
إن وضع النساء تحت سلطات بطريركية أكبر قد نتج عنه تهميش المرأة والحد من حرياتها المدنية وأهليتها القانونية حيث ظهرت مواقف جديدة تحتاج إلى تشريعات جديدة. وقد مارست الدول القومية الحديثة سلطاتها على أراضيها ومواطنيها عن طريق مد نطاق سلطاتها عليهم والإشارة إليهم على أنهم مواطنيها أو تحت حمايتها. وقد تعرضت النساء لشكل جديد من السيطرة البطريركية حيث إن قوانين الجنسية تتشدد بصورة متزايدة ولعل السبب في ذلك أن الدول القومية عندما قامت بصياغة قوانين المواطنة أقرت بأن المرأة هي حاملة لجنسية الزوج أيا كانت(6). ولقد كان هذا القانون من بنود القانون المدني الفرنسي وقد قامت الدول الأوروبية بتطبيقه وتبعتها في ذلك الدولة العثمانية على يد معتنقي الفكر الإمبريالي. وقد نص هذا القانون أيضًا على أن ما ينتج عن هذا الزواج من أبناء يحملون بالتبعية جنسية الأب. وقد سلمت المحاكم المصرية بالقانون الذي يقضي بحمل المرأة لجنسية زوجها إلا في حالة اختلاف العقيدة الدينية للزوجين. وبالرغم من ذلك فقد تغيرت القوانين منذ إقرار مبدأ حمل جنسية الأم بعد كثير من المعاناة والإنكار خاصة في حالات الأبناء الذين هجرهم آباؤهم الأجانب وحرموا حقهم في ميراث الأم بمقتضى قوانين الملكية المصرية، ومع تيسير إجراءات الحصول على الجنسية لا يزال مبدأ عدم المساواة قائمًا. وبالتالي فإن قانون يوليو 2004 المعدل قد أعطى الأبناء من آباء أجانب الحق في الحصول على جنسية المرأة المصرية، إلا أن هذا القانون كان مؤقتًا وعجز عن إعطاء حق الحصول على الجنسية للزوج وحرم ما ينتج عن زواج المصرية بأجنبى من أبناء من تقلد أي وظائف حكومية بالرغم من أن هذا القانون قد أعطى حق الحصول على الجنسية وحق تقلد الوظائف الحكومية لزوجات وأبناء الرجال المصريين.
وأود أن أختم هذا الجزء بمثال آخر يوضح الخلط بين القوانين الوطنية والعلمانية وبين قوانين الشريعة والقوانين الشخصية لإيجاد نظام يتصف باتفاقه مع الشريعة إلا أنه كذلك بصورة جزئية. وهو بهذا الشكل يعمل ضد المرأة. سوف استخدم هنا قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية المصري كمثال، مبرزة المصاعب التي تواجه الأرامل من أجل الحصول على مستحقاتهن من الدولة. تعتمد قوانين الميراث على الشريعة كما بينها القرآن الكريم فتحصل الزوجة على ربع تركة الزوج المتوفى إذا لم يكن له أولاد وثمن التركة في حالة وجود أبناء، وعند تعدد الزوجات للزوج الواحد فيشتركن في ربع التركة أو ثمنها طبقًا لوجود أبناء للزوج أم لا. وتحصل الابنة على نصف ما يحصل عليه الابن وتطبق هذه النسب على كل مستويات المواريث طبقًا للنوع الاجتماعي، وتطبق هذه القوانين على المسلمين والمسيحيين على حد السواء حيث إن الكنيسة القبطية التي تتميز بالبطريركية، لا تجد غضاضة في قبول القانون الإسلامي الذي يقضي بأن للذكر مثل حظ الأنثيين بالرغم من أنها ترفض قبول أي تغيير في قوانينها بما في ذلك إعطاء الزوجة المهجورة أو التي يساء معاملتها الحق في الطلاق. إن قوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات ما هي إلا خليط من قوانين التأمين الاجتماعي الحديثة وقوانين الإرث الإسلامية. وبينما شهدت قوانين المعاشات إصلاحًا كبيرًا في صالح المرأة لأنها في الأساس كانت تعتمد على أسس شرعية إلا أنه لا يزال يكتنفها بعض أوجه النقص، وفي الوقت ذاته ولأن هذه القوانين ما هي إلا خليط من قوانين عدة، فإن تقسيم المنافع يكون مجحفًا والتنفيذ الفعلى للقانون يخالف ما ينص عليه القانون. ويرجع ذلك إلى ما يمكن أن نطلق عليه“انفصام شخصية” قوانين المواريث والتأمين الاجتماعي. فإن المستحقات المالية التي يدفع الموظف جزءًا من راتبه طوال فترة عمله للحصول عليها بعد التقاعد تعتبرها الدولة صدقة تقدمها له وهذا ما تؤكده قيمة تلك المستحقات المالية. ولعل هذا سبب القول بأن الدولة هي المستفيد الأكبر والوارث لمستحقات المعاش لموظفيها. إن النظرة الفاحصة لهذه القوانين توضح ما تمثله من مشكلة للورثة وبخاصة الإناث منهم.
وطبقًا لقوانين التأمين الاجتماعي التي تم سنها في 1975 والتي لا تزال تطبق في مصر حتى الآن مع بعض التغييرات الطفيفة، فإن من يستحقون معاش الموظف المتوفى هم“الأرملة أو الأرامل والأبناء والبنات والوالدين والأخوان والأخوات الذين ينطبق عليهم الشروط الواجبة عند وفاة الموظف“. وبينما تمنح قوانين التأمين الاجتماعي في العادة المرأة حق التمتع بحقوق التأمين الاجتماعي لزوجها وتعطى أيضًا الموظف الحق في اختيار من يستحق هذه الحقوق بعد وفاته فإن هذا المبدأ لا يطبق في مصر ولا في بعض الدول الاسلامية وما يطبق فقط هو مبدأ من يستحق أن يورث طبقًا للشريعة الإسلامية، وبالتالي فإن كل من الأزواج والوالدين والأبناء والأخوان يكون لهم الحق في الميراث، وإذا ما وصل الابن إلى سن الحادية والعشرين أو السادسة والعشرين وهو لا يزال يدرس أو يعمل يتم قطع معاشه. وهذا تطبيقًا للمبادئ الحديثة التي تعتبر سن الحادية والعشرين سن الرشد، أما في حالة الابنة أو الأخت فإن معاشها ينقطع بزواجها أي أنها تستمر في الحصول على المعاش طالما لم تتزوج وطالما لم تشغل أية وظيفة أو تتقاضي معاشًا آخر أعلى في القيمة بصرف النظر عن عمرها. إن مبدأ بقاء الفتاة تحت ولاية أسرتها وانتقالها من حماية أبيها أو أخيها وما يوفران لها من دعم مادي إلى حماية زوجها ودعمه لها ماديًا، يقع في مركز هذه السياسة ومعنى ذلك أن هناك فلسفتين متباينتين تطبقان على الذكور والإناث فيما يتعلق بقضية المعاش، الأولى تتبع القوانين الحديثة التي لها أغلبية قانونية والأخرى تتبع التقاليد الاجتماعية القائمة على المبادئ الإسلامية. وكل ذلك في صالح الحكومة لأنه بمجرد وصول الابن إلى سن الحادية والعشرين وزواج الابنة التي عادة ما يحدث قبل سن الحادية والعشرين ينتقل المعاش إلى الحكومة إذا لم يكن هناك ورثة آخرون يتم إعادة توزيع المعاش عليهم.
إن مقارنة ومعرفة مستحقات المعاش التي تقررها قوانين التأمين الاجتماعي تكشف عن وجود مشاكل أكبر. فقد اتخذ القانون خطوات إيجابية على طريق المساواة بين الذكور والإناث فيما يستحقون من معاش. إن نسبة 1: 2 التي كانت تطبق فيما قبل قد تم تغييرها وأصبحت الأرملة تحصل على نفس المقدار الذي يحصل عليه الأرمل. وبناءً على التغيير الجديد يحصل أبناء الموظف المتوفى على نصف المعاش يقسم عليهم بالتساوي وتحصل الأرملة أو الأرمل على النصف الآخر، ويحدث الشيء ذاته في حالة بقاء والدي الموظف أو الموظفة المتوفية على قيد الحياة فإنهم يحصلون على ثلث المعاش ويحصل الزوج أو الزوجة على النصف. ويظهر هنا تساؤل: أين يذهب الجزء الباقي من المعاش؟ ويظهر نفس السؤال في حالة وجود عدد عن الورثة يقسم عليهم المعاش ذهاب جزء منه لصالح الدولة، ولعل أكبر مكسب تحصل عليه الحكومة يكون عندما يتوفى أحد الموظفين تاركًا أحد والديه أو كليهما على قيد الحياة بحيث يحصل أحدهما أو كلاهما على نصف معاش الابن. ويطبق القانون عندما يكون الورثة أبناء أو بنات المتوفي ففي كل هذه الحالات تصبح الدولة أحد الورثة لمعاش المتوفى. بما أن المرأة تحرم من حقها في الحصول على المعاش عند زواجها أو تكرار زواجها فإن قوانين المعاش تصبح عقبة أمام زواج المرأة أو تكرار زواجها، كما شجعتها على قبول بعض أنواع الزيجات غير الرسمية مثل“الزواج العرفي“، كما هو شائع الآن والتي تعرض حقوقها القانونية للخطر حتى لا تحرم المعاش الضئيل التي تحصل عليه من الدولة. وإذا ما أخذنا في الاعتبار الفقر الذي يعاني منه غالبية سكان مصر وضآلة قيمة المعاشات والتي لا تكفي لسد الاحتياجات الأساسية للحياة قبل تقسيمها، فإن فكرة كون الحكومة الوارث الرئيسي لأموال المعاشات التي يدفعها الموظف طيلة حياته العملية تبدو مثيرة للضحك.
أود أن أضيف أن القانون ينص على أنه عندما يتم قطع معاش أحد الأبناء يتم إعادة توزيع المعاش على الأبناء الباقين أو الأرمل أو الأرملة ولكن هذا لا يحدث، فبدلاً من ذلك تم نشر قائمة مفصلة تحدد القيم المستحقة في مواقف مختلفة. وطبقًا للقيم المنصوص عليها في قانون عام 1975 تحصل الأرملة على 3000 جنيه مصرى،أما في حالة وجود ابن فإنها تحصل على 2000 جنيه مصرى ويحصل هو على 2000 جنيه مصرى أيضًا. أما في حالة وجود أكثر من ابن فإنهم يحصلون على 3500 جنيه مصرى وتحصل هي على 2000 جنيه مصرى ومن العجيب أن الابن الذي يكون وارثًا وحيدًا يحصل على 2000 جنيه مصرى. إن هذه القيم الافتراضية التي نصت عليها القائمة المنشورة لا تزال مجحفة طالما لا تطبق الأنصبة التي نص عليها القانون ولا تعترف بمبدأ ضرورة إعادة توزيع المعاش عند قطعه عن أحد الورثة. وأحد الملاحظات الأخرى المثيرة التي تبرزها قراءة نشرة قيم المعاشات هي ما يقع على الزوجة من ضرر نتيجة لتعدد الزوجات، فبينما لا يشارك الأرمل أحدًا فيما يحصل عليه من معاش عادة ما تشارك الأرملة أخريات فيما تحصل عليه من معاش. وقد حاول القانون أخذ ذلك في الاعتبار بتخصيص قيم أكبر للأرامل في حالات تعدد الزوجات إلا أن مبدأ عدم المساواة لا يزال قائمًا. فطبقًا لنشرة قيم المعاشات تتلقى الأرملة 3000 جنيه مصرى، بينما تتلقى الأرملتان 5000 جنيه مصرى. ويعني ذلك إنه كلما زاد عدد الزوجات للرجل قل مقدار ما يحصلن عليه من معاش بعد وفاته. وبما أن القانون المصري يجيز تعدد الزوجات طبقًا للشريعة الإسلامية، وبما أن القانون يرفض الاعتراف بما يمثله تعدد الزوجات من ضرر على المرأة فلابد من أخذ قضية المعاش في الاعتبار، خاصة وأن كثيرًا من الأرامل كبار السن يعشن في فقر مدقع حيث لا يكفي ما يحصلن عليه من معاش لسد احتياجات الحياة الأساسية. فما بالك عندما يطلق الزوج زوجته بعد زواج دام لأكثر من عشرين أو ثلاثين عامًا ليتزوج بأخرى أصغر سنًا، فإن الزوجة الأولى تفقد كل شيء وتحصل الأخرى على المعاش كاملاً وعلى ذلك فلابد من وضع نظاماً يضمن للزوجة الحصول على معاش زوجها بعد أن تقضى معه عددًا محددًا من السنوات، ويمكن أن يطبق ذلك على الزوج أيضًا. أما في حالة تعدد الزوجات فيجب أن يلزم الزوج بدفع قيمة إضافية لزوجته لتعويضها عن أي ضرر قد يسببه اتخاذه لزوجة أخرى عليها أو على أولادها.
إن مقارنة عقود الزواج التي تتم في العصر الحديث بتلك التي كانت تتم من قبل تظهر أن قوانين الزواج والطلاق في مصر في الفترة التي سبقت العصر الحديث كانت أكثر مرونة، وتلك المرونة كانت تعطى المرأة حرية أكثر في التحكم في حياتها وتقرير مصيرها. إن العلاقة بين وكالة المرأة وسيطرة الدولة على القوانين تظهر عند مقارنة عقود الزواج التي تمت في فترة ما قبل الدولة العثمانية وتلك التي تمت في أوائل الدولة العثمانية الحديثة. وبينما تحتاج الإشارة إلى عقود الزواج التي كانت تتم في مصر القديمة إلى دراسة أكثر تخصصًا وتعمقاً إلا أن النظر إلى هذه العقود قد يفيد ما أثير في هذا العرض من قضايا. إن عقود الزواج القديمة تعكس الكثير من الإرادة الشخصية، فقد منحت المرأة القدرة والحرية على اختيار نوعية العلاقة الزوجية التي ترغب فيها. ولقد قام مؤرخو تاريخ مصر القديم بتسجيل وترجمة عدد من الوثائق التاريخية ترجع إلى عصر المملكة الجديدة وتتعلق بالزواج والحياة الأسرية ونجد في هذه الوثائق الزوج يعاهد الزوجة على الإخلاص والاهتمام والمعاملة الحسنة، ويتعهد بالعناية بأولاده ودعمهم ماديًا والحفاظ على صحة زوجته وكرامتها وبألا يعاملها معاملة السيد للأمة (كابل وماركو، 1996، 180).
وقد أكدت تلك العقود القديمة أيضًا على الذمة المالية للمرأة وحقها في التصرف في ممتلكاتها وذلك للحيلولة دون استيلاء الزوج على هذه الممتلكات تحت أي ظرف من الظروف.
ويبدو أن الزوجة وعائلتها كانت في العادة تسلم ممتلكات الزوجة إلى زوجها. وهذه الممتلكات لم تكن تعتبر مهرًا بل قرضًا يتم التصرف فيه بناء على اتفاق الطرفين عند إبرام عقد الزواج. وما يدل على ذلك ما قاله أحد الأزواج وهو ينتمى إلى المملكة الجديدة لزوجته والذي كان نصه“أقر بأني قد حصلت منك على مبلغ 3000 رخمة من الفضة على أن أعيد هذا المبلغ إليك خلال 30 يومًا من تاريخ طلبه، كما أتعهد بأن أرجع إليها مائة رخمة من الفضة تضاف إلى هذا المبلغ في حالة حدوث انفصال بيننا أثناء فترة حملك من كنفقة للولادة” (ويلفرنج، 1997، 43 -44).
وعلى عكس زمن ما قبل الدول العثمانية كان التسجيل الرسمي للزواج اختياريًا في مصر القديمة والإسلامية، فلم يكن القانون يقضى بذلك إلا أن عقد الزواج كان يبرم أمام قاض“مسجل رسمى” وذلك لتسجيل أي معاملات مالية أو أي التزامات أو وعود قد يتضمنها العقد. ولم يكن تسجيل الزواج شرطًا لجعله شرعيًا. وعادة ما كانت هذه العقود تفصل كثيرًا من الجوانب المتعلقة بالزواج مثل قيمة المهر الذي يدفعه الزوج لعروسه وممتلكات الزوجة عند الزواج ومختلف الالتزامات التي يتعهد بها الزوج بما في ذلك الملبس وما يتعلق بما قد ينجبون من أطفال أو بأي من أفراد أسرتها. وكان الطلاق وكيفية تسويته وأسبابه من الأمور التي تناولتها عقود الزواج في مصر القديمة مثلها في ذلك مثل عصر ما بعد الإسلام. ولم يظهر الاختلاف إلا في العصر الحديث حيث اقتصرت الإشارة إلى الطلاق في عقود الزواج على ذكر قيمة المؤخر الذي تحصل عليه الزوجة عند الطلاق أو عند وفاة زوجها. وقد كانت الإشارة إلى الطلاق وأسبابه وكيفية تسويته أمرًا عاديًا في عقود الزواج حتى زمن الإصلاحات الحديثة وخضوع قوانين الزواج للمعيارية. ومن الجدير بالذكر أن هذه التغيرات لم تطرأ فقط على عقود الزواج الخاصة بالمسلمين ولكن على تلك الخاصة بغير المسلمين أيضًا. وبالتالي فقد كان الأقباط الذي تحرم عقائدهم المسيحية الطلاق يبرمون عقود زواجهم أمام المحاكم الشرعية في مصر في فترة ما قبل العصر الحديث وفي الدول الإسلامية الأخرى، كما كان يتم طلاقهم أمام قضاة المحاكم الشرعية. ولم تكن فكرة استمرارية الزواج أو الحفاظ على وحدة العائلة في بؤرة اهتمام الحياة الاجتماعية أو التوجهات الاجتماعية قبل العصر الحديث بالرغم من المحبة الشديدة للأولاد والرفض التام لفكرة الطلاق كما تقتضيه السنة.
ومع ظهور الإسلام أصبحت عقود الزواج أكثر تجانسًا حيث إنها تضمنت“المتطلبات
الإسلامية للزواج” التي استمر بعضها بينما تعرض البعض الآخر للتحول والتغير بفعل الوقت. وبالرغم من أن عقود الزواج التي أبرمت في أوائل القرون التي أعقبت دخول الإسلام إلى مصر لم يتم بعد دراستها بالصورة الكافية، وفر مؤرخو هذه الفترة لنا عددًا لا بأس به من هذه العقود. وقد يتعجب الكثيرون من فيض المعلومات التي قد تحصل عليها من دراسة هذه الفترة الحساسة من تاريخ مصر وخاصة فيما يتعلق بتكون فكرة القانون والتفرقة بين الجنسين وعملية تأسيس الهيمنة الدينية والعلاقة بين عملية الهيمنة الدينية والتغير الاجتماعي. وقد تم تسجيل عقود الزواج التي أبرمت في أوائل العصر الإسلامي على ورق البردى أو الجلود أو قطع القماش مثلها في ذلك مثل تلك التي أبرمت في مصر القديمة. وقد كان الوسط الذي يتم تسجيل عقد الزواج عليه يختلف باختلاف الطبقات، فعلى سبيل المثال كانت الطبقات الثرية تفضل استخدام المنسوجات غالية الثمن.
وتوضح عقود الزواج التي أبرمت في القرن الثالث الهجري والتاسع الميلادي أن الزوجة كان لها الحق في تحديد نوعية العلاقة بينها وبين زوجها بما في ذلك ما يقوم به الزوج من أفعال في إطار الزواج. فقد كان شائعًا أن تشترط المرأة على زوجها في عقد الزواج حسن المعاملة كما تقضي السنة وإلا أصبح زواجهما لاغيًا بغياب هذا الشرط، وهذا ما يعرف بمبدأ الإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان كما تقضى الشريعة الإسلامية. وبالرغم من أن حسن المعاملة لا يزال شرطًا أساسيًا لاستمرار الزواج لم يرد ذكره في عقود الزواج التي أبرمت أثناء الدولة العثمانية، ولم توجد أية إشارة إليه في صيغة وثيقة الزواج التي وجدت في العصر الحديث. وبالإضافة إلى ذلك أصبح معنى الإحسان أمرًا يقرره القانون ولم يعد يخضع لتقدير الزوجة لما قد يجعل زواجها غير صالح أو (للعرف). فقد تم التركيز فقط على أحد المعاني التي تحملها كلمة الإحسان وهو (الضرر) فقد تضمنت قوانين الأحوال الشخصية قائمة مفصلة للأسباب التي تعطى المرأة حق رفع قضية تطلب فيها الطلاق وكذا حقها في الحصول على“التطليق“، ومن هذه الأسباب فقدان الرجل لقدرته الجنسية أو عجزه عن الصرف على الأسرة أو تعرضه لزوجته بالضرب الذي يسبب لها أذى جسديًا مثل كسر أحد أطرافها. وعندما حاولت بعض الناشطات من النساء في السبعينيات تضمين أسباب أخرى إلى هذه القائمة مثل اتخاذ زوجة ثانية والذي عرف بـ“قانون جيهان” ووجهن برفض من جانب المشرعين حيث دفعوا بأن اتخاذ زوجة ثانية لا يعد ضررًا حيث يقره القرآن والله سبحانه وتعالى لا يقضى فيه ضرر لعباده. وقد ضمنت هنا عقدين للزواج كتبا على ورق البردى يرجع تاريخهما إلى عامي 256 هـ و 279هـ على التوالي وقام بترجمتهما جروهمان(7)، لما يوجد فيهما من معنى حقيقي لمبدأ الضرر وقضية تعدد الزوجات. وقد استعنت بهما لتوضيح أن الزواج كان يتصل بأحد الجوانب الثقافية والسياقات الزمنية الذي كان يتم ممارسته من خلالها بدلاً من كونه مجرد صيغة تم التصديق على كل جوانبها وتقبل كما حددها القانون الحديث دون نقاش:
1 – وشرط على نفسه أمام زوجته عائشة أن يتقى الله فيها ويعاملها بالحسنى ويوفر لها حياة كريمة معه، اتباعًا لأمر الله ورسوله وأن يعاشرها بمبدأ الإمساك بمعروف أو التسريح بإحسان. وقبل الشرط بأنه في حالة التزوج بأخرى تكون عقدة النكاح لهذه الزوجة الأخرى في يد عائشة حيث يكون لها الحق في تطليق الزوجة الثانية منه حينما تشاء.. . (جروهمان 1994، 73- 73).
2 – قبل الزوج إسحق ابن سيرى شرطين هما إنه في حالة تزوجه بأخرى مسلمة أو غير مسلمة يكون مصيرها في يد زوجته الأولى هندية ابنة إسحاق بحيث يمكن أن تطلقها منه في أي وقت شاءت وعليه تنفيذ ذلك، وإنه في حالة اتخاذه لأي أمة (ما ملكت يمينه) فيحق لزوجته بيعها في أي وقت شاءت، كما لا يجوز له منعها عن أهلها أو منع أهلها عنها.. . (عبيد، 88 -90).
ومما سبق يظهر أن التفاصيل التي تضمنتها عقود الزواج التي أبرمت في أوائل العصر الإسلامي جعلت من هذه العقود وثيقة قانونية ملزمة يتوقع احترامها من قبل الطرفين. إن الشروط التي تضمنتها العقود التي أبرمت في العصر الإسلامي وما قبله، كما سوف نرى،كانت لصالح الزوجة حيث ضمنت لها الحق في حل زواجها بشكل يضمن كرامتها إذا لم يلتزم الزوج بالشروط الإسلامية للزواج والمتطلبات الأساسية التي تراها ضرورية. وبما أن الشرع قد أعطى الزوج الحق في التطليق دون نقاش فمن الطبيعي ألا يظهر الزوج الرغبة في إضافة مزيد من الشروط إلى عقد الزواج بعكس الحال بالنسبة للزوجة. وتساعدنا هذه الشروط على فهم الزواج في المجتمع الإسلامي لأنها تقوم بتعريف المقصود بكلمة“توقعات“. إن مطالبة الزوجة بحل الزواج يعرفنا بمسار الأمور كما أن المفاوضات التي تحدث بين الزوجين توضح لنا مفهوم وكالة المرأة. وسوف يتناول الجزء التالي من هذا المقال الشروط التي ضمنتها النساء في عقود الزواج أثناء الدولة العثمانية والفترة التي سبقتها.
وقد أظهرت عقود الزواج التي أبرمت في الفترة ما قبل العصر العثماني بعض المرونة مثلها مثل الفترة التي سبقت ذلك، إلا أنها حملت بعض التغيرات الواضحة. أما الدولة العثمانية فقد اشترطت تسجيل عقد الزواج بالمحكمة ربما فقط للحصول على رسوم مقابل هذا التسجيل، وربما أيضًا للسيطرة على سكان مصر، إن جهود الدولة العثمانية في مجال تحديد التخصصات القانونية وتوزيعها فيما بين محاكم مصر الست والثلاثين كجزء من التنظيمات الإدارية والقانونية التي قامت بها الدولة العثمانية طبقًا لقانون 1528 ما هي إلا محاولة لإرساء دعائم المركزية والسيطرة التي كانت من سياسات الدولة الحديثة الأولى. وبالتالي وبالرغم من أن الشروط التي تضمنتها عقود الزواج أثناء الدولة العثمانية كانت بمثابة معيار يعتمد على مكان عقد الزواج والطبقة التي يتم الزواج فيها، فإن الاختلاف بين عقود الزواج التي أبرمت في العصر الذي سبقه يظهر ما كانت تتمتع به المرأة من وكالة في العصر الذي سبق العصر العثماني. فعلى سبيل المثال ما أعطاه الزوج لزوجته من تفويض بتطليق الزوجة الثانية منه أو بيع أيٍّ ممن ملكت يمينه، كما هو موضح في وثيقتي الزواج السابق ذكرهما لم يستمر ممارسته في العصر العثماني حيث لم يرد ذكر هذا الشرط في أي من عقود الزواج التي أبرمت في هذا العصر. وبالرغم من ذلك احتفظت المرأة بحقها في تأسيس زواجها بالشروط التي تراها موجبة سواء عن طريق تضمينها لهذه الشروط في عقد زواجها أو عن طريق ما يتعهد به الزوج من شروط في العقد وهو ما يعرف (بالشرط المعلق). وكما ذكر سابقًا لم يسمح القانون في العصر الحديث بتضمين مثل هذه الشروط في العقد طبقًا لقوانين الأحوال الشخصية. ويمكن أن نذكر هنا بعض الشروط الخاصة التي يمكن المطالبة بها من قبل الزوجين في بعض الحالات المحددة وشروطًا عامة أخرى قد ترغب الزوجات في المطالبة بها. ومن الشروط الخاصة ما يتعلق بتجهيز شقة الزوجية وما إذا كانت الزوجة ترغب في العيش بالقرب من أسرتها أو بعيدًا عنهم حسب رغبة زوجها، وما إذا كانت توافق على العيش مع أسرة الزوج أم لا، وكذلك ما يتعلق بكسوة في الزوجة التي يوفرها لها الزوج. وقد ذكرت بعض العقود هذه الشروط بصورة عامة بينما حملت عقودًا أخرى تفاصيل أكثر تتعلق بالمتعلقات ونوعيتها (دشنا، اشهادات، 1273 {1827}, 1: 1- 9) أو بالخدم الذين يتوقع وجودهم في المنزل أو العبيد أو المجوهرات (الإسكندرية، أشهادات، 1273 {1857}, 1: 10- 68، 70، 11 – 81). ونجد في أحد العقود إحدى العاهرات تعلن توبتها، وتطالب بألا يستخدم زوجها ما عرفه عن ماضيها ضدها في المستقبل (مصر القديمة، 1079 {1669}، 103:95- 221)
وتظهر عقود الزواج أن مشكلة تعدد الزوجات كانت تسبب قلقًا كبيرًا للنساء، بالرغم مما أقرته الشريعة فيما يتعلق بعدد الزوجات اللاتي يمكن أن يتخذهن الرجل. استمرت المحاكم في وضع الشروط التي تحد من هذا الحق واعتبرت الرجل الذي لا يلتزم بتلك الشروط خارقًا للعقد. وسواء إن كانت هذه الشروط قد ضمنتها الزوجة بنفسها أو منحها إياها زوجها كتفويض لها فيما يتعلق بسلطته الزوجية، فإنه أمر غير ذي أهمية بالرغم من إنه كان موضوعًا للجدل في كثير من الجلسات التي عرضت نتائجها هنا. فمن المهم قراءة السجلات كنتاج ثقافة حية وليست كمجرد نصوص. إن الوثائق التي هي نتاج لعمليات المفاوضة التي تتضمن عددًا من الأفراد والتي هي طبيعة كل ما يبرم من عقود تدفعنا إلى النظر إلى ما وراء الكلمات، أي إلى الديناميكيات الاجتماعية والمفاوضات التي حدثت من أجل إنتاج مثل تلك الوثائق. فمن الواضح أن الزوجة ما كانت لتوافق على أي عقد زواج لا توافقها شروطه ولا أحد يمكن أن يتخيل تنازل الزوج بسهولة عن زوجته الثانية أو ما ملكت يمينه من أجل خاطر زوجته بسبب طيبة قلبه. فمن المهم أن نطلع على عدد من العقود وسجلات المحاكم وغيرها والتي هي نتاج للديناميكيات الاجتماعية لأشخاص يتمتعون بالحياة لهم رغبات ولديهم الاستعداد للتفاوض والوصول إلى حلول وسط. ويؤكد ذلك حاجة الزوج لتضمين بعض الشروط في عقد الزواج مثل تلك التي تتعلق بالمهر الذي قد يدفع على أقساط، الأمر الذي يعكس عجز الزوج عن دفع قيمة المهر بأكمله أو ما يتعلق بعجز الزوج عن دفع مهر على الإطلاق. وفي هذه الحالة لابد أن تتنازل الزوجة عن هذا الحق حتى يصبح الزواج قانونيًا حيث إن هذا الشرط هو مقتضيات الشريعة الإسلامية ليصبح الزواج قانونيًا. وقد يتضمن العقد أيضًا طلب الزوج بأن تسافر معه زوجته أو أن تعيش معه بعيدًا عن أسرتها على مسافة أبعد من مسافة القصر، ولابد أيضًا أن توافق الزوجة على ذلك كأحد حقوقها القانونية. ومن عقود الزواج التي تتضمن خداعًا كبيرًا تلك التي يضع فيها الزوج شروطًا تشبه تلك الشائعة فی زواج المتعة الذي يقره الشيعة، حيث يضمن الزوج في هذا العقد نيته بالسفر وترك زوجته بعد فترة زواج محددة مع التعهد بدفع بعض التسويات المالية إليها في حالة عدم عودته خلال فترة محددة. وقد شاع هذا النوع من الزواج بين المغاربة في الإسكندرية في العصر العثماني. ولعل السبب في ذلك يرجع إلى وجود عدد من التجار الرحالة غير المقيمين فيما بينهم. وبالإضافة إلى ذلك تظهر العقود التي يحفظها الأرشيف أنها كانت تتضمن شروطًا خاصة بالعقد مثل التزام الزوج ببعض المسئوليات التي لا يتوقع منه تحملها مثل تعهده بالصرف على أولاد زوجته من زواج قبله(8). وفي بعض الحالات تكون شروط العقد مشروطة بعمل ما وتكون نص الكلمات المستخدمة في هذه الحالة“ألقى” على نفسه وهذا ما توضحه العقود التي استشهد بها والتي ترجع إلى فترة العصر الإسلامي الأول. أن كلمة“تعليق” تشير إلى عمل يقوم به الزوج يستتبعه حدوث عواقب محدد سلفًا ولا تخلق موقفًا تفوض المرأة بوقوعه الحق في التصرف. ويجدر بنا الإشارة هنا إلى مثال جيد يمكن أن نضعه موضع المقارنة وهو تعهد الزوج بأنه في حالة اتخاذه لمرأة أخرى سواء زوجة أو (جارية) تطلق زوجته الأولى منه آليًا وتحصل على كل مستحقاتها المالية (المهر)(9). ولابد أن نشير إلى أن الشروط التي تضمنتها العقود التي استشهدنا بها كأمثلة هي نتاج للتفاوض بين طرفي العقد، وربما تعكس رغبة الزوجة في عدم اللجوء للقضاء للحصول على الطلاق أو الكفاح من أجل الحصول على مستحقاتها المالية في حالة إنكار زوجها عليها هذا الحق عندما تطلب الطلاق في حالة اتخاذ زوجها لزوجة ثانية. ولابد من التفريق بين شرط العقد والشرط المعلق اللذين تضمنتهما العقود وما يعرف“بالطلاق المعلق” حيث يتعهد الزوج بتطليق زوجته في حالة حدوث موقف ما. وتعطى سجلات المحاكم المصرية سواء في العصر الحديث أو ما سبقه أمثلة كثيرة عن هذه الأنواع حالات الطلاق، فبينما كان يتم تسجيل شروط العقد في عقد الزواج يحدث الطلاق المعلق أثناء الزواج ويتم التعامل معه بشكل مختلف. فبينما كان الطلاق يقع عند إعلان الزوج لذلك قبل الإصلاحات التي حدثت في القوانين(10)، وفرت القوانين التي تم سنها في العصر الحديث ثغرة يمكن من خلالها أن يتراجع الزوج فيما لفظ به من يمين طلاق على أساس التلفظ به في حالة الغضب الشديد أو السكر. وفي القضية الأخيرة التي وقعت في العصر الحديث طبق المذهب الحنفى وأرغمت الزوجة أن تبقى زوجة لزوجها على غير رغبتها وهذا على عكس ما كان يحدث في فترة ما قبل العصر الحديث حيث كان ساد تطبيق المذهبين المالكي والشافعي في مصر.
ويمثل الخلع أو الإبراء اختلافًا بين قوانين الأحوال الشخصية قبل وبعد القرن الـ 19 حيث شهدت القوانين بعض التحديث وتظهر سجلات قضايا الطلاق التي حدثت في الفترة التي سبقت العصر الحديث أن الزوجة كانت تحصل على حكم بالطلاق لصالحها من قبل القاضي إذا ما كان الاستمرار في الزواج يشكل ضررًا عليها. فإذا تعرضت الزوجة لما يعتبر ضرراً طبقًا للعرف أو المذهب مثل خرق الزوج لأحد بنود عقد الزواج فإن القاضي كان يحكم بتطليقها وحصولها على كل مستحقاتها المالية من زوجها مثل المؤخر والنفقة والعدة وفي بعض الأحيان تعويضًا ماليًا(11). ولم تكن الزوجة تطالب بإعطاء أدلة على ما وقع عليها من ضرر نتيجة لأحد الأعمال التي أتي بها الزوج كما لم يكن هناك قائمة تتضمن أنواع الضرر التي يمكن أن تتعرض له الزوجة يقاس عليها ما إذا كان الضرر يوجب الطلاق أم لا، كما هو الوضع في العصر الحديث. فقد كانت الزوجة تحصل على الطلاق بسبب تكرار سفر زوجها وخوفها على نفسها من الفتنة وارتكاب الزنا. أسنا، 1193 [1777]30:11 -43، منفلوط 1080 – 1810 – قضية 126). وإذا كان الضرر يتمثل في عدم وفاء الزوج بالتزاماته المالية كان القاضي يسمح للزوجة باقتراض الأموال بضمان ممتلكات زوجها للصرف على نفسها وأولادها وللحصول على مؤخر صداقها. وإذا لم يكن هناك أي ضرر واقع على الزوجة إلا أنها ترغب في الطلاق كانت الزوجة تلجأ إلى الخلع وعادة ما كان القاضي يمنحها هذا الحق(12). وفي العصر العثماني كان الخلع شكلاً من أشكال الطلاق الذي لا يتضمن ضررًا تطالب به الزوجة إما بالتوصل إلى اتفاق مشترك على الانفصال مع الزوج يتم توثيقه في المحكمة أو بالتوجه إلى القاضي رأسًا لطلب الخلع. ولأن الخلع لا يكون بسبب ضرر وقع على الزوجة فإنها تتنازل عن كل مستحقاتها المالية للزوج (المؤخر والنفقة). وفي قضايا الخلع تطلب الزوجة من القاضي الإبراء الذي بموجبه يُحل الزواج ويعود الطرفين للوضع المالي الذي كان عليه كل منهما قبل الزواج. وقد تدفع الزوجة تعويضًا ماليًا للزوج، ولا يتضمن الإبراء التنازل عن النفقة التي يجب أن يدفعها الزوج لأولاده لأن ذلك لا يعد من حقوق الزوجة التي يمكن أن تتنازل عنها مقابل الطلاق (مصر، إعلامات، 1266 [1850]، 23 :456- 162). وفي العصر الحديث تغيرت إمكانية طلب المرأة للطلاق بموجب الإصلاحات التي طرأت على القوانين وأصبح حصولها على الخلع أو الإبراء مشروطًا بموافقة الزوج وذلك حتى التعديلات التي حدثت في القوانين في الآونة الأخيرة، فقد كان الخلع يعرف على أنه اتفاق بين الزوج والزوجة على الطلاق وبالتالي كان لا يمكن أن تحصل المرأة على الطلاق بدون موافقة الزوج (الإسكندرية، 1338 [1891]، 19:24- 90). فبينما كان للزوج الحق في التطليق بنفسه أو باللجوء إلى المحكمة أنكر على المرأة حقها في طلب الطلاق إلا بموافقة الزوج وذلك طبقًا لقوانين الأحوال الشخصية الحديثة. وبالإضافة إلى ذلك كانت قوانين الخلع حتى الآونة الأخيرة تضمن نفقات حضانة الأطفال فيما بين الحقوق المالية التي لا يجب أن تتنازل عنها المرأة للحصول على الطلاق. ومعنى ذلك أن القوانين الحديثة قد أنكرت على الطفل حقه في نفقات الحضانة واعتبرتها كما لو كانت تدفع للزوجة.
وكما أوضحت هناك الكثير من الاختلافات بين عقود الزواج التي تمت في العصر الحديث وفي العصر الذي سبقه بالإضافة إلى القوانين وإجراءات التقاضي المطبقة في المحاكم. إلا أنني أود أن أشير إلى أن الدولة القومية قد أخذت من هذه العقود وسيلة للسيطرة على مواطنيها وتحقيق مصالح الدولة. وبينما كانت المعلومات التي توجد في عقود الزواج التي تمت في العصر الحديث وفي العصر الذي سبقه متشابهة إلى حد كبير فكلاهما تتضمن اسم الأب والعنوان ومهنة الزوج والزوجة إذا وجدت وتفاصيل المهر إلا في حالة عدم ذكره كما كان الحال في بعض مدن مصر الجنوبية هذا بالإضافة إلى اسم القاضي الذي أبرم العقد، كان هناك بعض الاختلافات الجوهرية. فعقود الزواج الحديثة تأخذ شكل الاستمارة مع وجود فراغات تملأ بالمعلومات المطلوبة. وقد طرأت تغييرات على هذا الشكل بمرور الوقت حتى تم التوصل في أواخر القرن التاسع عشر إلى الشكل النهائي لهذا العقد، وتتضمن العقود الحديثة التاريخين الهجري والميلادي، هذا بالإضافة إلى صورة شخصية للزوجين وشهادة صحية(13). إذا كان أحد الزوجين أجنبي وأيضًا شهادة تقر ببلوغ الزوجين السن القانونية للزواج والتي يقرها قانون الأحوال الشخصية (16 للإناث، 18 للذكور). وتتضمن عقود الزواج الحديثة بالإضافة إلى ذلك اسم الأم وتاريخ ومكان ميلاد العريس والعروس ورقم البطاقة الشخصية وتاريخ وجهة صدورها وكذلك أية معلومات تتعلق بحصول الزوجة على معاش عن أبيها أو أي من أفراد أسرتها. وتستخدم هذه المعلومات للتحكم في المواطنين فبما أن المرأة تحرم من أي معاش تحصل عليه بزواجها طبقًا لقوانين المعاش فإن عقود الزواج ما هي إلا وسيلة للسيطرة على الأمور المالية.
في هذا العرض الذي تناول العلاقة بين بناء الدولة وحقوق المرأة والذي ركزت فيه على القانون والأسرة، قدمت قضية أساسية يمكن تلخيصها كما يلي:
إن الإصلاحات التي طرأت على القوانين في القرنين التاسع عشر والعشرين لم تحدث بالضرورة تغييرًا في وضع المرأة. إن قوانين الأحوال الشخصية المعاصرة في مصر بالرغم من أنها قائمة في الأساس على الشريعة الإسلامية، تختلف اختلافًا كبيرًا عن القوانين التي تحكم العلاقة بين الجنسين – والتي أيضًا تعتمد على الشريعة – التي كانت مطبقة في المحاكم فيما قبل الثمانينيات من القرن التاسع عشر. وبمعنى آخر، بالرغم من أن القاعدة القانونية للقوانين التي تنظم العلاقة بين الجنسين هي الشريعة، فإن تطبيقها في الفترة التي أعقبت الإصلاحات القانونية يختلف عن تطبيقها فيما قبل ذلك. إن الدول القومية الحديثة بطبيعتها تشكل إطارًا حاويًا للثقافة وذلك عن طريق المركزية والمعيارية والتوجه نحو التحديث والتي تشكل جميعها توجهًا يتشابك مع نظريات تقسيم العمل طبقًا للنوع الاجتماعي والذي يعتمد على الاختلاف البيولوجي كسبب لتهميش المرأة والنظر إليها باعتبارها غير قادرة على إعالة نفسها. ومن سوء الحظ لم يناقش أي شخص غير رائدات الحركات النسائية والمفكرين قضية كون قوانين الأحوال الشخصية المعاصرة في مصر قائمة على الشريعة وكونها ثابتة لا تتغير، وهنا تظهر المحنة التي تواجه قضية مساواة المرأة. إن إعطاء القوانين صبغة القدسية يجعل تغييرها أمراً شبه مستحيل. والسؤال الآن لماذا تهتم الدولة بتغيير القوانين والإجابة هي أن هذه الدولة يتحكم فيها الرجل فمن الطبيعي أن تعطى الدولة الحق للرجال في أن يشاركوها سيطرتها على نصف المجتمع الآخر الذي يتسم بالضعف ويشمل النساء والأولاد بالطبع. وتدعى الدول الإسلامية عبر العصر الحديث أنه ليس بإمكانها إحداث أي تغيير في قواعد الشريعة والقوانين التي تنظم العلاقة بين الجنسين بسبب حساسية الدين. ويرجع ذلك إلى انعدام البحث في التاريخ ورفض الماضى على أنه ملئ بالجوانب السلبية التي يستحيل أن نتعلم منها شيئًا، الأمر الذي مكن الدولة من إحداث تلك الفوضى.
وتحتم علينا الظروف الراهنة البحث في تاريخ حقوق النساء والتأكيد على الحقائق الفعلية لحياة المرأة مع فهم جيد للتوجهات الأخلاقية للفقه وتوضيحه لحقيقة حياة النساء. ولابد أن تكون المقارنة بين الحقائق التاريخية والدقائق المتعلقة بحياة النساء وما توضحه التوجهات الأخلاقية التي سادت في الماضي عن النساء موضوعًا لجهود جادة يقوم بها الباحثون والمفكرون في مصر على وجه الخصوص حيث إنها لابد أن تكون باللغة العربية. كما لابد أن ترى القوانين التي تنظم العلاقة بين الجنسين في سياقها التاريخي الذي أنتجها وذلك لتوضيح ما طرأ على القوانين من تغيير حدث متماشيًا مع ما طرأ على المجتمع من تغيير، وللتفريق بين ما هو إسلامي ودائم وما يدعى انتماءه لحجية الإسلام عن طريق التوجهات الحديثة التي تحركها أصول ثقافية اجتماعية سياسية. إن توضيح الاختلافات التي طرأت على القوانين عن طريق الإطلاع على السجلات الحقيقية والسجلات الصادقة قد يمكننا من تحدي هذا التوجه الذي ينادي باستمرارية وحجية القوانين التي تنظم قضايا الأسرة والعلاقة بين الجنسين وإنه لا يمكن المساس بها. إن هذا ليس بالمهمة السهلة ولكنها إذا نجحت فسوف تمكننا من إحداث الضغط المطلوب لإحداث التغيير الذي قد ينبع من التقاليد الثقافية والتاريخية لمصر. أود أن أضيف أنه لابد من النظر إلى الوثائق التاريخية في الفقه والأدب وغيرها على أنها نتاج مجتمع حي وثقافة حية وليس كنص أصم. إن قراءة النصوص التاريخية دون النظر إلى الديناميكيات الاجتماعية والصراعات والأزمات سواء كانت شخصية أو اجتماعية أو محلية والتي أنتجت هذه الوثيقة أو هذا النص، يحرمنا من التعرف على دقائق حياة المجتمع الذي أنتج تلك الوثائق. إن قراءة هذه الوثائق كنتاج لإحدى هذه الثقافات وليس كثقافة وميراث أو قطعة أثرية سيمكننا من رسم صورة حقيقية لحياة امرأة.
ولقد آثار هذا العرض عددًا من القضايا التي وضحت الغرض منه ولقد اخترت هذه القضايا لأهميتها الذاتية. وبالرغم من أن الخلع قد مكن المرأة من التخلص من أي زوج يسيء معاملتها، فلابد من إعادة النظر في قضية عقد الزواج المشروط التي أثارتها بعض الناشطات من النساء في مصر. إن تضمين بعض الشروط عند إبرام عقد الزواج هو السبيل الوحيد نحو استقرار الزواج، إلا أن عمل قائمة مطولة بالشروط كما اقترح منذ عدة سنوات قد يمثل إشكالية.
إن النظر إلى أمثلة عقود الزواج التي يرجع تاريخها إلى العصر الفرعوني يصيبنا بالدهشة ويجعلنا نتساءل لماذا لا يوجد مثل هذه العقود في الوقت الحالي مع إنها كانت تعمل لصالح المرأة لفترة طويلة!. فالهدف من شروط العقد هو تنبيه كل من الزوجين إلى ما قد يسعد الآخر ويؤدى اتفاقهما إلى الاحترام المتبادل وحرص كل منهما على عدم إيذاء الآخر والعمل على نجاح الزواج. وإذا لم يحدث اتفاق يتم تسوية ما بين الزوجين من أمور عالقة مثل تقسيم الممتلكات وكيفية رعاية الأطفال طبقًا للشروط التي يتضمنها العقد وهذا في حالة ما إذا رغب الزوجين في تضمين مثل تلك التفاصيل في العقد. ويساعد عقد الزواج المرأة على إثبات ما يمكن اعتباره ضررًا وينبه الزوج إلى ذلك قبل الشروع في الزواج. وكما هو الوضع الآن فإن للرجل الحق في حل الزواج طوع رغبته واتخاذ زوجة ثانية طوع رغبته، أما الزوجة فقد تخسر بيتها وأولادها وحقوقها المالية للتخلص من وضعها كزوجة لزوج له أكثر من زوجة بالرغم مما قد يسببه ذلك لها من ضرر نفسى وبدني (بعض الأمراض مثل الإيدز قد أثارت قلقًا كبيرًا في جميع أنحاء العالم اليوم). وإذا كان الغرض من القوانين هو حماية الضعفاء فإن قانون الأحوال الشخصية المصري يفتقد ذلك. وهذه قضية لابد من مناقشاتها ومعارضتها ومحاولة حلها.
وهناك قضية أخرى تفرض نفسها وهي الحالة المادية السيئة التي تعاني منها الأرامل بعد وفاة أزواجهن وتركهم لمصدر مالی محدود يتمثل في المعاش الذي تأخذ الدولة جزءاً كبيرًا منه بمجرد زواج الأبناء أو وصولهم للسن القانونية التي توجب قطع المعاش عنهم. أين هي تلك الحماية المزعومة عندما تحرم الأرملة من حقها في حصولها على معاش زوجها الكامل، الذي كان يقتطع جزء من راتبه الشهري للحصول عليه نتيجة لسوء تطبيق قوانين المعاشات. أما عن المعونات الاجتماعية التي تقدم إلى تلك الأرامل فإنها تضعهن في موضع الاستجداء بالرغم من أن تلك المعونات ما هي إلا حقهن. وعلى ذلك فأمام جماعات المرأة في مصر مهمة النظر في قوانين التأمين الاجتماعي والمعاشات ومحاولة تغيير طرق تطبيقها. وتحصل الحكومة في الوقت الحالي على جزء من معاش المتوفى بسبب التطبيق الجزئي لقوانين الميراث في الإسلام. ومن المفروض أن تكون قوانين التأمين الاجتماعي والمعاشات جزءًا لا يتجزأ من نظام الدولة لتحقيق الرفاهية لمواطنيها الذين يدفعون جزءاً من رواتبهم الشهرية للحصول على المستحقات التي تنص عليها القوانين. وفي جميع دول العالم لا يحق للحكومة أن تستقطع أي جزء من المعاش إلا في حالة عدم وجود وريث لهذا المعاش أو أي شخص سماه صاحب المعاش وأعطاه الحق في الحصول عليه. ويعني ذلك أن هذا النظام المزدوج الذي يطبق عندنا لابد من مناقشته ومحاولة تغييره. كما لابد من التطبيق الكامل لقوانين الإرث في الإسلام بمعنى أن يحصل كل الورثة على نصيبهم من المعاش طالما كانوا على قيد الحياة. فلابد أن ينظر إلى المعاش على أنه أحد المستحقات المالية التي يجب أن يحصل عليها من يسميهم المتوفى (المستفيد من المعاش) ويكون الزوج أو الزوجة على رأس هؤلاء. وفي كلتا الحالتين لا يمكن أن تكون الحكومة أحد المستفيدين بالمعاش إلا في حالة عدم وجود أي وريث للمتوفى. وهذا بعيد كل البعد عن الوضع القائم حيث تعيش الأرامل في فقر مدقع، بينما تحصل الحكومة عن طريق وزارة التأمينات الاجتماعية على حقهن لصرفه على أغراضها الخاصة.
وبالإضافة إلى ذلك من الضروري أن ننظر إلى الآثار المترتبة على تعدد الزوجات خاصة فيما يتعلق بالمعاش الذي تحصل عليه الزوجات، من الحتمي أيضًا العمل على سن قانون يكون للزوجة بموجبه الحق في الحصول على المعاش إذا عاشت مع زوجها عددًا محدداً من السنوات، ولا يجوز لأحد الطعن في هذا الحق إذا ما طلقها الزوج قبل وفاته. وإذا ما تزوج الزوج بأخرى تستقطع الدولة جزءًا آخر من راتبه الشهري حتى يمكن لهذه الزوجة الثانية أن تحصل على معاش بعد وفاته وألا تحرم هذا الحق؛ وقد يحد ذلك من تعدد الزوجات ويجعل الزوجة الثانية تفكر قبل الإقدام على الزواج. وحيث أن المرأة تمثل جزءًا كبيرًا من القوى العاملة في الدولة فلابد من تطبيق نفس القوانين على الأرامل من الأزواج بحيث يحصلون على معاش زوجاتهم المتوفيات حتى لو كانوا هم أنفسهم يعملون بالدولة أو يحصلون على معاش.
أميرة سنبل: أستاذة التاريخ بكلية القانون والمجتمع في جامعة جورج تاون بقطر. وعضوة مجلس أمناء مؤسسة المرأة والذاكرة.
1- المجموعة الرسمية للمحاكم الشرعية والأهلية، محكمة الاسكندرية القبطية الشرعية، 4 سبتمبر 1938، قضية رقم 25،ص 56 – 58، مجلد 9، سنة 39.
2 – المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية، 1937 (بولاق، القاهرة:المطبعة الأميرية، 1937) ص 11.
3 – بيوتايا دى لفال 132.
4 – الكتاب الذهبي، مجلد 1، ص 234.
5 – البكري الذهبي، مجلد 1،1991، 21.
6 – قضية رقم 16، 158، بتاريخ 10 مارس 1904، نشر في نشرة التشريعات والفقه المصرية، الجدول الأبجدى، 1898- 1908(الإسكندرية:جمعية الناشرين المصريين،
1909)، ص 191.
7 – توجد العقود بدار الوثائق القومية بالقاهرة، مصر.
8 – مقال عبد الرحيم عبد الرحمن،“الأسرة والقوانين المنظمة للعلاقة بين الجنسين في مصر العثمانية” في: أميرة الأزهرى سنبل، المرأة والأسرة وقوانين الطلاق في التاريخ الإسلامي، تفاصيل عن هذه العقود.
9 – سجل داشت،1006 (1597)، 45: 377.
10 – على سبيل المثال في عام 1215 هـ/ (1800م) في إحدى القضايا في دمياط، أعلن رجلا أنه قد حلف يمين طلاق (طلاق بالثلاثة) على زوجته إذا لم تطعه وترجع معه إلى البيت. وفي وقت لاحق من هذا اليوم ذهبت الزوجة إلى المحكمة وأعلنت أنها طلقت آليًا من زوجها، وقد حصلت على جميع مستحقاتها المالية بما في ذلك نفقات“تغسيلها” والتي كانت جزءًا من شروط اتفاقهما. (دمياط، اشهادات، 1215(1800)، 87: 81) قد صدقت المحكمة على الإعلان.
11 – مصر، اكلمات،1266 (1850)، 244: 23 -651، دشنا، اشهادات، 1283 (1865)، 1: 17- 3, 9 -2, 15 -3 , 16 -8 , 25 -44.
12- مصر، إعلامات، 1266 -67 (1850 -51)، 237:23 -635 منفلوط، سجلات،1228 – 29 (1812 -13) , 26: 5 – 244, 122- 651, 38: 5-136.
13 – على سبيل المثال القاهرة، الشهر العقاري، سجل مدني، الأزبكية، 1969، 22- 10- 3085.
الحركة النسائية المصرية والإصلاح السياسي
عمرو عبد الرحمن
هل من إمكانية أن تستفيد الحركة النسائية ممثلة في المنظمات النسائية الدفاعية وغيرها من اتحادات نسائية داخل الأحزاب القائمة من مناخ الانفتاح السياسي القائم بشكل يؤدى لمزيد من حرية حركتها واستقلاليتها إزاء الدولة وتطوير استراتيجيتها الذاتية أسوة ببقية المنظمات الحقوقية وغيرها من منظمات المجتمع المدني؟ للإجابة على هذا السؤال تسترشد هذه الورقة بافتراض مبدئي مفاده أن قدرة الحركة النسائية على الاستفادة القصوى من التحولات الحادثة في المجال السياسي حاليًا هي رهينة بمدى استقرار هذه الحركة على تعريف محدد لماهيتها وما يستتبع ذلك من استراتيجيات. وعند الحديث عن ماهية الحركة النسائية يبرز السؤال الخاص بأغلبية المنظمات العاملة في الحقل الحقوقي عمومًا: هل تشكل هذه المنظمات حركة اجتماعية جديدة تستهدف تعبئة أكبر قدر ممكن من المشاركة النسائية بهدف تمكين هؤلاء النساء كمواطنات في مواجهة أو من خلال كل من الدولة التنظيمات السياسية القائمة والثقافة السائدة معًا يقتضي إحداث تحولات جذرية في أنماط ممارسة السلطة في المجتمع ككل، أم أن هذه الحركة ينبغي لها أن تكون ملحقة على تصور سیاسی شامل لاتجاه وكيفية تغيير المجتمع تلعب فيه الحركة النسائية دورًا يستهدف ضمنًا مصلحة النساء؟
في هذا السياق تغامر الورقة بافتراض أن الحركة النسائية المصرية من حيث هي حركة اجتماعية متميزة تستطيع الانتفاع من إجراءات الإصلاح السياسي الجارية بالقدر الذي تتمسك فيه باستقلاليتها التنظيمية تجاه كل من مؤسسات الدولة والتنظيمات السياسية إلى جانب التركيز على قضايا النساء المتميزة حتى لو لم تتقاطع بالضرورة مع المطالب السياسية للحركات السياسية المطالبة“بالتغيير“.
يعرف نيل ستامر Niel Stammer الحركات الاجتماعية الجديدة بأنها أشكال الفعل الجماعي التي تنظم في حركتها أفراداً لا تجمعهم المصلحة المشتركة فقط، ولكن كذلك هوية ذاتية فرعية تختلف عن الهوية الكلية المطروحة في الخطاب الأيديولوجي للدولة. وتتميز هذه الحركات بالعمل عبر المؤسسات القائمة في المجتمع دونما التقيد في إطار مؤسسى دون غيره. أي أن الحركة الاجتماعية الجديدة، تهتم بالهوية والجوانب الأداتية أكثر من اهتمامها بالأيديولوجية أو التوزيع(1). السؤال المركزي ليس من يحصل على ماذا، ولكن كيف ينبغي أن يعيش البشر حياتهم. الهدف ليس الاستيلاء على السلطة ولكن تفكيكها بالأحرى وإحداث تغييرات جزئية متراكمة في آلية عملها. تتعدد الأمثلة على ذلك الطيف من الحركات مثل الحركة العمالية أو حركات السكان الأصليين. أي أن هذه الحركات يمكن مقابلتها بالأفكار الهوياتية التقليدية التي تتعامل مع السياقات الاجتماعية المختلفة على أنها كل مجرد وتركز في آلية عملها على النسبية الثقافية، كما أنها من الممكن أن تقابل بالحركات الأيديولوجية التقليدية التي ترتكز في عملها على أشكال مؤسساتية صارمة تعبر عن كليات لا تاريخية مثل الأمة أو الطبقة(2). تتقاطع الحركات الاجتماعية الجديدة مع هذا التصور عن المجتمع وتعيد بناءه، في حركتها اليومية على شكل سياقات مستقلة في آلية عملها تستطيع التأثير في كل منها على حدة من خلال إحداث تعديلات جوهرية في موازين القوى السائدة داخلها.
في هذا السياق ولد الجيل الثاني من الحركات الحقوقية مع نهاية الستينيات كأحد أشكال الحركات الاجتماعية الجديدة إلى جانب حركات مناهضة التسلح أو الحركات النسوية. يتسم هذا الجيل الثاني من الحركات الحقوقية بالتركيز على حقوق المرأة، السكان الأصليون، الفئات المهمشة، حركات الحقوق المدنية.. . إلخ. فمن حيث الشق الهوياتي في التعريف، تشكلت هذه الحركات الحقوقية بغرض رد الاعتبار للهويات المطمورة تحت آلية عمل الأبنية القانونية والبيروقراطية الحداثية التي أصبحت تنحي إلى استعمار ذاتية الأفراد بما يهدد بالعصف بجوهر مفهوم الحرية. أما من حيث الشق الأداتي في التعريف، تسعى هذه الحركات إلى توسيع النشاط السياسي ليشمل جوانب أخرى غير الصراع على السلطة، ومن ثم فهي تقدم بديلاً جديدًا في كيفية ممارسة السياسة، أو بالأحرى إعادة اكتشاف السياسة في طبعتها الحداثية. مما جعل بعض المفكرين يطلق عليها اسم“الهيمنة الصاعدة“. وتسهم فعاليات الحركات الاجتماعية في بناء مفهوم الهيمنة بهذا المعنى، وفي إعادة تشكيله أيضًا؛ ذلك لأن تلك الفاعليات تعنى في جوهرها إعادة تعريف علاقات القوة كعمليات غير مؤسسية، والاتجاه نحو الانفتاح والمشاركة في صنع السياسات في مواجهة النموذج التقليدي بتراتبيته المحكمة، وقيادته الحازمة، وتسعى إلى توسيع المجال أمام المبادرات الشعبية عن طريق بناء هياكل محلية (منظمات – اتحادات – عيادات صحية… إلخ)، وتنظيم المظاهرات، والإضرابات، والمقاطعة، والاحتجاج.. . إلخ. وهذه الحركات الاجتماعية الجديدة تتميز بأنها لا تسعى لامتلاك مؤسسات السلطة، ولا تزاحم الأحزاب السياسية في مجال نشاطها، فقط هي تأمل في ترسيخ نمط فعال من المشاركة الاجتماعية، على المستويات المحلية والقومية في بلدانها، وعلى المستوى العالمي بالنسبة للحركات التي تنزع نحو هذا الاتجاه، وذلك بغرض التأثير على سلطات صنع القرار وتحقيق مكاسب جماهيرية على مستوى أو أكثر من تلك المستويات(3). بعبارة أخرى، تعيد الحركات الاجتماعية الجديدة رسم الحدود بين المجال السياسي وكافة مجالات المجتمع الأخرى وبين العام والخاص. فمن ناحية تحتفى هذه الحركات باستقلاليتها الذاتية ولا تقصر تصورها للتغيير على المجال السياسي. ومن ناحية أخرى تسعى لتسييس قضاياها النوعية من خلال ربطها بالإطار الواسع لعلاقات السلطة في المجتمع ونزع صفة“الفرعية أو الهامشية” عنها؛ أي أن الشخصي يغدو سياسيًا. والتغيير لا يبدأ من المجال السياسي وينتشر رويدًا رويدًا حتى يصل إلى العلاقات الاجتماعية الخاصة، على العكس من ذلك، يبدأ التغيير وفقًا لهذا التصور من الخاص أو الهامشي حتى يصل إلى السياسي من خلال سلسلة معقدة من العمليات.
وتبعًا لهذا الاستدلال الخاص بعلاقة السياسي بالاجتماعي تصل هالة كمال في تحليلها: للحركة النسائية المعاصرة على الصعيد العالمي إلى النتيجة التالية:
الحركة النسائية هي حركة سياسية من حيث كونها على وعي بوجود خلل في علاقات القوى بين فئات المجتمع، مع الأخذ في الاعتبار مركزية وضع النساء في إطار علاقات القوى المجتمعية، وتعمل في سبيل تغييرها وخلق التوازن المطلوب، بما يتضمنه ذلك من مواجهات مع السلطة: سياسية واجتماعية واقتصادية وفكرية.. . وباعتبارها حركة سياسية مجتمعية تقوم الحركة النسوية بتبنى قضايا النساء كنقطة انطلاق، وفي إطار تفاعلها مع العالم من منظور خبرات النساء وتجاربهن الحياتية تظل الحركة النسوية نتاجًا وتعبيرًا عن المفاهيم السياسية والاجتماعية المتباينة(4).
إن جاز لنا أن نلخص وجهة نظر هالة كمال في علاقتها بموضوع هذه الورقة فيمكن أن نفترض أن الحركة النسائية لا تنتظر الاعتراف بشرعيتها من المنظمات السياسية وأنها لا ينبغي عليها الالتحاق بأي من المنظمات السياسية القائمة لإنجاز أهدافها. على العكس من ذلك، تستطيع الحركة النسائية لعب هذا الدور دونما توسط بالأشكال السياسية السائدة في حين أنها ترتبط مع هذه الأشكال بأنماط متنوعة من العلاقات التي تخرج عن ثنائية الضم أو الصراع. وهي بهذا المعنى تسهم في عملية مقرطة المجتمع ككل، وليس المجال السياسي فقط، وخلخلة علاقات القوى السائدة وخلق مجالات ديمقراطية للفعل والحركة دون أن يتم ذلك بالضرورة في المجال السياسي.
في هذا الصدد يمكن الإشارة لتجارب متعددة من سياقات اجتماعية مختلفة نجحت فيها الحركات النسائية في الإسهام في عملية مقرطة مجتمعاتها دونما أن تلحق بالتنظيمات السياسية الساعية لذات الهدف. تستعرض ماكسين مولينو Maxine Molyneux على سبيل المثال الدور الذي لعبته الحملات المتتالية التي تبنتها المنظمات النسائية اللاتينية لمواجهة العنف ضد المرأة. تذهب في تحليلها إلى أن الحركة النسائية بتركيزها على هذه الممارسات قد أسهمت في مواجهة ثنائية العام / الخاص المركزية في عمل الديمقراطية الليبرالية. وأصرت بذلك على أن الأسرة لا ينبغي أن تبقى خارج مجال عمل مؤسسات العدالة.. . بمعنى آخر تسعى هذه الحركات إلى ممارسة المواطنة على أوسع نطاق ممكن: بين النساء وبعضهن البعض، بين النساء وأجهزة الدولة وأخيرًا في إطار المجتمع المدني. وهذه العملية كانت تقتضى بالضرورة تسييس المجال الخاص، وهو مجال ممارسة الحقوق الشخصية والمنفذ على ما يعرف بالمجال العام (5).
وعلى صعيد الممارسة فقد نظمت هذه الحملات بالكامل المنظمات النسائية غير الحكومية اللاتينية والتي نجحت في تشكيل شبكات واسعة تمتد من الخاص إلى المحلى إلى الإقليمي إلى العالمي وتضم منظمات سياسية، مثل الأحزاب وبعض ممثلي المجالس المحلية المنتخبة إلى جانب ممثلى أجهزة الدولة الرسمية، وبعض المنظمات غير السياسية بطبيعتها بل والتي تبدو للوهلة الأولى أنها تقف في الخندق المضاد مثل الكنيسة على سبيل المثال. بالإضافة إلى ذلك ضمت هذه الشبكات عددًا ضخمًا من وكالات الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية العاملة في نفس الحقل. واتخذ هذا التشبيك أشكالاً إبداعية. على سبيل المثال، أوكلت تلك المنظمات مهمة التنسيق المحلى لعمليات التدريب وغيرها من مشروعات تمكين المرأة على مستوى المقاطعات، بكل ما يعنيه ذلك من استفادة مادية نتيجة تدفق أموال الجهات المانحة، لبعض المجالس المحلية المنتخبة والتي تضم تمثيلاً سياسيًا متنوعًا، ويكون الاختيار على أساس مدى إسراع المجلس المعنى بإنفاذ التشريعات المناهضة للعنف ضد المرأة التي يتم إقرارها على المستوى الوطني. أكثر من ذلك، ضمت الجهات المنسقة في بعض المقاطعات جهات حكومية جنبًا إلى جانب مع منظمات غير حكومية ذلك مثلاً(6).
مع نهاية 1999 صدقت جميع دول أمريكا اللاتينية على الاتفاقية الدولية لمناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة CEDAW ما يقتضيه ذلك من ضرورة موائمة التشريعات المحلية لمبادئ هذا العهد الدولي، وهي عملية سياسية بامتياز ما زالت تمارسها المنظمات غير الحكومية وتحقق فيها إنجازات متتالية دونما حسم لقضية الديمقراطية ككل على الصعيد الوطني. أي أن المنظمات النسائية نجحت في خلق واقع ديمقراطي جديد يفرض تنازلات حقيقية على أبنية الدولة التشريعية والسياسية ويخلق حيزًا أوسع لحركة الأحزاب السياسية وغيرها من هياكل المشاركة التقليدية، وهي عملية أعقد بكثير من النموذج الخطى للتغيير الذي يبدأ في المجال السياسي وينتهي في المجال الخاص.
يمكن إدراج الجيل الحالي من الحركة النسائية المصرية والذي يتوزع ما بين العمل داخل عدد من المنظمات الحقوقية الدفاعية أو عدد من الأحزاب والمنظمات النسائية تحت هذا التعريف الواسع للحركة الاجتماعية الجديدة كما سبق عرضه. فتتميز الحركة النسائية عن غيرها من سائر الحركات الحقوقية المصرية في أنها تنتمى لتراث طويل من العمل النسائي المصرى. وهذا العمل النسائي الذي يمتد بجذوره إلى بدايات القرن الماضي كان قد طور عددًا من الآليات المدنية، مثل الجمعيات الأهلية العاملة في حقل قضايا المرأة، لم تعد محل نقاش داخل قطاعات النخبة المصرية. على العكس من ذلك ظلت مشروعية الجمعيات الأهلية الدفاعية في المجالات الحقوقية الأخرى هدفًا مفضلاً لسهام النقد الأيديولوجي من قبل عدد من التيارات الفكرية إلى جانب المضايقات الأمنية المختلفة التي حکمت عملها طيلة العقدين الماضيين. هذا القبول ألقى بظلاله على مواقف الناشطات النسويات تجاه العمل بالتنسيق مع الأجهزة الحكومية أو شبه الحكومية والذي لم يتسم بالحساسية الشديدة التي اتسم بها العمل بالتنسيق مع الجهات الحكومية لدى باقى المنظمات الحقوقية الأخرى. أكثر من ذلك، لم ينصب اهتمام العمل النسائي بشكل حصري على المجال السياسي وإشكالياته. على العكس من ذلك تبنت الأجيال المختلفة من الحركة النسائية المصرية مفهومًا أرحب لتنمية المرأة تجاوز المعاني السياسية الضيقة.
ميزت الملامح السابق ذكرها عمل الجيل الحالي من المنظمات الدفاعية كما أضافت تلك المنظمات إسهامها الخاص في مجال عمل الحركة النسائية المصرية. أول هذه السمات هو التمرد على الأشكال الإدماجية المختلفة التي ميزت علاقة منظمات المرأة بأجهزة الدولة، علاقة منظمات المرأة بالاتحاد العام للجمعيات الأهلية أو وزارة الشؤون الاجتماعية. فقد نحت معظم المنظمات غير الحكومية النسائية إلى العمل خارج الأطر القانونية المنظمة لعمل الجمعيات الأهلية والتي تفرض أوضاعًا من التبعية على هذه الجمعيات. ويعود هذا في جزء منه إلى الخلفيات السياسية لدى الناشطات النسائيات واللائي أتين في الغالب من خلفيات يسارية خاضت صراعًا مستمرًا مع أجهزة الدولة داخل الجامعات من أجل استقلال الحركة الطلابية وغيرها من فعاليات المجتمع المدني. هذا يقودنا إلى السمة الثانية: أن الناشطات النسائيات سعين دائمًا إلى ربط قضايا المرأة النوعية بالقضايا السياسية – وليس تسييسها بالطبع – مثل قضية الديمقراطية أو السياسات الاقتصادية والاجتماعية المتبعة. السمة الثالثة هي أنماط العلاقة الجديدة التي نسجتها هذه المنظمات مع الجهات المانحة. مصدر الجدة في هذه العلاقات يعود بالأساس إلى طبيعة مجالات التعامل التي تجاوزت حدود المجالات التنموية التقليدية التي تتبنى قضايا النوع الاجتماعي بمعناها الواسع والتي تمتد من محاربة ختان الإناث إلى دعم الناشطات في الأحزاب السياسية وليس قصرها على الاقتراب الحقوقي المحض. يضاف إلى هذه الملامح ملمح رابع وأخير وهو أن الجيل الحالي من الحركة النسائية المصرية ربما تكون الحركة الاجتماعية الوحيدة في مصر التي اصطدمت بوضوح بالمؤسسة الدينية وتفسيراتها ورموزها. تكثف هذا الصدام منذ ثمانينيات القرن الماضي مع صعود الحركات الإسلامية بما روجته من مفاهيم محافظة حول العلاقات الاجتماعية ككل وحول مكانة المرأة بشكل خاص.
نعود الآن للسؤال المحوري للورقة والخاص بكيفية استفادة الحركة النسائية المعاصرة من مناخ الانفتاح السياسي الجديد. للإجابة عن هذا السؤال ربما يكون من المفيد تناول التصور السائد لقضية الإصلاح السياسي في السياق المصرى لدى قطاعات النخبة المصرية سواء العاملة في الحقل السياسي أو الحقل المدني.
تتمثل السمة المحورية لصعود المطالبة بالإصلاح السياسي في التسييس المبالغ فيه لقضية الديمقراطية في العالم العربي وفي القلب منه مصر بالطبع. على مدار العام الماضي تم قطع جسور الاتصال بين قضية الديمقراطية وأي أبعاد ثقافية أو اجتماعية وأصبحت قضية الديمقراطية في التحليل الأخير متعلقة بمدى التغيير الحادث في رأس السلطة التنفيذية وما يقتضيه ذلك من تعديلات في الإطار الدستوري القائم وفي تقنيات المشاركة السياسية. أما إشكاليات بناء الديمقراطية من أسفل كعملية تستهدف تحقيق سيطرة الأفراد على شروط وجودهم الاجتماعي في مواجهة تجليات السلطة في المجالات المختلفة، فقد تركت لشأنها كمسؤولية معلقة تنتظر من يتصدى لها.
يأتي على قائمة العوامل التي أدت إلى بزوغ هذا التصور القديم / الجديد لقضية الديمقراطية التحول الحادث في تصور القوى الدولية الفاعلة في الإقليم بشأن قضية الديمقراطية في العالم العربي وعلاقتها بقضية المرأة. هذا التحول يمكن رصده من خلال تتبع التراجع المطرد لمكانة قضية المرأة في علاقتها بقضية الديمقراطية في العالم العربي من خلال قراءة تقرير التنمية الإنسانية العربية ومبادرة الشرق الأوسط الكبير وانتهاءًا بالضغوط عبر القنوات الدبلوماسية بشأن قضية الإصلاح السياسي. فبينما اتسمت مبادرة الشرق الأوسط الكبير بالإحالة الدائمة لتقرير التنمية الإنسانية العربية بتركيزه المفرط على ارتباط قضية الحريات السياسية بأوضاع المرأة، اتسمت الضغوط الأخيرة بالتركيز على التغيير في رأس السلطة التنفيذية بما يقتضيه ذلك من التركيز على الانتخابات وما يستدعيه من أعمال المراقبة. تراجعت قضايا المرأة إلى مستوى غير مسبوق سواء في خطاب الجهات المانحة أو على مستوى مبادرات الإصلاح السياسي. بعبارة أخرى احتلت قضية الديمقراطية في هذا الخطاب مكانة تشبه مكانتها في السياسة التقليدية السابقة على صعود الحركات الاجتماعية الجديدة. ويمثل هذا التحول خلاصة تحولات فكرية واستراتيجية متعلقة برؤية القوى المهيمنة على حركة التفاعلات في النظام العالمي، خصوصًا الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لطبيعة التركيب الاجتماعي للمنطقة العربية وعلاقته بالمصالح الاستراتيجية لهذه القوى في هذا الإقليم. فعلى المستوى الاستراتيجي حدث تحول جوهري في الفكر الاستراتيجي الأمريكي من التركيز على قضايا الحكم بمعناها الواسع إلى التركيز على قضية الإصلاح السياسي بمعناها الضيق. بقدر كبير من التبسيط يمكن الوصول إلى استنتاج مفاده أن المنطقة مازال أمامها الكثير قبل أن تنطبق عليها مقولات الحكم الصالح عن الشفافية وحكم القانون وتمكين المرأة وأنها ينبغي أولاً أن تلحق بركب العولمة بما يقتضيه ذلك من انفتاح في المجال السياسي وتغيير طريقة اختيار رؤوس السلطة التنفيذية. وعلى المستوى الفكري ركزت جهود منظري اليمين المحافظ على تبيان الأثر السلبي الذي لعبه تأييد الإدارات الأمريكية المتعاقبة لأنظمة علمانية أو شبه علمانية في نزع الاستقرار عن المنطقة. ومن باب مد الخطوط على استقامتها كانت النهاية المنطقية لهذا الاستدلال الذهني المحض هو ضرورة قبول التيارات الإسلامية كأمر واقع داخل الحياة السياسية المصرية بما يمثلونه من قيم، بكل ما يقتضيه ذلك من إعادة نظر جذرية في علاقة الإدارة الأمريكية والجهات المانحة بالنخب العلمانية في المنطقة وأجندة هذه النخب وأولوياتها وفي القلب منها قضية المرأة. فعلى سبيل المثال تكتب مارينا أوتواى Marina Ottaway الباحثة بمعهد کارنیجي لدراسات السلام:
إن افتراض الإدارة الأمريكية أن دعم المرأة العربية قد يؤدى إلى دعم الديمقراطية في المنطقة هو افتراض مضلل.. . بداية ينبغي تأسيس نظام من توازن السلطات قبل أن تستطيع مختلف القوى الاجتماعية الانتفاع من مميزاته. هذا ما حدث في الولايات المتحدة، حيث إن مطالب المرأة لم تقدم للمجتمع إلا مع بداية العشرينيات في حين أن المؤسسات الديمقراطية كانت قد تأسست قبل ذلك بكثير… المعوق الرئيسي للديمقراطية في العالم العربي هو السلطة المطلقة التي يتمتع بها الحكام في ظل غياب أي مؤسسات فاعلة تستطيع الحد منها وموازنتها. الضغط الرئيسي يجب أن يكون على الأنظمة كي تفتح مجالاتها السياسية لا أن تسمح بمشاركة أوسع للمرأة(7).
نحن أمام نص ينظر لما بات يعرف بالاستثنائية العربية بامتياز. هنا نلحظ بوضوح ما تحدثنا عنه في الفقرة السابقة عن قناعة راسخة بأن المنطقة العربية ما زالت بعيدة كل البعد عن مفاهيم الحكم بالمعنى الحديث وفي مقدمتها تمكين المرأة. على أن الأخطر من ذلك هو استعادة للمفهوم القديم للتغيير الذي يبدأ وينتهي في المجال السياسي والذي تنتشر آثاره آليًا إلى المجالات المجاورة. فمركز الضغط هنا وأداته الوحيدة هي السياسة. وعلى الرغم من اعتراف الكاتبة ببؤس أوضاع المرأة في العالم العربي إلا أنها تترك مهمة تحرر هذه المرأة أسيرة النبوءة الديمقراطية التي حلت بيقينيتها محل النبوءة الثورية القديمة التي وعدت بتحرير المرأة شريطة تأييد الفكرة الاشتراكية. إن كان من نتيجة يمكن استخلاصها من تلك الرؤية فهي أنه ينبغي علينا العودة للمربع الديمقراطي رقم واحد بكل ما يتطلبه ذلك من إعادة النظر في دور المنظمات غير الحكومية العاملة في حقل قضايا المرأة.
نحن لسنا معنيين في هذا المقام بالإجابة عن سؤال ما إذا كانت هذه التحولات تشكل تحولاً استراتيجيًا في أولوية السياسة الخارجية لتلك الكيانات أم أنها محض مناورة الهدف منها الضغط على الأنظمة القائمة ودفعها لاتخاذ إجراءات أكثر انفتاحًا في التعامل مع المعارضين. كل ما يعنينا هو تبيان الأثر المركب الذي لعبته تلك التحولات عند تبنيها محليًا. فبالموازة مع تلك التحولات في الاستراتيجيات الدولية تجاه المنطقة، أو كنتيجة لها في نظر البعض، انطلقت موجة جديدة من التحركات الاحتجاجية المطالبة بالديمقراطية و“التغيير“. انقسمت هذه الاحتجاجات ما بين احتجاجات فئوية الطابع تدمج ما بين المطالب المهنية والمطالب الديمقراطية على المستوى الوطني مثل تحركات نادي القضاة لاستصدار قانون السلطة القضائية أو تحركات عدد من نشطاء النقابات المهنية لرفع الحراسة عن نقاباتهم، وما بين“جبهات” واسعة تضم طيفًا واسعًا من النشطاء السياسيين المعارضين مثل“الحركة المصرية من أجل التغيير” والتي خرج من عبائتها عدد من التجمعات السياسية التي حاولت أن تعكس المهمة: أي الربط بين المطالب الديمقراطية العامة التي ترفعها“كفاية” والمطالب الفئوية الخاصة لأعضاء التجمع الجديد مثل“شباب من أجل التغيير” أو“صحفيون من أجل التغيير“. غنى عن الذكر أن الصنف الثاني من التجمعات قد استحوذ على النصيب الأكبر من التغطية الإعلامية والتعاطف ما بين أجنحة النخب المختلفة، بما فيها عناصر من داخل الحزب الحاكم أو أجهزة الدولة. السمة الغالبة لهذه الفعاليات الاحتجاجية هي أنها تستعيد في خطابها أو ممارستها التصورات التقليدية للعلاقة ما بين المجال السياسي والمطالب النوعية، مثل مطالب النساء أو الأقليات: جميع هذه الإشكاليات لن تحل بدون إحداث تغيير شامل في الأبنية السياسية القائمة وفي مقدمتها رأس السلطة التنفيذية. إلى أن يتحقق ذلك، على جميع النشطاء الفاعلين في هذه المجالات النوعية الانضمام إلى الجسم الرئيسي للحركة العامل في المجال السياسي ثم السعى لتسييس كافة الفعاليات المتعلقة بقضاياهم النوعية. ووفق هذا التصور، تقوم الحركات والمنظمات السابقة على تأسيس الحركة السياسية المطالبة بالتغيير من الحركة السياسية ذاتها مقام الجنين من المولود أو أنها بمثابة إرهاصات لا تتخذ شكلها النهائي إلا في هذه الحركة. وفوق كل ذلك يستحيل على الحركات العاملة في المجالات النوعية إنجاز مهمتها دونما الانتقال للنضال في ساحة العمل السياسي.
كي لا يكون الحديث مرسلاً يمكن الاستشهاد بالبيان التأسيسي للحركة المصرية من أجل التغيير الذي يحدد بوضوح أن الحركة قامت من أجل: مواجهة المخاطر والتحديات الهائلة التي تحيط بأمتنا، والمتمثلة في الغزو والاحتلال الأمريكي للعراق، والاغتصاب والعدوان الصهيوني المستمرين على الشعب الفلسطيني، ومشاريع إعادة رسم خريطة وطننا العربي، وآخرها مشروع الشرق الأوسط الكبير، الأمر الذي يهدد قوميتنا ويستهدف هويتنا مما يستتبع حشد كافة الجهود لمواجهة شاملة على كل المستويات: السياسية والثقافية والحضارية، حفاظا على الوجود العربي لمواجهة المشروع الأمريكي الصهيوني.. . الديمقراطية هي“السبيل الوحيد لمواجهة المؤامرات الإمبريالية والعدوانية الصهيونية، والانتصار على التحديات والتهديدات التي تحيط بمصر والمنطقة من كل جانب“. بما يعنى أنه لو كان ثمة سبيل آخر لأيدناه (مثلا انقلاب عسكرى وطنى!). ويعني ذلك أيضًا أن الديمقراطية لا تظهر هنا بوصفها عملية تحريرية للفرد وسبيل لتمكين الناس من السيطرة على شروط وجودهم في مواجهة المراتب البيروقراطية والأبوية التي تسعى لاستعمار ذاتيتهم، وإنما تصبح أقرب إلى واجب فرعى من واجباتهم تطرحه الظروف كأداة“لإنقاذ الوطن“.
الأمر يتجاوز مجرد اللغة المستخدمة في البيانات بل يمتد إلى إصرار ضمنى على الشطب على كل تنوع: تدور المناقشات داخل حركات الأساتذة والمهندسين والفنانين حول ما إذا كان من الواجب التركيز على المطالب الديمقراطية النوعية للجماعة النوعية أم التمسك بالشعار الواحد“ضد التمديد والتوريث“. كما تدور المناقشات حول ما إذا كان ينبغي“النزول للشارع” أم عقد مؤتمر مثلاً لبلورة مطالب لهذه الفئة أو تلك، وفي معظم الأحوال ينتهى الأمر بانتصار منطق التظاهر أو المطلب العام. وغلبة منطق التظاهر ذلك يجد تفسيره بوضوح في ترتيب أولويات الحركة السابق الذكر: إنقاذ الوطن أولاً ثم الحديث عن أي مطالب“فرعية“. والحال أن هذه التصورات الكامنة في منطق حركة“كفاية” وقادتها تتطلب تفسيراً يخرج عن نطاق هذه الورقة. على أن نقطة البداية في تفسير هذه الظاهرة يرجع إلى الخلفية السياسية لقادة هذه الحركات الوليدة. فقد قامت هذه الحركات“الديمقراطية” على أكتاف عناصر لم تكن يومًا أي ود يذكر للديمقراطية سواء في صيغتها الليبرالية التقليدية أو في تعبيراتها النقدية المعاصرة. فسواء أتى القادة من صفوف القوميين العرب أو الناصريين أو الماركسيين أو القوميين يبقى الدافع الرئيسي للتجمع هو“الإنقاذ” والدفاع عن الأمة. ولأنهم قوميون و“هوياتيون” بصفة عامة، اعتبروا أنفسهم تلقائيًا ممثلى الشعب. فالقوميون يميلون بطبيعة إيديولوجيتهم ذاتها إلى تصور“الأمة” ككيان واحد مصمت متحد، وبالتالي يناسبه تعبير واحد ما عن مصالحه المتحدة الجوهرية، التي تتمثل بالتحديد في الحفاظ على ما يسمى هويته. والهوية الواحدة تتطلب تجسيداً واحدًا وحيدًا، هو بالطبع بطل الهوية المتصدي للأعداء، بل إن هذا هو مبرر وجوده الوحيد. وهذا ما يفسر لنا أن من وقعوا البيان التأسيسي لـ“كفاية” أنفسهم لم يتورعوا عن أن يعتبروا أنفسهم، بكل“تواضع“،“رموزاً” سياسية وفكرية وثقافية ونقابية ومجتمعية بهم أكبر من مواطنين، رموز، وبالتالي فاجتماعهم في كفاية“يرمز” للوطن! وما اتفقت عليه“الرموز” هو بالطبع مشروع الوطن، من خرج عليه فقد خان. ومن هنا اعتبرت“كفاية” نفسها“حالة فريدة من الوفاق الوطني بين كافة القوى الوطنية المصرية دون تمييز أو استثناء“.. وبالتالي لا يخرج عنها سوى الخوارج عن الوطن. ولأن الهوية باطنة في الشعب، أو لنقل أنها هي“فطرته“، فإن دور البطل، أو“الرمز“، أو“وفاق القوى الوطنية“، لا يتعدى إيقاظ هذه الفطرة واستدعاءها. وبنفس منطق“إيقاظ” روح الشعب رفضت“كفاية” أي نضال من أجل الديمقراطية من خلال دخول معركة الانتخابات الرئاسية، فهو إضفاء للشرعية على النظام. ومن جماع“انتفاضة” الانتلجنسيا الوطنية أو تحولات السياسة الأمريكية والأوروبية في المنطقة تم استدعاء نموذج إدماجي للاحتجاج على ممارسات النظام القائم بنبرة قومية/ إسلامية زاعقة تواطأت – كعادتها دائمًا على طمس عملية المقرطة الحقيقية التي تجرى في مجمل التركيبة الاجتماعية وسعت لاستباقها وكبحها باسم إنقاذ الأمة من نظام مبارك هذه المرة وليس من الاستعمار الخارجي.
من المبكر جدًا رصد تأثير هذا التحول المفاجئ للمطالب الديمقراطية إلى النموذج الإدماجي على مجمل عمل الحركة النسائية المصرية. وبالتالي يمكن اعتبار ما سيلي ذكره بمثابة التنبيه لبعض المنزلقات التي ينبغي التنبه لها في الفترة المقبلة. بالإضافة إلى ذلك لا يمكن تجاهل حقيقة أن العدد الأكبر من ناشطات المنظمات النسائية الدفاعية الجديدة هن إما ناشطات سياسيات سابقات أو حاليات ينتمين في غالبيتهن إلى هذه التيارات الأيديولوجية المشكلة للحركات الصاعدة المطالبة بالتغيير. العديد من هؤلاء الناشطات سواء داخل الأحزاب السياسية أو المنظمات غير الحكومية لا يزال يتحين الفرص للعودة للمجال السياسي، وهو حق مشروع لا يمكن تجاهله مع الأخذ في الاعتبار أن المجال السياسي حاليًا يشهد انفتاحاً غير مسبوق بعد عقود طويلة حرمت خلالها أجيال من النشطاء المصريين من العمل السياسي بشكله المباشر. بعبارة أخرى جاءت العودة الثانية للسياسة الهوياتية التي تمارس من خلال مظاهرات الشوارع وليس من خلال أروقة المنظمات غير الحكومية لتشكل عاملاً لتكثيف الجدل داخل الحركة النسائية حول علاقة ما بين السياسي والمدني/ النوعي وضعت الحركة النسائية أمام مفترق طرق فيما يتعلق بتصورها لذاتها. فكيف كان رد الفعل الظاهر حتى الآن؟
على مدار الشهور الماضية تكررت الدعوة لتشكيل أشكال تنسيقية تعبر عن إسهام الحركة النسائية في“النضال الديمقراطي القائم“. فعلى سبيل المثال تبنت عدد من الناشطات النسويات الدعوة للقاء تشاوري بشأن علاقة المرأة بحركات التغيير الصاعدة في أعقاب اعتداءات يوم الاستفتاء على تعديل الدستور وهو اللقاء الذي أطلق عليه تعبير موحى“الشارع لنا“. يذكر البيان الداعي للقاء:
لن نبقى أسرى الخوف في منازلنا.. فالشارع ملك لنا مثلما هو ملك لجميع المصريين.. وقد نزلنا إلى الشارع تلميذات وطالبات وعاملات وفلاحات وربات بيوت ومهنيات وأساتذة جامعات.. نزلنا إلى الشارع تضامنا مع الانتفاضة الفلسطينية الباسلة واحتجاجًا على حرب العراق الإجرامية.. نزلنا إلى الشارع احتجاجا على تدنيس المصحف في جوانتانامو وتضامنا مع فلاحات سراندو ونساء العريش وعمال إسكو والأسبستوس.. ولن نتراجع.
رمن خلال القراءة السريعة للغة المستخدمة في الدعوة إلى هذا اللقاء وكذلك من خلال تتبع الحوار الدائر في اللقاء المذكور، وغيره من الحوارات التي دارت في صفوف التيارات السياسية الراديكالية المشكلة لقوام حركات التغيير الصاعدة، يمكن المغامرة بالقول أن هذه الدعاوى لم تزد حتى الآن عن السعى لتأسيس فرع نسائي للحركات المطالبة بالتغيير. إن التجمعات المرغوبة هي بالأحرى علامة على دخول النساء كفئة اجتماعية مميزة لحلبة الصراع الدائر بين قوى التغيير والنظام القائم أسوة بالصحفيين والعمال والشباب. وهم جميعًا في دخولهم ذاك إنما ينتقلون من آلة ساكنة غير قادرة على التغيير إلى حالة أخرى مشحونة بالفعل وتعتبر هي الوحيدة القادرة على إحداث التغيير المطلوب. وهذا المنزلق تنبهت له العديد من الناشطات على شبكة الإنترنت وهو ما يمكن تتبعه من خلال الحوارات التي دارت في عدد من المجموعات البريدية،نحن بإزاء ما يمكن أن نعتبره نموذجًا إدماجيًا معكوسًا. كما فرض نظام يوليو 1952 تصوراً لقضايا المرأة والعمال والفلاحين وغيرها بوصفها قضايا فرعية لا يمكن أن يتم تسويتها إلا بربطها بقضية كبرى محورية هي قضية القومية العربية والاشتراكية. وانعكس ذلك في أشكال التنظيم الإدماجية القائمة والتي أبت إلا إدماج حركة المرأة المصرية في أشكال كوربوراتية مثل الاتحادات النسائية أو المنظمات النسائية داخل الأحزاب؛ كذلك تحتل قضية الديمقراطية في هذا التصور ذات المكانة التي تحتلها القضية القومية عند النظام أو قضية الاشتراكية. ويشترك النشطاء في هذا التجمع مع تلك التجارب السابقة عليه في محورية السياسي وأولويته على ما عداه من قضايا بالإضافة إلى النفور التقليدي من الاستقلالية التنظيمية واعتبارها تفتيتًا للحركة. في جميع الأحوال لم تتجاوز فعاليات هذا“اللقاء” حدود“اللقاء” وما زال نشطاؤه يراوحون في المكان. فقد نظمت تلك المجموعة من الناشطات بعض الأشكال الاحتجاجية على ذات الطراز المتبع لدى حركات التغيير الصاعدة كاعتصامات نقابة الصحفيين على سبيل المثال. وهو في أفضل الأحوال قد يصلح كإطار تنسيقي للنساء المشاركات في حركة التغيير ولكن لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتباره إطارًا جديدًا لحركة نسائية صاعدة تحاول أن تنتفع من مناخ الانفتاح السياسي المتنامي في مصر. أما على مستوى التجمعات النسائية داخل الأحزاب فقد كان دورها شبه معدوم تقريبًا واقتصر في أغلب الأحوال على إصدار عدد من البيانات المتفرقة التي تعتبر في أفضل الأحوال بمثابة هوامش على رؤى ومواقف أحزابها.
أما من ناحية التجمعات التي تأسست بالفعل يأتي تجمع المنظمات النسائية من أجل التغيير وهو يضم ثلاث منظمات حقوقية نسائية. واللغة المستخدمة في البيان التأسيسي لا تخرج عن ذات الفخ الذي وقعت فيه الدعوات الأخرى لتأسيس تجمعات نسائية مطالبة بالتغيير: ساعة العمل السياسي قد حانت فلندع قضايانا التي عملنا عليها جانبًا، إلى حين، ولنبحث عن علاقة، ولو قصرية، تربط نضالنا بنضال القوى السياسية. فينص البيان التأسيسي على:
إزاء الوضع الذي يشهد تصاعداً خطيراً في الممارسات الأمنية في مصر، تمثل في:
التوحش في مواجهة المعارضة. استخدام النساء كأداة لضرب أي تحرك سواء على المستوى الفردي أو الجماعي، الأمر الذي ظهر جليًا في استخدام النساء والتحرش بهن في أحداث العريش، وسراندو، ويوم الاستفتاء الأسود، وأحداث 30 يوليو من انتهاكات لأعضاء حركة كفاية.
1. رصد وفضح وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم.
2. استخدام كافة الآليات السلمية في التصدي لمثل تلك الأعمال.
3. المشاركة السياسية للمرأة من أجل تعميق الديمقراطية وحقوق النساء.
4. التنسيق مع كافة الحركات المصرية الساعية لمستقبل أفضل لبنات وأبناء هذا الوطن.
ونحن لا نرى هذه الحركة منفصلة عن الحركات الساعية للتغيير في مصر، أو تعمل على اجتزائها، وإنما هي جزء لا يتجزأ من المطالبة بتحرير الوطن، وحقوق المواطن.
اللغة المستخدمة في هذا البيان التأسيسي تفوق لغة التيارات السياسية الأخرى راديكالية في بعض الأحيان. والمنظمات النسائية مدعوة للإسهام في التغيير بالقدر الذي تتحول فيه إلى وحدة إمداد ومساندة لعمل النشطاء في المجال السياسي: تقدم لهم المساعدة القانونية وتفضح أساليب منتهكي حقوقهم وتحث المرأة على المشاركة في هذه المعركة. ونلاحظ هنا أن هؤلاء النشطاء ليسوا مدعوين لأخذ قضايا المرأة في اعتبارهم على سبيل المثال عند التفاوض والتنسيق مع قوى المعارضة الأخرى، وهي بالأساس إسلامية. كما أن خطاب هذه القوى المطالبة بالديمقراطية يبدو وكأنه فوق النقد على الرغم من خلوه من أي إشارة تذكر لقضايا المرأة النوعية. بل إن البيان يخلوا حتى من عتاب أو دعوة من طرف خفى لا يخل بمضمون البيان لتضمين هذه القوى لمطالب النساء في خطابها. كل ذلك ليس له وجود على الرغم من أن المنظمات الموقعة هي منظمات لها تراث طويل في ترسيخ الهوية المميزة لقضايا المرأة. كل هذه المطالب تتراجع لتفسح الطريق لعمل“القوى الوطنية من بنات وأبناء هذا الوطن“.
على أن الموضوعية تقتضى الإشارة إلى أن هذا التجمع يحاول جاهدا الابتعاد عن فخ التسييس إلا أن أنشطته لا زالت حتى الآن مقصورة على العمل في إطار تجمعات المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال المراقبة الانتخابية. وهذا يعود جزئيًا إلى كون هذا التجمع هو بالأساس تجمع للمنظمات الحقوقية العاملة في حقل قضايا المرأة. وهذه المنظمات على الرغم من أوجه تميزها عن مجمل الحركة الحقوقية السابق الإشارة إليها إلا أنها في التحليل الأخير جزء من هذه الحركة وتعمل في إطار أجندتها بشكل أو بآخر. إلا أنه في هذا السياق يحسب لهذا التجمع على سبيل المثال توخي الحياد في التعامل مع قضية شبه غیاب ترشيحات المرأة عن قوائم كل من الحزب الوطنى وأحزاب المعارضة الشرعية. بالإضافة إلى ذلك يحسب لهذا التجمع حرصه على الاستقلال التنظيمي في مواجهة سعى التحالفات السياسية لإدماج كل التجمعات والأشكال الاحتجاجية في إطار واحد.
من ناحية أخرى، يلاحظ أن التجمعات النسائية البازغة المهتمة بقضية التغيير لم تسع إلى مد جسور التواصل مع“الناشطات النسائيات” داخل أروقة الدولة أو داخل الحزب الحاكم. من الواضح أن“نساء السلطة” ليس لهن مكان في نضال“نساء القوى الوطنية“, الأمر الذي يشكل إهدارًا لفرصة تاريخية في ربط أكبر عدد ممكن من عضوات الحزب الوطني الحاكم للمرة الأولى بخطاب عن الإصلاح السياسي حتى لو لم يتم تبنيه بالكامل من قبل هؤلاء الناشطات. أكثر من ذلك لم يسع أي من هذه التجمعات إلى مد جسور التعاون مع الناشطات الإسلاميات على وجه المثال. وظل الوضع لا يخلو من طرافة: تتفاوض وتنسق الحركة السياسية مطالبها مع الإخوان المسلمين دونما أي مشاركة من قبل النساء في الصباح، في حين تنتقد هذه التجمعات النسائية مواقف الحركة الإسلامية من قضية المرأة في الليل، فما الذي يمنع من أن تأخذ الحركة النسائية زمام المبادرة بشأن قضاياها وهمومها وتفتح حواراً مباشراً مع ناشطات الحركة الإسلامية دونما توسط من الممثلين السياسيين في كلا الجانبين. وهذا من شأنه أيضًا أن يجلب قطاعات واسعة من الناشطات الإسلاميات إلى ساحة الجدل بشأن دور النساء في حركات التغيير.
بعبارة أخرى، ظلت الجهود البازغة داخل الجيل الثالث من الحركة النسائية المصرية مشغولة بحوارها الداخلي ومناقشة قضاياها العالقة، مثل العلاقة بين السياسي والمدني، دونما محاولة البحث عن صيغة أخرى تسعى من خلالها إلى تأسيس حركة نسائية جديدة تنتفع من المتغيرات الجديدة على الساحة السياسية بعيدًا عن الأسوار الصينية التي بنتها بينها وبين نساء أخريات لهن إسهامهن في صياغة خطابات الإصلاح السياسي. بكلمة واحدة، حتى هذه اللحظة غلبت الحركة النسائية المصرية الساعية للانخراط في حركات التغيير الانتماءات السياسية التاريخية، والتي تعود في الأغلب إلى ثلاثة عقود خلت، على قضايا المرأة الملحة. لا يمكن تحميل الحركة النسائية أكثر من طاقتها ولكن في هذا الإطار ينبغي التنبيه إلى عدد من البديهيات التي يمكن أن تطمس في سياق هذا الجدل الداخلي:
أولاً: تشير النتائج الأولية للمرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية إلى صعود ملحوظ لمرشحي جماعة الإخوان المسلمين داخل البرلمان. نحن لسنا بحاجة للتذكير أن الجماعة المذكورة في سياق تقديم أوراق اعتمادها إلى الساحة السياسية المدنية قدمت الكثير من التنازلات بشأن قضية الديمقراطية وتداول السلطة والأقباط في حين أنها لم تتناول قضية المرأة بالقدر الكافي من الاهتمام وظلت مواقفها على حالها في هذا الشأن. وهذا الجمود وإن كان يعود جزئيًا إلى افتقار الجماعة لأي تأصيل نظري يتعلق بالمواءمة بين حقوق المرأة وخطها السياسي العام، إلا أنه يعود في المقام الأول من وجهة نظرنا إلى أن قضية المرأة لم تكن في قلب الانتقادات الموجهة للجماعة بشأن قضية الديمقراطية وأنها، أي قضية المرأة، لم تحظ بالاهتمام الكافي من قبل القوى السياسية المدنية في إطار جدلها ومساوماتها مع جماعة الإخوان المسلمين في الفترة الأخيرة. فهل سيستمر هذا التجاهل تحت دعوى أن لا صوت يعلو فوق صوت المعركة الديمقراطية؟ هذا التطور الهام يتطلب عملاً جادًا بين الناشطات داخل المنظمات غير الحكومية وداخل التنظيمات السياسية المختلفة لمراقبة أداء البرلمان المقبل بشأن الجوانب التشريعية والسياسية المتعلقة بهموم ومشاكل المرأة المصرية. وعلى رأس هذه الأولويات عودة الاهتمام بقضايا الأحوال الشخصية والتعليم والصحة وغيرها من القضايا اللصيقة بالمرأة والتي يخشى من طمسها لصالح القضايا الملحة داخل المجال السياسي.
ثانيًا: استقلال الأشكال التنظيمية للحركة النسائية المصرية أصبح حتمية لا ينبغي التهاون فيها أو التقليل من شأنها حتى مع رفاق النضال الثوري أو النضال الديمقراطي. فقد أثبتت التجربة أن التنظيمات السياسية مهما بلغت درجة تقدميتها لا يمكن أن تحتكر تمثيل قضية المرأة فما بالك بتنظيمات مازالت تنتمي في أغلبها للتلوينات الشعبوية سواء كانت اشتراكية أو قومية وهي التلوينات التي لم تكن كثير تقدير لتميز قضايا المرأة المصرية نوعيًا.
ثالثًا: على الحركة النسائية المصرية أن تمد جسور التواصل مع الناشطات النسائيات المصريات داخل وخارج جهاز الدولة دون إيلاء كثير من الاعتبار للخلافات الأيديولوجية. فبينما يوضع الحزب الوطنى ونشطاؤه في مرمى النيران حينما يتعلق الأمر بالانتخابات البرلمانية على سبيل المثال لا ينبغي ذلك بالضرورة على قضايا المرأة. هذا التواصل بقدر ما يفيد نضال المرأة المصرية فإنه ينعكس كذلك على مجمل التطور الديمقراطي ككل والذي لا يمكن أن يتم في ظل مناخ القطيعة الأيديولوجية بين حركات التغيير والحزب الوطني الحاكم.
عمرو عبد الرحمن: محلل سياسي بالمفوضية الأوروبية بالقاهرة.
(1) Neil Stammers,”Social movement and social construction of human rights”, Human Rights Quarterly Vol. 21, 1999 pp 984.
(2) Ibid 985.
(3) إبراهيم البيومي غانم،“الحركات الاجتماعية الجديدة: تحولات البنية وانفتاح المفهوم“
8/ 5/ 2004 www. Islam online.net
(4) هالة كمال،“الحركة النسائية حركة سياسية“, طبية العدد الرابع، القاهرة، مارس 2004.
(5) Maxine Molyneux, Doing the rights thing: rights- based development and Latin American NGOs. Sian Lazar, London: ITDG Publishing, 2003 pp 66.
(6) Ibid p 68.
(7) Marina S. Ottaway.”Do not confuse Women Rights and Democracy,” International Herald Tribune 30 March 2004.