طبيعة المرأة
رقم الايداع:
2007/26784
الترقيم الدولي:
977-5895-25
رقم الطبعة:
الطبعة الأولى
تاريخ النشر:
2007
التحرير:
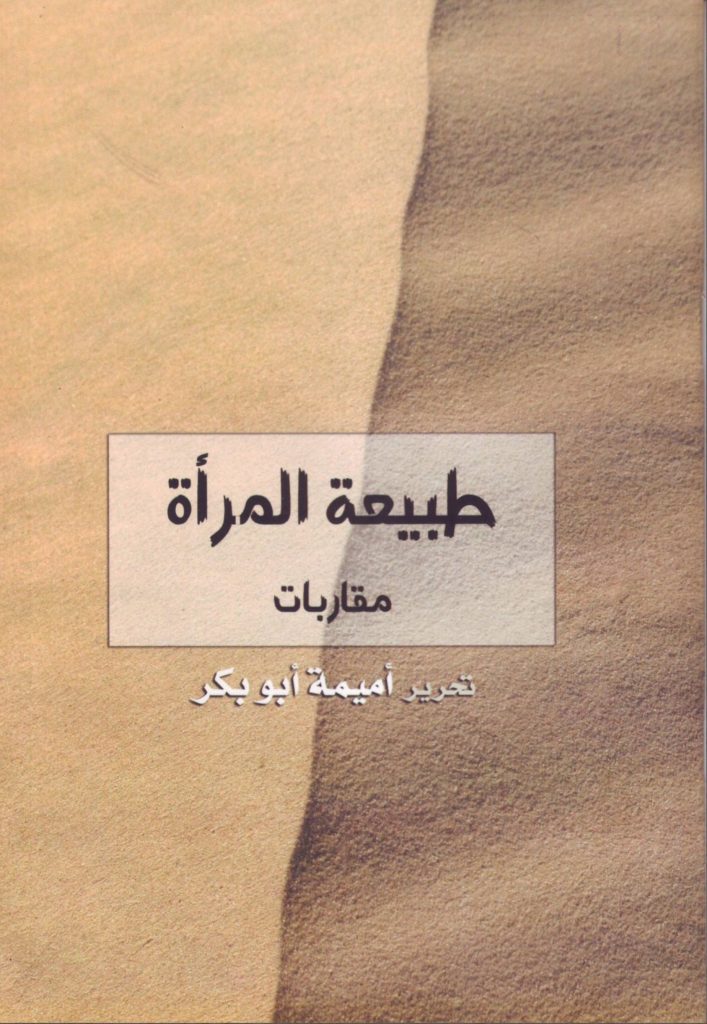
مقدمة
الفكرة والهدف من الحلقة النقاشية:
رغم أن فاعليات هذه المائدة المستديرة التي عقدتها مؤسسة المرأة والذاكرة كانت في عام 2001، إلا أن هذه المسألة لا تزال مطروحة في مجتمعاتنا العربية حتى يومنا هذا، ولا تزال تُشكل قضية لم تحسم وعائقًا أمام فكرة العدالة المطلوبة بين الرجال والنساء، والمساواة الإنسانية التي شرعتها الأديان. هي فكرة متجذرة في الثقافة العامة، وتبدو غير مهمة في حد ذاتها، ولكنها في الواقع في غاية التأثير على قضية تنميط شخصية كل من المرأة والرجل، والتعميم المغلوط بخصوص تقييم خصائص كل جنس على حدة. لذلك رأينا أن ننشر هذه المداخلات على سبيل التوثيق والإشارة السريعة إلى سُبل مقاربة وتفكيك هذا المفهوم الثقافي الغامض. هل للنساء “طبيعة” مختلفة ومميزة عن طبيعة الرجال؟ هل لكل من الرجل والمرأة طبيعة “خلقية“، أو فطرة محددة مطبوع عليها مهما حدث؟ وما المقصود بمفهوم طبيعة هنا؟
لم يكن الهدف من هذه الحلقة النقاشية افتعال صراعات أو تناقضات بين مواقف فكرية متعارضة، ولكن كان المقصود من هذه التجربة هو محاولة تطبيق منهج الدراسات المسماة بـ “دراسات عبر التخصصات“، وهي التفاعل أو الجمع بين تخصصات علمية متعددة في مقاربة موضوع أو قضية ما. دعونا المتحدثات والمتحدثين المشاركين إلى طرح الموضوع من وجهة نظر محددة، وكل من واقع تخصصه أو خبرته العلمية. لا تعد مناقشة هذه الفكرة ترفًا فكريًا أو سفسطة لا طائل من ورانها كما يظن البعض، أو فرصة للتندر والفكاهة، فلم يكن الهدف هو التسطيح، بل التعمق. كما نعتبر أن التداعيات الاجتماعية والثقافية لهذا المفهوم ليست بسيطة، لأن فكرة الطبيعة أو الفطرة الأزلية لكل من الرجل والمرأة تقف عائقًا فعليًا أمام محاولات الإصلاح الاجتماعي، وأمام قوانين وتشريعات لتطبيق الحقوق وممارساتها وترجمتها إلى واقع. مثلاً عند مناقشة أي من القوانين التي تثير جدلاً في مجتمعاتنا – مثل تولي المرأة لمنصب القضاء أو طلاق الخلع أو سفر الزوجة أو الحضانة، إلى آخره – لا تدور حيثيات المعارضة حول أي أسباب منطقية أو محاذير دينية واضحة، ولكن حول طبيعة المرأة (كل امرأة) العاطفية وعدم قدرتها على الاحتمال والتأني والتروي والتعقل، فهي كائن لطيف، ولكن غير موثوق به في الأعمال الهامة. لم نكن بصدد مناقشة فقهية لموضوعات القضاء والخلع والسفر، والملاحظ أنه لم تدع إلى المائدة المستديرة شخصية دينية، لاعتقادنا أن للفكرة جذور تاريخية وثقافية واجتماعية، وليس لها أصل ديني شرعي. وهنا يكمن جزء من المشكلة: فالفكرة راسخة في الثقافة، ويُعتقد خطأ أنها من المبادئ الإسلامية، في حين أننا لا نجد آية قرآنية واحدة تقر هذه القسمة الفطرية الخلقية بين طبيعة أنثوية وأخرى ذكورية، بل أن القرآن الكريم تحدث عن “النفس الواحدة“، وقدم لنا نموذج ملكة سبأ ذات العقل والحكمة والسلطة، ثم فرعون نموذج الاستبداد والطغيان والجبروت في ارتباكه واندفاعه. ولأن مؤسسة المرأة والذاكرة معنية بالتاريخ الثقافي – أي تاريخ الأفكار والمفاهيم – فقد كان اهتمامنا منصبًا على أصل هذا المفهوم وكيفية توظيفه لتحجيم المرأة في نطاق معين (وكذلك الرجل)، واستخدام التنميط غير الواقعي وغير العلمي كمبرر لتعطيل الحقوق والمساواة الإنسانية وتكريس التفرقة والتراتبية.
هل الطبيعة البيولوجية – أو بمعنى أدق الوظائف البيولوجية المخلوقة للمرأة – تنطوي على قدرات نفسية وعاطفية وعقلية معينة وثابتة لكل النساء في كل زمان ومكان؟ إن الاعتقاد السائد أن لكل نساء العالم شخصية واحدة تحكمها البيولوجيا والهرمونات، يتخلل الخطاب العام ويختلط بأحكام الدين والأحكام القضائية، والمادة الثقافية أو الفكرية أو الصحفية المقدمة في المجتمع. في خبر صغير ذو دلالة كبيرة بجريدة الأهرام (۱۸ فبراير ۱۹۹۹)، عن الحيثيات التي ساقتها محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة عندما حكمت برفض منح جواز سفر لمدرسة بكلية الآداب، جامعة الإسكندرية، ومنعها من السفر إلى لبنان للتدريس بجامعة في بيروت لمدة 3 أسابيع، لم يكن السبب حكمًا فقهيًا واضحًا، أو مناقشة لظروف هذه الأسرة، أو احتمال وجود أولاد أو فرد في الأسرة مثلاً، ولكن السبب الرئيسي: “… قررت الشريعة الإسلامية المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والحريات العامة والواجبات والمسئوليات مع الاعتراف بوجود اختلاف كبير بينهما في التكوين الجسدي والنفسي والفطري، مما ينتج عنه اختلاف في الخصائص الذاتية أو الأمور الخاصة لكل نوع، وبالتالي فإنه لا وجه للقول بالمساواة في الأمور الخاصة“. نفس هذا المنطق كان وراء الجدل الدائر حول منصب القضاء، بل ذهب البعض إلى التندر والسخرية عندما نشر المستشار محمد أبو علم مقالاً بيوميات “الأخبار“، تحت عنوان “عذرًا القضاء حامل“، وعندما حاولت الكاتبة الصحفية حُسن شاه أن تدافع عن هذه الوظيفة أو المهمة الشريفة التي خلقها الله، كان رد الأستاذ صلاح مبارك في مقال بجريدة “النبأ” (5 يوليو ١٩٩٨): “… فلماذا إذا لا تتفرغ (المرأة لهذه المهمة) على الأقل بصفة مؤقتة حتى تقوم إن شاء الله بالسلامة“!! حتى طبيعة المرأة “البيولوجية” تستخدم كسلاح ضدها وللسخرية والتحجيم عندما يلزم الأمر.
وفي مقال يخلو من ذكر لأي مصدر أو مرجع للمعلومات المقدمة، كتبت مها عبد الفتاح في “أخبار اليوم” (۲ سبتمبر ۲۰۰۰) عن: “الهرمون الرجالي، التستوستيرون، المسئول عن سر تفوق الرجل في الحياة العامة والخاصة… التفوق الجسماني بالتأكيد والذهني في معظم الأحيان“. تؤكد الكاتبة على وجود دراسات عن تأثير هذا الهرمون في تشكيل الشخصية – بدون أن تذكر اسم أي دراسة بالتحديد أو كتاب او مرجع – وتختم مقالها بالزعم أن: “جميع الدراسات العلمية تثبت أن الجنس الأسود في الرجال لديه نسب تستوستيرون أعلى من الجنس الأبيض بنسبة ارتفاع قد تصل إلى ٪١٩، وهو ما قد يفسر هيمنة السود على بعض المباريات الرياضية التي تتطلب لياقة بدنية عالية… وقد يفسر أيضًا ارتفاع نسبة الجرائم عمومًا، وجرائم العنف بين الأزواج منهم خصوصًا“. تقدم الكاتبة هذه المعلومات كمادة علمية أكيدة في جريدة عامة واسعة الانتشار والقراءة من قبل القارئ العام، بدون أي محاولة للاشتباك النقدي مع المادة، وبدون الوعي بالعنصرية الشديدة التي ينطوي عليها هذا الموضوع، والذي كان يجب تفنيده وغربلة العنصرية المتخللة فيه، بدلاً من ترسيخه في الوعي العام كمادة علمية. وتتوالى حتى اليوم مثل هذه المادة التي تعكس وتؤثر في الوقت نفسه على الوعي الثقافي، ففي أحدث مثال، عنوان لافت للانتباه لمقالة للدكتور عبد الهادي مصباح في جريدة “المصري اليوم” (۲۲ ديسمبر ۲۰۰۷)، “المرأة أكثر شعورًا بالألم من الرجل“. العمود يتناول: “مستويات الهرمون الأنثوي الاستروجين، الذي يختلف مستواه في الجسم باختلاف مراحل الدورة الشهرية، يمكن أن يكون له تأثير مباشر على اختلاف إحساس المرأة بالألم من وقت لآخر“. دائمًا ما ينال هذا الطرح “البيولوجي الهرموني” الاهتمام، ويقدم في الخطاب الثقافي العام كقضية هامة، ويؤدي إلى مزيد من تنميط للجنسين، وترسيخ التفرقة الحادة، بدلاً من الإنسانية المشتركة.
ويرتبط بفكرة الطبيعة البيولوجية للمرأة، الاعتقاد السائد أن الأعمال المنزلية من اختصاصات المرأة بالذات – ليس فقط بسبب تقسيم اجتماعي عملي لأدوار الأسرة الواحدة – بسبب أن “طبيعة” المرأة تميل بـ“الفطرة” إلى نوعية هذه الأعمال؛ فهناك تلازم أزلي وطبيعي جدًا بين هذه الأعمال والمرأة. ويشهد د. سعيد إسماعيل على بكلية التربية بجامعة عين شمس، بأنه أثناء تدريسه لطلبة وطالبات الدبلوم الخاص، أحيانًا تحضر بعض الطالبات ومعها طفل صغير مضطرة لاصطحابه لأن الأب لا يعتبر أن هذه مسئوليته، وأن دراستها العليا مجرد ترفيه ومسألة ثانوية، أو أنها لا تستطيع الذهاب إلى المكتبة، فهو لا يمنعها بطريقة مباشرة أن تواصل دراستها، ولكن شرط أن لا تقصر قيد أنملة في تلبية الاحتياجات ورعاية مطالب البيت والأسرة بالكامل، أي الأعمال الرئيسية الطبيعية المرتبطة بطبيعتها وخلقتها. “وهكذا خرجت المرأة كي تدرس وتتعلم وتعمل، لكننا مازلنا نطلب منها كل المهام التي كنا ننتظرها منها وقت أن كانت متفرغة في المنزل، فأصبحت تنؤ بالعديد من الأعباء والمسئوليات المركبة والمتراكمة، إلى درجة لابد أن تنتهي بها إلى أن تبدو مقصرة في كل واحد منها، فيشتد النقد واللوم، وتصدر أصوات مرددة: آدي نتيجة تحرير المرأة” (الأهرام ۲ مارس ۲۰۰۰).
خلاصة القول، أن فكرة الطبيعة المتأصلة تمنع المرأة من ممارسة حقوقها التي يقرها المجتمع نظريًا أكثر من عمليًا، كما أنها تستخدم سياسيًا ضدها عندما يلزم الأمر. لذلك أردنا– من خلال هذه المائدة المستديرة– أن نفتح الباب لدراسة مسألة “طبيعة المرأة” و“طبيعة الرجل” من نواح مختلفة وداخل مجالات متنوعة: الناحية النفسية والسلوكية ومن زاوية علم الاجتماع والأنثروبولوجيا ومن المنظور الديني والتاريخي والثقافي، إلى آخره، لنصل إلى نتائج موضوعية بناء على معلومات وأدلة علمية.
مجالات طرح الموضوع:
1- كيف يعرف الطب النفسي فكرة “الطبيعة“؟ هل المقصود فطرة نفسية معينة وتكوين عاطفي خلقي، أم القدرات العقلية؟ وهل هذه الطبيعة مكتسبة وتخضع لمؤثرات تربوية وتنشئة اجتماعية وتشكيل ثقافي؟ إن الدراسات التي ظهرت في علم الأنثروبولوجيا خلال العشرين سنة الأخيرة، وكذلك في النظريات الحديثة في علم النفس، بدأت تلقي بظلال الشك على مفهوم أن “الاختلافات الطبيعية” بين الجنسين موحدة وثابتة لا تتغير عبر المجتمعات والثقافات والأزمنة، وأن علم النفس – في هذه القضية – يرسخ أحيانًا للدور النمطي التقليدي للمرأة النابع من الثقافة ذاتها، ويسبغ عليها أوصاف العاطفية والاعتماد على الغير والرغبة في الحماية والصبر والسلبية والخضوع وغلبة المشاعر والعواطف، إلى آخره، بينما لا يتم إلحاق صفات دفء المشاعر والحنان بالرجل مثلاً. هل فكرتنا عن طبيعة النساء في مقابل طبيعة الرجال تخلو من تنميط ثقافي واجتماعي مصطنع لأغراض تخدم فكرة تحديد وفصل الأدوار الاجتماعية وفصل المجالين العام والخاص وتحديد حركة الجنسين.
قدم د. عادل أبو زهرة عرضًا سريعًا ومثيرًا للأزمان السحيقة (ما قبل التاريخ)، ولأنشطة الرجال والنساء فيها، ليثبت من الناحية الأنثروبولوجية أن الطبيعة الأنثوية أو الذكرية ليست بالضرورة ثابتة أزليًا أو فطرية، بل متغيرة ومتطورة من زمن إلى زمن. وهذا أيضًا ما ذهب إليه د. أحمد عبد الله في مداخلته، عندما أشار إلى دور التنشئة الاجتماعية في تنمية “ملكات” أو قدرات بعينها في كل من المرأة والرجل، كما أشار إلى إزدواجية العقل والعاطفة (الرجل – المرأة) وإشكالية إعلاء العقل ثم تجاهل الفروق الفردية داخل كل مجموعة: بين الرجال وبين النساء. تطرق كذلك إلى الخطاب الديني المغلوط للمفسرين حول المرأة والمجال العام. أما د. ملك رشدي فقد شرحت بتفصيل أكثر فكرة الدور الاجتماعي المرسوم و“المتوقع” من كل جنس والتقسيم بين العام والخاص (مجالي الرجل – المرأة)، كإنتاج اجتماعي/سياسي، وليس “حتمية بيولوجية“. فقد استخدمت البيولوجيا لتبرير وتعضيد ما صاغه المجتمع واتفق عليه، أي باختصار مفهومي التنميط و“البناء الاجتماعي” (social construct). كما عرضت عرضًا مفيدًا للغاية عن النظريات المختلفة في علم الاجتماع، التي تناولت الاختلاف بين الجنسين، ودور العاملين البيولوجي والثقافي في تشكيل الشخصية المتوقعة، مشيرة إلى أهمية التنظير في إعانتنا على فهم وتفسير الواقع الذي نريد أن نغيره ونصلح من شأنه.
2- هل لفكرة “الطبيعة أو “الخلقة” الإنسانية تاريخ يتعين علينا أن نعرفه ونعيه جيدًا؟ متى نشأت وتطورت الفكرة، وكيف بدأ استخدامها تاريخيًا؟ إذا عرفنا أصول الأفكار والمفاهيم قد نستطيع أن نناقش على أساس واضح التأثير اقتناع المجتمعات واستيعابها لهذه الأفكار على التنشئة الاجتماعية وتحديد السلوك الاجتماعي وتشكيل الثقافات. أي ما تداعيات ظهور هذا المفهوم على المرأة؟ وما دور الأفكار العنصرية أو النظريات الاقتصادية الحديثة مثلاً في ترسيخ واستغلال مفهوم طبيعة المرأة؟ يوجه بعض الباحثين نظرنا إلى أعمال ونظريات لعلماء اقتصاد عن حفظ توازن اقتصاد الدول وهي نظريات تتمحور حول آليات السوق ومركزيته وتقسيم الحياة الاقتصادية إلى عمالة منزلية وإنتاجية السوق، وأن النساء “بطبيعتهم” أصلح للنوع الأول، لأن لديهم التزام بيولوجي لإنتاج الأطفال ورعاية استثماراتهن دون الحاجة لتصريف طاقاتهن في أي أنشطة أخرى. بينما ليس على الرجال هذا الالتزام، ومن الطبيعي أن يصرفوا طاقاتهم ووقتهم في أنشطة السوق فقط (انظر/انظري كونستانس بيوكانون، “اختيار القيادة“، ١٩٩٦)، (Constance Buchanan, “Choosing to Lead”).
إلى جانب إشارة د. ملك رشدي إلى مسألة التحولات الاجتماعية والاقتصادية والحراك الطبقي وتأثير كل ذلك على تشكيل التوقعات المجتمعية لأدوار الجنسين، ربطت د. سحر صبحي تاريخ العنصرية العرقية في أوروبا خلال القرن التاسع عشر، في التمييز بين الجنس الأبيض والجنس الأسود من ناحية، والتمييز بين الرجل والمرأة من ناحية أخرى. وأظهرت أن إعلان تفوق الجنس الأبيض عقليًا وفكريًا وحضاريًا، بُني على تأسيس نظريات فلسفية وعلمية كرست اختلاف لون البشرة والتركيب الجسماني والتشريحي لتنميط أجناس وشعوب بأكلمها وإثبات دونيتها. ولا شك أنه ربط مثير وزاوية جديدة للنظر إلى الموضوع، تدعو إلى التأمل. فالمنهج واحد، وقد تكون الغاية واحدة: توظيف العلم أحيانًا للتفرقة والتمييز والتراتبية. وهذا يوضح البعد السياسي للمسألة.
3- كيف يمكن أن تضيف دراسات العلوم السياسية إلى معلوماتنا في هذا المجال، خاصة مسألة الحيز العام والخاص. فهذا يذكرنا بأول من نظر لهذا التقسيم في الحياة البشرية، وهو أرسطو، الذي تحدث عن هذين المجالين مع ترسيخ لتراتب صارم بين “المجال الخاص” ويقطنه النساء والعبيد والأطفال والحيوانات الشغالة، حيث المهمة هي “الحفاظ على عناصر الحياة الأساسية“، وحيث يكون “الصمت الخاضع هو تاج على رأس المرأة“. أما الذكور فهم کائنات سياسية في الأساس يتعاونون على تكوين وتنظيم الحياة العامة الخارجية، لأنهم طبيعيًا الأصلح للقيادة، وهدفهم المشترك هو تحقيق المساواة بينهم في هذا المجال السياسي العام “كمواطنين“. ويسبغ أرسطو على هذا الهيكل التراتبي صفة “المسلمات أو الحقائق“. وقد نقدت أو فندت المدارس النسوية هذا الفكر الذي أسس للحط من شأن قيم المجال الخاص/الأسري والإعلاء من قيم التنافس على القوة والسلطة والمال التي تميز “الإنسان السياسي والاقتصادي” في المجال العام، بهدف إلقاء الضوء على عملية الترتيب الاجتماعي المصطنع وغير العادل الذي يكتسب مع الوقت جمودًا لا مبرر له، وكذلك صفة الطبيعة، فمن الواجب إعادة تقييم هذا التراتب بين المنظومتين العامة والخاصة، والحكم على أيهما أقرب إلى المُثل الأخلاقية.
ورد هذا الرأي الذي ينتقد الاستقطاب بين العام والخاص – العقل والعاطفة – الرجل والمرأة في مقال لماري ديتز “المواطنة ذات البعد النسوي في النظرية السياسية 1913 – 1985″، (Mary Dietz, “Citizenship with a Feminist Face”).
أكدت فيه على معيار “المواطنة” كتحليل أعمق لعنصر “السياسة” في فكر أرسطو نفسه – خاصة ما تحدث عنه في موضع آخر عن عملية صنع القرار داخل الجماعة البشرية. فمن خلال هذا النشاط الإنساني يستطيع البشر أن يتعاونوا ويشتركوا ككائنات ذات قيمة متساوية في الوصول إلى قرارات جماعية حول قضايا تمس مصالحهم المشتركة جميعًا، وهذا هو التعريف المبسط فكرة “المواطنة” عند أرسطو. فعندما يمارس الناس حياتهم بصفتهم مواطنين بيدهم اتخاذ قرارات جماعية لتحديد المصير، سيحققون الحياة المدنية السليمة والحرية الحقيقية. ومن هذا المنطلق نستطيع تجاوز الاستقطاب بين العام والخاص ومشكلة أي المجالين أولى بأن تسود قيمه ومبادئه، عندما يتحول الأمر إلى قضايا مجتمعية عامة وإلى تطبيق أو تحقيق حياة “الجماعة الديمقراطية“. أي أن هذه القراءة تحاول الاستفادة من هذا الجانب من فكر أرسطو كرد على تحجيم حياة الإنسان في شكل تقسيم الطبائع البشرية. هل الحل إذًا يكمن في التركيز على تحقيق قيم “المواطنية” العادلة مثل الديمقراطية والشراكة والعمل الجماعي والمساواة المدنية؟
حاولت د. هبة رؤوف بالفعل تجاوز الازدواجيات وإشكالياتها من خلال اختيارها أن تركز على فكرة اعتبرتها ذات أولية مقدمة وهي: الطبيعة الإنسانية. كما كانت مداخلتها استلهامًا لمجموع الأفكار التي طرحها د. عادل أبو زهرة ود. أحمد عبد الله ود. ملك رشدي، ورد فعل لها. تساءلت عن ماهية الطبيعة الإنسانية وفطرتها بادئ ذي بدء قبل الانتقال إلى مستوى “الجندر” (gender)، وأدوار الجنسين وطبيعتهما، لأنها رأت أن “الطبيعة الإنسانية“، هي التي تتعرض للتشويه وبدأت تفقد مكانتها ومرجعيتها القيمية في هذا العصر الحداثي، الذي نعيشه، مما يستحيل معه الكلام أصلاً حول طبيعة المرأة أو الرجل. وهذه نقطة تثير مسألة “الأولويات” (prioritization)، التي عادة ما تطرح عند الحديث حول قضايا المرأة: هل من مصير مشاكل المرأة و(الجندر) الإزاحة والتأجيل والتجاهل، بحجة أنها ليست أولوية في دائمًا خضم متاعب مجتمعاتنا؟
4- هل لهذه الفكرة مرجعية دينية محددة، أم هي نتاج ميراث ثقافي مغلوط؟ من أوائل العلماء المسلمين الذي استخدم تعبير “فطرة” المرأة في القرن العشرين، كان هو الشيخ محمد عبده في تفسيره لبعض آيات القرآن الكريم، ولكن يبقى هذا واحدًا من التفسيرات العديدة للقرآن والسنة في هذا المضمار. هل نصوص الآيات الكريمة أو السنة الشريفة قاطعة فعلاً في مسألة طبيعة المرأة المختلفة عن طبيعة الرجل؟ رغم ما يعرفه معظم الناس عن أن محمد عبده يختلف عن المفسرين والعلماء في إقراره مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في “الذات والإحساس والشعور والعقل” (انظر/انظري تفسير المنار)، إلا أنه يناقض هذا المبدأ نفسه حين يتحدث في موضع آخر من التفسير عن “فطرة الله تعالى في توزيع الأعمال…، على المرأة تدبير المنزل والقيام بالأعمال فيه، وعلى الرجل السعي والكسب خارجه“، فهذا هو “الأصل والتقسيم الفطري“. منذ ذلك الحين، وأصبحت هذه هي الفكرة السائدة والمصطلح المستخدم على مدار هذا القرن، مع تعضيدها بنظريات متزامنة في علم النفس، أو الحديث عن الاعتبارات البيولوجية مثل الخطاب المستخدم في تفسير سيد قطب “في ظلال القرآن“، عن “طبيعة المرأة الانفعالية“، لأن “وظيفة الأمومة العضوية البيولوجية تستدعي مقابلاً نفسيًا“، يصعب معه “التفكير البطئ المتأني“، و“الطبيعة لا تتجزأ، فالمرأة شخصية موحدة، هذا طابعها” (تفسير قطب للآية ۲۸۲ من سورة البقرة). وفي موضع آخر من التفسير يتحدث سيد قطب عن “شطري النفس البشرية وأن الفطرة اقتضت أن الرجل له خصائص في تكوينه العضوي والعصبي والعقلي والنفسي مختلف عن المرأة وتكوينها العضوي والعصبي والنفسي“، فالله زود الرجل بقدرة “استخدام الوعي والتفكير“، وبقدر من “التروي وإعمال الفكر” لا تستطيعها المرأة. وهذا يذكرنا بمفسر مثل فخر الدين الرازي الذي يستخدم في تفسيره علم أرسطو البيولوجي عندما يقول أن “النسيان غالب طباع النساء لكثرة البرد والرطوبة في أمزجتهن“. أي أن كل منهما اعتمد على العلوم الشائعة في عصره لتكون حيثيات للتفسير والشروح المقدمة. نجد كل هذا في خطابات العلماء الذين حمّلوا الآيات أكثر مما فيها بالفعل، رغم أن الله (سبحانه) يحدثنا في القرآن كما أشرنا عن “النفس الواحدة” في أكثر من موضع.
باستثناء مثال الرازي، فإن هذه الفكرة اكتسبت في رأينا قوة ورسوخًا أكثر في العصر الحديث، فلم يستخدم غالبية المفسرين القدماء التبرير المبني على اختلافات “طبيعية” أو “كامنة ومتأصلة” بين الرجل والمرأة، فأكثر مناقشاتهم انصبت على التفسير “السوسيولوجي” وليس البيولوجي للفروق بين الجنسين عندما تحدثوا عن عوامل الخبرة والتعامل والاختلاط مع المجتمع الخارجي والتعرف على شئونه في الحكم على قدرات النساء. حتى في استخدام الفقهاء وعلماء الحديث لكلمة العقل، أو مفهوم التفاوت العقلي بين الناس، لم يقصدوا “العقل الغريزي“، ولكن “القدرة العقلية العملية” التي تُكتسب وتتطور في الإنسان نتيجة لخبرات البيئة الاجتماعية المحيطة به، وهنا تتفاوت قدرات الناس أو الجنسين (ارجع/ارجعي لمقال محمد فاضل “امرأتان ورجل“، في المجلة العالمية لدراسات الشرق الأوسط، ۲۹، ۱۹۹۷)،
(Mohammad Fadel, “Two Women, One Man” in International Journal of Middle East Studies).
وكتاب رضوان السيد “الأمة والسلطة والجماعة“، بيروت: دار اقرأ، ١٩٨٤، وكذلك تفرقة المؤرخ وعالم الحديث شمس الدين السخاوي بين العقل المطبوع والعقل المسموع في كتاب “الإعلان والتوبيخ“، ق ١٥ م).
5- في الثقافة الغربية يكمن منبع هذه الفكرة في تحولات تاريخية محددة في القارة الأوروبية. ويجد المؤرخون المحدثون لدهشتهم، أن كلا من الرجال والنساء في القرون الوسطى يظهرون “طبيعة” إنسانية مختلفة ومغايرة عما يفترض وعينا “الحداثي” عن الطبيعة الأزلية الثابتة للذكورة والأنوثة، أو للرجل والمرأة. كما يكتشفون أن حدود المسموح به اجتماعيًا وثقافيًا في مجالات كثيرة من الحياة لم تكن مرسومة بالصرامة والجمود الذي نتخيله عن هذه العصور، أو حتى مقارنة بنفس تلك الحدود في عصرنا الحديث (طالع/ طالعي سوزان ستيوارد “النساء في تاريخ العصور الوسطى“، ۱۹۸۷)،
(Susan Stuard, “Women in Medieval History and Historiography”).
وهذا بدوره يعضد النظريات المشار إليها من قبل بعض المتحدثين (خاصة د. ملك رشدي)، من أن منظومة العلاقات بين الجنسين و“طبيعة” كل منهما وأدوارهما يتم تشكيلها ثقافيًا واجتماعيًا، وأنها تغيرت فعلاً على مر القرون والعصور.
وعن التقسيم الحاد بين الحيز العام والحيز الخاص، درس الباحثون القرون التي تلت عصر النهضة في القرن السادس عشر، عند بدايات تغير وسائل الإنتاج والاستهلاك، بلوغًا إلى الثورة الصناعية في القرن التاسع عشر، وما تبعها من تشكل السوق وآلياته وحركته وقيمه، منفصلاً عن مجال الأسرة الخاص والمنزل، وجدوا أن هذه المرحلة هي بدايات تأسيس الانفصال بين العام والخاص في الثقافة الأوروبية، والذي تبعه تحجيم دور النساء في دائرة الخاص – أي المنزل والعائلة والأطفال والخدم، إلى آخره – وقصرهن على هذا المجال فقط، في مقابل ارتباط الرجال بالعام وأعماله في المجتمع الخارجي – أي ما هو أصعب وأقيم وأكثر تميزًا وسيطرة، وبالطبع أكثر ربحًا. لذلك يرى بعض المحللين أن هذا الانفصام والتحجيم الذي أحدثته الثورة الصناعية أدى إلى تقلص الدور الإنتاجي للنساء خاصة في الطبقة المتوسطة الصاعدة، وحصرهن في المجال الأسري الخاص، حيث مسئولية الرعاية والعاطفة البعيدة عن السوق والمصنع ومهن الحياة العامة خارج المنزل، التي تخص الرجال في الأساس (رينات برايدنثول “النساء في التاريخ الأوروبي“،1977)
(Renate Bridenthal, “Becoming Visible: Women in European History”).
وقد بلغ هذا الاتجاه ذروته في العصر الفيكتوري ببريطانيا (ق ١٩)، الذي روج كبناء اجتماعي (social construct) لصورة امرأة الطبقة المتوسطة، رمز “المنزل” و“الحياة المنزلية” فقط، بكل عناصره الخدمية والرعانية (domesticity)، لأن “طبيعتها” لا تؤهلها للأعمال “العقلية” في الحياة العامة. وهناك تكهنات عن الصلات بين هذه المفاهيم في التراث الغربي الحداثي وخارجه، وكيفية انتقالها إلى المجتمعات العربية الإسلامية في هذا الوقت عندما كانت مستعمرة، ثم استيعابها أو استبطانها لدى النخب الثقافية ودعاة الفكر “الحداثي“، الذين اعتقدوا في مفاهيم الحداثة الغربية – برمتها بدون تفنيد أو غربلة – والتي انطوت على صورة رومانسية عن طبيعة المرأة العاطفية الرقيقة، التي تملي عليها سلوكًا وتفكيرًا عاطفيًا وأموميًا بحتًا، وليس بالضرورة عقلانيًا أو منطقيًا.
في هذا السياق تجدر الإشارة كذلك إلى ظهور نمط أو مثال “المرأة الحقيقية” (true womanhood) في أمريكا الشمالية في النصف الأول من القرن التاسع وهو نمط لبناء اجتماعي تم تقديمه على أنه النموذج المثالي في المجلات النسائية والصحف والكتب الإرشادية والدوريات الدينية والمحاضرات العامة والخطاب الوعظي، إلى آخر عناصر الثقافة العامة في ذلك الوقت، وتقرر أن صفات السلوك الأنثوي “الطبيعي” أو الشخصية النسائية “الحقة” هي بالتحديد: (أ) المثالية الأخلاقية والتدين. (ب) النقاء والعفة. (جـ) الخضوع والاستكانة. (د) الارتباط الجوهري بالحياة المنزلية (باربرا ولتر “مذهب المرأة الحقيقية من ١٨٢٠ حتى ١٨٦٠: الدورية الأمريكية، 18، 1966، (Barbara Welter, “The Cult of True Womanhood”).
أخيرًا، يلزم التنويه إلى أننا لم نطلب من المتحدثين تقديم ورقة بحثية نهائية، بل كانت الدعوة إلى عرض مقاربة مبدئية تفتح الباب لمزيد من الدراسات التفصيلية فيما بعد، لذا احتفظنا بالطابع غير الرسمي الاستكشافي لهذه المداخلات، ولم نضمن قوائم منفصلة للمراجع، كما تم طبعها على حسب ترتيب المتحدثين والمتحدثات وقتها.
أميمة أبو بكر
-1-
د. عادل أبو زهرة
أستاذ العلوم السلوكية جامعة الإسكندرية
عندما قرر محمد علي في بداية الثلاثينات من القرن التاسع عشر إنشاء أول مدرسة للبنات، وكانت مدرسة للقابلات، وكانت برامجها التعليمية تشتمل على تعليم القراءة والكتابة والحساب وبعض المهارات الطبية، اختار ضاحية حلوان موقعًا لها. وعندما تم الإعلان عن ذلك حدثت أزمة كبيرة حيث اعترض علماء الدين على خروج المرأة من منزلها وذهابها إلى المدرسة، وقامت مجموعة من علماء الدين في ذلك الوقت بكتابة عريضة رجاء إلى “مولانا المعظم محمد علي باشا“، “أطال الله بقاءه“، يرجونه فيها العدول عن قراره على اعتبار أن مكان المرأة الطبيعي هو المنزل وعملها الطبيعي هو خدمة زوجها والعناية بدارها وتنشئة أطفالها، أما الخروج إلى الطريق العام والاختلاط بالرجال فقد وصفوه بأنه خرق لسنة من سنن الله في الكون، أما تعليمها وذهابها بعد ذلك إلى الأعمال فقد يكون علامة من علامات الساعة.
ولأن محمد علي كان ديكتاتورًا لديه مشروع ولديه رؤية فلم يعر مطلبهم أي اهتمام، ولم تأت خطبهم التحذيرية على المنابر وقولهم بأن الساعة آتية لا ريب فيها بأي جدوى، وأنشأت المدرسة وافتتحت، وخرجت المرأة إلى الطريق العام وذهبت لتتعلم، ولم تقم الساعة حتى الآن، وأنا لا أشك في إخلاص هؤلاء الدعاة، ولا أشك في أنهم كانوا على يقين من صحة ما يقولون، لأن الظروف التي كانت قائمة في هذا الوقت جعلتهم يتصورون أن طبيعة المرأة ثابتة وأنها متمثلة أمامهم في كل النساء اللائي يخالطونهم، وأن هذه الطبيعة غير قابلة للتطور والتغير.
قهر المرأة بناء على ما يعتقد أنه طبيعي فيها:
القهر يعني إجبار الإنسان على القيام أو عدم القيام بعمل ما أو أن يتصرف بطريقة ما أو يلعب دورًا ما دون أن يكون له حق الاختيار في القيام بهذا العمل أو الامتناع عن القيام به أو لعب هذا الدور، وقهر النساء على التفكير باسلوب خاص والقيام بأعمال معينة وأدوار خاصة جعلنا ننظر إليهن، وجعلهن ينظرن إلى أنفسهن، على أنهن كائنات مختلفة تمامًا عن الرجال، مع أن هذا غير صحيح، لكن شدة القهر وتعدد صوره علمت النساء الخنوع والخضوع والتحايل واللف حول الواقع، ثم اعتقدن في النهاية أنهن كذلك بالفعل.
إن سوء تقدير قدرة المرأة على التفكير والعمل له جذوره الثقافية والتاريخية، فالتمييز يبدأ بفكرة، والقهر يبدأ أيضًا بفكرة تتم زراعتها في التربة الاجتماعية، فتنبت من العادات والتقاليد والقيم ما يصبح راسخًا، يقاوم التغيير. بل كثيرًا ما ترتدي العادة أو التقليد أو الفكرة لباسًا مقدسًا تحاط بأسوار من الشوك تدمي أقدام كل من يحاول الاقتراب من هذه الأسوار أو اقتحامها، بل قد يدفع الإنسان حياته ثمنًا إذا ما حاول تغيير هذا الواقع القيمي الذي اكتسى بالقداسة.
ومن المؤكد أن النساء في كل أنحاء العالم يدفعن ثمنًا غاليًا من حريتهن وكرامتهن، نتيجة لسيادة أفكار خاطئة عما يقال عن طبيعة المرأة وإمكانياتها وقدراتها والأدوار التي يمكن أن تقوم بها في الحياة.
إن تغيير هذا الواقع القيمي وإعادة النظر في ذلك القدر الهائل من العادات والتقاليد التي شكلت الوعي تجاه النساء (وعي الرجال تجاه النساء ووعي النساء تجاه أنفسهن)، يحتاج إلى قدر كبير من الشجاعة، كما يحتاج أن نعلن جميعًا أن أي فكرة أيًا كان مصدرها تتسبب في شقاء النساء وتعاستهن وبؤسهن، وتتسبب في تعطيل قدراتهن على الحب والعمل المنتج والتفكير الحر النقدي الإبداعي، وعلى المشاركة في إعادة صياغة شكل المجتمعات الإنسانية، يجب تغييرها، وإلا فستظل المرأة مقهورة، وسيظل نصف المجتمع معطل عن الابتكار والإبداع ومعطل عن الإسهام في صياغة شكل الحياة الإنسانية التي تمثل المرأة جزءًا أساسيًا من تكوينه.
طبيعة المرأة:
ينتج الطفل من تزاوج هرمونات ذكرية وهرمونات أنثوية، وفي حالة تفوق الهرمونات الذكرية، يخرج الطفل ذكرًا، أما في حالة تفوق أو سيادة الهرمونات الأنثوية، يخرج الطفل أنثى. لذلك فبعض الاتجاهات في العلوم السلوكية تأخذ بفكرة الجنسية الثنائية للشخص الواحد، فالذكر في داخله عناصر لأنثى لم تكتمل، والأنثى في داخلها عناصر لذكر لم يكتمل. وعلى جسد كل أنثى علامات ذكرية، كما أن على جسد كل ذكر علامات أنثوية، أي أنه لا يوجد ذكر مائة بالمائة، أو أنثى مائة بالمائة، وكلاهما (الأنثى والذكر) ينتميان إلى طبيعة بشرية واحدة قابلة للتغير والتطور. فامرأة القرن السادس عشر تختلف عن امرأة القرن التاسع عشر، وكلتاهما تختلفان عن امرأة تعيش قرب نهاية القرن العشرين. ولو تصورنا امرأة مصرية عاشت وماتت في القرن الثامن عشر، خرجت من قبرها وشاهدت نساء اليوم يقدن السيارات، ويصممن المنازل، ويرأسن اجتماعات معظمها من الرجال، لو حدث ذلك ربما أصيبت مثل هذه المرأة بصدمة قد لا يتحملها قلبها فيتوقف عن العمل.
قبل أكثر من ستة آلاف عام، ابتكر الرجال أدوات مثل الرمح والقوس والمطرقة والفأس والسكين، ثم السيف والمحراث والعجلات الحربية. أما النساء فقد ابتكرن الأوعية والأواني والقدور والأكواب والمشاعل والصناديق وصوامع الغلال وطواحين الحبوب والفرن والحظيرة والمخزن والصهريج، هذه الأدوات التي ابتكرتها المرأة تطورت فيما بعد إلى السور والردهة والبيت والقرية. وإذا كان للرجال فضل استئناس الحيوان، فقد كان للنساء فضل اختراع الزراعة التي تمثل واحدة من أعظم الثورات في تاريخ البشرية. كما كان للنساء الفضل الأكبر في صناعة الفخار، وصناعة النسيج، وصناعة العصائر، والمشروبات المخمرة، بل يمكن القول أيضًا أن الاستقرار الإنساني اختراع نسائي.
إن ابتكار الزراعة كان أهم حدث في تاريخ البشرية حتى حوالي مائتي سنة مضت، وهو التاريخ الذي عرف فيه الإنسان الثورة الصناعية، وكان استنبات الحبوب اختراعًا نسائيًا، كما سبق وذكرنا، ومن المرجح أن ابتكار المرأة للزراعة رفع من شأنها في المجتمعات الزراعية الأولى. ويؤرَّخ لابتكار المرأة للزراعة بحوالي ثمانية آلاف عام قبل الميلاد. وقبل أن يعرف الإنسان عملية الاستنبات المعقدة، كان الناس جميعًا إما صيادين أو جامعي ثمار، ومن المرجح أن الرجال في هذه المجتمعات البدائية هم الذين قاموا بأنشطة الصيد. ولأن النساء كن أقل حركة من الرجال لانشغالهن بالحمل والولادة والإرضاع، فعندما كان الرجال يخرجون لصيد الحيوانات المتوحشة، كان النساء ينشغلن بجمع الحبوب والبذور وثمار الفاكهة والبيض والدرنات. وكان عمل النساء هو الذي يزود الجماعة بالقوت الضروري، أما عمل الرجال فبالرغم من أنه يحمل قدرًا أكبر من المغامرة والإثارة، إلا أن عائده لم يكن منتظمًا أو مضمونًا. وبينما كانت النساء تطورن عملية الزراعة اليدوية في العصر الحجري الحديث (۸۰۰۰ ق م – ۳۰۰۰ ق م)، بأودية أنهار الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفي أماكن أخرى من الهند والصين، كان الرجال يحاولون استئناس الحيوانات المتوحشة، وبدأوا يحتفظون تدريجيًا بالحيوانات في قطعان يسيطرون عليها ويعودونها على التكاثر وهي أسيرة في المراعي. وهكذا نجحوا في استئناس وترويض الأغنام والماعز والأبقار والثيران والخيول. وبحلول عام 3000 ق م، كانت هذه القطعان تشبع حاجات غذائية لجماعات أكبر عددًا وأكثر كثافة، كما اهتدى الرجال إلى استخدام الثيران في حرث حقول ذات مساحات أكبر من تلك التي كانت النساء تزرعنها بالأيادي، واخترع الرجال فيما بعد المحراث الثقيل واستخدموا الثيران في جره، وبالتالي ربطوا الحيوان بعالم الزراعة النسائي، وبذلك أصبح في إمكان الإنسان إنشاء المدينة. أي أن القرية كانت اختراعًا نسائيًا، بينما المدينة كانت من اختراع الرجال. والمدن كانت ثمرة تزاوج ثقاقتين مختلفتين في العصر الحجري الحديث، ثقافة الجماعات الزراعية المتأثرة بالروح الأنثوية وثقافة الرعاة الذكرية. ومن المؤكد أن ثقافة الزراعة الأنثوية كانت أكثر ابتكارًا وأكثر تعقيدًا من ثقافة المراعي الذكرية، لأن ثقافة المراعي لم تتقدم كثيرًا عن ثقافة الصيادين في العصر الحجري القديم (قبل ۸۰۰۰ ق م)، وعندما تزاوجت هاتان الثقافتان (الزراعة والرعي)، قام الرعاة بنقل حيواناتهم إلى المزارع واستخدموها في فلاحة الأرض التي استمدت منها النساء مكانتهن المتميزة، وبالتالي بدأت مقاليد الأمور تنتقل إلى الرجال.
إذن لقد احتفظت المرأة بمكانة متميزة ومرموقة لمدة حوالي خمسة آلاف عام من 8000 ق م إلى 3000 ق م، قبل أن يدخل الرجال بالعالم إلى ثقافة المدن التي سيطروا فيها على أمور الحياة تمامًا. وخرجت المرأة تدريجيًا من الإسهام في الحياة العملية الإنتاجية، وبدأ الرجل في إعالتها وتحويلها إلى جزء من ممتلكاته، حيث سيطر الرجال سيطرة شبه تامة على أمور الحياة (حوالي ٢٥٠٠ ق م) وقبعت المرأة في البيت لفترة طويلة، وفقدت دورها المتميز في العملية الإنتاجية، لذا تدهورت قدرتها الابتكارية وأحوالها الأخرى. وبدأت تخرج الأفكار التي تتحدث عن ضعفها ونقصها، وتحولت من شريكة للرجل إلى أداة من أدوات متعته وخدمته. وترتب على ذلك أن حرمت النساء في كل المدنيات القديمة تقريبًا من المكانة التي تمتعن بها في مجتمع العصر الحجري الحديث (۸۰۰۰ ق م – ۳۰۰۰ ق م)، وانحطت مكانتهن بعد أن انزوين في المنازل إلى مرتبة الممتلكات والخدم. ففي بلاد ما بين النهرين (1750 ق م)، كانت المرأة تعد ملكًا لزوجها أو أبيها، وللزوج أن يطلق زوجته وقت يشاء أو يعدها جارية، بل له الحق أن يرغمها على طاعة الخدم، كما يملك أن يقدمها لدائنيه ضمانًا لديونه. وكانت الزوجة تواجه الموت على خيانتها لزوجها، بينما الأزواج الذين يخونون زوجاتهم لا يواجهون أي عقاب. وفي الحضارة اليونانية لم يكن للنساء الحق في الاشتراك في الاجتماعات العامة، أو المشاركة في مناقشة الأمور العامة. وكان ينظر إليهن مثلما ينظر إلى العبيد والأطفال. وفي الدولة الرومانية كان ينظر للزوجات والبنات على أنهن من ممتلكات الزوج أو الأب، ولهما حق التصرف فيهن، ولهما عليهن حق الحياة والموت. وينطبق نفس الحال على المدنيات القديمة في بلاد الهند والصين واليابان، ففي الهند كانت النساء تعزلن في مؤخرات المنازل داخل غرف خانقة مغلقة النوافذ، لا يدخلها الضوء أو الهواء حتى لا يتمكن رجل آخر من رؤيتهن، وكان عليهن أن ينتحرن إذا مات أزواجهن. وفي الصين كانت تربط أقدام البنات بأشرطة ضاغطة بإحكام، كي تتوقف عن النمو وتبقى صغيرة ناعمة لا تزيد عن عشرة سنتيمترات (حتى وإن كانت مشوهة العظام)، كي تحظى بإعجاب الرجال. وفي اليابان كان خدم الزوج الياباني يشغلون الغرف الأمامية من المنزل فيما تظل النساء في غرف خلفية حتى لا يراهن أحد. وفي عصر الجاهلية العربية كان الأب يقتل بناته خشية الفقر أو العار. وفي أماكن أخرى من العالم، وحتى وقت قريب في القرن العشرين، استخدمت النساء لجر المحاريث مع الحمير والثيران.
لأسرة الأمومية:
لم تكن الأسرة طوال تاريخها أبوية، أي ينتسب فيها الأبناء إلى الأب، بل كانت في فترات غير قصيرة أمومية، ينتسب فيها الأبناء للأم. ومازالت بعض القبائل في أماكن متفرقة من العالم أمومية، تخرج فيها المرأة إلى العمل، بينما يبقى الآباء في المنازل لرعاية الأطفال وإعداد الطعام. وهذا ينفي ما يقال من أن بقاء المرأة في المنزل هو من الأمور الطبيعية.
إلا أن الانتقال إلى عصر المدن لم يقتصر فقط على تمكين الرجل من حكم العالم، بل امتد تأثيره إلى نطاق الأسرة، حيث فرض الآباء سيطرتهم. فثقافة المحراث لا تزال حتى الآن ثقافة أبوية النسب، وأقل من 10 ٪ فقط أمومية النسب. وقد كان تطور نظام الانتساب للأب والاستقرار في داره بدلاً من الانتساب إلى الأم والانتقال للحياة في دارها يشير إلى تدهور ملحوظ في مكانة المرأة. ويرجع السبب الرئيسي في هذا التغير إلى أن الرجال قد اقتلعوا الأساس الاقتصادي لمكانة المرأة، فلم يقتصر الأمر على جعل الزراعة مهنة الرجال، بعد أن كانت المهنة الأساسية للنساء، بل تم حرمان النساء تدريجيًا من أدوارهن المتميزة في الحرف الأخرى، التي كانت ابتكارًا نسائيًا في الأساس. فلقد أصبح الرجال مثلاً هم صناع الفخار والخزف بعد ابتكارهم تكنولوجيا أكثر تعقيدًا. وعندما توسع الرجال في القيام بالأعمال المهمة هيمنوا على المدن المتنامية وصاغوا الثقافة على صورتهم. ويتحدث علماء الأنثروبولوجيا عن النظام الأمومي النسب، والنظام الأمومي المركز، ويقولون أن الجماعة الأمومية النسب هي الجماعة التي يتقرر فيها النسب والميراث عن طريق العلاقة بالأم وليس الأب، كما يحدث في مجتمعاتنا الحديثة. ويقولون عن الجماعة الأمومية المركز أنها الجماعة التي ينتقل فيها الزوج ليعيش مع أهل زوجته بدلاً من انتقالها لتعيش مع أهل الزوج، أو في داره كما هو الحال في مجتمعاتنا الحديثة. ويذهب بعض علماء الأنثروبولوجي إلى أن النظام الأمومي سواء كان الانتساب للأم أو الحلول في دار أهلها، هو الوضع الأصلي للإنسانية.
في العصرين الحجري القديم والحجري الحديث، لم تقتصر مهمة النساء على ضمان استمرار الحياة عن طريق جمع الطعام بشكل منتظم أو استنباته بالزراعة، وإنما كن يخرجن الحياة من أحشائهن، ولابد أن عملية الولادة كان لها تأثير هائل على المجتمعات البدائية. وتشهد الفنون البشرية القديمة على الأهمية التي شكلتها خصوبة المرأة. ويقول هؤلاء العلماء أنه من الجائز جدًا أن الآلهة في أقدم المجتمعات البشرية لم تكن أربابًا بل كانت ربات، وذلك لأن أشد التجارب البشرية سحرًا وغموضًا، وهي ولادة الحياة ورعايتها كانت من عمل النساء، وفي هذا الشأن تقول المفكرة الفرنسية “سيمون دي بوفوار” في كتابها الذائع الصيت “الجنس الثاني“:”أن أهم قيمة في مجتمع الصيد كانت سلب الحياة، وهي عمل الرجال، بينما ظلت وظيفة منح الحياة ورعايتها من عمل النساء“.
وتدل شواهد عديدة على أن العصر الحجري الحديث غلبت عليه الثقافة النسوية، فكانت الآلهة في الغالب من النساء لأنهن مصدر الحياة. وكانت الآلهة الكبرى عند الشعوب الزراعية ربات الأرض، وكان منوطًا بهن إحياء الأرض وإخراج النبات والثمار. لذا ففي بلاد ما بين النهرين، حيث الحضارات السومرية والأكادية والبابلية والآشورية والكلدانية، ظهرت ربات مثل “نیامات“، و“تنهور ساج“، و“عشتار“، كما اتخذ المصريون من “إيزيس” ربة، كذلك فعل الهندوس أيضًا بعبادتهم للربة “كالي“، أما الربة الكبرى عند اليونانيين فكانت الإلهة “ديمترا“.
لكن بعد سيطرة الرجال، حل الأرباب محل الربات، بل لقد أصبحت الآلهة المقترنة بالزراعة مذكرة مثل “أزوريس” في مصر، و“باخوس” في اليونان، وأصبح لرب السماء أهمية أم الأرض. لذا يرى “لويس ممفورد“، أن المدينة نفسها هي النتاج المميز للخصائص الجنسية الذكورية، مثلما كانت القرية في العصر الحجري الحديث تعكس الخصائص الجنسية الأنثوية.
فروق طبيعية أم اجتماعية:
اتضح بناء على العديد من الملاحظات والمشاهدات التي تم جمعها عن سلوك الأفراد والجماعات، أن معظم ما كان يعتقد أنه طبيعي في الفرد أو الجماعة هو في الواقع محصلة لظروف اجتماعية وثقافية، هي التي تعتبر مسئولة عنها. وقد قالت “سيمون دي بوفوار“: “أنا لم أولد امرأة لكن المجتمع هو الذي صاغني على هذه الصورة“. كما وجدت الباحثة الأنثروبولوجية “مرجريت ميد” في ثلاثينات القرن الماضي ضمن دراسات عديدة قامت بها، أن معظم الخصائص السلوكية الحالية للرجال والنساء ليست في الواقع لاختلاف الجنس، وإنما هي انعكاس لأثر الثقافة والتربية على الأفراد، وما كنا نتصور أنه عام عند جميع الشعوب، فيما يتعلق بالفروق الجنسية، وجد أنه ليس كذلك، بل هو خاص بثقافات معينة فقط. وفي محاولتها لإثبات هذا الفرض، قامت “مرجريت ميد” بزيارة “غينيا الجديدة“، حيث اختارت ثلاث قبائل بدائية، وعاشت بينهم لبعض الوقت، وعكفت على دراستهم، وكانت هذه القبائل هي قبيلة “أرابيش“، وقبيلة “مندوجومور“، وقبيلة “تشامبولي“. ولقد لاحظت الباحثة في القبيلة الأولى، أنه لا توجد فروق جوهرية بين سلوك الرجال والنساء، فكانوا يتصرفون جميعًا بنفس الأساليب التي تسلكها النساء في ثقافتنا السائدة الآن. لكنها لاحظت أن الرجال والنساء في قبيلة “مندوجومور” متشابهون أيضًا، لكنهم على عكس قبيلة “أرابيش“، يتصرفون بنفس الأسلوب الخشن والعنيف الذي قد نلاحظه في سلوك الرجال في ثقافتنا السائدة. أما أكثر ما آثار اهتمام “مرجريت ميد“، فهو سلوك الرجال في قبيلة “تشامبولي“، حيث وجدتهم يتصرفون طبقًا لما نتوقعه نحن من النساء في ثقافتنا الحالية، حيث ينفقون وقتًا طويلاً في التزين وفي تصفيف شعرهم، ويتدربون على المشي بالطريقة التي تسير بها النساء في ثقافتنا، ويبالغون في رقتهم، ويقومون بمعظم الأعمال المنزلية، على عكس نساء هذه القبيلة اللائي كن يتصرفن طبقًا لما نتوقعه نحن من الرجال في ثقافتنا الحديثة، فهن اللائي يخرجن للعمل وجمع الطعام وفي علاقتهن بالرجال هن اللائي يأخذن جانب المبادرة.
وهكذا يبدو أن ما نسيمه بالطبيعة الثابتة غير صحيح، وما نسميه كثيرًا بطبائع الرجال وطبائع النساء، ما هو إلا نموذج ثقافي اختص بمرحلة معينة من مراحل تطور التاريخ الإنساني.
-2-
د. أحمد عبد الله
مدرس مساعد الطب النفسي بجامعة الزقازيق، استشاري نفسي بموقع islamonline
سوف أؤكد في مداخلتي هذه على بعض الجوانب انطلاقًا من تخصصي کمدرس مساعد للطب النفسي، وكذلك من واقع خبرتي في مجال الاستشارات النفسية والاجتماعية (Cyber Counseling). فقد أتاحت لي هذه الاستشارات فرصة التعرف على مشكلات نفسية واجتماعية تخص العلاقة بين الجنسين لدى فئات عمرية تتراوح من خمسة عشر سنة إلى ما فوق الأربعين. وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى أن معظم التساؤلات تربط بشكل صريح أو ضمني بين المشكلات والسياق الثقافي السائد، وخاصة الجانب الديني، حيث يفترض السائل أن الإجابة لابد وأن تأخذ في الاعتبار العامل الديني والثقافي. وهذا على وجه التحديد ما أود أن أركز عليه في مداخلتي أو رؤية ما يسمى بطبيعة الرجل والمرأة آخذًا في الاعتبار العامل الديني سواء أطلقنا عليه الثقافة الدينية أو الخطاب الديني.
هل هناك اختلاف بين الطبيعة النفسية للرجال والطبيعة النفسية للنساء؟ سؤال بسيط، ولكنني لم أجد إجابة واضحة المعالم يمكن الإمساك بها وتحديد هذا الاختلاف. صحيح أن النظريات النفسية تعالج مثل هذه الأمور من خلال رصد وتحليل وتركيب ما يسمى بالنفس، ولكن مفهوم النفس ذاته يخضع لرؤى نظرية مختلفة. فتفسير فرويد، على سبيل المثال، يتأسس على فكرة الأنا والأنا الأعلى كما هو معروف. أما طبيعة الاختلاف بين الرجل والمرأة فيؤسسه على فكرة قلق الإخصاء (Castration Anxiety) أي أنه يفترض أن الرجل هو النموذج الكامل والمرأة ناقصة بسبب هذا القلق، ومن هنا يأتي الصراع. ويعتبر الصراع مقولة أساسية في نظرية فرويد بما في ذلك الصراع بين مكونات النفس الداخلية، فمن خلال الصراع يحدث التطور والنمو.
أما في التفسيرات الحالية، نجد أن مقولة التنشئة الاجتماعية تستخدم لتفسير الظاهرة. فمن خلال التنشئة يكتسب كل جنس ملكات تختلف عن الجنس الآخر، ومن هنا تأتي الاختلافات بين الرجل والمرأة. وهكذا تكتسب المرأة ملكات عاطفية في حين يكتسب الرجل ملكات التفكير. والجديد أنه الإعجاب الشديد بملكة التفكير مقابل التقليل من أهمية العاطفة. فالتفكير كما يقال وظيفة عليا للقشرة الدماغية (high cortical)، أما العاطفة فهي ضمن وظائف النفس المرتبطة بالأحاسيس والانفعالات (emotions). ومن هنا تأتي فكرة أن الرجل هو الذي يمتلك ملكة التفكير، وبالتالي فهو الذي يصلح لمهام مثل الإدارة، القضاء، الخ. وحتى عندما يقال أن المرأة أيضًا تفكر، ففي هذا استبطان لفكرة أن التفكير في مرتبة أعلى من العواطف. ولكن بالمقابل ثمة آراء ترى أن العواطف أساسية لعملية التفكير وبدونها يكون التفكير ناقصًا، وبكلمات أخرى فإن إضطراب العواطف يؤدي إلى خلل في التفكير.
وعلى أي حال، ثمة أساطير سائدة حول طبيعة الرجل وطبيعة المرأة. فالرجل هو المعيار، وهذا ما نجده عند أرسطو الذي يحدثنا عن المواطن الرجل قبل فرويد الذي يحدثنا عن استعلاء الرجل. وبما أن الرجل هو المعيار والنموذج الكامل، فكل ما نريده هو أن نحقق للمرأة المساواة مع النموذج أو المعيار، تمامًا كما يحدث الآن على مستوى الأمم، فالغرب هو النموذج الذي ينبغي اللحاق به وتمثّله. وهذا ما نجده كذلك في عدد من تفاسير النصوص الدينية، والتي لو نزع عنها الديباجة الدينية ستبدو وكأنها نصًا يونانيًا أو إغريقيًا. وأضرب مثالاً على ذلك أحد التفاسير الخاصة بالآية القرآنية “الرجال قوامون على النساء“. يقول التفسير أن هذه القوامة والسيطرة نتيجة لتفضيل الله للرجال على النساء بالعقل والحزم والرأي والقوة ونوع العواطف المؤهلة للقوامة والغزو، فضلاً عن الصوم والصلاة والنبوة والخلافة والإمامة والآذان والخطبة والشهادة في الحدود والقصاص ومضاعفة الميراث وملك النكاح والطلاق والنسب وهم أصحاب اللحى والعمائم. وفي الحقيقة أن هذا التفسير يحمّل الآية ما ليس فيها، وأعني بذلك أن المسألة مرتبطة “..بما فضل الله بعضهم على بعض“، والتي يمكن فهمها بأن الله فضل الرجال على النساء بأشياء وفضل النساء على الرجال بأشياء. إن التفسير السابق يصنع من الرجل أسطورة النموذج الكامل والمكتمل، فهو أقرب إلى الرجل الإله أو نموذج الإله في الحضارات الوثنية. إن هيمنة مثل هذه الأساطير نجدها في العديد من الخطابات من اتجاهات مختلفة.
هنا افترض أن ثمة تأثير على الخطاب الفقهي والفكر الإسلامي أكثر بكثير مما يتصور أصحاب الخطاب الديني، فثمة تأثر بالأفكار الوثنية وتأثر بالمسيحية والتي تصور الطبيعة المزدوجة للمسيح، وتأثر باليهودية وكذلك بالأفكار المعاصرة والتي تُدمج في الخطاب الديني ويعاد إنتاجها على هامش تفسيرات ورؤى معينة خاصة بقراءة النص الديني، في حين أن النص لا يحتملها. لقد لا حظت أن الخطاب الديني سواء القديم أو الحديث دائمًا ما يتضمن مصدرًا رئيسيًا(major) وآخر ثانويًا (minor)، بمعنى أننا قد نجد حديثًا مرويًا وقد يكون مشكوكًا في سنده، ولكن يقدم بوصفه حديث صحيح في حين أن مصدرًا آخر قد يكون أكثر قوة ولا يؤكد الحديث. ولعل المثال الذي يوضح ذلك يتعلق بمسألة الختان، فقد نجد أن حديثًا يوصي بالختان، بينما الفعل الواضح للرسول (صلى الله عليه وسلم) أنه لم يختن بناته ولم يأمر أحداً من ذويه بفعل ذلك. فكيف يستقيم هذا الاختلاف بين الفعل والقول منهجيا؟ في هذه الحالة يجب التعامل الفعل بوصفه المصدر الرئيسي، أما النقل عن الرسول فيجب التعامل معه على أنه مصدر ثانوي. وثمة مثال آخر لإيضاح الفكرة، عندما نتحدث عن وجود المرأة في المجال العام، علينا أن نلتفت إلى وقائع ذات دلالة، فثمة حديث شريف شهير يروي دعوة الرسول رماة الحبشة لتقديم عرض ترفيهي في المسجد النبوي، وكانت السيدة عائشة مع الرسول بالمسجد وكان الرسول يقول لها حسبك كفاية وترد معلنة رغبتها في البقاء. إن دلالة ذلك تتمثل في أن الرسول لم يمانع وجود السيدة عائشة، وبالتالي يمكن أن نتفهم من ذلك حق المرأة في الترفيه بوصفه حقًا من حقوق الإنسان وفقًا لظروف زمانها.
وبالعودة إلى موضوع طبيعة الرجل والمرأة، أتصور أن هناك أصلاً بيولوجيا للاختلاف، وكلما اقتربنا من البيولوجي كلما اتضح الاختلاف. فمن المؤكد أن هناك اختلافات تبدأ من الكرموزومات وتتعلق بالهرمونات وكرات الدم الحمراء ونسق العضلات الخ. لا أدري إذا كان هذا اختلافًا في الطبيعة أم لا ولكنه اختلاف واضح، ويصبح الاختلاف أكثر تركيبًا وتعقيدًا كلما ابتعدنا عن البيولوجي واتجهنا نحو الاجتماعي، وقصر الاختلاف على الجانب البيولوجي يعد نوع من التعسف، ولكنني أتصور أنه في المسافة بين البيولوجي والاجتماعي النفسي توجد فكرة الملكات وتربية الملكات من خلال عمليات التنشئة الأسرية والاجتماعية.
ولكن، مع الأسف، فإن فهم هذه الاختلافات يواجه صعوبات حيث أن معظم الدراسات ذات طبيعة إحصائية، أي إجراء دراسات احصائية على مجموعات من الرجال والنساء تنتهي مثلاً إلى أن النساء أكثر تأثرًا بالمؤثرات اللفظية (verbal)، بينما يستجيب الرجال أكثر للمؤثرات العملية (practical). ولكن هذه في النهاية دراسات تتعلق بمجموعات محددة من الرجال والنساء، وغالبًا ما تفتقد إلى الدراسات التتبعية: بمعنى أنه لا توجد دراسات على مجموعة من الأطفال من الجنسين يتاح لهم فرص متكافئة لتربية كل الملكات سواء ما يتعلق منها بالتفكير أو العواطف، واللفظي أو العملي لبيان نتيجة ذلك بعد فترة زمنية. ففي تصوري أن الملكات عند الجنسين قابلة للتطوير بشكل أو بآخر حسب الظروف والأحوال والسياقات التي تتطور فيها. وأتصور أيضًا أن هناك نوعًا من التعميم فيما يتعلق بالاختلاف البيولوجي. فالأسرة هي مجال هذا الاختلاف، لكن ما يحدث هو سحبه من الأسرة للمجال العام. فهذا الاختلاف داخل الأسرة يهيئ لأدوار معينة تتطلب ملكات ومهارات معينة، فالرجل أبا، والمرأة ستصبح أمًا. ومع ذلك فهذا أمر غير ثابت ولكنه يتسم بالدينامية داخل نطاق الأسرة، وهذه الدينامية يصعب معها القول بأن ثمة وظائف لصيقة بالرجل وأخرى لصيقة بالمرأة. فالقوامة على سبيل المثال، والتي هي موضوع شديد التعقيد، ويمارس داخل نطاق الأسرة وفق شروط معينة كالرعاية والشورى، إلا أن ما حدث هو سحب القوامة إلى خارج نطاق الأسرة وتعميمه وهذا أمر في غاية الأهمية ويستحق الدراسة. وباختصار يمكن القول أن الاختلافات البيولوجية مجالها الأسرة، فكلما اقتربنا من المجال الأسري تزداد تجليات الاختلاف البيولوجي، وكلما ابتعدنا عن الأسرة تخف حدة هذه التجليات حتى تنعدم في بعض المساحات.
يضاف إلى ما سبق، ذلك النزوع لتجاهل الفروق الفردية عند كل من الرجال والنساء، وكذلك الاختلافات في المراحل العمرية. فما يحدث هو وضع الرجال في سلة والنساء في سلة، وكأنه لا توجد اختلافات بين الرجال واختلافات بين النساء. ولذا تبدو كلمة الرجال كما النساء كلمات مضللة لأنها لا تشير إلى الاختلافات الفردية. ففي تصوري أن وظائف مثل القضاء أو الإمارة أو الحكم جميعها يخضع لمقاييس معينة ليس الجنس من بينها. وفي علم النفس هناك ما يسمى بالمقاييس النفسية أو مواصفات معينة لبعض الوظائف، وهي تحدد مدى صلاحية الشخص لوظيفة معينة. ويمكن لهذه الاختبارات أن تتكرر في أوقات لاحقة وخاصة قبل اتخاذ قرارات هامة، وهذا ينطبق على الرجال والنساء.
قضية أخرى ينبغي الالتفات إليها، وهي أن ثمة اتجاه نحو العمل الجماعي والشراكة من خلال مؤسسات، فليس الفرد كفرد هو الذي يقضى أو يحكم وإنما المؤسسة، حتى المستبدين أنفسهم يعتمدون على المؤسسات. ففكرة الولاية العظمى بدأت تنتهي إن لم تكن انتهت فعليًا. والعمل من خلال فريق يخلق درجة من التنوع والتكامل بين أكثر من طرف. والتنوع أيضًا يختلف عن فكرة الصراع المستبطنة بشكل أو بآخر في الخطابات السائدة سواء كانت تستخدم ديباجات دينية أو حديثة. بل إن الخطابات النسوية تستبطن هذا الصراع عندما تنظر إلى الرجل باعتباره المركز، وتسعى إلى نزع موقعه المركزي ووضع الأنثى مكانه، وبالتالي لا تكون حركة تمركز حول الأنثى، بقدر ما تكون حركة “استرجال” لأنها تلعب اللعبة ذاتها التي سعت لهدمها.
-3-
د. ملك رشدي
أستاذة علم الاجتماع بالجامعة الأمريكية في القاهرة
سأتناول موضوع طبيعة الرجل والمرأة من زاوية علم الاجتماع، والذي اهتم بقضايا النوع الاجتماعي وتقسيم الأدوار بين الرجال والنساء. وقد بدأ الاهتمام بهذه القضايا داخل حقل علم الاجتماع مبكرًا ومنذ منتصف القرن العشرين، وخاصة بعد الحرب العالمية الثانية، وما تبعها من مشاريع لإعادة تنظيم المجتمعات الغربية بعد الحرب. وكما نعلم فإن اهتمام علم الاجتماع ينصب على العلاقات والنظم الاجتماعية التي تشكل سلوك الفرد، وكيفية مساهمة الفرد في تشكيل هذه العلاقات.
وانطلاقًا من كون علاقة النوع هي جزء لا يتجزأ من العلاقات الاجتماعية السائدة، فقد ظهر داخل حقل علم الاجتماع مفهومان أساسيان ساعدا على بلورة فكرة علاقات النوع، وهما مفهوم الوضع الاجتماعي (social status) والدور الاجتماعي (social role). ويشير هذا المفهوم إلى الأوضاع الاجتماعية المتعددة للفرد داخل المجتمع، فالفرد يكتسب أوضاعًا اجتماعية من خلال النشأة أو من خلال جهده وعمله. على سبيل المثال يمكن للأم أن تكون في الوقت ذاته ابنة وموظفة، ومن خلال هذه الوضعيات المختلفة يجري رسم الأدوار الاجتماعية المختلفة التي يتوقع المجتمع من الفرد أن يقوم بها كأم وابنة وموظفة. وهذا ما يطرح دائمًا السؤال حول ما يتوقعه المجتمع من الفرد عندما يكون في وضع اجتماعي معين؟ فالدور الاجتماعي المتوقع من وضعية المرأة كأم يتمثل في قدرتها على الحب والتضحية ورعاية الأطفال، ولكن في بعض الأحيان عندما يحدث تحول اجتماعي سريع قد تلعب المرأة أدوارًا أخرى في مجال العمل أو المشاركة السياسية. وهنا يستجيب المجتمع لهذا التحول ويظهر درجة من الليونة في التعامل مع دور المرأة كأم من أجل تلبية الاحتياجات الاجتماعية الأخرى. ومن ثم فالمجتمع يقوم بتطويع المحددات التي تحكم هذه الأدوار بحيث يسمح لها بنوع من التفاوض حول الأدوار المختلفة.
وهكذا يعتبر مفهوما “الوضع والدور الاجتماعي” من أهم مكونات البناء الاجتماعي، فمن خلالهما يجري تنظيم الحياة بشكل يمكن التنبؤ به، حيث تتضافر الأعراف والتقاليد والقوانين التي يصيغها المجتمع، وتعمل على الوصول إلى الصيغ السلوكية التي يدخل بها الأفراد في العلاقات مع الآخرين بشكل مقبول اجتماعيًا. وترتبط هذه الصيغ بما نسميه التنميط (stereotype). ويأخذ تنميط الصور الاجتماعية صيغة مبسطة عادة تتبناها عناصر اجتماعية مشتركة فيما بينها، ولكن في كثير من الأحيان يأخذ التنميط صيغًا سلبية يتم من خلالها تبرير التمييز الاجتماعي، ومنها التمييز على أساس الجنس فيما يسمى بالمجتمعات الأبوية والتي تعطي السلطة للرجال.
وبالنظر إلى تناول هذه القضايا من منظور علم الاجتماع، ويشترك في ذلك مع الأنثربولوجيا، سنجد أن لدينا مجموعة من النظريات الأساسية تمثل الأساس الذي يتمحور حوله باقي الاتجاهات النظرية وهي: أولاً، “الوظيفية“، والتي تنطلق من أن المجتمع يشكل نسقًا اجتماعيًا متجانسًا. وعادة ما يطرح الوظيفيون سؤالاً يتعلق بطبيعة المكونات الأساسية للمجتمع والكيفية التي يمكن من خلالها اندماج هذه المكونات في نسق متجانس لكي تشكل منظومة متجانسة. وقد أسهم الوظيفيون في إضفاء بعدًا تاريخيًا على فكرة تقسيم الأدوار الاجتماعية، من خلال دراسة المجتمعات التقليدية ما قبل الصناعية وما تضمنته من تقسيم لأدوار الرجال والنساء. وقد كشفت مثل هذه الدراسات أن الصيد والخروج للمجال العام كان من نصيب الرجال، في حين كان الحيز الخاص والعائلي من نصيب النساء. وهكذا أصبح الرجل هو العائل الرئيسي، مما أدى إلى إعلاء شأن دور الرجل على حساب دور المرأة، وظهرت فكرة التراتبية (stratification) على أساس النوع الاجتماعي، والتي برزت بوصفها حتمية بيولوجية. وفي شكل أكثر حداثة سعت الوظيفية إلى مواكبة التطور الاجتماعي من خلال إعطاء صورة وظيفية عن الأسرة المتوسطة، حيث تعمل المرأة ويكون عملها دورًا مساندًا لدور الرجل الرئيسي، ولكنه في نهاية الأمر دور خاضع. وبهذا المعنى فإن الوظيفية تؤكد تبعية المرأة للرجل من خلال نسق علاقات محدد، أما خروج المرأة للعمل فقد كان سببه ظروف مؤسسية خارجية دفعت المرأة إلى مجال العمل، واضطر المجتمع أن يتقبل الفكرة ويعطيها التبريرات اللازمة. باختصار فقد قدمت الوظيفية تفسيرات جيدة للتاريخ وأصل تقسيم الأدوار في المجتمع ما قبل الصناعي، مؤكدة على أهمية النسق الاجتماعي. ومع ذلك يظل المفهوم الوظيفي غير كاف لفهم المتغيرات التي طرات على العائلة والعلاقات التي تحكمها.
أما النظرية الثانية التي أود الإشارة إليها فهي “نظرية الصراع” (Conflict Theory)، والتي تأسست على الفكر الماركسي، ويعد كتاب إنجلز (Frederich Engels) “أصل العائلة” بمثابة الرؤية المؤسسة لهذه النظرية.
ففي هذا الكتاب يشرح إنجلز كيف أدى الصراع على الموارد إلى انقسام المجتمع – وبالتالي وجود أشكال من عدم المساواة – وأن الملكية الخاصة هي أساس هذا الانقسام. وقد تم تطوير هذه النظرية لتتجاوز فكرة الصراع بين الطبقات وتشمل الصراع بين الأجيال وعلى النطاق العائلي. والمختلف في هذه النظرية أنها، على عكس الوظيفية، تركز على عوامل الانقسام عوضًا عن عوامل التجانس، أي كيف تقوم بعض الفئات الاجتماعية بحماية مصالحها على حساب الآخرين. وقد تمت إعادة صياغة هذه النظرية لتفسير علاقات النوع، حيث تم استبدال مفهوم الطبقات إلى حد كبير، بمجموعة الأفراد الذين تتفاوت فرص حصولهم على الموارد المحدودة، سياسيًا واقتصاديًا. وأوضحت لنا هذه النظرية أبعادًا كثيرة كانت مخفية، إلا أنها متهمة بأنها تنطوي على نظرة تآمرية ضد الرجل، وكان الرجل على وعي تام بفكرة استغلاله للمرأة، ومن ثم يبدو الأمر وكأن هناك مؤامرة تحاك ضد المرأة. هذا في حين أن ثمة قوى غير متعمدة (unintentional forces) تحرك الأشياء.
وثمة نظرية ثالثة لا تقل أهمية، وهي “التفاعلية الرمزية” (symbolic interactionalism). وقد فرضت هذه النظرية حديثًا، وساهمت في تغيير بؤرة النظر إلى الموضوع. فبدلاً من النظر إلى البعد المؤسسي، تم النظر إلى الأفراد وما بينهم من تفاعلات متشابكة في إطار علم النفس وعلم الاجتماع. وإنطلاقًا من محورية مفهوم التفاعل، فإن الإطار الثقافي يحظى بأهمية كبيرة في هذه النظرية. ويجري تحديد الواقع الاجتماعي بوصفه واقعًا يتفق عليه الأفراد من خلال رؤي اجتماعية لمختلف الأدوار، كان يتضمن دور المرأة كأم أن تكون أما حنونة، وعليها أن تتصرف وفق هذه الرؤية. وهكذا يصبح النوع الاجتماعي بمثابة بناء اجتماعي (social construct)، يقوم على اتفاق ضمني بين أفراد المجتمع من أجل تحديد صفات الرجل (الرجولة) والمرأة (الأنوثة). ووفق هذه النظرية، فإن فهم النوع ينبغي أن يتم في إطار التجربة الذاتية التي يمر بها الأفراد، إما بشكل منفرد أو في إطار التفاعلات فيما بينهم. وتهتم هذه النظرية أساسًا بالمعاني التي يعطيها الناس لسلوكهم. ويعد (Erving Goffman) من رواد هذه المدرسة وله اسهامات هامة في إطار رؤيته لتعدد الأدوار على المسرح الاجتماعي داخل النسق الثقافي الجماعي. ومع ذلك فإن هذه النظرية تعاني أيضًا من قصور كسابقتها، ويتمثل قصورها في غياب البعد المؤسسي، والذي يتحكم أحيانًا في العلاقات بين الأفراد، وكذلك البعد التاريخي.
وعلى هذه الخلفية النظرية بدأت حركات نسوية تقدم تأويلات تداخلت فيها نظريات علم الاجتماع والنظريات النسوية، واتخذت هذه الحركات أشكالاً مختلفة. فهناك “النسوية الليبرالية” (liberal feminism) والتي تنادي بالمساواة بين الأفراد بغض النظر عن الجنس واللون، ولكن دون المطالبة بتغيير المجتمع. وبكلمات أخرى فإن مشروع النسوية الليبرالية يمكن وصفه بأنه محاولة لتوفيق الأوضاع والتقليل من حدة اللامساواة بين الرجال والنساء استنادًا إلى مفهوم “التمكين” (empowerment)، مع التأكيد على الخصائص الإيجابية المرتبطة بدور المرأة، كتربية الأطفال والعناية بهم وما إلى ذلك. وهناك كذلك اتجاه “النسوية الماركسية” (socialist Marxist feminism)، والتي تقوم على فكرة أن النظام الرأسمالي يدعم القهر الطبقي، ومن ثم التمييز بين المرأة والرجل، وبالتالي فإن تغيير النظام الرأسمالي يمثل شرطًا لتغيير العلاقة بين الجنسين. وبهذا المعنى فإن النسوية الماركسية توصف بأنها راديكالية. وثمة اتجاه نسوي أكثر راديكالية، والذي ارتبط بحركات التحرر المدنية التي تطالب بأن يجري تقييم الرجل والمرأة كل بمعاييره الخاصة، وأن على النساء خلق حيزهن الخاص والعام وفقًا لمعاييرهن. كما أن هناك الاتجاه “الأندروجيني” (androgynous)، والذي يرى أن ثمة مشترك بين الرجال والنساء، فالرجل يمكن أن يكون عاطفيًا ويبكي إذا ما شاهد موقفًا مؤثرًا، كما يمكن للمرأة أن تكون قاسية وعملية، فكلاهما يمتلك الخصائص ذاتها. ولكن التمييز يتم على أساس اجتماعي، أي من خلال بناء “الذوات” اجتماعيًا، ولكن هذا البناء الاجتماعي يمكن تفكيكه وإعادة بنائه. وأخيرًا هناك الاتجاه الذي أولی اهتمامًا بمفهومي “الأبوية” (patriarchy) و“الذكورة” (masculinity) وتشير معظم الدراسات الذي أنتجها هذا الاتجاه النظري أن فهم قضايا المرأة يأتي عن طريق فهم “الأبوية” و“الذكورة“. ففي أحد الإسهامات النظرية لهذا الاتجاه يجري تصور المجتمع من خلال نموذج ذكوري مهيمن (hegemonic masculinity)، تخضع له ذكورة وأنوثة (femininity) تابعة ويجري تدعيم الذكورة المهيمنة بأشكال نمطية نجدها مثلاً في الإنتاج السينمائي من خلال شخصیات مثل سيلفستر ستالون، رشدي أباظة، فريد شوقي، همفري بوجارد، وهي تقوم بالأساس على النموذج المتغاير جنسيًا (heterosexual ideal)، بما يتضمنه من قوة بدنية وغير ذلك من مظاهر الرجولة النمطية. ويرى هذا الاتجاه أن فهم وضع المرأة لن يتم بدون فهم الوضع الاجتماعي للرجل وفهم العلاقة بينهما، وكذلك الطبيعة المتغيرة والدينامية لكل من الذكورة والأنوثة. وثمة مثال على ذلك لشخص يدعى “جيمس ماركس” كان يتمتع بسمات الرجولة النمطية ونجح في تسلق الجبال ووصل إلى قمة إفرست، ولكنه تحول وأصبح امرأة، وألف كتابًا عن تجربته هذه يقول فيه:
“يقال إن الفاصل الاجتماعي بين الرجل والمرأة في تراجع، ولكني أود أن أقول أنني مررت بتجربة المرأة والرجل معًا في النصف الثاني من القرن العشرين، ووجدت أنه لا تمر على لحظة دون أن أشعر بفارق في التعامل بين كوني رجل وكوني امرأة. فنبرة الصوت التي أواجه بها، وضع الجسم الواقف أمامي في الصف، المناخ العام في الحجرة أو المطعم الذي أدخله، كل هذا يؤكد دائمًا على تغير هويتي. وكلما اختلف رد فعل الواقف أمامي كلما اختلف رد فعلي. وكلما تعامل الناس معي على أني امرأة كلما أصبحت امرأة وتأقلمت مع وضعي الجديد. كلما اعتقد الناس أنني غير قادرة على فتح زجاجة نبيذ أو رفع حقيبة من على الأرض وجدت نفسي غير قادرة على هذا الفعل. إنه ليضحكني مثلاً عندما أدعى على العشاء في مطعم أن أتذكر كيف كان النادل يعاملني: كان يقابلني بمنتهى الجدية والاحترام أما الآن فهو يبتسم لي ويفرد المنشفة أمامي مداعبًا ويتوقع أن أرد عليه بالمثل وهذا ما أقوم به“.
وفي ختام مداخلتي إن السؤال المطروح دائمًا من قبل معظم الباحثين بشأن الاختلاف بين الرجل والمرأة يركز على ما إذا كان هذا الاختلاف ثقافيًا أم بيولوجيًا. لا أحد ينكر الاختلاف البيولوجي، ولكن هذا الاختلاف هو علامة ولا ينبغي أن يكون سببًا للتمييز. وهنا أؤكد على مفهوم البناء الاجتماعي، بمعنى أن الذكورة والأنوثة هي “بنى” اجتماعية بالأساس. كما أشير أيضًا إلى مفهوم آخر، وهو إضفاء الطابع الاجتماعي على النوع (gender socialization)، أي عملية التنشئة التي تقوم على تقسيم أدوار نمطية بين الإناث والذكور. ولفهم كل هذا نحن في حاجة إلى ربط الواقع بفكر نظري، والاستفادة من الإنتاج النظري الموجود، وحتى نغير واقعنا علينا أن نفهمه ونفسره لبناء رؤية واضحة حول هذا الواقع.
-4-
د. هبة رؤوف
مدرسة العلوم السياسية كلية السياسة والاقتصاد بجامعة القاهرة
طلبت ورقة الدعوة، أن يقدم كل متحدث مقاربة من منظور التخصص (discipline)، ولذا سأتحدث من منطلق تخصصي الأساسي وهو “النظرية السياسية“. إلا أنه تخصص يتقاطع مع الفلسفة السياسية أو فلسفة السياسة كعلم قابل للتفنيد والاختلاف معه، أو حتى التكذيب. وأنا أؤيد هذا الاتجاه الأخير، لأن العلم كعلم كان قد تحول في وقت من الأوقات إلى مطلق في حد ذاته (scientism)، مع تراجع الفلسفة والأيديولوجية والدين. لكن أنا ضد فكرة أن يتحول العلم إلى معيار، بحيث يصبح كل ما هو ممكن مباح، بدون مرجعية أو ضوابط.
رغم أن موضوعنا هو طبيعة الرجل وطبيعة المرأة، لكن في حقيقة الأمر هذا الموضوع فرعي، لأن انشغالي الأساسي الآن هو “الطبيعة الإنسانية” (human nature)، وهو مفهوم اعتبره في صميم تخصص العلوم السياسية، أو في قلب الفلسفة السياسية منذ نشأتها، لأن ببساطة تحديد كنة طبيعة الإنسان هو الذي حدد ما إذا كان يحتاج إلى دولة وقوانين ومؤسسات أم لا. وكذلك للفلسفة السياسية علاقات وثيقة بالعلم والتاريخ.
كنت قد قاربت “موضوع المرأة” من خلال دراستي في الماجستير عن المرأة والسياسة في الرؤية الإسلامية وخاصة مسألة ولاية المرأة، لأن معظم دعاة فصل المرأة عن المجال العام يستند إلى فكرة أنها ذات طبيعة مختلفة، وكان من الضروري أن أفهم كيف يفكر العقل الفقهي وأثر الثقافة عليه والمنهجية التي أسسها واتبعها. ومع ذلك من خلال التنقيب في هذه المصادر الفقهية والإسلامية الأولى قابلتني أمثلة دالة؛ مثلاً المجتمع النبوي الأول لم يكن متحيزًا من حيث “الجندر” (gender)، ولم يكن الرسول (صلى الله عليه وسلم) يميز بين أحفاده وحفيداته في المعاملة، وكان في “مهنة أهله“. وهذه ليست مرجعيات دينية، بل مرجعيات تاريخية وثقافية. أيضًا فكرة بيعة الرسول السياسية والحربية للنساء (فلم يبايعهن على الطبخ مثلاً)، وأخبار النساء اللاتي حاربن ودافعن عنه في الغزوات وحملن سيوفًا ثقيلة وبعضهن نجون، وهكذا. دعونا أيضًا نتذكر ما كتب في التاريخ حول اختلاف نساء مكة ونساء المدينة، واختلاف الثقافتين والمجتمعين (two different communities). وأنا أفهم وأوافق على فكرة أن الثقافة تؤثر وتغير في السلوك، وأن الإنسان يتغير في ثقافته، وحتى الدين الإسلامي تعامل مع الثقافة السائدة في حينه من منطلق تغيير أشياء، ولكنه استبقى أشياء أخرى، وراعي مسألة الفروق الفردية بين الناس وداخل كل مجموعة من الجنسين (التي تحدث عنها د. أحمد عبد الله).
وهذه النقطة تقودنا مرة أخرى لمسألة الطبيعة الإنسانية: هل هناك طبيعة إنسانية أصلاً أم لا؟ هناك من يحول هذه الطبيعة إلى ناموس ثابت (fixed) وأرى أن ذلك ضد مقاصد الشريعة، لأن الاجتهاد في جوهره هو إدراك لفكرة التغيير، ولكن على أرضية قاعدية (base) معينة بدون سقف. وأعتقد أن القرآن الكريم زودنا بمفاهيم أساسية قاعدية نسترشد بها مثل الفطرة، وربط الفطرة بكل الناس وليس المؤمنين فقط.. هناك إذا فطرة إنسانية مشتركة، يخلق الله عليها البشر، بغض النظر عن الأديان والجنس، وهذه الفطرة ليست بيولوجية جسمانية أو مادية، فهذا هو الاشتراك الأساسي بصرف النظر عن أي اختلافات أخرى. لم يفخر الرسول (صلى الله عليه وسلم) يومًا بأنه ذكر، بل قيل أنه كان “أشد حياءًا من العذراء في خدرها“. ومن اللافت للنظر، أن الثقافة السائدة في ذلك الوقت (أي ما وصلنا من المصادر في حينها) وصفته بهذا الوصف، ولم يستهجن المصدر سحب وصف حياء العذراء على الرسول. وفي نفس الوقت، لم يستحي الرسول أن يبكي، أو يعلن حبه للسيدة خديجة، وسمى الوقت الذي عاشه معها “زمن خديجة“، فنسب الزمن إليها. وهكذا اعتبر أن مثل هذه الأمثلة الصغيرة دالة على فكرة الطبيعة المشتركة للإنسان أو الفطرة الأساسية.
أما مسألة سحب القوامة داخل الأسرة على الولاية العامة، فهذا خطأ فقهي، لأن القوامة داخل المنزل لها وظائف وشروط محددة ومقيدة، وقد تنتقل قضائيًا من الرجل إلى المرأة في حالات معينة، إلى آخره. لكن ولاية الحيز العام، فيجب أن تتسم بالمساواة والأهلية والكفاءة.
من هنا أريد أن اتعرض لمسألة الانقلاب على المتضادات في المفاهيم والبناء الثقافي: مثلاً كان قد أطلق علي مسمى (familist)، أي الاعتقاد في مفهوم “العائلة” والتمحور حوله، بدلاً من أن أكون “نسوية” (feminist). وردي أنه يجب أن يكون – كما أشرت سابقًا هناك أرضية واحدة انطلق منها، وإلا لن يتبقى شئ من مفهوم الطبيعة الإنسانية الأساسية، إذا عملنا على التفرقة بين عنصريها: لا نستطيع أن نعتبر الإنسان مادة فقط ولا يجوز تجاهل أو التقليل من شأن الأبعاد الأخرى للطبيعة الإنسانية مثل العاطفة، فليس هناك ما يعيب أن يكون الإنسان أي إنسان – عاطفيًا.
هناك مشكلة في فهمنا الحالي لمكانة وقيمة الطبيعة الإنسانية بسبب المنظور العلمي البحت، فالعلم يتقدم بسرعة مذهلة ويفتح آفاقاً ومساحات لم تكن متاحة، وهناك اعتقاد بأن الدين لم يستجب لهذا التطور، فهو رجعي ومتخلف. مثال على ذلك مسألة “تأجير الأرحام“، التي تتجاهل أي بعد أخلاقي ديني، أو حتى “رؤية اشتراكية” ممكن أن تسمي هذا النشاط رأسمالية لا إنسانية، وتجارة بالجسد الأنثوي. والمحير أن هذه الحالة بالذات ممكن أن يجيزها المنظور النسوي، فيعتبرها إرادة حرة وحرية شخصية وحق الفرد في جسده. كذلك حرية تغيير الجنس، فهذه كلها ممارسات بدأت تظهر على السطح من نفس المنطلق: عدم الخضوع إلى أي اعتبارات أو قيود غير الإرادة الشخصية المنفردة، وتحول الرغبة إلى قانون، أو إلى مرجعية في حد ذاتها. ماذا تبقى إذًا من الطبيعة الإنسانية الأصلية، وعلى أي شئ تبني؟ إذا لم يكن أساسها (base) الدين والأخلاق فماذا إذًا؟ إذا اعتبرنا أن الهوية مرتبطة بالزمان والمكان والمساحة والإرادة الإنسانية الاختيارية، التي ليست بالضرورة أن تكون عقلانية أو أخلاقية، فما جوهرها الثابت إذًا؟ هل هذا هو الطريق الذي نريد أن نسير فيه: طريق اللامرجعية واللاثبات واللاأساس، حتى لا يكون هناك سبيل للتراجع؟ هل طريق العلم البحث (بدون مرجعيات وضوابط) هو الخلاص؟
من مفارقات حركة التحرر النسوي، أنها بدأت لتحرر الجسد – العنصر المادي المتبقي من الطبيعة الإنسانية – وانتهت إلى أنها أصبحت أسيرة لهذا الجسد، ومعاييرها هي معايير الجسد. فالآن الحرية التامة أو المواطنة الكاملة، هي أن يصبح الفرد “مثليًا“، ويتم الاعتراف بالحق في “المثلية” (homosexuality)؛ بعد أن انطلقنا في البداية من تحليل طبائع الرجال والنساء والمطالبة بالعدالة والمساواة، وصلنا إلى حق وحرية الناس في التعبير عن هويتهم الجنسية، مما يجعلنا نتساءل عن الثمن المدفوع لهذا المسار، وعن السيناريوهات المستقبلية.
-5-
د. سحر صبحي
أستاذة مساعدة بقسم اللغة الإنجليزية في جامعة القاهرة
سأحاول من خلال مداخلتي هذه مقاربة الموضوع من زاوية مختلفة، فقد طُلب مني أن أقدم عرضًا تاريخيًا لفكرة طبيعة كل من الرجل والمرأة، ومن أجل الوصول إلى ذلك، سوف أقدم عرضًا تاريخيًا سريعًا لظهور ونشأة فكرة “العنصرية“. في اعتقادي أن مفهوم “العنصرية” وثيق الصلة بما نثيره حول طبيعة الرجل والمرأة، خاصة وأنه يرتبط بقوة بمفهوم التحرر. وتنطوي فكرة العنصرية على أحكام إزاء مجموعات معينة انطلاقًا. الشكل الخارجي أو الطبيعة البيولوجية، حيث يجري وضع أفراد مجموعة اجتماعية معينة في سلة واحدة، وإضفاء أحكام قيمية عليها. وقد تصبح هذه المجموعة أسيرة هذه الأحكام، مما يعوق القدرة على التحرر من الطريقة التي يجري من خلالها من تصور المجموعة.
وفي هذا السياق سوف أطرح وبشكل سريع نشأة وتطور الخطاب العنصري في الغرب. وسوف أبدأ من ألمانيا عام ١٨٠٠ عندما ظهر كتاب “موجز تاريخ الإنسان (“Outline of the History of Man”) للفيلسوف الألماني “هيردر” (Johann Gottfried von Herder). يعتبر هذا الكتاب من أول الأعمال التي ربطت بين تقدم المجتمع وشكل أفراده، وتقوم نظرية “هيردر” على أن كل ثقافة هي نتاج بيئتها، حيث تتأثر بعوامل المناخ والطبوغرافيا. وقد تطورت الحضارات من خلال إسهام كل المجموعات البشرية، حيث لعبت كل مجموعة دورًا في فترة زمنية محددة، ثم تقلص دورها لينتقل الإرث الثقافي لمجموعة أخرى، وهكذا. وعلى الرغم من اعترافه بإسهامات الحضارات المختلفة إلا أنه رتبها بشكل تطوري زمني، ليصل في النهاية إلى قمة الحضارة والتحضر والمتمثلة في العصر الأوروبي الحديث. وكان “هيردر” أول من ربط بين الإنتاج الثقافي لمجتمع ما ولون بشرة أعضاء هذا المجتمع. فقد فسر مثلاً البشرة السوداء باعتبارها علامة على التقهقر الحضاري، ففي رأيه أن الإنسان يولد أبيض اللون ثم يكتسب السمرة بسبب المناخ والتخلف الحضاري، ومن هنا يجرى التأكيد على العلاقة بين العوامل البينية ومستوى التحضر. ويضيف أن الطبيعة عوضت المجتمعات المتخلفة بخصائص حسية، فالمجتمعات البيضاء المتقدمة، هي مجتمعات عقلانية، أما المجتمعات السوداء فهي مجتمعات حسية غرائزية.
وبعد “هيردر” (Johann Gottfried von Herder) جاءت كتابات الأنثروبولوجي الإنجليزي “جيمس بريتشارد” (James Cowles Pritchard) والذي ألف أول كتبه عام ١٨١٣، وأصدر آخر كتبه في الخمسينيات من القرن التاسع عشر، وهذه الفترة بكل تأكيد تعد مرحلة حرجة في مجال السياسة الأوروبية على وجه الخصوص. وقد حاول التوفيق بين فكرة التطور ولون البشرة، ولكن، على عكس “هيردر“، فقد اعتبر أن الإنسان يُخلق ببشرة سوداء ثم يكتسب البياض مع تطوره الحضاري، وبالتالي فإن الحضارة المتطورة هي حضارة بيضاء. وإذا كانت نظرية “بريتشارد” تضع اللون الأبيض في مرتبة أعلى، إلا أنها فتحت المجال أمام شعوب للتحضر، بشرط تمثل الحضارة الأوروبية البيضاء. ومن ثم فقد دعا إلى السيطرة على الشعوب الملونة حتى يتمكن الرجل الأبيض من أن يضفي عليهم الحضارة واللون الأبيض.
وتواصل الإنتاج النظري الأوروبي في هذا المجال، حيث جاء كتاب “روبرت لاثام” (۱۸۱۲–۱۸۸۸) (Robert Gordon Latham) الشهير (“The Natural History of the Varieties of Man”) عام 1850 والذي قام بتدعيم اتجاه نظري كان سائدًا، حيث التحول من الحكم على الشعوب من خلال “علامات تجريبية” (empirical signs) إلى صيغة يبدو أنها علمية، وترتكز على العلوم المرتبطة بدراسة الجمجمة (Phrenology). وهكذا انتقلت العنصرية من لون البشرة إلى خصائص الجمجمة التي هي بيت المخ. فمن خلال شكل ومقاس وحجم الجمجمة يمكن الحكم على الشعوب وتصنيفها. وفي هذه النظرية أيضًا استعادة القسمة بين العقل الذي يحتل مرتبة عليا والحس الذي يحتل مرتبة دنيا. وخلص إلى أن العنصر الأبيض يتمتع بحجم مخ أكبر، بينما يتسم الملونون ببروز الفك وغلظة الشفاة، وهي علامات حسية. وقد راجت هذه المدرسة رواجًا كبيرًا بعد أن أضفت مشروعية على العنصرية من خلال ربطها بالعلم. وكان هذا بمثابة نقلة نوعية في الخطاب النظري العنصري.
وبالانتقال إلى فرنسا، نجد نظرية هامة أسسها “جورج كوفييه” (1768 – ۱۸۳۲) (Georges Cuvier) صاحب الكتاب الشهير “نظرية الأرض” ۱۸۱۲. الجديد في هذه النظرية أنها كانت ترى أن ثمة أصول متعددة للبشرية، على عكس فكرة الأصل الواحد في النظريتين السابقتين، حيث نقل قصة بداية الخليقة من آدم إلى نوح. وتسمى هذه المدرسة بـ“الكارثية” (catastrophism) إشارة إلى الكوارث الطبيعية التي تعرضت لها الأرض، وظهور الجنس الآري بعد ذلك في آسيا. ولكن هذا لم يمنع من وجود مخلوقات أخرى من نبات وحيوان في أماكن أخرى، وكذلك وجود الزنوج في أفريقيا، حيث لم يكن لهم علاقة بالجنس الآري البازغ من جديد. وقد حظيت هذه المدرسة بشهرة واسعة وتتلمذ على يد “كوفييه” مجموعة أخرى من المنظرين منهم الإنجليزي “روبرت نوكس” (Robert Knox)، والأمريكيين “جورج مورتون” (Samuel George Morton)، و“جوسيا نوت” (Josiah C. Nott). ويعتبر نوكس الذي درس في فرنسا من أشد المروجين لفكرة الحتمية كما جاء في كتابه (The Race of Men) حيث أكد على تعدد الأصل، وعلى أن عنصر والوراثة هو كل شئ، وهو الذي يدمغ الشخص بطابعه. وكان لـ“نوكس” أثر كبير، فمن تلامذته “جيمس هانت” (James Hunt) والذي شغل منصب رئيس الجمعية الأنثروبولوجية في لندن. والأنثربولوجي الرحالة الشهير “ريتشارد بيرتن” (Richard Burton).
وتختلف نظرية المدرسة العنصرية العلمية عن نظرية المدرسة العنصرية الإنسانية، في أن الأولى تؤكد على ثبات القسمة العنصرية وأزليتها. ومن هنا جاءت أفكار استحالة الخروج من التكوين البيولوجي، واستحالة تقدم الملونين، وحتمية بقائهم تحت سيطرة العنصر الأبيض. وبناء عليه فقد نادت هذه المدرسة بالفصل بين العنصرين في كل المجالات الاجتماعية وتوزيع الأدوار بين أدوار قيادية وأخرى تابعة. وفي إطار هذه المدرسة راجت فكرة “التعدد الجيني” (poly-genetic) – خاصة في الولايات المتحدة – في الخمسينيات والستينيات من القرن التاسع عشر. ومضمون هذه الفكرة هو تعدد الأصول البشرية، ومن أهم مؤسسيها “جوسيا نوتس” (Josiah C. Nott).
وبالطبع قد كان وراء هذه النظريات دوافع سياسية تبرر التوسع الاستعماري الأوروبي باسم نشر الحضارة. أما في الولايات المتحدة فقد راجت فقط نظرية “التعدد الجيني” لإثبات الطبيعة اللإنسانية للملونين، وبالتالي عدم استحقاقهم لأية امتيازات ينص عليها الدستور الأمريكي بوصفهم غير منتمين للبشرية، وهكذا كان ممكنًا استبعاد تطبيق الدستور على زنوج الجنوب.
ومع ظهور نظرية التطور لداروين تم وضع حد للجدل القائم بين مدرسة العنصرية الإنسانية ومدرسة العنصرية العلمية. فقد حلت نظرية التطور بعض نقاط الاختلاف بين المدرستين وكانت أهم النقاط التي ارتكزت عليها هذه النظرية ربط الهوية النوعية والقدرات بالتركيب البيولوجي. وهكذا ظهرت منذ الستينيات، نظريات علمية تسعى لإثبات الوضع الأدنى للمرأة مقارنة بالرجل، بما يسمح بهيمنة الرجل على نفس النسق الذي تم من خلاله بناء النظريات العنصرية. وقد تم استعارة نظرية التطور في كل مجالات العلوم الاجتماعية، ورسم خط تطوري مجتمعي على غرار خط التطور البيولوجي، فتم دمج الاجتماعي بالطبيعي.
وأخيرًا أشير إلى “أوجوست کومت” (Auguste Comte)، ونظرية “الفلسفة الوضعية” (positive philosophy)، فقد قال إننا بدأنا نرى في تركيب العنصر الأبيض بعض صفات التفوق الإيجابية، حيث يلاحظ أن ظروفًا فسيولوجية وكيميائية وبيولوجية ساهمت في جعل الدول الأوروبية أنسب وأقدر على أن تكون مشهد الحضارة العليا. وفي الكتاب ذاته قال أنه بمقارنة جنس النساء بجنس الرجال، فإن التحليل البيولوجي يظهر أن النساء كعنصر بشري في حالة طفولة أبدية. وهذا التصور مبني على نوع من التطور يقسم المجتمعات إلى ثلاثة مراحل هي:
(1) Material Phase. (2) Ritual Phase. (3) Golden Age.
وبالتالي فإن الوضع البدائي والطفولي للنساء يجعلهن بعيدات كل البعد عن النواحي الهامة للشكل النموذجي للعنصر البشري.
وباختصار أقول أن هناك ضرورة لكشف الارتباط بين خطاب التفرقة على أساس النوع والخطاب المرتبط بالتفرقة العنصرية. أي ما هو التاريخ المشترك بينهما، وإلى أي مدى؟ وما هي الأسباب التي قد تجعلنا نرفض التفرقة العنصرية ونقبل بالتفرقة على أساس النوع؟














