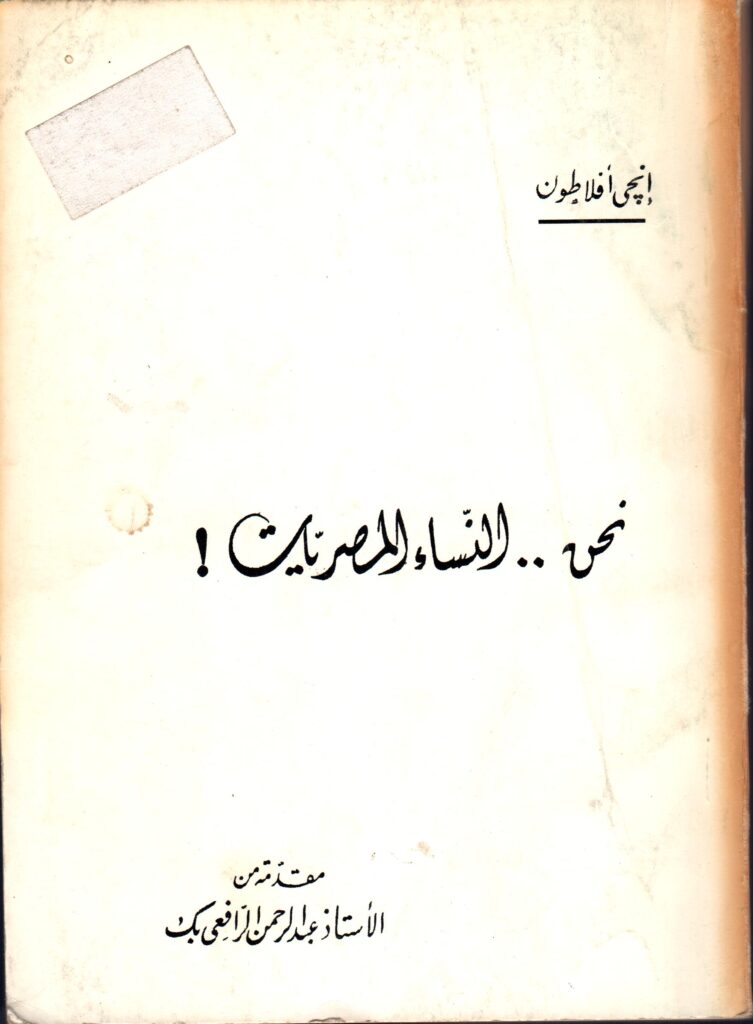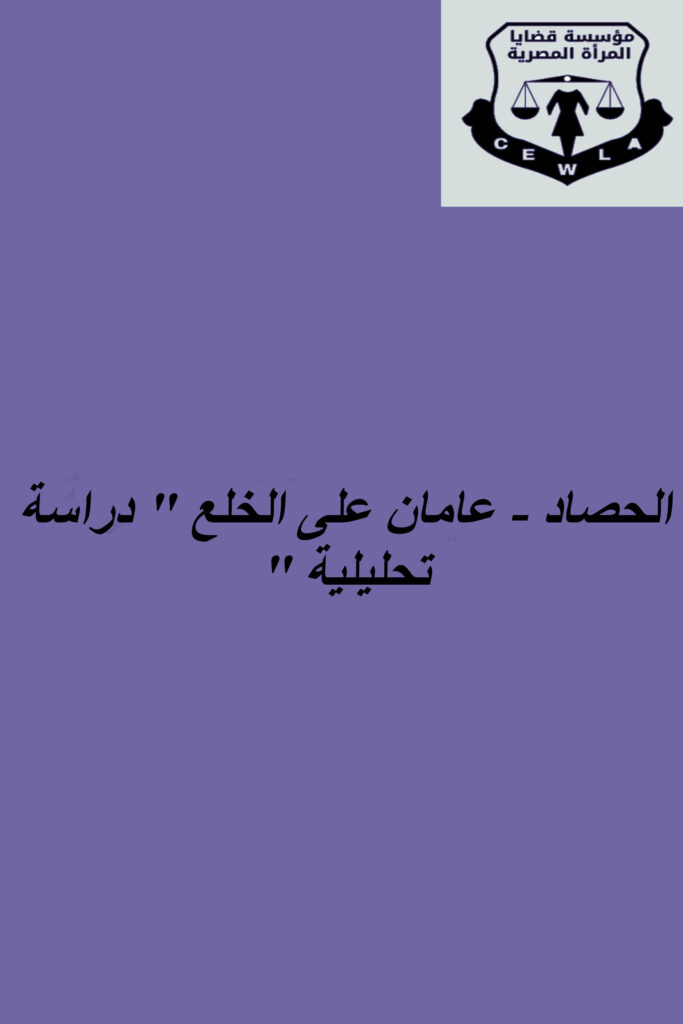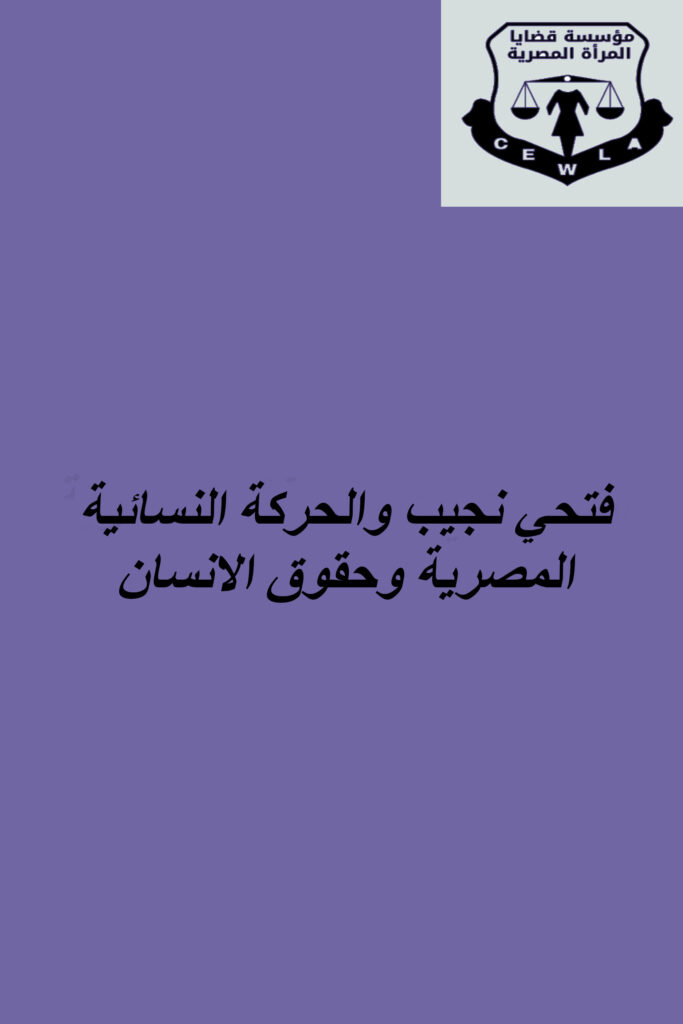نحن.. النساء المصريات!
مقدمة
عائشة التيمورية.. زينب فواز.. هدى شعراوى.. ملك حفني ناصف.. نبوية موسى.. درية شفيق.. منيرة ثابت.. إنجي أفلاطون.. لطيفة الزيات… ثريا أدهم.. نساء قدمن الكثير، بقوة نفسية وقناعة فكرية لم تسمح لأصوات معادية أن ترهبهن. نساء جاسرن بالكلام حين كان الكلام محرما على المرأة.. نساء بادرن بالثورة على أوضاعهن والمطالبة بحقوقهن.. نساء انخرطن في العمل السياسي النابع من أرضية فكرية صلبة ورؤى تشمل رجال ونساء المجتمع.. نساء نستلهم منهن ومن أفكارهن قوة وحجة.
لماذا إنجي أفلاطون؟ هجرت مجتمعا مترفا ورفضت أن تبقى في برج عاجي بلا دور, أرادت أن تعيش وقد عاشت بحق: دافعت عن المهمشين وانضمت لهم، خاضت تجربة الهرب والسجن والاعتقال والإضراب عن الطعام, رسمت لوحات تعبر عما تراه وتعيشه، وقدمت نتاجا فكريا.. إنجي أفلاطون جمعت بين النضال والفن والفكر.
وعام ١٩٤٩ سجلت رؤيتها لقضية المرأة فى هذا الكتاب الذي نفخر بإعادة طبعه وتقديمه للقراء عام ۱۹۹۹.
إنه من المفرح والمحزن فى آن أن نقوم بإعادة طبع“نحن النساء المصريات” فهو حدث مفرح لأن فيه إعادة إحياء لفكر مناضلة قدمت حياتها في سبيل رفعة المرأة والوطن وإنه لمن دواعي الفخر أن نلتقى مع رؤية وفكر إنجى أفلاطون إذ أن خطابنا النسوى يكاد يكون مشابها لخطابها ورؤيتها المعرفية. أما المحزن فهو أننا – لازلنا – وبعد مرور خمسين عاما نجاهد في طرح هذا الخطاب وكأن نصف قرن لم يكن كافيا. لا شك أن هناك تغييرات حادثة وملموسة فيما يخص قضية المرأة وأبرزها حصولها على حق الترشيح والتصويت وازدياد نسبة تعليم المرأة ولكن يبقى الكثير من الأشياء ثابت لا يتغير وهي الحقوق التى لازلنا نجاهد من أجل الحصول عليها والتي تناولتها إنجی أفلاطون في هذا الكتاب.
ورغم أن مهمتنا واضحة ومحددة وهى إدراج الرؤية النسوية على أجندة المجتمع وصناع القرار إلا أنه أحيانا ما يتم تشتيت هذا التركيز بفعل التهمة ومن هنا التي تُلقى علينا جزافا وتبـاعـا وهى أننا تابعات فكريا للغرب وذلك في محاولة لفصلنا عن المجتمع الذى نعمل فيه ومن أجله. ومن هنا تنبع أهمية أخرى لهذا الكتاب فهو يدحض هذا الاتهام ويجعله واهيا ويعطينا فرصة الاستمرارية والتواصل مع من قبلنا وتمهيد الطريق لمن بعدنا وكما تقول إنجى أفلاطون“لن يستطيع أحد أن يوقف عجلة الزمن“.
مركز دراسات المرأة الجديدة
إلى نساء مصر…
إلى الملايين العشرة التي تكوّن نصف هذا الشعب… إلى المرأة المصرية.. فلاحة وعاملة وموظفة.. صبية وزوجا وأما..
* * *
وإلى كتابنا الأحرار.. قاسم أمين.. والرافعى وطه حسين وسلامة موسى وخالد خالد ومظهر.. الذين رددت أقلامهم أصداء ضمائرهم الحرة، دون الأهواء والمادة والأغراض !
* * *
وإلى الحركة النسائية الفتية…
إلى المدافعات الحقيقيات عن قضية المرأة المصرية، دون الهاويات والمتملقات، وذوات الأصباغ والمغانم الشخصية, والزاحفات إلى الوراء…
* * *
إلى المرأة المصرية…
وإلى أنصار ونصيرات المرأة المصرية…
أهدى هذا الكتاب،،
إنجي أفلاطون
المرأة نصف المجتمع: حقيقة أزلية كانت ولم تزل أساس الإنسانية منذ خلق الله آدم وخلق معه حواء. وهى القاعدة الأولى فى إقامة صرح الحضارة وتكوين الأمم والممالك وتطورها، ونهوضها وتقدمها. وهى أيضا أساس الحياة العائلية في المجتمعات الراقية، ولا تستقيم أوضاع هذه الحياة ولا تؤتى ثمرها إلا إذا كانت المرأة شريكة الرجل فيها حقا, شركة معنوية وروحية وقانونية ومادية. وما الحياة العائلية إلا صورة للحياة الاجتماعية عامة. فلا ينهض المجتمع إلا بنهوض الحياة العائلية، ولا يتقدم إلى الأمام إلا بتقدم الرجل والمرأة على السواء وتعاونهما وتضامنهما في القيام بالأعباء العائلية ثم العمل على رفعة شأن الوطن وسعادة المواطنين جميعا، رجالا ونساء كبارا وصغارا، شيبا وشبابا.
ومن أجل ذلك وجب علينا أن نعمل على تقدم المرأة كما نعمل على تقدم الرجل، وأن نعترف لها بمكانتها في المجتمع ونقر لها بالمساواة بينها وبين الرجل في الحقوق المدنية والسياسية. وإذا كنا موقنين بأن تقدم المجتمع يقتضى تقدم الرجل والمرأة معا وأن الوطن في حاجة إلى تعاونهما ومساهمتهما في تلبية ندائه، والنهوض بأعبائه، فعلينا نحن الرجال أن نعترف للنساء بحقوقهن السياسية. أما حقوقهن المدنية فهي معترف بها من قبل، وإنما يجب علينا صيانة هذه الحقوق ورعايتها فعلا واستكمال ما ينقص تشريعنا في هذه الناحية، وخاصة فيما يتصل بنظام الطلاق وتعدد الزوجات.
فيجب إصلاح هذا النظام بحيث يكفل للمرأة حقوقها وإنسانيتها ويصون كرامتها ومصالحها.
يطيب لي في هذا المقام أن أنوه بكتاب السيدة“إنجي أفلاطون” فهو دفاع قوى متين عن حقوق المرأة المصرية ودعوة صادقة إلى النهوض بمستواها لكي تتبوأ المكان اللائق بنصف المجتمع المصرى. وفي الحق أنه دفاع موفق مؤسس على دراسات علمية وبحوث مستفيضة وإحصاءات دقيقة. فهو ليس وليد الارتجال والعبارات الطنانة والنظرة السطحية بل هو نتيجة إحاطة شاملة وتفكير عميق، مصوغ فى أسلوب شيق ممتاز. وإني لأشاطر آراءها إجمالا وأرى أن على الرجال أن يعترفوا للمرأة بحقوقها كاملة في الحياة العائلية, والحياة الاجتماعية, والحياة السياسية، وأن يكون اعترافهم عن طواعية واقتناع لا عن تورط أو مجاملة. ولعمرى أن دراسة هذه المسألة دراسة بحث وتمحيص جديرة بأن تقنع كل مفكر بشرعية هذه الحقوق، وبأن تقريرها يزيد الأمة تكتلا ومناعة, وقدرة على الكفاح والنضال القومي. وييسر لها سبل التقدم في شتى النواحى: الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
ولقد أحسنت المؤلفة الفاضلة صنعا بدراسة حقوق المرأة من الوجهة العلمية والتاريخية، ثم من الوجهة التشريعية، فأبانت عن مبلغ احترام الشريعة الإسلامية لهذه الحقوق إذا أخذنا بالصحيح الثابت من مبادئها وأحكامها, وتركنا الدخيل عليها. ولا غرو فالشريعة التى قررت استقلال المرأة الاقتصادي، وخولتها الحقوق المدنية التي للرجل في المعاملات، وأقرت ولايتها مناصب القضاء ومشاركتها الرجال في أعباء الجهاد وفي إبداء الآراء في الشئون العامة, لا يمكن أن ينسب إليها الحيلولة دون تقرير حقوقها السياسية طبقا للنظم والأوضاع المدنية. فإن ولاية القضاء هى بلا مراء أرفع شأنا من حق الانتخاب والترشيح لعضوية البرلمان. هذا إلى ما تميزت به الشريعة السمحاء من المرونة ومسايرة التطورات الاجتماعية مما عبر عنه عباقرة الفقه الإسلامي بالسياسة الشرعية. فالشريعة التي تصل إلى هذا الحد من التطور والمرونة تبعا لضرورات الزمان والمكان لهى أبعد الشرائع عن هضم حقوق المرأة والغض من مكانتها.
إننا ننشد التقدم للأمة المصرية. ولا تسير الأمة قدما في سبيل التقدم إلا إذا شمل أفرادها جميعا من رجال ونساء.
ديسمبر سنة ١٩٤٩
عبد الرحمن الرافعي
اليوم يدور فى مصر جدل عنيف حول حقوق المرأة بين فريقين رئيسيين: الفريق الذي يؤيد المساواة بين المرأة والرجل في المجتمع، والفريق الذي يعارض هذه المساواة. وتحيط بكل من هذين الفريقين شيع تختلف فيما بينها على مدى التأييد أو مدى المعارضة.
وإذا كانت الصحف والمجلات حافلة بالمقالات المعبرة عن هذه الآراء المختلفة المتباينة، فإنها مازالت على كثرتها بعيدة كل البعد عن تحليل أوضاع المرأة في المجتمع المصرى الحديث تحليلا علميا واقعيا ناطقا. بل هي تدور كلها حول مسائل رئيسية أو فرعية ليست مدعمة بالحقائق أو مؤسسة على الواقع الملموس.
ولست أدعى أن واجب الصحافة هو القيام بهذا التحليل العلمي المدعم بالحقائق والمؤسس على الواقع الملموس. فهذا واجب الكتاب لا الصحفيين. وإنما أعبر هنا عن حاجة الأدب المصرى الواقعى إلى دراسة علمية واقعية لأحوال المرأة المصرية ومشاكلها ومطالبها، يمكن أن تسدى بعض العون في هذا الجدل العنيف الذي يدور اليوم حول حقوق المرأة، ليكون جدلا واقعيًا صحيحًا.
وإن هذا المؤلف الذي أقدمه اليوم إلى القراء ليس إلا محاولة سريعة ومساهمة متواضعة في هذا البيان. فهو لا يرمى إلى إثارة مشكلة المرأة التي تشغل الأذهان فعلا, بل إلى تقريب المرأة المصرية وظروفها وأحوالها من أذهان القراء وإعطاء صورة أقرب إلى الحقيقة – بقدر الإمكان – من واقع المجتمع المصرى.
ولا ريب أن هذا الكتاب لن يروق في أعين أعداء المرأة الذين قال عنهم المرحوم قاسم أمين – بحق – إنهم أعداء الديمقراطية وأعداء التقدم! كذلك لن عنهم يروق هذا الكتاب فى أعين بعض اللواتي يدعين الدفاع عن حقوق المرأة المصرية ولسن فى واقع الأمر إلا ظلالا لأعداء المرأة يترسمن خطاهم إلى الوراء، فهن الزاحفات إلى الوراء، والباحثات عن المناصب والمغانم الشخصية الأنيقة!!
فأما أعداء المرأة السافرون فهم أولئك الذين يجهرون بنداء“المرأة للبيت“!
ونداء“المرأة للبيت” من غير شك نداء فيه كثير من الإغراء ويدعو إلى كثير من التفكير وتقليب الرأى, حين يقابله من جانب أنصار المرأة ذلك النداء المعروف“تحرير المرأة“. ولكن هذا كله ينبع من اللعب بالألفاظ الذي يجيده أولئك الأعداء. فنداء“المرأة للبيت” لا يؤدى فى حقيقته وجوهره إلا إلى تحطيم البيت وتشريد المرأة والأطفال والرجل معا. ذلك أنه يعنى اعتبار المرأة خادمة في البيت لا صلة بينها وبين المجتمع الذى تعيش فيه، لا تدرى عنه شيئا، ولا تساهم بشئ في تدبير أموره وعلاج مشكلاته! يعني إخضاع المرأة لسلطان الرجل إخضاعا تفنى به شخصيتها وكرامتها وآدميتها، ويحرم المجتمع من جهود النصف من أعضائه! يعنى حرمان البيت من سيدة كاملة الشخصية كاملة الوعى بحقوقها وواجباتها إزاء أسرتها وإزاء المجتمع، قادرة على جعل الأسرة نواة صالحة سعيدة لمجتمع صالح سعيد!
ولكن ليس يكفى هذا الرد إفحاما لأعداء المرأة فالسبيل الأجدى لرد کیدهم هو مواجهتهم بالحقائق الساطعة والأرقام الناطقة، وهو الأمر الذي ينقص أدبنا المصرى الواقعي.
وهذا هو هدف الكتاب:
بقيت كلمة لابد منها لتوضيح توقيت الكتاب. فالشعب المصرى يقف اليوم على أبواب الانتخابات العامة الجديدة ليختار نوابه وممثليه في الحكم. ومادام هذا الاختيار هو المظهر الرئيسى من مظاهر النظام الديمقراطي، فإن من حق المرأة المرأة المصرية على الناخبين والنواب معا أن تطالب في فاتحة العهد الجديد بالاعتراف بحقوقها المهضومة استكمالا لمبادئ الديمقراطية والنظام التمثيلي.
وأرجو أن يحقق الكتاب هدفه من المساهمة في إقناع الرأى العام وذوى الأمر بعدالة مطالب المرأة، وتحريرها من القيود التي تكبلها في حياتها الخاصة والعامة، حتى تنضم مصر إلى ركب الدول التي أقرت للمرأة حقوقها ومساواتها بالرجل ركب الحضارة الحديثة,
إنجي أفلاطون
دراسة حقوقها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية
نتناول في هذا الباب دراسة وضع المرأة المصرية في المجتمع. وسوف نرى من هذه الدراسة كيف أن منزلة المرأة المصرية في المجتمع المصرى تقل كثيرًا عن منزلة الرجل فيه، وكيف أن المرأة المصرية ضحية أبدية للتقاليد البالية والأفكار الرجعية التى لا تتفق مع ما بلغته المرأة المصرية في تطورها من تقدم ورقي.
وسوف نقسم الكلام فى هذا الباب إلى أربعة فصول رئيسية. فنبدأ بدراسة المرأة في بيتها أى بين أسرتها, صبية وفتاة ثم زوجة وأما. ونرى كيف أنها واقعة دائما تحت سيطرة الرجل, أبا أو أخا أو قريبا أو زوجا، تتألب عليها التقاليد والقوانين معا، فتمنح الرجل سلطة كاملة تقيدها بالأغلال وتعوقها عن ركب المدنية المتطورة.
ثم ننتقل إلى دراسة وضع المرأة المصرية كعضو من أعضاء المجتمع المصرى، والدور الذي تلعبه في الحياة الاقتصادية والثقافية والسياسية، فنرى كيف تحرمها التقاليد والقوانين من كثير من الحقوق التي أبيحت للرجل, وكيف تطورت المرأة المصرية وتقدمت فى ميدان الثقافة والعلم، وباتت تلعب دورا هاما في الحياة الاقتصادية والثقافية.
إن أبلغ تعبير يصف الوضع الحقيقى للمرأة في الأسرة المصرية هو ذلك المثل الصعيدى المشهور“لا تخرج المرأة من بيتها إلا مرتين، عند زواجها وعند وفاتها“. فالمرأة المصرية سجينة دائما، لا تبرح سجنا إلا لتدخل آخر، تخرج من سجن أسرتها إلى سجن زوجها، ومنه إلى سجنها الأبدى – القبر.
وهكذا يمكن أن توصف المرأة المصرية بعبدة الرجل. فهي – فتاة – خاضعة للأب أو الأخ أو القريب. وهى – زوجة – خاضعة للزوج، هي تابعة للرجل دائما، عالة عليه، تأتمر بأمره وتنفذ مشيئته في الصواب وفي الضلال.
أما مبادئ الثقافة والتعليم التى تعطى للمرأة فيغلب عليها طابع واحد ظاهر, هو إعدادها لتكون خادمة في البيت, خادمة على قدر تافه من الثقافة تقوم بأعباء البيت الشاقة دون كلل أو شكوى، وتواجه الواجبات الضخمة التي تفرضها عليها حياتها الزوجية مع سيدها الجديد.. الزوج. هذا هو المثل الأعلى الذي يتبعه الآباء عامة في إعداد بناتهم وتثقيفهن.
ولكن تطور التعليم والثقافة في العصر الحديث جذب الفتاة المصرية لأول مرة إلى مواجهة العلوم والآداب والتاريخ, وفتح عينيها على عالم جديد يختلف تماما عن دنياها الضيقة المحدودة الآفاق، وأنار لها السبيل إلى أن تعمل وتكسب رزقها حتى لا تبقى عالة على الرجل، وتشعر بكيانها شخصيتها كعضو له قدره ومكانته من أعضاء المجتمع, كفرد كامل لا يستمد وجوده من رجل آخر أيا كان هذا الرجل, وإنما من شخصيته المستقلة وثقافته ومواهبه ودوره الذي يؤديه في حياة المجتمع.
ولكن التقاليد التي مازالت تسيطر على عقلية الآباء وقفت حائلا بين الفتاة وهذا النوع من التثقيف والتعليم، وساعدت هذه التقاليد عوامل أخرى – سوف يأتى شرحها في موضعها – على حرمان الفتاة المصرية من هذا المجال الذي أنتجه التقدم الاجتماعي، وعلى توجيهها إلى ذلك التعليم الأولى المحدود أو التعليم النسائى الخاص بالتدبير المنزلى وأشباهه.
وهكذا نشب كفاح مرير بين التيارين, تيار التقدم الذي فتح للمرأة المصرية آفاق جديدة في سبيل المساهمة الفعالة فى حياة المجتمع الاقتصادية والثقافية والعلمية بل والسياسية, في سبيل التحرر من ربقة الرجل وتنمية مواهبها وثقافتها وإمكانياتها، وتيار الرجعية الذى يدفع بالمرأة إلى التخصص في الخدمة المنزلية وإبقائها سجينة البيت لا تدرى عن المجتمع الذي يضمها شيئا فتفنى شخصيتها في شخصية سيدها المطاع، الأب أو الزوج أو غيرهما، وتكيت مواهبها وإمكانياتها ويحرم بذلك المجتمع من جهود النصف من أعضائه.
أما أي التيارين تكون له الغلبة فى هذا الكفاح المرير، فهذا أمر يتوقف على عزيمة المرأة المصرية ووعيها وكفاحها، وعلى مقدرتها وذكائها ونجاحها فيما اتخذته من رسالة تؤديها في المجتمع.
ويجب أن نسجل أنه حتى في الحالات التي أخذت فيها بعض الأسر المصرية ترسل فتياتها إلى مدارس التعليم العام على قدم المساواة مع الرجال تحت تأثير الاتجاه المتقدم، أو جهدهن ومثابرتهن، بقيت الفتاة مهددة بالقيود التقليدية التي تحفل بها حياتها في الأسرة، والسلطة المطلقة التي يتمتع بها ولى أمرها, تلك القيود وتلك السلطة التي إن لم تحرمها كلية من التعليم وتلزمها عقر دارها وتبقيها سجينة كما كانت, فهى كفيلة بأن تفسد تعليمها وحياتها معا، بما تخلقه من تناقض خانق بين اتساع آفاقها الثقافية والعلمية وضيق آفاقها المنزلية وكبت مواهبها وتقييد حريتها، تناقض يعطل تطورها ويعوق تكوينها العلمى والنفسى، وبذكرها على الدوام بأنها – مهما تعلمت – تابعة للرجل عالة عليه، تفنى شخصيتها في شخصيته، وأن مكانها في المجتمع ليس سوى ظلا للرجل.
أما في الريف، فعلى الرغم من العمل الذي تقوم به المرأة في الزراعة والمسئوليات الضخمة التى تتحملها أكثر مما تتحمل غيرها من نساء المدن, فإنها غارقة في الخضوع لسيطرة الرجل أكثر من نساء المدن. ويرجع هذا من جهة إلى تأخر الريف الذى يسوده الجهل والتقاليد البالية، ومن جهة أخرى إلى أن الأغلبية الساحقة من الفلاحات (وتبلغ نحو أربعة ملايين امرأة) تشتغل دون أجر في حقل الأب أو ولى الأمر أو الزوج كما تشتغل في البيت. فهي دائما تابعة للرجل سواء قبعت في عقر دارها أو اشتركت في العمل الزراعي، هي دائما خادمة له في البيت أو في الحقل، أو فيهما معا كما هو الحال الغالب.
ويتمتع الرجل فى الريف بسيطرة مطلقة لا حد لها على المرأة حيث تسود بقايا الحجاب (وخاصة فى الصعيد)، وفكرة تفوق الرجل على المرأة، مما يزيد في سوء حالتها وإهدار شخصيتها. فلا يباح للمرأة في الصعيد أن تتناول الطعام إلا بعد أن يفرغ الرجال من طعامهم، أو أن تمشى إلى جوار زوجها أو من في حكمه بل يجب أن تسير خلفه. وويل للمرأة الريفية إذا بادلت رجلا غريبا عنها الحديث أو ضعفت علائم احترامها وتقديسها لولى أمرها.
فإذا انتقلنا إلى مشكلة زواج الفتاة لاحظنا أن الأمر الغالب فيه تدخل الرجل في اختيار شريك حياتها. أما الحالات النادرة التي يباح فيها للفتاة اختيار شريك حياتها بمحض إرادتها فهى أثر من آثار تطور التعليم والتقدم الاجتماعي، تبدو في الأسر التي تشربت شيئا من الأفكار الغربية، أو نتيجة لكفاح الفتاة نفسها من أجل مزاولة حقها في اختيار زوجها المستقبل، ذلك الكفاح الذي ينبع غالبا من حصولها على قدر من الوعي والتعليم، أو على استقلالها الاقتصادى فى كسب عيشها بعملها، أو على كليهما معا.
وفيما خلا هذه الحالات القليلة – التي تتزايد بتطور التعليم والتقدم الاجتماعي المطرد – يتمتع ولى الأمر بسلطة مطلقة في اختيار شريك حياة المرأة, إما ابتداء، بأن يكون له وحده الحق في الاختيار دون أن يسمح للفتاة حتى“بالجرأة” على الاقتراح أو التحبيذ أو الاستنكار، أو انتهاء، بأن تكون له الكلمة الأخيرة، حتى ولو أبيحت للفتاة” جرأة” الاقتراح أو التحبيذ أو الاستنكار.
وفي الحالتين لا يتوقف الاختيار على إرادة الفتاة أو موافقتها أو رفضها، بل على إرادة الأب أو ولى الأمر عموما. ومن الطبيعي – بالتالي – ألا يستوحى ولى الأمر اختياره من التوافق والتفاهم والتقارب والانسجام بين الزوجين المستقبلين، طالما أن إرادة الفتاة لا وزن لها في الاختيار بل يستوحى فيه آراءه الشخصية ونظرته إلى قيم الأشياء، وأحيانا – أهواءه ومصالحه الخاصة. وهكذا نجد أن الأساس الذى يرتكن إليه الزواج – في أغلب الحالات هو“المال“. فأول ما يدور فى خلد الرجل عند النظر إلى طالب الزواج هو ثروته أو مركزه الاجتماعي. ناهيك عن الاعتراضات التقليدية التي تثور حول أسباب تافهة لا تمت بصلة إلى جوهر العلاقات الزوجية المتينة، كما هو الحال إذا كان طالب الزواج من أسرة غير عريقة المجد – والمجد في مصر هو الثراء لا غير – أو كان قد سبق له الزواج أو كان أرملا أو مطلقا له أطفال، أو ليس موظفا في الحكومة… إلخ.
ولا يجب أن نغفل أن هذه العقلية السائدة في مسألة اختيار الزوج قد أثرت على الفتاة المصرية والشاب المصرى معا. ويقع على كليهما نصيب من المسئولية فى استمرار هذه النظرة إلى الزواج باعتباره“صفقة تجارية” رابحة. فالفتاة التي تنطوى مثلها العليا على العثور على زوج ثرى أو ذى مكانة ملحوظة في المجتمع، دون نظر إلى صفاته الشخصية أو احتمال التقارب والانسجام بينهما – حتى تلك المتعلمة الواعية والمتمتعة بحق الاختيار كما هو الحال في الأسرة الكبيرة مثلا – تدعم هذه العقلية التجارية السائدة, العقلية التي – هي نفسها – أولى ضحاياها. والرجل الذي يسعى وراء فتاة ثرية أو من أسرة ذات نفوذ تمهد له سبيل الصعود وتفرش طريق مستقبله بالورود والرياحين، أو يوافق على أن يشرك فى حياته زوجة لم يؤخذ رأيها فيه أو لم يؤخذ برأيه فيها، يدعم هو الآخر تلك العقلية التجارية السائدة، ويساهم في إهدار شخصية المرأة وحريتها ومستقبلها.
ولا عجب – وهذا هو الأسلوب الغالب في التزاوج – أن نشهد في كل يوم عشرات المآسى الناجمة من بناء الأسر على هذا النحو الممقوت، عن الجمع بين أشخاص لا تربطهم رابطة سوى“المال“. إن شأن هؤلاء هو شأن من يبنى على الرمال!
لا عجب أن يؤدى هذا الأسلوب الفاسد إلى انحلال الحياة الزوجية وتصدع الأسر. ونحن نلمس هذا كل يوم في أنباء الخيانات الزوجية والزنا والطلاق وتعدد الزوجات وغير ذلك من المظاهر المحزنة التى تهده كيان الأسرة المصرية وتطعنه في الصميم.
وحتى في هذه المظاهر التى تميز انحلال الأسرة وتصدعها, نرى القانون الوضعى والتقاليد تتيح للرجل فرصا سانحة تيسر له الانطلاق وراها دون قيد يوقفه ولا رادع يرده إلى الصواب، ويمسك عن المرأة حتى فرضتها في الدفاع عن نفسها وعن بيتها وعن كرامتها. فإذا ما أغفلنا جانبا أن القانون الوضعي والتقاليد لا تقف من الرجل الفاسد والمرأة الفاسدة موقفا واحدا، ولا تسوى بينهما فى المعاملة, وأنها تشجع الرجل الفاسد فى فساده وتنزل بالمرأة الفاسدة أشد العقاب, هالنا أن نلاحظ هذا القانون وتلك التقاليد تحرم المرأة من أوليات الحرية الشخصية أو تقيدها تقييدا شديدا، حريتها الشخصية في أن تخلص من شقائها فى ظل زوجية يشاركها إياها رجل فاسد عربيد، سول له فساده أن يستغل ثغرات القانون الوضعى وجمود التقاليد السائدة في أن يقوض دعائم الأسرة ويجلب إليها النكد والشقاء.
إن هذه المظاهر التى سوف نسردها حالا واحدا بعد الآخر, هي الدليل الناطق على ضعف بناء الأسرة المصرية. وهى الجانب البغيض في الحياة الزوجية والذي امتدت إليه فكرة عدم المساواة، فزادت الظلم الرازح على أكتاف المرأة المصرية أضعافا وأضعافا.
أولا: تعدد الزوجات: كثر الكلام حول مشكلة تعدد الزوجات بين المؤيدين والمعارضين. ولسنا هنا في معرض التكرار لما قيل وما يقال، بل يعنينا في هذا المجال أن نشير إلى الرابطة الوثيقة بين تعدد الزوجات وجوهر مشكلة المرأة في مجموعها. فالرجل الذى يستغل الإباحة (الظاهرة) في أن يضيف إلى بيته زوجة ثانية وثالثة ورابعة – لا يستطيع بحال أن يعدل بينهن – إنما يهدم بيت الزوجية من أساسه ويقوض دعائمه ويجعل من المرأة أداة لهو عارض ومتعة زائلة.
هنا يطيب لنا أن نتأمل في وجوه أولئك الذين يدعون إلى فكرة“المرأة للبيت” وأن نسألهم فى تهكم وسخرية: أى بيت تقصدون ؟! أین“البيت” یا أنصار“المرأة للبيت“؟!
أهو بيت الحياة المشتركة الوادعة المخلصة, يرتبط فيها الرجل والمرأة برباط وثيق من الحب والتعاون والأبوة والأمومة، في سبيل إقامة أسرة وطيدة الأركان دائمة الكيان؟!
أم هو بيت المتعة المؤقتة العارضة، الذى توضع فيه المرأة كالسلعة المشتراة أو كالأمة المستباحة، يقبل عليها الرجل حينما يشاء الإقبال، ويدبر عنها حينما يعتريه السأم ويشاء الإدبار، ليقبل على غيرها من السلع والإماء ؟
أي بيت هذا الذى تلقى فيه الزوجة هوانا على هوان, ومذلة فوق مذلة تفترسها آلام الغيرة, وتعصف بها أهواء الرجل ونزواته العربيدة ؟!
إن أنصار“المرأة للبيت” الذين يستبيحون تعدد الزوجات إنما يحطمون البيت ويهدمونه، ويقتلعون جذور تلك الشركة المقدسة التي تربط الرجل بالمرأة والتي تسمى الزواج، ويبدلون التنابذ بالتعاطف، والتنازع بالتقارب والتفاهم، ويجعلون من البيت ميدانا لمعركة كبرى بين عدة نساء تحارب كل منهن الأخريات من أجل الرجل المشترك!! ثم يدعو هؤلاء السادة المرأة إلى أن تقبع في البيت شقيقة بالمآسى التي تهدد حياتها وأولادها, تعسة بذلك السيف المسلط على عنقها.. الزوجة الأخرى.. أو الزوجات الأخريات!
ناهيك عن الأضرار الأدبية والاقتصادية والاجتماعية الأخرى، فقد أفاض غيرنا في سردها وشرحها. أما هذا الذى أشرنا إليه فهو جوهر المشكلة ومضمونها الرئيسي. ولنا عود إلى الموضوع.
ثانيا: الطلاق: حديث معاد. تلك العبارة الرهيبة في بساطتها وتفاهتها, الرهيبة في مضمونها وجوهرها والتي تربط مصير المرأة ومستقبلها وآمالها وأطفالها بلسان زوجها حين ينطق قائلاً“اذهبي فأنت طالق“.
يطيب لنا هنا أيضا أن نسأل أنصار“المرأة للبيت” عن هذا البيت الذي يعنون, حين يباح للرجل أن يحطم البيت بعبارة تجرى على لسانه دون قيد ولا رقيب.
ويكفى أن نستلفت أبصارهم إلى مثال من الحياة الواقعية تعبر عنه زوجة بائسة – أو بالأحرى زوجة سابقة – على صفحات مجلة المصور.
“… أنا زوجة عاشرت زوجى ثمانية وعشرين عاما وخلفت منه أولادا، وتدرج في عهد هذه الزوجية من مناصبه الصغرى إلى مناصبه العليا حتى أصبح“شيئا مذكورا“. وشاءت أريحيته ومروءته بعد هذا العمر الطويل أن يطلقني طلاقا نهائيا وأن يفصلني من خدمته كما يفصل المستخدمون“الظهورات” أو كما يفصل العمال أو الخدم – غير أن هؤلاء لهم قوانين تحميهم وتقرر مكافآتهم عن مدد خدمتهم على أساس السنين والمرتبات… أما نحن“الزوجات“”والأمهات” فحسبنا عند القضاء الشرعى نفقة عام واحد على غير أساس حسابى… اللهم إلا ما تقدره المحكمة…
“إن النقابات تدافع عن أعضائها وتتدخل المحاكم أو وزارة الشئون لإنصاف هؤلاء الأعضاء. أما نحن الزوجات والأمهات فلا قانون لنا ولا نقابات ولا وزارة شئون, مع الفارق الكبير بين موظف أو عامل لا تربطه بالوظيفة أو العمل إلا روابط المادة، وبين“زوجة وأم” تربطها بالبيت والأسرة الروابط الروحية.
“أترى يا سيدى أن عدلكم الوضعى عدل؟ أو أن نظرتكم إلى الزوجة والأم نظرة؟ وأن اهتمامكم بالبيت المصرى ومصيره اهتمام؟“.
وكأنى بهذه السيدة توجه حديثها إلى أنصار فكرة“المرأة للجحيم” لتكشف عن حقيقة ذلك الزعم الباطل الجرىء الذى يسترون خلفه, حين يبيحون للرجل حق الطلاق مطلقا من كل قيد أو رقيب، وهو عبارة“المرأة للبيت“.
على أننا نستلفت أنظار هؤلاء السادة إلى حقيقة أخرى تنطق بها الأرقام في الإحصاءات الرسمية, معبرة عن مصير هذا“البيت” المزعوم الذي يريدون أن تنصرف المرأة من أجله عن الحياة الاجتماعية والسياسية والثقافية.
ففي سنة ۱۹۳۹ حدث ٥٢٤٢١ طلاق فى مقابل ۱۸۳۸۲۳ زواج
وفي سنة ١٩٤٠ حدث ٥٤٢٢٨ طلاق فى مقابل ۱۹۹۸۳۱ زواج.
وفى سنة ١٩٤٢ حدث ٦٨٠٥٥ طلاق فى مقابل ٢٢٦٥٧٦ زواج
فأما المرأة التعسة فليس لها هذا الحق المطلق في تقويض الأسرة. وما كان لها بطبيعة الحال أن تطالب بهذا الحق الشرير, الذى وصفه الرسول بقوله (إن أبغض الحلال عند الله الطلاق). فالمرأة وهى غالبا قد أجبرت على معاشرة زوجها إجبارا, لا تستطيع أن تتخلص من حياتها المشتركة مع زوجها إلا في حالات قصوى حصرها القانون. على أن الواقع في التطبيق العملي للنصوص القانونية يسد أمام الزوجة السبيل إلى الخلاص من زوج يسومها الخسف والهوان ويجعل منها سجينة مسلوبة الحرية أبدا.
هذا هو الطلاق في الأسرة المصرية المسلمة، سيف مسلط في يد الزوج على رأس الزوجة ومستقبلها وأطفالها, يلوح به ويستخدمه متى شاء، فيطيح بالأسرة، وأمنية بعيدة المنال للزوجة بالرغم من شقائها وبأسائها.
ثالثا: الزنا: قد لا يعرف الكثيرون أن القانون الوضعى المصرى يبيح الزنا للرجل. وإذا قلنا يبيحه فالأجدر بنا أن نقول يشجعه ويحبذه. وليست هذه الإباحة سوى تطبيق منطقى لعدم المساواة بين الرجل والمرأة، وللاجحاف الشديد بحقوقها وكرامتها وشخصيتها. فالرجل الذى لا يكتفى بشراء أربع إماء يشبع فيهن نزواته وأنانيته, أو يعجز عن استيفاء هذا العدد المباح من الإماء, يستطيع أن يتخذ العشيقات والخليلات وقتما شاء وأينما شاء.
مرة ثالثة نستلفت أبصار أعداء المرأة لنجابههم بهذه الحقيقة البشعة وهذا الظلم الفادح. أليست هذه الحياة الزوجية التى يدافعون عنها، والعلاقة“المقدسة” التي ينهرون المرأة حين تطالب بتطهيرها من شوائبها الدنيئة؟ هذا هو البيت الذي يعنونه حين يرددون عبارتهم الجوفاء“المرأة للبيت” البيت الذي يحشر الرجل فيه زوجاته العديدات بل إماءه ومتعاته, البيت الذي ينسفه الرجل بعبارة من فيه لا معقب عليه فيها من رقابة أو تقييد، يخونه الزوج حين يسوله شيطانه الخيانة دون خشية من جزاء أو عقاب.
فالقانون المصرى يبيح الخيانة من جانب الرجل بشرط واحد فقط، وهو أن يخوضها في غير بيت الزوجية – وأرض الله واسعة!
ولنترك القانون نفسه يتحدث. وكأنه حين يتلو أحكامه يتوارى خجلا من أنانية الرجل الصارخة! فالمادة ٢٧٤ من قانون العقوبات تقول:
“المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين“
وهذا شئ جميل! فالقانون يأخذ الفاسدة من النساء أخذا عنيفا رادعا. وأما الفاسد من الرجال فهو الذى تعنيه المادة ۲۷۷ حين تقول:
“كل زوج زنى في منزل الزوجية.. يجازى بالحبس مدة لا تتر مدة لا تزيد على ستة شهور“.
إذن الفاسد من الرجال – في عرف القانون – ليس الزاني في أي مكان, وإنما من يذهب به الفجور إلى حد ارتكاب فعلته فى منزل الزوجية. أليست أرض الله واسعة؟
ولكن الأمر لا يقف عند هذا الحد. فالفاسدة من النساء تواجهها عقوبة الحبس مدة قد تصل إلى سنتين، أما الفاسد من الرجال – بل الفاسد الفاجر الذي ذهب به الفجور إلى ارتكاب الزنا فى منزل الزوجية – فالعقوبة التي تواجهه لا تتجاوز ستة شهور.
هل نبالغ حين نقول إن القانون المصرى يبيح للرجل الزنا، بل يشجعه، بل يحبذه ؟
وهذه هي المناقشة التى دارت بين أعضاء مجلس النواب حين نوقش هذا القانون.
أشير إلى المادة ۲۷۷ ونصها:
“كل زوج زنى غير مرة في منزل الزوجية بامرأة يكون قد أعدها لذلك وثبت عليه الأمر بدعوى الزوجة المذكورة بجازى بالحبس مدة لا تزيد عن ستة شهور أو غرامة لا تتجاوز عشرة جنيهات مصرية“.
“حضرة النائب المحترم الأستاذ إسماعيل سليمان حمزة – أرى أن تحذف من المادة عبارة” تكون قد أعدها لذلك“، إذ أنى لا أفهم أن شرط الإعداد هو الذي يؤدى إلى العقوبة. فافرضوا أنه وجدت امراة عرضا في منزل الزوجية وتمكن الزوج من الزنا بها. فهل يقال إنه لا يعاقب لأنه لم يعد هذه المرأة لذلك الغرض؟
إذا قلنا بعدم العقاب فكأننا فوتنا قصد الشارع. ومادام قد ثبت أن الرجل ارتكب جريمة الزنا غير مرة وجب رفع القيد الثانى. ولا أرى إذن ضرورة لعبارة“تكون قد أعدها لذلك“، وأطلب حذفها.
“معالى النائب المحترم مكرم باشا عبيد” – إنى أوافق حضرة الأستاذ إسماعيل حمزة على اقتراحه وأزيد عليه اقتراحا برفع عبارة“غير مرة“. وفي الواقع إن الرجال قساة جدا أيها السادة لأنهم هم الذين يشرعون لأنفسهم. وإنى أنضم لحضرات النواب الذين تكلموا عن الدين، لا لأننا نطبق الدين على الدنيا، بل لأن الدين هو مثلنا الأعلى. وكل منا يرجو أن تنتشر الفضيلة بين الناس ونتمكن في المستقبل من معاقبة كل أنواع الزنا مهما كانت ظروفه, وحياتنا الاجتماعية الحالية تجعل الشارع يتردد عند تقرير عقوبة الزاني ولا يمكن أن يصل التشريع الوضعى إلى مستوى التشريع السماوي، وليس معنى هذا أن الشريعة الغراء أو الشرائع الأخرى قاسية في عقوبتها لأن الواقع إنه يجب أن يعاقب الزاني أيا كان وفى كل حالة. ولكن الاعتبارات الاجتماعية كما قدمت هي التي تجعل الشارع يتردد في العقوبة. على أنه في الوقت نفسه لا يجوز أن نسمح صراحة للرجل أن يزنى من غير عقاب ويزنى بحضور امرأته أو في منزل الزوجية. فهو إن فعل ذلك كان فاسقا غير جدير بالرأفة، ووجب على الشارع أن يوقع عليه العقوبة التي يستحقها وأغلب ظني أن هذا أقل إنصاف منا كرجال للفضيلة ذاتها وللمرأة ذاتها. (تصفيق) ولذلك أوافق على عبارة“غير مرة” و“امرأة تكون قد أعدها لذلك” الواردتين بالمادة.
“حضرة النائب المحترم الأستاذ إسماعيل سليمان حمزة” – أقترح حذف عبارة” أو غرامة لا تتجاوز عشرة جنيهات إذ أنه يجب الاقتصار على عقوبة الحبس والمساواة في هذا الصدد بين الرجل والمرأة.
“حضرة النائب المحترم الأستاذ زهير صبری” حضرات النواب المحترمين: الواقع إن النساء يتهمننا نحن الرجال بأننا حينما نشرع نراعي مصلحتنا دائما ونعمل ضدهن. وقد ترتب على ذلك أن قامت في بلاد العالم ثورة نسوية ترمى إلى تحقيق العدالة والمساواة بين المرأة والرجل. وليست محاولات النساء لدخول برلمانات بريطانيا وفرنسا وألمانيا وغيرها إلا مظهرا لهذه الثورة.
لقد وضع الرجل كل الشروط اللازمة للمحافظة على العرض ففرض على الزوجة كل العقوبات، فى حين أنه أقل منها أو خففها عن نفسه, مع أن العدالة تقضى بأن تكون عقوبة الزانى هى ذات العقوبة المفروضة على الزانية.
فالمادة ۲۷۷ من المشروع تنص على حالة الزوج الذي زني غير مرة في منزل الزوجية بامرأة يكون قد أعدها لذلك وثبت عليه هذا الأمر… إلخ.
فالمشرع اشترط في هذه المادة ثلاثة شروط وهى – الإعداد والتعدد ووقوع الفعل في منزل الزوجية. ولكنه لم يفعل مثل ذلك لصالح المرأة. فالرجل له أن يزني في الخارج كما يشاء، وله أن يزنى مرة واحدة في منزل الزوجية. أما المرأة فلا تستطيع شيئا من ذلك وإلا نالها العقاب – فلم لا نتركها كالرجل تعمل ما تشاء خارج منزل الزوجية ليكون هناك تعادل ومساواة على الأقل؟
یا حضرات النواب المحترمين: لقد أجمع علماء النفس على أن الرجل هو السبب في دعارة المرأة، لأنها قد تندفع فى هذا السبيل انتقاما من زوجها ومبادلة الخطيئة بالخطيئة. ولقد كان الواجب أن يعاقب الرجل قبل أن تعاقب المرأة لأنه هو الذي ساقها إلى مهاوى الدعارة.
“حضرة النائب المحترم الأستاذ محمد أمين والى” – لقد رسم هذا القانون حدود الزوج وحدود الزوجة. ولذا لا يصح أن تقاس عقوبة أحدهما بعقوبة الآخر. فقد نص على عقوبة الحبس للرجل الذى يقتل زوجته وهي متلبسة بجريمة الزنا. ولكن ليس كل رجل يفعل ذلك. فقد يتسامح الزوج في هذا الحق، ويكتفى برفع الدعوى العمومية على زوجته فيحكم عليها بالحبس سنتين. فكان إذن يجب كى نسوى بين الزوجين أن يباح للزوجة حق قتل زوجها في حالة التلبس بالزنا. وإنى أوافق على التعديل الذي تقدم به معالي وزير المالية بشرط أن تبقى العقوبة كما هي الآن.
“حضرة النائب المحترم الأستاذ عبد الله الحديدي – حضرات النواب المحترمين. لقد قصد الشارع بالمادة المطروحة أمام حضراتكم أن يعاقب شخصا يمكن القول عنه بأنه مستهتر بحرمة العلاقة الزوجية. ولو نظرنا إلى هذا الفعل في ذاته لوجدنا أن ضرره لا يقتصر على مجرد ارتكابه فحسب، بل قد يجبر الزوجة على إتيان مثله, إما معاندة منها لزوجها أو رغبة في محاكاته انتقاما منه وتشفيا. لهذا كان لزاما علينا في هذه الحالة أن نتشدد في توقيع العقوبة. لذلك أرى أن الاقتراح الخاص بحذف عقوبة الغرامة اقتراح وجيه، وأؤيد معالى مكرم باشا عبيد في رأيه.
“حضرة النائب المحترم الأستاذ أنطون جرجس أنطون” – يحق لنا أن نتسائل بعد أن حذفت عقوبة الغرامة. هل للزوجة أن تقف تنفيذ الحكم كما يجوز للرجل؟
“الرئيس” – سنأخذ الرأى الآن على الاقتراحات التي قدمت من بعض حضرات النواب المحترمين بتعديلات فى المادة ۲۷۷ بحسب ترتيبها وهي.
أولا: اقتراح من حضرة النائب المحترم زهير صبري ونصه: أقترح أن تكون المادة ۲۷۷ كالآتى:”كل زوج زنى وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد على سنتين“.
فالموافق على الاقتراح يقف. (وقفت أقلية) !!!
ثانيا: اقتراح من حضرات النواب المحترمين محمود عبد النبي بك والشيخ أحمد أبو سديره وعبد المنعم مصطفى خليل بك نصه:”نرى تعديل المادة ۲۷۷ بما يأتي: كل متزوج زنى في منزل الزوجية أو غيره وثبت عليه الزنا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر“.
فالموافق على هذا الاقتراح يقف (وقف أقلية)!!!
الرئيس – إذن تقرر رفض الاقتراح.
ثالثا: اقتراح من حضرة النائب المحترم الأستاذ إسماعيل حمزة ونصه:”أقترح حذف عبارة“غير مرة” و“بامرأة تكون قد أعدها لذلك” من المادة ۲۸۷ التي أصلها ۲۷۹ من مشروع الحكومة“.
“حضرة الأستاذ المحترم الوكيل البرلماني لوزارة الحقانية” – توافق الوزارة على هذا التعديل فيصبح نص المادة كما يأتي: كل زوج زني في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة المذكورة يجازى بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو غرامة لا تتجاوز عشرة جنيهات مصرية“.
“حضرة الأستاذ المحترم الوكيل البرلمانى لشئون القصر” – إن اقتراح حضرة النائب المحترم الأستاذ إسماعيل سليمان حمزة يحتوى على شقين. فأخذ الرأى على أحد شقيه فيه تضييع لقيمة الاقتراح.
“الرئيس” – إن حضرة النائب المحترم الأستاذ إسماعيل سليمان حمزة قدم اقتراحين بتعديلات فى المادة ۲۷۷ وأحدهما الاقتراح الذي تلوته قبل الآن على حضراتكم. فالموافق عليه يتفضل بالوقوف (وقفت أغلبية) !!!
“الرئيس” – إذن يصبح نص المادة بعد التعديل هكذا“كل زوج زني في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة المذكورة يجازى بالحبس مدة لا تزيد عن ستة شهور أو غرامة لا تتجاوز عشرة جنيهات مصرية“.
ويمعن القانون في قسوته على المرأة فى هذا المجال فينص في المادة ٢٣٧ منه على ما يأتي:
“من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا وقتلها فى الحال هي ومن يزني بها يعاقب بالحبس (مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات) بدلا من العقوبات المقررة في المادتين ٢٣٤ و ٢٣٦ (الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة)”.
ونحن لا نعيب على القانون نصه. هذا وإنما عبثا نحاول البحث فيه عن نص يسوى بين عقوبة الرجل الذى يقتل زوجته الزانية وبين عقوبة المرأة التي تقتل زوجها الزاني, حتى حين يذهب به الفجور إلى ارتكابه الزنا في منزل الزوجية.
لا مساواة في العقاب. فالقاتلة زوجها الزاني حال تلبسه بالزنا تعاقب كالقاتل الشرير لا فرق بين الحالتين!!
ونحن لا ندعو إلى إباحة قتل الزوج الزاني. أو نحن بالأحرى في غير المجال الذى نناقش فيه ذلك. وإنما نعرض للأنظار أن القانون حين يخفف عقوبة القاتل زوجته الزانية يفترض أن للرجل كرامة ونخوة وشرفا وعرضا ويلتمس له الأعذار حين يذهب به الغضب إلى حد القتل. وهذا القانون نفسه حين يترك مصير القاتلة زوجها الزاني دون تخفيف, يفترض أنه لا كرامة للمرأة ولا نخوة ولا شرف ولا عرض، ولا يفكر في أن يلتمس لها العذر حين يذهب بها الغضب مصير إلى حد القتل !!
هذه التفرقة هى التى ننقدها. وهي التي تدعم وتؤكد أن المرأة في الحياة الزوجية مسلوبة الحقوق يعبث بها الرجل ويخونها, والقانون من ورائه يحميه ويشد أزره ويغريه عليها بالسوء.
رابعا: الضرب: وهذا هو ما يسمى باللغة المهذبة حق التأديب الجسماني، وشأنه هو الآخر شأن الحديث المعاد. غير أننا يجب أن نشير إلى استغلال الرجل هذا الحق وسوء استعماله وتحويله إلي حق التعذيب لا التأديب، وطالما طالعتنا الصحف بأنباء التعذيب الوحشى الذى تلقاه كثير من الزوجات لأتفه الأسباب على يد أزواجهن. بل طالما طالعتنا الصحف بأنباء جرائم القتل التي ارتكبها الأزواج ضد زوجاتهن إرضاء لسيطرتهم وغرورهم.
ومن هذا القبيل ما نشرته إحدى الصحف الأجنبية في مصر (بروجريه إجبسيان) تحت عنوان مثير – قائلة:
“الزوجة المضروبة ليس لها الحق في رد الاعتداء!!” ولخصت الخبر فيما يلي:
“قدمت وصفية سيد أحمد شرف أمام محكمة الجنح بتهمة اعتدائها على زوجها بالضرب. وفي الجلسة سألها القاضي عن صحة التهمة المنسوبة إليها فأجابت:
– نعم ضربته ولكنني لم أفعل ذلك إلا على سبيل الدفاع عن النفس أمام ضرباته. فقد كان مسلحا بأداة صلبة أراد أن يحطم بها رأسي على أثر مشادة بيننا فاضطررت إلى أن أضربه لأتفادى الموت على يديه.
وقد دافع محامى الزوجة دفاعا طويلا، وأثار مشكلة هامة مقدما الحجج والبراهين على ضرورة المساواة بين الزوجة والزوج في الحقوق والواجبات.
ولكن المحكمة لم تشاطره هذا الرأى وقضت بأن للزوج – طبقا للشريعة الإسلامية – الحق في تأديب زوجته جسمانيا وضربها، وأدانت الزوجة فحكمت عليها بالحبس شهرا مع إيقاف التنفيذ“.
ونحن نرمى إلى إبراز الحقيقة الواقعة عند تطبيق هذا الحق واستخدامه. وهى أن الرجل كثيرا ما يذهب فيه إلى أبعد الحدود فيسيء تقدير الأسباب ويسيء فهم حدود الاعتداء!! والمثال الذي قدمنا فيه شئ من إبراز هذه الحقيقة المؤلمة. وهى مظهر آخر من مظاهر استعباد المرأة وإهدار كرامتها وآدميتها في المجتمع المصرى.
خامسا: الطاعة: وهى واحدة من الحقوق المطلقة الممنوحة للزوج ومظهر من مظاهر السلطان والسيطرة المباحة للرجل على امرأته دون نظر أو تقدير لرغبات المرأة وميولها وآمالها. فليس للمرأة أن تترك بيت الزوجية مهما كرهت البقاء فيه فإن غادرته على غير رغبة من الزوج وفشلت في الحصول على حريتها بالطلاق – وهو الغالب من الأحوال – أكرهها الزوج على إليه بقوة البوليس فتعود صاغرة ذليلة خاضعة بل سجينة مقهورة مغلوبة على أمرها.
وإذا قلنا سجينة فنحن نعنيها قصدا لا مجازا. فالطاعة لا تكره المرأة على معاشرة زوجها هذا الذي تبغضه وتمقـتـه مـعـاشرة على أسنة الرماح فحسب، بل تلزمها عقر دارها لا تبرحه لأى سبب من الأسباب إلا بإذن سيدها وسجانها المعظم.
هنا نلمس فكرة“المرأة للبيت” في أقصى معانيها وأبشع صورها، هنا نرى فكرة“المرأة للجحيم” عارية من الزخارف والأباطيل التي يحيطها بها أنصارها ويسترون بها شوهاتها وفظائعها.
أما وقد فرغنا من تعداد المظاهر الرئيسية التي تميز الحياة الزوجية في المجتمع المصرى تعدادا سريعا موجزا، لا سيما فيما يعتبر من الحديث المعاد, فإنه قد بات واضحا لنا أن هذه الجوانب البغيضة في بناء الأسرة المصرية ليست سوى امتداد لفكرة رئيسية, هى محور كل ما تقاسيه المرأة المصرية من إجحاف وظلم. هذه الفكرة الرئيسية هى إهدار شخصية المرأة وكرامتها وحقوقها على يد الرجل واعتبارها مخلوقا أدنى من الرجل، تابع له وعالة عليه.
وليس من شك في أن الرغبة في إصلاح حال المرأة المصرية غالبة جارفة لا تقوى على الوقوف في وجهها مزاعم أعداء المرأة, أنصار تلك الفكرة الممسوخة“المرأة للبيت“
على أن هذا الإصلاح لا يجب أن ينصب على القوانين الوضعية القائمة بتعديلها فحسب، بل يجب أن يمتد كذلك إلى تطور الأخلاق القومية، والقضاء على التقاليد القديمة التي مازالت باقية منذ آلاف السنين متحدية كل تقدم اجتماعی وثقافی.
إن هذا الإصلاح المنشود يجب أن يقوم على دعامة جوهرية هي احترام شخصية المرأة وإرادتها وحريتها الشخصية، ذلك أن كل تعديل في القوانين لا يصاحبه تقوية الأساس الذى يبنى عليه بيت الزوجية يبقى حبرا على ورق, ويترك هذا البيت عرضة للانهيار والانحلال.
فإذا بدأنا بالمرأة صبية فى دار أسرتها، وجب أن نحطم القيود والأغلال التي تكبت شخصيتها وتسوقها سوق الأغنام إلى دار زوج لا تعرفه ولا تميل إليه. ولن تتحطم هذه الأغلال وتلك القيود إذا تركنا للفتاة حرية اختيار شريك حياتها فحسب، إذ أنه ما لم يتم القضاء على هذه العقلية التجارية السائدة في النظر إلى الزواج كصفقة مالية رابحة, فسوف تبقى تلك الحرية المشوهة المزعومة حبرا على ورق، ولن يعدو الإصلاح أن ننقل إدارة الصفقة وإبرامها من الأب أو ولى الأمر إلى الفتاة نفسها. لابد إذن من تدريب الفتاة المصرية على الشعور بشخصيتها المستقلة والإحساس بكرامتها الآدمية، وتلقينها أنها ليست سلعة في سوق الزواج تعطى لمن يدفع أعلى ثمن، وأن الزواج شركة عاطفية وعملية دائمة دوام الحياة، لابد لنجاحها وإثمارها من التحقق من التفاهم والتقارب والانسجام بين الشريكين.
ولكن هذا التلقين وذلك التدريب يظلان هما أيضا حبرا على ورق، مالم يصاحبهما الباعث إلى شعور الفتاة وإحساسها بشخصيتها وكرامتها. هذا الباعث الذي يحطم الفكرة السائدة بأن المرأة تابعة للرجل عالة عليه، والذي يحمى الفتاة من الاندفاع إلى بيع نفسها فى سوق الزواج لأقدر المزايدين عليها – هذا الباعث هو التعليم أولا، ولكنه ليس التعليم فحسب، بل التعليم الذي يقود الفتاة إلى تحقيق استقلالها الاقتصادي في المجتمع، إلى كسب الرزق بالعمل الشخصى, ولنا عود إلى الموضوع.
أما الاحتفاظ بالأوضاع السائدة اليوم فليس فيه إلا الإيحاء إلى الرجل بتفوقه على المرأة التي بيعت أو باعت نفسها له، وبأنها مخلوق ضعيف تابع له وعالة عليه، لا يستحق الاحترام وتقدير الند والرفيق، بل الرثاء والشفقة؛ وفى أغلب الأحوال – الازدراء والاحتقار. وليس فيه كذلك إلا الإيحاء إلى المرأة بمنزلتها الوضيعة أمام سيدها الذى يطعمها ويأويها ويحميها أو ينبذها ويطردها ويحرمها من الهناء والاستقرار والأولاد.
حتى إذا ما أسس البيت المشترك على دعائم من الاحترام المتبادل والتفاهم والمودة, وجمع تحت سقفه شريكين كاملي الشخصية متعاطفين, بات الإصلاح الباقی سهلا میسورا يكاد يكون في غنى عن نصوص القانون وأحكام القضاء ولابد أن يتناول هذا الإصلاح القضاء على مظاهر الإجحاف الذي يحيق بالمرأة في الأسرة بمنع تعدد الزوجات, وتقييد الطلاق من جانب الرجل مع تحقيق المساواة بين الزوجين فى حق الطلاق, وتحريم الزنا تحريما باتا حاسما من الجانبين على قدم المساواة، وإلغاء نظام الطاعة.
ومن الجلى أن نواحى الإصلاح المنشودة في جموعها تتركز في نداء واحد هو المساواة بين الجنسين. هذا النداء الذى ندعو إليه هو الضمان الوحيد لعلاج حال الأسرة المصرية نواة المجتمع المصرى. وليست هذه المساواة المطلوبة هى ما يزعمه الهازلون حين يسمونها استرجال النساء أو تحريض المرأة على هجر البيت. فهى ليست على شئ من التناقض مع طبيعة المرأة ومسئوليتها كزوجة وأم، كما يهرف أنصار فكرة“المرأة للبيت“، بل هي على العكس الضمان الذي يكفل هناء البيت ومن يضمه واستقرار الحياة الزوجية السعيدة، والتي لابد منها في مجتمع سليم.
إن فكرة“المرأة للبيت” فى مضمونها ليست سوى تجميع المساوئ التي تحيط بالأسرة المصرية. فهى تعنى للفتاة إجبارها على الزواج قسرا وكرها، وتعنى للزوجة إباحة تعدد الزوجات وإطلاق حق الطلاق والزنا والطاعة والتعذيب، وتعنى للمرأة عامة حرمانها من التعليم، ومن المساهمة في الحياة الاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية ومن تنمية شخصيتها ومواهبها.
إن فكرة“المرأة للبيت” فى حقيقتها هي فكرة“المرأة عبدة البيت المحطم“.
أما فكرة المساواة بين الجنسين كما عرضناها في هذا الفصل فهي تعنى البيت الصحيح الهانئ والمجتمع السليم السـعـيـد – هي فكرة“المرأة للمجتمع“.
ولابد لفكرة المساواة من أن تنتصر. فإن عجلة الزمن تدور! وليس في وسع المكابرين أن يوقفوا عجلة الزمن وأن يتحدوا تطور المجتمع!
حين نتكلم عن التعليم فى مصر لابد أن نذكر ذلك العدو البغيض الذي وقف عقبة في سبيل تطورنا الاقتصادي والاجتماعى والثقافي. هذا العدو اللدود هو الاستعمار البريطاني الغاشم.
لقد حرص الغاصب الجشع على أن يوقف الانتشار الطبيعي للتعليم في بلادنا حتى يسودها الجهل والأمية، فيعيش هو فيها سلبا ونهبا واستغلالا، آمنا مطمئن البال، لا يقلقه صوت الشعب اليقظ، ولا يقض مضجعه هدير الجماهير الواعية المتعلمة. فالجهل والأمية حليفان مخلصان للاستعمار البغيض يبسط بهما سلطانه وسيطرته على المستعمرات، بل هما سلاحان ماضيان يحققان ما تهدف إليه أسلحته الأخرى من احتلال عسكرى واغتصاب للسيادة الوطنية والاستقلال القومى وإرهاب بالحديد والنار. هذا الهدف هو تدعيم سيطرته على الشعوب المستعمرة وتأخير وعيها وشل كفاحها الوطني من أجل التحرر من نيره البشع.
لم يكن عجيبا إذن أن تبرز سياسة الاستعمار البريطاني في مجال التعليم في مصر، ويمكن تقسيمها إلى مرحلتين. الأولى مرحلة السيطرة البريطانية الكاملة على الحكم أى من سنة ۱۹۱۹، والثانية مرحلة الصراع الدائم المتقدم بين الحركة الوطنية الشعبية وبين الاستعمار البريطاني، ذلك الصراع من أجل استكمال الاستقلال الوطني والسيادة القومية ونشر الديمقراطية.
ونحن – وإن كنا في صدد الكلام عن تعليم المرأة – قد عرجنا على بيان آثار السياسة البريطانية الاستعمارية فى التعليم عامة.. ذلك أن المرأة لا تعدو أنها تمثل نصف الأمة ينالها ويحيق بها ما ينال الأمة فى مجموعها أو يحيق بها من خير أو من ضرر. على أن الأمر بالنسبة لتعليم المرأة المصرية لا يقف عند هذا الحد بل يتجاوزه. فليس يخفى على أحد أن المرأة المصرية متخلفة في مضمار التعليم عن الرجل إلى حد كبير, فهى لا تعانى تأخر التعليم العام فحسب بل تعانى أيضا ذلك الضيق الذي يصادف تعليم المرأة بوجه الشعبي خاص.
وهذا ما سوف يأتي بيانه.
المرحلة الأولى: هي مرحلة السيطرة المباشرة للاستعمار البريطاني على جميع شئوننا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتمتد من عام ۱۸۸۲ – تاريخ الاحتلال البريطانى المشئوم – حتى الثورة الوطنية التي قامت عام ١٩١٩ في وجه هذا الغاصب.
في هذه المرحلة حرص الغاصب الأجنبى على كبت النهضة المصرية الحديثة التي بدأت في عهد العاهل محمد على الكبير – مؤسس مصر الحديثة – ورعاها فيما بعد الخديوى إسماعيل, تلك النهضة التى تناولت كثيرا من نواحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبرزت بروزا واضحا في تقدم التعليم تقدما ملحوظا. وجه الاستعمار إذن سهامه إلى التعليم، وانطلق زبانيته الأشرار يوصدون أبواب العلم والنور والمعرفة في وجه الشعب المصرى وتجلت هذه السياسة الأثيمة واضحة في الأمور الآتية:
1 – خفض ميزانية التعليم. ويكفى أن نقارن مقارنة سريعة بين ميزانية التعليم في عهد الخديوى إسماعيل – وكانت تبلغ نحو ٨% من ميزانية الدولة العامة – وبیسن ميزانية التعليم والصحة معا فى عهد كرومر – وقد هبطت إلى ١.٥% من ميزانية الدولة العامة. فتنطق لنا هذه الأرقام معبرة تعبيرا واضحا عن اتجاه سياسة الاستعمار البريطاني في مصر بالنسبة للتعليم.
كذلك نلاحظ أن ميزانية التعليم فى عام ۱۸۸۳ كانت تبلغ ٩٥ ألفا من الجنيهات فهبطت في خلال عشرة سنوات أى حتى عام ١٨٩٣ إلى ٩٣ ألفا من الجنيهات. هذا في الوقت الذي ازداد فيه تعداد الشعب المصرى ثلاثة ملايين من الأنفس وارتفعت فيه أرقام الميزانية العامة بطبيعة الحال.
٢ – إلغاء مجانية التعليم – ويكفى أن نسوق للقراء عبارة من تقرير كرومر الذي رفعه إلى الحكومة البريطانية فى عام ١٨٨٤، ليبين لنا نفاق الزبانية البريطانيين ومناوراتهم من أجل الحيلولة دون تقدم الشعوب المستعمرة الواقعة تحت سيطرتهم المستبدة.
قال كرومر في هذا التقرير“عندما احتل البريطانيون مصر عام ۱۸۸۲ وجدوا أن كل ما تنفقه الحكومة على التعليم ينصرف إلى تعليم أولاد فئة صغيرة من أغنياء البلاد فأخذوا في تغيير هذه الحالة وبذل الهمة في تحصيل المصروفات من الطلبة وإلغاء مجانية التعليم تدريجيا“.
ولسنا ندرى هل كان كرومر جادا أم هازلا حين صاغ في تقريره تلك الأكذوبة الكبرى ليوهم بأن إلغاء مجانية التعليم إجراء ديمقراطي في مصلحة الشعب المصرى, ساعد ابن الشعب الفقير على أن يتعلم ويكتسب الثقافة والمعرفة.
لقد كان الأجدر به أن يعترف بأن سياسة إلغاء المجانية في التعليم ليست سوى تحقيق الأغراض الاستعمار البريطانى الحريص على إبقاء الشعب المصرى جاهلا محروما من المعرفة والثقافة. وهذا هو المنطق المعقول الذي لا يفوت الأفهام الساذجة ولا يعميه نفاق المستعمرين ورياؤهم وأكاذيبهم. وهو المنطق الذي اعترف به“دنلوب” مبعوث وزارة المستعمرات البريطانية إلى وزارة المعارف المصرية حين قال فی ۱۹۰۲“لكي نحرم أبناء الطبقة التي لا تملك الوسائل للاستمرار في المدارس الثانوية والعالمية فقد رفعنا مصروفاتها إلى خمسة جنيهات“.
3 – التعليم الاستعماري – لاشك أن الاستعمار يود لو استطاع إغلاق المدارس والمعاهد وتحريم العلم، بل وفرض العقوبات على ممارسة التعليم أو طلابه، فإن في ذلك الضمان الحاسم لعرقلة تقدم الوعي الشعبي. ولكن الاستعمار لا يستطيع أن يلجأ إلى هذا الأسلوب المكشوف الصارخ من أجل تحقيق أغراضه، بل يترك الشكل الخارجى وينقض على الجوهر والمضمون. وهذا ما فعله الاستعمار البريطانى فى مصر، إذ انقض على جوهر التعليم فجعل أسلوبه قاصرا على تخريج عدد من الكتبة والموظفين اللازمين للعمل في مصالح الدولة تحت السيطرة البريطانية. فلم يكن هدف التعليم أو أسلوبه معنيا برفع عقلية الشعب إلى المستوى اللائق أو نشر الثقافة والقضاء على الأمية وإعداد الجيل الفتى إعدادا فنيا وعلميا وأدبيا صالحا. وإنما كان التعليم الذي تولاه الاستعمار البريطانى فى مصر هو ما عبر عنه رسوله كرومر بالآتى:
“آمل أن أوضح ما أعنيه بالطبقة المتعلمة. إنى لا أقصد التعليم العالى. فالمسألة الرئيسية هي إعطاء بعض المعلومات عن القراءة والكتابة لبعض الشباب بحيث تؤهلهم أن يشغلوا بكفاءة وظائف صغرى في الإدارة… يجب أن نعلم الطلبة ما يؤهلهم لخدمة الحكومة فى الوظائف الكتابية الصغرى بمرتبات تقل عن مرتبات الكتبة الذين يؤتى بهم من الخارج“.
وهذا هو مسلك الاستعمار نحو التعليم في مصر. فهو لم يكتف بتلك الجريمة الكبرى التى لطخت تاريخ الإمبراطورية البريطانية بالأوحال, وهى عرقلة التقدم الطبيعى الذى سجله تاريخ مصر الحديثة منذ عهد محمد على الكبير, هذا التقدم الذى كان من شأنه – لولا تدخل المستعمر الغاصب – أن يضطرد انتشار التعليم وازدياد المدارس والقضاء على الأمية, بل اقترنت هذه الجريمة الشنعاء بتلك الاجراءات الإيجابية التى رجعت بالتعليم إلى الوراء – ولم تدعه حتى ثابتا حيث هو.
لا عجب إذن أن تطالعنا الإحصاءات بالأرقام الناطقة بأثر الاستعمار البريطاني في التعليم العالى المصرى.
فبينما كان في سنة ۱۸۸۰ نحو 150 طالبا يدرسون الطب وخمسين يدرسون الهندسة، نرى أن العدد فى سنة ۱۸۹۷ لا يزيد على ٤٠ طالبا يدرسون الطب و ۲۹ يدرسون الهندسة.
أما التعليم الثانوى والابتدائى فقد عطل الاستعمار تطورهما الطبيعي فلم يزد عدد الطلاب فيهما على النحو الذي كان منتظرا. ومع ذلك فقد عبر دنلوب عن“قلقه!” من ازدياد عدد الطلاب لا سيما في المدارس الابتدائية, فأفصح مرة أخرى بصراحته الساذجة عن حقيقة سياسة الاستعمار في التعليم قائلا:
“إن عدد المتقدمين للشهادة الابتدائية يزيد باستمرار رغم ارتفاع رسوم الامتحان إلى ثلاثة أضعاف“.
أما وقد عرفنا سياسة الاستعمار في التعليم المصرى عامة حين كان مسيطرا سيطرة مباشرة على الحكم، فقد آن لنا أن نتحدث عن تعليم المرأة في تلك الفترة. ومن الطبيعى أن نلاحظ أول ما نلاحظ أن تقدم تعليم المرأة المصرية كان هو الآخر بطيئا، شأنه في ذلك شأن التعليم العام بل أشد بطئا.
وها هي الحقائق العارية والأرقام الناطقة مؤيدة لما ذكرناه.
ففي سنة ۱۸۷۳ أنشأ الخديوى اسماعيل أول مدرسة ابتدائية للبنات (المدرسة السنية) وأنشئت الثانية فى عام ۱895. ولم تنشأ غيرهما حتى الثورة الوطنية تقريبا. أى أنه فى مدى أكثر من أربعين عاما لم يكن في مصر سوى مدرستين ابتدائيتين للبنات, بينما أنه فتحت فى خلال الثلاثين عاما الأخيرة – أى حتى سنة ١٩٤٨ – أكثر من مائتي مدرسة ابتدائية منها ٧٥ مدرسة ميرية و ١٤٥ مدرسة حرة.
وحتى هاتان المدرستان ألغى البريطانيون المجانية التي كانت قائمة فيهما وذلك منذ عام ١٨٩٤.
أما التعليم الثانوى للبنات فلم يكن له أثر في تلك المرحلة الأولى.
المرحلة الثانية: وهى مرحلة الصراع بين القوتين المتضادتين – قوة الثورة الوطنية التي تهدف إلى تحقيق الاستقلال الوطنى الكامل ونشر الديمقراطية في البلاد – وقوة الاستعمار البريطانى الذى يهدف إلى إبقاء البلاد تحت سيطرته وتأخير نهضتها وعرقلة تقدمها في كافة الميادين.
وتمتاز هذه المرحلة بطفرة رائعة فى التعليم العام، ترددت أصداؤها في میدان تعليم المرأة المصرية. ففى سنة ١٩٢٥ أنشئت أول مدرسة ثانوية للبنات. وتزايد عدد الطالبات فى المدارس الثانوية والابتدائية منذ ذلك الحين تزايدا مضطردا.
والأرقام التالية تنبئ فى وضوح عن مدى تقدم تعليم المرأة فى مصر.
ففي سنة ۱۹۲٥ فقد قدر عدد الطلاب فى مصر بنسبة 20% من مجموع الصبية البالغين سن التعليم وكانت الطالبات يمثلن خمس عدد الطلاب.
أما في سنة ١٩٤٥ فقد قدر عدد الطلاب بنسبة ٤٠% من مجموع الصبية البالغين سن التعليم وارتفعت نسبة الطالبات فى هذا العدد إلى الخمسين.
ويتضح من هذا أنه بينما ارتفع عدد الصبية في المدارس إلى الضعف في خلال عشرين عاما، ارتفع عدد الطالبات فى خلال هذه الفترة ذاتها إلى الضعفين.
وقد سبق أن أشرنا إلى أنه قد أنشئت فى خلال الثلاثين عاما الأخيرة أكثر من مائتى مدرسة لتعليم البنات من ابتدائية وثانوية وغيرها. وانتهى الأمر إلى فتح أبواب الجامعة أمام الطالبات.
إذن فقد شهدت المرحلة الثانية من مراحل التعليم المصرى نهضة واضحة في تعليم المرأة المصرية. هذه النهضة الواضحة راجعة إلى عاملين رئيسين:
الأول: كفاح الحركة الوطنية المصرية لتحرير البلاد من كبت الاستعباد الأجنبي وقيوده ونشر الديمقراطية والتعليم، ذلك الكفاح الذي انتهى إلى الحصول على الدستور المصرى فى عام ۱۹۲۳ وأذن بفاتحة عهد من الإصلاحات الشعبية. ولما كانت المرأة المصرية قد اشتركت في معارك الثورة الوطنية الكبرى اشتراكا إيجابيا مازالت ذكرياته قائمة حتى اليوم, فقد أدركت بوعيها المتيقظ المتطور ضرورة مواصلة كفاحها من أجل رفع مستواها الاجتماعى والثقافي. وهكذا اتجهت المرأة المصرية فى حماس إلى معاهد العلم والثقافة ترتوى منها بالقدر المستطاع، وجاهدت فيما جاهدت من أجل فتح الأبواب الموصدة في وجهها، ومساواتها بالرجل في جميع مراحل التعليم، مما تجلى في نضال الاتحاد النسائى المصرى الذى كان يمثل – إذ ذاك – آمال المرأة المصرية تمثيلا صادقا، والذى كان له بالفعل اثر مباشر فيما نالته المرأة المصرية في مجال التعليم بوجه خاص.
والعامل الثانى: هو اشتراك المرأة فى النشاط الصناعي والتجاري وغيره من ميادين الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المجتمع المصرى. فقد نزلت المرأة المصرية إلى ميادين العمل المختلفة في المصانع والمتاجر ومكاتب الشركات والتدريس والطب… الخ، وكان لابد لها من حد أدنى من الثقافة والمعرفة حتى تتمكن من خوض معترك الحياة الاجتماعية العملية. وهكذا اندفعت آلاف الفتيات إلى المدارس يتزودن بالمعرفة اللازمة لكسب القوت بالعمل.
هذا هو تفسير تلك النهضة الرائعة التى صاحبت تطور تعليم المرأة في مصر فى مرحلة الصراع بين الحركة الوطنية المتقدمة ورجعية الاستعمار الغشوم، مرحلة الكفاح من أجل استكمال أركان الاستقلال الوطني مصر والإصلاحات الشعبية الديمقراطية.
وبذلك استكملنا – فى استعراض سريع – سرد التطور التاريخي لتعليم المرأة المصرية. وينتهي بنا هذا السرد إلى استعراض الحالة القائمة اليوم في هذا الصدد.
ذلك أنه بالرغم من تلك النهضة الثقافية التي شهدتها الثلاثون عاما الأخيرة من تاريخ مصر الحديثة، فإن الحقيقة المرة في أمر التعليم في مصر ماثلة أمام عيوننا, تصرخ بأن نسبة الأمية فى الشعب المصرى مازالت أكثر من 80% أما الوجه التاريخى لهذه الحقيقة المرة فهى أن الاستعمار البريطاني في مصر هو الذى آخر هذه النهضة المباركة أكثر من ثلاثين عاما، بل وحطم النهضة التاريخية التى بدأها محمد على الكبير واستأنفها إسماعيل فيما بعد، وأنه لولا هذا الدخيل الغاصب لكان شأن الأمية في مصر غير هذا الشأن.
وإذا كان هذا التأخر الواضح فى مستوى التعليم بين أفراد الشعب المصرى عامة والنساء بوجه خاص يرجع فى المقام الأول – كما أسلفنا – إلى سياسة الاستعمار البريطاني ومقاومته للنهضة الثقافية المصرية، فإن هذه السياسة الأثيمة تنعكس في ظاهرة أخرى واضحة للعيان، وهي أن الفقر المدقع عامل آخر من عوامل التأخر الثقافى للشعب المصرى عامة ونسائه بوجه خاص.
فانخفاض مستوى المعيشة بين الشعب المصرى – وخاصة الفالحين الذين يمثلون نحو ثلاثة أرباعه – ظاهرة تنبع هيا الأخرى من التأخر الاقتصادي وعرقلة النهضة الصناعية المصرية، الأمر الذى يعتبر الاستعمار مسئولا عنه كذلك.
هذا الفقر المدقع يحول بين الآباء وتعليم أبنائهم نظرا إلى حاجتهم إليهم في العمل وكسب الرزق, للمساهمة فى نفقات الأسرة وإطعامها. فالفقر والجهل شقيقان متلازمان. وتبدو هذه الظاهرة واضحة في الريف حيث يعمل الأطفال في الحقول منذ الحداثة ويتخلفون عن الذهاب إلى المدارس الإلزامية أو الأولية رغم جهود وزارة المعارف، والهيئات الإدارية المحلية، والمحاكمات الجنائية للآباء. بل لقد شهدت المحاكم المصرية في الريف كثيرا من الحالات التي يفضل الأب فيها أن يدفع الغرامة الجنائية المحكوم بها عليه كلما تخلف ولده عن المدرسة الإلزامية, على أن يرسله إليها ويحرم بذلك من ثمرات عمله في الزراعة أو الحرف الأخرى.
وشهدت بعض المحاكم في الريف حالات يستجوب فيها الأب عن علة تخلف ولده عن المدرسة الإلزامية فيجيب بأنه لا يملك (الجلباب) الذي يستر به جسمه للذهاب إليها. وكثيرا ما يصدق الرجل !
على أنه إلى جانب المسئوليات التاريخية التي تقع على الاستعمار البريطاني – كما أوضحنا – تقع مسئولية كبرى على عاتق المسئولين اليوم عن سياسة التعليم فى مصر، أى الحكومة المصرية. فما زال على هذه الحكومة – إلى جانب العمل على رفع مستوى المعيشة بين أفراد الشعب والفلاحين خاصة – أن تصرف الكثير من عنايتها واهتمامها إلى رفع مستوى التعليم الأولى ونشره وتدعيمه باعتباره أول مراحل التعليم، وبعبارة أخرى مرحلة التعليم الشعبي. ولن يتحقق ذلك إلا بإعطائه جانبا هاما من ميزانية التعليم وهو خلاف الحال القائم الآن.
ذلك أنه وإن كان الدستور المصري قد نص على إلزامية التعليم الأولى ومجانيته، فإن الجزء الأكبر من ميزانية التعليم يصرف على التعليم الثانوي والعالى.
وقد أشار الخبير البيطاني المستر ف. مان في تقريره الذي كتبه عام ١٩٣٢ إلى هذه الحقيقة قائلا:
“إن لمصر نظاما مزدوجا فى التعليم, التعليم الابتدائي والثانوي والعالي للفئات الميسورة، والتعليم الأولى المجانى للجماهير وخاصة في الريف. وكان التعليم الأولى مهملا جدا في الريف خوفا من نزح الفلاحين إلى المدن. فقد نسيت وزارة المعارف أن التعليم العام متوقف على المدارس الأولية. وبينما ينفق في انجلترا ٤ جنيهات على التعليم الأولى في مقابل كل جنيه ينفق على التعليم العالى – ينفق فى مصر جنيهان للتعليم العالي في مقابل كل جنيه ينفق على التعليم الأولى“.
وقد اقترحت بعض الشخصيات الخبيرة ومن بينها الدكتور حافظ عفيفي باشا والدكتور طه حسين بك تدعيم التعليم الأولى والإلزامي ورفعه إلى مستوى التعليم الابتدائى حتى يمكن من بعده مواصلة الدراسات العليا.
ويبدو أن وزارة المعارف ماضية في الأخذ بهذا الاقتراح، وليس من شك في أن تحقيقه يعتبر خطوة كبيرة في سبيل نشر التعليم بين الشعب والقضاء على الأمية ورفع مستوى الثقافة الشعبية. ويمتد أثر هذا الاقتراح بطبيعة الحال إلى تعليم البنات كذلك، وهو الذى يعنينا بوجه خاص في هذا البحث.
فإذا ما انتقلنا إلى حال المرأة المصرية اليوم في مجال التعليم، واجهتنا الإحصاءات الرسمية بحقيقة أشد مرارة وإيلاما. هذه الحقيقة تتجلى في أن المرأة لا تمثل في العشرين فى المائة من المتعلمين في مصر أكثر من نسبة تافهة هي ٢% أي أن نسبة الأمية بين النساء تبلغ ٩٦% وبين الرجال 64%.
وما دمنا قد عدنا إلى موضوعنا – بعد أن تطرق بنا البحث إلى النواحي العامة للتعليم في مصر – فيلزم أن نفيض قليلا في بيانه لنستكمل بذلك النواحي الخاصة بتعليم المرأة المصرية.
ذلك أنه على الرغم من تطور التعليم الابتدائى للبنات وازدياد عدد الطالبات في المدارس الابتدائية ازدياد كبيرا، فإن شهادة إتمام الدراسة الابتدائية تقف بالفتاة في مفترق طريقين: الأول: طريق الدراسة الثانوية فالجامعة أو المعاهد الفنية العالية، وهو طريق الفتى كذلك، والثاني طريق المدارس النسوية ومعاهد التدبير المنزلى وغير ذلك من المعاهد التي تتخصص في إعداد الفتاة للبيت دون أى شئ آخر.
فكما أن نظام التعليم العام مزدوج: التعليم الأولى الذي يقف بالتلاميذ إلى حد لا يستطيعون تخطية, والتعليم الابتدائى الذى يفتح الطريق حتى الجامعة والمعاهد العليا، كذلك نظام تعليم المراة مزدوج: التعليم الثانوي والعالى من ناحية والتعليم النسائى من ناحية أخرى.
ومن البديهي أنه ليس ثمة ضرر في إيجاد المدارس التي تؤهل الفتاة للأعمال التي تقدر عليها المرأة أكثر من الرجل، كمدارس الفنون الطرزية ومدارس معلمات الأطفال ومدارس الممرضات. فإن من شأن هذه المدارس أن تعد للأمة خائطات ومدرسات للحياكة والتطريز ومدرسات للأطفال وممرضات, كلهن متخصصات في عملهن. ويقابل هذا النوع من المدارس تلك المعاهد التي تعد الطلاب للمهن المختلفة.
أما المدارس النسائية البحتة فهى تقتصر على إعداد الفتاة لخدمة البيت وتحصر نطاق ثقافتها في هذا المجال الضيق المحدود. حقا يجب تزويد الفتاة بهذه المعلومات المتعلقة بالحياة الزوجية والأمومة وإدارة البيت، ولكن مجال تزويد الفتاة بهذه المعلومات وتلك الثقافة هو مجال التعليم العام والتعليم الثانوي بوجه خاص. وقد روعيت هذه الضرورة فعلا في التعليم الثانوى للبنات فأضيفت إليه سنة كاملة بحيث أصبحت مدته ست سنوات بدلا من الخمس التي يقضيها الفتى في هذه المرحلة من التعليم.
إننا لا ندعو إلى حرمان الفتاة من الثقافة المنزلية أو إلى إهمالها واجباتها الزوجية وواجبات الأمومة ولكننا ندعو إلى تزويدها كذلك بالثقافة العامة التي تجعل منها عضوا نافعا فى المجتمع الذي تعيش فيه، وإلى تشجيعها على أن تكسب المعرفة العلمية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية التي يكتسبها الرجل، ليكون لها في المجتمع مركز الرجل فيه. وهذا لا يتأتى إلا بتحقيق المساواة في التعليم العام دون المدارس النسائية الخاصة.
فأما سياسة الحكومة في تعليم المرأة المصرية، فهي تتجهه في وضوح وجلاء إلى تشجيع التعليم النسائى الخاص على حساب مساواة المرأة بالرجل في مراحل التعليم. ومعنى هذا الاتجاه حرمان المرأة المصرية من تنمية مواهبها العلمية والأدبية والعملية التى تمكنها من المساهمة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية في المجتمع المصرى، وجعل المرأة المصرية خادمة مثقفة. ويتضح هذا الاتجاه من الأمور الآتية:
1 – إطلاق المجانية في أغلب المعاهد النسائية الخاصة، بل وتشجيع الطالبات على الالتحاق بها بمنحهن مرتبات يومية وغير ذلك من المغريات, بينما تفرض المصروفات المدرسية الباهظة على طالبات المدارس الثانوية.
٢ – إلغاء المجانية التى كانت تتمتع بها طالبات الجامعات – ولا سيما في كلية الآداب – وقد تقرر هذا الإلغاء في عام ١٩٤٦ وحال دون تشجيع الفتاة المصرية على دخول الجامعات, راحتفظ بالنسبة المنخفضة لعدد الطالبات الذي لا يتجاوز 7% من مجموع الطلاب.
٣ – التأثير في الرأي العام عن طريق الصحافة والدعايات المختلفة لتأليبه ضد فكرة المساواة في التعليم بين المرأة والرجل. فما زالت هناك أصوات تتردد – بمعارضة التعليم الجامعى للفتاة المصرية. وقد قاست طالبات الجامعة الأمرين من هذا النوع من التفكير الرجعى وواجهت عقبات شاقة مازالت آثارها باقية حتى اليوم.
ولقد عبرت السيدة أمينة السعيد عما صادفها في حياتها الجامعية من قسوة وتضييق في مقال نشرته صحيفة الهلال الشهرية في ديسمبر سنة ١٩٤٨ قالت فيه إن الطالبة فى الجامعة كانت لا تستطيع أن تقرأ أو تتكلم في حضور الطلاب، ولا أن تترك شعرها عاريا بغير غطاء، ولا أن تنظر إلى ناحية الطلاب أو توجه إليهم التحية أو الحديث.
وإذا كانت الحياة الجامعية فى مصر قد سجلت تطورا كبيرا محمودا فما زالت آثار التفرقة بين الطالب والطالبة قائمة حتى اليوم.
4 – موقف الأستاذ مرسى بدر بك وزير المعارف السابق من تعليم الفتاة المصرية، وهو الموقف الذي أثار ضجة كبرى مازالت أصداؤها تتردد في الصحف والمجلات والأحاديث الخاصة. فقد أمر هذا الوزير بإلغاء بعثات الطالبات المصريات إلى الخارج (فيما عدا انجلترا). ولسنا في حاجة إلى الرد على العقلية التي اتخذت هذا التصرف وأشباهه من التصرفات التي ترى إلى الرجوع بالمرأة المصرية مائة عام إلى الوراء، إلى عهد الحريم المعروف، فقد تولى الرد عليها كثيرون وكثيرات من ذوى الرأى، وإنما نسجل بهذا المثال الصارخ دليلا حاسما على أن تعليم المرأة المصرية كثيرا ما يقع فريسة للرجعية التي تحول دون تطوره وتقدمه وتحرم المرأة من تنمية شخصيتها ومواهبها كعضو نافع من أعضاء المجتمع.
هذه هى قضية تعليم المرأة – جانب آخر من عدم المساواة بينها وبين الرجل, يؤكد تلك الفكرة البغيضة التى تجعل من المرأة المصرية عبدة خاضعة للرجل.
قدمنا أن مشكلة المرأة في العمل كانت ومازالت مثار نقاش طويل، شأنها في ذلك شأن مشكلة المرأة في مجموعها. ومجالنا هنا أن ندلى برأينا في هذا النقاش العنيف، ثم نعرج على دراسة أحوال المرأة في فروع النشاط الاقتصادي والاجتماعي المختلفة.
فأما الخلاف الدائر اليوم بين أنصار (المرأة للبيت) وأنصار المساواة بين المرأة والرجل فهو خلاف فى الهواء… غير ذي موضوع! ذلك أن المرأة المصرية – شاء أنصار“المرأة للبيت” أم لم يشاؤوا – قد نزلت فعلاً إلى ميادين العمل وكسب الرزق، ولم يعد ثمة مجال لردها عما هي بسبيله. فالخلاف إذن نظرى مجرد، معزول عن الواقع في الحياة العملية.
ولكن الملاحظ أن أنصار“المرأة للبيت” يحاولون أن يصوروا عمل المرأة محطما“للبيت” حتى يضللوا الرأى العام بهذا التصوير الخاطئ المشوه ويرمون أنصار المساواة بين المرأة والرجل بأنهم يريدون صرفها عن العناية ببيتها كزوجة وأم. وليس من شك فى أنه لا يخطر على بال أحد من المدافعين عن مساواة المرأة بالرجل أن يشجعها على إهمال واجبات الزوجية والأمومة، بل على العكس تؤدى هذه المساواة إلى حسن قيام المرأة بهذه الواجبات. فالمساواة بين الجنسين فى التعليم تؤدى إلى رفع مستوى المرأة وتهذيبها وتنمية مواهبها وقدرتها. والمساواة بين الزوجين فى الحياة الزوجية بمنع تعدد الزوجات وفى الطلاق وغير ذلك, تؤدى إلى صيانة الأسرة وحماية البيت من عوامل القلق والانهيار. كذلك المساواة بين الجنسين فى العمل بإعطاء المرأة حرية النزول إلى الحياة الاقتصادية على قدم المساواة مع الرجل تؤدى إلى رفع مستوى حياة الأسرة والمجتمع وتحمى شخصية المرأة واستقلالها وإرادتها وكرامتها.
وهذا ما سوف نعرض له في هذا البحث.
فالمرأة حين تعمل تحقق الأهداف الآتية:
أولاً: تعمل المرأة تحت ضغط الحاجة الملحة – فالأغلبية الساحقة من النساء اللاتي يعملن فى مصر تلجأ إلى العمل مضطرة لكسب الرزق، لأنه لا خيار أمامها بين البيت والعمل، بل يدفعها الفقر إلى البحث عن لقمة العيش فيما تتخذه من حرفة أو مهنة.
وهنا تظهر حقيقة المدافعين عن فكرة“المرأة للبيت” سافرة، فأين هذا البيت الذي يريدون أن تقبع المرأة فيه ولا تعمل ؟ بيت الفقر والجهل والمرض ؟ البيت الذي تموت فيه جوعا وعريا، لأن هؤلاء السادة قد قرروا في أبراجهم العاجية أن تكون المرأة للبيت والبيت فحسب ؟! كم هي نظرية مسلية حقا أن نظل نناقش ونناقش فيما إذا وجبت عودة المرأة إلى بيتها لا تبارحه أم اشتراكها في العمل، بينما تئن الملايين من الأسر المصرية تحت وطأة الفقر وسوء التغذية، وبينما أن اشتراك المرأة في ميادين العمل يمكنها من رفع مستوى الحياة في الأسرة – فتاة كانت أم زوجة أم أما!!
ثم نسائل هؤلاء السادة في أبراجهم العاجية لماذا لم يخطر ببالهم أن يسألوا أنفسهم“هل تعمل الفلاحة أم لا” وماذا يكون من أمر الريف المصرى إذا قضينا على الفلاحة بأن تقبع في دارها لا تبرحه ولا تشترك في الحرث والبذر والجمع والرى والحصاد والرعى والعناية بالماشية ؟
أليست تعمل الفلاحة أكثر من أربع عشرة ساعة في اليوم إلى جانب أبيها أو أخيها أو زوجها ؟ وهل حالت التقاليد القاسية في الريف دون أن يباح للمرأة العمل ؟ ثم هل تهمل الفلاحة – وهى تشترك في الزراعة – بيتها وزوجها وأطفالها.
إن العمل لا يعنى للمرأة رفع مستوى حياتها فحسب، بل يعنى أيضا إعطاءها قدرا من الاستقلال الاقتصادي، وبالتالى فرصة التحرر من أن تكون تابعة للرجل الذي يطعمها، عالة على أبيها أو ولى أمرها أو زوجها، وبالتالي فرصة الخلاص من سيطرة الرجل واستعباده, والشعور بشخصيتها وكرامتها وآدميتها، وهذا هو الذى يقلق مضجع الرجعيين أنصار“المرأة للبيت” أعداء المساواة بين الجنسين. فهم لا يحاربون رفع مستوى حياة الأسرة بما تكسبه المرأة العاملة. وهم لا يحرضون على إبقاء المرأة فى البيت رعاية للبيت وحماية للأطفال. وهم لا يتخذون من عدائهم للمرأة ذريعة للكرامة والكبرياء والتفوق. وإنما يروعهم أن تتوفر للمرأة عوامل التحرر من تبعيتها للرجل وتعويلها عليه والخلاص من سيطرته عليها واستعباده إياها، ويزعجهم أن تنال المرأة عناصر استقلال شخصيتها وحمايتها من الفناء فى شخصية الرجل. إن أعداء المساواة بين الجنسين لا يريدون أن تحس المرأة بكيانها الفردي المستقل عن كيان الرجل، لأنها يوم تحس هذا الاحساس, لن تجد نفسها مدفوعة إلى أن تعرض نفسها سلعة في سوق الزواج، يلهو بها أقدر المزايدين. بل سوف تجد أنها تكسب قوتها بعرق جبينها لا يعوقها عائق عن اختيار الرجل الذي يروق في ناظربها وفي تقديرها، ولا يفرض عليها مستبد أن تزف إلى سيد تجهله وتخشاه وتبغضه لكي يطعمها ويؤويها، فإن رفضته فالموت جوعا أو على قارعة الطريق، ولا تجزع أمام أشباح الطلاق وأشباح الزوجة الأخرى وأشباح الطاعة وأشباح الزنا وأشباح التعذيب والإذلال، التي تهدد الزوجة وتقض مضجعها.
هذا هو الذي نعنيه حين نقول إن العمل يعنى للمرأة تحررها من ربقة الرجل – أبا أو أخا أو زوجا – فإن كسب الرزق بعرق الجبين هو ركن الاستقلال الاقتصادي الذي ننشده للمرأة المصرية فى المجتمع المصرى، وإن الاستقلال الاقتصادى هو الضمان الذي يحمى المرأة من التعرض لصنوف المذلة والهوان التي تلقاها على يد الرجل.
ولكن العمل لا يعنى للمرأة تحررها من البيت، إذا كان هذا التحرر – كما هو في نظر أعداء المرأة – يعنى أن تهجر البيت وتذرع الطرقات مستهترة بالأخلاق القويمة والتقاليد الصحيحة، فإن هذا المعنى البغيض عدو لدود لقضية المرأة وتحررها وللبيت والأسرة وللمجتمع في مجموعه.
ثانيا: تعمل المرأة لأن مساهمتها في نواحي النشاط الاجتماعي المختلفة من اقتصادية وثقافية وعلمية عامل أساسي في تقدم المجتمع الذي تعيش فيه. ذلك أن حرمان نصف المجتمع من الإشتراك في تطوير هذا المجتمع وتعزيز تقدمه، لا شك يعطل هذا التقدم وذاك التطور. وقد ظهرت مساهمة المرأة في ميادين العمل مع تقدم الحياة الاقتصادية في البلاد المختلفة وخاصة مع ظهور الصناعة وازدياد الحاجة إلى الأيدي العاملة.
وقد برزت هذه الظاهرة فى مصر منذ النهضة التي صاحبت أولى انتصارات الحركة الوطنية في ميادين الإنتاج القومى. وأدى تطور الصناعة في مصر إلى ازدياد الحاجة إلى الأيدي العاملة وخاصة النساء. ولم يقتصر الأمر بالمرأة على العمل في الصناعة، بل تعداه إلى أوجه النشاط الاجتماعي والاقتصادي والثقافي التي ترتبت على النهضة المصرية الحديثة، ولا شك أن مصر اليوم مازالت في حاجة إلى مضاعفة نهضتها وتوفير أسباب تقدمها. لا شك أن مصر اليوم في حاجة دائمة إلى الأبدى العاملة الجديدة والأفكار الجديدة والعقول الجديدة القادرة على تذليل العقبات التي تقف في وجه تطورها. ولا شك أيضا في أن حرمان الجنس النسائى فى مصر من المساهمة في إمداد التطور الاجتماعي والاقتصادي والثقافي للمجتمع المصرى بنصيبه من هذه الأيدى الجديدة والأفكار الجديدة والعقول الجديدة لن يؤدى إلا إلى إضافة عقبة جديدة إلى العقبات التي تقف في وجه تطورنا وتقدمنا. ولن يجرؤ مفتر على إنكار مواهب المرأة المصرية وكفاءتها وقدرتها فيما تساهم به في الحياة العملية أو إنكار مجهودها الملموس فى المجتمع المصرى الحديث.
هذا هو جوهر المشكلة.
ونخلص مما قدمنا بنتيجة واضحة, هى أن المرأة المصرية قد نزلت فعلا إلى ميدان العمل – شاء أعداؤها أم كرهوا – وأن عمل المرأة ضرورة اجتماعية لها كفرد وللمجموع بوجه عام، إذ يخلق منها شخصية مستقلة، تكسب خبزها بنفسها دون أن تكون عالة على أحد، وتملك حريتها في اختيار شريك حياتها وفى أن تعيش حياة محترمة وشريفة. كذلك يضمن للمجتمع مساهمة النصف من أعضائه في توفير أسباب تقدمه وتطوره.
هذه حقيقة ليست محل جدل جدى, رغم مكابرة المكابرين. ولكن موضع الجدل يشير إلى مشكلة أخرى ليست هى مشكلة هل تعمل المرأة أو لا تعمل؟ بل كيف تعمل المرأة؟ إن موضع البحث اليوم يجب أن ينصب على حال المرأة في العمل، والمناقشات يجب أن تدور حول الضمانات التي تمكن المرأة من تأدية واجباتها المنزلية وهى تكسب عيشها مساهمة في إطعام أسرتها وفي مضاعفة الإنتاج القومى!
إن المشكلة الحقيقية إذن هى كيف نجعل من عمل المرأة عنصرا من عناصر تقويتها البيت وتقوية المجتمع. وهى المشكلة التي يغفلها أنصار“المرأة للبيت” عامدين, في سبيل الإيهام بقيام التناقض بين“العمل” و“البيت” وبأن نزول المرأة إلى ميادين العمل يؤدى بها إلى إهمال البيت وإضعافه وتحطيمه. لابد إذن من بحث ظروف المرأة في العمل !
نزلت المرأة المصرية إلى ميدان العمل. وقد تجلت هذه الظاهرة في أعقاب الحرب العالمية الأولى، ومارست وجوه النشاط العامة وخاضت ميادين الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
فبعد أن كانت المرأة المصرية لا تعمل إلا في الزراعة، نرى أنه في سنة ۱۹۲۷ وصل عدد النساء المشتغلات إلى ٨٤۰۰۷۸ امرأة، ثم قفز هذا العدد في سنة ١٩٣٧ إلى 1.363.756 امرأة.
ولعل في الإحصاء التالى المقارن أوضح دليل على تقدم المرأة المصرية في مجال العمل ونزوعها إلى التحرر من ربقة ساداتها القوامين عليها:
|
عدد النساء المشتغلات |
1927 |
1937 |
|
|
الزراعة |
523.942 |
703.121 |
|
|
الصناعة |
46.347 |
47.038 |
منهن 8.222 في الصناعات المنتجة |
|
النقل |
1.505 |
1.012 |
|
|
التجارة |
42.160 |
60.152 |
|
|
الإدارات العامة |
1.057 |
520 |
|
|
الخدمات الاجتماعية |
14.965 |
16.068 |
|
|
الخدمات الشخصية |
86.877 |
69.039 |
|
|
حرف غير منتجة ومجهولة |
122.224 |
466.786 |
|
|
مجموع النساء المشتغلات |
840.078 |
1.363.756 |
|
|
بدون حرف |
5.2444.79 |
5.504.609 |
|
|
الجملة |
6.083.557 |
6.868.645 |
(الإحصاء السنوي للجيب سنة 1947).
ومن دراسة هذا الإحصاء يتضح أن نسبة زيادة عدد النساء المشتغلات – وتبلغ ٥٠٤,٦٠٩ امرأة – أعلى من نسبة زيادة السكان في العشر سنوات التي تنتهي في سنة ۱۹۳۷ ويتضح هذا حين نرى أن عدد النساء القابعات في دورهن لم يزد إلا بنحو ۲۸۰۱٣٠ امرأة.
ولعل أول ما يستلفت النظر في هذين الإحصاءين أن المرأة لم تكن موزعة توزيعا عادلا على وجوه النشاط المختلفة. فهن فيما عدا بعض المهن المحدودة كالزراعة والصناعة والمهن الحرة وبعض الخدمات الاجتماعية يعملن أعمالا يسيرة تافهة غير ذات أثر فى الإنتاج. ففى النقل والتجارة مثلا، بل وفي بعض فروع الصناعة ذاتها، لا يتولين إلا أعمالا صغيرة جانبية. هذا إلى جانب بعض الحرف التي تعتبر حرفا وضيعة كالخادمات وصاحبات المهن المجهولة.
وهكذا بقيت النساء – غالبا – بعيدات محرومات من الأعمال المنتجة ذات الشأن. فكيف يسوغ إذن أن تحرم النساء القديرات من الأعمال الرئيسية ؟ وكيف يحق أن يقتصر نشاطهن على الأعمال البسيطة التافهة ؟
وليست مهمة المرأة فى مجال العمل لكي تأكل وتعيش وأن تكفى نفسها كفاية اقتصادية فحسب، بل يجب أيضا أن تقوى شخصيتها وتنمى مداركها العلمية والثقافية والفنية، حتى تشعر أنها عضو عامل منتج إنتاجا مثمرا في المجتمع الذي تعيش فيه. ولن يتسنى هذا إلا باشتراك المرأة في الإنتاج اشتراكا فعالا, وتوليها الكثير من المسئوليات الهامة في جميع ميادين النشاط الاجتماعى.
المرأة في الصناعة: بلغ عدد العاملات في الصناعة في عام ١٩٤٥ – 16.016 عاملة. وكانت صناعة النسيج والملابس هدف معظمهن فبلغن فيها 9.286 عاملة. ويمثل هذا الرقم خمس الأيدي العاملة في صناعة النسيج, وهي من أهم الصناعات فى الاقتصاد الصناعى المصرى وبلغت في الارتقاء جدا كبيرا.
وإن أبرز ما يستوقف النظر فى العاملات المصريات أن أغلبهن غير متزوجات. بل إن نسبة كبيرة منهن صغيرات السن لم يبلغن الخمس عشرة عاما. فالإحصاءات تدل على أن ۳.۱۰۷ عاملة منهن أصغر من ١٥ سنة وأن 12.909 عاملة فوق ١٥ سنة. أما المتزوجات فهن أقلية ضئيلة لا تكاد تذكر.
وتنال العاملة فى الصناعة أجرا تافها يصل إلى ثلث أجر العامل المتوسط الذي يمارس نفس العمل الذي تؤديه. ورغم تفاهة الأجر ورغم تعرض العاملة لمخاطر العمل، فإنها محرومة من كافة الضمانات الاجتماعية. وقد لمس بعض المهتمين بالمسائل العامة هذه الحقيقة فطالبوا بإصلاح الأحوال, ومن هذا القبيل ما نشرته جريدة الزمان في يوم ۱۲ إبريل سنة ١٩٤٩، قائلة“ولعل من المؤسف حقا أن العاملة فى مصر لا تدرى من أمر نفسها شيئا إلا ساعات العمل الذي تؤديه لقاء أجر يومى تتقاضاه أسبوعا بأسبوع، راضية مطمئنة ولا تعمل للمستقبل أى حساب. فإذا ما انقطعت عن العمل لسبب أو لآخر فإنها لا تعرف لنفسها حقوقا. فما هو السبب فى ذلك؟ لاشك أنه الجهل الذي يسود العاملات فيحول بينهن وبين المطالبة بأى حق أو تأمين اجتماعي أو ما شابه ذلك. سألت بعضهن عن الضمانات التى تكفلها لهن الحكومة والمصانع فلم يجبن بأكثر من نظرات حائرة تدل على عدم فهمهن لشئ مما أقول…… لقد دفعتهن الحاجة إلى العمل من أجل العيش وهذا هو كل شئ عندهن. فإذا ما تزوجت العاملة تركت المصنع وكأنها لم تعمل به يوما واحدًا. وإذا حلت كارثة تحملتها وحدها دون أن يقدم المصنع لها مساعدة معينة. ولعله من المضحك والمؤسف في نفس الوقت أنك تجد فى المصنع الواحد صندوق إعانة للعمال فقط، وليس للعاملات نصيب فيه, مع أن جزءا من رأس مال هذا الصندوق تدفعه العاملات إذا ما بدرت من إحداهن مخالفة ووقعت عليها عقوبة مالية.
“ولقد تساءلت هل من حق العاملات الاشتراك في النقابات العمالية أسوة بالرجال حتى تتاح لهن فرصة المطالبة بحقوقهن لدى أصحاب الأعمال إذا ما هضمت هذه الحقوق. وقد أجاب الرجال بأن التقاليد في مصر تأبى على المرأة الاشتراك في النقابات, لما يترتب على ذلك من اجتماعات في أوقات متأخرة من الليل لا تتناسب وطبيعة المرأة…
“وكثيرا ما يدفع البؤس والفاقة بعض المتزوجات العاملات إلى الاستمرار في عملهن. ولكن بعض الشركات والمصانع الكبيرة تحارب هذا الاتجاه وتفضل الصغيرات في السن ولا تسمح للمتزوجات بالإشتغال. وذلك راجع إلى أن أجور الصغيرات أقل بكثير من أجور الكبيرات. ثم إن المتزوجات علاوة على ارتفاع أجورهن نسبيا يضطرون من حين إلى آخر إلى الإنقطاع عن العمل في شهور الحمل الأخيرة وعند الوضع وهذا يؤدى إلى نقص الانتاج وقد علمت أنه يحدث في بعض الشركات أن تشتغل العاملة المتزوجة أو المطلقة على اعتبار أنها عذراء، ولكن سرعان ما تطرد إذا اكتشف أمرها“.
واختتمت الجريدة مقالها منادية“هذه هي حالة العاملات فى مصر كما شاهدتها. ولا يسعنى إلا أن أطالب المسئولين بالعمل على رعايتهن بالتثقيف والتوجيه الصحي السليم والإرشاد الاجتماعى الصالح. فهن فئة لا يستهان بها، ولو رعيناها لنهضنا بعدد كبير من بنات مصر من حقهن على الدولة أن ترعاهن وتحفظ مالهن من حقوق“.
وقد أصابت الجريدة عين الحقيقة حين أشارت إلى تفضيل الشركات والمصانع تشغيل الصغيرات حديثات السن على المتزوجات. فبالإضافة إلى أن العاملة المصرية لا تنال أجرا مساويا لأجر الرجل – وهذا ظلم واضح – فإن تشغيل الحديثات فى السن ينافى المبادئ المعمول بها في الدول المتمدينة من تحريم هذا التشغيل.
كذلك التقاليد تدفع بالعاملة حين زواجها إلى هجر العمل والتفرغ للبيت, إذ تخيم على تفكير العاملة المصرية ظلال قاتمة من دعاوى أعداء المرأة أنصار فكرة“المرأة للبيت“. فهى سريعة الاستسلام إلى الخضوع للرجل، تجعل من نفسها تابعة له عالة عليه، وتحطم بيديها – إن لم تكن مضطرة – فرصة استقلالها الاقتصادى الذى يضمن لها الارتقاء بشخصيتها وكرامتها إلى مستوى الزوج، وتتحول بالتالى إلى فريسة سهلة للرجل وامتيازاته لا تقوى على معارضته, أو تقويمه !!
فاذا ما أغفلنا سياسة أصحاب الأعمال وأحكام التقاليد البالية وجدنا الواقع يحرم العاملة المصرية من فرصة العناية ببيتها طالما بقيت عاملة. فهى تعمل لساعات طويلة تزيد عن الحد المتبع في البلاد المتمدينة مثل فرنسا وإنجلترا, أميركا وغيرها. وليس فى المصانع المصرية ما يوجد في تلك البلاد من أماكن لرعاية أطفال العاملات في وقت العمل.
كل ذلك يحدو بالعاملة أن توقف نشاطها على الزوج والبيت حين تتزوج.
وكان من أثر انصراف العاملات إلى البيت حين يتزوجن أن أدركن مصيرهن المحتوم وأهملن العمل على استكمال حقوقهن وتحسين ظروف عملهن ومستقبلهن كعاملات، كالمطالبة بنظام التأمين الاجتماعي أو الاشتراك في النقابة، لذلك بقين في مستوى خفيض يحلمن فيه بالزواج ليخرجن من هذا الجحيم ساعيات بأقدامهن إلى ما قد يكون أشبه بالجحيم أو أشد سعيرا !!
لذلك إذا ضمنا للعاملة المتزوجة حق العمل، فلن يطول بنا الوقت حتى نرى العاملة تدرك حقوقها وتعمل على تحسين ظروفها في العمل لرفع مستواها وتمكينها من القيام بواجبها المزدوج فى العمل والبيت معا.
وليس هذا الرأى وليد الفكر المجرد، بل إنه وليد الحوادث وخبرة البلاد المتمدينة وخصوصا إنجلترا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، إذ اتخذت العاملات فيها من عبارة“نفس الأجر لنفس العمل” شعارا دائما الجدول أعمال/ النقابات فتساوت العاملات بالعمال في أغلب هذه البلاد.
نرى مما تقدم أن حق العاملة المتزوجة فى العمل هو حق حـيـوى لنفسها ولأسرتها بل وللمجتمع. فالغالبية العظمى من العمال في مصر تعيش دون المستوى الأدنى للمعيشة. ولذلك يعتبر الاعتراف للعاملة المتزوجة بحق العمل وتيسير ظروف عملها من الضروريات اللازمة لرفع مستوى حياة الأسرة المصرية.
ولقد تعرض الأستاذ جريتلى في كتابه“تركيب الصناعة الحديثة في مصر” إلى مستوى المعيشة للعامل المصرى فقال:
“في يوليو سنة ١٩٤٢ أجرى قسم الاحصائيات تحقيقا عن المصروفات الضرورية لعامل له زوج وأربعة أطفال ليأكل ويلبس ويسكن في المستوى الأدنى فاتضح أنه يحتاج إلى ٤٤٠ قرش فى الشهر، بينما كان متوسط الأجر الشهري ۲۹۲ قرشا. وحتى بعد أن استبعدت لجنة الإحصاء اللحم والبيض والسمك والصابون من المصروفات السابقة (الملابس والأدوية لم تحسب مثلا), أصبح المبلغ الذى يحتاجه هو ٣٤٦ قرشا فى الشهر. وهذا يوضح لنا أن أغلب العمال يعيشون تحت مستوى المعيشة“.
ولما ازداد عدد العاملات من النساء فى الصناعة والتجارة صدر القانون رقم ٨٠ لسنة ١٩٣٣ لتنظيم عمل النساء وحمايتهن. فحدد الحد الأقصى لساعات العمل بتسع, مع يوم راحة فى الأسبوع، ومنع العمل الليلي لهن، والعمل الخطر، والعمل الذى يؤدى تحت الأرض. كما خول العاملة الحق في أجازة بأجر شهرا كاملا قبل الوضع وخمسة عشر يوما بعد الوضع مع استمرارها في العمل. ولا يجيز القانون لصاحب العمل أن يتخذ تلك الحالة ذريعة لطرد العاملة.
ولكن هذا القانون قد ولد ميتا. فأصحاب الأعمال لا يقبلون في مبدأ الأمر تشغيل العاملات المتزوجات بل إنهم يطردون العاملات إذا تزوجن.
هذا هو شأن المرأة المصرية العاملة فى الصناعة. وهو شأن لا تحسد عليه قطعا !!
المرأة فى الزراعة: يبلغ عدد سكان الريف المصرى حوالى ١٥ مليونا نصفهم من النساء. وبدل إحصاء سنة ١٩٣٧ على أن عدد النساء العاملات في الزراعة يبلغ 703121 امرأة. ويقصد الاحصاء بالعاملات في الزراعة أولئك النساء اللاتى يؤجرن عملهن للغير في الزراعة. على هذا أن الإحصاء ليس مؤداه أن باقى النساء قابعات فى خدورهن مستكينات، بل على العكس تقف نساء الريف المصرى بجانب أزواجهن أو أسرهن يشاطرنهم أعمالهم الشاقة في الحقل بجانب أعباء المنزل العادية. فالمرأة الريفية تنهض قبل مطلع الشمس لتهيئ الأمور العادية فى بيتها, ثم ترافق زوجها أو رب أسرتها أو تلحق به في الحقل، تقف بجانبه فى وهج الشمس وحرارتها، منحنية على الأرض تجمع الأعشاب أو تبذر الحبوب بل إنها تقوم في أحايين كثيرة بتهيئة التربة للزراعة، فتمسك بالفأس كالرجل تهوى بها على الأرض تشقها وتمهدها للبذر. حتى إذا حان وقت الغداء استحضرت الطعام من دارها لتشاطر زوجها أو أسرتها إياه, ثم تعود مرة ثانية إلى أرض الشقاء، فتظل تكد وتكدح حتى مغيب الشمس لتؤوب إلى بيتها, تكاد تدفع نفسها دفعا من شدة التعب لتقوم بأعمال المنزل الأخرى من جديد!!
وإذا لاحظنا أن الحياة في الريف حياة شاقة جامدة، وإذا لاحظنا أن منزل الفلاح خال من أبسط اللوازم الصحية, ضيق بما فيه من إنسان وحيوان, لأشفقنا على سيدة المنزل من التبعات التي تقع عليها في أداء واجباتها المنزلية. فهي التي تعد الطعام، وهى التي تصنع الخبز، وهي التي تجمع الوقود، وهى المسئولة عن توفير المياه في بيتها وغير ذلك كثير من الأمور التي لا تتولاها ساكنات الحضر.
وإذا كانت ربة البيت فى الريف في كفاح وكد مقيمين, فالعاملات الزراعيات يعملن في ظروف أسوأ، ينشأن في شقاء العمل منذ نعومة أظفارهن. فهن يبدأن الاحتراف بالعمل قبل سن الثامنة بأجور تافهة. وأجر العاملة الزراعية بين سن الثامنة والسادسة عشر لا يزيد على أربعة قروش يوميا في أحسن الظروف، بل وفى تشريعات الحرب التي قررت الحد الأدنى للأجور. أما حين تتزوج العاملة فهى تضطر إلى ترك العمل فتلحق بأرض زوجها إن كان له أرض, وإلا تبقى فى عملها المستقل إذا سمح لها بذلك الزوج.
وللأب عيروط کتاب شیق أسماه“الفلاحون” تعرض فيه المثال مما تبذله الفلاحة المصرية من جهود عظيمة فى الزراعة، لاسيما في الكفاح من أجل القضاء على الآفات الزراعية التي تهدد المحاصيل، وخصوصا دودة القطن.
ومن المعروف أنه كان للفلاحة المصرية نصب كبير في التخفيف من ضرر إصابات الدودة لمحصول القطن في هذا العام. ولا يجدر بنا أن نغفل ما لقيام الفلاحة بالأعمال الزراعية – استقلالا أو مشاركة – من أثر كبير للحد من ناب الفقر العميق المتغلغل في الريف المصرى, ذلك الفقر الذي هو أس بلاء الأمراض الكثيرة المتوطنة هناك والجهل الغامر الذي يخيم على الفلاحين.
ولقد تكالب الفقر والجهل والمرض على الفلاحة المصرية تكالبا أودى بجزء كبير من نشاطها وأضعف نسلها. فالفلاحة تلد دون مساعدات طبية. ويرجع هذا إلى خوفها الناجم من الجهل والخرافات الشائعة.
وإذا كان من الأصول الطبية للولادة أن تقبع الوالدة في راحة بعد الولادة, فإن الفلاحة لا تؤمن بهذه الأصول. فلا تكاد تفرغ من الولادة حتى تنهض في اليوم التالي لتؤدى أعمالها الشاقة فى البيت والحقل كاملة. ونتج من ذلك أن لحق الموت عددا كبيرا من الأطفال ووصلت نسبة الوفاة بينهم ١٥٢ في الألف وهي نسبة فادحة لا سيما بمقارنتها بحال الدول الأخرى.
هذه صورة ساذجة سريعة لحياة الفلاحة المصرية المليئة بالنشاط والشقاء, والتي تلعب دورا هاما في الإنتاج المصرى الزراعي.
المرأة فى ميدان الخدمات العامة: ضربت المرأة بسهم وافر في الخدمات العامة. ففي إحصاء سنة ۱۹۳۷ نجد أن 16.068 امرأة يشتغلن في الخدمات العامة، منهن ٤٠٠٠ مدرسة و ۷۰۰۰ موظفة أخرى. ولم يكن لهذه الطائفة من النساء الحق في الجمع بين العمل والزواج. ولكن المرأة المصرية جاهدت في التحرر من هذا القيد، غير أن هذا الجهاد لم يثمر في جميع ميادين العمل التي ولجتها. فمازالت عاملات التليفون محرومات من ذلك الحق الطبيعي. وحتى من نلن هذا الحق من الموظفات والمدرسات صادفن في ممارسته صعوبات مادية، أبرزها خصم جزء من مرتبهن عند الزواج مقابل علاوة الزوج، وتحديد عطلة الوضع بثلاثة أسابيع غير مدفوعة الأجر، في الوقت الذي تكون في أشد الحاجة إلى مرتبها وما يزيد عليه.
وليت الصعوبات تقتصر على ما قدمنا بل تقوم أمام الموظفة المتزوجة مشكلة أخرى، وهى كيف ترعى طفلها أثناء العمل، وليست هناك دور الحضانة التي تخصص لرعاية الأطفال أثناء عمل الأمهات. وليس في مقدور الأم أن تتحمل عبء استخدام مرضعة أو مربية بينما مرتبها لا يكاد يكفى ضرورات الحياة.
ولعل المسئولين في وزارة المعارف العمومية لم يلاحظوا هذه الأمور لما تبين لهم التناقض المضطرد في عدد المدرسات وعجز الوزارة عن فتح مدارس جديدة بسبب هذا النقص. وليس من شك فى أن تذليل هذه العقبات التي تعترض طريق المدرسة المصرية عند زواجها سوف يمكن الحكومة من استخدام كفاءات فائقة أقعدتها هذه العقبات عن العمل!!.
والموظفات عموما في هذا الصدد أمام أمرين عليهن أن يخترن أحدهما:
الأول: أن تستمر الموظفة في العمل وتضحي بحق طبيعي لها وهو حق الزواج والأمومة.
والثاني: أن تتزوج وتترك العمل مصدر استقلالها ورخائها ورفع مستوى حياتها. والاتجاه العام الملحوظ فى هذه الآونة هو تفضيل الحياة المنزلية وهجر الهدف الذى سعين إليه فترة طويلة شقين فيها حتى وصلن إليه.
ولا تقتصر مشاكل النساء فى العمل على ما سردناه. بل إن الوظائف التي يصلن إليها – في غالب الأحوال – لا يتعدينها إلى المناصب العليا. فأرفع منصب تولته المرأة المصرية حتى اليوم هو منصب مراقبة مساعدة في وزارة المعارف، وهو منصب – على أهميته – لا يعتبر لغير المرأة نهاية المطاف أو محط الأنظار. وبقيت الوظائف الفنية كالقضاء والسلك السياسي محرمة على المرأة حتى اليوم.
وقد تخرجت في كلية الزراعة هذا العام أول دفعة من الطالبات المتحمسات للعمل في ميدان التخصص الذى انصرفن إليه. ولكن وزير الزراعة السابق رفض إلحاقهن بالأعمال التى يتطلعن إليها وجاهدن في سبيلها ما جاهدن.
وهذه أحاديث بعض الخريجات إلى مجلة (الاثنين):
الآنسة عفاف الصيفى –“سيذكر التاريخ يوما أن الفتاة المصرية اكتسحت كل شيء أمامها حتى“شغل الغيط“… لقد كانت أمنيتي معقودة على أن أكون معيدة بكلية الزراعة، فحرمت نفسى من الراحة لأحصل على درجة“جيد“. وحدث هذا فعلا… وبعد ذلك يأتى معالى أحمد باشا عبد الغفار فيوصد فى وجوهنا أبواب العمل!”
الآنسة روحية إبراهيم -“هل تظن أنه من العدل أن يهدم مستقبلنا بعد أن ظللنا نعمل ونكافح أربع عشرة سنة كاملة في سبيل التعليم؟ لقد قال لنا العميد أن الكلية ستستعين بنا كمعيدات وأن الوزارات ستتخاطفنا… واليوم بعد أن ظفرنا“بالبكالوريوس” أنكروا علينا حقوقنا“.
وقد رأت“الاثنين” أن تستطلع رأى وزير سابق للزراعة هو الأستاذ فؤاد سراج الدين باشا فأدلي بما يلى:
“إني أرى أن المجال متسع أمام هؤلاء الخريجات في بعض أقسام وزارة الزراعة كقسم تربية النحل وقسم الدواجن وقسم الصناعات الزراعية وغيرها من الأقسام. بل إن العمل في مثل هذه الأقسام الفنية يجب قصره على الفتيات الحاصلات على“البكالوريوس“.
“إن الفلاحات الجاهلات في الريف يقمن بنصيب كبير فما بالك“بفلاحات” مثقفات متمرنات؟
“إن الواجب علينا أن نشجع هؤلاء الخريجات بإفساح الطريق والوظائف أمامهن، تقديرا لكفاحهن الشاق الطويل. وإلا فما معنى أن تقبلهن كلية الزراعة طالبات فيمضين فيها أربع سنوات أو يزيد، ثم تغلق بعد ذلك في وجوهن الأبواب… إنى آمل أن ينظر زميلي أحمد عبد الغفار باشا في أمر هؤلاء الخريجات نظرة تقدير وتشجيع…!”
المرأة في ميادين العلوم والفنون والآداب: إن نصيب المرأة المصرية في هذه الميادين نصيب مشرف حقا. فقد ازداد عدد خريجات الجامعة المصرية زيادة مبشرة تدعو إلى التفاؤل. واتجهت المرأة كثيرا نحو الأعمال الحرة فمارست الطب والمحاماة والصحافة والكتابة والفنون. بل نجد إن المرأة المصرية قد احتلت مكانها كذلك فى هيئات التعليم الجامعية. فكلية العلوم فيها عدة من المعيدات، وكلية الآداب بها مدرستان، وهو حدث – وإن كان نادرا – يدل على تفاهة الحجج التي يتذرع بها أعداء المرأة حين يزعمون أنها عاجزة من القيام بأعمال الرجال.
وفي ميدان الخدمات الصحية بلغ عدد الممرضات والطبيبات والحكيمات نحو ١٦ ألف تقريبا.
واندفعت المرأة إلى ميدان التجارة والحرف والأعمال اليدوية ووصل عدد المشتغلات فيها إلى 60.152 منهن 1.575 من صاحبات الأعمال.
وقد أكدت المرأة نجاحها في كل باب طرقته رغم مالاقـتـه مـن عوائق ومشاق، وأثبتت شجاعتها، وكشفت عن مواهبها المخبوة في البيت، حتى أضحى اشتراكها في ميادين الحياة العامة لازم لحياة الأمة المصرية وتقدمها.
وهكذا تكفلت الحوادث بهدم شعار“المرأة للبيت” وأثبتت أنه خيال وأضغاث أوهام، وأنه لن يؤدى فى إقراره إلا إلى التخريب والتحطيم. فلنتصور مثلا ماذا يحدث لو أحجمت المدرسات عن الذهاب إلى عملهن وبقين في البيت لأنهن نساء! ولنتخيل ماذا يحصل لو قعدت الحكيمات والممرضات في خدورهن مستجيبات إلى نداء“المرأة للبيت” ؟! بل لنذهب إلى أبعد من هذا ونفترض أن نساء صناعة للنسيج قبعن فجأة في عقر دورهن وتركن أعمالهن في المصانع فماذا يمكن أن يحدث لتلك الصناعة الهامة؟.
ولماذا نذهب بعيدا والفلاحات قريبات من الخاطر؟ ماذا يمكن أن يقول أعداء المرأة لو أخذ هذا العدد برأيهم, ووقفن على أعتاب بيوتهن وتركن الحقول بما فيها؟! أية مجاعة يقاسيها الشعب المصرى يومئذ ؟؟
إن عمل المرأة خارج البيت ضرورة اجتماعية واقتصادية كعملها داخله. ومادام الأمر في هذا الوضوح فلا جدوى من إضاعة الوقت في الجدل العقيم مهما كان عنيفا. بل يجب أن تبذل الجهود من أجل تخفيف الأعباء التي تقاسيها المرأة فى العمل وتعوقها عن أداء واجبها المزدوج.
ولقد سبقتنا جميع الدول المتحضرة إلى إنشاء دور حضانة وحدائق لرعاية أطفال النساء المشتغلات أثناء تأديتهن العمل. وقد بلغ عدد دور الحضانة في إنجلترا سنة ١٩٤١ نحو 195 ترعى ۸۰۰۰ طفل، وقد أنشئ فيها منذ ذاك ۲۰۹ من هذه الدور، ومثلها فى طريق الإنشاء. ويبلغ عدد دور الحضانة في فرنسا نحو الخمسمائة.
ليس في مصر دور من هذا النوع. وهذا يفسر الصعوبات القاسية التي تواجه الأمهات المشتغلات مهما كانت ميادين أعمالهن وتدفع بالمرأة المصرية دفعا إلى هجر العمل أو إهمال الطفل شريدا فى الطرقات، مادامت لا تملك الوسيلة لجلب خادمة ترعاه أثناء غيابها.
لذلك يجب على الحكومة والهيئات العامة أن تيسر على الأمهات المشتغلات – عاملات وموظفات ومدرسات – مشقة رعاية أطفالهن، حتى يستطعن أن ينهضن بأعبائهن الشاقة فى البيت وفي الإنتاج. ويجنى بذلك للمجتمع ثمرات ما يبذله هذا النصف من أعضائه من مجهودات نافعات في سبيل تقدمه وارتقائه.
المرأة المصرية محرومة من الحقوق السياسية، محرومة من حق الانتخاب وحق الترشيح لعضوية البرلمان. وهذا الحرمان يتوج كل نواحي الإجحاف الواقع على المرأة فى المجتمع المصرى، وهو حرمان مناف لأبسط مبادئ الديمقراطية. فالديمقراطية تفترض الاعتراف بالحقوق السياسية لجميع أفراد المجتمع دون تفرقة بين غنى أو فقير, كبير أو حقير، وتفترض اشتراك الشعب في الحكم عن طريق اختيار ممثليه فى الهيئات البرلمانية بالانتخاب العام. فإذا منعنا نصف أفراد الأمة من التمتع بالحقوق السياسية، وإذا حرمنا نصف الشعب من حق اختيار ممثليه في الهيئات البرلمانية بالانتخاب العام، فقد خرجنا على المبادئ الأولية للنظام الديمقراطى، وألفينا أمامنا نصف ديمقراطية لا ديمقراطية كاملة ووجب علينا – لملاقاة التناقض بيننا وبين أنفسنا – أن نحول دون هذا الانتقاص الصريح من النظام التمثيلى وأن نكمل النقص بمنح النصف الآخر من المجتمع حقه في التمتع بمزايا الديمقراطية.
إن اشتراك النساء في حياة المجتمع السياسية ركن رئيسي من أركان النظام الديمقراطي الصحيح، وعامل أساسى من عوامل التطور والتقدم في هذا المجتمع. فليست النساء في المجتمعات الحديثة عنصرا خاملا يعيش على هامش الحياة كما يريد أعداء المرأة، لا حق له فى الاشتراك في حياة المجتمع السياسية، أى فى الحكم، بل هن نصف الشعب، لهن من الأهمية في حياة المجتمع وتطوره ما للنصف الآخر. وقد أثبتن أنهن يستطعن المساهمة في ميادين العمل والثقافة والعلوم على قدم المساواة مع الرجل، ويقدرن على أن يحدثن في حياة أوطانهن ما يحدثه الرجال وأن يقدمن له أجل الخدمات.
وليست النساء جانبا من المجتمع معزولا عنه لا يحس بآلامه وحاجاته ولا يحسن تقديرا ولا توجيها، فلا جدوى من اشتراكه في حياة المجتمع السياسية أي في الحكم. بل هن مواطنات مرهفات الحس والشعور، تتردد في صدورهن أصداء الحياة الاقتصادية والاجتماعية والوطنية، فيلمسن حاجات بلادهن وشعبهن فى الشئون الداخلية والخارجية, ويصطدمن في كل يوم بمشكلات المجتمع الرئيسية فى الغذاء والملبس والمسكن والأطفال والعلاج والتعليم وغيرها.
ليس حرمان المرأة من الحقوق السياسية إذن ظلما واقعا عليها فحسب، بل هو عقبة ضارة بتقدم الشعب وتطوره، وانتقاص صارخ من الديمقراطية التي يتبناها الرجال.
ولكن لتنصت قليلا إلى عويل أعداء المرأة حين يخدعون الرأى العام بالأباطيل إبهاما بصوابهم. يزعم هؤلاء السادة فى أبراجهم العاجية أن المرأة لا يصح أن تباشر الحقوق السياسية التي يباشرها الرجل، لأن في ذلك صرفا لها عن دورها فى المجتمع وهو العناية بالبيت وتربية الأطفال.
“المرأة للبيت” دائما“المرأة للبيت“!!
ومرة أخرى نقول لهؤلاء السادة إن المرأة – شاؤوا أم كرهوا – قد اشتركت فعلا في الحياة السياسية في أغلب بلاد العالم، ولم يعد ثمة مجال لردها عنها، كما اشتركت من قبل – شاؤوا أم كرهوا – في ميادين العمل.
وقد نالت المرأة حقوقها السياسية فى الهند والصين وغيرها من بلاد التقاليد الشرقية، ومع ذلك لم يجرؤ مفتر على الزعم بأن الأسرة في الهند قد تحطمت وانحلت, أو أن البيت فى الصين لم يعد له كيان يعتد به.
إنه من سخف القول حقا أن نزعم أن اشتراك المرأة المصرية مرة في كل خمسة أعوام فى التصويت فى الانتخابات العامة سوف يصرفها عن بيتها وأسرتها وأولادها. فإن هذا المنطق المقلوب يستتبع حتما أن نعتبر اشتراك الرجل في هذا التصويت صرفا له عن عمله المنوط به طبيبا كان أو مهندسا أو موظفا، ويستتبع حتما أن نعتبر نظام الانتخاب الديمقراطي صرفا للشعب في مجموعه عن الإنتاج والعمل والنشاط الاجتماعي في ميادينه المختلفة. وهكذا يصل بنا منطق هؤلاء السادة إلى استنكار المبادئ الديمقراطية وتحطيم صرح البرلمانية والنظام التمثيلى. أليست كلها تصرف الشعب رجالا ونساء عن العمل؟ وفى هذا التدليل الواضح أكبر برهان على أن أعداء المرأة هم أعداء الديمقراطية ؟
وينثنى هؤلاء السادة فى منطقهم الملتوى، فيزعمون أنهم يعنون المرأة المرشحة لعضوية البرلمان والمناصب السياسية الكبرى كمناصب الوزراء والسفراء وغيرها. ولكننا نلاحقهم دائما بكشف أباطيلهم الصارخة، فإن اشتراك المرأة في عضوية البرلمان أو المناصب السياسية المختلفة ليس إلا نوعا من العمل تؤديه المرأة في المجتمع تماما كالمدرسة والطبيبة والعاملة والفلاحة. وقد أورينا من قبل أهمية عمل المرأة لها وللمجتمع في مجموعة، وأورينا أن الجمع بين العمل ورعاية البيت لا يتضمن ذرة من التناقض لا سيما إذا صرفنا جهودنا إلى معاونة المرأة في عملها بتوفير الأسباب والظروف التي تمكنها من القيام بواجبها المزدوج، والتي تجعل منها بحق“المرأة للمجتمع“.
إنه من سخف القول حقا أن نزعم أن اشتراك المرأة في البرلمان أو المناصب السياسية الأخرى سوف يؤدى إلى إهمال البيت وتشريد الأطفال. فإن هذا المنطق المقلوب يستتبع حتما أن نعتبر اشتراك الرجال من الأطباء والمدرسين والمحامين والعمال فى البرلمان أو الوزرات تحطيما للطب والتعليم والمحاماه والصناعة, ويستتبع حتما أن نعتبر نظام الانتخاب الديمقراطي صرفا لأقسام الشعب المختلفة من أصحاب الحرف والمهن عن حرفهم ومهنهم، وتعطيلا للإنتاج في المجتمع. وهكذا يصل بنا منطق هؤلاء السادة إلى استنكار المبادئ الديمقراطية وتحطيم صرح البرلمانية والنظام التمثيلي. أليست كلها لتصرف الشعب رجالا ونساء عن العمل؟
وفي هذا التدليل الواضح أيضا أكبر برهان على أن أعداء المرأة هم أعداء الديمقراطية.
وقد ينثنى هؤلاء السادة مرة أخرى فى منطقهم الملتوي فيقررون أن الرجال الذين ينصرفون عن مهنهم إلى السياسة يتركون غيرهم من المنصرفين إلى تلك المهن وبذلك لا يتعطل الإنتاج. وفى هذا القول وحده القضاء المبرم على مزاعمهم. إذ لن يبقى على النساء المشتركات فى المناصب السياسية إلا أن يأتين بمن يعينهن على ما يفوتهن أداؤه من مهام البيت ومشاغل الأسرة.
وينتهى هذا النوع من الجدل العقيم عند هذا الحد. فإنه من سخف القول حقا أن تطالب المرأة التى بلغت بها الثقافة السياسية والاهتمام بالمسائل العامة ومحبة الشعب إلى مقاعد الحكم، بأن تنصرف إلى تنظيف الأطباق وكنس الأرض وإعداد الطعام في البيت، فإن لم تفعل أخذنا نولول ناديين“البيت” الذي تحطم وهوى والأطفال” الذين شردوا في الطرقات!!
فإذا ما أعوزت أعداء المراة الحجة فى هذا المجال ولوا منه هاربين يتلمسون الأسباب في مجال آخر تدعيما لأوهامهم وآرائهم الواهية.
لا عجب إذن أن يطالعنا هؤلاء السادة بحجة أخرى، وهي أن النساء في مصر جاهلات متأخرات فإن نسبة الأمية بينهن قد بلغت أضعافها بين الرجال. ولا يسعنا إلا أن نواجه هذه الحجة بالسخرية والتهكم والرثاء. فارتفاع نسبة الأمية في الشعب ليست، ولا يمكن أن تكون العامل الحاسم في تقرير الديمقراطية أو نفيها. ولا يمكن انتظار تعليم الشعب حتى يباح له التمتع بالنظام الديمقراطى، بل على العكس لا يمكن القضاء على الأمية ونشر التعليم إلا في ظل هذا النظام الديمقراطى نفسه. وقد عرف الشعب المصرى هذه الحقيقة بتجربته الأليمة! فقد حكم الاستعمار البريطانى مصر حكما استبداديا مباشرا نحو أربعين عاما زادت فيها نسبة الأمية بين الشعب نظرا لازدياد عدد السكان وافتقارهم إلى التعليم. فلما أدت انتصارات الحركة الوطنية إلى الحصول على الدستور في عام ۱۹۲۳ عرف الشعب المصرى فاتحة عهد انتشار التعليم وانكماش الأمية شيئا فشيئا رغم الزيادة المضطردة في عدد السكان.
وقد كانت نسبة الأمية بين أفراد الشعب المصرى حين حصل على النظام البرلماني بمقتضى دستور سنة ۱۹۲۳ أكبر من نسبة الأمية المعروفة اليوم بين النساء المصريات.
على أنه لا يجب أن يفوتنا أن نسجل على هؤلاء السادة منطقهم الملتوى مرة أخرى، وإن لم تكن الأخيرة. فإن منطقهم هذا يستتبع أن نحرم الشعب من الحقوق الديمقراطية والنظام البرلماني إذا كانت نسبة الأمية مرتفعة بين أفراده. ومعنى ذلك استنكار الديمقراطية وتحطيم البرلمانية والنظام التمثيلي الشعبي.
وفي هذا التدليل كذلك أوضح برهان على أن أعداء المرأة هم أعداء الديمقراطية.
ولقد عبر الأستاذ إسماعيل مظهر فى كتابه“المرأة في عصر الديمقراطية” تعبيرا رائعا عن أفكار أعداء المرأة وأعداء الديمقراطية حين قال:
“ليست هذه البلاد مستعمرة للرجال تدار بمحض إرادتهم وتوزن أقدارها بمقتضى أهوائهم. وليس نساء هذه البلاد مستعبدات ولسن إماء اشتريناهن بالمال، بل هن محررات بحكم الطبع وحكم القانون. هن كائنات كاملات الحرية كاملات الإنسانية كاملات الحقوق. أما أن نقول عكس ذلك ثم ندعى أننا شعب ديمقراطي حر يعيش في أرض حرة فإن ذلك يكون أبعد شي عن منطق الواقع.
إن الذين ينكرون على المرأة حقوقها السياسية – لا يصدرون فيها عن اقتناع أو رأى صحيح. وإنما هم ينزعون هذه النزعة دفاعا عن مصالح خاصة يحاولون الاستئثار بها. فهم يمنعون عنصر المرأة عن الدخول في معترك السياسة ويحاربون هذا النظام بأظافرهم وأسنانهم لأن هذا العنصر إذا دخل ميدان السياسة فسوف يكون أداة تقلم من أظافرهم وتمنعهم عن القضم بأسنانهم. إنهم ينكرون هذا الحق على المرأة لأنهم سوف يخجلون. ولقد أصبح الخجل مرضا حادا في بيئاتنا السياسية، نطلب منه الفرار“.
وقد ضم جميع الكتاب الأحرار صوتهم إلى المدافعين عن المساواة بين المرأة والرجل، لا سيما في التمتع بالحقوق السياسية. والصحف حافلة بالآراء القيمة المدعمة لحقوق المرأة معبرة عن اتجاه الرأى العام إلى المطالبة بالاعتراف لها بهذه الحقوق. ونذكر فى هذا المجال الدكتور طه حسين بك ولطفى السيد باشا والأستاذ سلامة موسى وكثيرا من قادة الفكر الحديث.
ولقد استجاب على ماهر باشا فى سنة ۱۹۳۸ إلى دعوة الرأى العام المتقدم فاقترح قبول المرأة عضوة فى مجلس الشيوخ، ولكن اقتراحه انتهى بالرفض.
واستأنف الحملة العملية من بعده علوبه باشا والعرابي باشا وأحمد رمزی بك فقدم كل منهم مشروعا بقانون يمنح المرأة المصرية حق الانتخاب. واستند العرابي باشا فى مشروعه إلى أن الدستور المصرى يترك للمرأة حق الانتخاب بحكم نصوصه العامة، ويكفى تعديل قانون الانتخاب بما يكفل الاعتراف لها بهذا الحق. ودعم حجته بالمادة الثالثة من الدستور التي تنص على ما يأتي:
“المصريون لدى القانون سواء وهم متساوون في التمتع بالحقوق الدينية والسياسية وفيما عليهم من الواجبات والتكاليف العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الأصل أو اللغة أو الدين“.
وقد رفضت لجنة الشئون الدستورية هذا التدليل زاعمة أنه لا يمكن تطبيق المادة الثالثة من الدستور في مجال الحقوق السياسية التي تختلف كل الاختلاف عن الحقوق المدنية والشخصية.
على أن الحملة مازالت في عنفوانها مبشرة بالفوز القريب. فإن تيار الرأى العام كفيل بأن يجرف فى طريقه كل ما يصادفه من عقبات الرجعيين أعداء التقدم.
وقد استقر في أذهان القادة ورجالات الفكر والسياسة أنه لا معدى من الاعتراف للمرأة بحقوقها السياسية آجلا أو عاجلا. وعجلة الزمن تدور في قوة وعناد !!
ولكن يبقى دائما خطر أعداء الديمقراطية كامنا يترصد، ويتحين الفرصة ليثب على حقوق المرأة وثبة تسلبها كل قيمتها, وتعود بنظامنا الديمقراطي أجيالا إلى الوراء. هذا الخطر الداهم المهدد هو ما يعبرون عنه بحصر الحقوق السياسية في دائرة ضيقة هى دائرة المتعلمين من أبناء الشعب المصرى رجالا ونساء. ويؤسفنا أن نسجل أن إحدى المشتغلات بالحركة النسائية في مصر تشاطر هؤلاء السادة آراءهم الخطرة ومبادئهم الهدامة فتقول في سياق دفاعها عن حقوق المرأة ما معناه:
“كيف تبيحون للرجل الجاهل الأمى أن يساهم في الحياة السياسية المصرية بينما تحرم المرأة المتعلمة من هذه المساهمة؟ اعطوا المرأة المتعلمة حقوقها السياسية إذن، فهي أجدر بها من الرجال الأميين“!!
ونحن ننبه إلى هذا الخطر المحدق الكامن في ذلك النوع من الجدل. فإن منطق هؤلاء السادة يستتبع حتما – فى سياق المساواة المزعومة بين الجنسين – قصر الحقوق السياسية على الأقلية المتعلمة أفراد الشعب نساء ورجالا. ويستتبع بالتالي تخريب نظامنا الديمقراطى لا استكماله، إذ يحرم أغلبية الرجال في مصر من الحقوق السياسية في سبيل إعطاء أقلية ضئيلة من النساء حقوقها السياسية.
وإذا كان الدفاع عن الحقوق السياسية للمرأة في جوهره دفاعا عن النظام الديمقراطى واستكمالا لنواحى النقص فيه, لأن الديمقراطية تقوم على أساس حق جميع أفراد الشعب في اختيار نوابه وحكامه، فإن الرضاء بتحديد مبادئ الديمقراطية وقصر الحقوق السياسية على المتعلمين من أفراد الشعب توصلا إلى منح المتعلمات هذه الحقوق, ليس إلا انتهاكا لمبادئ الديمقراطية وتحطيما لصرح البرلمانية والنظام التمثيلى الشعبى.
ألم نقل إن أعداء المرأة – ولو تستروا في ثوب أنصار المتعلمات – هم دائما أعداء الديمقراطية ؟
إن كفاح المرأة المصرية فى سبيل حصولها على حقوقها السياسية جزء لا يتجزأ من الكفاح في سبيل تقوية الديمقراطية في مصر ولا يمكن أن يسمح باستخدام هذا الكفاح ضد النظام الديمقراطي نفسه. أما أولئك القانعين والقانعات بإعطاء المرأة المتعلمة فحسب حقوقها السياسية، الذين يستنكرون الاعتراف للنساء الجاهلات – بل للرجال الجاهلين كذلك – بهذه الحقوق، فالأجدر بهم أن يوجهوا جهودهم إلى المطالبة بالقضاء على الأمية فورا ونشر التعليم، حتى يحسن الشعب رجالا ونساء استخدام حقوقه السياسية، بدلا من أن يحرموا الأغلبية الساحقة من هذا الشعب من حقها الطبيعي في اختيار ممثليها وحكامها اختيارا حرا.
فالحل المنطقى للمشكلة ليس حرمان الأمية والأمى من الحقوق السياسية, وإنما هو تعليم الأمية والأمى ليحسنا استخدام الحقوق السياسية. ذلك أن الديمقراطية ليست حكم الرجال فحسب، وليست حكم المتعلمين والمتعلمات فحسب، وإنما هي حكم الشعب في مجموعه رجالا ونساء.
ولقد اتخذت مشكلة الحقوق السياسية للمرأة طابعا دوليا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وتكوين هيئة الأمم المتحدة. فقد سجل ميثاق هيئة الأمم المتحدة في مقدمته وفى مادته الأولى ضرورة المساواة بين المرأة والرجل في كافة الحقوق والواجبات. كذلك ضمن إعلان حقوق الإنسان الذي أبرمته الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة في ١٠ ديسمبر سنة ١٩٤٨ النص على هذه المساواة. بل إن الجمعية العامة للأمم المتحدة أصدرت في ۱۹ نوفمبر سنة ١٩٤٦ قرارا توصى به الدول الأعضاء فيها بتحقيق المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل، إذا كانت هذه المساواة غير مقررة فيها بعد. وألف المجلس الاجتماعي والاقتصادى التابع لهيئة الأمم المتحدة لجنة خاصة لشئون المرأة تدرس حقوقها وأحوالها في بلاد العالم المختلفة.
وهكذا يعتبر حرمان المرأة المصرية من حقوقها السياسية خرقا لميثاق هيئة الأمم المتحدة وإعلان حقوق الإنسان وتوصيات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي انضمت مصر عضوا فيها.
وليس من شك في أن هذا الموقف الشاذ الذى تتخذه الدولة المصرية من بين دول العالم المتحضرة، فيه حط من قدرها وتشويه لسمعتها في المجالات الدولية.
ولقد رأينا الحكومة السورية أخيرا تسارع إلى الاعتراف للمرأة السورية بالحقوق السياسية. ولكنها قصرت ذلك على المتعلمات! على أنه ليس من شك في أن المرأة السورية جديرة بالتهنئة على ثمرة كفاحها الذي جعل منها أول امرأة في الشرق العربي تنال الاعتراف بحقوقها – وإن كان اعترافا جزئيا محدودا – فهو خطوة لها ما بعدها.
ألم نقل إن عجلة الزمن تدور ؟!!
عرضنا في الفصول السابقة من الباب الأول أوضاع المرأة في المجتمع المصرى. ولعلنا وفقنا في إبراز المظالم التى ترسف المرأة المصرية في قيودها سواء فى حياتها العائلية أو فى حياتها الاجتماعية والثقافية والعلمية أو في مجال الحقوق السياسية. وليس من شك فى أن بيان المظالم لا يكفي، فإن جعبة أعداء المرأة لا تفرغ من الأساليب الملتوية التي يبررون بها تلك المظالم الفادحة. ولقد عرضنا أنواعا عديدة من تلك الأساليب، ويبقى أن نعرض للحجة التقليدية الكبرى, التي مازال هؤلاء السادة يرددونها في حرص وتمويه, وهي مبادئ الدين.
هل يعارض الإسلام حقا تحرير المرأة كما يزعم أعداؤها؟
حتى إذا ما انتهينا من الإجابة على هذا السؤال وبيان براءة الدين الحنيف من تهمة يلصقها به بعض ذوى الأغراض والتفسير المعوج، بقى علينا أن نوضح الأسباب الحقيقية التي جعلت من المرأة هذا المخلوق الضعيف مسلوب الحقوق. ونختتم هذا الباب ببيان أهداف المرأة المصرية ومطالبها من أجل تحريرها.
هذه إذن فصولنا الثلاث: المرأة والإسلام ثم الأسباب الحقيقية لوضع المرأة في المجتمع المصرى، وأخيرا المبادئ الرئيسية لتحرير المرأة المصرية.
“عمد زعماء الدين في كل زمان إلى ما يسلحهم به الدين من سلطة لتكون هذه السلطة برهانهم الأوحد ودليلهم القاطع في مجال الرأي. وعمدوا إلى جانب ذلك إلى تصوير الدين بأنه ذلك الشئ الجامد الصلب الذي لا يساير الزمن ولا يخضع لمقتضى ما تخضع له الأحياء من التطور والنشوء – عضويا وفكريا وعاطفيا – ظانين أن الزمن إنما يدور ولا تدور معه الأحياء ولا تختلف الأوضاع ولا تتغير المشاعر ولا تتبدل الاتجاهات، وأن ذاك الذي كان عليه الناس فى زمان ماض لا يؤثر فيه العوامل الاجتماعية والاقتصادية. عمد زعماء الدين إلى أشياء اتخذوا منها وسيلة لإقرار سلطانهم لا سلطان الدين كقولهم بالتفكير والمروق والردة…
إن الإسلام الحنيف لم يضع من الأحكام ما هو مطلق من قيود الزمان والمكان وظروف الحال بل أنه حضنا على أن نجتهد وأن نفكر وأن نتطور مع الزمان ومع الظروف (۱)”.
إن هذه العبارة ترد أبلغ الرد على المتذرعين بالدين الإسلامي في عدائهم لحقوق المرأة. ذلك أن نصوص القرآن التي تضمنت في بعض المواضع تفضيل الرجل على المرأة لم تطلق هذا التفضيل إطلاقا يدوم على الزمان والمكان وتغير الظروف والأحوال، ولم تقض على البشر أن يصموا أسماعهم وأبصارهم وتقديرهم عن حقيقة التطور الحتمى المستمر. فكما أن رجال الفقه قد اتخذوا من الاجتهاد وسيلة لاستنباط المبادئ الدينية والدنيوية فيما يجد من الظروف وما يستحدث من أحوال المعيشة والمعاملات، فإن الأحرى بهم أن يتجهوا في تقدير مطالب المرأة وجهة النظر والاجتهاد فيما يتطلبه تطور المرأة في المجتمع الحديث، بل وتطور المجتمع الحديث ذاته.
بل إن المتذرعين بالدين الإسلامى هم الخارجون عليه حين يقحمون عليه أفكارهم الجامدة الرجعية. ذلك أن روح الدين الإسلامي تؤكد فكرة المساواة والتعاون والتسامح، بل هي قائمة على أساس المساواة والتعاون والتسامح بين البشر، وتؤكد فكرة التطور ومسايرة الزمن واستحداث ما يليق بالظروف الحديثة. وقد كان الدين الإسلامى ذاته ثورة على أوضاع الجاهلية الأولى واستحداثا لما يليق بالظروف الجديدة التي عاصرت ظهوره، ومساهمة كبرى في تطوير الزمن وتمهيد السبيل للتطورات التالية. وسوف نبين هذا عما قليل.
فالقول إذن بأن الدين الإسلامى لا يقبل التطور أو مسايرة الزمن ولا يسمح برفع المظالم التي تحيق اليوم بالمرأة المصرية ولا يؤيد فكرة المساواة بين الرجل والمرأة – وهي فكرة أساسية في بناء المجتمع الحديث – هذا القول لا يمت إلى الإسلام بغير اللفظ الأجوف، بل هو خروج على الإسلام وروح الإسلام.
وليس من شك فى أن هؤلاء السادة لا يقصدون مخالفة التعاليم الدينية ولا الخروج على الإسلام. وإنما يزجون بالدين في آراء يبرأ الدين منها ويذهبون في تفسيره مذاهب لا تطيقها مبادئه ونصوصه، كل هذا ليتخذوا الدين سندا في عرقلة التقدم الاجتماعى وتكئة فى كل ما يصدر عنهم من الأفكار البالية والآراء الرجعية.
فإذا تأملنا في أحكام الإسلام فى حق الفتاة في اختيار زوجها، اتضح لنا في غير تردد أو غموض أن هؤلاء الرجعيين الذين ينكرون على الفتاة المصرية هذا الحق بدعوى التقاليد بل والدين, إنما يزورون مبادئ الدين ويقمحون عليها من خيالاتهم ما هى عنه بعيدة كل البعد. فالدين الإسلامي قد أقر حق الفتاة في إختيار زوجها، ولم يحرم الاختلاط بل أباح تعرف الخطيبة بخطيبها ومجالستها إياه. وحرم الإسلام تزويج الفتاة على غير إرادتها وجعل الجزاء على ذلك بطلان الزواج.
جاء عن عبد الله بن بريدة عن أبيه. جاءت فتاة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن أبى زوجنى ابن أبيه ليرفع بی خسیسته – قال فجعل الأمر لها فقالت قد أجزت ما صنع أبي ولكن أردت أن أعلم النساء أنه ليس للآباء من الأمر شئ.
فنحن إذن حين نستنكر حرمان الفتاة المصرية من حق اختيار زوجها المستقبل إنما نستوحى مبادئ الدين وتعاليمه ولا نحيد عنه. أما هؤلاء السادة الذين يعارضون تحرير المرأة والاعتراف بحقوقها فهم الخارجون على الدين الحائدون عن تعاليمه.
ويجدر بنا في هذا المقام أن نواجه هؤلاء السادة الذين يعارضون المطالبة بإلغاء تعدد الزوجات بالآية القرآنية الرائعة“فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة” ثم بالآية القرآنية الرائعة“ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم“.
إن مبادئ علم الفقه الإسلامي تنبئ في سهولة ويسر أن إباحة الإسلام تعدد الزوجات ليست إباحة مطلقة وليست إباحة واجبة ممتنعة على التحريم. فهى ليست إباحة مطلقة لأنها مقيدة بشروط أهمها العدل بين الزوجات العديدات، وفكرة العدل بين الزوجات في جوهرها غير قاصرة على المال أو الطعام أو الملبس. بل إنها تتجاوز هذا وذاك إلى وجوب احترام المرأة ورعاية شخصيتها وكرامتها وآدميتها. وأن يكون لها فى الرجل شريك ورفيق وصديق يبادلها الرأى ولا يفرض عليها أمره، بل أن يكون للزوجات العديدات في نفس الرجل شريك ورفيق يبادلهن الراى ولا يفرض على واحدة منهن أمره دون الأخريات. أما وقد أشار القرآن الكريم فى آية“ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم” إلى استحالة العدل بين الزوجات العديدات، وأثبت بذلك أنه لن يكون في الرجل لنسائه شريك ورفيق وصديق يحترم شخصيتهن وكرامتهن ويبادلهن الراى دون أن يفرض على واحدة منهن أمره دون الأخريات، فقد قضى بذلك على فكرة الإباحة المطلقة وجعل منها الاستثناء، إن لم تكن الاستحالة ذاتها أي التحريم.
وهى ليست إباحة واجبة ممتنعة على التحريم لأن القرآن في نصه عليها لم يحرم منعها أو يمنع تحريمها بل تركها مرسلة في قيودها ليكيفها أولو الأمر في المجتمع كيفما تقضى الظروف وتتطلب دواعي التطور والتقدم فيه. فإن استحسنوا التحريم بحكم التطور الاجتماعى فلهم أن يقروه ويأخذوا به. بل إن القرآن ذاته فيما أورده على هذه الإباحة من قيود وسدود جعلت منها الاستثناء إن لم تكن الاستحالة ذاتها, قد مهد الأذهان للتحريم والمنع وترك السبيل مفتوحا إلى إلغاء تعدد الزوجات إلغاء تاما. ألم يجعل القرآن هذه الإباحة معلقة على شرط العدل بين الزوجات حين قال“وإن لم تعدلوا فواحدة“؟ ثم ألم يثبت القرآن استحالة هذا الشرط حين قال“ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم“؟.
قد يذهب البعض إلى التساؤل عما يرمى إليه القرآن الكريم من حكمة خافية حين ترك الإباحة مرسلة فى قيودها التي جعلت من الإباحة الاستثناء إن لم تكن الاستحالة ذاتها, ولم يقض بالتحريم صراحة وجهرا. والرد على هذا التساؤل يسير غاية اليسر، فإن الإسلام – دين التطور – قد ظهر في عهد كان الرجل يجمع فيه بين عدد غير محدود من الزوجات فقضى على هذه الإباحة المطلقة وحددها بأربع زوجات. وكانت حكمة الإسلام في هذا التحديد وتجنب التحريم المباشر هى حكمته التي وضحت في تحريمه الخمر على درجات لا دفعة واحدة. فهو لم يعمد دائما إلى مفاجأة البشر أو مباغتتهم بالجديد الذى يصلح من حالهم ويقوم اعوجاجهم إذا كان هذا الجديد عسيرا عليهم، من شأنه أن يحملهم مالا يطيقون. هذه في رأينا حكمة الإسلام في عدم تحريم تعدد الزوجات تحريما باتا مطلقا، وهو يتفق ويتسق مع ما قال به فقهاء الدين عن تدرج الإسلام في تحريم الخمر من تحريمه وقت الصلاة فحسب إلى التحريم البات المطلق.
ولكن هناك فرقا بين حكم القرآن في تحريم الخمر وحكمه في تعدد الزوجات فقد ثبت حكمه في نصوصه بتحريم الخمر تحريما باتا مطلقا ولم يثبت حكمه على هذا النحو في صدد تعدد الزوجات. ولهذا الأمر في رأينا حكمة ليست خافية ولا غامضة. فإن تعدد الزوجات فى صدر الإسلام لم يكن على شئ من التنافر أو التناقض مع طبيعة الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية إذ ذاك. وبالتالى لم يكن ثمة مصلحة فى تحريمه. بل على العكس كان من شأنه تشجيع النسل وزيادة المواليد وصيانة المحاربين الذين يبعدون عن ديارهم من الوقوع في الزلل نتيجة الحرمان الطويل، ولا سيما وقد اعتادوا من قبل أن يزفوا إليهم ما شاؤوا من النساء دون قيد أو شرط.
وهكذا ترك الإسلام مسألة تعدد الزوجات يقضى فيها وفق الزمان والمكان وظروف ذاك الزمان وهذا المكان.
فإذا انتقلنا إلى مشكلة الطلاق واجهنا أنصار إباحة الطلاق المطلقة للرجل بالحديث الشريف“إن أبغض الحلال عند الله الطلاق“. فهل كان الرسول خارجا على الدين حين هاجم حق الرجل المطلق في الطلاق ؟
ونواجههم أيضا بما روى عن النبى“ذهبت امرأة ثابت بن قيس إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام تطلب الطلاق من زوجها لا لشئ سوى أنها تبغضه. قالت: يارسول الله – إني لا أطيقه بغضا. قال لها الرسول: أتردين عليه حديقته؟ وكانت هذه الحديقة المهر الذى دفع لها. قالت نعم – قال الرسول لثابت أقبل الحديقة. وطلقها تطليقة – ونفذ الطلاق فورا.
فالدين الاسلامي حين أباح الطلاق للرجل لم يترك الإباحة مطلقة ممتنعة عن التقييد والمراقبة ولم يحرم المرأة من حق طلب الطلاق على يد الحاكم.
فهو لم يترك الإباحة للرجل مطلقة ممتنعة عن التقييد والمراقبة لأنه لم يضمن نصوصه ما يفيد المنع من تقييد طلاق الرجل برقابة الحاكم – أو القاضي – ولم يوجب ترك هذا الحق المطلق فى يد الرجل يمارسه وفق أهوائه ونزواته. وفي الحديث الشريف الذى نقلناه آنفا أوضح الدليل على أن الطلاق ليس حـقـا أساسيا من الحقوق التي يثبتها الدين للرجل، بل هو رخصة مكروهة عنده بغيضة إليه. وفى هذا دعوة صريحة إلى تضييق هذه الرخصة المكروهة البغيضة، وليس أحق من الحاكم أو القاضى بأن يكون الرقيب الأمين على قيام الرجل باستخدام هذه الرخصة.
فالقول إذن بأن تقييد حق الرجل المطلق في الطلاق على يد القاضي فيه خروج على تعاليم الدين ليس إلا تفسيرا جامدا غير منطقى لأحكام الدين، بل هو الخروج على الإسلام وروح الإسلام ومروق على تعاليم القرآن والرسول!!
وكذلك الدين لم يحرم المرأة حق الحصول على الطلاق على هذا النحو الذي تعانيه المرأة المصرية. وفى تلك الواقعة التى نقلناها عن زوجة ثابت بن قيس حين طلبت إلى الرسول تطليقها من زوجها لأنها لا تطيقه كرها فطلقها منه – في تلك الواقعة الدليل الواضح على العسف الذى تلاقيه المرأة المصرية أمام القضاء حين تطلب الطلاق من زوج تكرهه أو تلقى على يديه الهوان والمذلة أو زوج مزواج يشرك غيرها في بيتها فيحيله ميدانا للشقاق والعراك، أو عربيد يقضي يومه وليله بين الخمر والنساء والقمار. إن الحالات المحصورة المحدودة التي تمنح المرأة فيها حريتها من سجنها المقيت وسجانها البغيض فيها تضييق شديد على الحرية الشخصية وإهدار لمعنوية المرأة وكرامتها. ويزيد في شدة هذا التضييق أن المرأة غالبا ما تفشل في إقامة الدليل والبرهان على أحقيتها في طلب الطلاق. وهذا التضييق ليس من الدين في شئ، بل هو مغالاة في كبت المرأة وتحطيم شخصيتها وجعلها تابعة للرجل عالة عليه دواما.
وأما حكم الإسلام فى الزنا – وهو الحكم الذي ذهب القانون الوضعي المصرى إلى نقيضه تماما – فهو الرجم للزانى والزانية معا، وليس للزانية فحسب، هو تحريم الزنا على الرجل والمرأة على قدم المساواة، دون تمييز للرجل أو التماس الأعذار له في جريمته النكراء!
ونود أن ننظر إلى وجوه أعداء المرأة وهى تربد في مواجهة هذا الدليل الحاسم القاطع! فإنهم لم يروا بأسا في أن يخرجوا على الإسلام ويحيدوا عن مبادئه لصالح الرجل، ولم ينطقوا يوما باستنكار هذا المذهب الذي ذهب إليه القانون الوضعي، ولو على سبيل الإيهام بأنهم أنصار الدين – بالقول وفى الظاهر – وإنما أخذتم اليوم حماسة الدفاع المزعوم عن الدين وتعاليم الدين، وراحوا يستنبطون الأباطيل يلصقونها بالإسلام إلصاقا، لا لشئ إلا لتضليل الرأى العام والتغرير به, لا لشئ إلا لأنهم فى جوهر الأمر – كما قال المرحوم قاسم أمين – أعداء الديمقراطية وأعداء التقدم!!
ثم نستدرج هؤلاء السادة إلى الإسلام فى ميدان الحقوق السياسية لنجد معهم في البحث عما يزعمون من معارضة الإسلام للاعتراف بحقوق المرأة السياسية. ألا يزعمون أن الاعتراف للمرأة المصرية بالحقوق السياسية خروج على الدين وعلى التقاليد ؟
فأين هذا النص الذى يقضى بحرمان المرأة من حقوقها السياسية في المجتمع الإسلامي؟ بل أين هذا النص الذى يلقى على الحقوق السياسية للنساء شبهة المنع والتحريم؟
إن الإسلام وتقاليد الإسلام براء من حرمان المرأة من حقوقها السياسية فنصوص القرآن لم تقض به. أما تقاليد الإسلام فقد علمتنا العكس من الحرمان، علمتنا الاعتراف للمرأة بحقها في المساهمة في شئون الحكم. فقد كان الخلفاء الراشدون” يستشيرون النساء فى هذه الشئون ويعلنون ذلك في غير تردد ولا تحفظ. وكانت المرأة فى عهدهم تقول وتعمل في الأمور العامة كما كان الرجال يقولون ويعملون. وكان عبد الرحمن بن عوف يشاور النساء في اختیار الخليفة كما يشاور الرجال وعثمان بن عفان يشاور نسوة النبي في أمر الفتنة ويذيع رأيهن فى موسم الحج بعد أن قبله وعمل به“. ولم يذهب أحد في ذلك العهد إلى أن مشاورة النساء واستطلاع رأيهن، بل العمل به خروج على الإسلام وتعاليم الإسلام وتقاليد الإسلام!
ألا يحق لنا بعد هذا البيان القول بأن حرمان المرأة من الحقوق السياسية هو الخروج والمروق على الإسلام وروح الإسلام وتقاليد الإسلام؟
هذه إذن هي أحكام الإسلام فيما عرضنا من القيود التي تكبل المرأة المصرية سواء في فرض الزواج عليها أو تعدد الزوجات أو الطلاق أو الزنا أو حرمانها حقوقها السياسية، ومنها يبين أن أعداء المرأة حين يزجون بالدين في محاوراتهم وأباطيلهم، إنما يتعلقون بخيوط واهية لا تجديهم فتيلا. وعليهم اليوم أن يجدوا فى البحث عن مزاعم جديدة تؤيد دعواهم الفاشلة!!
ولقد انبعث من بين رجال الدين أنفسهم – منذ خمسين عاما – صوت المغفور له الشيخ محمد عبده يطالب بتحريم تعدد الزوجات. ففي سنة ۱۸۹۹ طلبت الحكومة إليه أن يدرس مشروع القانون المدنى ويبدى عليه ماله من ملاحظات وتعديلات، فقدم تعليقا على المشروع ضمنه المطالبة بتحديد تعدد الزوجات. وقال في هذا التعليق إن هذا التعدد وإن كان مباحا في صدر الإسلام لما قد يكون له من فوائد فإنه اليوم مناف لضرورات التطور الاجتماعي. وهذا بعض ما قال“وأذى الضرة لا يعدو ضرتها. أما الآن والأمر على ما نرى ونسمع فلا سبيل إلى تربية الأمة مع شيوع تعدد الزوجات فيها. ولا يمكن للعلماء إنكار أن الدين أنزل لمصلحة الناس وخيرهم وأن من أصوله منع الضرر والضرار“.
كذلك عرف أن المغفور له الشيخ محمد مصطفى المراغى شيخ الجامع الأزهر السابق كان ينصح بتقييد تعدد الزوجات واستند فى هذا النصح إلى تفسير آيات القرآن.
وقد عرفنا عالما من علماء الأزهر الشريف هو فضيلة الأستاذ خالد محمد خالد ينحو في تقدير مطالب المرأة هذا المنحى فيصرح في مقاله المنشور بمجلة السوادي في مارس سنة ١٩٤٨ تحت عنوان“منيره ثابت تزحف، ولكن إلى الوراء” بما يأتي:
“إن ممارسة المرأة لحقوقها السياسية والاجتماعية على الصورة التي نراها بها في كل ناد من اختلاط وسفور وأناقة – مهما كان مهذبا – لا يقره نص واحد من نصوص الإسلام. وإنما يعتمدون حين يريدون مناصرة تحرير المرأة باسم الدين على الاجتهاد وعلى تخريج النصوص وتوليدها اتجاهات حديثة ترتكز على بعض مصادر التشريع كالقياس والمصالح المرسلة.
إن الدعوة إلى منح المرأة حق الطلاق الذي“أبيح للرجل بغير ضابط ولم بيح لها” ليست ثورة على الدين, فقد أعطى الإسلام هذا الحق للمرأة تمارسه عن طريق الحاكم وهو ما يراد الآن تطبيقه بالنسبة للرجل…”
ثم قال الكاتب عن اتهام أنصار تحرير المرأة بالخروج على الدين“هو جزء من خطة مرسومة يحاول واضعوها دائما أن يزجوا الدين في قضايا خاسرة وأن يجعله طليعة غازية تمهد لكافة المظالم السياسية والاقتصادية والاجتماعية… أليست مهزلة عجيبة؟ لكن أعجب منها أن يسكت عنها رجال العلم والدين“.
وفي المقدمة الرائعة التى تفضل الدكتور طه حسين بك بأن يقدم بها كتابي السابق عن المرأة – جاءت هذه العبارة المعبرة.
“المرأة المصرية حين تطالب بما تطالب به من الحرية لا تخالف سنة موروثة ولا شيئا من آدابنا التقليدية المحفوظة، إنما تطالب بإحياء هذه السنة ورعاية هذه الآداب. فقد كانت الأمة الإسلامية فى حياتها الأولى تبغض الظلم أشد البغض وتنكر العسف أشد الانكار وتعرف للمرأة من الحقوق مثل ما كانت تعرف للرجال في تلك العصور… ولو قد عرف المسلمون في تلك العصور النظم البرلمانية لما حرموا المرأة شيئا من حقها السياسي. فالمطالبة بالحقوق السياسية للمرأة في هذا العصر ليست بدعا ولا شيئا يشبه البدع وإنما هو إحياء للسنة الموروثة وإصلاح الحياة النساء“كما أصلحت حياة الرجال“.
وكتب الأستاذ إسماعيل مظهر في كتابه“المرأة في عصر الديمقراطية” يقول:”وإن الإسلام الذى أباح للمرأة أن تبدي رأيها وأن تتجر وأن تتعلم وأن يكون لها ملك تتصرف فيه بمحض إرادتها، لا تتفق مبادؤه هذه مع أسر المرأة في البيت وأن يكون كل حقها في الحياة أن تقيم بين جدران أربعة تحصر في جوانبها الضيقة كل واجباتها في الحياة.. خرج نساء العالم المتمدين إلى المتجر والمصنع والحقل, ونريد لنسائنا أن يكن قعيدات البيوت وأن يظللن الكائنات المعولة وأن يمضين ذليلات حقيرات بعيدات عن الحياة مقصورات على الطبخ والغسل وحمل القمامة إلى خارج الحجرات والمنازل. ثم نقول إن ذلك حكم الله. إنما ذلك حكم أننا نحاول أن لا نساير الزمن ونبغي أن نظل كما كان آباؤنا مأسورين في حلقة من الأفكار البالية, جاهلين أن العالم قد اندفع إلى الأمام فراسخ وأميالا…
على أن حقيقة تعاليم الإسلام ومبادئه لا تقف عند هذا الحد بل تتجاوزه إلى حقيقة أخرى عميقة الأثر واضحة المعنى. تلك أن الإسلام في ذاته – كما قدمنا – كان ثورة على الأوضاع القديمة، أوضاع الجاهلية الغشوم، وكان تطويرا لأوضاع الناس وعرفهم وقواعد حياتهم الدينية والدنيوية معا.
ولا يمكن أن يقال عن دين هو التطور عينه أنه جامد مطلق لا يسمح بالتطور أو بالتطوير. فالمرأة فى عهد الجاهلية كانت من العبيد أو أدنى منزلة. وكانت مكانتها المحتقرة فى المجتمع انعكاسا طبيعيا لنظام الرق والعبودية. فكان لمولد البنت وقع الصاعقة على أبيها، ومذلة العار الذي لا يمحى إلا بدفنها حية، وهو ما يعرف بوأد البنات. فليس من العجيب إذن أن يواجه الدين الإسلامي عند انبثاق نوره المصلح, مجتمعا ينكل بالمرأة كل التنكيل وينكر عليها كل حق أو شبهة حق، ويبلغ به الانكار إلى إنكار حقها في الحياة ذاتها! جاء الإسلام ثورة جارفة على هذه الأوضاع المؤلمة، فحرر المرأة من مصيرها الدامي، وقرر لها حق الحياة، ورفعها إلى مستوى الآدميين، وجعل منها فردا من أفراد المجتمع له فيه من الخطر والأثر والكرامة ما للرجل.
وقد بهرت قواعد الإسلام أساطين المشرعين ورجال الفقه والقانون، إذ أباح للمرأة حقها المطلق فى التملك والتصرف في أموالها بالبيع والرهن والوصية والهبة، شأنها في ذلك شأن الرجل تماما، محررة من كل قيد أو رقابة، وأباح لها كافة الحقوق المدنية الأخرى التي يتمتع بها الرجل كالتجارة والمعاملات والتقاضي والمثول أمام المحاكم للدفاع عن حقوقها والصلاة في المساجد والإشتراك في المجالس الأدبية والسياسية والدينية. كذلك حرر الإسلام المرأة في حياتها الشخصية وقرر لها حريتها الفردية في اختيار زوجها على النحو الذي قدمنا.
ويطول بنا الكلام إذا أفضنا في شرح أثر تعاليم الإسلام في تحرير المرأة ورفع مستواها والقضاء على كثير من القيود التي تجعل منها أمة مستعبدة أو سلعة تباع وتشترى فى سوق الرقيق أو الزواج. فليس أمر هذا التحرير خافيا على أحد.
وإنما يحلو لأعداء المرأة أن يغفلوا هذا الجانب من جوانب الدين حتى يضللوا الرأى العام عن حقيقة الدين، ويخفوا جوهر التطور الذي قام على أساسه، مستهدفين بذلك الإمعان في تصوير الدين بالمبادئ الجامدة التي لا ترعى زمانا ولا مكانا, وتفرض جمودها على المجتمع المتحرك دائما، المتطور دائما، المتجه دائما إلى الأمام.
ويخلص لنا مما قدمنا جميعه أن الإسلام لم يكن ثورة على الأوضاع الجاهلية الغاشمة فحسب، ولم يقر لنا من المبادئ ما يحرر المرأة من ربقة الاسترقاق والمظالم الفادحة فحسب، بل إنه قام أيضا على أساس من التطور ومراعاة ظروف الزمان والمكان يسمح دائما بتقرير القواعد الصالحة للمجتمع.
وليس من شك في أن هذه القواعد تتضمن فيما تتضمن تحرير المرأة المصرية في المجتمع المصرى المتطور، حتى تساهم في تطوره وفي دفعه إلى الأمام. هذه هي الحقيقة العارية, شاء أم كره أعداء المرأة. الزاحفون والزاحفات إلى وراء!؟
يبين لنا من الفصل السابق أن الإسلام الحنيف لم يهبط بالمرأة إلى هذا المستوى الأدنى الذى هى فيه، بل ارتفع بها من الحضيض الذي كانت غارقة فيه أيام الجاهلية والعبودية وحررها من قيودها, وجعل من“النساء شقائق الرجال“ (2)، وأطلق مبادئ المساواة بين الجنسين للعمل بها وفق ظروف المجتمعات المختلفة وتطورها.
ما هي إذن الأسباب الحقيقية التي حالت دون تحرير المرأة نهائيا من قيودها وجعلت منها هذا المخلوق الضعيف الذي يعيش على هامش الحياة محروما من الحقوق التي يتمتع بها الرجل، رغم اعتراف الإسلام لها بهذه الحقوق وإطلاقه مبادئ المساواة بين الجنسين لتطبيقها وفق ظروف المجتمعات المختلفة وتطورها ؟!
إن المرأة لم تكن دائما ذلك المخلوق الضعيف الذليل في كل عصور البشرية. فقد عرفت البشرية عصرا كانت المرأة فيه مساوية للرجل تمام المساواة، بل كانت تفوقه أحيانا. وكان ذلك حينما كانت المرأة مشتركة في الحياة الاقتصادية والإنتاج جنبا إلى جنب مع الرجل وعلى قدم المساواة معه, فكانت تضمن بعملها وكسب خبزها استقلالها الاقتصادي الذي كان يحميها من الوقوع فريسة للرجل.
وكان هذا هو حال المرأة المصرية في العصر الفرعونى، وقد صوره“ماکس
ميلر” المؤرخ المعروف فى قوله” لم يضمن أي شعب قديم أو حديث وضعا قانونيا عاليا للمرأة مثل سكان وادى النيل، فالآثار تبين لنا المرأة وهي تتناول الطعام أمام الناس وتذهب إلى أعمالها وتسير في الطرقات بمفردها وتعمل في التجارة والصناعة، وكان من حقها أن تملك الأشياء وأن تتصرف بوصيتها كما تريد“.
وصوره“ویل دورانت” فى مؤلفه المعروف“تاريخ الحضارة” على النحو الآتى:
“ومن الظاهر أن هذا التفوق فى وضع المرأة كان ناتجا من نظام“قبيلة الأم” Matriarcal المخفف الذى ميز المجتمع المصرى. فلم تكن المرأة سيدة البيت فحسب, بل كانت الملكيات العقارية كلها تورث طبقا للنسب النسائي.
وكان السائحون اليونانيون يتعجبون لهذه الحرية وقد اعتادوا في بلادهم على حبس نسائهم. فكانوا يسخرون من الأزواج المصريين الخاضعين لنسائهم ويذكر دیودور دی سيسيل على سبيل الفكاهة أن عقد الزواج على ضفاف النيل يتطلب طاعة الزوج لزوجته“.
فلما خيمت على البشرية عهود العبودية المظلمة سقطت المرأة فريسة لنظام الرق، وانقلبت إلى أداة ترف ومتعة للرجل تباع وتشترى في الأسواق. وسجل تاريخ البشرية هذه المرحلة بالنسبة لجميع شعوب الأرض تقريبا، حيث كانت المرأة سجينة البيت أو“الحريم“، لا تشترك فى الإنتاج، بل تعيش عالة على عمل الرجل الذي يؤويها ويسيطر عليها.
إن شعار“المرأة للبيت” ينبع تاريخيا من هذه العصور المظلمة التي خلفتها الإنسانية وراء ظهرها, وانطلقت نحو النور والضياء والتقدم.
ثم انقشعت سحب تلك العصور المظلمة والقرون الوسطى عن عهد التقدم الاقتصادي، عصر الثورة الصناعية والرخاء والتطور الاجتماعي والسياسي. وكانت الثورة الفرنسية فاتحة هذا العصر المجيد في أوروبا خاصة، فانطلق دعاة الاقتصاد الصناعى الجديد بنداء الحرية والإخاء والمساواة يحطمون القيود العتيقة والتقاليد البالية ويحملون لواء الدعوة إلى وفرة الإنتاج والرخاء. وكان من الطبيعي أن ينعكس نداء الحرية والإخاء والمساواة على وضع المرأة في المجتمع، وأن تشمل الدعوة إلى الإنتاج الجديد كل القوى والأيدي العاملة في الشعوب رجالا ونساء. وهكذا وضع التطور الاقتصادي الحديث أساس تحرير المرأة من قيودها العتيقة، ورفعها من وهدة العبودية و“البيت” إلى مصاف الرجال وصيرورتها للمجتمع لا للرجل وحده.
فأما الشعوب التي اندفعت في طريق التقدم الحديث حرة من كل قيد طليقة من كل عقبة، فقد حققت المرأة فيها انتصارات رائعة، فحصلت على حق العمل وحق التعليم والحقوق السياسية. وهذه انجلترا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية أدلة ناطقة على ما نقول!
وأما الشعوب التي وقفتها السدود والقيود عن هذا التقدم الحديث فعاقت تطورها الاقتصادي وتركتها متأخرة عن ركب الحضارة الحديثة، فقد انعكس تأخرها على وضع المرأة فيها فظلت هذه فى وضعها القديم أو ما يشبه القديم.
وهذه بلاد الشرق الأوسط أدلة ناطقة على ما نقول!
وليست تلك السدود والقيود إلا الاستعمار الأجنبي الذي سيطر على هذه البلاد وعاق تطورها الاقتصادي والاجتماعى والسياسي، وجعلها متأخرة عن ركب الحضارة الحديثة.
ومصر من بلاد الشرق الأوسط التي ابتليت بلاء الاستعمار!
إن محمد على الكبير قد أدى فى مصر دور الثورة الفرنسية أو ما يقاربه، فقد قضى على المماليك الإقطاعيين بضربة واحدة، وأقام أسس النهضة الصناعية المصرية، وكان بحق مؤسس مصر الحديثة الناهضة. والتاريخ يسجل لهذا العاهل العظيم أنه بذل الجهود الرائعة الخالدة لكي يجعل مصر دولة صناعية حديثة، منطلقة فى طريق التقدم الحديث حرة من كل قيد, طليقة من كل عقبة. وكان من الطبيعى أن تنعكس هذه النهضة التاريخية على وضع المرأة المصرية في المجتمع. فنرى المؤرخ المشهور المرحوم أمين سامي باشا يسجل هذه المفخره لمحمد على باشا فى مؤلفه القيم“تقويم النيل” فيصفه بأنه أول من فتح أبواب العلم لفتيات مصر، وأول من رعى حقوقهن الإنسانية الاجتماعية، حتى لقد أذن لهن بالجمع بين الوظيفة والزواج. وكان هذا الإذن في صورة أمر كريم يدعو إلى الكثير من التأمل والتفكير. كان رحمه الله قد شجع فتيات الأسر الكريمة على ارتياد مدرسة الطب وعين لخريجات هذه المدرسة وظائف معينة فى المستشفيات ومختلف أقسام“المحروسة” أى مصر. فلما تخرجت أول دفعة وزعت على هذه الأعمال رأى ألا يحرم الفتاة المصرية المتعلمة العاملة من حقها كأنثى من الزواج، فأصدر أمره إلى مأمورى الأقسام بجمع بيانات وافية عن كل طبيب أعزب مستقيم حسن السيرة والخلق ليجرى العمل على تزويجه من الفتيات المشتغلات بالطب. وقرر لكل طبيب يتزوج على هذا الوجه معونة مالية خاصة تتضمن تأثيث بيته على نفقة الدولة.
ولاشك أن الذي دفع ساكن الجنان إلى هذا هو ترغيب الرجال المثقفين في الزواج من نساء عاملات, ومحاربة الأفكار الرجعية التي لم تكن تنظر إلى المرأة المشتغلة بعين مليئة بالاحترام والتوقير.
ويتضح من هذا أن محمد على الكبير قد رأى أنه لابد من مساهمة المرأة المصرية في الإنتاج والعمل، حتى يتمكن من تجنيد الأمة بأسرها رجالا ونساء في العمل من أجل إنهاض الأحوال الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في مصر. ولذلك اقترن نزول المرأة إلى ميدان العمل بالنضال ضد القيود التي تربطها وتعوق تطورها، ذلك النضال الذى بدأه عاهل مصر العظيم بتشجيعها على العمل وحث الرجال على احترامها والسعى إلى الزواج من النساء العاملات، أو محاربة الأفكار الرجعية التى تنادي بإبقاء المرأة في“الحريم المقفول“، والتي تظهر اليوم بيننا فى نداء“المرأة للبيت“.
إن محمد على الكبير قد أدرك أن نهضة مصر الحديثة لابد أن تقترن بنهضة المرأة المصرية وتحريرها من قيودها، فأطلق لها حق التعليم وحق العمل وحق الخروج، وصان قدرها ودعا الناس إلى احترامها. ولو أن الظروف قد عاونت على انطلاق مؤسس مصر الحديثة فيما أخذ بأسبابه وشرع في تحقيقه لكان للدولة المصرية في التاريخ الحديث شأن آخر، ولكان للمرأة المصرية – بالتالي – في المجتمع المصرى شأن غير هذا الشأن!
ولكن مصر من بلاد الشرق الأوسط التي ابتليت بلاء الاستعمار!!
لقد شرحنا من قبل أثر الاستعمار فى وضع المرأة المصرية في المجتمع المصرى عند الكلام على تعليم المرأة. فرأينا كيف حرص الاستعمار على استغلال انحطاط المرأة المصرية وتأخر الوعى الشعبي ليمعن في تحقيرها وجعلها جاهلة عاجزة بعيدة عن المجتمع المصرى وشئونه.
وكانت سياسة الاستعمار فى مجال المرأة تطبيقا منطقيا لسياسته العامة في سبيل إعاقة التطور الاقتصادي والاجتماعى والسياسي، الذي بدأه محمد على الكبير واستأنفه من بعده اسماعيل العظيم، والذي كان من شأنه الطبيعي أن ينعكس على وضع المرأة فيرفع من قدرها ويحررها من قيودها.
وقف الاستعمار إذن عقبة في سبيل نهضة النصف من هذه الأمة كجزء لا يتجزأ من سياسته العامة في سبيل عرقلة نهضة الأمة المصرية في مجموعها. فهو لم يطلق للمرأة حق التعليم بل قيده وعرقله، لأنه يريد أن يبقى الأمة المصرية غارقة في ظلمات الجهل والأمية. وهو لم يطلق للمرأة حق العمل لأنه يريد أن يبقى المجتمع المصرى مجتمعا زراعيا متأخرا، فلا أقل من أن يضمن حرمان نصفه النسائي من الاشتراك في الانتاج القومى ورفع مستوى المعيشة. وهو لم يطلق لها الحقوق السياسية لأنه يريد حرمان الشعب في مجموعه من إدارة شئونه السياسية وإبقائه تحت سيطرته الاستبدادية الأوتوقراطية.
كل هذا يثبت لنا ارتباط نهضة المرأة بنهضة الأمة. وهو الأمر الذي أدركه محمد على الكبير، وردده من بعده نصير المرأة المرحوم قاسم أمين! ويعبر الفيلسوف الفرنسى الكبير“فورييه” عن هذا الارتباط بقوله“إن مستوى تحرير المرأة في كل مجتمع هو مقياس كل تحرير“.
وها هو الأستاذ سلامة موسى الكاتب الديمقراطي المعروف يقول مؤيدا:”إني أحب أن أعالج هذا الموضوع بكلمات قليلة لأني أعتقد أن أعظم ما يؤيد الاستعمار ويبقيه بل يخلده هو الرجعية. وإن أعظم ما يخشاه الانجليز في مصر والمستعمرون في الأقطار الشرقية الأخرى هو تلك الحركات الارتقائية التي تقول بحرية المرأة وبالتعليم العام والتصنيع العام. ولذلك أعتقد أيضا أن قاسم أمين حطم من الاستعمار الانجليزى فى مصر بدعوته إلى حرية المرأة وتعليمها واستخدامها كالرجل أكثر مما حطم مصطفى كامل حين استند إلى التقاليد بدعوته إلى الاستقلال فقط. ومنطق التاريخ يؤيد ما نقول. ذلك أنه لا يمكن أمة أن تستعمر أخرى إلا إذا كانت هذه الثانية قد تجمد تطورها وتقيدت بتقاليدها، ولذلك ترى الأمة التى استعمرتها أن تستبقى هذا التجمد وهذا التقيد حتى تجعل هزيمتها الحربية في المعركة هزيمة اجتماعية دائمة. ويجب أن نذكر أن الفقر والجهل والمرض هى فى صميمها تقاليد، لأنها في النهاية تستند إلى عادات ثقافية أو اجتماعية تمنع الثراء والمعرفة والصحة. فالأمة التي تلتزم الزراعة وتحطم الفلاحين بالاستغلال هي أمة فقيرة حتى حين تدفع خمسمائة جنيه ثمنا للفدان. ذلك لأن هذا الثمن لم يرتفع إلا لأن نصيب الفلاح مما ينتج صغير جدا. وأهوى ما يهواه الانجليز أن نبقى على هذه الحال کى يشتروا القطن رخيصا وأكره ما يكرهونه أن نأخذ بالصناعات العصرية. وكذلك أحب ما يحب الانجليز أن نمنع تعليم البنات بالجامعة وقد منعوا هم التعليم الثانوي للبنات عندنا إلى يوم إعلان الاستقلال. وأعظم ما يشتهون هو الدعوة إلى الحجاب حتى يعود نصف الأمة أى عشرة ملايين إنسان معطلا لا ينتج“.
وهكذا ترى أن قضية المرأة وثيقة الصلة بقضية الاستقلال وقضية الديمقراطية، وأن الأسباب الحقيقية لوضع المرأة الحالي في المجتمع المصرى لا تكمن إلا فى تراث العصور الاستبدادية التى مرت بالشعب المصرى. وهذا مصداق قول قاسم أمين إن أعداء المرأة أعداء الديمقراطية وأعداء التقدم.
فلا ترجع عدم المساواة بين الجنسين إلى الإسلام وتعاليم الإسلام إذن، ولا إلى ضعف جسمى أو عقلى للمرأة إذن، ولا إلى طبيعة الوظيفة الاجتماعية للمرأة إذن، وإنما يرجع إلى أسباب تاريخية واقعية واضحة سطرت آثارها على صفحات من الدماء والدموع من تاريخ مصر الحديثة!
إن نهضتنا المعاصرة التى تتجلى فى السعى إلى استكمال سيادتنا القومية بجلاء الجيوش الأجنبية عن وادى النيل وإلى تقوية الديمقراطية، لابد أن تقترن بالاعتراف للمرأة المصرية بحقوقها وتحريرها من النير الذي تعانيه، وإشراكها في المعترك العام وفى الصناعة وفى الإنتاج، كما أن ثورتنا الوطنية الكبرى من أجل الاستقلال قد اقترنت بيقظة المرأة المصرية واشتراكها في معترك الثورة وفي الانتاج إلى قدر.
وبالتالي ليس يقبل القول بأن القضية الوطنية الديمقراطية لا تهم المرأة المصرية ولا تعنيها، فهى وثيقة الارتباط بقضيتها. والمرأة المصرية تدرك أنه حين تستكمل مصر ديمقراطيتها ونظامها البرلمانى التمثيلي، فهذا يعنى الاعتراف للمرأة بحقوقها السياسية وتحريرها من نير الرجل.
ذلك أن استمرار النهضة المصرية الحديثة معناها مضاعفة الجهود في الانتاج لتحقيق الرخاء العام ورفع مستوى المعيشة. وهذا يتطلب دعوة جميع القوى والأيدي العاملة فى المجتمع المصرى للاشتراك في تحقيق أهداف هذه النهضة الرائعة التي نقف اليوم على أبوابها. فلا أقل من أن تشمل نصف القوى الاجتماعية المصرية التى تمثلها المرأة المصرية. وقد رأينا مرارا أن اشتراك المرأة في الحياة الاقتصادية يتطلب تحررها من القيود التي تلزمها عقر البيت جاهلة عاجزة عاطلة. ورأينا كذلك أن اشتراك المرأة في العمل يعنى لها الاستقلال الاقتصادى وبالتالي تحررها من أن تكون عالة على الرجل تابعة له. وهذا تأكيد للمعنى الذى قررناه وعبر منه من قبلنا كثير من الكتاب وعلى رأسهم نصير المرأة المرحوم قاسم أمين, وهو أن النهضة القومية تتضمن في طياتها حتما نهضة المرأة وتحريرها.
كذلك استكمال الديمقراطية وقواعد النظام التمثيلى البرلماني معناه تعمیم الديمقراطية للأمة بأسرها ونصفها النسائى بالتبعية. وهذا يتطلب الاعتراف للنساء بحقوق الانتخاب والترشيح وإطلاق الحقوق السياسية للمرأة كما أطلقت للرجل.
فالمرأة المصرية حين تطلب بما تطالب به لا تستوحى رغبة عارضة من الرغبات الأنانية المعزولة عن مصالح الهيئة الاجتماعية ولا تنساق وراء المطامع الشخصية لبعض النساء اللواتي يتخذن الحركة النسائية ذريعة للظهور والشهرة، وإنما تستوحى استكمال العدل والديمقراطية لنصف المجتمع وبالتالي استكمال النهضة والرخاء والتقديم للمجتمع المصرى كله.
هذا هو جوهر الوضع الاجتماعى للمرأة فى مصر بل في جميع بلدان العالم. أو إذا كان بعض المشتغلات بالحركة النسائية المصرية عاجزات عن إبراز قضية المرأة في ثوبها الحقيقى، فهذا يفسر الضعف والتخبط في دفاعهن عنها ويجعل من مطالبة المرأة المصرية استجداء للعطف والشفقة والاحسان لا جزءا من قضية مصر المستقلة الديمقراطية.
ولكن الرأى العام لا ينسى ولن ينسى ذلك الدفاع المجيد الساطع عن قضية المرأة بأقلام أعظم كتابنا وأدبائنا الأحرار منذ قاسم أمين، أولئك الذين حرصوا على المطالبة بتحرير المرأة المصرية كخطوة لازمة وحتمية نحو استكمال الحرية والديمقراطية.
لم يبق إلا أن نعدد المبادئ الرئيسية التي يمكن أن يقوم على أساسها تحرير المرأة المصرية من ربقة الرجل وتحقيق المساواة بين الجنسين وهي:
أولا: تحريم تعدد الزوجات تحريما تاما.
ثانيا: تقييد حق الرجل المطلق فى الطلاق والمساواة بين الزوجين في حق الطلاق على ألا يستخدم هذا الحق إلا على يد القاضي.
ثالثا: تحريم الزنا تحريما تاما على الزوجين والمساواة في العقوبات بينهما.
رابعا: تحريم ضرب الزوجة وإلغاء نظام الطاعة.
خامسا: نشر التعليم بين النساء وتشجيع التعليم العام والتوسع في إنشاء المدارس الثانوية للبنات ورفع التعليم الأولى إلى مستوى التعليم الابتدائي.
سادسا: ضمان حق المرأة فى العمل وفى الجمع بين العمل والزواج وتحريم طرد النساء العاملات حين يتزوجن.
سابعا: إنشاء دور لحضانة الأطفال ورعايتهم أثناء عمل الأمهات.
ثامنا: المساواة بين الجنسين في الوظائف والعمل والأجور والضمانات الاجتماعية.
تاسعا: تقرير حق المشتغلات الحوامل في أجازة الوضع المدفوعة الأجر.
عاشرا: الاعتراف للمرأة بالحقوق السياسية كاملة بدون قيد ولا شرط.
كانت حركة المرأة المصرية مقترنة بالحركة الوطنية التي انفجرت في ثورة سنة ۱۹۱۹. وليس هذا بعجيب! إذ أن المرأة – وهى تمثل نصف الشعب – لا تنهض ولا تتحرك إلا مع نهضة الشعب وحركته فى مجموعه. ولذلك انبعثت الحركة النسائية المصرية فى مظهرها الجدى من طيات الحركة الوطنية المصرية وعاصرتها، بل لازمتها متأثرة بها ومؤثرة فيها في مراحلها المختلفة.
وإذا كانت الحركة الوطنية المصرية قد بقيت – قبل انفجارها في الثورة الكبرى – كامنة في نفوس المصريين لا تبدو فى مظاهرها الخارجية إلا على لسان قادتها وزعمائها أمثال مصطفى كامل ومحمد فريد، فقد بقيت الحركة النسائية المصرية كامنة – كذلك – فى نفوس المصريات والمصريين جميعا، لا تبدو في مظاهرها الخارجية قبل انفجار الثورة الوطنية الكبرى إلا على لسان قادتها وزعمائها.
وقد كان أول مبشر بالحركة النسائية المغفور له خالد الذكر قاسم أمين بك.
ثم ظهرت حركة النساء المصريات جارفة مدوية مع الثورة، واستمرت هذه الحركة في أعقاب الثورة في أشكال مختلفة.
وهذا هو موضوع دراستنا فى هذا الباب. فنبدأ بقاسم أمين، ثم ننتقل إلى الثورة المصرية، وأخيرا إلى الحركة النسائية في أعقاب الثورة.
إن اسم قاسم أمين فى ذاته يعبر عن قضية المرأة المصرية منذ ظهورها. ويقترن اسم قاسم أمين بكتابيه الخالدين“تحرير المرأة” و“المرأة الجديدة” وقد ظهر الكتابان في عام ۱۹۰۰ فأحدثنا دويا هائلا في الرأي العام.
حرص قاسم أمين في كتابيه هذين على تحليل أوضاع المرأة في المجتمع، وأفاض في بيان المظالم الواقعة عليها، وكان بذلك أول من تناول هذا الموضوع في عصره, وسد فراغا كبيرا مازال الأدب الواقعى المصرى يعانيه حتى اليوم.
ولا يجمل بنا أن نزيد القراء معرفة بقاسم أمين وآرائه وأفكاره إلا على لسان قاسم أمين نفسه، فهو أفصح المعبرين عنها وأشدهم أمانة. قال الكاتب العظيم مجملا أفكاره في عبارة واحدة فيها كل المعنى وجوهره“هذا هو الأصل فيما نشهده، ويؤيده الاختبار التاريخى من التلازم بين انحطاط المرأة وانحطاط الأمة وتوحشها, وبين ارتقاء المرأة وتقدم الأمة ومدنيتها” (3)
وكأننا بقاسم أمين يلقى عباراته هذه في وجوه الذين يعزلون المرأة عن المجتمع، ويرون فيها مخلوقا ثانويا يعيش على هامش الحياة، ليس له في الحياة الاجتماعية من نصيب إلا“البيت“!
وليس أمتع للذهن وأقوى للحجة من أن نصحب القراء في جولة بين صفحات هذا الكتاب الرائع لنترك كاتبه يلقى إلينا بما يزيد قضية المرأة المصرية قوة على قوتها.
يقول“لماذا يعتقد المسلم أن عاداته لا تتغير ولا تتبدل، وأنه يلزمه أن يحافظ عليها إلى الأبد؟ ولماذا يجرى على هذا الاعتقاد في عمله مع أنه هو وعاداته جزء من الكون الواقع تحت حكم التغيير والتبديل في كل آن؟ أيقدر المسلم على مخالفة سنة الله في خلقه إذ جعل التغيير شرط الحياة والتقدم, والوقفة والجمود مقترنين بالموت والتأخر؟ أليست العادة عبارة عن اصطلاح أمة على سلوك طريق خاصة فى معيشتهم ومعاملاتهم حسبما يناسب الزمان والمكان؟ من ذا الذي يمكنه أن يتصور أن العادات لا تتغير بعد أن يعلم أنها ثمرة من ثمرات عقل الإنسان يختلف باختلاف الأماكن والأزمان؟“
ويقول“سبق الشرع الإسلامي كل شريعة سواه في تقرير مساواة المرأة للرجل، فأعلن حريتها واستقلالها يوم كانت فى حضيض الانحطاط عند جميع الأمم، وخولها كل حقوق الإنسان واعتبر لها كفاءة شرعية لا تنقص عن كفاءة الرجل في جميع الأحوال المدنية من بيع وشراء وهبة ووصية، من غير أن يتوقف تصرفها على إذن أبيها أو زوجها. وهذه المزايا التي لم تصل إلى اكتسابها – حتى الآن – بعض النساء الغربيات, كلها تشهد على أن من أصول الشريعة السمحاء احترام المرأة والتسوية بينها وبين الرجل… ولما كانت المرأة ضعيفة اهتضم الرجل حقوقها وأخذ يعاملها بالاحتقار والامتهان وداس بأرجله على شخصيتها. عاشت المرأة فى انحطاط شديد أيا كان عنوانها في العائلة زوجة أو أما أو بنتا، ليس لها شأن ولا اعتبار ولا رأى, خاضعة للرجل لأنه رجل ولأنها امرأة. فنى شخصها في شخص الرجل ولم يبق لها من الكون ما يسعها، إلا ما استتر من زوايا المنازل, واختصت بالجهل والتحجب بأستار الظلمات. واستعملها الرجل متاعا للذة يلهو بها متى أراد ويقذف بها إلى الطريق متى شاء, له الحرية ولها الرق, له العلم ولها الجهل، له العقل ولها البله، له الضياء والفضاء ولها الظلمة والسجن، له الأمر والنهي ولها الطاعة والصبر، له كل شئ فى الوجود، وهى بعض ذلك الكل الذي استولى عليه. من احتقار الرجل للمرأة أن يملأ بيته… بزوجات عديدات يهوى إلى أيهن يشاء منقادا إلى الشهوة, منساقا بباعث الترف وحب استيفاء اللذة, غير مبال بما فرضه الدين من حسن القصد فيما يعمل, ولا بما أوجبه عليه من العدل فيما يأتي. من احتقار المرأة أن يطلق الرجل زوجه بلا سبب. من احتقار المرأة أن يقعد الرجل على مائدة الطعام وحده ثم تجتمع النساء من أم وأخت وزوجة ويأكلن ما فضل منه. من احتقار المرأة أن يسجنها في منزل ويفتخر بأنها لا تخرج منه إلا محمولة على النعش إلى القبر. من احتقار المرأة أن يعلن الرجال أن النساء لسن محلا للثقة والأمانة. من احتقار المرأة أن يحال بينها وبين الحياة العامة والعمل فى أى شئ يتعلق بها. فليس لها رأى في الأعمال ولا فكر في المشارب ولا ذوق فى الفنون ولا قدم في المنافع العامة ولا مقام في الاعتقادات الدينية، وليس لها فضيلة وطنية ولا شعور ملئ.
ولست مبالغا إن قلت إن ذلك كان حال المرأة في مصر إلى هذه السنين الأخيرة, التي خفت فيها نوعا سلطة الرجل على المرأة تبعا لتقدم الفكر في الرجال واعتدال السلطة الحاكمة عليها“.
ثم يتكلم قاسم أمين بك عن تعليم المرأة فيقول:
“ولا يزال الناس عندنا يعتقدون أن تربية المرأة وتعليمها غير واجبة، بل إنهم يتساءلون هل تعليم المرأة القراءة والكتابة مما يجوز شرعا أم هو محرم بمقتضى الشريعة؟
وأتذكر أنى أشرت يوما على أب، وقد رأيت معه بنتا بلغت من العمر تسع سنوات أعجبنى جمالها وذكاؤها، بأن يعلمها، فأجابني“هل تريد أن تعطيها وظيفة في الحكومة ؟” فاعترضت عليه قائلا: وهل في مذهبك لا يتعلم إلا الموظفون؟ فأجابني: إنى أعلمها جميع ما يلزم لإدارة منزلها ولا أفعل غير ذلك، قال هذا على وجه يشعر أنه لا يحب المناقشة في رأيه. ويعنى هذا الأب العنيد بإدارة المنزل أن بنته تعرف شيئا من صناعة الخياطه وتجهيز الطعام واستعمال المكوى وما أشبه ذلك من المعارف التى لا أنكر أنها مفيدة بل لازمة لكل امرأة. ولكني أقول ولا أخشى نكيرا أنه مخطئ في توهمه أن المرأة التي لا يكون لها من البضاعة إلا هذه المعارف يوجد عندها من الكفاءة ما يؤلها لإدارة منزلها.
ففي رأيي أن المرأة لا يمكنها أن تدير منزلها إلا بعد تحصيل مقدار معلوم من المعارف العقلية والأدبية. فيجب أن تتعلم كل ما ينبغي أن يتعلمه الرجل من التعليم الابتدائى على الأقل، حتى يكون لها إلمام بمبادئ العلوم يسمح لها بعد ذلك باختيار ما يوافق ذوقها وإتقانه بالاشتغال به متى شاءت“.
وقال عن حق المرأة في العمل ما يأتي:
“فلأن النساء في كل بلد يقدرن بنصف سكانه على الأقل، فبقاؤهن في الجهل حرمان من الانتفاع بأعمال نصف عدد الأمة، وفيه من الضرر الجسيم ما لا يخفى. ولا شئ يمنع المرأة المصرية من أن تشتغل مثل الغريبة بالعلوم والآداب والفنون الجميلة والتجارة والصناعة إلا جهلها وإهمال تربيتها. ولو أخذ بيدها إلى مجتمع الأحياء، ووجهت عزيمتها إلى مجاراتهم في الأعمال الحيوية واستعملت مداركها وقواها العقلية والجسيمة، لصارت نفسا حية فعالة تنتج بقدر ما تستهلك، لا كما هى اليوم عالة لا تعيش إلا بعمل غيرها، ولكان ذلك خيرا لوطنها لما ينتج عنه من ازدياد الثروة العامة والثمرات العقلية فيه.
وإنما مثلنا الآن مثل رجل يملك مال عظيم فيدعه في الصندوق ويكتفي بأن يفتح صندوقه كل يوم ليتمتع برؤية الذهب. ولو عرف لاستعمله وانتفع منه وضاعفه فى سنين قليلة.
ولو تبصر المسلمون لعلموا أن إعفاء المرأة من أول واجب عليها، وهو التأهل لكسب ضروريات هذه الحياة بنفسها هو السبب الذي جر ضياع حقوقها. فإن الرجل لما كان مسئولا عن كل شئ، استأثر بالحق في التمتع بكل حق، ولم يبق للمرأة حظ في نظره إلا كما يكون لحيوان لطيف يوفيه صاحبه ما يكفيه من لوازمه تفضلا منه, على أن يتسلى به“.
وقال عن العلاقة الزوجية والمنزلية:
“ولو أردنا أن نحلل إحساسها (الزوجة) بالنسبة لزوجها، نجد أنه يتركب من أمرين: ميل إليه من حيث هو رجل أبيح لها أن تقضى معه شهواتها، وشعور بأن هذا الرجل نافع لها للقيام بحاجات معيشتها. أما ذلك الامتزاج بين روحين اختارت كل منهما الأخرى من بين الآلاف من سواهما امتزاجا تاما, يؤلف منهما موجودا واحدا كأن كلا منهما صوت والآخر صداه، ذلك الإخلاص التام الذي ينسى الإنسان نفسه ولا يدع له فكرا إلا في صاحبه.. فهو ثمرة عزيزة لا تطلب إلا عند النفوس التى تغلب فيها العواطف الكريمة على الاستئثار“.
والتربية تنحصر فى أمر واحد هو تعويد الطفل على حسن الفعل وتحلية نفسه بجميل الخصال. والوسيلة إلي ذلك واحدة، هي أن يشاهد الطفل آثار هذه الأخلاق حوله، لأن التقليد في غريزة الطفل يكتسب به كل ما تلزم معرفته. فإن كانت الأم جاهلة تركت ولدها لنفسه يفعل ما يزينه له عقله الصغير وشهواته الكبيرة، ويرى من الأعمال ما لا ينطبق على محاسن الأدب, فيتخلق بالأخلاق القبيحة ويعتاد العوائد السيئة“.
“إني أكرر ما قلته من أنه يستحيل تحصيل رجال ناجحين إن لم يكن لهم أمهات قادرات على أن يهيئنهم للنجاح. فتلك هي الوظيفة السامية التي عهد التمدين بها إلى المرأة في عصرنا هذا. وهى تقوم بأعبائها الثقيلة في كل البلاد المتمدنة حيث نراها تلد الأطفال ثم تصوغهم رجالا. وبديهي أن العمل الأول وهو الولادة عمل بسيط مادى تشترك فيه المرأة مع الحيوان، فلا تحتاج إلا إلى بنية سليمة. أما العمل الثاني – وهو التربية – فهو عمل عقلى امتاز به النوع الإنساني، وهو محتاج في تأديته إلى تربية واسعة واختبار عظيم ومعارف مختلفة. والأمر الذى يلزم أن تلتفت إليه كل أمة لا تغفل عن مصالحها الحقيقية، هو وجود النظام في الأسر التي يتكون منها جسم الأمة, لأن الأسرة هي أساس الأمة. ولما كانت المرأة هى أساس الأسرة، كان تقدمها وتأخرها في المرتبة العقلية أول مؤثر فى تقدم الأمة وتأخرها. وبالجملة فإن ارتقاء الأمم يحتاج إلى عوامل مختلفة متنوعة من أهمها ارتقاء المرأة, وانحطاط الأمم ينشأ من عوامل مختلفة متنوعة أيضا من أهمها انحطاط المرأة. فهذا الانحطاط فى مرتبة المرأة عندنا هو أهم مانع يقف في سبيلنا ليصدنا عن التقدم إلي ما فيه صلاحنا“.
من هذه الفقرات المعبرة المسطرة فى كتاب“تحرير المرأة” يبدو لنا ذلك السبق الرائع الذي أحرزه قاسم أمين على عصره ومعاصريه. ولو اتسع لنا المجال لزدنا القراء تعريفا بهذا المؤلف العظيم، لا سيما وأنه نادر الحصول اليوم. ولكننا نكتفى بهذا القدر من النقل – وهو كثير – آملين أن يتفضل أحفاد قاسم أمين بتكرار إعادة طبع الكتاب، مساهمة في نصرة قضية المرأة وللنفع العام.
ويمكن أن نجمل الكلام فيما وضعه قاسم أمين من حلول لمشكلة المرأة المصرية فيما يلى:
أولا: تحريم تعدد الزوجات تحريما يكاد يكون تاما، مع استنكاره حتى للاستثناء. وفى هذا يقول“ولا يعذر رجل يتزوج أكثر من امرأة اللهم إلا في حالة الضرورة المطلقة، كأن أصيبت امرأته الأولى بمرض مزمن لا يسمح لها بتأدية حقوق الزوجية. أقول ذلك ولا أحب أن يتزوج الرجل بامرأة أخرى حتى فى هذه الحالة وأمثالها، حيث لا ذنب للمرأة فيها, والمروءة تقضى أن يتحمل الرجل ما تصاب به امرأته من العلل، كما يرى من الواجب أن تتحمل هى ما عساه أن يصاب به… أما في غير هذه الأحوال فلا أرى تعدد الزوجات إلا حيلة شرعية لقضاء شهوة بهيمية، وهو علاقة تدل على فساد الأخلاق واختلال الحواس وشره في طلب اللذائذ“.
ثانيا: تقييد حق الرجل فى الطلاق. وقد صاغ قاسم أمين اقتراحه هذا في صيغة مشروع قانون ضمنه أن الطلاق لا يجوز إلا أمام القاضي أو المأذون، وإلا بعد فترة من محاولات التوفيق والإقناع.”أما طلاق الرجل من غير قيد فهو باطل“.
ثالثا: تعليم المرأة لكي نجعلها رفيقة لزوجها وأما طيبة ومواطنة صالحة في المجتمع.
رابعا: ضمان حق المرأة في العمل وكسب عيشها بنفسها متى شاءت. وتبرز أهمية هذا الطلب وخطورته فى أنه يعنى الاستقلال الاقتصادي للمرأة, الذي يعينها على صيانة كرامتها وشخصيتها وتحريرها من ربقة الرجل.
خامسا: رفع الحجاب, أى سفور المرأة وإباحة الاختلاط المهذب وحق الفتاة في اختيار زوجها المستقبل.
هذه هي الأفكار الرئيسية التي عبر عنها قاسم أمين في كتابيه“تحرير المرأة” و“المرأة الجديدة“. وإذا كانت هذه الأفكار يعوزها الإطلاق من القيود التي وضعها فيها، فإن تفسير ذلك هين يسير. فإذا كان قاسم أمين لم يطالب بمساواة المرأة بالرجل في جميع مراحل التعليم, واقتصر على طلب تعليمها على التعليم الابتدائى فحسب، فإن ذلك يرجع إلى العصر الذي نادى فيه قاسم أمين بأفكاره هذه, حين كان التعليم الابتدائى للمرأة أمرا بعيد المنال. لا يجمل بنا إذن أن ننسى أن قاسم أمين قد عاش فى وقت يسبق عصرنا بنصف قرن من الزمان، لا سيما على إغفاله المطالبة بالحقوق السياسية للمرأة المصرية.
ألم يقل هو نفسه إن التطور سنة البشر ؟!
ولقد أثارت كتابات قاسم أمين ثائرة الرجعيين جامدي العقول، فاتهموه بالكفر والإلحاد والخروج على تعاليم الدين والتقاليد الموروثة. ولكن سرعان أن ذهبت صيحاتهم الجوفاء مع الريح. وكان أبلغ ما قاله قاسم أمين عن هؤلاء الثائرين قوله“وكثيرا ما يكتفى الكسول وضعيف القوة في الجدل بأن يقذف بكلمة باطلة على حق ظاهر يريد أن يدفعه, فيقول تلك بدعة في الإسلام، وما برمی بهذه الكلمة إلا حب التخلص من مشقة الفهم أو الخروج من عناء العمل في البحث أو الإجراء. سيقول قوم إن ما أنشره اليوم بدعة، فأقول نعم؛ أتيت ببدعة ولكنها ليست في الإسلام، بل فى العادات وطرق المعاملة التي يحمد طلب الكمال فيها“.
وهناك فريق آخر من ناقدى قاسم أمين عابوا عليه مثاليته وخياليته وبعده عن الواقع من الأمور فى الحياة الاجتماعية. وتنكر هؤلاء في ثوب أنصار المرأة فاتهموا قاسم أمين بأنه طالب بحقوق المرأة مبكرا قبل الأوان، فأثار الشعور ضد فكرة تحرير المرأة وأثر بذلك تأثيرا ضارا في قضيتها.
ونقول لهؤلاء السادة إن اشتداد المقاومة ضد فكرة تحرير المرأة التي نادى قاسم أمين بها، تدل فى ذاتها على أنه قد أصاب من أعداء الفكرة موجعا فألجأهم إلى تقوية نضالهم ضدها، حتى لا يستفحل أمرها بالانتشار. وليس هذا شأن الفكرة المبكرة السابقة لأوانها والتي يمر بها الأنصار والأعداء مر الكرام لا يلقون إليها بالا ولا اهتماما.
هذا هو قاسم أمين, أول مبشر بالنهضة النسائية المصرية، وأول مدافع عن حقوق المرأة، وواضع النواة الأولى للحركة النسائية فى مصر.
لسنا مبالغين حين نقول إن الثورة الوطنية المصرية التي انفجرت في وجه المستعمر الأجنبى الغاصب منذ ۱۹۱۹ كانت السبب المباشر ليقظة كبرى في ضمير المرأة المصرية، وبالتالى لتطور الحركة النسائية المصرية تطورا رائعا. فلقد شعرت جماهير النساء المصريات التي كانت بعيدة عن شئون الوطن السياسية داخلية وخارجية بواجباتها الوطنية، وخاضت نيران المعركة الرهيبة التي شنها الشعب المصرى على الاستعمار البريطاني. لقد هجرت المرأة المصرية – إذ ذاك – الحريم المقفول, وضربت بالتقاليد العتيقة والعادات البالية عرض الحائط لكي تواجه أسنة الرماح البريطانية في المظاهرات والمواكب الوطنية. لم تفكر المرأة المصرية لحظة – إذ ذاك – في أنها غريبة على الشئون العامة، أو أن السياسة مقصورة على الرجال كما ينادى أنصار“المرأة للبيت“، بل ألقت جانبا هذه الدعاوى الجوفاء، ورفعت بدورها علم الثورة عاليا، جنبا إلى جنب مع الرجل، وبذلت التضحيات الجسام راضية مختارة في سبيل استقلال الوطن وطرد الغزاة الغاشمين!!
ولو أن أحدا من هؤلاء السادة أنصار“المرأة للبيت” قد رفع عقيرته يومذاك بندائه هذا الأجوف، لا تهم في وطنيته وإخلاصه لقضية الشعب بالتواطؤ مع المستعمرين على حرمان الثورة من نصف مجاهديها، وبالتالي على تخريب الثورة وتمكين الاستعمار من تأكيد سيطرته على البلاد.
ظهرت نواة الحركة النسائية فى مارس سنة ۱۹۱۹، حين تلقى عدد كبير من النساء المصريات دعوات مجهولة المصدر تدعوهن إلى كنيسة“مركوس” في موعد معين لعقد اجتماع نسائى. ولبت الدعوة آلاف من النساء الوطنيات، وأسفر هذا الاجتماع النسائى الأول من نوعه عن انتخاب اللجنة التنفيذية للنساء الوفديات، وعلى رأسها الزعيمة المغفور لها هدى شعراوي، والتي قادت بحق الحركة النسائية المصرية فيما بعد.
ومنذ هذا الوقت نشطت الحركة النسائية نشاطا جديا فعالا، وسطرت في تاريخ الثورة المصرية صفحات خالدات من المجد والفخار. وقد اتخذ هذا النشاط فى الثورة مظهرين: مظهرا مباشرا – في المظاهرات والمواكب النسائية التي خرجت فى الطرقات تنادى بسقوط الاستعمار وحياة مصر مستقلة وفى الاشتراك فى مظاهرات الرجال, والتعاون الوثيق في الحركة الثورية بنقل التعليمات السرية والمنشورات بل والأسلحة، وعلاج الجرحى والعناية بهم – ومظهر غير مباشر تجلى فى التحمس للزوج أو الأب أو الأخ والأقارب المشتركين في المعركة.
وقد سارت أول مظاهرة نسائية في ١٦ مارس سنة ١٩١٩ احتجاجا على المذابح الوحشية التي قابل بها البريطانيون مظاهرات الشعب السابقة وتنكيلهم بها.
ووصف الوطني الكبير الأستاذ عبد الرحمن الرافعي بك هذه المظاهرة في كتابه الرائع“ثورة سنة ۱۹۱۹ الجزء الأول” فقال:
“خرج المتظاهرات في حشمة ووقار وأعددن احتجاجا مكتوبا ليقدمنه إلى معتمدى الدول هذا تعريبه:
“جناب المعتمد..
“يرفع هذا إليكم السيدات المصريات, أمهات وأخوات وزوجات من ذهبوا ضحية لمطمع البريطانيين، يحتججن على الأعمال الوحشية التي قوبلت بها الأمة المصرية الهادئة، لا لذنب ارتكبته سوى المطالبة بحرية البلاد واستقلالها تطبيقا للمبادئ التى فاه بها الدكتور ويلسن وقبلتها جميع الدول محاربة كانت أو محايدة. نقدم لجنابكم هذا ونرجو أن ترفعوه لدولتكم المبجلة لأنها أخذت على عاتقها تنفيذ المبادئ المذكورة والعمل عليها. ونرجوكم إبلاغها ما رأيتموه وما شاهده رعاياكم المحترمون من أعمال الوحشية وإطلاق الرصاص على الأبناء والأطفال والأولاد والرجال العزل من السلاح لمجرد احتجاجهم بطريق المظاهرات السلمية على منع المصريين من السفر للخارج لعرض قضيتهم على مؤتمر السلام أسوة بباقى الأمم، وتنفيذا للمبادئ التي اتخذت أساسا للصلح العام، ولأنهم يحتجون أيضا على اعتقال بعض رجالهم ونفيهم إلى جزيرة مالطة.
“لنا الأمل يا جناب المعتمد أن يحل طلبنا هذا نحن السيدات المصريات محل القبول. ولازلتم عونا لنصرة الحق مؤيدين لمبادئ الحرية والسلام“.
سارت السيدات في صفين منتظمين وجميعهن يحملن أعلاما صغيرة, وطفن الشوارع الرئيسية فى موكب كبير هاتف بحياة الحرية والاستقلال وسقوط الحماية. فلفت موكبهن أنظار الجماهير، وأذكى في النفوس روح الحماسة والإعجاب, وقوبلن فى كل مكان بتصفيق الناس وهتافهم. وأخذ النساء من نوافذ المنازل وشرفاتها يقابلهن بالهتاف والزغاريد، وخرج أكثر أهل القاهرة رجالا ونساء لمشاهدة هذا الموكب البهيج الذي لم يسبق له نظير وأخذوا يرددون هتافاتهم.
ومر المتظاهرات بدور القنصليات ومعتمدى الدول الأجنبية لتقديم الاحتجاج المكتوب. ولكن الجنود الإنجليزية لم يدعوا هذا الموكب البرئ يسير في طريقه، فحينما وصل المتظاهرات إلى شارع سعد زغلول يردن الوصول إلى“بيت الأمة“، ضربوا نطاقا حولهن ومنعوهن من السير وسددوا إليهن بنادقهن وحرابهم مهددين وبقى السيدات هكذا مدة ساعتين تحت وهج الشمس المحرقة، فلم يرهبن هذا التهديد بل تقدمت واحدة منهن وهي تحمل العلم إلى جندى كان قد وجه بندقيته إليها ومن معها وقالت له بالإنجليزية“نحن لا نهاب الموت. اطلق بندقيتك فى صدرى لتجعلوا فى مصر مس كافل ثانية“. ومس كافل هي الممرضة الانجليزية المشهورة التي أسرها الألمان في الحرب العظمى الأولى واتهموها بالجاسوسية وأعدموها رميا بالرصاص، وكان لمقتلها ضجة كبيرة في العالم. فخجل الجندى وتنحى للسيدات عن الطريق، فكتبن احتجاجا ثانيا على هذه المعاملة الغاشمة ألحقنه باحتجاجهن الأول وقدمنه إلى معتمدى الدول وهذا نصه:
“جناب معتمد دولة…
“قرر السيدات المصريات بالأمس القيام بمظاهرة سلمية والمرور على دور السفراء لتقديم الاحتجاج الكتابي المرفق بهذا، والذي نتشرف برفعه لجنابكم الآن. وعندما اجتمعن بشارع سعد زغلول باشا حاصرتهن قوة مسلحة من العساكر البريطانية ووجهت لهن السلاح حتى لا يتحركن لا إلى الأمام ولا إلى الخلف, وبقى السيدات هكذا مدة ساعتين تحت نار الشمس المحرقة.
هذا ما رآه المحتلون من معاملة السيدات، وهو بمفرده وبغير تعليق دال على استمرار الانجليز فى استعمال القوة الغاشمة حتى مع السيدات لإخماد أنفاس هذه الحركة العامة, التى لم يكن أساسها أي عداء لضيوفنا الأجانب, لأنها موجهة فقط ضد أعمال الاستبداد والقوة التي يقابل الانجليز بها مطالب الأمة الحقة الشرعية.
لهذا يا جناب المعتمد نضم هذا الاحتجاج الثاني لاحتجاجنا الأول، ونرجو إبلاغه لدولتكم الموقرة، التي أخذت على عاتقها نصرة مبادئ العدالة والحرية.
وتفضلوا بقبول احترامنا“.
“وعقد السيدات عزمهن على إقامة مظاهرة أخرى. فاجتمعن يوم الخميس ۲۰ مارس صباحًا الحديقة القريبة من النيل بجاردن سيتي، ومن هناك سرن ماشيات وفي مقدمتهن ستة أعلام, كتب على إحداها باللغة العربية“إننا نحتج على سفك دماء الأبرياء العزل من السلاح“، وكتب على الثاني“نحتج على قتل الأبرياء“، وعلى الثالث“نطلب الاستقلال التام“، وعلى الأعلام الثلاثة الأخرى هذه العبارات مترجمة إلى الفرنسية. وسارت المتظاهرات وخلفهن مركباتهن حتى وصلن إلى شارع قصر العيني، فناظر الجيش بالإنشاء حتى وصلن إلى شارع سعد زغلول. ووقفن أمام“بيت الأمة” هاتفـات، ثم أقبلت قوة كبيرة من البوليس ومن الجنود الانجليز في سيارات مسلحة, فضربوا نطاقا حولهن. وظل الحصار نحو ساعتين وهن واقفات في الشمس, من منتصف الساعة الحادية عشر صباحا حتى الساعة الواحدة بعد الظهر, وأرسلن باحتجاجاتهن إلى سفارات الدول. وجاء القنصل الأمريكي بنفسه وشاهد هذا الحصار فذهب إلى فندق سافوا حيث القيادة البريطانية واحتج على هذه الفظاعة، فصدر الأمر على عجل برفع الحصار وتمكين السيدات من الخروج من النطاق المضروب حولهن فركبن السيارات والعربات التي كانت تنتظرهن وانصرفن إلى بيوتهن“.
وقد حيا شاعر النيل حافظ إبراهيم مظاهرة السيدات بقصيدة رائعة مجد فيها شعورهن وشجاعتهن وحمل حملة لاذعة على مسلك الجنود الانجليزية حيالهن قال:
خرج الغواني يحتججن …. ورحت أرقب جمعهنه
فإذا بهن تخذن من …. سود الثياب شعارهنه
فطلعن مثل كواكب …. يسطعن في وسط الدجنة (الظلام)
وأخذن يجتزن ….الطريق ودار“سعد” قصدهنه
يمشين في كنف الوقار …. وقد أبن شــعــورهـنه
وإذا بجيش مقبل …. والخيل مطلقة الأعنة
وإذا الجنود سيوفها …. قد صوبت لنحورهن
وإذا المدافع والبنادق …. والصوارم والأسنة
والخيل والفرسان قد …. ضربت نطاقا حولهنه
والورد والريح في …. ذاك النهار سلاحهنه
فتطاحن الجيشان …. ساعات تشيب لها الأجنة
فتضعضع النسوان …. والنسوان ليس لهن منة قوة
ثم انهزمن مشتات …. الشمل نحو قصورهنه
فليهنأ الجيش الفخور …. بنصره ويكسرهنه!
فكأنما“الألمان” قد ….. لبسوا البراقع بينهنه
وأتوا“بهندنبرج” (4) مختفيا بمصر يقودهن
فلذلك خافوا بأسهن …. وأشفقوا من كيدهنه!
وقد سقطت في نيران المعركة الوطنية أول شهيدة من النساء في مظاهرة ١٠ أبريل سنة ۱۹۱۹، وهى المرحومة شفيقة محمد التي صرعتها حراب الانجليز وبنادقهم أثناء اعتدائهم الوحشى على الشعب المصرى الثائر رجالا ونساء وسجل الوطنيون هذا الحدث في منشور حماسی طبعوه تحت عنوان“شفيقة أولى الضحايا من النساء المصريات” وجاء فيه:”انجلت الموقعة عن قتل أول شهيدة مصرية فى حرب الحرية، عن أول ضحايا سيداتنا، عن موت شفيقة واختتم بهذه العبارة“أن أباها قد أودعها عواطف الشعب المصرى الكريم وتعزى عن وحيدته بحرية بلاده. فهكذا الرجولة وهكذا الإخلاص للوطن ففي ذمة الإنسانية: شفيقة ومس كافل وجان دارك!” (5)
كذلك كان للفلاحة المصرية نصيب وافر فى وقائع الثورة في الريف. فقد لعبت دورا كبيرا فيما قام به الرجال من تعطيل وسائل المواصلات الحديدية والسلكية معرقلين بذلك انتقال الجنود البريطانيين.
إن اشتراك المرأة المصرية فى الثورة الوطنية يعنى بدء الحركة النسائية الفعلية. فإن كفاح المرأة في سبيل تحرير وطنها من الاستعمار والاستعباد يتضمن في نفس الوقت الكفاح من أجل حقوقها المهضومة ومكانتها المكبوتة والاستعمار ليس عدوا للشعب بوجه عام فحسب, بل هو كذلك عدو للمرأة وتقدمها وتطورها، يسعى دائما إلى إبقائها فى طوايا الظلمات ليعزل بذلك من مواجهته نصف الأمة التى يحكمها. لذلك تسعى المرأة دائما من الجانب الآخر إلى التحرر من الاستعمار، لا لتشاطر الشعب في مجموعه ميزة الاستقلال والحرية فحسب، بل لتزيل كذلك من طريقها هذا العدو اللدود الذي يناصبها الازدراء وينكر عليها الوجود والكرامة والشخصية!!
ومادامت المرأة المصرية قد أثبتت فى مجرى التاريخ أنها قادرة على القيام بواجباتها الوطنية وعلى المساهمة في إعلاء شأن وطنها بأعمال التضحية والبطولة، فإنه يكون من العبث الفارغ أن ننكر عليها حقوقها السياسية أو مساواتها بالرجل فى المجتمع المصرى, وأن نردد في عناد ممقوت, ذلك النداء الممقوت الغامض,”المرأة للبيت“.
أدى اشتراك المرأة المصرية فى الثورة الوطنية عام ١٩١٩ – وهو الاشتراك الذي يعتبر بدء الحركة النسائية الفعالة – إلى إيقاظ وعيها وتقوية إحساسها بالمظالم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية الواقعة عليها – بوصفها امرأة – في المجتمع المصرى. وهكذا كان من الطبيعى أن تستمر حركة النساء المصريات وأن تمتد وأن تنتشر ولكن الحركة النسائية في استمرارها وامتدادها وانتشارها بعد الثورة المصرية قد اتخذت طابعا جديدا مستقلا، هو الطابع النسائي الخالص. فبعد أن كانت الحركة النسائية في غمار الثورة متخذة طابعا تغلب عليه النزعة الوطنية المعادية للاستعمار, والخالية أو التي تكاد تكون خالية من المطالب النسائية البحتة، أصبحت هذه الحركة في أعقاب الثورة الوطنية ذات طابع نسائى خالص، أو يكاد يكون نسائيا خالصا.
وكانت لجنة السيدات الوفديات التى انتخبتها جموع النساء إبان الثورة – وعلى رأسها السيدة هدى شعراوى – تقود الحركة النسائية في ذلك الوقت. وقد دعيت هدى شعراوى فى عام ۱۹۲۰ – على أثر ذيوع شهرتها في أنحاء العالم كزعيمة للنساء المصريات – إلى المؤتمر النسائى الدولى لتمثل مصر فيه، فكونت وفدا من السيدات الفضليات تحت رئاستها للسفر إلى الخارج. ولكن أزواج عضوات الوفد النسائي منعوهن من السفر!
وهذا ما كتبته هدى شعراوى عن الواقعة. قالت“رأيت وجوب تلبية الدعوة خدمة للمرأة المصرية، فأقنعت بعض الصديقات بالسفر إلى المؤتمر, وأبرقنا إلى أوروبا بذلك. ولكن الأزواج خذلونا فى اللحظة الأخيرة ورفضوا – بعد قبول – أن يسمحوا لزوجاتهم بالسفر، فتحطم أملى، واضطررت إلى إرسال برقية أعتذر فيها بمرض المندوبات بالحمى الأسبانيولية التي كانت منتشرة في مصر إذ ذاك! ولعلني أحمد للحمى وجودها الذي مكنني من تقديم عذر مقبول!”
على أنه ما كان يجدر بالزعيمة الراحلة أن تنتحل عذرا تخفى به أمام المؤتمر الدولى حقيقة الأمر. ونعتقد أنه كان الأحرى بها أن تبرق إليه بالواقع. وقد كان هذا كفيلا بإثارة السخط فى الرأى العام العالمى على تقييد حرية المرأة المصرية على هذا النحو. وفى هذا ما فيه من تأييد عالمى لقضية المرأة المصرية والحركة النسائية المصرية!
وفي عام ۱۹۲۳ دعيت السيدة هدى شعراوى من جديد إلى المؤتمر النسائي الدولي في روما. وقد تمكنت هذه المرة من السفر إليه على رأس وفد من السيدات المشتغلات بالحركة النسائية. وتبلورت الحركة النسائية تبلورا خالصا في إنشاء الاتحاد النسائى المصرى فى ١٦ مارس سنة ۱۹۲۳، متميزة بذلك عن الحركة النسائية الوطنية التي كانت تمثلها لجنة السيدات الوفديات منذ عام ۱۹۱۹. واكتسبت بذلك الحركة النسائية نهائيا طابعها الخاص الذي بدأ يغلب عليها في أعقاب الثورة.
وسجلت عودة الوفد النسائى من المؤتمر الدولى حدثا تاريخيا هاما في حياة المرأة المصرية. فقد خلعت هدى شعراوى حجابها لأول مرة أمام الجموع المحتشدة لاستقبال الوفد فى الميناء، وظهرت سافرة الوجه, محدثة بذلك انقلابا في تاريخ المرأة المصرية الحديثة. وقد حذت عضوات الوفد الأخريات والنساء المجتمعات فى الميناء حذو هدى شعراوى, محققات بذلك أول خطوة تخطوها المرأة المصرية بنفسها – رغم معارضة المعارضين وثورة الثائرين – نحو التحرر من القيود الثقيلة البالية!!
وتتمثل أهمية هذا الحدث التاريخي – إلى جانب أن المرأة المصرية قد سجلته بإرادتها وعزيمتها – فى أنه قضى على رمز عبودية المرأة المصرية وتأخرها بالنسبة للرجل، وهو الحجاب. وسرعان أن امتدت هذه الحركة إلى أوساط النساء في جميع الطبقات وأصبحت عامة، فتخلصت النساء المصريات في مجموعهن – إلا أقلية ضئيلة من نساء الطبقة الصغيرة وفلاحات الصعيد الأقصى – من الحجاب.
وفي عام ١٩٢٤ أصدرت اللجنة التنفيذية للسيدات الوفديات والاتحاد النسائي المصرى معا بيانا يتضمن المطالب النسائية، وبعثا به إلى الصحف وأعضاء البرلمان والمحافل الدولية. وأهم هذه المطالب ما يأتي.
١ – مساواة الجنسين فى التعليم وفتح أبواب التعليم العالى وامتحاناته لمن يهمها ذلك من الفتيات تشجيعا لنبوغ من لها مواهب خاصة (ولا يفوتنا ذکر مدام کوری مكتشفة الراديوم استشهادا على نبوغ المرأة) وتسهيلا للتكسب لمن تحتاج منهن ورفعا لمستوى العقلية العامة في البلاد.
۲ – تعديل قانون الانتخاب باشتراك النساء مع الرجال في حق الانتخاب ولو بقيود في الدور القادم، كاشتراط التعليم أو دفعها نصابا معينا على مالها من الملك. ولا يكون من الإنصاف الاعتراض على اشتراك هذه الطبقة من النساء سيما وقانون الانتخاب يجعل للرجل الأمى والخالي من الملك حقا فى أن ينتخب وينتخب. وليس من المعقول ولا من العد وأغلبية الرجال كذلك أن تحرم المرأة مع الشروط المتقدمة من المساواة بمثل هذا الجمهور من الرجال.
3 – إصلاح قوانين الزواج وذلك:
أ – بسن قانون يمنع تعدد الزوجات إلا لضرورة كأن تكون الزوجة عقيما أو مريضة.
ب – بسن قانون يلزم المطلق أن لا يطلق زوجته إلا أمام القاضي الشرعي وحققت الحركة النسائية فى هذا الوقت هدفين من أهدافها: أحدهما منع زواج الفتاة دون السادسة عشرة، والآخر المساواة بين الجنسين في مراحل التعليم وخصوصا فتح أبواب الجامعة للطالبات الراغبات. فقد نص القانون على تحريم عقد زواج البنت دون السادسة عشرة والولد دون الثامنة عشرة، واتخذت الفتاة المصرية في سنة ۱۹۲۹ مكانها لأول مرة في كليات الجامعة المصرية.
وفي عام ١٩٣٣ احتفل الاتحاد النسائي بأولى خريجات الجامعة احتفالا رائعا كان له أثر كبير في إقبال الفتيات على طلب العلم من ناحية، وفي إقناع الرأى العام بمقدرة المرأة المصرية – حين تتاح لها الفرصة – على الوصول إلى أعلى درجات التعليم. كذلك بذل الاتحاد النسائي جهودا مشكورة من أجل إرسال الفتيات في البعثات إلى الخارج لاستكمال تعليمهن، وعاونت على تحقيق هذه الفكرة شخصيات من أعلام الفكر والأدب في مقدمتهم معالى لطفى السيد باشا والدكتور طه حسين بك.
امتازت هذه المرحلة من تاريخ الحركة النسائية بالوحدة والتضامن والتعاون بين المشتغلات بمشكلة المرأة, حتى بعد إنشاء الاتحاد النسائى المصرى مستقلا عن لجنة السيدات الوفديات. ولكن سرعان ما دب الانقسام في صفوف الحركة النسائية, كما دب الانقسام من قبل صفوف الحركة الوطنية بظهور الأحزاب السياسية المختلفة. وبدأت مرحلة الانقسام فى الحركة النسائية المصرية وظهور الجمعيات والأحزاب والاتحادات المختلفة.
وبدأ هذا الانقسام بالقطيعة التامة بين لجنة السيدات الوفديات والاتحاد النسائى المصرى. فأما السيدات الوفديات فقد انصرفن إلى النشاط الحزبي البحت بين صفوف الوفد، ولكنهن قمن بدور إيجابي في الكفاح السياسي الشعبى من أجل الدستور الذى ناله الشعب بالدماء. فعندما ألغى دستور سنة ١٩٢٣ ووضعت حكومة إسماعيل صدقى باشا دستور سنة ۱۹٣٠ ثارت المظاهرات الشعبية مطالبة باستعادة دستورها القديم، واشتركت النساء الوفديات فى هذه المظاهرات. ووقع كثير من المعارك مع البوليس والشعب سقط فيها عدد من القتلى والجرحى مازال ذكرهم خالدا في قلوب الشعب المصرى حتى اليوم.
وكان من بين هذه المظاهرات مظاهرة نظمتها السيدات الوفديات بدأت من دار المرحوم رياض باشا وسارت فى طرقات القاهرة محتجة على إلغاء الدستور وحرمان الشعب من الحريات الديمقراطية، ومطالبة بإعادة هذا الدستور. وقد لقيت هذه المظاهرة نجاحا كبيرا بين جماهير الشعب فانضم إليها الكثيرون. ولكن سرعان أن تدخل البوليس فقبض على عدد كبير من النساء والرجال وأودعهم سجون الأقسام.
وقد حدثتنى السيدة سكينة حمزة عن صفوف الشجاعة والبطولة التي أبدتها المتظاهرات المعتقلات في السجون، فروت كيف كن يلجأن إلى استخدام أحمر الشفاة وسيلة للكتابة على الجدران معبرات عن إصرارهن على موقفهن المطالبة بإعادة الدستور، وكيف اضطرت الحكومة تحت ضغط المظاهرات المستمرة إلى الإفراج عن المعتقلات في الليل.
على أن هذا الماضى المجيد يقف عند هذا الحد في تاريخ السيدات الوفديات إذ اقتصر نشاطهن منذ هذا الوقت على الاجتماع مرة كل عام في ذكرى سعد زغلول، والاستماع إلى خطبة أو خطبتين، دون أن يكون لهن نشاط يذكر. كذلك زاد في ضعف اللجنة ما وقع في صفوفها من انقسام مواز للانقسامات التي وقعت في صفوف الوفد نفسه كانقسام السعديين والكتلة الوفدية.
وأما الاتحاد النسائى المصرى فقد مضى في سبيله كما قدمنا مستقلا عن لجنة السيدات الوفديات وأدى خدمات مشكورة في ميدان الحركة النسائية المصرية.
وفي عام ١٩٤٢ أعلنت السيدة فاطمة نعمت راشد إنشاء الحزب النسائي وهو أول هيئة نسائية خالصة تظهر إلى جانب الاتحاد النسائي – وأعلن برنامجه الذي جاء فيه:
١ – مساواة المرأة بالرجل والنهوض بها برفع مستواها الأدبي والفكري والاجتماعي. ٢ – يسعى الحزب بكل الوسائل المشروعة لتنال المرأة المصرية حقوقها القومية والسياسية والاجتماعية كاملة فيكون لها حق الانتخاب والتمثيل النيابي والتمتع بحقوقها كمواطنة مصرية.
٣ – توثيق الراوبط بين نساء مصر والبلاد الشرقية
وللحزب برنامج تفصیلی آخر ضمنه بعض مطالبه وهى:
1 – قبول الفتيات في كل وظائف الدولة على العموم متى كانت لديها المؤهلات اللازمة لشغل هذه الوظائف.
٢ – إعطاء العاملات حق التمتع بكل قوانين العمال ومساواتهن بهم في جميع الحقوق ووجوب اشتراكهن فى النقابات وعمل الترتيب اللازم بحيث تعطى العاملات أجازات كاملة للوضع بأجر كامل والعمل على إنشاء دور لحضانة الأطفال حتى عودة أمهاتهم من العمل.
٣ – ضرورة العمل على منع تعدد الزوجات ومنع إطلاق حرية الطلاق وتقييدهما بما يستبقيهما رخصة لمواجهة الضرورة الطارئة أو الحاجة الماسة وتحريمها حيث يمليها العبث الفارغ.
٤ – تحسين النفقات الشرعية ووجوب سرعة البت فيها.
5 – رفع سن الحضانة عن السن المقررة إلى الآن (١٤ – ١٦).
وقد تعرض الحزب النسائى على أثر ظهوره لحملة عنيفة من الاتحاد النسائي، الذي كان يتهمه بإيقاع الفرقة والانقسام في صفوف الحركة النسائية. ولكن السيدة فاطمة نعمت راشد ردت على هذه الحملة بدفاع طويل قررت فيه أن الاتحاد النسائي قد خمد نشاطه وفترت جهوده، ولم يعد يمثل من الحركة النسائية إلا أعمال البر والإحسان، وأنها حين أنشأت الحزب النسائى لم تكن منقسمة على الاتحاد، لأنها لم تكن عضوة فيه يوما من الأيام، بل كانت تتعاون معه في نشاط الحركة النسائية بوجه عام بكتابة المقالات في الصحف والمجلات وغير ذلك.
والحق أن الحزب النسائى قد برز فى ميدان الحركة النسائية بروزا واضحا وبعث برنامجه النشاط في الحركة النسائية فترة من الزمن فشغلت مشكلة المرأة الرأى العام من جديد. ولكن هذا النشاط لم يثمر في تحقيق هدف واحد من برنامج الحزب ولم يبذل الحزب جهودا كافية في سبيل أهدافه.
وفي غداة الحرب العالمية الثانية نهض الشعب المصرى مطالبا بالجلاء ووحدة وادى النيل ووقعت في خلال عام ١٩٤٦ كثير من المعارك الوطنية الدامية. ولقد اشتركت المرأة المصرية فى المظاهرات الشعبية اشتراكا ملحوظا، بل وساهمت في اللجنة التنفيذية للطلبة والعمال التي قادت الحركة في ذلك الوقت. وقد أثمرت الحركة الشعبية ثمرتها فالتجأت الحكومة المصرية إلى مجلس الأمن لعرض القضية الوطنية عليه والشعب من ورائها يشد أزرها ويدفعها.
ولكن اشتراك المرأة المصرية فى هذه الحركة الوطنية كان مستقلا عن المنظمات النسائية القائمة، وكان أشبه بموقف المرأة من الثورة الوطنية عام ۱۹۱۹ فى انصبابه على الأهداف القومية عامة.
وفى عام ١٩٤٩ ظهرت إلى الوجود منظمة نسائية جديدة هي اتحاد بنت النيل تحت رئاسة الدكتورة درية شفيق. وهذا نص برنامجه:
١ – السعى إلى رفع مستوى الأسرة المصرية ثقافيا واجتماعيا وصحيا.
٢ – السعى إلى إصدار التشريعات التي تحقق تدعيم الأسرة المصرية وتجنيبها عوامل النقسام والتفكك، وذلك عن طريق تقييد الطلاق وتعدد الدوجات بحيث يقصران على الضرورات التي تجيزهما، ويصون الأسرة من نتائج سوء استعمال هذه الرخصة، وبذلك نسبغ الحماية على الأمومة والطفولة معا. ووسيلتنا في تحقيق هذه الأهداف تنحصر فى السعى لتقرير حق المرأة في الانتخاب والنيابة عن الأمة لتتمكن من الدفاع عن حقوق المرأة المصرية والمساهمة في استصدار التشريع الذى يكفل هذه الحقوق واستقرارها وتعميمها“.
وعلى الرغم من هذا البرنامج المقتضب المبهم, والذي لا يختلف في قليل أو كثير عن برنامج الهيئات النسائية المصرية الأخرى اختلافا يبرر إنشاء هيئة جديدة، فإن اتحاد بنت النيل برز في الميدان الصحفى كأنشط مدافع عن الحقوق السياسية للمرأة المصرية فى الوقت الحاضر. فقد عقد مؤتمرات صحفية وانفردت رئيسته بكتابة المقالات فى الصحف مدافعة عن هذه الحقوق، وتمكنت بذلك من تقوية شعور الرأى العام بقضية المرأة المصرية، وإن كانت تلجأ في كثير من الأحيان إلى أسلوب الاستجداء“والتماس العطف” فيما تطالب به, وهو أسلوب من الدعاية لا يثمر في القضايا الاجتماعية، وينحصر أثره على القضايا الشخصية وما يشبهها. أما باقى عضوات هذا الاتحاد فلم يسمع عنهم الرأى العام أو منهم كثيرا!
وإذا كانت الحركة النسائية المصرية حديثة العهد باتحاد بنت النيل، كما أن هذا الاتحاد حديث العهد بدوره بالحركة النسائية المصرية، فإن الأمر يدعو إلى التريث في الحكم عليه حكما قاطعا حتى تتضح حقيقته للرأى العام.
وإن غدا لناظره قريب!
هذا استعراض سريع لحال الحركة النسائية المصرية المعاصرة. ولا يجدر بنا أن نمر على التاريخ مكتفين بسرده سردا مجردا من التعليق والنقد والتوجيه فالظاهرة التي تستلفت النظر في جميع المنظمات النسائية القائمة أنها قاصرة في الغالب على عدد ضئيل من السيدات المثقفات وسيدات المجتمع ولا تضم بين صفوفها ممثلات للنساء الشعبيات, ربات الأسر المتوسطة والطالبات والعاملات والموظفات, بل والفلاحات اللاتى يقاسين آثار المظالم الواقعة على المرأة المصرية في أقصى حدتها.
ولسنا ننعى السيدات المثقفات قيادتهن للحركة النسائية، فهذه القيادة أمر طبيعي. وإنما يعوزهن التأييد الشعبي من جانب الملايين من النساء المصريات، حتى يشعر أولو الأمر بأن مطالب النساء منبعثة من المجموع لا من حفنة من الهاويات الباحثات وراء المغانم الشخصية.
والحق أن المشتغلات بالحركة النسائية المصرية لسن كلهن من سيدات الصالونات الأنيقات الباحثات وراء الأصباغ والمغانم الشخصية، ولسن كلهن من ذوات الشعور الهش الرقيق والهاربات من النساء الشعبيات (لا لسبب مفهوم إلا الخوف أو الاستهتار). فهذا النوع من الهاويات مصيره الفشل المحتوم. ولكن الحركة النسائية المصرية تضم في صفوفها خير العناصر المثقفة القادرة على النضال، ذات الماضى المجيد، والتي لا يضنى المجهود الشاق غصنها الرطب بل تستطيع إذا أصابت الاتجاه – أن تصل ماضيها المجيد بحاضر مجيد ومستقبل أمجد!
وإذا كان لنا أن نقارن الحركة النسائية المصرية بنظيرها في الدول الأجنبية نلاحظ على الفور صدق النقد الذى أبديناه. فالاتحاد النسائي الفرنسي يضم أكثر من مليون عضوة عاملة، ومنظمات نساء أمريكا يضم مثل هذا العدد, والرابطة النسائية الدانمراكية تضم بين صفوفها نحوا من نصف مليون امرأة.
أما المنظمات النسائية المصرية فلا يتجاوز عدد أكبرها على مائتي عضو أو مالا يزيد على ذلك كثيرا. وفى كل يوم تطالعنا الصحف بأنباء النشاط الحافل الذي تبديه المنظمات النسائية الأجنبية في سبيل مطالب النساء. ففى انجلترا تبذل المنظمات النسائية جهدا رائعا من أجل تحقيق المساواة في الأجور بين العمال والعاملات. ومن أمثلة هذا الجهد ما تكتبه عضوات هذه المنظمات على جدران المصانع من نداءات أهمها“نريد نفس الأجر لنفس العمل!”، وما تعقده من اجتماعات تضم آلاف النساء العاملات من أجل تقرير الخطوات اللازمة لتحقيق مطلبهن.
وفى فرنسا لعب الاتحاد النسائى دورا فعالا فى مكافحة السوق السوداء، بتنظيم ربات المنازل الفقيرات ضد هذا الخطر الذي يهدد حياتهن وحياة أسرهن وأطفالهن.
وفى الهند نظمت الفلاحات في جمعيات تعاونية لتحسين ظروف معيشتهن والمطالبة برفع أجور العاملات الزراعيات.
هذه أمثلة عابرة من نضال المنظمات النسائية المصرية إذا أرادت الحياة والنجاح. أما الاكتفاء بالمقالات وحفلات التكريم وغير ذلك من المظاهر الجوفاء فلا يجدى فتيلا في نصرة قضية المرأة المصرية المظلومة!
ولابد للحركة النسائية المصرية أن تنتصر وتحقق أهدافها، فإن عجلة التطور تدور وتدور. ولن يستطيع أعداء المرأة – أعداء الديمقراطية وأعداء التقدم – السافرون منهم والمتسترون – بل والمتسترات أيضا في ثوب أنصار قضية المرأة – لن يستطيع هؤلاء وأولئك أن يوقفوا عجلة الزمن وأن يتحدوا تطور المجتمع!
(1) الأستاذ إسماعيل مظهر في كتابه“المرأة في عصر الديمقراطية“.
(2) حديث من الرسول صلى الله عليه وسلم.
(3) كتاب“تحرير المرأة” للمرحوم قاسم أمين بك.
(4) المارشال هندنبرج القائد الألمانى الشهير فى الحرب العالمية الأولى.
(5) ثورة ۱۹۱۹ – الجزء الأول – عبد الرحمن بك