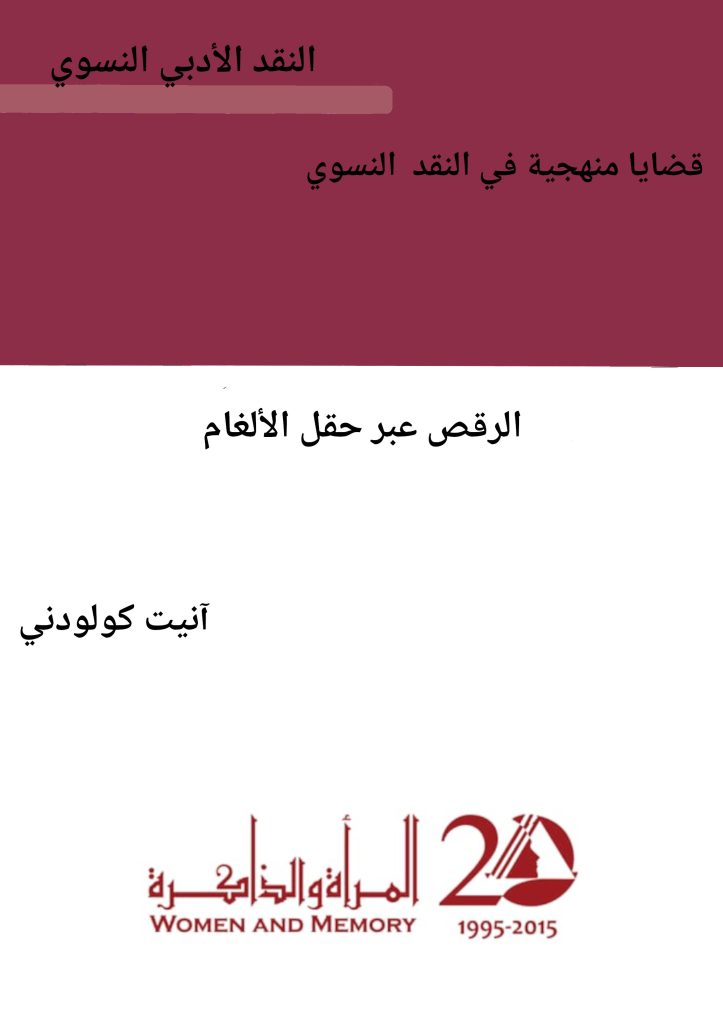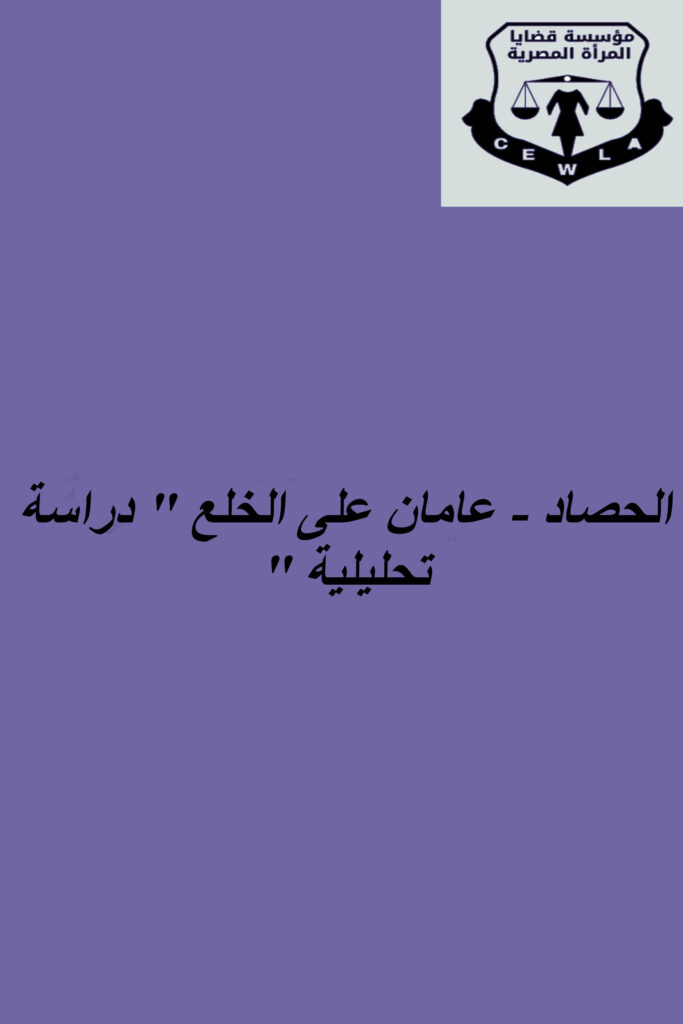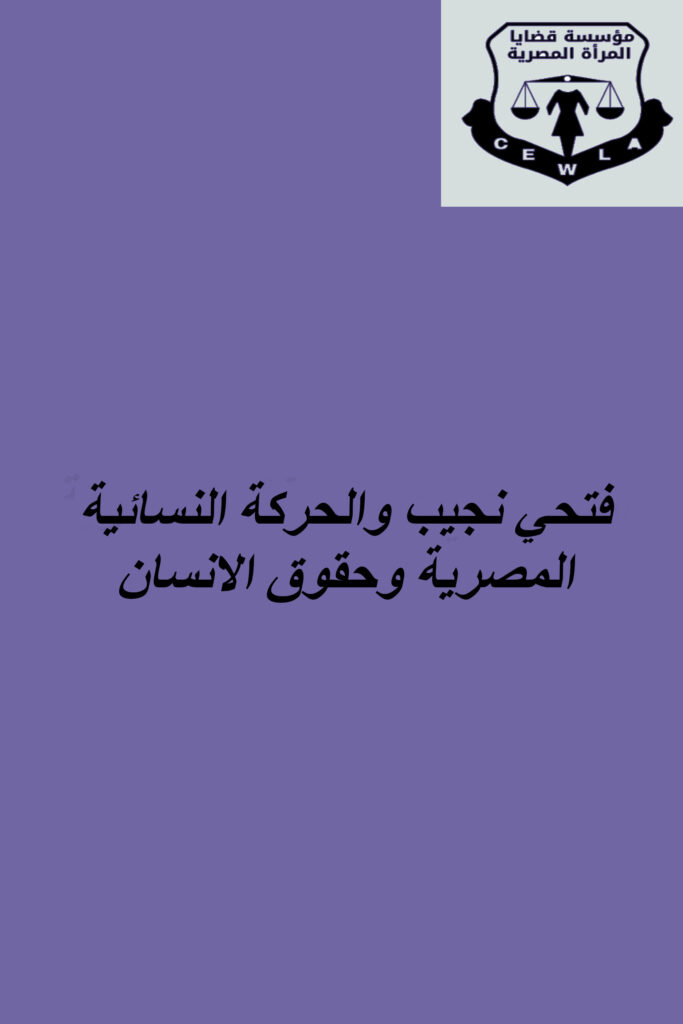الرقص عبر حقل الألغام
ملاحظات في النقد الأدبي النسوي:
نظرية وممارسة وسياسات
لو كان لامرأة أن تتمتع بالصبر الكافي في عام 1969 لأن تطرح سؤالاً حول تعريف النقد الأدبي الـ “نسوي“، لربما كانت. في أعقاب صدور كتاب ماري إيلمان “التفكير في النساء” ( ,Mary Ellmann Thinking About Women)1، قد حصلت على الإجابة القائلة بأن مثل هذا النقد يتضمن الكشف عن التنميط الجنسي للنساء في كل من كتاباتنا الأدبية ونقدنا الأدبي، كما يتضمن توضيح أوجه النقص في المدارس النقدية القائمة وفي مناهج التعامل العادل والحساس مع الأعمال المكتوبة بأقلام النساء، وبشكل عام، فإن مثل هذا التوقع كان سيتحقق بمرور الزمن، بل وفي الواقع نجد أن كتاب ماري إيلمان ما زال مقروءًا بشكل واسع كما يوجهنا في اتجاهات مفيدة. ولكن الأمر الذي لم يكن في الحسبان عام 1969 هو القوة الفاعلة لتلك الأيديولوجية التي ساعدت الكثيرات والكثيرين منا على تخطي الفجوة بين العالم كما وجدناه والعالم كما أردناه. فبالنسبة لمن درس منا الأدب، نجد أن ذلك الإحساس السابق وغير المعرب عنه بشأن الخضوع للاستبعاد والإقصاء عن التأليف، إضافة إلى الإحساس بالضيق الشخصي والأليم عند اكتشاف العاهرات والسافلات، والملهمات والبطلات اللآتي يمتن أثناء الولادة، وظهورهن في الأماكن التي كنا نتمنى رؤية أنفسنا فيها، كانت كلها أحاسيس أصبح من الممكن – ولأول مرة – أن يتم فهمها باعتبارها تحمل معاني أكثر من “مجموعة متفرقة وغير متحققة من العواطف الخاصة“.2 ومع تجدد شجاعتنا للإعلان على الملأ عن مظاهر استيائنا الخاصة، فإن ما كان في السابق “شعورًا فرديًا بعدم الأمان الشخصي” أصبح أخيرًا “يعتبر جماعيًا بأنه عدم ثبات هيكلي“3 داخل نفس الأفرع المعرفية التي درسناها. إن النقد النسوي، في تتبعه بلا رجعة لكل التداعيات المترتبة على ملاحظات ماري إيلمان وفي اكتسابه قدرًا من الجرأة بفضل الطاقة التحررية للأيديولوجيا النسوية – على تنوع أشكالها وهيئاتها – سرعان ما تجاوز مجرد “كشف التحيز الجنسي في عمل أدبي تلو الآخر“4. ووعدنا بإمكانية “بدء تسجيل اختيارات جديدة في تاريخ أدبي جديد“.5 وقد جاءت تلك النزعة التي عايشناها، مع إيدريان ريتش (Adrienne Rich)، نزعة بالغة القوة فعايشناها باعتبارها مسألة تفوق بمراحل كونها “فصلاً في التاريخ الثقافي“، بل أصبحت “فعلاً من أجل البقاء“.6 ولم يمثل النقد النسوي تهديدًا للأدب والنقد في حد ذاتهما، بل بالنسبة للنتائج التاريخية والاجتماعية والأخلاقية المترتبة على مشاركة النساء أو إقصائهن عن أي من الأدب أو النقد.
وكانت مسيرة البحث في السبعينيات تمضى بخطى سريعة وغاضبة – وخاصة في أعقاب صدور تحليل كيت ميليت في عام 1970 عن السياسات الجنسية للأدب7 وما أضافته من قوة وعجلة لما تمثل قبلها في غضب ماري إيلمان الساخر – وذلك في الوقت الذي أدى فيه تنوع هذا التوجه البحثي إلى إفشال كافة الجهود الساعية إلى تعريف النقد الأدبي النسوي باعتباره نظامًا متماسكًا أو كتلة واحدة من المنهجيات. ففي إطاره الواسع أصبحت كل الأمور مطروحة للتساؤل، أي الأعمال الأدبية العظمى، ومعاييرنا الجمالية واستراتيجياتنا التأويلية وعاداتنا في القراءة، وفوق هذا وذاك أنفسنا باعتبارنا نقادًا وناقدات ومدرسين ومدرسات. إن تحديد المجال الكامل للنقد الأدبي النسوي يتطلب مساحة كتاب على الأقل، وسيتحول إلى كتاب متقادم حتى أثناء تأليفه، وبالتالي، وعلى سبيل الإيجاز، دعوني أحاول تقديم عرض مختصر.
لعل أكثر أوجه نجاح هذا النوع الجديد من الأبحاث وضوحًا تمثل في العودة إلى تداول أعمال بأقلام نسائية، كان قد سبق ضياعها أو تجاهلها، ففي أعقاب النجاح المبدئي لدار النشر النسوية (Feminist Press) في إعادة طباعة كنوز مثل الرواية القصيرة “الحياة في المصانع الحديدية” بقلم ريبيكا هاردينج ديفيز التي ترجع إلى عام 1861 (Rebecca Harding Davis, Life in the Iron Mills 1861)، والقصة القصيرة “ورق الحائط الأصفر” بقلم شارلوت بيركيتز جيلمان التي ترجع إلى عام ۱۸۹۲ (1892 Charlotte Perkins Gilman, “The Yellow Wallpaper)، وهما النصان اللذان قامت دار النشر النسوية بإعادة طباعتهما في عام ١٩٧٢ وعام 1973 على الترتيب8، أخذت دور النشر التجارية والتلك المتخصصة في إعادة إصدار طبعات جديدة من كتب قديمة بالتنافس فيما بينها في إعادة طباعة مجموعات من النصوص الضائعة، بل وإعادة طباعة سلاسل بأكملها في بعض الحالات. وبالنسبة للمتخصصين والمتخصصات منا في الأدب الأمريكي على وجه التحديد، كانت تلك الظاهرة بشرى بإعادة تشكيل جذري لمفاهيمنا عن التاريخ الأدبي، وببداية فصل جديد في فهم تطور التراث الأدبي النسائي على أقل تقدير. وقد تمتعت تلك الطبعات الجديدة بنجاح تجاري كما أصبحت دور النشر وإعادة الطباعة متوافقة مع التوجهات السياسية للقارئات والقراء المهتمين بتلك الإصدارات، مما أدى إلى أن وجدت الكثيرات منا أنفسهن منجذبات إلى تأليف مقدمات نقدية التي تتقصى في صفحات الروايات المنزلية والعاطفية من القرن التاسع عشر بعض الإشارات والعلامات على أشكال التمرد الصامت أو الثورة الراديكالية الصريحة، وذلك في انتظار الموجة الحالية من “النسوية الجديدة“. ومن خلال قيامنا مع طالباتنا وطلابنا بإعادة قراءة تلك العمال التي سبق ضياعها، كان من المحتم علينا إثارة أسئلة مربكة فيما يتعلق بأسباب اختفائها من مجموعات “الأعمال الكبرى“، كما انزعجنا من المعايير الجمالية والنقدية التي تم بموجبها التقليل من شأن ومكانة تلك النصوص النسائية، إن تزايد إتاحة العمال النسائية أدى بالطبع إلى تزايد الاهتمام بالعناصر التي – إن وجدت – ربما تشكل نوعًا من الوحدة أو الصلة فيما بينها، إن الإمكانية القائلة بقيام النساء يتطوير تراث فريد، أو على الأقل مترابط، خاص بهن، هي مسألة أثارت اهتمام المتخصصات منا في أدب قومي ما أو في الفترات التاريخية. ويأتي كتاب نينا بايم الصادر مؤخرًا عن “رواية المرأة: دليل الروايات المكتوبة بأقلام النساء وعن النساء في أمريكا، ۱۸۲۰– ۱۸۷۰ ( Nina Baym, Woman’s Fiction: A Guide to Novels by and about Women in America, 1820 1870)9 موضحًا ولع المتخصصات في الأدب الأمريكي بدراسة الكتب “الأكثر مبيعًا” في أزمانها، ومكانة كتّاب الأدب الروائي الرائج، وقد كانت تتمتع النساء من بينهم بمكانة بارزة على مدار القرن التاسع عشر، في حين كانت الدراسات النسوية للأدب البريطاني تؤكد على كثرة الكاتبات اللآتي اعتبرن جديرات باحتلال مكانة ضمن كبار الكتاب. وسعيا من أجل توضيح أبعاد الأسئلة الواجب طرحها، دون التركيز على البناء على أعمال الأخريات، قامت كل من جانيت كابلان وإيلين مويرز وباتريشا ماير سباکس وايلين شوولتر ( Janet Kaplan, Ellen Moers, Patricia Meyer Spacks, Elaine Showalter) وغيرهن بتركيز طاقاتهن على تحديد وجود “كم من الأعمال” المتماسكة داخليًا بأقلام نسائية يمكن أن تمثل تراثًا مضادًا خاصًا بالمرأة. فبالنسبة لجانيت كابلان في عام 1975، تضمن الأمر دراسة المحاولات المتنوعة التي قامت بها الكاتبات لرسم صورة الوعي الأنثوي والوعي بالذات، لا باعتباره فئة نفسية بل أداة أسلوبية أو بلاغية.10 ومن خلال تأكيدها أساسًا على أن الأدب يعلن عن الجانب الخاص، قامت باتريشا ماير سباكس في العام نفسه بوضع اهتمامها بوجود “مخيلة الأنثى” داخل أطر اجتماعية وتاريخية، منتهية إلى أنه “لأسباب تاريخية واضحة اهتمت النساء بأمور هامشية مقارنة باهتمامات الرجل“، وقد أرجعت إلى ذلك الاختلاف الحتمي في مواضع التركيز والموضوعات الأدبية الخاصة بالكتاب رجالاً ونساء.11 وفي العام التالي جاء كتاب إيلين مويرز “نساء الأدب: الكاتبات العظيمات” (Ellen Moers, Literary Women: The Great Writers) مركزًا على سبل التأثير الأدبي التي ربطت بين الرواية الإنجليزية وأيادي النساء.12 وأخيرًا تولت إيلين شوولتر، في عام ١٩٧٧، مسألة وجود التراث أدبي للمرأة في الرواية الإنجليزية من جبل الأخوات برونتي وحتى يومنا هذا” وذلك مؤكدة على أنه بسبب كون النساء عمومًا يشكلن نوعًا من “الثقافة الفرعية داخل إطار المجتمع الأكبر” فإن أعمال الكاتبات تحديدًا ستبين بالتالي وجود وحدة في “القيم والقواعد والتجارب والسلوكيات المؤثرة على كل فرد” حيث تجد كل امرأة مصادرها من “التعبير عن الذات متناسبة مع مجتمع سائد وذكوري بالتبعية)”13.
وفي نفس الوقت الذي تمت فيه أعادة النظر وإعادة قراءة الكاتبات، خضع الرجال أيضا لتدقيق نسوي جديد. وإذا وضعنا سنوات من التحليل العصيب في جملة واحدة أمكننا القول بأن النتيجة المستمرة لذلك لم تقل عن قيام انتباه حاد إلى الطرق التي يتم بها تسجيل بعض علاقات القوى، والتي تكون عادة علاقات يقوم من خلالها الذكور بفرض أشكال من التأثير على الإناث، وأساليب تدوينها في النصوص (الأدبية والنقدية) التي ورثناها عمن سبقونا، لا من منطلق كونها موضوعًا بل باعتبارها أمورًا مفروغًا منها غير قابلة للتساؤل وكثيرًا ما لا يعترف بها، تمنحها الثقافة، والأمر الأهم من التأويلات الجديدة لنصوص فردية يتمثل في تناول التداعيات (بالنسبة للنساء) المترتبة على القواعد التقليدية التي تحكم تلك النصوص. فعلى سبيل المثال، عند تتبع روايات بريطانية مختارة من القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين، والتي تقوم بتوظيف ما أطلقت عليه جين كينارد “قاعدة الرجلين المتقدمين للزواج التقليدية“، نجد أن جين كينارد قد سعت إلى فهم أسباب وكيفية أن المطالب البنيوية التي تفرضها تلك القاعدة التقليدية، وحتى عند استخدامها بأقلام نسائية، تعمل على الإيحاء حتميا بـ “دونية وضرورة تبعية النساء“. وتبين دراستها عام 1978 عن “ضحايا القاعدة التقليدية” (Jean E. Kennard, Victims of Convention) أن الطبيعة الرمزية للزواج والتي تمثل النهاية التقليدية لمثل تلك الروايات “تشير تكيف الشخصية الرئيسية مع قيم المجتمع، وهو وضع تتم معادلته بنضج تلك الشخصية“. ولكن اهتمام جين كينارد ينصب على أن المطالب البنيوية الخاصة بالشكل الأدبي كثيرًا ما تؤدي إلى التضحية تحديدا بتلك “المزايا التي دعينا إلى الإعجاب بها لدى“البطلات.14 ونجد أن جين كينارد على حق في تحذيرنا من استخلاص أي فكرة مبسطة ومختزلة من كتاباتها بشأن علاقات المحاكاة بين الفن والحياة. ولكن مقارنتها توحي مع ذلك بأن ما يهم في الأدب الروائي ليست نهايته سواء جاءت بالموت أو الزواج، بل ما يهم هو المطالب الرمزية الخاصة بنهاية تقليدية ما وما تشير إليه بشأن القيم والمعتقدات الخاصة بالمجتمع الذي أوجدها. وهكذا تشارك كتاباتها في التأكيد المتزايد في الدراسة الأدبية النسوية على كون الأدب مؤسسة اجتماعية، غير متأصلة فقط داخل تراثها الأدين بل وأيضا داخل المنتجات الفنية المادية والعقلية الخاصة بالمجتمع الذي ينتج هذا الأدب، وبالإشارة إلى قرار كيت میلیت عام ۱۹۷۰ بربط “التأملات الأدبية” الخاصة بها بما سبقها من تحليل للسياقات التاريخية والاجتماعية والاقتصادية للسياسات الجنسية،15 نجد عملا أحدث – وأبرزه دراسة ليليان روبنسون Lillian Robinson)) – يبدأ بإحدى المسلمات القائلة بأن عملية الإبداع الأدبي “لا تتكون من أحداث شبحية تدور في الرأس بل من اقتران الحالات والمسارات الخاصة بالنماذج الرمزية مع حالات ومسارات العالم الأوسع“. 16 وترى هؤلاء الناقدات أن علاقات القوى المدونة في شكل القواعد التقليدية في موروثنا الأدبي تحدد المعالم التي يتم بها فك رموز علاقات القوى تلك وشفراتها القائمة في الثقافة عمومًا. وتتحول الدراسة النقدية للشفرات البلاغية بين أيديهن إلى بحث عن الشفرات الأيديولوجية، نظرًا لما يتجسد في كليهما من أنظمة قيمية أو جدلية التنافس بين أنظمة القيم، وكثيرًا ما نلحظ إصرار هؤلاء الناقدات أيضًا على فحص انعكاس الحياة في الفن، بل وكذلك تأثير الفن على الحياة من منطلق معياري، ومن خلال توجهها إلى الفن الدارج (popular art) المتاح للنساء العاملات على سبيل المثال، تهتم ليليان روبنسون يفهم “الأشكال التي يستخدمها” بل والأهم “الأساطير التي يخلقها، والتأثير الذي تفرضه“. وهي تعلن أن “الطريقة التي يساعد بها الفن الناس على ترتيب أو تأويل أو التخلص من تجاربهم أو تحويلها إلى أساطير” قد تكون مسألة “معقدة وكثيرًا ما تكون غامضة، ولكن تحديدها وتعريفها ليس محالاً“.۱۷
وسواء جاء تركيز كل النقد الأدبي النسوي على السياسات المادية أو المتخيلة بشأن الابتكار الأدبي، والنصوص الفردية أو التراث الشامل، والعلاقات بين المؤلفين والمؤلفات وبين الأجناس الأدبية أو الأوضاع التاريخية، والمؤلفات والمؤلفين المفقودين أو الأسماء المشهورة، فإن هذا النقد على تنوعه وتباينه ينتهي به الأمر إلى التجانس والاتساق فيما بينه من حيث موقفه من إعادة القراءة التي تقترب من النبرة الاعتذارية. إن ما أطلقت عليه إيدريان ريتش (Adrienne Rich) من قبل مسمى “المراجعة“، أي “العمل القائم على إعادة النظر والرؤية مجددًا ودخول نص قديم من اتجاه نقدي جديد“18، هي عملية اتخذت صبغة متزايدة من حماية الذات في عام 1978، عندما طالبت جوديث فيتيرلي (Judith Fetterley) المرأة القارئة بتعلم “مقاومة” المخططات القائمة على التحيز الجنسي والتي قد يوجهها النص إلى القارئة – بأن يطلب منها التماهي ضد نفسها، أي بالتلاعب بتعاطفها الصالح الأبطال وضد شخصيات الأنثى الماكرة أو السافلة.19 وكان التحالف غير المتوقع الذي تم بين الدراسة الأدبية النسوية والدراسات النسوية في اللغويات واكتساب اللغة من الدعائم التي قام عليها الكثير من جهود إعادة القراءة النقدية. ونجد أن ملاحظة تيلي أولسن (Tille Olsen) المنطقية عن مخاطر “الدوام – من خلال الاستخدام المتواصل – لوقائع القوى القاهرة المستمرة منذ قرون، والتي تم إدماجها منذ فترة مبكرة داخل اللغة“20، هي ملاحظة نالت قدرًا معتبرًا من التحليل في كتابات النسويات اللآتي يدرسن “اللغة بوصفها نظامًا رمزيًا وثيق الصلة بالبنية الاجتماعية الأبوية“. وإذا أخدنا تلك الكتابات جنبًا إلى جنب فسوف أنها توضح “أهمية اللغة في إقامة وانعكاس على علاقة غير متناظرة بين النساء والرجال“.21
إن أخذ تداعيات هذا الأمر في الاعتبار من حيث مصير النساء اللآتي يحاولن ممارسة حرفة اللغة هو أمر يعني، وربما للمرة الأولى، التحقق من المأزق الحقيقي للشعرة التي تجد أكثر تجاري الشخصية الغالية “محاصرة بالمحرمات، وملغمة بالتسميات الزائفة“.22 كما يفسر مأزق القارئ الرجل الذي يجد نفسه، عند فتحه صفحات من كتاب للمرأة، يدخل عالمًا غربيًا وغير مالوف من الدلالة الرمزية، فكما تؤكد نيلي فورمان (Nelly Furman) بإصرار، إن لم يكن أي من استخدام اللغة أو اكتساب اللغة “حيادًا جندريًا” (gender- Nneutral)، بل “متشربًا بقيمنا الثقافية المتأثرة بالجنس“.23 وكذلك فإذا كانت القراءة هي عملية “فرز لبني الدلالة” 24 في أي نص، فإن القراء الذين يجدون أنفسهم خارج إطار الأنظمة الرمزية التي المكونة لتجربة الأنوثة في الكتابات النسائية و يجدونها غير مألوفة بالنسبة لهم، فإنهم سيقومون بالضرورة بتنحية تلك الأنظمة باعتبارها في مفهومة أو بلا معنى أو تافهة. ولن يجد الأساتذة الرجال سببًا يجعلهم يضمون مثل هذه الكتابات ضمن مجموعات “كبار المؤلفين“. وفي نفس الوقت، فإن الكاتبات اللآتي يجدن أنفسين داخل تراث من اللغة الأدبية والأشكال التقليدية التي تم توظيفها بالفعل في خدمة التعبير الذكوري على مدى قرون، سيضطررن ضمنيًا إلى “مصارعة” اللغة من أجل “إعادة صياغتها كلغة مناسبة لمسارات الفكرية“.25 وقد انتبهت النسويات المهتمات بسياسات اللغة والأسلوب إلى كافة تلك المسائل انتباه حادًا، فقد لاحظت الناقدة النسوية إيلين سيكسو (Hélène Cixous) قائلة “إن اللغة تخفي خصمًا لا يقهر” وذلك “لأنها لغة الرجال وقواعدهم اللغوية“.26 ولكننا نجد تأكيدًا مماثلاً لذلك، في كتابات ساندرا جيلبيرت وسوزان جوبار مثلاً، يصر على فهم حاجة كل القراء، رجالاً ونساءً على حد سواء، إلى تعلم التغلغل داخل العوالم غير المألوفة الخاصة بالفعل الرمزي والتي تشكل الكتابات النسائية في الماضي والحاضر.27
إن محاولة تناول هذا الكم من الأسئلة الصعبة والنجاح في إنجاز الكثير – بل وحتى الاعتراف بالبدايات الزائفة الحتمية والتداخلات والتكرار – في فترة زمنية قصيرة هي أمور – ضمنت بالتاكيه للنقد الأدبي النسوي مقامًا كريمًا خلال تلك الرحلة الفكرية التي تطلق عليها إجمالاً في المجال الأكاديمي مسمى “التحليل النقدي “. ولكن بدلاً من أن يتم الترحيب بنا على متن القطار، ثم إجبارنا على التعامل مع حقل الغام. إن الطاقة والتنوع الخاص بمشروعنا جعلانا معرضات للهجوم على أساس أننا تفتقد إلى التعريف والتماسك والاتساق، بينما نجد أن انتباهنا إلى الطرق التي تقوم بها اللغة بتشفير وترميز ونشر أنظمة القيم الثقافية هو نفسه الذي يستنزل علينا لعنات في أصداء لما انهال على الناقدات والنقاد الماركسيين في الجيل السابق، فإذا كنا باحثات متفرغات لإعادة اكتشاف الكم المفقود من الكتابات بأقلام النساء، فإن نتائج بحثنا تكون خاضعة للتساؤلات على أسس جمالية، وإذا كنا ناقدات مصممات على ممارسة القراءات القائمة على المراجعات النقدية فيتم الزعم بأننا تركز على تضييق مجال الرؤية وأن النتائج التي نتوصل إلينا ما هي إلا تشويهات بل والأسوأ من ذلك هو الزعم بأنها سوء قراءة جدلية.
إن شدة تلك الصيحة، مع ما نلقاه من تغييب كامل في بعض المناحي،28 لا تشير إلى ما فينا من تواقص وإنما إلى مدى التحدي الذي يواجهنا، حيث أن الأمور التي تطالب بالتدقيق والتمحيص فيها ليست سوى المسملات الثقافية المشتركة والمتجذرة والمتأصلة لفترة طالت إلى الدرجة التي جعلت زملاءنا غير مدركين لما هي عليه، وبمعنى آخر، فإن المزاعم الموجهة إلينا بأننا نقوم بتشويه النصوص أو أننا مصدر تهديد قد يؤدي إلى اختفاء التراث الأدبي الغربي العظيم في حد ذاته، 29 هي مزاعم لا يتم التأسي عليها حقا مخافة اختفاء النص أو التراث، بل خشية تراجع ذلك الشكل الخاص بالنص وذلك التشكيل الخاص بالتراث والذي كان في السابق يحدد معالم إحساس القراء الرجال بالسلطة والأهمية في العالم، وعلى سبيل المقارنة، عندما نتوجه إلى أنفسنا، كقارئات، بالسؤال عما إذا كان “يسعدنا حقا زواج دوروثيا بروك من ويل لاديسلو؟ وشيرلي كيلدار من لوي مور؟” أو ما إذا كان علينا، كما تشير كينارد، أن نتقبل الأساليب التي تمت بها “التضحية بالمزايا التي دعينا إلى الإعجاب بها لدى هؤلاء البطلات، وذلك لصالح الانضباط البنيوي“، 30 فإنما نقوم حينها بطرح أسئلة صعبة وعميقة ومربكة عن التداعيات الأخلاقية المترتبة على مواطن اللذة الجمالية المحسومة وغير المطروحة للنقاش، وفي النهاية فإن الأمر يعني فرض نظام علوي يطالب المشاهد بالالتفات إلى معاناة أوفيليا في مشهد كان على المشاهد دوما مجرد تثبيت أنظاره على هملت. وهكذا فإن إدراك كون ذلك كله باعتباره حقيقة التحدي الذي قدمناه للمشاهدين، وبالتالي بوصفه الدافع الذي أثار كل العداء الصريح، هو إدراك يجب أن يعلمنا التفاوض والتعامل مع حقل الألغام، إن لم يكن بلباقة فعلى الأقل بفهم أكثر وضوحًا لأنماطه الدفينة.
إن الطريقة التي يتم بها عادة توجيه الاعتراضات على عملنا تعمل بالتأكيد على إخفاء معالم دوافعها العميقة، ولكن قد يرجع ذلك جزئيًا إلى إحجامنا عن تحمل المسؤولية الكاملة عن الفرضيات الثورية حقا الكامنة في الجوهر النظري لكل ما حققناه حتى الآن. وبالتالي لعل الوقت قد حان لإعادة أكثر مسار النقاش الدائر بإجبار خصومنا على التعامل مع القضايا الهامة، والدفع بأنفسنا إلى تعبيرًا أكثر وضوحًا عن أنفسنا، وأخشى أننا حتى الآن تعاملنا مع الصعوبات بصور متفرقة، وهي الصعوبات القائمة في تحدي سلطة المذاهب والمدارس الأدبية الراسخة ثم تبرير أوجه الامتياز والتميز الواضع في التراث النسائي مع تناوله بما يتوافق أحيانًا مع معايير لا يمت لها التراث النسائي بصلة جوهرية وثيقة.
وفي اللحظة التي يتعين علينا اقتحام الخطاب – أي إعلان تميز أو أهمية ما “وجدناه” من نتائج – إذا بنا نكتشف أن باب المناقشة تم غلقه منذ فترة طويلة، وقد أكد لي مرة زميل من الدارسين في جامعة أوكسفورد قائلاً “لو كانت كيت شوبان حقا جديرة بالقراءة” لكانت “قد كتب لها البقاء – مثل شيكسبير“، ثم قام بالتصويت معترضًا على اعتراف قسم الدراسات الإنجليزية ببرنامج دراسي (سمينار) في الدراسات النسائية كنت أقوم بتدريسه ضمن مقرر دراسي عن الكاتبات الأمريكيات فالتراث الرسمي بالنسبة له كان يتمتع بالامتياز، أما إقصاء كيت شوبان فإنما كان يوضح مكانتها الأدنى. ومن وجهة نظري لم يكن في إمكاني تبرير اعتراف قسم الدراسات الإنجليزية بدراسة كاتبة مثل کیت شوبان (Kate Chopin) بقدر ما لم يكن في الإمكان التشكيك في عبقرية شيكسبير، وبنظرة إلى الوراء، أصبحت الآن قادرة على إدراك أن النقاش لا يقتصر على طرح معارضات بلا طائل بل أدى إلى تجنب تام لتناول مشكلة أكثر عمقًا كامنة تحت سطح خلافنا، أي أن وضع عمل ما ضمن التراث الرسمي إنما يضعه بعيدًا عن أية تساؤلات بشأن إثبات مكانته، بل ويدعو الدارسين والدارسات إلى تقديم المزيد من القراءات والتأويلات الألمعية بغرض التدليل على العظمة التي تم بالفعل إضفاؤها على الكاتب أو العمل الأدبي من خلال إدماجه ضمن التراث الرسمي.
ولو كنت قد فهمت الأمر على حقيقته حينذاك، لكنت ربما قد أدخلت بعض المقولات إلى تلك المجموعة من الفرضيات التي تدور حول نفسها وتخدم مصالحها، وكانت حينها ستتناول مقولاتي تلك حقي في طرح الأسئلة حول الأسباب التي تضفي الهيبة والمهابة على أي نص، وحاجتي إلى معرفة ما ينبئنا به عن “كيف نحيا، وكيف كنا نحيا، وكيف تم توجهنا نحو الصورة التي نتخيل أنفسنا عليها، (و) كيف قامت لغتنا بمحاصرتنا وكذلك تحريرنا“. 31 إن كوننا قد تلقينا تعليمنا النقدي داخل الحدود الضيقة المفروضة بواسطة التراث الرسمي من كبار المؤلفين والأعمال الأدبية إنما يبعدنا باستمرار عن مثل تلك الأسئلة والتساؤلات. بل ونجد أنفسنا نرد بلا نهاية على الردود المتسرعة بأن الحضور الذكوري الأعم والأشمل ضمن المؤلفين الرسميين لم يكن سوى صدفة تاريخية ولم يكن أبدا تحيزًا جنسيًا مقصودًا، وذلك بالإضافة إلى المزاعم بالقيمة الجمالية “الواضحة” التي تتسم بها تلك النصوص الرسمية، إن الأمر كما أراه عملية حوارية غير مجدية لا تؤدي سوى إلى مزيد من التعليم بدلاً من الكشف عن المساحة التي تتم حمايتها، مع جرنا مرة تلو الأخرى عبر حقل الألغام.
وإنني على قناعة أن مظاهر العداء الحالية قد تتحول إلى حوار حقيقي مع نقادنا إذا كشفنا صراحة في النهاية عما يبدو، بالنسبة لذلك المراقب، بمثابة مكونات المقولات الأساسية الثلاثة التي حتما تثيرها اهتماماتنا، كما أنها مقولات يمكنها، في حالة التعامل معها بعناية وذكاء، أن تنفخ روحًا جديدة في مناطق من مجال عملنا المهني تكاد تعاني سكرات الموت، وهذه المقولات هي كالتالي: 1) إن التاريخ الأدبي (ومعه السياق التاريخي للأدب) هو محض خيال، ۲) طبقًا لكيفية القراءة كما تعلمناها فإن ما نتعامل معه ليس نصوصًا بل منظومات، وأخيرًا 3) نظرًا لأن الأسس التي نضفي تبعًا لها القيمة الجمالية على النصوص ليس أسسًا معصومة من الخطأ أو غير قابلة للتغير أو عامة، فإن ما يجب علينا إعادة فحصة لا يقتصر على الجماليات التي تستخدمها بل يشمل أيضًا الفرضيات والتحيزات الكامنة المؤثرة في المناهج النقدية التي تشكل (جزئيًا) استجاباتنا الجمالية، وعلى سبيل الإيجاز لن أحاول تقديم الآراء الخاصة بكل من المقولات الثلاثة، بل سأكتفي بتوضيح كاف لإبراز ما أراه بمثابة علاقتها الجوهرية الوثيقة بالمجال المحتمل والتحدي الحالي الذي توحي به الدراسة الأدبية النسوية.
1. إن التاريخ الأدبي (ومعه السياق التاريخي للأدب) هو محض خيال. فبداية، إن التراث الرسمي يمثل نموذجًا يتم من خلاله رسم أوجه التواصل والانقطاع، وكذلك التأثيرات على التفاعلات فيما بين الأعمال والأجناس والمؤلفين. ولكننا نميل إلى نسيان أن هذا النموذج هو من صنع أيدينا، وهو سيتخذ شكلاً مختلفًا تمامًا وسيتم تفسير ما يتضمنه وما يستبعده بطرق مختلفة تمامًا إذا آمنت الأيديولوجيا النقدية السائدة أن الأشكال الأدبية الجديدة تنتج من نوع من الجدل الداخلي المستمر داخل التراث والأساليب المسبقة. أو على النقيض من ذلك، إذا قامت الأيديولوجيا بالتصريح بأن التغير الأدبي يعتمد على التطور المجتمعي وبالتالي تتحدد معالمه تبعًا للهزات التي يشهدها التنظيم الاجتماعي والاقتصادي للثقافة عموما.32 وبالفعل فكلما حدث في القرن الماضي من البحوث في الأدبين الإنجليزي والأمريكي أن حل بديل محل الآخر رأينا تحولات قوية في “الحكمة” التراثية.
ويوحي ذلك الأمر بالتالي بأن إحساسنا بوجود “تاريخ أدبي” وما يستتبعه من ثقتنا في وجود تراث رسمي “تاريخي” هو إحساس تضرب جذوره لا في أي فهم محدد للماضي بقدر ما ينبع من حاجتنا لاستدعاء الماضي واستخدامه من أجل فهم أفضل للحاضر. وهكذا، ومن منطلق ما قاله ديفيد كوزينس هوي، يصبح من الضروري “الإشارة إلى أن فهم الفن والأدب هو جانب جوهري من فهم الذات في الحاضر بحيث هذا الفهم للذات يحدد الأشياء التي يتم أخذها” باعتباره يكون ذلك الماضي الفني والأدبي، وعلى سبيل الاستشهاد بكلام ديفيد كوزينس هوي كاملا فإن “تلك العملية المستمرة من إعادة تأويل الماضي تتزامن مع العملية المستمرة من إعادة تأويل الحاضر تقسمه بنفسه“.33 وفي زماننا نعاني مما أطلق عليه هارولد بلوم “خفوتًا ملحوظًا” في “إحساسنا المتبادل بالمعايير التراثية“،34 وذلك مع غياب ثقتنا في أي نموذج، أو أيها على الإطلاق. يفسر حقًا اختياراتنا للتراث الرسمي أو ما يشرح بدقة التاريخ الأدبي، ذلك إلى جانب خضوعنا لمزيد من الضغوط من دعاوى النسوبات المطالبة ببعض المبررات للمعايير التي تم بناء عليها إقصاء الكتابات النسائية بقدر كبير واستبعادها من هذا التراث الرسمي ومن التاريخ.
وأمام هذا الطريق الذي يبدو مسدودًا، تقوم المتخصصات في التنظير الأدبي النسوي بتضمين الملاحظة القائلة بأن اختياراتنا وتقييماتنا للأدب الحالي لها تأثيرها إما بترسيخ أو بإعادة تشكيل إحساسنا بالماضي، حيث تتحدد معالم السلطة التي يتمتع بها أي تراث رسمي قائم تبعًا لإدراكنا أن العمل الأدبي الموجود حاليًا يبدو وقد خرج حتميًا تقريبًا من ذلك التراث (حتى ولو كان ذلك على سبيل معارضة التراث أو التمرد عليه)، ويصبح هذا العمل الأدبي موضعًا للتساؤل إذا بدا لنا ما نقرؤه على علاقة ضعيفة أو لا علاقة له بما تعتبره تراثًا سابقًا عليه، وهكذا فإذا كان للمجتمع النقدي الأوسع أن يبدأ في الالتفات جديًا إلى السيل المهمر مؤخرًا من الأدب الرفيع المكتوب بأفلام النساء، فسوف يصاحب تلك العملية بالتأكيد بحث في الماضي بواسطة المؤرخات والمؤرخين للأدب، من أجل تفسير الظاهرة الخاصة بالحاضر وخلال تلك العملية سيتعرض التاريخ الأدبي نفسه للتعديل، حيث نجد أن الكتابات النسائية التي ترجع إلى القرن السابع عشر أو الثامن عشر أو التاسع عشر، والتي لم تكن تلتفت إليها من قبل، قد تنال أهمية جديدة باعتبارها “بشائر” أو مؤثرات سابقة تركت بصمتها على كاتبات الحاضر، بينما قد يحظى بعض الكتاب أيضًا بمكانة جديدة بوصفہم شخصیات شعرت نساء اليوم أو حتى الأمس بالحاجة إلى رفضهم. وبمعنى آخر فإنني أؤكد هنا على أن اختيارات التي نقوم بها في الحاضر تعمل حتميا على تعديل إحساسنا بالماضي الذي أوصلنا إليها.
ويتصل بهذا الأمر التحدي النسوي الموجه إلى الوهم النقدي الكاذب القائل بأننا نقرأ “الكلاسيكيات” لإعادة بناء الماضي “على ما كان عليه حقا“، وأننا نقرأ شيكسبير وميلتون كي نفهم المعاني التي قصداها، ومع افتقارنا إلى أعداد من آلة الزمن وإلى أشكال من البعث الإعجازي، ليس لدينا طريقة للتعرف بدقة أو بالتأكيد ما الذي “كان حقًا“، أي ما الذي قصده هوميروس عندما كان يغني، وميلتون عندما كان يملي. وقد قامت ناقدات أكثر مني حذقا بالإشارة إلى استحالة تأسيس قراءة ما على سند من نية المؤلف أو المؤلفة، نظرًا لأنه كلما بعدت المسافة بيننا وبين كاتبة أو كاتب ما كلما بعدت عنا ما يخص هذا الكاتب أو الكاتبة من أنظمة للمعرفة والعقيدة، ووجهات النظر، وبنى الرؤية (الفنية وغيرها). 35 (وأقوم هنا بحذف مسألة صعوبة النجاح في إثبات أو نفي سند النية والقصد من الكتابة، لأنه لا مفر من أن صاحب السلطة الوحيد غائب، أي أنه قد مات) وبالتالي، فإن ما نقصده حقًا عندما نتحدث عن الكفاءة في قراءة النصوص التاريخية هو القدرة على التعرف على القوالب والتقاليد الأدبية التي كتب لها البقاء عبر الزمان – بما جعلها تظل فاعلة في ذهن القارئ أو القارية – والقدرة في حالة غياب تلك القوالب على ترجمة (أو ربما تحويل) شفرات النص إلى أشكال أكثر قربًا إلينا في الحاضر ولكننا لا تقوم أبدا بإعادة بناء الماضي حقا تبعًا لما كان عليه، وهكذا فإن مكسبنا من قراءة “الكلاسيكيات” لا يتمثل في معرفة اليونان أيام هوميروس أو إنجلترا في عصر جورج إليوت. علما عرفها كل منهما، ولكن مكسبنا هو تقريب الماضي المستد روائيًا وخياليًا وإتاحته لنا من أجل اهتماماتنا في الحاضر، وذلك من خلال استراتيجياتنا التأويلية، وإذا فهمنا ذلك أمكننا أن نتجي جانبًا ذلك الوهم المتكرر القائل أن علاقة الكلاسيكيات “المتواصلة بالحاضر” تمثل “شهادة على الملامح الدائمة للتجربة الإنسانية“.36 إن “الملمح الدائم” الوحيد، الذي تشهد عليه قدرتنا على قراءة وإعادة قراءة النصوص المكتوبة في قرون سابقة، هو قدرتنا على الابتكار – بمعنى أن التاريخ الأدبي بأكمله صنعة خيال فنقوم يوميًا بإعادة خلقه إذ نعيد قراءته، والأمر الذي يميز النسويات في هذا الصدد هو رغبتهن في تعديل وتوسيع مجال ما نعتبره تاريخيًا ذا علاقة بالحاضر مستمدًا من المخزون الكبير من موروثنا الأدبي، ذلك بالإضافة إلى إدراك النسويات لهذا المخزون طبقًا لما هو عليه حقا، أي باعتباره موردًا لإعادة تشكيل تاريخنا الأدبي، ماضيه وحاضره ومستقبله.
طبقًا لكيفية القراءة كما تعلمناها فإن ما نتعامل معه ليس نصوصًا بل منظومات. إن التتبع المنطقي للنتائج المترتبة على المقولة الأولى يؤدي، لف. إلى خلاصة مفادها أننا نستحوذ على المعنى في نص ما ونوظفه تبعًا لما نحتاجه (أو نرغبه)، أو بمعنى آخر تبعًا للفرضيات أو الاستعدادات النقدية (الواعية أو غير الواعية) التي تضفيها على النص. كما أننا توظف معان مختلفة أو ننقل لقطات مختلفة في أوقات مختلفة – حتى من النص الواحد – تبعا لافتراضاتنا وأوضاعنا ومتطلباتنا المتغيرة، وهو ما يشكل في جوهره قلب المقولة الثانية، فطبقًا لمدى كون الأدب في حد ذاته مؤسسة اجتماعية، فإن القراءة بالتالي هي الأخرى نشاط اجتماعي مكتسب – أو ناجم عن التعلم، إن ما يجعل الأدب على هذه الدرجة من الإثارة والتشويق هو بالتأكيد أنه قابل أن يخضع دومًا لإعادة التعلم والمزيد من الصقل، بما يوفر للفرد أو المجتمع القارئ بأكمله، وبمرور الزمن، تنويعات لا نهائية لنفس النص. وهو قادر على توفير ذلك، ولكن يتعين علي أن أضيف أنه يقوم ذلك بمعدل مبالغ فيه، فكثيرًا ما تصبح عاداتنا في القراءة ثابتة بحيث تكون كل تجربة من تجارب القراءة تلو الأخرى معيارية مع قيام نوع واحد معين من الأعمال الروائية بالتالي بتحديد توقعاتنا من الروايات التالية، كما تقوم الأدوات الأسلوبية لكاتب مفضل أو كاتبة (أو مجموعة من الكتاب والكاتبات) بتنبيهنا إلى وجود أو غياب تلك الأدوات في أعمال كتاب أو كاتبات آخرين، وهلم جرا. وقد لاحظ موراي كريجر أنه “بمجرد قراءة قصيدته الأولى” فإنه “ينتقل إلى الثانية والأخرى التي ستتوالى في سلسلة متزايدة من الأفكار المسبقة عن نوع النشاط المنخرط فيه. وفي الأمور المتعلقة بالتجربة الأدبية، مثلها كغيرها من التجارب” ينتهي موراي كريجر إلى أن “المرء لا يتسم بالعذرية سوى مرة واحدة“.37
وبالنسبة لغالبية القراء والقارئات تتم تلك العملية بدرجة من اللاوعي، وليس من غير الطبيعي أن ما نتعلم قراءته في طفولتنا قراءة جيدة وممتعة يجعلنا على استعداد لأنواع معينة من أذواق القراءة عند الرشد، وقد لا تختلف تلك العملية فيما يتعلق بالناقد الأدبي المحترف أو الناقدة الأدبية المحترفة، ولكنها تكون على الأقل عملية تخضع لقدر أكبر من الوعي. وتكون برامج الدراسات العليا، في أحسن حالاتها، أماكن تدريبية للمنظومات التأويلية أو تقنيات القراءة المتنافسة، من حيث الأسلوبية الفاعلة والبنيوية والتحليل السيميوطيقي، وذلك على سبيل المثال لعدد قليل من المصطلحات المحدثة. إن البهجة التي نتعلم التمتع بها عند التمكن من هذه الاستراتيجيات التأويلية يتم اعتبارها أحيانا بالخطأ على أنها بعجة تتعلق بقراءة نصوص معينة، وخاصة في حالة الأعمال التي ما كانت ستتاح لنا أو كانت ستعتبر مؤذية لنا، فإثناء عملي في مرحلة الدراسات العليا على سبيل المثال، ومع وجود معلمات ومعلمين رائعين قائمين على إرشادي، تعلمت الحصول على متعة كبيرة من نص “الفردوس المفقود” (Paradise Lost)، وذلك على الرغم من أن كوني يهودية ونسوية لا يمكنني من الاعتراف بالجانب الديني ولا بما يتضمنه من تراتبية في تقييم بين الجنسين، فإذا كان النص، طبقًا لشروطه الخاصة به (وهو ما تعلمت أن أفهم أي نص عليه)، يتلاعب بمشاعري ويقودني إلى المتعة – وهو ما أؤكد على نجاح النص في تحقيقه – عندئذ لابد أن تلك المتعة ترجع على الأقل جزئيًا إلى أنني، رغم اغتراب عالمي الحقيقي عن الكثير من سمات ذلك النص الأساسية، إلا أنني تمكنت من دخول هذا النص من خلال الاستراتيجيات التأويلية التي تتيح لي إحلال بعض الملاحظات المربكة نوعًا ما محل ملاحظات تعلمت الالتفات إليها بقدر أكبر من المتعة. ومع أن بعض أساتذتي ربما كانوا سيطلقون على هذه العملية مسمى “تعلم قراءة النص بشكل سليم” إلا أنني أصبحت أرى تلك القراءة الآن بوصفها تعلم استخدام وتوظيف الاستراتيجيات النقدية التي أحسنوا تعليمي إياها، إن معرفتي على سبيل المثال بفضل القواعد الملحمية على هذا النص الشعري تجعلني قادرة على أن أكتشف في أصدائه وصباغاته سطورًا ومواقف من فيرجيل وهوميروس، وعندما أضع هذا النص الشعري في إطار الجدل المسيحي الدائر بين الخير والشر فإنني أتفهم عندها الدلالة الفلسفية والأسلوبية لحديث إبليس البلاغي المزخرف مقارنة بما يرد على لسان الرب من لغة تتسم بالعظمة والبساطة في المجلد الثالث. ولكن في كل حالة من تلك الحالات كان هنالك نموذج تأويلي قام بالفعل استرشدت به في اكتشافي الدليل على وجوده.38
وعندما نأخذ في الاعتبار تداعيات تلك الملاحظات بالنسبة لعمليات تشكيل التراث الرسمي وفيما يتعلق بتحديد القيمة الجمالية، فإننا نجد أنفسنا داخل مأزق الدجاجة والبيضة، مع عدم القدرة على تمييز الأهمية القصوى للذي نقرؤه مقابل كيف تعلمنا أن نقرأه، فببساطة، نحن نقرأ جيدًا وباستمتاع ما نعرف كيفية قراءته، وما تعرف كيفية قراءته يعتمد إلى حد كبير على ما قرأناه بالفعل (أي الأعمال التي أدت إلى تطوير توقعاتنا وتعلمنا منها استراتيجياتنا التأويلية)، ثم إن ما نختار قراءته – وبالتبعية نقوم بتدريسه وبالتالي “جعله تراثًا رسميًا” – عادة ما يأتي بناء على قراءتنا السابقة. إن مظاهر الانفصام الجذري تكون متعبة ومجهدة وغير مريحة، بل وأحيانا بعيدة تمامًا عن فهمنا.
مع أن الفكرة نفسها لا تأتي دوما بهذا المعنى تحديدًا، ولكن شريحة معتبرة من أعمال النسويات الصادرة مؤخرًا متناولة إعادة قراءة للكاتيات تتيح التوصل إلى الخلاصة القائلة بأن غياب هؤلاء الكاتبات عن الأنظار ربما لا يرجع إلى عدم تميز تلك الأعمال بل قد يعود إلى عدم قدرة جماهير القراء، وأغلبهم من الرجال، على تأويل النصوص النسائية والإعجاب بها بالقدر المناسب، وهو المر الذي يرجع في جانبه الأعم إلى غياب المعرفة المسبقة بين الطرفين، إن الأعمال الروائية التي تؤلفها النساء عن العوالم التي يعشن بها ربما تدين بالفضل للأعمال المؤثرة والسابقة التي كتبتها أقلام نساء أخريات، أو تدين ببساطة للتجربة اليومية التي مرت بها المؤلفة نفسها، أو لمزيج من الاثنين في أحيان كثيرة. إن القارئ الذي يواجه مثل هذه الأعمال الروائية دون معرفة بالتراث الأدبي المؤثر فيها ولا بسياقاتها المتصلة بعالم الواقع سيجد نفسه في وضع يصعب عليه فيه حل شفرات معانيها المقصودة حلاً صحيحًا حتى وإن كان قادرًا على قراءة الكلمات الموجودة في الصفحة. وهذا هو الجانب الذي يجعل الدراسات الصادرة حديثًا بأقلام سباكس ومويرز وشوولتر وجيلبيرت وجوبار وغيرهن دراسات ذات أهمية جوهرية، فمن خلال محاولة تحديد الروابط والصلات والتداخلات التي تؤدي إلى وجود تراث أدبي للمرأة، تقوم هؤلاء الناقدات بتقديم عوامل مساعدة لا يمكن الاستغناء عنها في فهم والتعرف على التراث والتقاليد الأدبية الفريدة والسياقات المتصلة بالجنس التي تنبع منها كتابة النساء.
إن القارئ (الرجل عادة) الذي من خلال التجربة والقراءة لم يلتق أبدًا بتلك السياقات من قبل – تاريخيًا، حجرة الولادة، وحجرة الاستقبال، وحجرة الأطفال، والمطبخ وحجرة الغسيل، وهلم جرا – سيفتقد بالضرورة إلى القدرة على تأويل الحوار أو الحدث الكامن فيها تأويلاً كاملاً، حيث يعرف كل كاتب روائي جيد أن المعنى المتصل بأي قول أو فعل تقوم به الشخصية هو بالضرورة وظيفة من وظائف الموقف المحدد الذي يصدر عنه. 39 ومن هنا كانت فيرجينيا وولف محقة في توقعها ميل الرجل القارئ إلى إغفال ومحو ما يعجز عن فهمه، وتنحية الكتابات النسائية بوصفها تقدم “لا مجرد اختلافًا في الرؤية، بل رؤية ضعيفة أو تافهة أو عاطفية نظرا لاختلافها عن رؤيته . وفي مقالتها التي ترجع إلى عام ١٩٢٩ عن “النساء والفن الروائي” تناولت فيرجينيا وولف (Virginia Woolf, “Women and Fiction”)، وبوضوح بالغ، الطرق التي قام بها الكتاب الرجال وموضوعات الرجال باستباق لغة الأدب، ولكنها مع ذلك علقت ضمنيًا على مشكلة القراء (الرجال) والتوقعات التقليدية عند القراءة في إطار رأيها في كون المرأة الكاتبة بالفعل قد “تجد أنها تتمنى دوما تعديل القيم الراسخة (في الأدب) – لإضفاء الجدية على ما يبدو غير ذي أهمية بالنسبة للرجل، وإضفاء التفاهة على ما يهمه“.40 ومع كل هذا، “إن “الكفاءة” الضرورية لفهم رسالة أدبية (ما) … تعتمد على عدد كبير من القواعد“، وكما أشار سيزار سيجر، يجب على القارئ الكفء إما أن يشارك أو على الأقل أن يتآلف “بالإضافة إلى ومع شفرة اللغة … (مع) شفرات العادات والمجتمع والتصورات عن العالم” 41 (وهو ما قصدته فيرجينيا وولف بكلمة “القيم“). إن الرجال الذين يجهلون “قيم” النساء أو تصوراتهن عن العالم سيكونون بالضرورة قراء غير أكفاء للأعمال التي تقوم بطريقة ما أو بأخرى باختصار شفراتهم.
وتزداد المشكلة تفاقمًا عندما يكثر اعتماد لغة النص الأدبي على التصوير الجمالي، يمكن القول كما بيّن تيد كوهين أنه بينما “عمومًا وفي وجود بعض المؤهلات الواضحة … يكون الاستخدام الحرفي للغة مفهوما لكل أصحاب تلك اللغة … ويمكن أن تكون اللغة التصويرية غير مفهومة للجميع قيما عدا من يشتركون فيما بينهم في المعلومات عن المعرفة والمعتقدات والنوايا والتوجهات“. 42 فلم يكن الأمر صدفة أو مسألة عرضية، على سبيل المثال، في قرار شارلوت بيركنز جيلمان أن تجعل الانهيار العصبي المتصاعد وتزايد عجز البطلة في نص “ورق الحائط الأصفر” (“Charlotte Perkins Gilman, The Yellow Wallpaper) يتم في حجرة علوية كانت في يوم من الأيام حجرة الأطفال (ونوافذها ذات قضبان). ولكن القارئ غير المتعارف على الطرق التي عاشت بها النساء تقليديًا داخل المنازل قد لا يأخذ الوصف المبدئي لمكان الحدث في الاعتبار على أنه يحمل معان ودلالات مهمة، وبالتالي فإن هذا التحول التدريجي إلى الطفولة في رسم شخصية البطلة الراشدة سيفقد بعض إيحاءاته الرمزية. كذلك بالمثل نجد أن الشاعرة المعاصرة التي تعلن جنبًا إلى جنب إيدريان ريتش (Adrienne Rich) الحاجة إلى “شعر جديد تمامًا يبدأ هنا غنما هي تعترف بأن المواد المتاحة للترميز والتصوير من السياقات النسائية ستختلف بالضرورة عما استخدمه الرجال تقليديًا:
الرؤية تبدأ في الحدوث في مثل تلك الحياة
كما لو كانت المرأة قد مضت بعيدًا في هدوء
عن النقاش واللغة المستخدمة في حجرة
وجالسة في المطبخ بدأت تقلب في حجرها
قطعًا من الغزل ومخلفات قماش قطني ومخملي
…
جاذبة مبادئ الحياة معًا
دون مجرد إرادة السيادة
بل الحرص فقط على الأشكال اللانهائية
ومتعددة الحياة التي تجد نفسها فيها. 43
فما هو مصير الكاتبة التي لا يتكون مجتمعها من القراء الأكفاء سوى من أفراد من بنات جنسها؟ وماذا عن رد فعل الناقد الذي يجد في نظرته الأولى إلى فيرجينيا وولف أو دوريس ليسينج أن كافة الاستراتيجيات التأويلية طوع أمره غير كافية لفك شفرات صفحاتهما بشكل كامل وممتع؟ وقد كانت النتيجة المترتبة على ذل، تاريخيًا، هي تراجع مكانة ما تنتجه النساء وما يترتب عليه من غيابهن عن كبرى المذاهب والتراث الرسمي الأدبي. ولكن اليوم، ومع الإشارة إلى أن فعل “تأويل اللغة ليس أكثر حيادية جنسية عن استخدام اللغة أو نظام اللغة نفسه“، فإن الدارسات النسويات المتخصصات في اللغة مثل نيلي فورمان (Nelly Furman) يقدمن لنا يد العون للوصول إلى فهم أفضل للعلاقة الجوهرية بين الجنس الذي تنتمي إليه وبين استراتيجياتنا في التأويل أو القراءة. وهي في تأكيدها على “مساهمة … القارئ
(أو القارئة) في إرجاع الدلالة إلى الدال الرسمي“،44 وبالتالي تعدنا هي غيرها بأن تنفض عنا جميعًا – نساء ورجال على حد سواء – فرضياتنا الجمالية التقليدية الراسخة.
نظرا إلى أن الأسس التي نضفي تبعًا لها القيمة الجمالية على النصوص ليس أسسا معصومة من الخطأ أو غير قابلة للتغير أو عامة، فإن ما يجب علينا إعادة فحصة لا يقتصر على الجماليات التي تستخدمها بل يشمل أيضًا الفرضيات والتحيزات الكامنة المؤثرة في المناهج النقدية التي تشكل (جزئيًا) استجاباتنا الجمالية، إنني من ناحية أؤكد على أن الرجال سيصبحون فراء أفضل أو قادرين على تقدير الكتب النسائية بعد قراءة كم أكبر منها (مثلما تم تعليم النساء دائما أن يقرأن نصوص الرجال قراءة جادة). ومن ناحية أخرى، فمن الملاحظ أن ملاحظاتي ترتكز
على نقل فعل الحكم النقدي من تحديد قيم جمالية وإضفائها على النصوص، وتوجيهه نحو تأكيد مدى ملاءمة أية منظومة تأويلية بما يتناسب مع القراءة الكاملة لكتابات الرجال والنساء، إن مقولتي الثالثة – وأعترف أنها ربما تكون الأكثر إثارة للجدل – تثير التساؤلات حول الميل المتكرر في النقد إلى تأسيس معايير التقييم الأعمال الأدبية في الوقت الذي يمكننا فيه خدمة الأدب بتطوير معايير لتقييم مدى ملاءمة مناهجنا النقدية.45 ولا يعني ذلك أنني أود تنحية التقييم الجمالي جانبًا، وإنما لا يكمن الأمر في رأيي في الاختيار بين الاحتفاظ بالقيم الجمالية أو التخلص منها، بل إن الاختيار يكون بين امتلاك بعض الوعي بما يشكل (على الأقل جزئيًا) أسس استجاباتنا الجمالية وبين المضي دون مثل هذا الوعي، ففي رأيي إنه نظرًا لمدى كون الاستجابة الجمالية مستمرة في أن تكون جانبًا أساسيًا ضمن نظام الاستجابة الإنساني – التلقائي جزئيًا، والخاضع للتعلم جزئيا – فإننا حتما سنقوم بتطوير نظريات تساعد على فهم أو صياغة أو حتى المبادرة بتلك الاستجابات.
إن تحدي مدى ملاءمة الرأي النقدي الموروث أو الامتياز المؤكد بشأن التراث الرسمي يتطلب من الناقدات الأدبيات النسويات السعي إلى اكتشاف الكيفية التي يتم بها إضفاء القيمة الجمالية أساسًا، ومكان تواجد تلك القيمة (داخل النص أم داخل القارئ)، والأهم من هذا وذاك هو مدى صحة مزاعمنا عن “أحكامنا” الجمالية. وتتساءل الناقدة النسوية عن الأهداف التي تحققها تلك الأحكام، وما هي التصورات الخاصة بالعالم أو المواقف الأيديولوجية التي تساعدنا (ولو عن غير قصد) في تدعيمها؟ وهي إذ تفعل ذلك تشير، من بين ما تشير إليه، إلى أن أي استجابة يطلق عليها مسمى “جمالية” قد تعني مجرد لحظة لتجربة حية أو حدث ما، كما يمكنها أن تعني نوعًا من الحنين أي الاشتياق إلى مكونات عالم أبسط عندما كان العالم يبدو معروفا أو على الأقل مفهومًا. وهكذا فإن القيمة التي يتم إضفاؤها على عمل أوبرالي أو مسرحية من مسرحيات شيكسبير قد تكمن بالفعل في المتعة التي ينالها المتفرج أثناء المشاهدة، أو قد تكمن في إيحاءات المسرحية التي تحن إلى عالم كان في يوم من الأيام مفهومًا ومنظمًا، وفي نفس الوقت، فإن الناقدة النسوية تواجه على سبيل المثال القارئ الذي لا يستطيع التعامل مع إمكانية ان تكون عوالم النساء غنية بالرموز، وهو القارئ الذي يماثل شخصيات الرجال في قصة “امرأة حكم على رفاقها” بقلم سوزان جلاسبيل التي ترجع إلى عام ۱۹۱۷ ((Susan Glaspell, “A lury of Her Peers) وقد افترض عمق “تفاهة الأشياء في المطبخ“.46 وهي تعلم أن مثل هذا القارئ سيعجز عن إضفاء الأهمية على الأعمال الروائية التي تلتفت إلى “أشياء المطبخ” بل وسيحكم على تلك الأعمال بالتفاهة والنقص الجمالي، وهي ترى أن التوجه الفعال إلى هذا القارئ يتطلب منها توضيح أن ما يبدو خلافًا على القيمة الجمالية هو في الواقع خلاف على سياقات الأحكام، والمسألة هي مدى كفاية الفرضيات المسبقة وعادات القراءة المؤثرة في النص، أي بصراحة، لقد فاض بنا الكيل من المقولات والأحكام الخاصة بالقيمة الجمالية، وقد آن الأوان أن تقوم به همتنا في تقييم المعايير المعتمدة وأنماط القراءة المعيارية التي أدت جزئيًا إلى تلك الأحكام.
وعمومًا فإنني أعتقد أني أوضحت موقفي، وعلى سبيل المزيد من الإيضاح أضيف هذه الخاتمة:عندما تتوجه النسويات بالانتباه إلى أعمال الكتاب من الرجال الذين تم منحهم تقليديًا قديمة جمالية عليا. وعندما يمكننا ذلك فإننا نتبع نصيحة تيلي أولسن بأن نؤكد على ما نتمتع به من “حق القول: إنه السطح، وهو يزيف الحقيقة، وهو أمر مهين“47، حيث أن مثل تلك المقولات لا تعني بالضرورة أن الأمر سينتهي بنا إلى تراث رسمي متقلص. إن التساؤل حول مصدر المتع الجمالية التي اكتسبناها من قراءة سبينسر وشيكسبير وميلتون وغيرهم، لا يوحي بضرورة إنكارنا تلك المتع، بل يعني فقط أن الاستجابة الجمالية محفوفة مرة أخرى باهتمامات إبستمولوجية معرفية وجمالية وأخلاقية. وبمعنى آخر، فإن ذلك يعني أن القراءات لنص “الفردوس المفقود” والتي تقوم بتحليل بناه التراتبية المعقدة مع فشلها في ملاحظة التداعيات الجندرية (علاقات القوى بين الجنسين) داخل تلك التراتبية، أو تلك القراءات التي تصر على الكمال الفطري (أو حتى الملهم) في استخدام اللغة التصويرية عند ميلتون مع فشلها في ملاحظة النتائج المترتبة على ذلك بالنسبة لحواء من حيث ضعفها الناجم عن جنسها وهو الضعف الذي يتطلب “تشذيبًا” مثلها في ذلك مثل الزهور التي ترعاها، أو القراءات التي تركز على تعامل القصيدة على مستوى الأفكار وإعادة صياغتها لمفاهيم كلاسيكية متعلقة للقدرة الحربية والملحمية وتوظيف تلك المفاهيم داخل البطولة (الأخلاقية) المسيحية مع فشلها في ملاحظة ما تعرضت له حواء من تعديل وإلغاء أسلوبي إلى خارج تلك العملية، هي كلها قراءات مع ما تحمله من فائدة إلا أنها لن تعتبر كافية تمامًا بعد الآن، إن المتع التي تعلمنا الحصول عليها من النص الشعري لن تتقلص بالتبعية، ولكنها ستصبح جزءًا من اهتمام متغير في عملية القراءة.
ويقال إن ما يميز عملنا عن تلك الأعمال الأخرى من المراجعات النقدية “للوعي الاجتماعي” هو غياب التماسك المنظم. ففي مواجهة قراءات التحليل النفسي أو القراءات الماركسية، على سبيل المثال، التي تعتمد بقدر حاسم، في قوتها الإقناعية، على اتساقها الداخلي الظاهر باعتبارها نظامًا محكمًا، إلا أن مجمل النقد الأدبي النسوي يبدو للأسف قاصرًا من حيث النظام المحكم ومفتقدًا إلى برنامج العمل. ويعتبر هذا العيب في الواقع، ومن كافة الجوانب، أكثر العيوب التي نتهم بها وأكثر التهديدات الملغمة في حقل الألغام. إن إحدى ملاحظاتي التي أعربت عنها مسبقًا، بشأن ما بدا عليه النقد الأدبي النسوي منذ عام 1976 “أشبه بمجموعة من الاستراتيجيات القابلة للتبادل فيما بينها، بدلاً من أن يكون مدرسة متماسكة أو توجها نحو هدف مشترك“، هي ملاحظة تم استخدامها من قبل البعض كاتهام. بينما استخدمها آخرون كمقولة معبرة عن نفاذ الصبر. ولم يكن مقصدي منها الاتهام أو نفاذ الصبر، ولكني شعرت حينها، كما هو شعوري حاليًا، أن ذلك سوف “يثبت كلاً من قوته وضعفه“،48 بمعنى أن هذا الخلل الظاهري سيجعلنا عرضة لنوعية الاعتراض الذي أشرت إليه، في حين أن تنوعنا سوف يؤمن لنا وضعنا في نهاية الأمر في المكان الذي يفترض تواجدنا فيه منذ البداية، أي التواجد على الجانب البعيد من حفل الألغام بصحبة غيرنا من دعاة التعددية وأشكال الفكر العددي.
ونحن بالطبع، في أعماقنا، كمعظم النقاد والناقدات، تنتمي إلى البنيويين (سواء قبلوا هذا المسعى أم لم يقبلوه)، لأن ما نسعى إليه في الأنماط (أو البني) التي يمكنها أن تنظم وتفسر ما قد يبدو طور التكوين، وهكذا فنحن نخترع أو تعتقد في أننا نكتشف علاقات بين الأنماط في النصوص التي نقرؤها والتي تبشر بتجاوز الصعوبة والارتباك وصولاً إلى الوضوح والتماسك. ولكن كما حاولت التأكيد في هذه الصفحات، فإن “الحقيقة” أو “الدقة” المفترضة لتلك النتائج يجب أن تعارضها النسويات بوساطة المسألة البديهية بالغة الوضوح القائلة بأن ما يتم الالتفات إليه في العمل الأدبى، وبالتالي ما يتم الحديث عنه لا يتحدد عادة تبعًا للعمل نفسه بل بالتكنيك النقدي أو المعايير الجمالية التي يتم النظر إليه من خلالها أو بالأدق التي يتم قراءته وفك شفراته بوساطتها، وبالتالي فإن مجمل ما تؤكد عليه الناقدة النسوية هو حقها المساوي في إخراج دلالات جديدة (وربما مختلفة)وتحريرها من نفس تلك النصوص، وحقها في نفس الوقت في اختيار الملامح الخاصة بالنص التي تعتبرها ذات علاقة بالموضوع نظرًا لما تطرحه من أسئلة جديدة ومختلفة حوله، وخلال تلك العملية لا تزعم الناقدة النسوية أن قراءاتها وأنظمة القراءة المختلفة الخاصة بها تتصف بالحسم أو الاكتمال البنيوي، وإنما تزعم فقط فائدتها في التعرف على الإنجازات الخاصة بالمرأة كمؤلفة وقابليتها للتطبيق الأمين في فك شفرات المرأة كعلامة دالة.
إن قيام نقاط التركيز البديلة تلك بإتاحة قراءات أو تأويلات بديلة للنص الواحد – وحتى فيما بين النسويات – يجب ألا يمثل سببًا للقلق، فتلك التطورات إنما توضح المقولة التي يتبناها أصحاب التوجه التعددي بشأن “عند الاقتراب من أي نص يتمتع بقدر من التعقيد … يجب على القارئ اختيار جوانب بعينها للتأكيد عليها تبدو له جوهرية” وكذلك “في الواقع، إن تنوع القراءات التي نجدها للنص الواحد هي من وظائف عملية اختيار جوانب جوهرية التي تقوم بها مجموعة متنوعة من القراء“، بل ويواصل روبرت شولز (Robert Scholes)، الذي استشهدت بكلامه فيما سبق، حديثه مؤكدًا أنه “لا توجد قراءة واحدة “صحيحة” لأي عمل أدبي معقد“، ، ويمضي على منوال المدرسة الشكلانية الروسية (Russian Formalist School) فيلاحظ قائلاً “إننا لا نتحدث عن القراءات التي تتصف فقط بالصدق أو الزيف، بل عن القراءات التي تتصف بدرجة ما أو بأخرى من الثراء، أي استراتيجيات مناسبة بدرجة ما أو بأخرى“.49 ونظرًا لأن المشتركات في مصطلح “النسوية” يمارسن مع ذلك أشكالاً متنوعة من الاستراتيجيات النقدية فيجب علينا أن نعترف فيما بيننا أن أخواتنا الناقدات “مع اختيارهن أن يحكين قصة مختلفة قد يحددن في تأويلهن جوانب مختلفة من المعاني التي تنقلها القطعة الواحدة من النص“50.
وكن تبني مسمى “التعددية” لا يعني نهاية الخلاف فيما بيننا، بل يعني فقط وجود احتمال قائم على إمكانية كون القراءات المختلفة، حتى للنص الواحد، مفيدة بصور مختلفة، بل وتلقي أضواء جديدة، داخل سياقات بحثية مختلفة. وهو ما يعني بالتبعية أننا ندخل في عملية جدلية من فحص واختبار بل وتجريب السياقات – سواء كانت فرضيات نقدية مسبقة أو مواقف أيديولوجية صريحة (أو مزيجًا ما من الاثنين) – بما أدى إلى قراءات متباينة. وقطعًا لن يكون كل شيء مقبولاً لكل منا بنفس الشكل، بل وحتى تلك الفرضيات المسبقة أو الأيديولوجيات المقبولة قد تستدعي مزيدًا من التنقيح أو التوضيح. ولكن على الأقل، وبسبب تعاملنا مع الفرضيات التي أدت إلى قراءة ما، سنكون أكثر قدرة على التعبير عن الأسباب التي تجعلنا تعتبر قراءة أو تأويلاً ما مناسبًا أو غير مناسب کما أن هذا النوع من العملية الجدلية لا يجعلنا أكثر وعيًا بماهية النقد والكيفية التي يعمل بها فحسب، بل يمنحنا سبيلاً للوصول إلى إمكاناته المستقبلية ويجعلنا على وعي بشأن “ما فعلناه” و“ما يمكن فعله بعدها، أو مرة أخرى“.51 طبقًا لما ورد عن ر. ب. بلاگمور، أو أضيف إليها ما يمكن عمله بشكل مختلف وبصياغة أخرى، فإن مجرد عدم قيامنا بمزيد من التسامح تجاه أوجه الإلغاء والإعمال التي تتصف بالتحيز الجنسي والتي قامت بها المدارس والمناهج النقدية السابقة لا يني أنه يتعين علينا بدلاً من ذلك تأسيس “حزب خاص” بنا.
ففي رأيي، إن غرضنا ليس، ولا يجب أن يكون، تكوين أي منهج بعينه للقراءة أو مجموعة سارية وثابتة من الإجراءات النقدية، ولا حتى توليد فئات موصوفة تكون بمثابة حلم بتراث أدبي رسمي غير متحيز جنسيًا.52 ولكني أرى أن مهمتنا هي المبادرة بتعددية مرنة على أقل تقدير، تستجيب للإمكانيات التي تبشر بها المدارس والمناهج النقدية التعددية دون أن تقع في أسر أي منها، مع إدراكها أن الأدوات الكثيرة اللازمة لتحليلنا سوف تكون بالضرورة موروثة إلى حد كبير، ولن تكون من صنع أيدينا إلا جزئيًا، ولن تتمكن من حماية أنفسنا من إغراءات تبسيط النصوص – وخاصة تلك النصوص المسيئة إلينا – سوى عن طريق توظيف تعددية منهجية، بما يجعلنا لا نستجيب لما أطلق عليه شولز بشأن النص من “أنظمة المعنى المتنوعة فيه وتفاعلاتها“. 53 إن أي نص نعتبره جديرًا باهتمامنا النقدي يكون عادة، وفي المحصلة النهائية، موقعًا لأنواع كثيرة ومتنوعة من العلاقات (الشخصية والأسلوبية والبنيوية والبلاغية والمتعلقة بالأفكار الرئيسية). وهكذا، فسواء كنا نميل إلى معاملة النص بوصفه محاكاة ، حيث تؤخذ الكلمات على أنها تعيد خلق أو تمثل عوالم تنتمي إلى الحياة، أو سواء فضلنا التعامل مع النص بوصفه نوعًا من المعادلة في التواصل حيث تنتقل الرسائل القابلة للفهم من الكتاب إلى القراء، وسواء اعتبرنا المعنى جزءًا لا يتجزأ من النص أو من فعل القراءة أو جزءًا من التعاون القائم بين القارئ والنص – إلا أنه يجب علينا، وبصرف النظر عن ميولنا، أن لا نولد من النص قالبًا جامدًا يضع قيدًا على أي مجال للتحليل الممكن. بل فلنحاول تولید حوار متواصل بين بشائر الإمكانيات المتنافسة، ما بين النسويات بعضهن البعض، وبين النسويات والنقاد من غير النسويات والنسويين.
ولست غافلة عن صعوبة ما أصفه هنا، حيث أن فكرة التعددية تبدو بمثابة نذير بنوع من الفوضى لمستقبل البحث الأدبي، بينما تبدو في الوقت نفسه وكأنها تنفي الأمل في إقامة نموذج فكري أساسي ما يمكنه تنظيم كافة البيانات – وهو أمل يأتي دائما في مستهل أي تمرين تحليلي. ولكن جهدي انصب هنا على توضيح الأوهام الجوهرية التي تؤثر على مثل تلك الاعتراضات: فإذا كان البحث الأدبي قد تجنب الفوضى تاريخيًا عن طريق تأسيس التراث الرسمي، فهو إنما قام بمجرد إحلال شكل من أشكال الفعل الاعتباطي محل الآخر، وهو ما حدث في تلك الحالة على حساب نص الجنس البشري وإذا كنا نحن النسويات نعتبر أنفسنا صراحة مؤمنات بالتعددية، فإننا لا تتنازل عن السعي من أجل أنماط من التقابل والتواصل، ولعله هو أساس التفكير في حد ذاته، أما ما نتنازل عنه فيتمثل ببساطة في عنجهية الزعم بأن عملنا إما جامع شامل أو حاسم ومحدد. (وهي نفس العنجهية التي تطالب زملائنا من غير النسويات والنسوبين بالتخلي عنها.) فإذا كان هذا النوع من التعددية يبدو وكأنه يهدد التماسك الحالي والمعايير النقدية الموروثة الخاصة بالتراث الرسمي لـ“العظماء“، فكما أكدت سابقًا. إن هذا التهديد نفسه هو الذي يمكنه أن يحررنا من المواقف المسبقة والقيود ونقاط الضعف في الماضي. وأضيف أن المسألة في أيدي النسويات هي بشير أكثر من كونها نذيرًا.
وهكذا فإن ما يوحد وينشط النقد الأدبي النسوي باستمرار لا يتمثل في الأفكار الجامدة ولا في المنهج، بل في ذلك الانتباه الحاد والجارف إلى الطرق التي يتم بها تدوين (أو تشفير) بنى السلطة، التي هي سلطة ذكورية في الأساس، في داخل موروثنا الأدبي، والالتفات إلى النتائج المترتبة على هذا التشفير بالنسبة للنساء – شخصيات وقارنات وكاتبات، ويصاحبه اهتمام تحليلي بتداعيات هذا التشفير لا من أجل فهم أفضل للماضي بل أيضًا في سبيل إعادة تنظيم أفضل للحاضر والمستقبل، فإذا كان هذا الاهتمام يعرف النقد الأدبي النسوي باعتباره ذراعًا من الأذرع الأكاديمية الكثيرة الممتدة من الحركة النسائية الأشمل، فإن هذا الانتباه، القائم داخل جدران الحياة الأكاديمية، يمثل تحديًا من أجل التغيير، ومولدًا خلال مساره المقولات الثلاثة التي تم تناولها هنا. إلا أن التعددية النقدية التي تنطلق حتميًا من تلك المقولات لا تشبه ما ورد عن ليليان روبنسون بشأن “الفكرة البورجوازية الأكبر، أي أسطورة التعددية، بما يترتب عليها من رفض للالتزام الأيديولوجي باعتباره أبسط من أن يحتضن الحقيقة (المعقدة بالضرورة)”.54 إن الالتزام الأيديولوجي وحده هو الذي أمكنه أن يجعلنا تدخل حقل الألغام، مع المجازفة بحياتنا العملية ومصدر رزقنا. إن قوة الأيديولوجيا وحدها في إحداث التحول في عوالمنا الفكرية، وما ألهمتنا به هذه الأيديولوجيا لتحرير طاقاتنا ومشاعرنا التي طال كبتها، بوسعها تفسير استعدادنا لتولي مهام نقدية التي كان مصيرها في العقد السابق هو “التخلي عنها يأسًا أو لامبالاة” 55 إن وجود اختلافات فيما بيننا هو أمر واقع إنما يثبت أننا، رغم التزاماتنا المشتركة، رفضنا مع ذلك الابتعاد عن التعقيد، وفضلنا التعبير عن الخلاف صراحة بدلاً من التنازل عن الأمانة الفكرية أو الملاحظات العميقة التي وصلنا إلها بصعوبة بالغة.
وأخيرًا أؤكد أن التعددية تؤثر على البحث الأدبي النسوي، لا لمجرد كونها وصفًا لما هو قائم بالفعل، وإنما وهو الأهم باعتبار التعددية هي الموقف النقدي الوحيد المتسق مع الوضع الحالي للحركة النسائية الأشمل، فمع ما بها من انقسام وتنوع في مجالات التركيز، لا تتمسك المنظمات النسائية المختلفة بنظام تحليلي واحد أوحد، وبالتبعية لا تعبر عن أية أيديولوجيا مشتركة تمامًا وثابتة غير متغيرة، إن الخسارة التابعة لذلك في التنظيم الفعال وفي التأثير السياسي في خسارة خطيرة ولكنها لم تصيدا بالشلل، فعلى الرغم من اختلافاتنا اتحدنا في العمل في المجالات ذات الاهتمام المشترك (ولعل أوضح مثال على ذلك هو القوة الدافعة من أجل “تعديل قانون الحقوق المتساوية“.) إن هذا الاتفاق كما أراه جعل من الممكن وجود جدل مستمر ومفيد في التحليل والحلول المعروضة. بما يحمينا من الوقوع في إغراءات فخ الاختزال والفكر الدوجماتيكي المتحجر، وطالما ظل هذا الحوار حياء سيظل نقدنا وسياساتنا خالية من الفكر المتحجر، ولكن أتمنى ألا يخلو نقدنا وسياساتنا أبدًا من الأيديولوجيا النسوية بكل ما فيها من تنوع، إذ “مهما تكون عليه الأيديولوجيات، من إسقاطات لمخاوف غير معترف بها، أو أقنعة تخفي دوافع عليا، أو تعبيرات عن تضامن الجماعة” (وقد كانت الحركة النسائية بالتأكيد حتى الآن تجمع بين كل تلك الجوانب وأكثر) – فمهما يكون ما تعبر عنه الأيديولوجيات، إلا أنها طبقًا لملاحظة جيرتز الثاقبة تمثل “بوضوح بالغ، خرائط للواقع الاجتماعي الإشكالي ومنظومات لخلق وعي جماعي“، وعلى الرغم من كون “دعاة الأيديولوجيا … أميل إلى التشويش على الطبيعة الحقيقية للمشاكل المعنية بقدر الميل إلى توضيحها“، طبقًا لما ورد عن جيرتز، فإنها ” على الأقل تلفت الانتباه إلى وجودها، ومن خلال الجمع بين المسائل المتضادة تزيد من صعوبة استمرار التجاهل والإغفال، فبدون الهجوم الماركس لما حدث الإصلاح في السياسات العمالية، وبدون القوميين السود لما تسارعت الأمور“.56 وأضيف إلى ذلك قائلة أنه بدون “مؤتمر سينيكا فولز” (Seneca Falls) لما تم منح النساء حقوقين السياسية، وبدون “رفع الوعي” لما كان النقد الأدبي النسوي ولا الدراسات النسائية.
ولكن الأيديولوجيا مع ذلك لا تكشف عن سلطنها حقا إلا بتنظيم حصيلة أفعالنا.57 وإذا كان النقد النسوي يطرح تساؤلات على الإطلاق فإنما يطرح تساؤلاً حول أسطورة الحياد الفكري البالية إذ أن ما أعتبره أنا بمثابة الروح الكامنة أو الرسالة التي يحملها أي نقد يقوم على أيديولوجيا واعية – أي كون الأفكار مهمة لأنها تحدد أساليب التي نحيا بها، أو التي تريد أن تحيا بها، في العالم – في رسالة يتم إبطالها عند حصارها في إطار حجرة المكتب أو الفصل الدراسي أو صفحات كتبنا. إن كتابة فصول تستنكر التنميط الجنسي للنساء في أدبنا بيتما تغلق أعيننا عن التحرش الجنسي الذي تتعرض لها طالباتنا وزميلاتنا، وكذلك تناول كاثرين هيبورن وروز الهند راسل في مقرراتنا الدراسية عن “صور النساء المستقلات في الحياة العملية في السينما” بينما تتمكن من عدم ملاحظة قلة أعداد الموظفات الإداريات في جامعاتنا، ودراسة النساء اللآتي ساعدن في جعل حصول النساء على الحقوق السياسية عالميًا واقعًا سياسيًا بينما نصمت عن زميلاتنا الناشطات السياسيات اللآتي يحرمن من الترقية أو التثبيت في العمل، وتضمين مقتطفات حول “النساء في الحركة العمالية” في مقرراتنا ضمن برامج الدراسات الأمريكية أو الدراسات النسائية بينما نظل في جهلنا المقصود بحالة سكرتيرة القسم التي تم فصلها من العمل بسبب جهودها في تنظيم اتحاد العمال المكتبيين، والتباهي بأوهام “الجدارة” و“التميز” و“المكانة” التي تصاحب الحياة الجامعية في سبيل عزل أنفسنا عن ملايين النساء اللآتي بعملن في ظروف الفقر – هي كلها ليست مواقف معبرة عن الرياء والنفاق فحسب، بل هي مدمرة لروح ومعنى كل ما نفعله. كما تضعنا، ولو عن غير قصد، في خدمة من زرعوا حقل الألغام في المقام الأول. وفي رأيي، إنه لأمر طيب للكثيرات منا أن نكون قد عبرنا حقل الألغام بصفة فردية، ولكن ذلك الوضع السعيد لن تثبت أهميته الدائمة إلا إذا قمنا معًا بكشف حقل الألغام على حقيقته (أي الخوف الذكوري من إشراك النساء في السلطة والأهمية) وإذا أبطلنا مكوناته كي تتمكن الأخريات اللاتي يليننا من الرقص حرفيًا عبر حقل الألغام.
أنيت كولودني، ناشطة وناقدة نسوية، وأستاذة الدراسات الأدبية والثقافية في كلية الإنسانيات بجامعة أريزونا في الولايات المتحدة الأمريكية، مهتمة بالنظرية النسوية وأدب الأقليات، ونشرت كتابها الأول عام 1975 عن المجاز والتجربة والتاريخ في الحياة والرسائل الأمريكية، أعقبته بكتابها الثاني عام 1986 عن كتابات النساء عن الغرب الأمريكي من القرن السابع عشر وحتى منتصف القرن التاسع عشر. كذلك التفتت في كتاباتها اللاحقة إلى وضع النساء داخل المؤسسات الأكاديمية ومكانة الدراسات الإنسانية في التعليم الجامعي.
* Annette Kolodny, “Dancing Through the Minefield: Some Observations on the Theory, Practice, and Politics of a Feminist Literary Criticism”, Feminist Studies 6 (1980).
حصلت مقالة “الرقص عبر حفل الألغام” على جائزة مسابقة فلورنس هاو في كتابة المقال لعام 1979، والتي يدعمها تجمع النساء في رابطة اللغة الحديثة (MLA). وقد تم تأليف بعض أجزاء هذه المقالة خلال الوقت الذي أتيح لي بفعل
منحة مؤسسة روكفيلير والتي أدين لها بالامتنان.
1 – Mary Ellmann, Thinking About Women (New York: Harcourt, Brace & World, 1968).
2 – أنظر/ ي:
Clifford Gertz, “Ideology as a Cultural System”. The Interpretations of Cultures- Selected Essays (New York: Basic Books, 1973, p. 232.
3 – المصدر السابق، ص٢٠٤.
4 – Lillian 5. Robinson, “Cultural Criticism and the Horror Vacul”, College English 33 (October 1972) reprinted as “The Critical Task” in Lillian Robinson’s Sex, Class, and Culture (Bloomington: Indiana University Press, 1978), p. 51.
5 – Elaine Showalter, A Literature of Their Own: British Women Novelists From Bronté to Lessing (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1977), p. 36.
6 – Adrienne Rich, “When We Dead Awakern: Writing as Re-Vision”, College English 34 (October 1972) reprinted in Adrienne Rich’s Poetry, ed. Barbara Charlesworth Gelpi and Albert Gelpi (New York: W.W. Norton, 1975), p. 90.
7 – Kate Millet, Sexual Politics (Garden City: N. Y: Doubleday, 1970(
8 – Rebecca Handing Cavi, Le in the Iron Mills, originally published in the Aclantic Monthly April 1861 Reprinted with A Biographical Interpretation” by Tillie Olsen (Old Westbury, NY: Feminist Press 1972).
Charlotte Perkins Gilman, The Yellow Wallpaper”, originally published in the New England Maine May 1892; reprinted with an Afterword by Elaine R. Hedges (Old Westbury, NY: Feminist Press, 1973(.
Nina Baym Wisman’s Fiction: A Guide to Novels by and about Women in America, 1820-18705 (thaca, N.Y: Cornell University Press, 1978.
10 – توضح سیدني جانيت كابلان في كتاب عن “الوعي الأقلوي في الرواية البريطانية الحديثة” أنها تستخدم مع مصطلح “الوعي الأنثوي” (feminine consciousness) “لا كمجرد موقف ما عام للنساء تجاه أنثويتهن، ولا كمرادف بعمر وعيًا معينًا بين الكاتبات. إنني مهتمة بالمصطلح كأداة أدبية، أي كمنهج في تشخيص الإناث في العمل الروائي“:
Sydney Janet Kaplan. Feminine Consciousness in the Modern British Novel (Urbana: University of Illinois Press, 1975). p. 3.
11 – Patricia Meyer Spacks, The Female Imagination (New York: Avon Books, 1975), p.6.
12 – Ellen Moers, Literary Women: The Great Writers (Garden City, NY: Doubleday, 1976(
13 – Showalter, A Literature of Their Own p. 11.
14 – Jean E. Kennard, Victims of Convention (Hamden, Conn: Archon Books, 1978). pp. 164, 18, 14.
15 – انظر/ ي:
Millet, Sexual Politics, pt. 3, “The Literary Reflection”, pp. 235-361
16 – هذه العبارة نقلا عن جيرتز ,(Geertz)
انظر/ ي:
Ideology as a Cultural System.p. 214
17 – Lillian S. Robinson, “Criticism – and Self-Criticism”, College English 36 (January 1974), and ” “Criticism: Who Needs It?” in The Uses of Criticism, ed. AP. Foulkes (Bern and Frankfurt: Lang, 1976(
both reprinted in Sex Class, and Culture, pp. 67 -80.
18 – Rich, “When We Dead Awaken, p. 90.
19 – Judith Fatterley, The Resisting Reader. A Feminist Approach to American Fiction (Bloomington: ” Indiana University Press, 1978(.
20 – Tillie Olsen, Silences (New York: Delacorte Press, 1978), pp. 239-40
21 – انظر/ي:
Cheris Kramer, Barrie Thorne, and Nancy Henley,
“Perspectives on Language and Communication, Review Essay, Signs 3 (Summer 1978): 646.
22 – أنظر/ ي تداول إبدريان ريتش لصعوبة العثور على لغة أصيلة لتجربتها مع الأمومة في كتاب:
Adrienne Rich, Of Woman Born:Motherhood as Experience and Institution (New York: W.W. Norton, 1976), p. 15.
23 – Nelly Furman, “The Study of Women and Language: Comment on Vol 3, no. 3. Signs 4 (Fall 1978( 184.
24 – مرة أخرى تأتي سباعي هنا لما جاء في مقالة جيرتز:
Geeertz. “Thich Description: Toward An Interpretive Theory of Culture, interpretation of Cultures. p.9
25 – Julia Penelope Stanley and Susan W. Robbins, “Toward a Feminist Aesthetic, Chrysalis, no 6(1977( p.63,
26 – Helene Clous, “The Laugh of the Medusa”, trans. Keith Cohen and Paula Cohen, Signs 1 (Summer 1976) 887:
27 – في كتابهما المجنونة في العلية“، تشير ساندرا جیلبورت وسوزان جوبار إلى أن الكتابات النسائية هي بمعنى ما “قابلة للمحو والكتابة عليها” حيث أنها في “صورها السطحية تخفي أو تشوش على مستويات للمعنى أعمق وأصعب في
الوصول إليها (وأقل قبولاً اجتماعيًا)” (ص٧٣)، وهو في رأيهما من تمت صياغته کی “يعبر ويخفي في آن (ص 81):
Sandra M. Gilbert and Susan Gubar, The Madwoman in the Attic: The Woman Writer and the Nineteenth-Century Literary Imagination (New Haven, Conn.: Yale University Press, 1979(
28 – ولتأخذي في الاعتبار، على سبيل المثال، التعميم المختزل وغير الدقيق الذي قدمه روبرت بویرز قائلاً أن “ما يميز الكتب العادية والمقالات المكتوبة حول النساء على الكتابة النسوية هي الإصرار النسوي على طرح نفس الأسئلة عند تناول کی عمل، والمطالبة بإجابات مرضية أيديولوجيا على تلك الأسئلة لتقييمه“، وذلك في مقالته:
Robert Boyers, “A Case Against Feminist Criticism, Partisan Review 43 (1976): 602
29 – رغم غموضه بشأن التواصل الأدبي بداية من هوميروس، إلا أن هارولد بلوم مع ذلك يتنبأ منذرًا بأن “الانفصال الحقيقي الأول .. سيتم في الأجيال اللاحقة إذا كان لعقيدة “المرأة المتحررة” الناشئة أن تنتشر من مجموعات التحمسات لها وتسود العالم“، وذلك في الصفحة رقم 33 من كتابه، وفي الصفحة رقم 36، يعترف هارولد بلوم بأنه بينما “سيعقب ذلك (شيء) في عنف الشجار إذا عبرت عن حكمي” على روبرت لوويل ونورمان ميلير إلا أنه سيؤدي إلى شيء يفوق الشجار إذا عبرت عن حكمي على … “أدب تحرير النساء“:
Harold Bloom, A Map of Misreading (New York: Oxford University Press, 1975), p. 33,36
30 – Kennard, Victims of Convention, p. 14.
31 – Rich, “When We Dead Awaken”, p. 90.
32 – الأولى هي مقولة يعبر عنه حاليًا بعض النقاد البنيويين والشكلانيين، ولعل أفضل تعبير عن المقولة الثانية يرد في کتاب جورج لوكاتش عن “القارئ والكاتب“:
Georg Lukacs, Writer and Critic (New York: Grosset & Dunlap (1970, p. 119
33 – David Couzens Hoy, “Hermeneutic Circularity, Indeterminacy, and Incommensurability”, New Literary History 10 (Fall 1978): 166 -67.
34 – Bloom, Map of Misreading p. 36. 36
35 – قام چون ديوي بتأكيد نفس هذه الفكرة في عام 1934 عندما أكد على أن العمل الفني “تتم إعادة خلقه كل مرة يخضع فيها للتجربة الجمالية… ومن غير المعقول أن نتساءل عن المقصد الحقيقي للفنان من إنتاجه، فهو نفسه سيجد معان مختلفة فيه في أيام وساعات مختلفة وفي مراحل مختلفة من تطوره الشخصي“. وأضاف شارحًا: من المحال ببساطة أن يمكن لأحد أن يعايش اليوم تجربة البارثيبدون (أي معبد الآلهة الإفريقية أثينا) كما عايشها المواطن الأثيني المؤمن المعاصر له، بنفس الدرجة التي يحملها تمثال ديني من القرن الثاني عشر من معان جمالية بالنسبة لشخص كاثوليكي مؤمن من الزمن الحاضر مقارنة بالمؤمنين المنتمين إلى تلك الحقبة الزمنية القديمة.
john Dewey, Art as Experience (New York: Capricorn Books, 1958), pp. 108- 9
36- Charles Altieri, “The Hermeneutics of Literary Indeterminacy: A Dissent from the New Orthodoxy,New Literary History 10 (Fall 1978), pp. 108- 9.
37- Murray Krieger, Theory of Criticism: A Tradition and Its System (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1976). p. 6
38- أنظر/ي:
Sanley E. Fish, “Normal Circumstances, Literal Language, Direct Speech Acts, the Ordinary the Everyday, the Obvious, What Goes without Saying, and Other Special Cases”, Critical Inquiry 4 (Summer 1978): 627-28
39 – المصدر السابق، ص٦٤٣.
40 – Virginia Woolf, “Women and Fiction”, Granite and Rainbow: Essays (London: Hogarth Press, 1959( p. 81.
41 – Cesare Segre, “Narrative Structures and Literary History”, Critical Inquiry 3 (Winter 1976): 272- 73.
42 – Ted Cohen, “Metaphor and the Cultivation of Intimacy”, Critical Inquiry 5 (Fall 1978):9.
43 – من النص الآتي:
Adrienne Rich, Transcendental Etude”, The Dream of a Cammon Language: Poems 1974-1977 (New York: W.W. Norton 1978). pp. 76-77.
44 – Furman, “Study of Women and Language”. p. 184.
45 – يلاحظ روبرت شولز قائلاً “إن التوجه المتكرر في النقد هو تأسيس معايير زائفة لتقييم الأعمال الأدبية“:
Robert Scholes, Structuralism in Literature: An Introduction (New Haven, Conn.: Yale University Press, 1974 ) p. 131.
46 – للحصول على مناقشة كاملة لقصة جلاسبيل القصيرة التي تأخذ هذه المشكلة في الاعتبار، أنظر/ي:
Annette Kolodny, “A Map for Rereading: Gender and the Interpretation of Literary Texts”. The New Feminist Criticism: Essays on Women, Literature, and Theory, ed. Elaine Showalter (New York Pantheon Books, 1985), pp. 46- 62.
47 – Olsen, Silences p. 45.
48 – Annette Kolodny, “Literary Criticism”, Review Essay, Signs 2 (Winter 1976): 420,
49 – Scholes, Structuralistn in literature, pp 144 – 45
، وتأتي هذه التعليقات ضمن تناوله لنظرية القراءة عند تسفیتان تودوروف.
50 – أستعير هذه الصياغة الموجزة للتواضع التعددي من مقالة أبرامز:
M. H. Abrams, “The Deconstructive Angel”. Critical inquiry 3 (Spring 1977): 427
كما توجد مؤشرات للتعددية، التي أصبحت تميز البحث النسوي، في المقالات المتنوعة التي جمعتها سوزان كوبيلمان كورنيلون في مجموعتها المبكرة والرائدة:
Susan Koppelman Cornillon, Images of Women in Fiction: Feminist Perspectives (Bowling Green, Ohio Bowling Green University Popular Press, 1972(
51 – R. P. Blackmur, “A Burden for Critics”, Hudson Review 1 (Summer 1948): 171.
وكان بلاكمير يشير هنا بالطبع إلى الطريقة التي يجعلنا بها النقد على وعي بكيفية عمل الفن. وأستخدم كلماته هنا لأني أؤكد على هذا الوعي نفسه يجب أن يركز أيضًا على الفعل النقدي ذاته: “الوعي هو الطريقة التي نشعر بها بعب، الناقد“.
52 – لقد سبق لي التعبير عن اعتراضي على الفئات المفروضة على دراسة الأدب في مقالتي:
Annette Kolodny, “The Feminist as Literary Critic”, Critical Response, Critical Inquiry 2 (Summer 1976):827- 28.
53 – Scholes, Structuralism in Literature, pp. 151- 52.
54 – Lillian S. Robinson, “Dwelling in Decencies: Radical Criticism and the Feminist Perspective”, College English 32 (May 1971); reprinted in Sex, Class, and Culture, p. 11.
55 – يعلق جيرتز قائلاً: “إن الأيديولوجيا تقرب المسافة العاطفية بين الأشياء على ما هي عليه وبين ما يريدها المرء عليه، بما يضمن بالتالي القيام بالأدوار التي ربما كان سيتم التخلي عنها يأسًا أو لا مبالاة“:
Geertz, “Ideology as a Cultural System”, p. 205
56 – المصدر السابق، ص۲۲۰، ٢٠٥.
57 – إنني أتبع هنا رأي فريدريك جيمسون القائل: “تبدو الأيديولوجيا بمثابة شبكة من الأشكال والقوالب والمعتقدات التي تنظم أفعالنا“:
Frederic Jameson, The Prison-House of Language: A Critical Account of Structuralism and Russian Formalism (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1974), p. 107