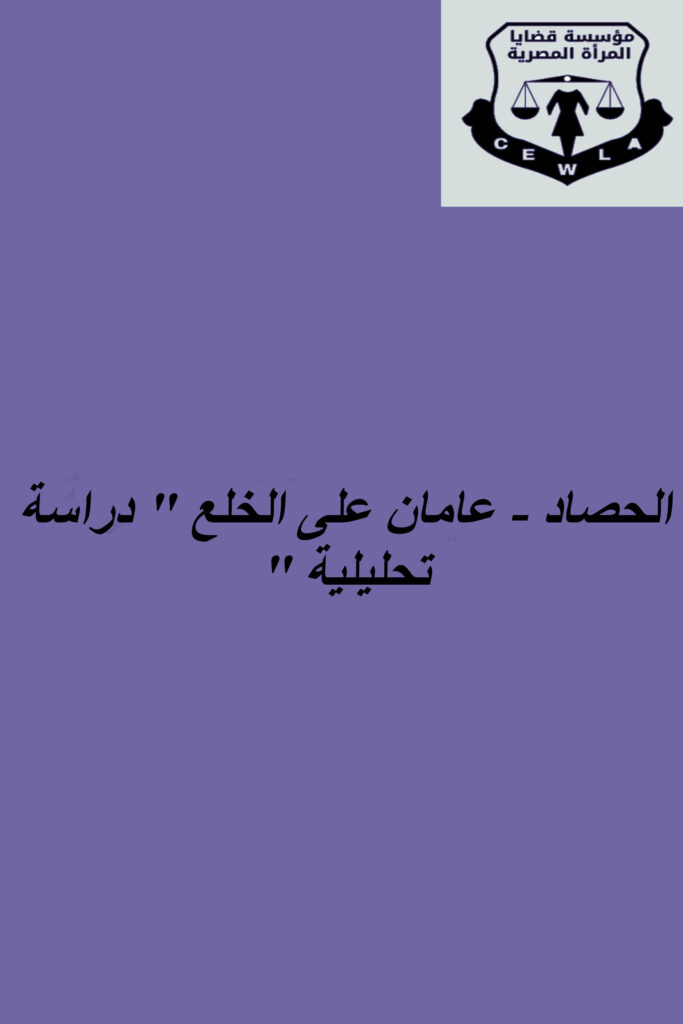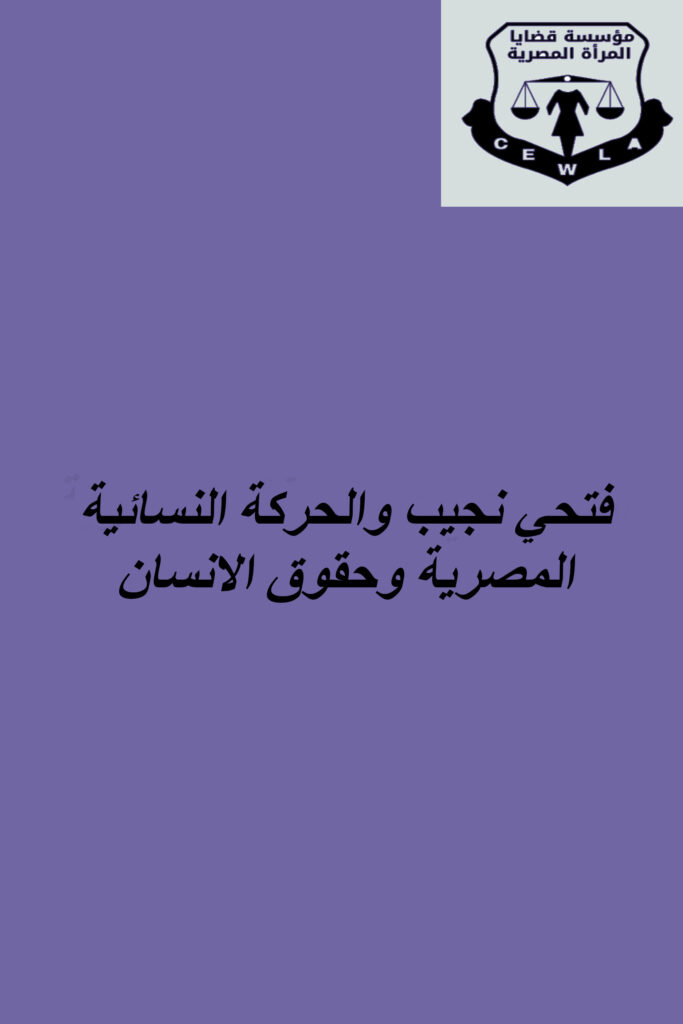أهم المقالات حول الأحداث
المرأة والعدالة الإجتماعية
بسمة موسی
منذ فجر التاريخ كان يرمز للعدالة بامرأة معصوبة العينين تحمل ميزاناً، استخدم هذا التعبير عبر قرون عديدة وحضارات مختلفة، وذلك لدلالته القوية ومعناه الواضح فالعدالة هي امرأة لأنها راجحة العقل ورحيمة، وتحمل ميزان دلالة على الحكم العادل الذى يوافق حجم الجرم المرتكب فلا هو أزيد ولا هو أقل، أما معصوبة العينين فدلالة على النزاهة، أى أن العدل لا يحابي أحداً أو يميل لآخر طبقًا لأهوائه الشخصية. هذه المعانى السامية والقيم النبيلة اتفقت عليها شعوب الأرض منذ قديم الزمان، كما حثت عليها جميع الديانات الإلهية، حتى الأنظمة العلمانية أقرتها. وفي داخل قاعات المحاكم توضع هذه الصورة للمرأة المعصوبة التى تمثل العدالة لتذكر العاملين بقطاع القضاء بالعدل للجميع. فإذا كانت البشرية منذ عهود سحيقة قد اتخذت من المرأة أعلى صورة للعدالة. فكيف جاء قرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة برفض تولى المرأة منصب القضاء في مجلس الدولة، لقد صدمني هذا القرار، لأنه لا يتعارض فحسب مع مبدأ المساواة بين الرجال والنساء المقر دستوريًا بالمواد ۱۱ و ٤۰ من الدستور الذى يساوى بين المواطنين المصريين بدون تمييز على أى أصل أو جنس أو لون، وكذلك المادة الأولى من الدستور، وهو مبدأ المواطنة الذى يقر حقوق متساوية للمصريين جميعًا، ولكن لأنه جاء من الجمعية العمومية لمجلس الدولة، والتى من المفترض أن القضاة هم حماة العدل والحق وأن هذا القرار يوضح البعد عن تقدير الدور الكبير الذى تؤديه المرأة بكل همة وعزم. أتمنى أن يصل ندائى إلى الأفاضل من أعضاء مجلس الدولة لمراجعة هذا القرار لأنه سوف يضع مصر فى حرج كبير كأحد انتهاكات حقوق المرأة. خاصة بعد أن رأينا نموذجًا مشرفًا فى القضاء منذ تعيين السيدة تهاني الجبالي عام ۲۰۰۳ وبعدها تعيين العديد من القاضيات. وفى الوقت الحالي اختارت مصر إحدى السيدات الفضليات وهى الدكتورة آمال عثمان لتدافع فيه عن ملف حقوق الإنسان المصرى مع أحد جهابزة القانون فى مصر، والذي يعنى أن الدولة تضع ثقتها الكبيرة بالمرأة. إن القضاة هم حملة مشاعل التنوير فى المجتمع ودورهم الأساسى هو مناقشة المشكلات القضائية وليس النوع الاجتماعي. وهم يعلمون جيدًا أن مصر لديها تعهدات دولية، ومنها تصديق مصر على كل من العهدين الدوليين، واتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ونشرت جميعها في الجريدة الرسمية المصرية، ومن ثم أصبحت لها قوة القانون وفقًا للمادة ١٥١ من الدستور المصرى. وأحكامها تنسحب بالضرورة على موضوع تولى المرأة لمنصب القضاء، حيث لا تمييز بينها وبين الرجل فى هذا الأمر علمًا بأنه ستكون لمصر مراجعة في مارس القادم عن وضع المرأة في المجلس الدولي لحقوق الإنسان. إن العالم يشهد تغييرات عديدية متسارعة فإذا اهتز ميزان العدالة لدينا فلمن تلجأ المرأة وهذا القرار يجيز العدالة ضدها فكيف ستدافع عن نفسها أمام قضاة مجلس الدولة وهم الخصم والحكم فى آن واحد وهذه إشكالية قانونية معقدة. إنني على ثقة من نزاهة القضاء المصرى وأعتز باستقلاليته وأعتز أيضًا بمجلس الدولة، حيث صدر عنه أحكام كثيرة تقر حقوق الإنسان المصرى بدون تمييز؛ ولذا يحدونا الأمل بإمكانية معالجة هذا القرار بشكل يحمى الحقوق الدستورية للمرأة التى تشكل نصف المجتمع، فالمجتمع المصرى أرقى مما نتصور في نظرته للمرأة وتطبيق العدالة الاجتماعية، ولا يهمه جنس من على منصة القضاء ولكن يهمه عدالة القضاء. إن العالم أجمع يرتب فى ٨ مارس القادم للاحتفال بالذكرى المئوية لأول مؤتمر عالمي يتحدث عن حقوق المرأة والذى عقد في كوبنهاجن فى ٨ مارس ۱۹۱۰ والذى أصبح فيما بعد يومًا عالميًا للمرأة. فهل ترتب نحن أيضًا الاحتفال الذى يليق بالمرأة في هذه المناسبة، وذلك بأن تعيد الجمعية العمومية لمجلس الدولة فتح باب المناقشة لهذا القرار وأن تبادر بعقد جلسات استماع للمهتمين بهذه القضية لسماع وجهات نظرهم. ولنتذكر الحكم التاريخي لمجلس الدولة عام ١٩٤٨ برئاسة المستشار الدكتور عبد الرازق السنهورى، والذى أصّل الحق الدستوري والقانوني في تولى المرأة منصب القضاء. إن العظمة ستكون للرجال من لدى الرحمن عندما يعيدون للمرأة حقوقها التي غلفها الزمن طي النسيان.المصرى اليوم
۲۱ فبراير ٢٠١٠
د. محمد نور فرحات
سؤال الذي تطرحه توصية الجمعية العمومية لمجلس الدولة التى عقدت مؤخرًا والرافضة لتعيين النساء كأعضاء بالمجلس هو: هل يجوز لسلطة من سلطات الدولة أن تعطل تطبيق الدستور أو القانون لاعتبارات الملاءمة؟
قبل أن أجيب عن هذا السؤال لابد أن أثبت دفعًا شكليا مؤداه أن الجمعية العمومية لمجلس الدولة في اجتماعها الأخير قد زعمت لنفسها ولاية لم ينص عليها القانون حين تصدت للتصويت على جواز أو عدم جواز تعيين النساء كأعضاء بالمجلس. فالجمعية العمومية للمجلس غير مختصة بأمور التعيين فيه، والمادة ٦٨ من قانون مجلس الدولة صريحة فى أن اختصاص هذه الجمعية مقصور على إصدار اللائحة الداخلية للمجلس بالإضافة إلى ما يحدده القانون لها من اختصاصات ليس من بينها وضع قواعد التعيين بالمجلس وضوابطه، إذ إن الاختصاص بالنظر في التعيين وفقًا للمادة ٦٨ مكرر من قانون المجلس مقرر لكيان آخر هو المجلس الخاص للشؤون الإدارية برئاسة رئيس المجلس وعضوية أقدم ستة من نواب الرئيس، وبالتالي فإن توصية الجمعية العمومية بمنع تعيين النساء قد صدرت ممن لا يملك، ومنعت حقا عمن يستحق.
أما من حيث الموضوع فالرأى عندى أن اعتبارات الملاءمة لا مجال لها عند اتخاذ أي قرار إلا إذا كان صاحب القرار يتمتع بسلطة تقديرية فى أن يصدر القرار أو لا يصدره، بشرط أن يكون استخدامه لسلطته التقديرية غير مشوب بإساءة استعمال السلطة أو التعسف فيها وغير مناقض الروح الدستور والقانون ذاته، ولا يمكن استعمال السلطة التقديرية بالمخالفة للدستور والقانون أو حتى بالمخالفة لروح الدستور والقانون، والقول بغير ذلك يؤدى إلى فتح الباب لمخالفة الدستور والقانون والعصف بمبادئهما العامة تذرعاً باعتبارات الملاءمة، وهو أمر إن حدث يخرجنا من إطار دولة القانون إلى دولة الهوى والتقدير والتعسف.
من أجل هذا كنت قد اختلفت وما زلت اختلف في كتاباتى الجامعية مع الحكم الذى أصدرته محكمة القضاء الإدارى سنة ١٩٥٣ في الدعوى التي أقامتها الدكتورة عائشة راتب ضد وزير العدل عام ١٩٥٣ بطلب إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تعيينها في النيابة العامة،
فبعد أن أقرت المحكمة بأحقية المدعية في التعيين سواء من وجهة النظر الشرعية أو القانونية عادت لترفض إجابة طلبها بحجة أن المواءمة الاجتماعية لا تسمح بذلك الآن، والرد على ذلك أنه لا مواءمة في تطبيق نصوص الدستور والقانون إن لم يقرر الدستور في القانون في صلب نصوصهما مشروعية هذه المواءمة، ومواد الدستور المصرى التى تتحدث عن المساواة بين المواطنين جاءت بعبارات مطلقة لا تجيز للمشرع إدخال أى قيود عليها، وذلك على خلاف مواد أخرى تنظم الحريات تجعل نطاق الحرية محصورًا في حدود ما يقره القانون،
فالمادة ٤١ من الدستور تقرر الحرية الشخصية في حدود القانون، والمادة ٤٤ تتحدث عن حرمة المساكن وفقًا لأحكام القانون، والمادة ٤٧ تتحدث عن حرية الرأى والتعبير في حدود القانون، ولكن المادة ٤٠ التي تقر مبدأ المساواة المطلقة بين المواطنين لا تتيح للمشرع “ومن باب أولى للقضاء أو للسلطة التنفيذية“، إمكانية النيل منها تحت أى ذريعة، تنص المادة ٤٠ من الدستور المصرى على أن “المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ولا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة“.
وهى عبارات حاسمة جازمة تقر مبدأ المساواة بشكل مباشر دون مواءمة أو استثناء، وإن كان هذا لا يغلق بالطبع الباب أمام الاجتهاد القضائي والفقهى لتحديد معنى المساواة، وهو ما أفاضت فيه أحكام المحكمة الدستورية والقضاءان الإدارى والعادى، دون أن يصل هذا الاجتهاد إلى حد العصف بمبدأ المساواة وانتهاكه وإقرار صور التمييز غير المشروع بين المواطنين.
وها قد مر أكثر من نصف قرن على حكم مجلس الدولة فى قضية الدكتورة عائشة راتب تولت فيه المرأة المصرية مناصب السفارة والوزارة ومناصب الرأى والفكر في الصحافة والجامعة بل مناصب تتيح لها الفتيا فى أمور الدين، ومع ذلك ما زال مستشارو مجلس الدولة يرون أن الظروف الاجتماعية غير موائمة لتعيين المرأة فى الوظائف القضائية، وبعيداً عن هذا الجدل، فإنني مصمم على إثبات حقيقة أنه لو فتحنا الباب لمخالفة الدستور والقانون بحجة المواءمة الاجتماعية لفتحنا بذلك باباً واسعاً لمخالفة القانون والدستور والعصف بحقوق وحريات الأفراد، فلماذا إذن نلوم الحكومة على تزوير الانتخابات ما دامت تتحجج بأن المواءمة الاجتماعية من وجهة نظرها لا تسمح بانتخابات نزيهة خشية أن يقفز التيار الإسلامي على الحكم؟ بل لماذا نُدين جميع صور الفساد ومخالفة القانون، التي يملك أصحابها من الذرائع ما هو خليق بإقناع الكثيرين بجدوى مخالفة القانون؟
يملك مجلس الدولة مثلما تملك أى هيئة عامة فى مصر أن تعين بين صفوفها أعضاء جدداً أو أن ترجئ ذلك التعيين بحجة أن الظرف غير مناسب لمبدأ التعيين ذاته، ولكن مجلس الدولة إذا قرر تعيين أعضاء جدد به لا يملك دستورياً العصف بمبدأ المساواة أو بمبادئ الحريات العامة المقررة دستوريًا بحجة عدم ملاءمة الظروف لتعيين شريحة من هؤلاء الأعضاء مصنفة بحسب الجنس أو الدين أو الأصل أو العرق أو غير ذلك مما حظرته المادة ٤٠ من الدستور فإذا كانت الظروف غير ملائمة لتطبيق الدستور أو القانون،
فالأولى بنا أن نكون على درجة من الرشد والعقلانية بل الشجاعة بأن نطلب إلغاء أو تعديل المواد غير الملائمة مع الظروف، التى لا تروق لنا فى الدستور والقانون، بأن ينص مثلاً على عدم جواز تعيين النساء فى القضاء، وعلى حظر تعيين الأقباط فى مناصب رؤساء الجامعات وعمداء الكليات، وعلى الحيلولة بين أبناء الفقراء والتعيين فى مناصب الخارجية والشرطة، ولنعترف صراحة بأن البعض منا يروق له أن يعود بمصر إلى التنظيم الاجتماعي للطوائف والملل الذي كان سائدًا في العصر العثماني، والذى ألغاه محمد على باشا عندما شرع في بناء مصر الحديثة.
والمرجح عندى أن الأمر فى مقاومة تعيين النساء فى القضاء لا يتعلق بالمواءمة الاجتماعية بل يتعلق بالثقافة الاجتماعية للقضاة، إذ إن النفور من تعيين النساء في المناصب القضائية، رغم علم الجميع أن الفقه الإسلامي لا يعارض ذلك فى أغلبه، ورغم علم الجميع أن المرأة قد تولت أرفع المناصب القضائية وأدناها وأثبتت فيها جدارتها فى العديد من الدول العربية والإسلامية، فإن هذا النفور يرجع إلى أن قيمة الاستعلاء الذكورى متغلغلة فى وعى القضاة لأسباب ثقافية عديدة، وليس قضاة مجلس الدولة نسيجاً وحدهم فى ذلك، فنذكر أن قطاعاً كبيراً من رجال القضاء العادي.
(حتى من بين هؤلاء الذين يمثلون تيار الاستقلال) لهم نفس الموقف الرافض لتعيين المرأة في القضاء لحجج أو لذرائع شتى لا تقوى على الصمود أمام أى مناقشة جدية، وظني أننا لو أجرينا استفتاء بين جموع القضاة بمختلف هيئاتهم على تعيين المرأة فى القضاء لجاءت النتيجة بالرفض، ولولا موقف القيادات العليا بالدولة الداعم لتولى المرأة القضاء لما قدر للمرأة المصرية أن تعين في القضاء العادى أو الدستورى، وموقف القيادة السياسية فى مصر الداعم للمرأة، شأن الأمر في دول عربية أخرى كالكويت مثلاً، يأتى أكثر تقدماً من موقف كثير من الشرائح الاجتماعية، ولعل القيادات السياسية في مجتمعاتنا المحافظة تحاول أن تعوض انتهاكات حقوق الإنسان السياسية والمدنية بدعم حقوق المرأة، خاصة أن هذا الدعم لا يمثل تكلفة سياسية باهظة، وتلك على أى حال قضية أخرى.
وشأن القضاة في استشراء ثقافة التمييز ضد المرأة شأن كل من يمارس سلطة في مصر سواء أكانت سلطة دينية أو قضائية أو سياسية أو حتى سلطة عشائرية وقبلية ومن الممكن افتراض أن السلطة في مصر أيًا كانت تجلياتها هي سلطة ذات طابع ذكورى، فالسلطة رجل والرجل سلطة،
وفى المقابل إذا أجرينا استفتاء حول تولى المرأة للوظائف بين قطاعات المثقفين والعلماء كرجال الجامعات والإعلام والثقافة فستأتى النتيجة لصالح المرأة، إن من يحملون السيف هم الأقرب إلى دعم التمييز أما من يحملون القلم فهم الأنزع إلى المساواة، ومن هنا تبدو العلاقة واضحة بين ثقافة المساواة ونبذ التمييز وبين الابتعاد أو الاقتراب من سلطة الجبر سواء في معناها السياسي أو الديني، ومن هنا أيضًا تبدو العلاقة واضحة بين مقرطة المجتمع بأكمله وإشاعة الاستنارة فيه وبين الإقرار الفعلى للمساواة.
بطبيعة الحال هناك تفسيرات كثيرة لسيادة العقلية الذكورية المحافظة في المجتمع القضائي خاصة اليوم: منها كثرة عدد القضاة المعينين من خريجي كليات الشريعة والقانون ومن خريجي كليات الشرطة وهؤلاء ذوو خلفية ثقافية دينية أو عسكرية محافظة، وقد تربوا على مفاهيم ذكورية السلطة، ولكن هذه التفسيرات وإن ساعدتنا على فهم الظاهرة إلا أنها مبعث للانزعاج الشديد من الحريصين على مستقبل وطن تسوده العدالة والمساواة والحرية.
ذلك أن وصول ثقافة التمييز إلى مجتمع القضاة خاصة من شأنه أن يبث الرعب والفزع في قلوب المصريين على مستقبل حقوقهم وحرياتهم المنوط بالقضاة حمايتها، وبالأمس القريب فزع المصريون فزعاً شديداً عندما دافعت قطاعات واسعة من القضاة عن حق أبنائهم في تولى وظائف القضاء بصرف النظر عن جدارتهم العلمية، وهى سنة غير حميدة جرى عليها العمل في تعيينات القضاء منذ عدة عقود، وسيق الكتاب والمفكرون الذين فتحوا هذا الملف إلى النيابة العامة للتحقيق معهم كمتهمين بتهمة إهانة القضاء، وفى هذا قدر من شخصنة السلطة واستعمال السيف القانون في غير ما شرع له، وفى الوقت الذى ألغى فيه القضاء الدستوري استثناء تشريعياً كان مقرراً لأبناء أساتذة الجامعات عند الالتحاق بالجامعة لمخالفته مبدأ المساواة، لا يرى بعض القضاة ضيراً من تقرير نفس التمييز لصالح أبنائهم وبالافتئات على حقوق المتفوقين من نظرائهم، وتنطلق لتبرير ذلك دعاوى مضحكة مثل قول أحد كبار القضاة أن تقدير مقبول يضاف إليه أبوة أحد رجال القضاء للخريج يساوى تقدير جيد.
وعلينا أن نمتد بالمنطق لنهايته فإذا كانت الأبوة لأحد الوزراء كان التقدير جيداً جداً أما إذا كانت الأبوة لمن يعلو ذلك فلا وجه للمقارنة أو المفاضلة، لماذا نشكو إذن من التوريث السياسي إذا كان التوريث سنة متبعة فى مختلف الوظائف: عند العمل في القضاء وفى الجامعة وفي الإعلام وفى الطب وغير ذلك؟ وهكذا مرة أخرى تتحول الدولة المصرية بالتدريج إلى دولة للطوائف يسقط فيها القانون ومبدأ المساواة وترتفع قيمة التمييز بسبب الجنس أو القرابة والواسطة، والمحسوبية المجرم قانوناً. ولكن أن يصل الأمر إلى الضمير القضائى فهذا مبعث الفزع الحقيقي، لأنه لن يستطيع الإمساك بميزان العدالة من افتقد ضميره الإحساس بقيمة العدالة.
ولن يستطيع أن يساوى بين الناس فى مجلسه ووجهه (كما أوصى عمر بن الخطاب)، من انحاز إلى أهل بيته لمجرد رابطة الدم، إن الإحساس بالعدل لا يتجزأ، وأخلاق العدل والحرية والمساواة هي الحاكمة لتطبيق النص القانوني. وإذا افتقد القاضى هذا الحس الخلقى الرفيع فليس لنا أن ننتظر تطبيقًا عادلاً للقانون أو حماية صارمة للحقوق والحريات، وهذا مبعث الخطر.
المصرى اليوم
٢٤ فبراير ٢٠١٠
لحسن الحظ أنى ولدت فى هذه الدنيا ذكرًا. فالذكورة تأتى مع الكثير من المزايا.. أولها أنى لست في حاجة لإثبات أنى إنسان، مثلى مثل غيرى له جميع حقوق الإنسان، ولو كنت قد ولدت أنثى، وكان هذا احتمالاً واردًا، لكانت كارثة! إذ كنت سأجد نفسى مضطرًا لهدر الكثير من الوقت والجهد والطاقة لأنفى عن نفسي تهمة الأنوثة التى لم يكن لى يد فيها، والتي تأتي بالكثير من الافتراضات الظالمة سابقة التجهيز، أهمها: أن عقلى ليس راجحًا على نحو كافٍ، وأن ذكائى أقل، وأن قدرتي على التحمل والصبر أضعف، وبأنى لا أستطيع التمييز بين الحق والباطل.
ورغم ذكورتى التي لا فضل لى فيها ولا اختيار، إلا أنى عشت هذه المشاعر المظلومة جميعها بالفعل، عشتها عندما كنت أختلط بالناس في الولايات المتحدة الأمريكية.. هذه المرة بسبب ديني وليس بسبب نوعي. مرات عديدة وجدت معاملة الناس لى تتغير، ونظراتهم تتلون بالحذر والاستغراب بمجرد أن يعرفوا أنى شرق أوسطى مسلم وأن اسمى الأوسط هو موهامد إلى (محمد على!). والتهمة السابقة التجهيز هي أنى إرهابي عريق أمارس القتل من باب الهواية في عطلة نهاية الأسبوع، ومثلما تكافح المرأة فقط لتنقل رسالة تحاول أن تقول فيها إنها إنسانة تساوى الرجل في الحقوق والكرامة رغم أنها أنثى، كان على أنا أيضًا في الولايات المتحدة الأمريكية المتحضرة أن أقنع الناس كل يوم وفي كل مناسبة أني إنسان عادي جدًا أساويهم في كل شيء رغم أنى مسلم.. ويا له من عبء!
وها أنا أسمع كلامًا كثيرًا يفرق بين المرأة والرجل ليضعها في مرتبة أقل.. وباسم الإسلام ذاته بكل أسف. وأقف أمام الآية الكريمة، “وإذا الموؤدة سئلت بأى ذنب قتلت“، لأجد أن الوأد في الجاهلية، والذى تحدث عنه كتاب الله المحكم هو أكثر رحمة من الوأد الذى يحدث للمرأة في كل يوم وكل ساعة باسم ديننا الحنيف، الذى هو منه براء. ففى الجاهلية كان الحل السهل هو القتل ومغادرة هذه الدنيا الظالمة بعد ساعات يسيرة من دخولها، تمامًا كما فعلت أنا عندما اخترت أن أترك أمريكا لكي أحيا في سلام مع نفسى. أما الوأد فى هذا الزمان، فهو اغتيال أشد وأقسى لأنه اغتيال للمرأة في إنسانيتها وعقلها وجهدها وكفاءتها، بل وقدرتها على التمييز. ولن يخفف من قسوة هذا الاغتيال المستمر أن يقال إن عدم صلاحية المرأة لهذا العمل أو ذاك سببه هو إشفاق الرجل عليها من المشقة والجهد، فإذا كنا نشفق على المرأة حقا كما نزعم لتركناها هي تختار لنفسها، لا أن نفرض نحن اختيارنا عليها.
هل أنا حقًا في حاجة إلى أن أقول إن المرأة تصلح للقضاء؟ اسألوا أبو حنيفة الذي تأخذ الدولة بمذهبه عندما لا يوجد فى قانون الأحوال الشخصية نص، اسألوا القرضاوي. إن مجرد طرح التساؤل ذاته في هذا الزمان مهين لإنسانيتنا جميعًا ذكورًا وإناثًا لدرجة أنى أخجل حتى من مجرد مناقشته، ولكنى ببساطة أقول، كيف يمكن أن تكون الجهة المنوط بها حماية العدالة شريكًا في المستوى من الظلم ؟! لقد كان وأد الإناث في الجاهلية يحدث مرة واحدة فى عمرها، وعندما نقول إن المرأة لا تصلح للقضاء، فإننا نمارس وأد الإناث بتناول عصرى أنكى وأشد، لأننا نمارسه هذا على رأس المرأة مرارًا وتكرارًا، لمرات عديدة في كل لحظة من كل عمرها.
25 فبراير ٢٠١٠
فاطمة خير
كيف يمكن لي أن أثق فى قاضى، لديه من الأساس موقف منحاز ضد النوع؟
كيف يمكن لامرأة أن تقف بين يدى قاضى أو تترك مصالحها لقناعاته؛ إذا كان منحازاً من الأساس ضدها؟
بكل صدق.. لا أستطيع أن أصدق أو أقتنع أو أن أقدم تبريراً يبدو منطقياً، لانحياز رجال القضاء ضد عمل المرأة معهم! ليس لأنى منحازة بالأساس لأداء المرأة المهنى – بشكل عام – فحسب، ولا لكوني أؤمن – طبعاً – بأن التفوق والتميز لا يعترف بالتمييز النوعي؛ بل لأننا نعيش في زمن لا تحتاج فيه المرأة للدفاع عن صلاحيتها للعمل فى هذه المهنة بكل فروعها، بعد أن سبقتنا دول عربية وإسلامية في ذلك؛ ما يفند أى حجة عن جواز تولى المرأة هذا العمل في بلد تدين غالبيته بالإسلام، أما عن الدول الغربية فحدث ولا حرج، لأن المرأة تمارس فيها القضاء منذ سنين طويلة، بما ينفي بكل تأكيد عدم صلاحيتها كـ “أنثى” لهذا العمل.
وإذا كانت بعض النساء قد حصلن بالفعل على هذه الفرصة مؤخراً؛ إلا أن التوجه العام، والذي يلخصه البعض – مجازًا – فى جملة “مؤلمة” تقول بأن “تهاني الجبالى” ستكون أول وآخر قاضية مصرية، يؤكد أن أى مكاسب حصلت عليها المرأة فى هذا الإطار ستذروها الرياح في أول فرصة، لأنها جاءت دون قناعات حقيقية لدى رجال هذا السلك.. الذين يحكمون بالحق.
أكثر من الإحباط بكثير؛ هو ما يصيب أى امرأة لديها طموح في سلك القضاء (على تشعبه)، عقب قرار الجمعية العمومية “الطارئة” لمجلس الدولة، التى انعقدت خصيصاً “للنظر في تعيين المرأة في الوظائف الفنية“، الجمعية العمومية قررت رفض تعيين المرأة كقاضية في المجلس، بعد اعتراض ٣٣٤ عضواً، من أصل ۳۸۰ عضواً حضروا الجمعية، فيما امتنع ؛ عن التصويت، ووافق ٤٢.
صحيح أنه من المقرر عرض نتيجة التصويت على رئيس مجلس الدولة ليعرضها بدوره على المجلس الخاص لاتخاذ القرار المناسب فى شأنه، لكن طبعًا التوجه العام للمجلس واضح في الرفض.. ثم الرفض.
لو أن أحدًا يمتلك تفسيرًا لما يجرى؛ فليخبرني.
كيف لرجل القضاء أن يحكم بالعدل وهو يفرق بين رجل وامرأة بالنظر إلى كونهما ذكرًا وأنثى؟
وكيف يتعامل رجل القضاء مع “زميلته” بالأساس على اعتبار كونها امرأة؟
ولو أن الوظائف القانونية تفرق بين المواطنين على أساس النوع؛ فلما لا تتم التفرقة بينهم في كليات الحقوق التى يدرس الجميع فيها المواد نفسها ويؤهلون للأعمال نفسها؟
لن أذكر كل ما يمكن أن تقوله الجمعيات المدافعة عن حقوق المرأة، ولا المدافعون عن تمكين النساء فى مصر، ولا حتى المنادين بتفعيل حقوق المواطنة. لكنني سأخاطب الرجال الذين نوكل إليهم الحكم بالعدل:
لو أن الطالبة التى تدرس القانون هي أقل ذكاءً من زميلها
ولو أن المحامية التي تمارس القضاء الواقف هي أقل أداء من زميلها
ولو أن الأستاذة التى تدرس القانون لمن سيصبحون – في المستقبل – رجال قضاء.. هي أقل كفاءة من زميلها..
لو أنكم ترون ذلك حقاً وتؤمنون به وضمائركم ترضى عنه؛ فلترفضوا أن تجلس نساء مصر بجواركم ليحكمن بالعدل، ولتعلنوها للعالم أجمع: أن النساء المصريات – من دون نساء العالم – لا يصلحن للعمل فى القضاء لأنهن “ناقصات عقل ودين“.
١٦ فبراير ٢٠١٠
سعيد شعيب
بدون شك هى صدمة، وصدمة كبيرة، أن ترفض أغلبية الجمعية العمومية لمجلس الدولة تعيين المرأة كقاضية. صحيح أن هذا رأيهم الشخصي ومن حقهم أن يقولوه، وعلينا أن نحترمه، ليس فقط باعتبارهم مواطنين يمارسون حرية الرأى والتعبير، ولكن أيضًا لأنهم قضاة لهم وللمؤسسة القضائية كامل التقدير. ولكن عندما تصل نسبة الرفض لتعيين المرأة في الجمعية العمومية 87% لابد من التعبير عن الانزعاج من كل هذا الانحياز المعادى، فهو في جوهره نوع من التمييز ضد مصريين وحرمانهم من حقوقهم، بناء على آراء شخصية، وأظن أن قضاة الجمعية العمومية الأجلاء لم يكن مطلوب منهم فى هذا السياق التعبير عن آرائهم الشخصية في مؤسسة قضائية، ولكن أظن أنهم كانوا بحاجة لأن يضعوا القوانين والدستور فى اعتبارهم، ودراسة ماذا كان هذا التعيين مناقض لها أم لا؟
بل وأى جمعية عمومية لنقابة أو جمعية أو غيرها من مؤسسات الدولة لا يحق لها أن تصدر قرارًا فيه شبه مخالفة للقانون.. وأظن أنه فى هذه الحالة يمكن إسقاطه عبر اللجوء للقضاء. فالقوانين المصرية لا تميز بين المواطنين على أساس الدين أو الجنس أو العرق، كما أن الدستور المصرى (أبو القوانين) يساوى مساواة مطلقة بين كل المصريين. أضف إلى ذلك أن المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، التي وقعت عليها الدولة المصرية هى جزء من القوانين المصرية.
ثم إذا كانت المرأة تم الموافقة على تعيينها قاضية فى المحكمة الدستورية، وهي السلطة الأعلى في القضاء المصرى.. فكيف يمكننا قبول منع تعيينها في مجلس الدولة؟
فمجلس الدولة وجمعيته العمومية ليس جزيرة معزولة عن باقى المؤسسات القضائية، ولا عن القوانين والدستور، ولا عن باقى مؤسسات الدولة.. ومن ثم فمناقشة الأمر ليست تدخلاً في الشأن القضائي، ولا محاولة للتأثير على قرار قاضي بالحكم فى القضية الفلانية.. ولكنه شأن يخص كل المصريين لأنه يتعلق بحرمان فئة منهم من الحقوق التى أقرها الدستور. فهو مع كامل الاحترام لقضاة مجلس الدولة دفاع عن الدولة المدنية المصرية، ودفاع عن دولة تساوى بين مواطنيها، ومن قليل ومن بعد دفاع عن القضاء الذى يجب أن يكون حصنًا منيعًا ضد التمييز.
١٧ فبراير ٢٠١٠
د. مراد وهبه
ظن أن ثمة صراعاً خفياً فى مجلس الدولة يخص مكانة المرأة في المجتمع، وأظن كذلك أن هذا الصراع يدور بين الهيئتين الرئيسيتين لمجلس الدولة وهما الجمعية العمومية والمجلس الخاص.
وقد بدا هذا الصراع فى مسألة مدى مشروعية تعيين المرأة قاضية فى مجلس الدولة، إذ وافق المجلس الخاص على جواز تعيين المرأة بالوظائف القضائية، بينما رفضت الجمعية العمومية ذلك الأمر، إلا أن المحكمة الدستورية العليا قد أكدت فى ١٤ مارس من هذا العام حق المرأة في العمل كقاضية بمجلس الدولة، كما أكدت أن تمكين المرأة من ممارسة هذا الحق هو من اختصاص المجلس الخاص دون الجمعية العمومية. والسؤال بعد ذلك هو على النحو الآتي: متى نشأ هذا الصراع؟ نشأ بتعيين عبد الرزاق السنهورى فى أول مارس سنة ١٩٤٩ رئيسًا لمجلس الدولة، بل مؤسسًا حقيقيًا لهذا المجلس.
والسؤال إذن: من هو عبد الرزاق السنهورى؟! هو القائل فى ١١ يناير ۱۹۲۳ إن الأحوال الشخصية يجب أن تكون مبنية على الشريعة الإسلامية، لأنها شريعة الشرق، وهذا القول يكشف عن مغزاه في اختياره “الخلافة الإسلامية” موضوعًا لنيل درجة الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة باريس فى عام ۱۹۲٥، إذ كان عنوانها “الخلافة الإسلامية وتطورها لتصبح عصبة أمم شرقية“.
والسؤال إذن: ما مغزى هذا العنوان؟ كان السنهورى على يقين من أن في الإسلام إمامة وخلافة، الإمامة هي الرئاسة الدينية والخلافة هى الرئاسة السياسية، وقد تجتمع الاثنتان في رجل واحد وقد تتفرقان على رجلين. وأياً كان الأمر فإن تحقيقهما أمر لازم. وبالرغم من ترك الأتراك للخلافة فإنها عادت في إطار “جامعة الدول العربية“. ومعنى ذلك، في رأى السنهوري، أنه لا فرق بين جامعة الدول العربية وجامعة الدول الإسلامية، أى لا فرق بين فكرة العروبة وفكرة الإسلام وتأسيساً على ذلك يمكن تفسير الصدام الذى جرى بين السنهورى وعبد الناصر.
في البداية تحمس السنهورى لتولى العسكريين الحكم ثم تحمس لإلغاء الأحزاب، ولكنه بعد ذلك عرض على عبد الحكيم عابدين – أحد رموز جماعة الإخوان المسلمين – الاشتراك في الحكم لأن هذه الجماعة، فى رأيه، هى المروجة لإقامة الخلافة الإسلامية وعندئذ حدث الصدام.
ثم جاء المستشار طارق البشرى، الذى كان رئيس هيئة مفوضى الدولة وبلور أفكار السنهورى، إذ ربط الخلافة الإسلامية بالدولة العثمانية، بل ذهب إلى القول إن محمد على هو الذي عمل على تثبيت الدولة العثمانية ضد حركات الإصلاح الدينى فى الجزيرة العربية، وبناء عليه يمكن القول إن رؤية كل من السنهورى والبشرى للمرأة هى تكرار لرؤية الدولة العثمانية وهي أن المرأة ليست إلا مجرد أنثى. وإذا كان ثمة مسار متصل بين السنهورى والبشرى فهل هذا المسار هو الحاكم لمجلس الدولة؟
أظن أن الجواب بالنفى لأن ثمة تياراً آخر ومن رواده المستشار فتحى نجيب، الذي كان رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا والذى كنت معه على علاقة حميمة. سألته ذات مرة: هل ثمة علاقة بين القاضي وثقافته في إصدار الحكم ؟ أجاب على النحو الآتى: إذا كانت القيم الثقافية هابطة فالعدالة هابطة، والذى يمنع هبوطها هو ثقافة القاضى وليس القاعدة القانونية المجردة. فإذا اعتمدت ثقافة القاضي على النقل دون إعمال العقل فالحكم يصدر ظالمًا بالضرورة، أما إذا اعتمدت ثقافته على التنوير والإبداع فالحكم يصدر عادلاً.
وتأسيساً على هذه الإجابة من قبل المستشار فتحى نجيب يمكن القول إن المرأة في مسارها، إما أن تكون محكومة أو حاكمة على نحو ما تشاء ثقافة المجتمع.
المصرى اليوم
3 إبريل ۲۰۱۰
إذا قرأنا قرار تعيين المرأة قاضية من وجهة النظر النسوية، – فقد يبدو أننا كسبنا نقطة. أما إذا نظرنا إليه من زاوية المصلحة الوطنية التى يشكل استقلال القضاء ركيزة أساسية لها، فسوف نكتشف أننا خسرنا أكثر من نقطة.
– 1 –
لقد التزمت الصمت إزاء الموضوع طوال الأسابيع الخمسة التى استغرقها هبوب العاصفة. وآثرت الانتظار حتى تقول المحكمة الدستورية كلمتها التى كان من اليسير على أي متابع لاتجاه الريح ومدرك للضغوط التي مورست، أن يتنبأ بما يمكن أن تخلص إليه. وهو أمر مؤسف لا ريب، يتعين إدراجه ضمن سلبيات ما جرى. وكان دافعى إلى العزوف عن الاشتراك في اللغط والصخب الذي ثار اقتناعي بأن القضية لم توضع فى إطارها الصحيح، بحيث انزلقت في مدارج الغلط كل ما بنى على الخطأ في الطرح.
كما أننى لا أخفى شعورًا بالدهشة إزاء الخلل الذى أصاب أولوياتنا ونحن نتعارك ونتراشق بسبب جلوس المرأة على منصة القضاء، في حين تتعلق أبصار العرب والمسلمين بما يجرى في الأرض المحتلة. آية ذلك أنه فى اليوم الذى احتل فيه قرار المحكمة الدستورية العليا بشأن الانتصار للمرأة القاضية العنوان الرئيسي لصحيفة “الأهرام” (يوم ٣/ 15) كان الخبر التالي في الأهمية هو الاشتباكات الحاصلة في القدس، التي سجلتها صورة للشبان الفلسطينيين وهم يرشقون بالحجارة الجنود الإسرائيليين الذى كانوا يردون عليهم بخزات الرصاص المطاطى والقنابل المسيلة للدموع.
أيًا كان الأمر، فالثابت أن ملف المرأة القاضية احتل حجمًا أكبر مما ينبغي التبس في ظله الأمر على كثيرين، كما أنه أغرى بعض المتحمسين بتحويله إلى ساحة جديدة للإثارة والمزايدة. كما أتاح لآخرين من الناقدين والناقمين فرصة قمع معارضيهم فى الرأى وتلويث سمعتهم. أما الذين حولوا المسألة إلى اشتباك مع تعاليم الإسلام وتجريح لها فحدث عنهم ولا حرج، لأن بعض مثقفينا أصبحوا ينتهزون كل فرصة لتجديد ذلك الاشتباك وتصعيده، مرة باسم الدفاع عن الدولة المدنية، ومرة باسم التصدى للأصولية والسلفية، ومرات باسم ما اعتبروه خلاصًا من تأثير الخرافات والغيبيات وغير ذلك من مخلفات “عصور التخلف والانحطاط“.
-2 –
نصيب مجلس الدولة من هذه السهام كان وفيرًا، فقد صور بحسبانه منحازًا ضد المرأة، وكان إطلاق هذه الشائعة كفيلاً بفتح باب التسابق على وضعه في قفص الاتهام، وإطلاق دعاوى محاكمته بتهم السلفية والأصولية. وكان ذلك أمرًا مثيرًا للدهشة حقًا، ليس فقط لأنه يعبر عن إصرار على مصادرة وجهة نظره فى الموضوع، ولكن أيضًا لأن سجل المجلس يحفل بالمواقف التي تشرفه وتبيض صفحته وتجعله أبعد ما يكون عن تلك الشبهات. ذلك أن الذين أطلقوا تلك الاتهامات تجاهلوا أن المجلس هو الذى أجاز قانون الخُلع، وأبطل قرار وزير الداخلية الذي كان يشترط ألا تسافر المرأة بغير إذن زوجها. وهو الذى قضى بألا تسجل في بطاقة هوية أى شخص ديانة غير ديانته الحقيقية.. كما أن مجلس الدولة هو المؤسسة المدنية الوحيدة التي اختارت رئيسًا قبطيًا مرتين (هما المستشاران حنا ناشد ونبيل ميرهم) ولا ينسى أيضًا أن مجلس الدولة هو الذي ألغى قرار تصدير الغاز إلى إسرائيل، وهو الذى قضى بعدم شرعية وجود “الحرس” في الجامعة.
الذي لا يقل أهمية عن كل ذلك أن القضاة ومجلس الدولة لم يتبنوا موقفًا ضد تعيين المرأة قاضية. وإنما هناك اتفاق بين الأغلبية الساحقة على أن حق المرأة فى ولاية القضاء تجيزه الشريعة الإسلامية، ولا يتعارض مع الدستور والقانون. وإن مبرر البت في الأمر ليس المرجعية الفقهية أو القانونية، وإنما هو الظروف الاجتماعية والبيئية بالدرجة الأولى.
لقد ارتأى أعضاء الجمعية العمومية لمجلس الدولة تأجيل البت فى الموضوع وعدم التسرع في إقراره، ليس لأنهم يعترضون على المبدأ، ولكن لأنهم يرون أن الأمر يحتاج إلى ترتيب يوفر ظروفًا مواتية لإنجاح دخول المرأة فى هذا المجال. ذلك أن الذين ينتمون إلى الهيئة القضائية محكومون مثلاً بقواعد في أداء عملهم، بعضها يتعلق بسنوات أداء خدمتهم في المحافظات المصرية المختلفة، الأمر الذى يثير أكثر من سؤال حول وضع النساء في هذه الحالة، وهل سيخضعن لهذا النظام أم سيقتضى الأمر استثناءهن منه، وتسكينهن مع أسرهن. وإذا خضعن لترتيبات التنقل بين المحافظات المختلفة، فهل سيتطلب ذلك تخصيص استراحات خاصة لهن كما هو الحاصل أعضاء الهيئة القضائية من الرجال. وإلى جانب ذلك فهناك الملاءمات المتعلقة باستقبال المتقاضين والمجتمع لهذه النقلة المفترضة.. إلى غير ذلك من التفاصيل يرى القضاة أنها مع تحتاج إلى روية وعدم التسرع في اتخاذ القرار.
القصة قديمة فيما يبدو لأن ثمة قضية شهيرة أثير فيها هذا الموضوع قبل نصف قرن (في عام ١٩٥٢)، حين رفعت إحدى أوائل خريجات حقوق القاهرة (عائشة راتب – الدكتورة والأستاذة والوزيرة لاحقًا) قضية أمام مجلس الدولة مطالبة بحقها فى التعيين فى النيابة العامة، ولكن المجلس برئاسة المستشار السيد على السيد، قضى بأن الظروف الاجتماعية والبيئية لا تسمح بذلك، وقرر أنه لا يستند فى ذلك إلى الشريعة أو الدستور، وإنما إلى حق الجهة الإدارية في مراعاة الظروف والملاءمات التى يعمل في ظلها الموظف.
– 3 –
يرى المستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض أن ملف إشراك النساء في الهيئة القضائية تداخلت فيه عوامل عدة خارجية وداخلية شكلت عنصر ضغط في الموضوع. وقد سمعت منه أن الموضوع أثير في أعقاب أحداث ۱۱ سبتمبر ۲۰۰۱، وأن وفدا من نادى القضاة أجرى حوارًا حول الفكرة مع وزير العدل آنذاك المستشار فاروق سيف النصر رحمه الله، وقد سمع منهم الوزير ملاحظاتهم حول الموضوع، لكنه أفهمهم أن ثمة ضغوطًا دولية استدعت ذلك، مورست في إطار ما سمى آنذاك بالحرب على الإرهاب. والملاحظ أنه بعد هذا اللقاء تم تعيين السيدة تهانى الجبالى عضوًا في المحكمة الدستورية العليا بمصر، كما تتابع تعيين الوزيرات في العديد من الدول العربية، والخليجية منها بوجه أخص.
ما حدث أيضًا فى الآونة الأخيرة تفوح منه رائحة الضغوط الداخلية، التى تمارس من قبل جهات عدة في مقدمتها المجلس القومى للمرأة. ذلك أن المجلس الخاص فى مجلس الدولة الذي يضم أقدم ستة مستشارين إضافة إلى الرئيس كان قد ناقش موضوع قبول طلبات تعيين النساء في اجتماع عقده يوم ١٨ يناير الماضي. وفى الاجتماع تم الاتفاق على عرض الموضوع على الجمعية العمومية للمجلس التى كان موعد اجتماعها العادى فى ١٥ فبراير للنظر في ترشيح النواب ووكلاء المجلس. فى هذا الاجتماع الذى حضره ۳۸۰ مستشارًا فما فوق، ارتأى 87% من الأعضاء تأجيل البث في الموضوع. ولكن وزير العدل سارع فى اليوم التالي مباشرة (16/ 2) إلى إرسال خطاب إلى رئيس الوزراء أحمد نظيف أبلغه فيه بأن خلافًا وقع بين المجلس الخاص وبين الجمعية العمومية لمجلس الدولة حول تعيين النساء. ولم يكن هناك خلاف في حقيقة الأمر لأن المجلس الخاص هو الذى قرر الرجوع إلى الجمعية العمومية. يوم 17/ 2 طلب الدكتور نظيف من وزير العدل الاحتكام إلى المحكمة الدستورية العليا في حسم الأمر. وفي نفس اليوم (لاحظ السرعة) وجه الوزير رسالة إلى رئيس المحكمة الدستورية بالمعنى المطلوب.
يوم ۱۸/ ۲ عُرض على هيئة المفوضين تقرير حول ما قيل إنه “خلاف” بين المجلس الخاص والجمعية العمومية لمجلس الدولة. فى ۲۲/ ۲ انعقد المجلس الخاص لمجلس الدولة وصوت ٤ من أعضائه مع الإرجاء، وصوت ٣ لصالح الاستمرار في قبول طلبات التعيين. ولكن ضغوطًا مورست بعد ذلك أدت إلى تغيير المواقف، بحيث أصبح أربعة يؤيدون تعيين النساء وثلاثة صوتوا لصالح الإرجاء.
استشعر مستشارو مجلس الدولة أن هناك اتجاها لتحدى إرادتهم، فتداعوا إلى جمعية عمومية في ۱٠/ ٣ حضرها ۳۱۹ مستشارًا صوت ۳۱۷ منهم لصالح الإرجاء، ورفضه اثنان فقط، أحدهما زوج ابنة رئيس مجلس الدولة. وفى مساء اليوم ذاته (۱۰/ ۳) دعا نادى القضاة إلى جمعية عمومية حضرها ٩٤٤ قاضيًا، صوت ٩٣٤ منهم لصالح الإرجاء. ولكن المحكمة الدستورية أصدرت قرارها في ١٤/ ٣، الذى تبنى موقفًا مناقضًا للرأى الذى أجمع عليه القضاة، وقرر الاستمرار فى تلقى طلبات تعيين النساء، بناء على موافقة المجلس الخاص بمجلس الدولة.
– 4 –
الوقائع المتتالية أكدت أن هناك رغبة عليا لإقرار التعيين، رغم تحفظات القاعدة العريضة من القضاة، وذلك ما يفسر مسارعة وزير العدل إلى إبلاغ رئيس الحكومة بخلاف لم يكن صحيحًا بين المجلس الخاص والجمعية العمومية. ومسارعة رئيس الحكومة بالرد، والركض بعد ذلك نحو المحكمة الدستورية للاستجابة للرغبة العليا. بموازاة ذلك تلاحقت فصول الحملة الأهلية للاحتجاج على الجمعية العمومية لمجلس الدولة، التى قادتها وزيرة القوى العاملة من ناحية، وأمينات المرأة في الحزب الوطنى فى القاهرة والإسكندرية ومحافظات أخرى من ناحية ثانية.. وكانت تلك بادرة طريفة، لأنها المرة الأولى التى تحرك فيها الحكومة والحزب الوطنى حملة احتجاج! بالتوازى مع ذلك أطلقت الأفلام والأبواق الإعلامية فى حملة تشهير بمجلس الدولة والقضاة واتهمتهم بالرجعية والظلامية. وكانت النتيجة أن العملية مثلت عدوانًا صارخًا على استقلال القضاة وحقهم في تنظيم أوضاع مرفق العدالة، شارك فيه وزير العدل ورئيس الحكومة، الذى استغرب القضاة تدخله المباشر فى الموضوع. وكان واضحًا أن السلطة التنفيذية اتخذت موقف التحدى لإرادة القضاة. كما أسفر المشهد عن الإيقاع بين المحكمة الدستورية وبين جماهير القضاة، ناهيك عن الأضرار الأدبية التي ترتبت على حملة التجريح والتشويه الإعلامية التي أهانت القضاة وحطت من قدرهم.
ليس لدى أي تحفظ على تعيين المرأة فى القضاء، ولكن اعتراضى الأساسي ينصب على الأسلوب الذى اتبع والثمن الذى دفع لقاء ذلك. ذلك أننى تمنيت أن يعتمد ذلك الأسلوب على الحوار وليس الإملاء. ولا أعرف لماذا لم يسأل القضاة مثلاً: إذا كنتم تعتبرون أن الظروف غير مواتية لتعيين النساء فى الهيئة القضائية، فكيف يمكن التغلب على تلك الظروف، وما هو الأجل الذي يستغرقه ذلك؟
ورغم أننا اعتدنا مكرهين على الإملاء في مجالات عدة، إلا أنه حين يؤدى إلى العدوان على استقلال السلطة القضائية، فإنه يصبح خطرًا ينبغى درؤه، لأنه يفتح الباب للتلاعب بالحقوق وبالعدالة التى هى صمام الأمان في تحقيق السلم الأهلى. وهى المعركة التي يخوضها القضاة منذ عقدين على الأقل، مؤيدين فى ذلك بالجماعة الوطنية فى مصر. إذ شئت فقل إنها كارثة أن يتم الضغط والعدوان على استقلال القضاء من جانب أى سلطة أو طرف فى الداخل. أما أم الكوارث حقًا فهي أن يكون العدوان استجابة لضغط خارجي.
إن الغيرة على استقلال القضاء والقلق على التدخل فى شئونه سحبًا بعضا من رصيد الحفاوة بتقرير حق المرأة في اعتلاء منصة القضاء، الأمر الذى يعيد إلى أذهاننا الخبر المأثور عن نجاح العملية، ووفاة المريض.
۲۳ مارس ۲۰۱۰
اختلطت الأوراق بعد سجال على صفحات الجرائد وفى أروقة المحاكم واحتجاجات أمام مجلس الدولة ومؤتمرات إعلامية، لم ير معظم الليبراليين ودعاة الديمقراطية أن ما يحدث الآن ما هو إلا تعنت ذكورى سلفى، وليس له علاقة بفرض الحكومة سطوتها على قرار مجلس الدولة برفض تعيين المرأة قاضية كما قيل عندما طلب رئيس مجلس الوزراء تفسيرًا لهذا القرار من المحكمة الدستورية العليا. اعتبر القضاة إن هذا الطلب إخلال بالفصل بين السلطات، ومؤامرة عليهم، وإرهاب فكرى من جانب الذين يدافعون عن حق المرأة فى مساواتها بالرجل، كما اعتبروه شأنا داخليًا، وتم إغفال القضية الأساسية، وهى أن المجلس اتخذ قرارا يتعارض مع الدستور والمواثيق الدولية التي تنص على مساواة الرجل بالمرأة، ويتعارض مع مفهوم المواطنة. لذا لا يجوز اعتبار القرار شأنًا داخليًا أو دفاعًا عن استقلال قرار المجلس مادام يتناقض مع الحقوق التي كفلها الدستور، ومع إقصاء النساء والتمييز بينهن وبين الرجال فى تولى المناصب. ولعل هذه هي المرة الأولى التى يقف فيها المجلس فى مواجهة مباشرة مع منظمات المجتمع المدنى الحقوقية والنسوية.
إن ما يحدث في مصر الآن والذى نجنى ثماره منذ بداية السبعينيات وقبلها نتيجة لتحالف الأصوليات الدينية مع السلطة الحاكمة، يدعونا للتأمل والدهشة في آن واحد.
فالقضية ليست تصويت أعضاء مجلس الدولة ضد مساواة المرأة بالرجل وحقها في تبوأ مناصب متنوعة فى القضاء، إنما هي تغلغل الفكر السلفى فى عصب هذه الأمة، وهو الذي أفرز الأحداث الطائفية والمحاولات المستميتة لفرض الحجاب والنقاب، وتكفير الناس، وإقامة محاكم التفتيش ضد المبدعين والمفكرين، وانتشار الأفكار الغيبية، وتغذية التعصب والتطرف والإرهاب.. الأمر الذى أدى إلى تحالف الفكر الذكورى بقوة مخيفة مع الفكر السلفي، وإعطاء الأفضلية للرجال كفئة مجتمعية مميزة وحاكمة متسلطة.
ألم يحن الأوان للتسلح بالجرأة والشجاعة فى مواجهة هذه المنظومة الذكورية من أجل أن نقلب موازين القوة التى تغذى هذه الأفضلية، وأن نعمل على تقويض المؤسسات الأبوية سواء كانت مؤسسات تربوية، ثقافية، دينية، اقتصادية، والتي ساهمت ومازالت تسهم في خلق وإنتاج وإعادة سيادة ذكورية، وأن نصر على عدم تجزئة القضايا النسوية، وعلى عدم تجزئة الحقوق والحريات. بمعنى آخر إحداث تغير جذرى فى البنى الاجتماعية والسياسية والثقافية السائدة، وتطوير آليات وسياسات ومقاربات تدعم المساواة على الصعيد المؤسساتي والمجتمعي والقانوني.
ما الذى أفضى بنا إلى هذه الأزمة؟ ما الذى جعل أصدقاء الأمس أعداء اليوم، ما الذي جعل النساء “شقائق الرجال” يصبحن مخلوقات ناقصات الأهلية يجب فرض الوصاية عليهن؟ وهن اللواتي لم يمانع القضاة حين وقفن معهم فى حركتهم المطلبية باستقلال القضاء؟ ما الذي جعل قضية تولى المرأة منصب القضاء تنتج خطابًا طائفيًا عنصريًا يستقر فى النسق الذهني العام ويغذى التمييز؟
لا يمكن فهم التمييز الجنسى بمعزل عن السياق التاريخى والتشكيل الاجتماعي والصور والمعاني والرؤى الثقافية التي تؤدى إلى خضوع المرأة وانحسارها أمام المد الذكوري الذي يلاحقها كلعنة، في المنزل والمدرسة والعمل والزواج والحياة العامة. لعنة تتبدى فيما تتعرض له النساء من إجحاف كمواطنات على المستويات نتيجة أن الرجال فى أى موقع يتمركزون حول ذكورتهم التي تغذيها فكرة أن المرأة مخلوق أدنى وضعيف وقاصر، تباع وتشترى ويفرض عليها الوصاية وفقًا للفهم الخاطئ لهذا القصور. فثقافتنا العربية تجاه المرأة هى ثقافة محافظة ومكبوتة تقوم على البراجماتية وعلى أخلاق سياسية أصولية وسلفية.
هذه الثقافة التى تخضع الرجل والمرأة لترسيمات ثقافية واجتماعية تنمط أدوارهما ووظائفها وعلاقاتها بمعزل عن رغباتهما الحقيقية، وتفرض توقعات لهذه الأدوار ضمن منظومة من الأحكام القيمية، تجعل العلاقة بين الجنسين تتسم بحركة زمنية نكوصية، تثبت الماضى وتتمرغ في تقاليده. يصبح فيها الرجل مركز الحركة والكون وبؤرة الفاعلية، ولا تكتسب فاعلية المرأة في الحياة العامة إلا من خلال فاعلية الرجل، مما يفرض حواجز تعمل على تغييب العقل وتحول المعرفة والتطور فى العلاقات الإنسانية بين الجنسين إلى أيديولوجية تنغلق معانيها على الذكور فقط، ويظل حصر المرأة فى إطار المنزل والحفاظ على الأسرة، هي الشماعة التي تعلق عليها كل الحجج التي تقصى النساء من أن يصبحن كائنات فاعلة لا ترتبط مشاركتهن بمشاركة الرجال أو مساواتهن بالرجال، بل كون المرأة كائنًا إنسانيًا مثل الرجل تمامًا لا يجب الفصل بينهما.
إننا لا يمكن أن نحدث أى تغيير عضوى فى الثقافة دون إحداث تغيير جذري في الأدوار والعلاقات الاجتماعية بين الجنسين، دون أن نحدث تغييرًا جذريًا فى الأفكار والآداب والنصوص والثقافة الشعبية وفى الضمير الجمعي. ولن يتأتى ذلك أيضًا بدون أن نتخلى عن الموقف الاعتذارى بالقول إننا لن ننتقص من الرجال امتيازاتهم وسلطتهم عندما نطالب بحقوق المرأة. بل يجب أن نسحب هذه السلطة وهذه القوة ونعيد توزيعها بالتساوى بين الجنسين.
إن الطائفية والعنصرية والتعصب فى تفش مستمر، وإذا لم يتم محاصرتهما وتفتيتهما بأسرع وسيلة فسوف تتنامى وتنتشر آفاتهم لتأكل اليابس والأخضر. فالخطر كل الخطر يكمن من الداخل من جانب المحافظين والأصوليين والرافضين لرياح التغيير.
إن الأزمات والهزائم والهوان والتبعية التى يمر بها الوطن باتت تنعكس تضخمًا في الأنا السلفية الذكورية، ويخطئ من يتصور أن عبور هذه الهزائم على أجساد النساء والانتقاص من حقوقهن الإنسانية هو بر الأمان للشعور بالانتماء والهوية. فهذه المصائب والهزائم يجب أن توحدنا رجالاً ونساء، وأن نقتسم أعباءها ونناضل فى سبيل أن تتحول إلى نصر يحمل راياته كل من الجنسين بكبرياء وشموخ كشركاء وليسوا فرقاء، حتى ينجلى الليل ويسفر عن وجهه الصباح ونفيق من هذا العرس الذكورى ومن هذه الفوضى الرجولية. إن التغيير لن يحدث بدون النساء كشقائق الرجال.
دعونا لا نفر في فراغ مراوغ يسكنا بالقلق والتوجس، ونصيخ السمع لوقع خطانا التي نجرجرها ونتعثر بها في ظلمات السلفية، لعلنا نجد دربًا مضيئًا يعيننا على تحمل هذا الليل الثقيل الذي يجسم على قلوبنا وأرواحنا ويجعلنا نحيد عن الصواب ونهدم الحد الفاصل بين الأبيض والأسود، بين الحريق والرماد ونصبح نسيًا منسيًا
۲۰ مارس ۲۰۱۰
القرار الذي اتخذته المحكمة الدستورية العليا بشأن تعيين المرأة في مناصب القضاء بمجلس الدولة، لم يضف جديدًا إلى الوضع الذى كان قائمًا قبل أن تبادر الدولة بالطلب الذي تقدم به الدكتور نظيف رئيس الوزراء للفصل فيما توهمته الحكومة من التباس في تفسير بعض مواد القانون المتعلقة باختصاصات المجلس.
عادت المشكلة إلى نقطة الصفر فيما يتعلق باختصاصات التعيين بصفة عامة وتعيين المرأة بصفة خاصة. وبدا وكأن الحكومة أرادت أن تبرهن على انتصارها في معركة محسومة سلفًا على ما سماه البعض الاتجاهات الذكورية في مؤسسة قضائية مهمة مثل مجلس الدولة.. باعتباره آخر المعاقل التى تقتحمها المرأة في مسيرتها نحو مناصب الدولة العليا.
وطبقًا للقرار الذى أصدرته المحكمة الدستورية، فلم يكن هناك في الأصل خلاف على أن كلمة “مصري” في القانون تعنى الرجل والمرأة على حد سواء. كما أنه لا خلاف على أن المجلس الخاص بمجلس الدولة هو المنوط به تعيين الأعضاء الجدد. واتضح أنه لم يكن هناك خلاف بين المجلس الخاص والجمعية العمومية على إرجاء إجراءات تعيين المرأة إلى حين تهيئة الأجواء المناسبة ولمزيد من البحث والدراسة. وبعبارة أخرى فإن كل ما أكده قرار المحكمة الدستورية هو أن الجمعية العمومية ليست هي جهة الاختصاص.
وفي الوقت نفسه فقد ترك للمجلس الخاص حقه فى اتخاذ ما يراه من قرار فى هذا الشأن. الموضوع كله إذن كان زوبعة فى فنجان. ولن تجدى فى تمكين المرأة من حقوقها ضغوط مصطنعة، وافتعال معارك ليس لها ما يبررها. وقد بدت الحكومة في هذه المسألة مدفوعة لافتعال صدام بين مؤسستين قضائيتين دون مبرر.
والواقع أن المسألة لم تعد فى حصول المرأة على مزيد من الحقوق والامتيازات، بل في قدرتها على إثبات وجودها والدفاع بنفسها عن هذه الحقوق، دون حاجة إلى الاختفاء وراء سلطة عليا في النظام أو الاحتماء بنفوذها.
لقد قطعت الدولة شوطًا بعيدًا فى تعديل القوانين والتشريعات التي تضمن للمرأة كثيرًا من حقوقها التي حرمت منها. ولكن يبقى أن تناضل المرأة بنفسها وبما تملكه من ذكاء وطموح وقدرة على المنافسة لبلوغ ما عجزت عن بلوغه حتى الآن.
وقد كنت ومازلت شخصيًا من المعارضين لتخصيص “كوتة” للمرأة في البرلمان، تحصل عليها دون أدنى جهد، إلا بقدر قربها وانصياعها لأصحاب النفوذ في الحزب الحاكم، أو في غيره، وليس عن طريق أصوات الناخبين. وكان الأجدر أن يكون “التمييز” لها عن طريق نظام القائمة النسبية الذى يحدد لها مكانًا على قائمة المنافسة بين المرشحين.
ويتحتم عليها فى هذه الحالة أن تخوض المعارك الانتخابية وسط الجماهير وتثبت قدرتها على الدفاع عن مصالحها.
إن نظام “الكوتة” فى مجلس الشعب يقدم لها مكانًا على طبق من فضة، أى بدون جهد أو كفاح أو خوض لمعارك انتخابية كالتي يخوضها الرجل. وصاحب الكلمة الأخيرة في هذا هو حزب الأغلبية الذي يتحكم في كل شيء!!
من الواضح أن المرأة فى مصر بحاجة من يقف بجانبها. وليس من يقف وراءها أو أمامها. فهؤلاء هم المنتفعون بها ومنها.
۱۷ مارس ۲۰۱۰
قرأت باهتمام شديد مقال الكاتب الكبير الأستاذ/ سلامة أحمد سلامة بجريدة “الشروق” العدد الصادر بتاريخ 17/ 3/ 2010 فى التعليق على أزمة تعيين القاضيات بمجلس الدولة، والتي اعتبرها سيادته “مجرد زوبعة فى فنجان” وأن الحكومة تحاول من خلالها الوقيعة بين الهيئات القضائية، وأن المرأة عليها إثبات وجودها والدفاع بنفسها عن هذه الحقوق بدلاً من الضغوط المصطنعة وافتعال معارك ليس لها ما يبررها.
ولأن الأمر يستحق وضع كثير من النقاط فوق الحروف، فإن هناك ضرورة لوضع الأزمة في نصابها وليس التهوين من شأنها، ومن ثم استخلاص ما بداخلها جليًا لأنه مهم لوطن في لحظات حرجة وحاسمة، وهو ما يأذن لى بإبداء بعض الملاحظات:
أولاً: أن ما فجر الأزمة هو اجتماع الجمعية العمومية لمجلس الدولة للاستفتاء على حق دستورى للمرأة يتعلق بأصل الحق ذاته فى وظيفة عامة يجب أن تمارسها وفقًا للحقوق الدستورية في المساواة أمام القانون والمواطنة وتكافؤ الفرص، ولأن الأمر لم يكن إرجاء وإنما رفض، اعتبرته الجمعية العمومية قرارًا ملزمًا بغير اختصاص أسفر عن تراجع المختص “لمجلس الخاص” فيما كان قد بدأه من إجراءات، ومن ثم فإن جوهر الأزمة يتجلى فى سؤال واضح ومحدد هو هل يجوز لأى هيئة أو سلطة فى المجتمع الاستفتاء على حق دستورى لفئة أو جماعة من المواطنين؟ سواء في اختصاصها أو خارج اختصاصها المنوط بها قانونا؟
إن الإجابة عن هذا السؤال المهم تمنع أن يتكرر الأمر فى حقوق دستورية أخرى قد تكون واردة فيما هو أخطر وأفدح داخل مجلس الدولة أو خارجه يرد فيه المجتمع لنقطة الصفر في أي لحظة يراها البعض.
ثانيا: أن هذه الأزمة تجلى فيها الخلط الشديد بين مفهوم “استقلال القضاء” والاستقلال بالقضاء لأن الأول هو أحد أعمدة الدولة القانونية الحديثة الخاضعة للدستور والقانون والثاني هو انتهاك للأدوار المؤسسية الخاضعة للدستور والقانون وقد بدا الأمر خطيرًا في تصور أن يكون الخلاف الفكري والثقافى لدى غالبية قضاة مجلس الدولة فيما يتصل بتقييم الملاءمة لعمل المرأة في الوظائف القضائية بالمجلس تغليبًا للبعد الثقافى الذاتي على إعمال قواعد الدستور والقانون، في حين أن مجلس الدولة هو قضاء مشروعية وليس قضاء ملاءمة والقاضي ملزم بتطبيق القانون والدستور حتى لو كان ذلك مخالفًا لرأيه الشخصي، خصوصًا أن قرار الجمعية العمومية بالرفض سواء كان مسببًا بمخالفة الشريعة أو القانون أو ملاءمة لظروف العمل كان يحمل في طياته تجاوزا في أحكام مجلس الدولة المتكررة من تأكيد عدم وجود موانع شرعية أو قانونية تحول بين المرأة وتولى الوظائف القضائية!
ثالثًا: تجلى أيضًا في إطار الأزمة أن هناك خلطًا بين ممارسة الاستقلال داخل الهيئات القضائية في إدارة شئونها، وبين وجود شئون مشتركة لسلطة القضاء لا يجوز لأحدها أن تنفرد بوضع قواعدها وفقًا للمادة “۱۷۳” من الدستور ومنها “الملاءمة المجتمعية” لتعيين المرأة في القضاء والتي حسمت بقرار جماعي شارك فيه مجلس الدولة باعتبارها شأن مشترك بقرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية سنة ۲۰۰۲ وتولت بعده المرأة قضاء الحكم في الدستورية والقضاء العادي وهو ما لا يمنح مجلس الدولة الحق في وضع ملاءمة خاصة به فى “إعمال أصل الحق” وإنما إعمال الملاءمة في قبول الأفضل من الجنسين بمعايير موحدة وفقًا لنطاقه القانوني الخاص وترتيباته المنظمة.
رابعًا: تجلى في إطار الأزمة أيضًا أن هناك خلل فى فهم الفروق بين المبدأ الدستورى للفصل بين السلطات والرقابة المتبادلة بين السلطات، فلم يكن الخلاف مفتعلاً كما رأه البعض، وإنما خلاف حقيقى أدى إلى ارتباك فعلى فى ممارسة اختصاصات قانونية ودستورية داخل الهيئة القضائية الجليلة “مجلس الدولة” وهو ما برر استنهاض اختصاص أصيل للمحكمة الدستورية العليا مقرر في الدستور “م ١٧٥” والقانون “المادة ٢٦” وهو التصدى لطلب التفسير المحال إليها من الجهات المختصة، وقد سبق للمحكمة ممارسة هذا الاختصاص فى قضايا كثيرة سابقة البعض منها كان يخص مجلس الدولة ذاته فى أداء دوره القضائي، وقد صدر قرارها في التفسير في مواجهة ما ارتبك في ممارسة الاختصاصات داخل الهيئة ولا يمكن اعتبار ذلك افتعال بصدام بين مؤسستين قضائيتين لأن كلتاهما يخضعان لنصوص واختصاصات دستورية وقانونية في ممارسة التزاماتهم تجاه مجتمع بأكمله وما كان للسلطة التنفيذية أن تحرك هذا الاختصاص الأصيل للمحكمة الدستورية العليا لولا وجود الخلاف في تطبيق نصوص القانون وإرباك الهيئة من خلال هذا التداخل فى ممارسة الاختصاصات وتداعياته مجتمعيا بما لا يمكن معه اعتبار أن كل منهما مستقلة فى مواجهة الأخرى وإنما هي مستقلة في ممارسة اختصاصها الدستورى والقانوني..
خامسًا: أما الحديث عن المرأة ومن يقف بجانبها أو وراءها أو أمامها من المنتفعين وغير المنتفعين فإن القلوب لمحزونة لأن يسقط من نضال المرأة المصرية ٧٠ عامًا من أجل تولى وظائف القضاء بعد أن عملت بالقانون في جميع مجالاته لمدة قرن من الزمان أحاطت فيها بالقاضى الجالس من كل الجبهات فى المحاماة وتدريس القانون وهيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة وقطاعي الطب الشرعى وخبراء وزارة العدل، وظل نضالها وكفاحها لأجيال أسبق من كل من حاول مساندتها في هذا الحق سواء كان مجلسًا قوميًا أو حكوميًا أو أهليًا، ولعلها القضية الأخطر في الأمر أن يتصور بعض من يختلفون مع سياسات حكومة أو نظام أن يكون لتبنى هذه الجهات بعض المطالب المشروعة لفئات الشعب المصرى مدعاة لمخاصمة هذه الحقوق ذاتها نكاية فيمن يختلفون معهم أو عليهم، فيبدو الأمر شبيها بمن أراد أن يغيظ وجهة فقطع أنفه !!
نعم لم يحسم مجلس الدولة أمر تعيين المرأة فى الوظائف القضائية بانحياز جلى لإعمال صحيح الدستور والقانون حتى الآن، وقد يتأخر ذلك أو يتقدم.
لكن تبقى الأزمة كاشفة وليست منشئة لعمق تجليات الأزمة الشاملة ثقافيًا ودستوريًا في المجتمع المصرى.
۲۳ مارس ۲۰۱۰
د. إبراهيم على صالح
إن أحداً لا ينازع أن القضاء المصري هو الجبل الشامخ والطود الراسخ.. الحصن الحصين الباقي.. الواقي سياجًا للحريات وصون حقوق المواطن من بطش السلطة أو سطوة رأس المال وتوحشه وقلب التركيب الاجتماعي رأساً على عقب. وبلوغاً لتأمين رسالته فإن الدساتير جميعها التي تحترم كرامة الإنسان تعارفت.. أجمعت على الحرص على كفالة استقلال القضاء وحصانة رجاله التزاماً واحتراماً، لهذا نصت المادة ١٦٦ “القضاء مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأي سلطة التدخل في القضايا أو في شئون العدالة” والمادة ١٦٨ “القضاة غير قابلين للعزل وينظم القانون مساءلتهم تأديبيًا“.
وإذا كان النظام الدستوري المصري عماده و ركازه وسناده هو الفصل بين السلطات الثلاث “التشريعية والتنفيذية والقضائية“، إلا أن طبيعة الأنظمة البرلمانية – لو صح اعتبار النظام المصري أنه برلماني الهوية – تجعل من السلطة التشريعية رقيبًا وحسيبًا على السلطة التنفيذية وتشل يدها عن الاقتراب من السلطة القضائية، بل إن هذه الأخيرة هي التي تحاسب وتراقب وتحكم وتحاكم من يتردي من أعضاء السلطة التشريعية فى مخالفة للقانون، بل إن الشرعية لا تكتمل العضوية البرلمان إذا ما طعن بالعبث في العملية الانتخابية، إلا بعد أن تقول محكمة النقض كلمتها التي لا ترد عن سلامة أو فساد العضوية.
بيد أنه ما يستلفت النظر ويشد البصر أنه في الخمس السنوات الأخيرة برزت علي السطح بعض المؤشرات تشي بالرغبة في اختزال أو استبعاد الرقابة القضائية أو قص ريشها مثل ما جري لدورها في الانتخابات البرلمانية وألا تجري تحت رقابة القضاء على الصناديق الانتخابية.
ولعل أبرز مثل ومثال يتجلي فيما نصت المادة ١٦٦ من الدستور “ولا يجوز لأي سلطة التدخل في القضايا أو في شئون العدالة“، فإنه في شأن تحديد الصلاحية للجلوس على منصة القضاء ومن الأحق بالجلوس عليها وهي جوهر شئون العدالة، إلا أنه استجابة لتيار واسترضاء لشعارات ترفعها جهة لا يرد لها قول وظهرت بدعه حق المرأة أن تركب كرسي القضاء، وأن القول بغير ذلك هو تفرقة بغير فارق وتمييز لجنس على آخر دون مميز.
وهي لب وقلب المشكلة القائمة في واحدة من قمم جهات القضاء هي حبة في عنقود الفاكهة المرة واستناداً إلى حجج هابطة.. حابطة.. ساقطة، بل عدوان علي محارم الدستور والقانون وسبيله هو التحايل على النصوص والعنف والتعسف في تفسيرها وتأويلها.. بل قل إنها من المضحكات المبكيات.. ذلك لأن السلطة التنفيذية التي تمثلت في رئيس الحكومة الرجوع إلى المحكمة الدستورية العليا في شأن الخلف الذي ثار من الجمعية العمومية للمجلس بأغلبية ٨٩% والمجلس الخاص بأغلبية أربعة أصوات من مجموعها السبعة وحالة أن تلك الغلبة وقفت عند حد الإرجاء وليس الرفض والإباء.
ويا للهول.. ويا لخيبة الأمل.. ذلك أن المحكمة الدستورية العليا قمة القضاء ودرة وتاج رأس القضاء وقبلة العدالة وبابها مفتوح على مصراعيه.. رسالتها.. وسبب وجودها أو كما يعبر عنه في القضاء والفقة الفرنسي RAISON DETRE يدور وجوداً وعدمًا مع النص الدستوري في المادة 175 “تتولي المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية علي دستورية القوانين واللوائح، وتتولي تفسير النصوص التشريعية، وذلك كله على الوجه المبين في القانون“، وأنه ولئن كان وجه الرأي فيما ذهبت إليه المحكمة الدستورية العليا، فإنه وبرغم أن اختصاصها مقصور علي تفسير النصوص التشريعية حسبما يتضح من القاعدة الأصولية بأنه لا يجوز تفسير نصوص القانون إذا كانت تعبر عن إرادة المشرع ولا يصح لأي جهة قضائية مهما علا قدرها وسما شأنها تحميل النص ما لا يحتمل أو مخالفة الغاية من التشريع.. ولعله من الجلي الواضح أن قراري مجلس الدولة سالفي البيان في شأن إرجاء نظر تعيين المرأة لا يعتبر من قبيل التشريع الذي يصح تفسيره، بل هو شأن داخلي بحت وقرار ولائي.. تنظيمي الطبيعة.. إداري الهوية مما يتأبي عن التفسير ومما ينحسر عنه اختصاص المحكمة العليا.
تري هل وقف الأمر عند هذا الحد
إنه من المضحكات المبكيات أنه طرح هذا الموضوع في مجلس الشعب فإن اجتهادات المجتهدين وتفسيرات المفسرين ومستجدات المجددين أن ما ورد في عدد من النصوص الخاصة بقانون السلطة القضائية عن لفظ “رجال القضاء” فإنه يستبدل بلفظ “أعضاء القضاء” وبذلك يسقط لفظ “رجال” وتتفتح أبواب الجنة للمرأة وجميع النساء.
ويا ليت الذين أجهدوا أنفسهم في البحث والدراسة اتجهت أبصارهم إلى الفساد الذي عم البلاد، أو كما قال الدكتور زكريا عزمي “بلغ حد الركب” أو إلى ما يواجهه المجتمع من آفات الغلاء وتدني دخول الفقراء الذين تصاعدت نسبتهم إلى ٤٠% من الشعب المصري دون حد الفقر أو إلى الديون التي تصاعدت إلى ٩٤١ مليار جنيهًا أو إلى الإضرابات والتظاهرات والاعتصامات والإضراب عن الطعام والمبيت على أرصفة مجلس الوزراء ومجلس الشعب.. أو إلى تدني موقف الريادة والقيادة لمصر وفقدانها ما كانت تحظي به من تقدير وتوقير على الصعيد العربي والعالمي على السواء أو حتى إلى الأزمات الداخلية والشوارع التي باتت الزبالة فيها تشكل تلالا.. أو إلى اليأس والإحباط لملايين المؤهلين الذين فقدوا الأمل في الوصول أو الحصول على عمل وفضلوا الانتحار في البحر الأبيض المتوسط بالسفن، بل قل القوارب التي كانوا يستقلونها لتهبط بهم علي أي شط أو ساحل أوروبي.
يا أيها السادة
تعالوا بنا نفتش.. نبحث.. ننقب عن حلول للأزمات التي تعصف بمصر.. إنه بركان يزمجر.. يصرخ وينذر ويحذر وإذا ما انفجر فالله وحده يعلم المصير والمستقر، وهو على أي لا يبشر بخير، بل العكس تماماً فإن ما يحيط بنا من جميع المواضع والمواقع أنه تتربص الكارثة بمصر وهي قاب قوسين أو أدني.. وأنه لمن المحزن أن الشعب يتساءل: هل استقر القرار على الضبعة مكانا للمشروعات النووية ؟.. بل إن الشعب يتساءل هل توجد في مصر حكومة وأين هي؟.. وأين سطوة الدولة.. هيبتها.. كرامتها.. عزتها؟ ولسنا نجد أوفي علي الغاية مما قاله نابليون في منفاه بسانت هيلينا أنه لم يجد في العالم كله بلداً يحتاج إلى دولة قوية على ما هو الحال بامتياز مثل مصر.
جريدة الدستور