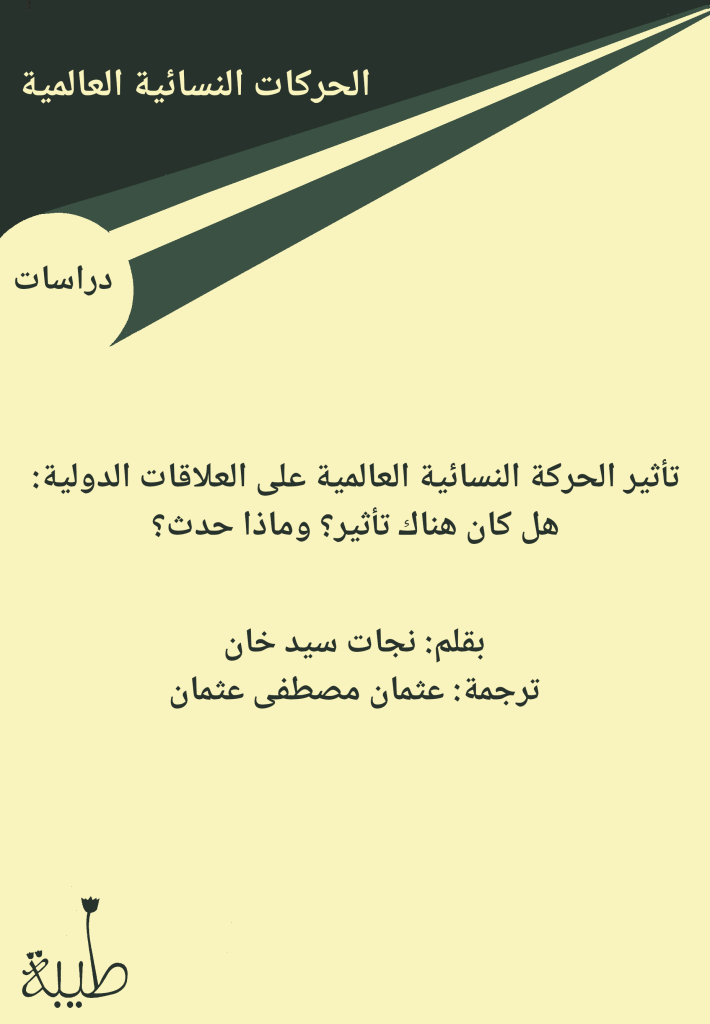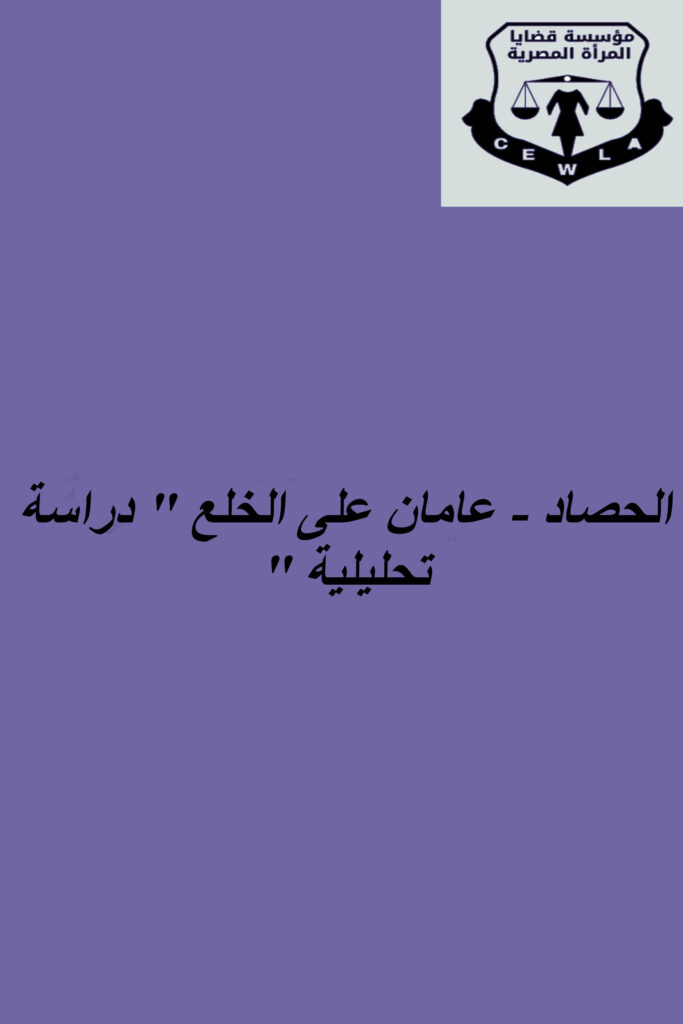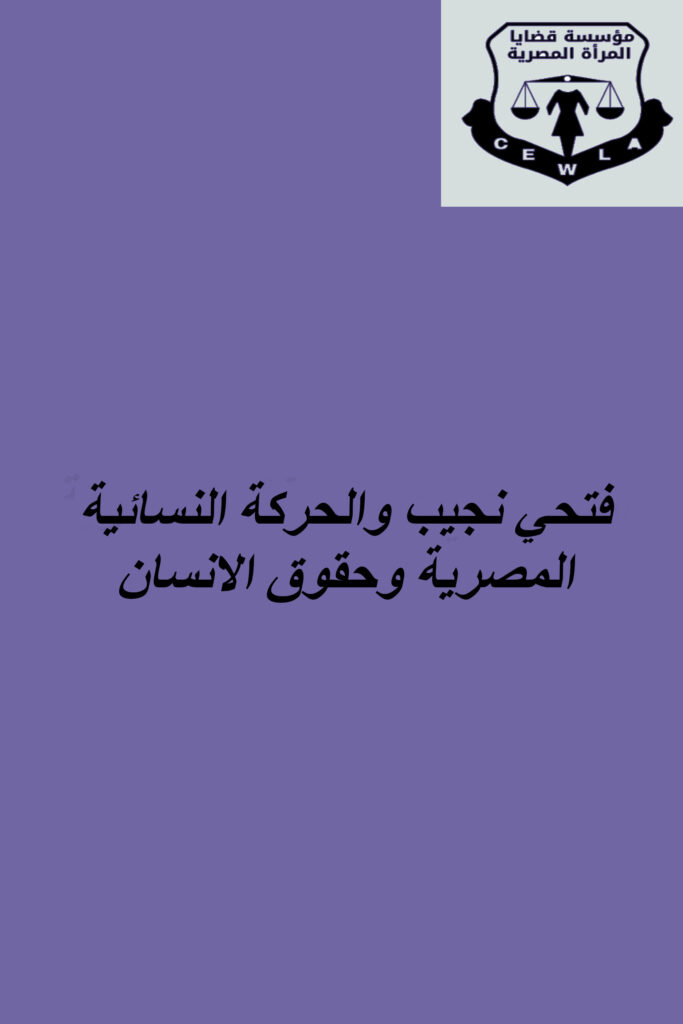تأثير الحركة النسائية العالمية على العلاقات الدولية:
هل كان هناك تأثير؟ وماذا حدث؟
طلب إلى محررو هذا الكتاب (*) تأمل تأثير نشاط الحركة النسائية على العلاقات والسياسات الدولية. وأود، بادئ ذي بدء، أن أعرب عن شعوري بالتشريف لأنهم اعتبروني «خبيرة» (كما وصفتنى الدعوة) في النظرية النسوية والسياسية. بيد أن هذا التشريف أثار رهبتي أيضًا؛ فقد توفرت على النشاط النسوى والعمل الأكاديمي جل حياتي، وكنت مدفوعة في ذلك بالتزام عاطفی مبعثه غضب شخصي بحت ومقاومة غريزية لكل أشكال القمع. وقد هبت الموضوع أيضًا لأننى، بالرغم من نشاطى على الجبهتين وعلى المستويين القومي والعالمي، فإنني لم أتوقف للتفكير في ما إذا كان لكل ما قمنا به– کنسويات ومدافعات عن حقوق النساء وأكاديميات– تأثير على العلاقات الدولية، والتي أفهمها على أنها «العلاقات بين الدول». لو كان هناك تأثير قد حدث بالفعل، فإن ذلك يعني عندي أن يكون العالم أكثر عدلاً وإنصافًا، وهو ما لم يحدث بعد! وبالرغم من ذلك، فقد طربت لدفعي إلى التفكير في هذه القضية، لأعاود معايشة، أو تذكر لحظات في حياتي كانت ملأى بالحركة والطاقة، كما حفلت بالإثارة والمصاحبة لفتح الحركات الاجتماعية والسياسية لأرض ومساحات جديدة، وللاتساع بالخيارات المتاحة أمام الناس، وبالحلم بعالم جديد والإيمان بأنه عالم قريب نكاد نلمسه بأيدينا.
أنا بنت حركة الستينيات، وهي فترة، ونضال، وزمان، تميزت بالحيوية والدينامية والنشاط السياسي؛ استغرقتنا حتى أن بعضنا لم يستطع بعد أن يتحرك خارج الأطر، ولا نعتقد أن علينا أن نخرج عن تلك الأطر لأن طاقتها دفعت العقود الثلاثة التالية قدمًا، وكثير مما أنجزناه اليوم نتيجة لها. ولكن بعد ثلاثة عقود، هناك حاجة ماسة لاستعراض ما مضى والبناء على تلك الشهادة وإثراء الحاضر من أجل مستقبل أكثر دينامية وأكثر انخراطًا في السياسة. وبالرغم من أن ذلك ينطبق على كل الحركات التي سعت للتعبير عن مصالح المقموعين والمستغلين، فإنني مهتمة هنا بحركة النساء، وبالنسوية على وجه التحديد. ومما يدل على حاجتنا لمثل هذا الاستعراض، حقيقة تتمثل في أن الحركة النسائية، بالرغم من احتفالها بكيانها وبمنجزاتها، كما فعلت في مؤتمر الأمم المتحدة بكين + 5 في نيويورك في يونيو 2000، فهناك فراغ في الحركة، وخواء وإحباط، بل ويأس، وهي مشاعر عادة ما تظهر في شكل إجهاد أو نفاذ قوة (أو حتى ملل)، يشعر به جيلي الذي «وصل»، كما قد تظهر لدى الأجيال الأصغر منى في صورة إحساس بأنه لم يعد هناك ما نحارب من أجله (أو رؤية أن النضال لا يستحق العناء).
في مؤتمر بكين + 5 لم يسعني إلا أن ألاحظ التناقضات العديدة التي نتصارع معها بشكل يومي والتي كانت تترامى إلى مسامعي أينما ذهبت وأيًا من كان أسأل. فهناك، من ناحية، من يرى أن الحركة النسائية قد «نجحت»، حيث سمح للنساء بدخول أروقة الحكومات والأمم المتحدة – بالرغم من أن ذلك يتم بشكل انتقائي. ومع ذلك كنت أسمع باستمرار نغمة أنه لم تعد هناك حركة نسائية. في نفس الوقت، وبالرغم من وجود وثيقة يفترض أنها صدرت بالإجماع ووافقت عليها، بشكل أو بآخر نساء من كل بلداننا، وعملنا معا لوضعها، فإن الانقسام بين الشمال والجنوب تكرس، وهناك على ما يبدو تفهم وإحساس أقل من جانب المرأة البيضاء في الشمال [اتجاه قرينتها في الجنوب]. ومما كان ملموسًا للغاية في مؤتمر بكين + 5 أيضًا أن الحركة النسائية العالمية تمثلت العالم الأحادي القطب كما تُعرفه الولايات المتحدة وأوروبا وتصوير الإسلام ووضعه كـ «آخر» جديد– قوة «أحادية التفكير»، و«بربرية» و «شريرة» حلت محل الشيوعية كـ «عدو» جديد. يحدث ذلك دون الرجوع إلى حقيقة أن هناك تنوعًا هائلاً داخل ما يسمى بالعالم الإسلامي، بل وحقيقة أن الأصولية الإسلامية بشكلها الحالي خلقتها الولايات المتحدة وأوروبا لأغراضها الجيوبوليتيكية الخاصة– تحديدًا محاربة الاتحاد السوفييتي في أفغانستان. ومن بين ما كان شديد الوضوح في نيويورك أيضًا، أن الحركة النسائية، أو الجماعات والشبكات النسائية – لو تبنينا رؤية أن الحركة لم يعد لها وجود– قبلت بالموقف الأكثر محافظة والمتمثل في «الإصلاح من داخل النظام»، مع تزايد عدم تحديها للنظام نفسه. وربما يكون من المناسب الآن أن نستعرض العقود القليلة الماضية لنرى ما حدث، والاتجاه الذي ينبغي علينا التحرك فيه إن لم نرض عما حدث.
إن الحركة النسائية في الستينيات وأوائل السبعينيات هي التي فرضت ضغوطًا على الأمم المتحدة لتعقد أول مؤتمر للمرأة في المكسيك سنة 1975. كانت المشكلة آنذاك، ولا زالت حتى اليوم، أن التنمية لا تخاطب النساء وأن سياسة «النقر المستمر» لم تُجد نفعًا. ثم أعلن العقد التالي عقدًا للمرأة، على أساس افتراض أن التنمية سوف تخاطب النساء تحديدًا. ثم كان على المؤتمر الذي عقد في نيروبي سنة 1985 أن يقيم إدخال وتنفيذ الأمم المتحدة والحكومات المنفردة للاتفاقيات التي أبرمت سنة 1975. على أن مؤتمر نيروبي مثل لنساء الحركة التئامًا لحركتهم، يعبر الحدود والانقسامات، التئامًا في حركة نسائية دولية تسعى للحصول على فهم الآخرين وعقد تحالفات سياسية وتحديد مجالات نضالنا داخليًا. ولم تكترث غالبيتنا بمؤتمر الأمم المتحدة. إذ إننا كنا على انتقاد لم يقتصر على دولنا القومية وعلاقاتها البينية أو افتقادها لتلك العلاقات، بل تعداه لانتقاد الأمم المتحدة نفسها.
كان من المفترض أن تمثل نيروبي نقطة تحول للحركة النسائية الدولية، بيد أن تغيرات كثيرة طرأت في السنوات التي فصلت عام 1985 عن عام 1995؛ فالحركة نفسها تحديدًا، وباسم «الانخراط في الاتجاه السائد» تم احتواؤها وترويضها. وعلى عاتقنا نحن كنساء تقع مسؤولية بعض ذلك، حيث إننا انقدنا إلى فكرة «الانخراط في التيار السائد» وأن نصبح جزءاً من النظام السياسي والاقتصادي والأيديولوجي الجديد. على أننا وقفنا أيضًا في وجه قوى جعلت تحدى حركة واحدة للنظام بأسره وحدها أمرًا مستحيلاً، خاصة لو كانت تلك الحركة تتحدى الأبوية المتأصلة في كل الحركات الأخرى وتواجه القمع والاستغلال في المجال الخاص بشكل مباشر أيضًا. إن الشعوب وحركات الشعوب هي التي صنعت التاريخ، فالشعوب تدفع التاريخ قدمًا بمواجهتها للأوضاع القائمة. ولم يصنع التاريخ أبدًا من خلال «التواطؤ» أو الدخول في «شراكة» مع الباغي أو بتكوين «لوبي». إن مصطلح «لوبي» وعملية تكوينه قد تثير اضطرابًا شديدًا لدينا. فهذا المصطلح يرجع للنظام السياسي الأمريكي الذي تدفع فيه جماعات المصالح الأموال لذوى النفوذ حتى يتواجدوا في أبهاء [جمع بهو: «لوبي» بالإنجليزية] مؤسسات السلطة ليدافعوا عن مصالحها. وللأسف الشديد فقد اتخذت الناشطات الاجتماعيات هذا المنحى الشديد التأصل في النظام السياسي الأمريكي، وهو ما كان يحدث على حساب استبعاد كل أشكال النشاط السياسي الأخرى في كثير من الأحيان.
ومما يثير العجب عندي أننا نتوقع الحل من الدولة والمؤسسات العالمية (بما فيه الأمم المتحدة) والقوى الأبوية الأخرى، بالرغم من أننا قد نرى فيها الفئة الباغية والسؤال هو: هل لا زلنا متمسكين بهذا النقد للأبوية أو الدولة أو الأمم المتحدة، أن اهتمامنا منصب الآن فقط على الاندماج في النظام؟ إننا بالتأكيد جزء من النظام كأكاديميين وكمنظمات غير حكومية وكنشطاء اجتماعيين مدفوعي الأجر نعتمد على موارد تأتينا من نفس هذه المؤسسات والدول القومية، ونسير على أجندة مقررة بالفعل وفي حيز رسم لنا.
وحتى أوضح كيف أن العمل داخل النظام يغير من مواقفنا بل ومن استراتيجياتنا، سوف أشير بإيجاز إلى تجربتنا في آسيا في التحول عن مواقفنا السابقة في الحركة النسائية، لأبين كيف أن تلك المواقف غيرت منها سياسات الدول القومية، والجنوب والشمال، والعلاقات الدولية على مستوى العالم. التقينا في مانيلا سنة 1993، بوصفنا نساء آسيا والمحيط الهادي، لنصوغ المواقف التي سنتخذها في بكين سنة 1995. وبالنظر إلى نوعية التنمية التي مررنا بها في العديد من البلدان الآسيوية، كان لدينا انتقاد شديد لدولنا القومية وللمنظمة وللسياسات والاقتصاد العالميين وللعالم أحادي القطب الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة. وذهبنا إلى المؤتمر بين – الحكومي في جاكارتا سنة 1994 متبنين هذا الموقف. إن منطقة آسيا والمحيط الهادي، كما تعرفها الأمم المتحدة، ليست فريدة فقط، ولكن لها أيضًا خصوصيتها. ففيها أفقر بلدان الجنوب، ولكنها ذلك مع تضم الشمال أيضا، ممثلاً تحديدًا في اليابان وأستراليا ونيوزيلندا، وليزداد الأمر سوءاً من جوانب عديدة، فهي تضم أيضًا الولايات المتحدة وفرنسا بوصفهما قوتين استعماريتين لا تزالان متواجدتين في المنطقة! وبخلاف تلك الأطراف، تتمتع بريطانيا وهولندا بوضع المراقب بوصفهما قوتين استعماريتين سابقتين، وهناك أيضًا الفاتيكان المتواجد دائمًا كممثل للعالم الكاثوليكي. وبالرغم من بعض مشاكل لنا مع حكوماتنا في بلدان الجنوب في المنطقة، فإنك تستطيع أن تتخيل أن المواقف المتعلقة بالاقتصاد العالمي والسياسة العالمية وتقرير المصير، إلخ، ضعفت كثيراً بوجود دول الشمال في المنطقة. وجرى إضعافها على نحو أكبر في اجتماع اللجنة التحضيرية الذي عقد في نيويورك سنة 1995، حيث كانت هناك محاولة لحمل المواقف الإقليمية جمعاء على الاتفاق على وثيقة إجماع عالمية. وقد نجح الشمال، حد بعيد، في فرض هيمنته السياسية والاقتصادية والأيديولوجية. ومع ذلك اعتبرت الدول القومية «برنامج العمل» الذي اتفق عليه في بكين وثيقة إجماع، بما أن دول الجنوب لا تتمتع إلا بالقليل من المرونة على أية حال، نظرًا لارتباطها الوثيق بالمعونة الدولية والمؤسسات المالية الدولية. ولكنها تستطيع، على أية حال، أن تتجاهل الفقرات التي لا تروق لها في الوثيقة.
كانت هناك، في رأيي، ثلاثة اتجاهات في الحركة النسائية في بكين. فكان هناك من كن تؤمن بأن العمل من داخل النظام والحصول على «اعتراف» بالحركة أمر إيجابي في حد ذاته. وكان هناك اتجاه آخر يوجه النقد على المستوى الاقتصادي والسياسي، ولكنه منغمس أيديولوجيًا في موقف عدم المواجهة، والتمسك بمفهوم/ كلمة «الجندر»، بما لها من حيادية، في مقابل «النسوية» والمفهوم الليبرالي لحقوق الإنسان؛ وهو ما أفصحت عنه الهيستيريا التي قوبل بها عقد المؤتمر في الصين، لافتراض افتقارها لاحترام حقوق الإنسان. ومما أصابنى بالدهشة أن نفس من لعبن دورا في مؤتمر حقوق الإنسان في فيينا سنة 1993، واللائي عملن لصياغة اتفاقيات وبروتوكولات دولية أخرى أعيد فيها تعريف مفهوم حقوق الإنسان ليشمل الحق في الغذاء والمأوى والملبس والتعليم، والصحة، إلخ. عدن للتمسك بالمفهوم القديم المحدود المقتصر على حرية التنظيم والتعبير والحديث، عندما تعلق الأمر بالصين. ثم كان هناك اتجاه ثالث، كنت أنا من المنتميات إليه، قد خاب أمله بالفعل في ما أفضى إليه الموقف الإصلاحي من نتائج، ويذهب إلى أننا لو لم نع الموقف بدقة ونعمل على قلب الاتجاه الحالي فقد تؤول الحركة النسائية إلى احتواء كامل، وإلى محو طابعها السياسي.
لقد تم هذا الاحتواء للحركة واستلاب اشتغالها بالسياسة بعدة طرق. كان أوضح تلك الطرق إعطاء مساحة لبعض النساء للدخول إلى مجالات لم يدخلنها من قبل، والوصول إلى مواقع ملحوظة السلطة والمميزات. كذلك فقد دفع تمويل أنشطة ومنظمات المرأة والحرفية المطلوبة لإدارة العمل الإداري، الحركة النسائية إلى التنافس من أجل الحصول على موارد، والانخراط في أعمال ورقية ضخمة والقلق على استدامة النشاط، ولعبت الرأسمالية العالمية والإعلام الدولي أيضًا دورًا، خاصة مع تمثل النساء في الحركة لفكرة أن الحل الوحيد يتمثل في أن نصبح جزءًا من «النظام». أما التحرك الأكثر خطراً فتمثل في إدخال كلمة «جندر»، وقضية حقوق الإنسان.
لقد بدأ عدد كبير من النسويات ونشطاء المرأة والأكاديميات في استخدام كلمة «جندر» بدلا من كلمة «نساء» عند مناقشة قضايا الحقوق والمساواة والأبوية. فمساواة النساء خلت مكانها لمساواة الجندر، ووعى النساء لوعي الجندر، وتحول الوعى بقضايا النساء إلى الوعي بالجندر. لقد تم الاستيلاء على لغة النسوية وتمييعها وتفريغها من محتواها السياسي، بل وتسطيحها.
والمشكلة في مفهوم «الجندر» أنه قد يقصد به الرجال والنساء على حد سواء، كما قد يقصد به الرجال أو النساء. فكلمة «جندر» تنطوي على أن الرجال والنساء كلاهما يعاني من القمع على نحو متساوٍ، بسبب التقسيم الحاسم للعمل، وأن تحررهما ضروری حتى يتحرر المجتمع. وبالرغم من صحة القول بأن الرجال أيضًا واقعون في إسار التقسيم الحاسم بين الذكورة والأنوثة، فالحقيقة المهمة في الموضوع أن الرجال هم الرابحون من هذا التقسيم. إن ما تركه هذا المصطلح شديد الحيادية من انطباع بالمساواة أو القمع المتساوى يضرب تعتيمًا على واقع قمع الرجل للمرأة واستعباده لها. الرجل يكسب من الأبوية بينما تخسر المرأة. فالأبوية عابرة للطبقات والأجناس والمناطق والإثنيات والأديان، وهو تعبير عالمي، أما مفهوم «الجندر» فينكر الأبوية، وينكر بذلك البنية.
إن كلمة «جندر» «المحايدة»، تنزع عن قضية إخضاع النساء طابعها السياسي، بإنكارها لبنية السلطة. وقد اشتق مصطلح «جندر» هذا من الفلسفة الليبرالية التي تقبل فيها كل الأفكار بشكل متساوٍ، كما أن كل الجماعات، بصرف النظر عن موقفها الاجتماعي، تولى وضعًا أخلاقيًا متساويًا. على أننا لا نستطيع على سبيل المثال، أن نساوى– من الناحية الأخلاقية– بين العمال والرأسماليين، حيث إن العمال هم المستغلون بينما الرأسماليون هم المستغلون الرابحون من هذه العلاقة. وللأبوية نفس البنية، ولكن تعبير «جندر» ينطوي على أن الرجال والنساء كيانان متساويان يواجه كل منهما الآخر من موقف عدم المجابهة. بيد أن الحقيقة هي أن الرجال والنساء طرفان في علاقة نزاع متبادل، بما أن مصالحهما ليست مشتركة. بعبارة بسيطة، الرجل ليس مقموعًا بنفس الدرجة. كما أن الرجل، في بنية العلاقات الاجتماعية، يوضع في موقع مختلف عن المرأة. إن الحركة النسائية بخسارتها لتحليل النظام الأبوى وإغرائها أو إقناعها باستخدام تعبير «الجندر»، ركزت على محاولة تدريب القامع واستدرار تعاطفه، بيد أن مفهومى تدريب الجندر والتحسيس، واللذين يلقيان تشجيعًا كبيرًا من مؤسسات التمويل، فشلا في أن يأخذا في الاعتبار هذين الموقفين المختلفين اختلافًا واسعًا واللذين يصدر عنهما الرجال والنساء. وبدون تحدى الأساس المادي للعلاقات الأبوية، فإن استثارة التعاطف مع الجندر والوعي بمشاكله لن يغيرا من علاقات القوى في المجتمع. والتسليم بأنهما سيحدثان تغييرًا يشبه القول بأن جعل الرأسماليين والعمال على وعى وإحساس بالاستغلال الذي يميز علاقتهما، سوف يؤدي بهما إلى الوعي بما يحدث وتقرير تغيير الأوضاع!
لقد بدأ عدد من النسويات، وبشكل متزايد، ينادين بأن قضية حقوق النساء تأتى تحت مظلة أوسع هي حقوق الإنسان. إن حقوق الإنسان والخطاب الديمقراطي، يصدران، في السنوات الأخيرة، عن المصالح الجيوبوليتيكة والاستراتيجية الأمريكية. وقد تم تأطير صيغة من هذا التوجه الرئيس الأمريكي جورج بوش الأب ثم دعمه الرئيس كلينتون، وصدور ذلك عن دولة قوية وغنية تهيمن على الاقتصاد العالمي والسياسات الدولية، يستدعى ذكريات بغيضة من خطاب «حضرنة وتنصير السكان الأصليين البرابرة» الذي رفعته أوروبا في القرن التاسع عشر. ولكن، بما أن محاولات تنصير العالم لم تعد أمرًا ينظر إليه باحترام في عالم يدفع «القوى العظمى» للاعتراف بالتنوع والتعددية، وتحول فيه أيديولوجية العلمانية المعلنة دون إمكانية استخدام الدين كقوة تساعد على الاستعمار، لجأت القوى العظمى الحديثة إلى خطاب يضرب بجذوره أخلاقيات الدين، وكذلك الأخلاقيات الليبرالية الإنسانية؛ فجاءت الاستراتيجية الأيديولوجية الجديدة المستخدمة للهيمنة على العالم متمثلة في استخدام شعار الديمقراطية وحقوق الإنسان.
لقد تم تصميم خطاب حقوق الإنسان، كما أفرزته الدول العربية القوية، ليعيد تعريف الحقوق والحريات والديمقراطية من وجهة نظر اقتصادية بحتة. فهو يدافع على سبيل المثال، عن الحق في الملكية الخاصة وفي الاستهلاك المظهرى. وهنا يصبح المستهلك المستقل الذي يتمتع بالحق في الاختيار من بين مختلف ماركات المنتجات، جزءًا من لغة حقوق الإنسان. والاتجاه نحو التخصيص (الخصخصة) وخفض التعريفات الجمركية ومنح الناس الحق والحرية في إدارة ممتلكاتهم وأعمالهم كما يحلو لهم، وكذلك الحق في شراء أي شيء يروق لهم، كل ذلك يدخل في إطار التعريف الرأسمالي لحقوق الإنسان.
بالرغم من الوجاهة الشديدة لما تنادى به النسويات من أن كل قضية هي قضية تهم النساء، وأن للنساء الحق في كل حقوق الإنسان، فإنهن يحتجن إلى إعادة النظر في خطاب حقوق الإنسان، بما أن كل نساء العالم، أو كل الفقراء بالفعل، لن يحصلوا حتى على حقوقهم الأساسية لو لم تنتزع بعض الحقوق من آخرين. عندها سوف نحتاج إلى تعريف حقوق الإنسان على أساس المصلحة الجمعية والمشتركة، حتى ولو فقد البعض حقوقهم الشخصية في تلك العملية. وقد كان ذلك في العادة يعنى، تاريخيا، الحقوق التي لا تمس للطبقة الحاكمة. وعلى النسويات أن يعين أيضا أن مفاهيم حقوق الإنسان، بالرغم من تعريفها من قبل الأمم المتحدة عبر نوع من الإجماع، فإن الولايات المتحدة والدول المهيمنة الأخرى هي التي تقرر في الواقع من الذي سيعاقب على انتهاكات حقوق الإنسان. ومن المثير أن تلاحظ أننا في الحركة النسائية غرقنا في الدعاية السلبية من جماعات حقوق الإنسان النسوية، والتي كانت معظمها نسويات بيض في الولايات المتحدة ناهضن الصين سنة 1995، لم نتلق في الوقت نفسه ولو إشارة واحدة للاعتراض على قصف كوسوفو، إن تحت أيدينا الآن معلومات تشي بأن الرئيس كلينتون طلب دعم جماعات حقوق الإنسان، على الأقل بالصمت. وقد وافقته على تلك الجماعات على ذلك، ولكن صمتها قوبل بشكل سلبي. ومنذ بضعة أشهر فقط أصدرت منظمة العفو الدولية، أخيرًا، بيانًا وتقريراً يقول إن الأهداف المدنية كانت جزءًا من الاستراتيجية العسكرية، وذلك في محاولة من المنظمة لاستعادة بعض المصداقية المفقودة بوصفها منظمة حقوق إنسان «مستقلة».
إلى جانب ذلك، على النساء أن يعين أن خطاب حقوق الإنسان قد ابتلع حقوق النساء. فكما اختفت النساء والنسويات في بنية مفهوم «الجندر»، أصبحن غير مرئيات أيضًا في إطار جعل حقوق الإنسان خطابًا تجريديًا غير ذي موضع محدد وغير سیاسی. فكما ذهبت فكرة «الجندر» بالأبوية، ذهبت أيضًا فكرة حقوق الإنسان بانتهاك الرجل لحقوق المرأة. فكلاهما له تأثير سلبي على حيوية التحليل وسياسات الحركة النسائية، وكلاهما يعني مولد النساء «النسوقراطية» femocrat أيا كان موقعها، في السياسة أو الحكومة أو الأمم المتحدة، أو وكالات التنمية، أو الأكاديميا، أو الجماعات والمنظمات غير الحكومية النسائية. إن التاريخ لم تصنعه البيروقراطية، ولا يمكن أن تصنعه النسوقراطية أيضًا.
كانت العديد من تلك التوجهات واضحة للعيان إبان انعقاد المؤتمر العالمي سنة 1995. وقد طلب مني في بكين أن أتحدث في الجلسة العامة حول موضوع «الاتجاه المحافظ على المستوى العالمي». وقلت حينها إنني عدت بعيني الدهشة والحنين إلى نیروبی، مسترجعة زمنا كنا نستطيع فيه أن نتحدث عن الاشتراكية ونناضل من أجلها دون أن ينظر إلينا باستخفاف مستتر، وأن ننسج أحلامًا دون أن يقال لنا «لتكونوا عمليين»؛ عندما كان يقال للنساء نساء وللرجال رجال، ولم تكن مؤسسة الأبوية مطموسة تحت غطاء مفهوم الجندر، حينها لم تكن حفنة من البشر قد أعلنت بعد عن موت التاريخ، بل والأيديولوجيا، بينما لا تزال الغالبية تكاد لصناعة التاريخ؛ عندما لم تكن «ما بعد الحداثة» قد أضفت بعد الشرعية على كل تعبير وكل خصوصية، بغض النظر عن رجعية هذه الخصوصية أو ذاك التعبير أو تخلفهما، أو منافاتهما أو مجافاتهما للأخلاق؛ وعندما لم يكن الإعلاء من الفردية ليمنع الناس في أن يتلاقوا في حركة؛ وعندما كانت الحركة النسائية نفسها نضالاً سياسيًا تلقائيًا، وليست مجموعة الأنشطة والمشروعات وخطط العمل.
هذا هو موقفي باختصار وأفكارى حول موضوع الحركة النسائية اليوم. وبعض ما حدث لم يكن هناك من سبيل لتحاشيه، حيث إن الحركة سعت للتأثير ولأن تصبح جزءًا من التيار العام السائد، ولكنها بانخراطها في التيار السائد فقدت أيضًا جوهر وجودها نفسه وقدرتها على إحداث تغيير جوهري في البني والنظم التي ناضلت ضدها، بل وقدرتها على تقرير مستقبلها. وقد فقدت أيضًا قدرتها على الضغط من أجل إحداث تغيير في العلاقات الدولية. وبالرغم من وجود تلك الفجوات، فقد كان من الممكن أن يمثل «برنامج العمل» خطوة أولى فعالة إلى حد معقول نحو إعادة البناء على المستوى المحلى والقومي والعالمي لو أن روحها طبقت وتحولت إلى واقع. ولكن ما حدث هو عملية تجميل نجحت فيها صياغة الوثيقة في احتواء الإشكالية. فالأمم المتحدة والدول، كلاهما استغل، بل وحور في كثير من الحالات، لغة الوثيقة من أجل تخريب الحركة، كما أن العديد من الدول حنثت بالوعود المقطوعة فيها.
على أن من أشد الأمور إثارة في مؤتمر بكين + 5 أنه بالرغم من أن العديد من الحكومات أعلنت أنها تحركت بخطة سريعة نحو تنفيذ «برنامج العمل»، فإن الجماعات النسائية والمنظمات غير الحكومية دعمن هذا الموقف. والواقع أن تقرير المنظمات غير الحكومية كان مشابهًا في محتواه، شكلاً ولغةً، للمواقف الرسمية، وكم كان ذلك مثيرًا للسخرية والضحك، وحتى نضرب عليه مثالاً، لننظر مثلاً إلى تقرير المنظمات غير الحكومية الباكستانية. فمعهد دراسات المرأة في لاهور، والذي أعمل فيه، وجهت إليه في العام الماضي اتهامات بأنه معادٍ للدولة وللحكومة وللإسلام ويضلل النساء، ويحض على الفسق، ويوالى الهندوس واليهود. وقالت الحكومة إنه أشد المنظمات تخريبًا في باكستان، وقامت أربع وكالات مخابراتية بمراقبة أنشطتنا. وبعد أن استولت الحكومة العسكرية على الحكم في أكتوبر 1999، استمرت المخابرات المدنية والعسكرية في مراقبة أنشطتنا، وبالرغم من ذلك، ذكر التقرير الباكستاني أن المعهد من النجاحات في باكستان، على اعتبار أنه كان نتيجة للمؤتمر العالمي في بكين وما تلاه من «شراكة» بين «الحكومي وغير الحكومي». مع العلم، أن المعهد كان مخططًا لإنشائه قبل المؤتمر بوقت طويل، وكان العمل في إنشائه بدأ بالفعل سنة 1993، بل وكان قد تم شراء أرض البناء قبل بكين. وقد ذكرت ذلك مراراً وتكرارًا للقائمين على كتابة وتنسيق التقرير، ولكن من الواضح أنهم كانوا يريدون أن ينسبوا الفضل إلى الشراكة التي تطورت بينهم وبين الحكومة. ولكن لم يدخل المعهد ولا الكيان الذي انبثق منه المعهد، وهو مركز موارد إيه إس آر ASR Resource Center في أي وقت في بني الشراكة التي نفذت بعد مؤتمر بكين.
إن احتواء حركة النساء عن طريق تأسيس، أو منطق العمل، من الداخل قد وصل في باكستان إلى نتيجة منطقية، بالرغم من أنها قد تكون مقيتة. فقد انضمت معظم حركات النساء إلى النظام العسكري غير الشرعي، ففي سنة 2000 تم الاحتفال رسميًا في إسلام آباد بيوم 8 مارس، بعقد مؤتمر عن النساء، كان المتحدث الرئيسي فيه هو الجنرال برفيز مشرف. كذلك تم تنظيم تجمع ومظاهرة قادها وزراء الحكومة، كما شارك أعضاء السلك الدبلوماسي في الاحتفالات. لقد كان ذلك سخرية من إضراب العاملات في شيكاجو وما تلاه من دعوة كلارا زيتكين (شيوعية!) لإعلان 8 مارس من يومًا عالميًا للمرأة! لقد ضم الوفد الحكومي الباكستاني في نيويورك أربع وزيرات على الأقل، كلهن من قطاع المنظمات غير الحكومية، بالإضافة إلى ممثلات لعدد آخر من المنظمات غير الحكومية، والتي أصبحت مشاركتها الآن، شبه إلزامية في كل الوفود الرسمية. وضم «وفد» المنظمات الحكومية عدداً ممن عملن مع الحكومة كعضوات في لجان استشارية أو مجموعات عمل. وهو ما يعنى أنه لم يعد هناك فرق، من الناحية العملية، بين الاثنين. وما حدث بالفعل أن وفد المنظمات الحكومية، بدلاً من أن يمارس ضغوطًا على الوفد الرسمي حتى يتخذ مواقف أكثر أصالة، في قضية حقوق الإنجاب وقضية التوجهات الجنسية على سبيل المثال، والتي لقيت اعتراضات هائلة في المؤتمر وصاغت حولها جماعات المرأة في باكستان مواقف شديدة الوضوح، تواطأ هذا الوفد مع موقف الحكومة ودعمه. وقد امتد هذا الدعم، بالطبع، لدعم الانقلاب العسكري. قد يكون ذلك انحرافًا، ولكنه على أية حال حالة واضحة من حالات السير مع الاتجاه السائد أو «العمل من الداخل» وصلت إلى نتيجتها المنطقية والبغيضة.
ولنعد الآن إلى مؤتمر الأمم المتحدة في نيويورك. كان للحركات النسائية، بالطبع، تأثير على نوعية الوثائق التي تعمل الأمم المتحدة حاليًا من خلالها، أو على إعدادها. وبالرغم من النكوص الملحوظ لعدد من البلدان، بما فيها بلدان من الشمال، فيما يتعلق بقضية الإجهاض، واحتدام الخلاف بين النساء من الشمال والجنوب حول استخدام كلمة «سحاق» أو حتى «توجه جنسي»، أبدت نساء الشمال تحفظًا شديدًا حول إثارة قضايا النظام الاقتصادي العالمي، والإعلام، والسيطرة المتزايدة على المعلومات والمعرفة من خلال انتشار تكنولوجيا المعلومات. في نفس الوقت، حنث الشمال بالتزاماته المالية، إلا فيما يتعلق بمجالات من قبيل أنظمة الاستدانة (التي تؤدى إلى توفير دخل وربط النساء بالسوق)؛ وزيادة قبول فكرة الجندر في مقابل النسوية؛ وحقوق الإنسان الليبرالية والبورجوازية كما يعرفها الشمال؛ والنساء اللاتي عانين من جراء أوضاع النزاع. ومن المثير حقًا ألا نجد في «برنامج العمل»، فصلاً يحمل عنوان «السلام» ولكن يحمل عنوان «النساء في أوضاع النزاع». ولا يسعنا إلا أن نعتبر الحرب والنزاعات والإرهاب من المعطيات، وبأن الأمم المتحدة لا تعرف سوى أن المرأة يجب مساعدتها على لملمة شعث حياتها مرة أخرى بمجرد وقوع نزاع أو حرب أو دمار.
أما عن السؤال الأكبر الخاص بما إذا كانت الحركة النسائية قد أثرت في العلاقات الدولية، والتي أعرفها بأنها البنية السياسية والاقتصادية والأيديولوجية العالمية، فيتحتم على أن أقول أنه ليس هناك من مؤشر على حدوث ذلك. والواقع أن العكس ربما يكون هو الذي حدث. لقد انتقلت الحركة من كونها حركة لتتمأسس وتصبح جزءًا من النظام المستقر. لقد مر التناقض بعملية تأليف ليتحول بشكل متزايد إلى فرضية. فجماعات النساء أصبحت الآن مؤسسات، والنسويات أصبحن أعضاء في النظام: وسرعان ما دخلت دراسات النساء أو «دراسات الجندر» في المناهج الدراسية في العديد من الجامعات؛ وقوائم النساء يحملها الآن ناشرو التيار السائد؛ وقضايا النساء يجرى التعامل معها، بالرغم من أن ذلك عادة ما يتم عن طريق شعارات ترفعها الحكومات؛ والشخصيات النسائية الرئيسية تم إشراكها في صناعة القرار في إطار بنية الدولة. ولو كان لدينا فهم جدلي للتاريخ، فسنعي أن هذه الفرضية سوف تفرز بلا شك وضعًا متناقضًا جديدًا لمواجهتها. يحدث ذلك بالفعل في بعض بلداننا، ولكنه سيؤدي أيضًا إلى زيادة الانقسام بين الشمال والجنوب. لو كان همنا أن يكون هناك عالم عادل تسوده المساواة وتتمتع فيه النساء بنفس الحقوق والمميزات التي يتمتع بها الرجال، وكذلك يتمتع الجنوب بنفس الحقوق والمميزات التي يتمتع بها الشمال؛ وإذا كان اهتمامنا موجهًا إلى النضال ضد كل أشكال القمع من الخاص إلى العالمي؛ وإذا أردنا إعادة البناء على المستوى العالمي، فعلينا أن نستعيد الأيديولوجيات العالمية التي يبدو أنها لقيت الإهمال. وأنا أشير هنا إلى الماركسية والاشتراكية والنسوية– مع إعادة صياغتها في ضوء حقائق ومتطلبات الحاضر، ولكن مع الأخذ في الاعتبار أنها لا تشكل جوهر أيديولوجيا ونضال لتحدى الرأسمالية العالمية والسوق التي يفترض أنها «حرة»، والهيمنة السياسية والاجتماعية والثقافية والعرقية؛ وكذلك الأبوية بالطبع.
يقع عبء الحركة العالمية، بما فيها الحركة النسائية العالمية، بالطبع على الشمال، في بلدان مثل ألمانيا، حيث إن حتى نضال الجنوب مجتمعًا لن ينجح، ولا يستطيع، في إحداث تغيير عالمي في ما يسمى بالنظام العالمي الجديد، بما أن تنظيم هذا النظام تقرره حفنة من الدول، وهي أساسًا الولايات المتحدة وأوربا واليابان. نستطيع أن نبذل كل ما في وسعنا في الجنوب، ولكننا لن نرى الحركة النسائية العالمية التي كانت قائمة في الستينيات والسبعينيات (دون كثير اتصال بين أطرافها) ما لم تعارض الحركة النسائية والأكاديميون في الشمال سياسات دولهم والنظام الدولي. وأنا لا أعنى بذلك أن تؤول قيادة الحركة النسائية العالمية إلى الشمال. على العكس. فأنا أعتقد أن الحركة في الشمال ينبغي أن يقودها الجنوب، على الأقل على مستوى الفهم، ولكنها ستحتاج إلى تنسيق الجهود؛ وسيتعين على نسويات الشمال، كما تعين على المحظوظات من نسويات الجنوب، أن يتخلين عن الكثير من امتيازاتهن. إنه تحد ولكنني لا زلت أؤمن بالأحلام. وأنا متمسكة بحلمي، فكما قال الشاعر الأمريكي الأسود لانجستون هيوز: «اقبض على الأحلام، إذ عندما تموت الأحلام، لا تغدو الحياة سوى طائر مكسور الجناح، لا يستطيع الطيران».
نجات سید خان: عميدة معهد دراسات المرأة في لاهور، باكستان.
عثمان مصطفی عثمان: مترجم وباحث.
(*) هذا المقال فصل من كتاب
Common Ground or Mutual Exclusion. Edited by Marrianne Braig and Sonia Wolfe. London, Zed Books, 2002.