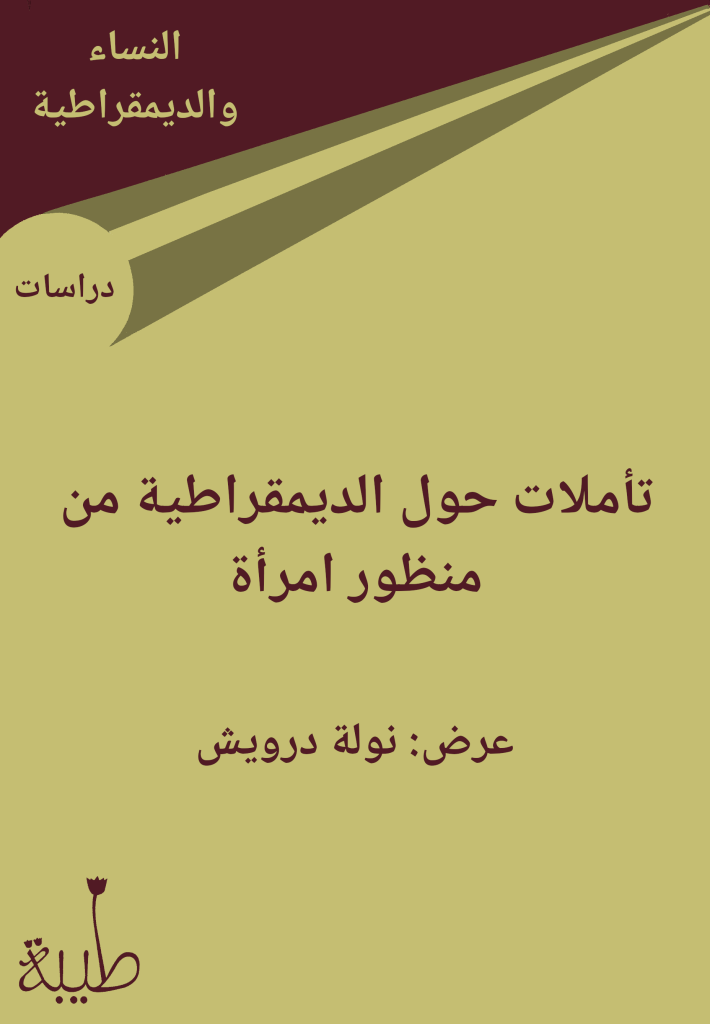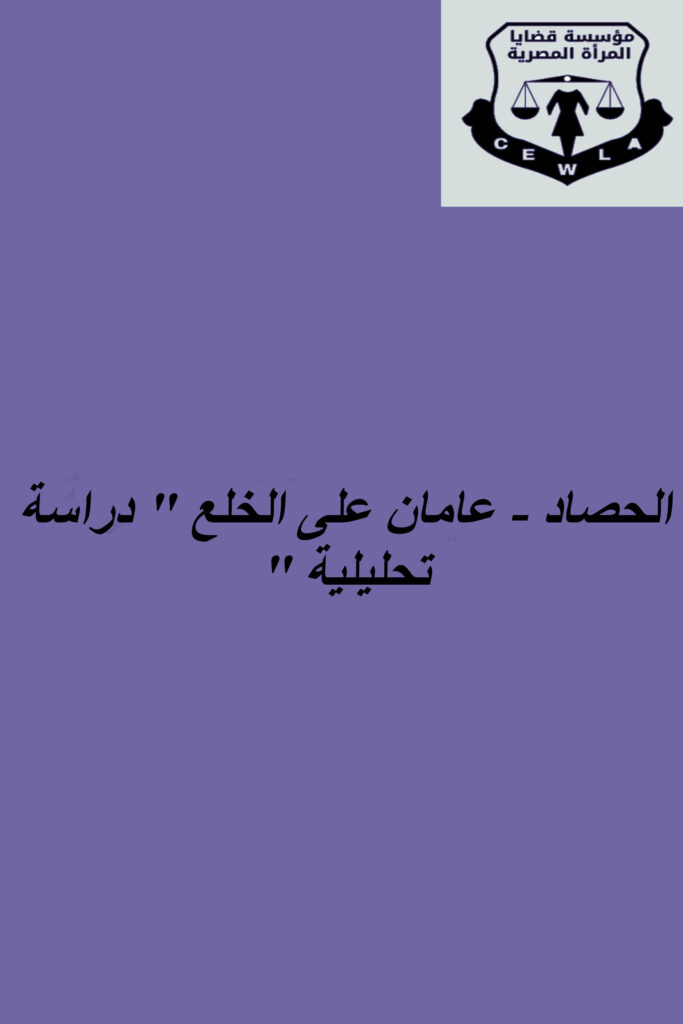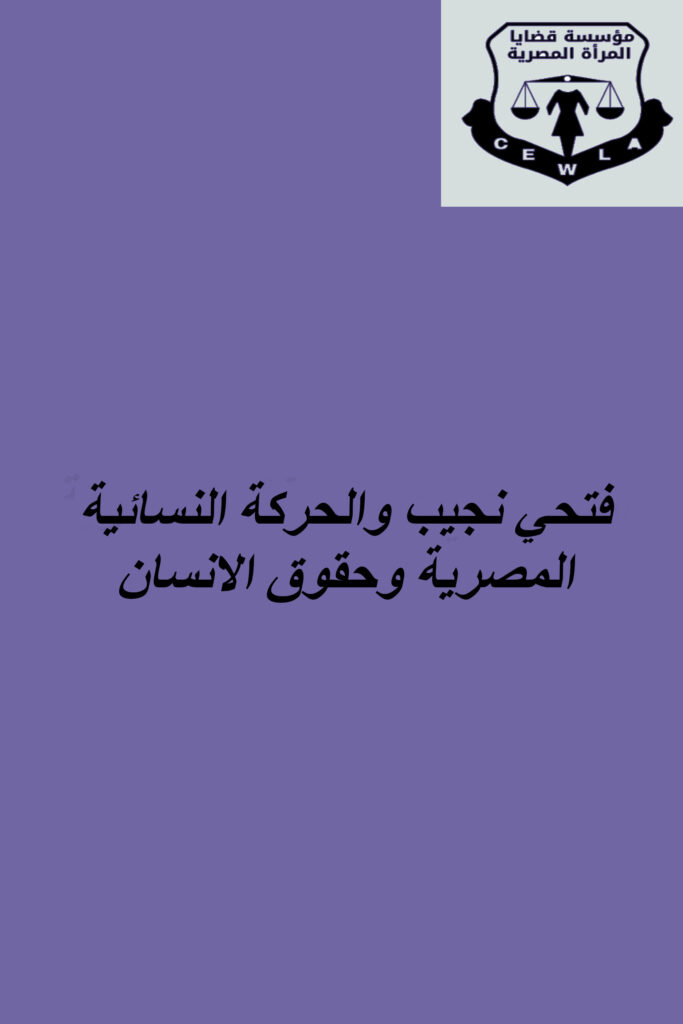تأملات حول الديمقراطية من منظور امرأة
نولة درويش*
لقد كثرت الكتابات في مصر خلال السنوات الأخيرة حول الديمقراطية، مع ما يواكبها من مطالب الإصلاح السياسي، والتشريعات المصاحبة له، سواء بإلغاء بعض القوانين التي تعد سيئة السمعة، أو بإصدار قوانين جديدة أو تعديل بعضها لفتح مساحة أكبر للحريات العامة. ويتم تصوير الديمقراطية باعتبارها الوصفة السحرية التي من شأنها حل جميع المشاكل، وإرساء أشكال من العلاقات الأكثر عدالةً واحترامًا للحقوق الأساسية للمواطنين. ولكن يظل هناك عدد من التساؤلات المرتبطة بالديمقراطية في علاقتها بفئات معينة، منها الفقراء على سبيل المثال، أو الأقليات؛ ويعني هذا المقال بالنظر في الإشكاليات الخاصة بالنساء في هذا المجال، مما يجعلنا نطرح بعض التساؤلات التي سنسعى إلى الرد عليها، ومنها: هل ستتحسن أوضاع النساء حقا مع إرساء الديمقراطية في البلاد؟ هل للنساء مصلحة في تحقيق الديمقراطية؟ هل يمكن أن تساهم النساء في إثراء الديمقراطية؟ هل ستعود مساهمة النساء في هذا المجال بالنفع للجميع، أم أن المكاسب ستقتصر على النساء وحدهن؟
أشارت كلمة الديمقراطية في التاريخ القديم إلى مجموعة من المقومات الواجب توافرها، مثل: التحرر من الطغيان، والتناغم، وسيادة القانون، والمساواة الطبيعية، وحكمة المواطنين، والتربية والتعليم، والتفكير المبني على المعرفة. وكان هذا المفهوم يتعلق حينذاك بنخبة من البشر دون سواهم؛ فلم ينطبق هذا المفهوم على العبيد على سبيل المثال. غير أن عجلة التاريخ قد ألغت العبودية الواضحة والصريحة، وبالتالي لم تعد تقتصر الديمقراطية “نظريًا” على فئة دون الفئات الأخرى. أما اليوم، ونحن في بدايات الألفية الثالثة، فقد تطور المفهوم كثيرًا، نظرًا لأنه أصبح يمتد إلى دوائر اجتماعية أوسع من جهة، ولأن المفاهيم المتعلقة بمقومات إدارة الحكم الرشيد قد تطورت هي الأخرى تطورًا كبيرًا من جهة أخرى؛ كما برزت احتياجات جديدة في الحياة تمتد إلى جوانب ملموسة وملحة لا تنحصر في الحقوق السياسية فحسب وإنما تغطي منظومة من الحقوق المتعددة، بعدما كانت الديمقراطية أشبه إلى الترف الفكري. دعونا إذن ننظر إلى ما تشير إليه اليوم هذه الكلمة من واقع الكتابات التي تناولت هذا المفهوم في السنوات الأخيرة؛ أي، ما الأركان التي يرى المفكرون أهمية توافرها حتى يمكننا الحديث عن تحقق الديمقراطية.
تصف القواميس كلمة الديمقراطية بأنها نظام سياسي يمارس فيه الشعب استقلاليته بدون وساطة جهة تمثيلية، أي ما يسمى بالديمقراطية المباشرة، أو من خلال ممثلين منتخبين من خلال نظام انتخابي حر يقومون بدور الوسيط بين المجتمع والسلطة السياسية، أي ما يعرف بالديمقراطية التمثيلية. باختصار، ووفقا لما تعلمناه في المدارس والجامعات، يشير المفهوم إلى حكم الشعب للشعب من خلال ممثليه المنتخبين. إلا أن كلمة الديمقراطية اكتسبت في الواقع العملي أبعادًا أخرى، وأصبحت تشير إلى منظومة من المقومات بعضها قديم، والبعض الآخر مستجد. وهو ما يدفعنا إلى السعي لكي نحدد أيضًا ما يعد منافيًا للديمقراطية لتبيان مدى الاقتراب أو الابتعاد عن المعنى المقصود في واقعنا المعيش. في هذا الإطار، ظهرت مجموعة من الأفكار، والاجتهادات، قد لا يكون هذا العرض شاملاً لها جميعًا؛ ولكن من المفيد أن نتأمل أهم تلك الأبعاد، لعلها تساهم في بلورة مطالب محددة ورؤى بديلة.
جاءت على رأس المقومات المطلوب توافرها تحقيق المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين، مهما كانت انتماءاتهم العرقية، أو الدينية، أو العقائدية، أو الطبقية، أو العمرية، أو الجنسية. وهو المطلب الذي تتضمنه أغلبية الدساتير، ولاسيما الدستور المصري؛ ومع ذلك، يحق التساؤل لو كانت لهذه الديباجة انعكاساتها الفعلية على أرض الواقع، وهو الأمر الذي سنتناوله عند التطرق إلى أوضاع النساء. في مقابل المساواة المطلوب تحقيقها، هناك الأسلوب التراتبي/ البطرياركي، وأشكال من التمييز في عديد من مجالات الحياة – بما فيها القوانين – والتي تعد من الممارسات التي لا يمكن اعتبار أنها تحمل طابعًا ديمقراطيًا بالمعنى المشار إليه سابقاً. إن الأخذ بهذا المكون الأساسي للديمقراطية هو تبني المرادف لانتشار ثقافة التسامح، والتناغم الذي كان ينادي به القدماء، واتساع مفهوم الوطن ذاته؛ مع الابتعاد عن اعتبار أن من هم أقدم، أو أكبر، أو أعلى رتبة، يتمتعون بالضرورة – وفي جميع الأحوال – بحق الكلمة الأخيرة والفاصلة.
ثم جاءت الشفافية في إدارة شئون الحكم، والتي بدون توافرها يستحيل الحديث عن الديمقراطية. هذه الشفافية تتضمن – ضمن أشياء أخرى – إقامة انتخابات نزيهة تحرص على التمثيل الصادق لإرادة الشعب حتى تؤدي نتائجها فعليا إلى حكم الشعب للشعب من خلال ممثليه المنتخبين بطريقة حرة. كما ترتبط الشفافية بالمساءلة والمحاسبية، وتحمل المسئولية، إلخ. أما حينما يتم تشويه رغبات الجمهور، وتنتشر أشكال من الفساد والتزوير، فلا يمكن أن يمثل ذلك الأسلوب الديمقراطي. كذلك، فإن التعتيم، والضبابية، وحجب المعلومات، ومنح الحصانة لفئات معينة بحيث تتصرف كما يحلو لها دون رادع أو رقيب، فهي كلها ممارسات منافية للشفافية. تحتوي كلمة الديمقراطية أيضًا على حقوق مثل الحق في حرية التعبير وحرية التنظيم؛ ويقع ذلك في تعارض مع قمع الحريات العامة والشخصية، وإسكات الأصوات المعارضة، وتحجيم حركة المجتمع المدني، وفرض القوانين الاستثنائية. والواقع أن هناك علاقة حيوية بين حرية التعبير وحرية التنظيم؛ فالأولى ليس لها معنى دون وجود مجتمع حيوي، يتفاعل مع الكلمة الحرة، قادر على تنظيم نفسه والدفاع عن مصالحه؛ بدون توافر هذا الركن، تتحول الكتابات والأفكار ومطالب التغيير إلى مجرد باب للتنفيس لا يقدم ولا يؤخر. ومن ناحية أخرى، يحتاج المجتمع المدني – حتى يصبح قويًا وفعالاً – إلى ارتفاع الأصوات التي تدعمه، وتدفعه إلى مزيد من العطاء والابتكار والإبداع. وهو الأمر الذي ينطبق أيضًا على الحياة السياسية بصفة عامة.
كما أن حكم الشعب للشعب يتطلب المشاركة الفعلية في اتخاذ القرار، وهو ما يعني رفض جميع أشكال الإقصاء والتهميش؛ فالديمقراطية بهذا المعنى يجب أن تكون تضمينية، ومحفزة، وملهمة، ومفجرة للمبادرات. من أجل تحقيق الديمقراطية، لابد أيضًا من تعدد الخيارات والبدائل الحرة أمام الناس، مع إتاحة الفرصة أمام الجميع لتفتح حرية العقل والتفكير والإبداع، وتدفق المعلومات وتداولها، وتوافر القدرة على المفاضلة بين تلك الخيارات والحصول عليها. أما المجتمعات التي تغيب عنها الممارسات الديمقراطية، فإنما يكون البديل هو الإكراه، وسياسات فرض الأمر الواقع، وقمع الفكر النقدي الحر، وتشكيل جيوش من الموظفين المطيعين. كما تتسم تلك المجتمعات بالبلادة الفكرية وبالتالي، بالفقر الإبداعي. في إطار تعدد البدائل، أشير ضمن مكونات الديمقراطية إلى احترام التعددية، والتنوع، والاختلاف، فيما يقابله فرض الرأي أحادي الجانب، وإدانة الخروج عن “المألوف“، ونشر ثقافة التنميط، والإخفاق عن إدارة الاختلاف بطريقة سلمية، واستبعاد شرائح من المجتمع، واعتبار كل ما هو “آخر” مضرًا ومصدرًا للخطر. كذلك يمثل تداول السلطة بطريقة سلمية أحد المكونات المهمة للمارسة الديمقراطية؛ فبدون هذا الملمح، لا بد من سيادة الأساليب الدكتاتورية والقمعية، وصولاً أحيانًا إلى حد البلطجة؛ وهي الخبرة التي تعلمناها من مجتمعات عديدة عبر التاريخ الطويل للإنسانية. يتطلب هذا التداول السلمي للسلطة توافر التكريس الفعلي للمؤسسية وسيادة القانون التي تعم في غيابها البلطجة، والمحسوبية، وتختفي المرجعيات الواضحة التي يمكن أن يحتكم الناس إليها. وحتى يستطيع أن يحكم الشعب نفسه، ينبغي أن يتمتع بقدرة الحصول على جميع منافع الحياة، وأن تتوافر ضمانات الحفاظ على سلامة الإنسان، وحصوله على العلم والمعرفة، وأساسًا أن يكون الإنسان فاعلاً بدلاً من أن يكون مفعولاً به. هذه المتطلبات تتناقض بالطبع مع مظاهر الإفقار، والتهميش، والتمييز بين المواطنين، وممارسة التعذيب، والقهر، وتعريض المواطنين للانتهاكات الجسدية أو النفسية، وسد أو تحجيم منابع العلم والمعرفة.
يعد الجزء السابق مدخلاً لتناول موقع النساء من ممارسة الديمقراطية. من المهم هنا التأكيد على أن قضايا النساء لا تنفصل عن قضايا المجتمع، وإنما تمثل أحد التجليات الأساسية المترتبة على وجود أو غياب الديمقراطية. ولكن هذه القضايا تحتاج إلى مقاربة خاصة لما لها من طابع متفرد وخصوصية ترتبط بفئة من أكثر الفئات تهميشًا داخل مجتمع هو مهمش في حد ذاته. فإذا كانت المحظورات السابقة تنطبق بدرجة أو بأخرى على عموم أبناء هذا الوطن، فإنما تنطبق بصفة خاصة على النساء المصريات، سواء في المجال العام أو الخاص. وإذا ما نظرنا عن قرب إلى أوضاع عموم النساء في مصر، فسوف نجد أنها تتسم بملامح أساسية مشتركة قد نجد لها استثناءً هنا أو هناك، ولكنها لا تمثل القاعدة العامة بأي حال من الأحوال.
سيتم تناول هذه الأوضاع، مع الربط بين البعد العام والبعد الخاص الذي يميل كثيرون إلى الفصل التعسفي بينهما. فعلى سبيل المثال، يحرص الناس في مصر على فض النزاعات التي قد تشب في الشارع بين أي اثنين؛ وهي نزاعات أصبحت تأخذ في السنوات الأخيرة أشكالاً أكثر عنفًا؛ أما ما يحدث في معظم الأحوال عندما نجد رجلاً يعتدي على امرأة في الشارع أو في المجال العام، واعترض الناس على ذلك، ثم قيل لهم إن هذه السيدة زوجته أو ابنته أو شقيقته، ينفض الناس من حول المشهد، لأن المسألة تدخل في إطار ما يسمى بالمجال الخاص؛ وهو مجال ينظر إليه باعتباره يخضع لقواعده الخاصة التي ليس من حق طرف خارجي أن يمسها أو يقترب منها. كان ذلك مجرد مثال لتجسيد الفصل المذكور أعلاه.
وينطبق المنطق نفسه على مجموعة القوانين المنظمة لحياة الناس؛ فعلى الرغم من أن الدستور المصري ينص على المساواة بين البشر، وأن مصر قد وقعت على العديد من الاتفاقيات والعهود الدولية التي تحمل هذا المعنى، والتي من أهمها بالنسبة للنساء اتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة، فلا تخلو القوانين المصرية من حالة الانفصام تلك بين ما هو عام وما هو خاص، فحينما نرجع بذاكرتنا إلى نصف قرن مضى، نجد أن النظام الجمهوري الذي جاء إلى الحكم آنذاك، لم يمانع دخول النساء في المجال العام، وتجلى ذلك في منح النساء المصريات حق الاقتراع والترشيح عام 1956، وهو تاريخ سابق بالنسبة لعديد من البلدان الأخرى، ولاسيما بعض البلدان الغربية.؛ كما سنت منذ 1954 التشريعات التي منحت المرأة حقوقًا متساوية في مجالي التعليم والعمل – فيها عدا القطاعات غير الرسمية والعاملات في الزراعة، وهي العمالة التي لم تحظ حتى اليوم بأي شكل من أشكال التغطية والحماية القانونية. بناء على ذلك، بدأت تظهر أجيال جديدة من النساء المصريات المندرجات في صفوف الجامعة، واللاتي خضن في مهن لم تكن مفتوحة أمامهن فيما قبل. ولكن، ظلت النساء المصريات عاجزات عن الحصول على التعديلات التي طالما طالبن بها في قوانين الأحوال الشخصية، في ظل غياب التنظيمات المستقلة التي تسمح بالدفاع عن برنامج نسائي أو مطالب نسائية قد تتعدى الحدود التي يرضى بها النظام. فالمكتسبات عبارة عن منح، تهبط من أعلى على رأس المحكومين، وقد تسحب من أعلى أيضا؛ ولا إرادة يتمتع بها الشعب أو يسمح له بها. ومع الهامش البسيط من حرية التحرك، نشهد اليوم الأساليب نفسها التي نقرأ عنها في خمسينيات القرن العشرين. ففي عام 1958، سعت مجموعة من النشطات إلى تسجيل جمعية لدى وزارة الشئون الاجتماعية؛ وقوبل هذا الطلب بالرفض “لأسباب متعلقة بأمن البلد“؛ والمفارقة أن الأمر نفسه يحدث في عام 2003 مع مؤسسة «المرأة الجديدة»؛ أي بعد مرور ما يقرب من نصف قرن من الزمن. أما اليوم، حينما نقترب من المجال الخاص، وبمعنى أكثر تحديدًا العلاقات الأسرية، نجد الجهات التشريعية تنتفض هلعًا، ولا يختلف في ذلك أي من الاتجاهات السياسية الموجودة في مصر. وهو ما بدا واضحًا مؤخرًا عند مناقشة مسودات نصوص، مثل الخلع، والزواج العرفي، وسفر الزوجة دون إذن، وقانون الطفل؛ وهي مجرد أمثلة للتدليل وعلى سبيل التذكير.
مع هذه الازدواجية في المعايير، سنجد أن المساواة المكفولة للنساء في المجال العام لا يمكن أن تكون إلا شكلية؛ ذلك أنه يمكن القول باختصار شديد أن هذا الفصل المتعمد يحدث في حين يمثل المجالان امتدادًا لبعضهما البعض، وأن ما يحدث في الحياة الخاصة يؤثر على الحياة العامة، والعكس صحيح؛ فمع أن القوانين لا تفرق بين النساء والرجال من حيث الأجور، هناك عدد من الممارسات التمييزية التي تحدث في أماكن العمل – على سبيل المثال – والتي تساهم في تعميق فجوة الدخل فيما بين الإناث والذكور، والتي تؤدي في هذا الإطار إلى عجز النساء عن المشاركة في اتخاذ القرارات حيث غالبًا ما يحتل الرجال المراكز القيادية والإشرافية في أماكن العمل – حتى تلك التي تعتمد أساسًا على عمالة نسائية – كما هو معمول به في الإطار الأسري؛ وهو ما ينتج عن النظرة الدونية للمرأة بصفة عامة، والشك في قدراتها، واعتبارها تابعة للرجل، إلخ.
هناك من ناحية غياب للمشاركة السياسية الفعلية للنساء، ونذكر على سبيل المثال المشاركة الهزيلة للمصريات في انتخابات 2005؛ كما يشهد على ذلك الواقع الفعلي لمشاركة النساء في الأحزاب السياسية، وكذلك في المواقع القيادية داخل منظمات المجتمع المدني، والتشكيلات الأخرى كالنقابات؛ وهو ما ينعكس على تدني مشاركتهن في الحياة العامة أو في عملية اتخاذ القرار. وهو ما نشهده بصور أخرى داخل مؤسسة الأسرة. كذلك تنخفض المشاركة النسائية في الأنشطة الاقتصادية، مع تركزهن في القطاعات الهامشية للاقتصاد، وارتفاع معدلات البطالة في صفوفهن؛ وهي جميعها عوامل تؤدي إلى تعميق ظاهرة تأنيث الفقر. وحينما تعمل النساء لصالح الأسرة – خاصة في مجال الزراعة – فإنما لا يتقاضين أي أجر مقابل ذلك؛ ولا تظهر مساهمتهن الاقتصادية في الإحصائيات الرسمية. وهناك نسبة كبيرة من النساء يعملن في المهن “المقبولة اجتماعيًا” بالنسبة إليهن، مثل التدريس، وأعمال السكرتارية، والتمريض؛ وهي المهن التي تعد امتدادًا لوظيفتهن الإنجابية والرعائية؛ وهن بالتالي عاجزات عن المنافسة في سوق العمل في سياق التحديات التي تفرضها العولمة. وعلى الرغم من أن القوانين لا تفرق بين النساء والرجال من حيث الأجور، هناك عدد من الممارسات التمييزية (المتعلقة بالضمان الاجتماعي، وتوظيفهن في كثير من الأحيان بدون عقود أي بدون أي مزايا مثل الإجازات مدفوعة الأجر أو الحماية الصحية والاجتماعية، وتقليص فرص التدريب أمامهن، وبالتالي انسداد فرص الترقي الوظيفي أمامهن، إلخ.) التي تساهم في توسيع الفجوة في الدخل بين الذكور والإناث. وإلى جانب ذلك، ما زالت قدرة النساء محدودة في الحصول على الموارد الاقتصادية مثل القروض الصغيرة، كما يلاحظ وجود فجوة مهمة فيما بين الجنسين من حيث ملكية الأراضي، وقدرة الحصول على التدريب المهني، والاستفادة من الإنجازات التكنولوجية. ومع هذا، ترتفع نسبة الأسر التي تعولها نساء في مصر، خاصة في المناطق الريفية بالصعيد؛ إذ تبلغ حسب الأرقام الرسمية ما يقرب من 18% من أسر مصر، بينما يرى بعض الباحثين أنها تصل إلى ما لا يقل عن 25%؛ وأغلبية هؤلاء النساء أميات، مما يحول دون حصولهن على وظائف مربحة؛ وهو عامل إضافي يساهم في تأنيث الفقر. هذا، فيما يتعلق بالمجال العام.
أما فيما يتعلق بالمجال الخاص، فمن الملاحظ أن هناك نسبة مرتفعة من النساء الأميات في مصر، خاصة في المناطق الريفية وفي صفوف العاملات بالزراعة. ومن الظواهر المهمة المرصودة انخفاض نسبة الإناث المندرجات في صفوف التعليم كلما ارتفعت المرحلة التعليمية. ذلك أن الأهل لا يرون فائدة كبيرة في الاستثمار في تعليم الإناث، خاصة أن ثمار هذا الاستثمار سوف يذهب إلى رجل قد يكون غريبًا. وبطبيعة الحال، تزداد الأمور سوءًا كلما كانت الأسرة أشد فقرًا. كما تعاني النساء المصريات – وخاصة تلك اللاتي يعشن في المناطق الريفية والفقيرة – من تدني الصحة الإنجابية مع ارتفاع معدلات الخصوبة؛ ومع إضافة ذلك إلى عدم توافر الخدمات الصحية المناسبة، ترتفع معدلات وفيات الأمهات، مع انتشار واسع للأنيميا في صفوف الحوامل. كما تتعرض النساء المصريات إلى أشكال من العنف منها ختان الإناث، وضرب الزوجات، والاغتصاب، والتحرش الجنسي في الشارع والمنزل ومحل العمل وفي المؤسسات العامة، والتعرض للإهانات المعنوية المتنوعة. والجدير بالذكر أنه لا يوجد في مصر قانون خاص يعاقب على العنف الأسري؛ بل إن هناك بعض القوانين التي تتضمن إجراءات تمييزية لصالح الرجال، مثل قانون الزنا الذي يفرق بين النساء والرجال في العقوبات الواقعة على الطرفين عند اقتراف الجريمة نفسها. ويمكن القول أنه بينما تؤمن القوانين – بصفة عامة – حقوق النساء في المجال العام، فإنها تختصرها إلى درجة كبيرة فيما يتعلق بالمجال الخاص؛ وفي ظل هذا الوضع، يصبح من الصعب على النساء الاستمتاع بما تمنحه لهن القوانين المتعلقة بالمشاركة العامة؛ فلا يعقل أن تكون المرأة فاعلة بكفاءة في أحد ميادين الحياة العامة، إذا كانت تتعرض داخل أسرتها لأنواع من القهر، والإسكات، والإقصاء. كما أن ما يمارس داخل الأسرة، ينعكس على المجتمع بمعناه الواسع؛ فمن من الرجال يقبل أن ترأسه سيدة، إذا كان هو نفسه يمارس التمييز ضد الإناث المحيطات به؟ وإلى جانب ذلك، تعاني النساء المصريات من الأمية القانونية؛ فحتى القوانين القليلة التي يمكن استعمالها كآليات لحماية النساء لا يتم تفعيلها من قبل طرفين أساسيين هما: عموم النساء من جهة، والقائمون على تطبيق القانون من جهة أخرى، وهناك تحديات اجتماعية وثقافية عديدة تواجه النساء المصريات، وتحد من فرص مشاركتهن في صياغة ثقافة ديمقراطية تضمينية، قائمة على الاعتراف بالآخر، والقبول به، والتحاور معه، والاستماع إليه، واعتباره فردًا كامل الأهلية، وليس تابعًا. كما تساهم التنشئة الاجتماعية في تكريس التوقعات الثقافية لأدوار الجنسين والتي تؤدي في كثير من الأحيان إلى ممارسة التمييز على أساس النوع في مجال التغذية، والحصول على الخدمات التعليمية والصحية، والقدرة على الحركة والانتقال، وتحمل الإناث مزيدًا من الأعباء الأسرية مقارنة بالذكور؛ ومن انعكاسات ذلك الصور التي شاهدناها في الفترة الأخيرة للمواطنين الذين يحملون جراكن المياه، والتي غلبت عليها الوجوه النسائية؛ كما نشير إلى أن معظم ضحايا أنفلونزا الطيور من الإناث، لأن إحدى وظائفهن النمطية تتعلق بتربية الدواجن. وتتم تنشئة الفتيات في أغلبية الأسر على فكرة أن الزواج والإنجاب أهم رسالة لهن في الحياة؛ وبالتالي، تتعرض الإناث أكثر من أقرانهن الذكور إلى الزواج والإنجاب المبكر، والختان، إلخ. كما تلعب المناهج الدراسية دورًا مها في تكريس تلك الصور النمطية للنساء؛ فبينما يجلس الصبي أمام جهاز الكمبيوتر، تلعب الطفلة بدميتها؛ وهو ما تؤكده مؤشرات التحاق الإناث بالتعليم الجامعي وما بعد الجامعي، خاصة في مجال التخصصات العلمية. ولا يختلف كثيرًا الدور الذي يلعبه الإعلام، سواء المقروء أو المرئي أو المسموع. فهناك عدد من الدراسات التي رصدت هذا الدور على مدى السنوات الأخيرة، ووصلت إلى استنتاج محدودية هذا الدور في القيام بمسئوليته الاجتماعية تجاه نساء مصر اللاتي يشكلن ما يقرب من نصف أفراد المجتمع. بل إن الأغلبية العظمى من وسائل الإعلام تساهم مساهمة فعالة في تكريس النظرة الدونية للنساء، وتنميط أدوارهن، واعتبارهن سلعًا جسدية. وهو ما يبرز عند تناول وسائل الإعلام لقضايا النساء، خاصة حينما تكون قضايا شائكة يرفض المجتمع المتشرب بالنظرة الذكورية الاعتراف بوجودها، أو الإقرار بمدى القهر الذي تعاني منه النساء.
كما يشكل الخطاب العام هو الآخر المفاهيم المجتمعية؛ فهو يذهب من ناحية إلى تعميق القيم التراتبية وأهمية الانصياع إلى ما يقوله الكبار، أو من هم أعلى في السلم الاجتماعي (فقراء/ أغنياء – نساء/ رجال – أطفال/ كبار – أقلية عرقية/ أغلبية عرقية، إلخ.) والذين يجب علينا جميعًا الالتزام تجاههم بالطاعة العمياء. هذا من جانب؛ فإذا ما نظرنا إلى الخطاب المتعلق بالنساء، سنجده خطابًا يتسم بمزيد من الشفقة، والتفضل، مع التمسك باستعمال المفردات التي تؤكد أن خوض النساء للمجال العام إنما هو مجرد منحة أعطيت لهن وعليهن الامتنان تجاه هذا الكرم. وأخيرًا، تظل آليات إدراج مكون المرأة في السياسات التنموية على قدر كبير من الضعف وعدم الجدية؛ وهو الأمر المنطقي تمامًا في إطار غياب إدراج الإنسان أساسًا في تلك السياسات.
هكذا نجد أن التحديات التي تواجه النساء المصريات ذات أبعاد اقتصادية، وقانونية، واجتماعية، وثقافية؛ ومع ذلك، تظل تحديات متداخلة، وبينها تأثير متبادل؛ مما يشير إلى أهمية المقاربات ذات الطابع الشامل والمتكامل. فلا يمكن أن ينهض مجتمع بدون نهوض جميع أقطابه، أي رجاله ونسائه، شبابه وشيوخه، جميع الأعراق والأديان التي يتضمنها، فئاته الاجتماعية المختلفة، أفراده الذين يتمتعون بكامل الصحة واللياقة وأولئك الذين يفتقدون بعض المقومات الصحية ولكنهم في أي حال من الأحوال جزء لا ينبغي أن يتجزأ من هذا المجتمع.
وفي محاولة الإجابة عن بعض التساؤلات المطروحة في المقدمة من خلال ما تضمنه العرض السابق، يمكن القول أن النساء قادرات على إضفاء أبعاد جديدة لمعاني الديمقراطية، لأنهن – بكل بساطة – مفتقدات لها سواء في الحياة الخاصة أو العامة؛ وبالتالي، من مصلحتهن الأولى المشاركة في إنجاح المسعى الديمقراطي. وعلى الرغم من أهمية القوانين والإطار التشريعي المصاحب لها، فإن المسئولية الكبرى ترتبط فيما يتعلق بالنساء بالإطار الثقافي الاجتماعي؛ وهنا تبرز الأهمية القصوى لتدخل الوسائط المسئولة عن تشكيل ثقافة المجتمع أي بالدرجة الأولى التعليم والإعلام. ذلك أن الديمقراطية ليست فقط عبارة عن مفاهيم، بل هي في المقام الأول ممارسة نحتاج إلى تطويرها بداخلنا، وداخل منازلنا، وفي الشارع، والمؤسسات العامة والخاصة، وفي مواجهتنا لجميع أشكال القمع. وبهذا المعنى، لن تكفي الديمقراطية وحدها لتغيير أحوال النساء، لأنها ما زالت ديمقراطية ذات وجه ذكوري، تحتاج إلى كثير من البلورة والتطوير في اتجاه ديمقراطية شاملة بمشاركة الجانبين، مع التأكيد على أهمية مساهمات الرجال في هذا المجال؛ فالطرف الأكثر تمتعًا بالسلطة هو الذي يتحمل المسئولية الأكبر في إحداث التغيير. ومع ذلك، تستطيع النساء إثراء معاني الديمقراطية بكل ما يحملنه من خبرات إنسانية مشبعة بالآلام ومشاعر الهوان المبنية على معرفتهن للقهر، مما يدفعهن إلى رفضه لأنفسهن، ولكل من حولهن، لأنهن – كما سبق القول – جزء لا يتجزأ من المجتمع. بناء على ما سبق، يمكن القول أن من مصلحة النساء إرساء الديمقراطية؛ ولكننا لا نشير هنا إلى الديمقراطية بالمعنى التقليدي للكلمة، وإنما إلى ديمقراطية تستند إلى بعد ثقافي إنساني قائم على تضمين جميع أطراف وفئات المجتمع.
*عضوة مؤسسة بمؤسسة المرأة الجديدة.