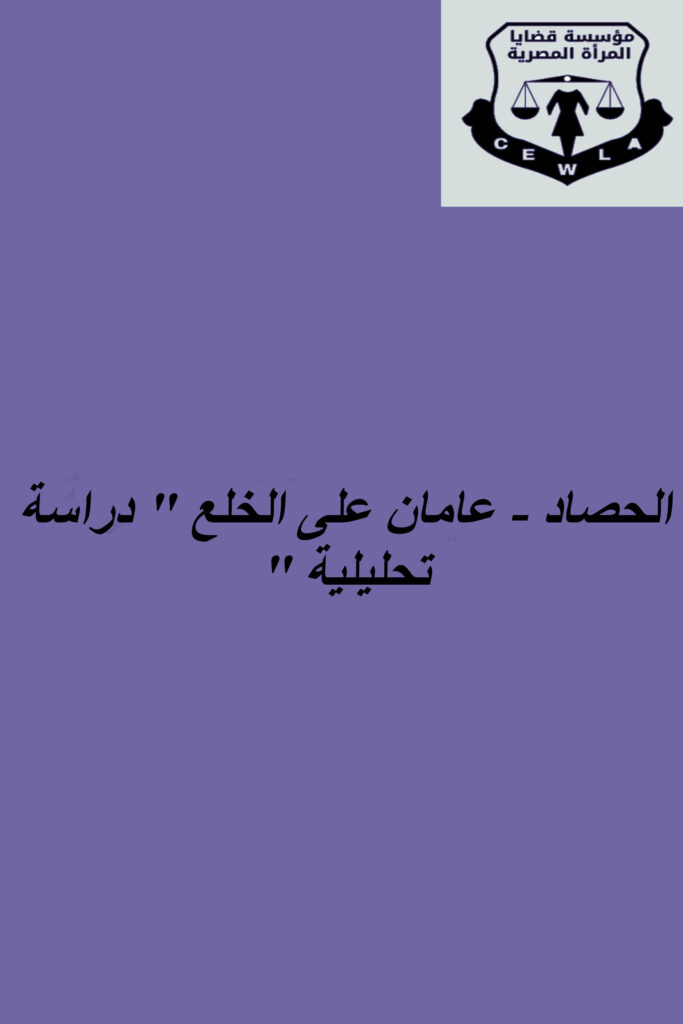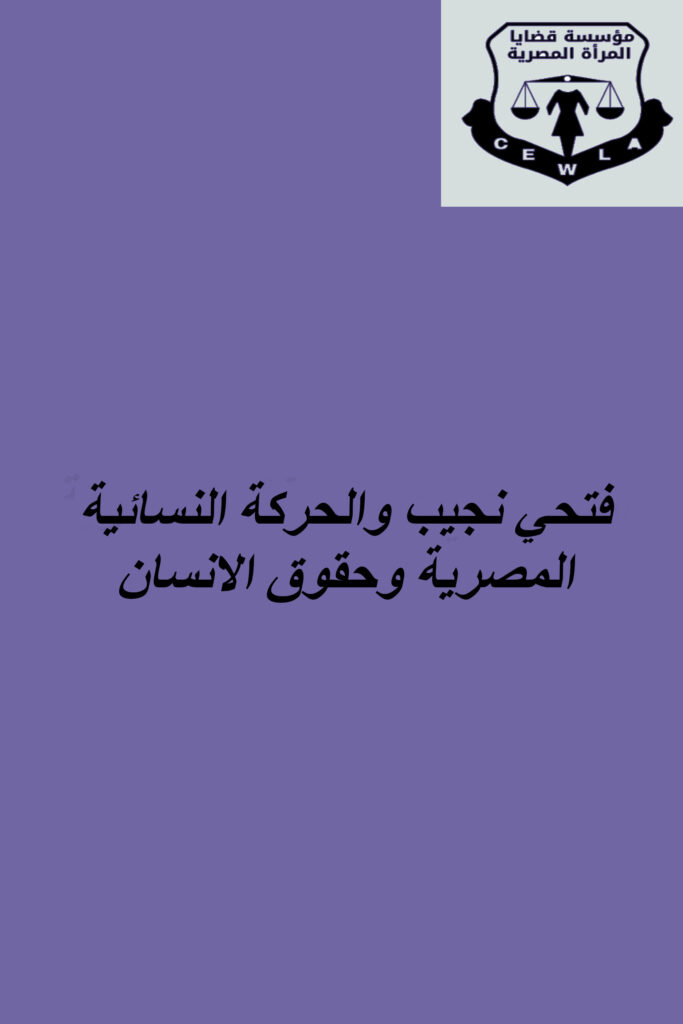تأنيث الثقافة
عادل أبو زهرة *
هذه الفكرة التي تبدو لي جديدة وهامة وجديرة بالاهتمام، أطرحها للنقاش العام على كل المهتمين بمستقبل البشرية، والدافع الذي جعلني أطرحها هو ذلك الطريق شبه المسدود الذي وصلت إليه الإنسانية مع بداية قرن ميلادي جديد، فبالرغم من كل تلك المنجزات التي حققها الإنسان في مجالات العلم والتكنولوجيا والتنظيم والإدارة والتخطيط إلا أن الإنسان في كل مكان تغمره مشاعر القلق والتوتر والخوف والاغتراب وانعدام الأمن وهي المشاعر التي تحرمنا من أن نشعر بالسعادة والطمأنينة والرضا، فزيادة معدلات الجريمة بكل أنواعها وانتشار الحروب في أماكن مختلفة من العالم وكثافة ظاهرة العنف والحروب العرقية والدينية، والتعصب ضد المختلف، وانتشار المخدرات بكل أشكالها بين أجيال مختلفة ومتعددة، وزيادة أعداد الفقراء والمعوزين والمهمشين، وتدهور أحوال البيئة، كل هذا ينبئ بأننا نمر بمأزق يستحثنا كي نجد له حلاً.
لقد عاش الإنسان لآلاف السنين في إطار ثقافة ذكورية أي ثقافة من صنع الرجال، فالأعراف والعادات والتقاليد وسلم القيم وتقسيم الأدوار كل ذلك كان من ابتكار الرجال. هم الذين حددوا ما يجوز وما لا يجوز، ما يصح وما لا يصح، ما يليق وما لا يليق، ما هو خير وما هو شر، ما هو حق وما هو باطل. هم الذين حددوا معاني الشرف والشجاعة والوطنية، هم الذين وضعوا القضبان التي تحركت عليها قاطرة البشرية، لكن يبدو أن هذه الثقافة قد وصلت بالقاطرة إلى طريق مسدود، وهي التي أوصلتنا إلى الأزمات التي نعاني ونشكو منها ليل نهار، لذا فلقد أصبح من المهم أن نعيد النظر في هذه الثقافة، وأن ننظر بتعاطف أكثر إلى الثقافة الأنثوية أي التي هي من صنع النساء أو يمكن أن تقدمها لنا المرأة.
لذلك تبلورت في ذهني فكرة تأنيث الثقافة، وأنا أعني بالثقافة هنا أسلوب الحياة ونظام القيم فالمرأة ظلت دائمًا عنصر استقرار وتماسك وترابط لأنها تحمل الحياة بداخلها ثم ترعاها وتتعهدها بالحدب والرعاية، وتاريخ المرأة يكشف لنا عن أنها كانت دائمًا ترمم المشروخ وتصلح المكسور المعطوب، تحنو وتمنح وتضحي، كما تعلمنا منها الجلد والصبر وتحمل الألم. والمرأة في الغالب تؤثر أسرتها على نفسها، في مقابل ثقافة الذكور التي أدخلت إلى حياتنا الغزو والاستيلاء والقتل والقنص والاغتصاب والهيمنة والسيطرة.
وإذا تأملنا إسهامات النساء في الحضارة البشرية حسب ما جاء في دراسات علماء الأنثروبولوجيا والآثار البشرية فسنجد أنهن اخترعن الزراعة، والأواني، والأكواب، والأباريق، وصوامع الغلال، والمخازن، وطواحين الحبوب، وعصارات الفاكهة، وأنوال النسيج، والفرن، والحظيرة، والمنزل. أي أن الاستقرار على الأرض كان اختراعًا نسائيًا، في حين أن الذكور هم الذين اخترعوا الخناجر، والسكاكين، الحراب، والنبال والسيوف، والعجلة الحربية، والمحراث الثقيل، والفخاخ، والبنادق، والمدافع، والدبابات، والطائرات، والغواصات، والفرقاطات الحربية، والقنابل، والصواريخ، والأسلحة الكيماوية والميكروبية، والمدمرات والألغام.
إن ابتكار الزراعة هو أهم طفرة في التاريخ البشري (حتى المائتي عام الأخيرة على الأقل) وهي من ابتكار النساء. والأرجح أنها رفعت مقام النساء في كثير من المجتمعات التي حدثت فيها. وكان ابتكار الزراعة في المراحل الأولى من العصر الحجري الحديث (۸۰۰۰ ق. م / 3000 ق، م) أخطر من استئناس الحيوان. والأرجح أن النساء لم يتراجعن إلى مرتبة ثانوية في المجتمع إلا بعد أن تمكن الرجال مستعينين بحيواناتهم من القيام بمعظم الأعمال الزراعية. لقد خلقت الزراعة أول شكل من “اقتصاد الوفرة” فهي أول اقتصاد يتوفر فيه للناس من الطعام ما يفيض عن حاجتهم. وما كان هذا ليتحقق لولا الادخار والتدبير.
والأمر لم يقتصر على ابتكار الزراعة وحسب بل كانت هناك ابتكارات كبيرة صاحبته، مثل ابتكار آلات الحرث والحصاد وأدوات وأواني التخزين مثل الصوامع، كما ارتبط ذلك بابتكار آلات الدرس والتذرية والطحن ثم تحويل الطحين إلى عصيدة أو إلى خبز، ابتكار التنور والخميرة، كما تبع ذلك اختراع المرأة للمشروبات المخمرة وبالتالي اختراع الأواني التي يتم حفظها فيها. وقد كانت جميع المبتكرات السابقة من عمل النساء، لذا يمكن أن ننسب إلى النساء “فضل الوصول إلى كيمياء صناعة الأواني وفيزياء الغزل وميكانيكا النول وعلم نبات الكتان والقطن“.
وفي حين كانت النساء ترتقين بفن الزراعة بعد عام 8000 ق. م في أودية أنهار الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفي أنحاء من الهند والصين بعد هذا بقليل، كان الرجال يزدادون دراية بالحيوان الوحشي فقد بدأ الرجال يتعلمون تدريجيًا الاحتفاظ بالحيوانات في قطعان يسيطرون عليها، ومن ثم يمكنها أن تتكاثر وهي أسيرة المزرعة، وهكذا نجحوا في ترويض الأغنام والماعز والأبقار والخيل والثيران. ومع عام ٣٠٠٠ ق. م. كانت هذه القطعان تقدم ما يكفي من الطعام لسد حاجات جماعات سكانية أكثر كثافة مما كان في القرى القديمة في العصر الحجري الحديث، والأخطر اهتداء الرجال إلى تسخير بعض هذه الدواب (لاسيما الثيران) في حرث حقول شاسعة في حين كانت النساء من قبل يزرعن مساحات صغيرة باليد.
وما أن اخترع الرجال المحراث الثقيل، وربطوا عالمهم الحيواني بعالم الفلاحة النسائي (وكلاهما حدث في أقدم الأماكن حوالي 3000 ق. م) حتى صار في إمكان البشر لأول مرة إنشاء المدن وتزويدها بما تحتاج إليه، وقد كانت هذه المدن أشد اصطباغًا بالنظام الأبوي، من اصطباغ قرى العصر الحجري الحديث بالنظام الأمومي.
كانت المدن ثمرة اقتران ثقافتين متباينتين، ثقافة الزراع المتأثرة بالروح الأنثوية، وثقافة الرعاة التي هيمن عليها الذكور. وكانت ثقافة المزرعة أكثر ابتكارًا وأشد تعقيدًا من ثقافة المرعى، بل إن حياة الرعاة لم تتقدم كثيرًا عن ثقافة الصيادين في العصر الحجري القديم. فلما اضطرت هاتان الثقافتان إلى التعايش في سلام واتحدتا إلى درجة أصبح من الممكن معها نقل الرعاة ومواشيهم إلى الزراعة وهي المصدر الحقيقي لمكانة النساء؛ أصبح الرجال هم الذين يتولون في العادة مقاليد الأمور. ولم يكن من الممكن أن تصبح القرى مدنا إلا بعد أن بلغت الزراعة درجة من الكفاية تفي بسد حاجة أعداد كثيرة من السكان لا يضطر معظمهم إلى قضاء حياتهم في الحقول.
ولما توسع الرجال في القيام بالأعمال المهمة، فرضوا أنفسهم في المجتمع وهيمنوا على المدن المتنامية، وعدلوا الثقافة على صورتهم، فحلت الأرباب مكان الربات بل إن الآلهة المقترنة بالزراعة صارت مذكرة كأوزوريس في مصر، وباخوس في اليونان على سبيل المثال، بل لقد حلت الآلهة محل ربات الأرض الأم كمصدر للحياة والتكاثر وأصبح “أب السماء في أهمية الأم الأرض“.
ولم تقتصر مهمة النساء بطبيعة الحال على ضمان استمرار الحياة عن طرق جمع الطعام بشكل منتظم وكاف يضمن البقاء، وإنما كن يخرجن الحياة من أحشائهن. ولابد أن سحر الولادة قد مس مشاعر البدائيين إذ تشهد أقدم الفنون البشرية على الأهمية التي شكلتها خصوبة الأنثى في نفوس هؤلاء الصيادين وجامعي الغذاء.
في حين كان الرجال يخرجون في جماعات صغيرة في إثر الحيوانات المتوحشة كانت النساء يجمعن الحبوب والبذور والجوز والفواكه والجذور والبيض واليرقات والحيوانات الصغيرة والحشرات، فعمل النساء كان مطردًا ومنتظمًا، وكان هذا العمل يزود الجماعة بالقوت الضروري ويجنبها المجاعة حتى ولو عاد الرجال بأيد خاوية فيما عدا فترات الأزمات الشديدة. أما عمل الرجال فكان أكثر إثارة، ولكن عائده كان أقل انتظامًا. ومما له أهمية أن المجتمع الذي لا يملك القدرة على توفير طعامه أو تنقصه المعرفة بسبل الاحتفاظ به كان في حاجة إلى النظام اليومي لعمل النساء أكثر من حاجته إلى الترف العرضي الذي تمثله المؤن التي قد يأتي بها الرجال.
ويقول لويس ممفورد: “إن الأمان والتفهم والإحاطة والحضانة كلها كانت من وظائف المرأة، ويجري التعبير عنها تعبيرًا بدائيًا في كل جانب من جوانب القرية، في البيت والفرن، وفي الحظيرة، وصندوق المؤن، في الصهريج وفي المخزن وصومعة الغلال. ثم انتقل منها إلى المدينة في السور والخندق وكل المساحات الداخلية للمباني، من الردهة إلى الرواق المنعزل ثم إلى البيت والقرية، بل إن المدينة ذاتها، في نهاية المطاف، صورة مكبرة من المرأة.
وقد كانت الأدوات والأسلحة في العصر الحجري القديم، كأدوات القطع والشق والحفر والنقب والفصل والتقطيع، تتفق مع الحركات والجهود العضلية، وتتطلب استخدام القوة بسرعة ومن بعد، وباختصار كانت الأدوات تتطلب كل وجوه النشاط العدواني، “فعظام الذكر وعضلاته تتحكم في إسهاماته التقنية، في حين نجد أن أعضاء المرأة الداخلية اللينة مناط حياتها، أما ذراعاها وساقاها فهي تفيد في الحركة على نحو أقل من فائدتها في القبض والضم“.
والأسلحة والأدوات ذات الطابع الرجولي استخدمها الرجال في الصيد وفي تقطيع الأحجار كالرمح والقوس والمطرقة والفأس والسكين. وقد أضيفت إليها أدوات ذات أصل أنثوي تتسم أشكالها بطراز العصر الحجري الحديث مثل أدوات الطحن.
والعملية التي يصنع بها الرجال والنساء “طباعهم” كما يشير تشايلد، لها صلة وثيقة بالأدوات التي يشكلونها لصياغة عوالمهم، فالأدوات تغير صانعيها كما تغير العالم، وكل عالم جديد يتطلب أناسًا مختلفين ذوي قدرات مختلفة وإمكانيات مختلفة. لم يقتصر النظام التكنولوجي في العصر الحجري القديم على خلق نظام اجتماعي يقوم على اليد وجمع الثمار، بل ابتكر أيضًا من المعرفة العلمية ومن الأحاسيس والخرافات والأدوار الجنسية، ما يسند حركة ذلك المجتمع. ومعرفتنا بتلك الطبيعة البشرية في العصر الحجري القديم هي أداة من الأدوات الكثيرة الحديثة التي لدينا لتشكيل أنفسنا.
لذا فمن الآراء الراجحة “أن الآلهة في أقدم المجتمعات البشرية لم تكن أربابًا بل كانت ربات“. وذلك لأن أشد هذه التجارب البشرية سحرًا وغموضًا. وهو منح الحياة، كان من عمل النساء. وهكذا أضفت ربة الخصب القداسة على مخاض المرأة وعلى عملها اليومي الذي لا يتغير: خلق الحياة ورعايتها.
وتذهب الكاتبة الفرنسية الشهيرة سيمون دي بوفوار المدافعة عن حقوق المرأة في كتابها “الجنس الثاني” إلى أن أهم قيمة في مجتمع الصيد الذي كان يقوده الرجال كانت سلب الحياة (عمل الرجال) بدلاً من منحها (عمل النساء) ومعظم هذه الجماعات من الصيادين كونت منتديات ذكورية عدوانية خلقت معتقدات وطقوسًا دينية استبعدت النساء وسيطرت على المجتمع كله“.
ليس هناك ما يحتم علينا أن نتفق مع ما ذهب إليه فرويد من أن الخصائص التشريحية قدر، ولا حتى نتقبل التسليم بالنتيجة التي خلص إليها ممفورد وهي أن “الأمان والتفهم والإحاطة والحضانة” هي من الوظائف الطبيعية للمرأة، فإن النساء كالرجال يدركن أنفسهن بالدرجة الأولى في إطار خصائصهن الجنسية أو في أي إطار آخر (كالعمل أو القرارات الخاصة أو الشخصية أو القومية أو ما إلى ذلك). ولكن الأرجح أن النساء والرجال منذ خمسة آلاف سنة أو عشرة آلاف سنة أو خمس عشرة آلاف سنة كانوا يرون أنفسهم وغيرهم في إطار الجنس في المحل الأول. لقد خلف لنا فنانو العصر الحجري القديم تماثيل نساء ذات ملامح جنسية بارزة، ثم تركوا لنا في مرحلة لاحقة، رسوم الكهوف وبها أشخاص ذووا ملامح جنسية ذكورية بارزة تدل بوضوح على الجنس دون سواه. وإذا كانت مرجريت ميد قد ذكرتنا بأنه لا يوجد ما يدعي بالمقومات “الطبيعية” في شخصيات الرجال والنساء فإن ممفورد يذكرنا بأن معظم النساء كن يعتقدن بوجود مثل هذه المقومات.
فما من مجتمع يحكمه تمامًا الرجال أو النساء، ولا شك أن لكل من الأمهات والآباء بعض النفوذ في كل مجتمع، داخل الأسرة وخارجها، وما من جماعة تستطيع أن تحرم نصف المجتمع (الجنس الآخر) من السلطان والمكانة أو التأثير حرمانًا تامًا، بإن تأثير النساء على الأطفال والأسرة والحياة المنزلية في المجتمعات التي لا تسمح لهن بالعمل خارج البيت لابد أن يكون له تأثيرًا كبيرًا. ولقد وصف بعض الكتاب المجتمع الأمريكي الحديث بأنه مجتمع “أمومي التوجه” نظرًا لأن الناس فيه يكتسبون قيمهم وأفكارهم في طفولتهم، في الوقت الذي يقضي فيه الآباء معظم وقتهم خارج المنزل في عالم العمل “الحقيقي“.
ففي مجتمعنا الذي يتغير كل شئ فيه باستمرار نتوق إلى تكوين صور عن الطبيعة الإنسانية العامة التي لا تتغير. ولكن خبرتنا الحديثة بالتغير دفعت علماء الأنتروبولوجيا إلى اكتشاف أن الناس يتصرفون في إطار “ثقافتهم” الخاصة، وأن في العالم عددًا كبيرًا من الثقافات المختلفة، وأن كل شئ يكاد يكون “طبيعيًا” بالنسبة لأهل إحدى الثقافات في مكان ما في عالم الماضي أو الحاضر. إن دراسة الآثار الإنسانية قد علمتنا أن نرى أن ثمة تغيرات أساسية طرأت على التاريخ الإنساني، فإذا جمعنا بين اكتشاف أهمية الثقافة، والتغيرات الأساسية في التجربة الإنسانية، كان معنى ذلك اكتشافًا للتغير الثقافي في التاريخ الإنساني، وهو تغير يصل مداه – من حقبة إلى أخرى – إلى حد تبدو معه فكرة الطبيعة البشرية فكرة غير صحيحة، وهكذا بدأنا في المائة سنة الأخيرة أو حوالي ذلك نرى أن ما نريد أن نسميه الطبيعة البشرية ما هو إلا نموذج ثقافي خاص من التاريخ البشري.
نحن نعيش في مجتمع يسوده النظام الأبوي إلى حد كبير. والانتساب للأب (أن تتخذ النساء عمومًا لقب آبائهن أو أزواجهن، وقلما يتخذ الرجال اسم أمهاتهم أو زوجاتهم) والإقامة في منزل الأب (فجميع الزوجات يعشن بالقرب من عمل الزوج إن لم يكن مع أسرته) هاتان العادتان من أمارات سيطرة الذكر في المجتمع الحديث، وكلتاهما عادة قديمة جدًا، وكلتاهما ليستا أزليتين. وينبغي أن نفطن إلى أن الاهتمام المفرط بالأنوثة قد لا يكون إلا وجهًا آخر من أوجه استغلال النساء عمومًا وضعفهن الفعلي في المجتمع، وأن ندرك قدرة الرجال على إضفاء غلالة من المثالية على النساء لإبعادهن خارج العالم الحقيقي، عالم العمل وإدارة شئون المجتمع.
تظهر الدراسات الحديثة أيضًا أن النساء هن اللواتي يقمن حقيقة بتلبية النصيب الأكبر من حاجات الأسرة الأساسية نظرًا لأن الرجال في أحوال كثيرة ينفقون الدخل الذين يحصلون عليه على شراء السجائر والمشروبات والمنتجات الاستهلاكية، وبصورة عامة فإن لدى الرجال في اقتصاديات الكفاف مسئولية أقل من النساء بالنسبة للحصول على الطعام وغير ذلك من السلع القاصرة على الاستهلاك المنزلي، وفي حين تعمل المرأة لتأمين الطعام لأطفالها ولأسرتها، فإن الرجل قد يوجه نشاطاته نحو القيام بمشروع تجاري أو السعي لتحقيق اهتمامات لا مجال فيها لزوجته وأطفاله.
وفي معظم أقاليم جنوب الصحراء الكبرى الأفريقية، على سبيل المثال، يقوم الرجال والنساء بزراعة المحاصيل لكن كلا منهم يقوم بذلك لأهداف مختلفة. فالرجال يزرعون المحاصيل المعدة للبيع النقدي ويحتفظون بالدخل الذي يحصلون عليه لأنفسهم، مع أن الزوجات أنفسهن يقمن بجمع العشب وعزق الأرض. والنساء على النقيض من الرجال يستخدمن الأرض أساسًا للمحاصيل التي تؤمن البقاء والعيش لإطعام أسرهن، ويتوقع من النساء كذلك تأمين المأوى والملبس والمصروفات المدرسية والرعاية الطبيعة لأنفسهن ولأطفالهن، وبالتالي فإن عليهن أن يكسبن دخلاً يغطي ما لا يمكنهن إنتاجه أو جمعه من الأراضي العامة في القرية، وإذا أتيح لهؤلاء النساء ما يكفي من الأرض أو المحصول الجيد أو الاثنين معا فإنهن يزرعن ويسوقن المحصول الفائض لكسب بعض النقود، وعندما تكون الأرض محدودة أو تكون التربة فقيرة، فإنهن يقمن بالعمل بأجر أو يصرفن المزيد من الوقت في النشاطات الأخرى التي توفر الدخل.
ليس كل ما في الثقافة الذكورية غير مرغوب فيه، فكما أننا بحاجة إلى ما تتميز به الثقافة الأنثوية مثل الحرص والحيطة والحذر والتدبير والتوفير والادخار والرعاية والحماية وترميم كل ما هو مشروخ أو مكسور أو عدم الميل إلى العنف فنحن بحاجة أيضًا إلى بعض ما في الثقافة الذكورية من ميل إلى المخاطرة والمغامرة والرغبة في الاستكشاف، لكن من المؤكد أن تأنيث الثقافة سوف يدخل إلى أسلوب حياة البشرية ويضيف إلى سلم قيمها بعض ما في الثقافة الأنثوية من قيم تجعل الحياة أفضل وأكثر رحمة وأقل عنفًا وقسوة.
عندما طرحت فكرة تأنيث الثقافة لم أقصد بالتأكيد القول بأن الثقافة الأنثوية هو مكون ثابت عبر الزمان والمكان لا يقبل التعديل أو التغيير ولا يعرف التطور كما لم أقصد من غير شك القول بأن الذكورية هي الأخرى ثابتة في كل زمان ومكان أو هي غير قابلة للتعديل أو التطوير، وإنما كنت أعني أن هناك بعض السمات في الثقافة الأنثوية تختلف عن سمات في الثقافة الذكورية، ولا يرجع ذلك إلى اختلاف في القدرات العقلية التي هي واحدة في الرجل والمرأة وإنما يعود هذا الاختلاف إلى بعض الأدوار التي تقوم بها المرأة وتتميز فيها عن الرجل مثل الحمل والإرضاع والعناية بالطفل في سنواته المبكرة. فحمل الطفل داخل رحم المرأة لمدة تسعة شهور والإحساس بوجوده والحرص عليه ثم عملية ولادته بكل ما يصاحبها من ألم ولذة، ثم عملية احتضانه وضمه وإرضاعه والعناية به تضيف إلى الثقافة الأنثوية سمات الحرص على الحياة لا إزهاقها وسمات الحذر والحيطة وتحمل الألم والنفور من العنف. لذلك نجد أن إسهامات المرأة في الحياة كلها كانت تشير إلى التعمير والترميم والحدب، فاختراع الزراعة وابتكار الأواني والأكواب والأباريق وصوامع الغلال وطواحين الحبوب والحظيرة والردهة والمنزل كلها تشير إلى التعمير والبناء، في حين أن اختراع الذكور لأدوات مثل السكين والخنجر والحراب والنبال والسهام والفخاخ والعجلات الحربية والألغام والقنابل والبنادق والمدافع تدل على الميل إلى الغزو والتحطيم والرغبة في الاستيلاء كما تشير إلى الميل إلى العنف. وعندما طرحت هذه الفكرة فلقد عنيت تخصيب الثقافة الذكورية بثقافة أنثوية، أي ثقافة الغزو والاستيلاء والعنف وإزهاق الحياة بثقافة البناء والتعمير والترميم والحرص على الحياة، وهذه ليست دعوة إلى تكريس التضاد بين الأنوثة والذكورة، أو وضع خطوط فاصلة بين الحيز الخاص والحيز العام على اعتبار أن الأول مجال المرأة والثاني مجال الرجل. وأنا لم أقل في مقالي أن الثقافة الأنثوية والثقافة الذكورية معطيات طبيعية (وإن كانت تتأثر بالاختلافات البيولوجية الواضحة والمحددة) وإنما أرى أن البيئة الاجتماعية والأدوار التي تطلب من الرجال والنساء تؤثر في الثقافتين الذكورية والأنثوية تأثيرًا كبيرًا.
لكن هذا لا يجعلني أغمض عيني عن فروق واضحة ومحددة نلاحظها جميعا في كل المجتمعات، فلا تزال الرياضات العنيفة هي من شأن الرجال على العموم ومن النادر أن نجد النساء يمنحن هذه الرياضات أهمية كبيرة. حتى على مستوى المشاهدة سوف نلاحظ أن جمهور الرياضات العنيفة هو في الغالب من الرجال، ولا أظن أن ذلك يعود إلى الأدوار المرسومة والمقبولة اجتماعيًا لكل من الرجل والمرأة فقط، وإنما تظل الظلال النفسية للفروق البيولوجية ذات تأثير واضح على توجهات وسلوك النساء والرجال، لقد قمت بهذه التجربة بنفسي على بعض تلميذاتي فوجدتهن ينفرن من المصارعة الحرة ومن الملاكمة ومن كمال الأجسام ومن مصارعة الثيران وحتى كرة القدم في بعض الأحيان، مع أنهن لا ينفرن من التنس ومن السباحة ومن الفروسية والكرة الطائرة والجري والقفز وكلها رياضات تخلو من الصراع والاحتكاك البدني.
* أستاذ العلوم السلوكية وعضو لجنة الثقافة والإعلام بالمجلس القومي للمرأة
1 – Betty Frieden, The Feminine Mystique, New York: Dell, 1970
2 – Betty Foszak and Theodor Roszak, Masculine /Feminine, New York: Harper and Row, 1969.
3 – Joseph Campbell, The Masks of God, New York: Viking Press, 1959.
4 – Kevin Reilly, The West and The World: A Topical History of Civilization, New York. Harper and Row, 1980.
5 – Lewis Mumford, The City in History, New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1961.
6 – Margeret Maed, Sex and Temperament in Three Primitive Societies, New York: Dell, 1950.
7 – Robert Briffault, The Mothers, London: Allen and Unwin, 1959.
8 – Simone de Beuvoir, Le Deuxieme Sexe, Paris: Gallimard, 19.