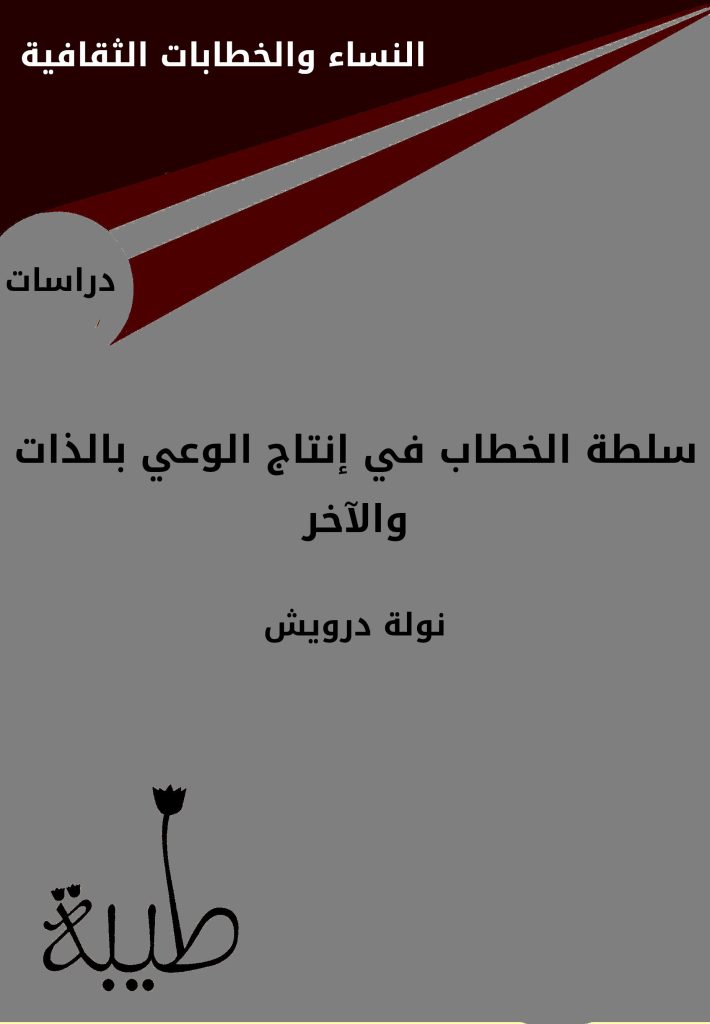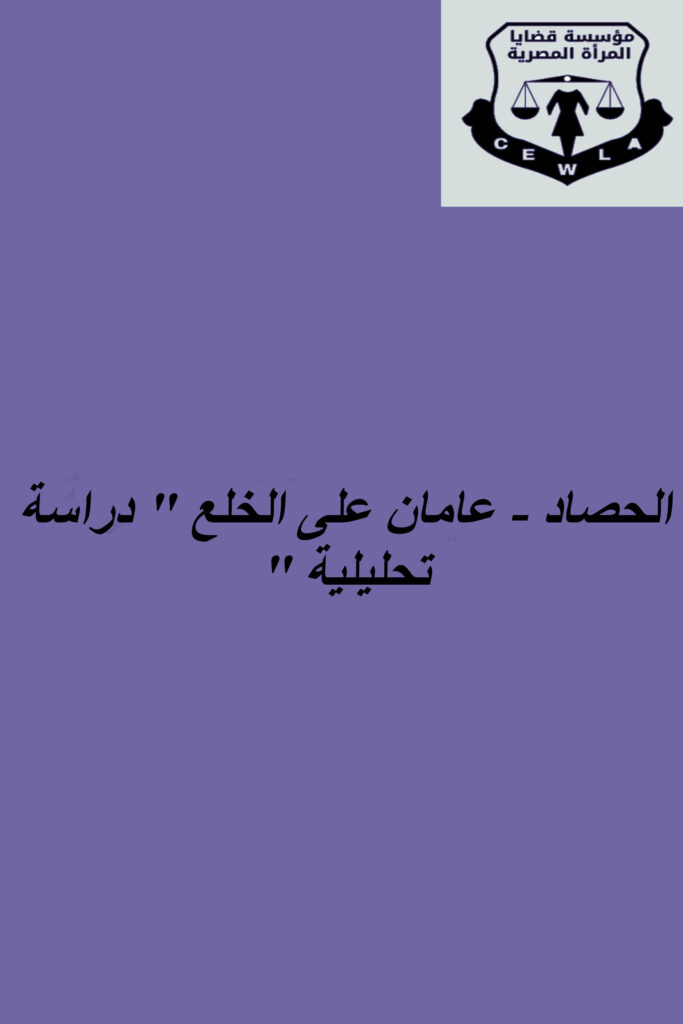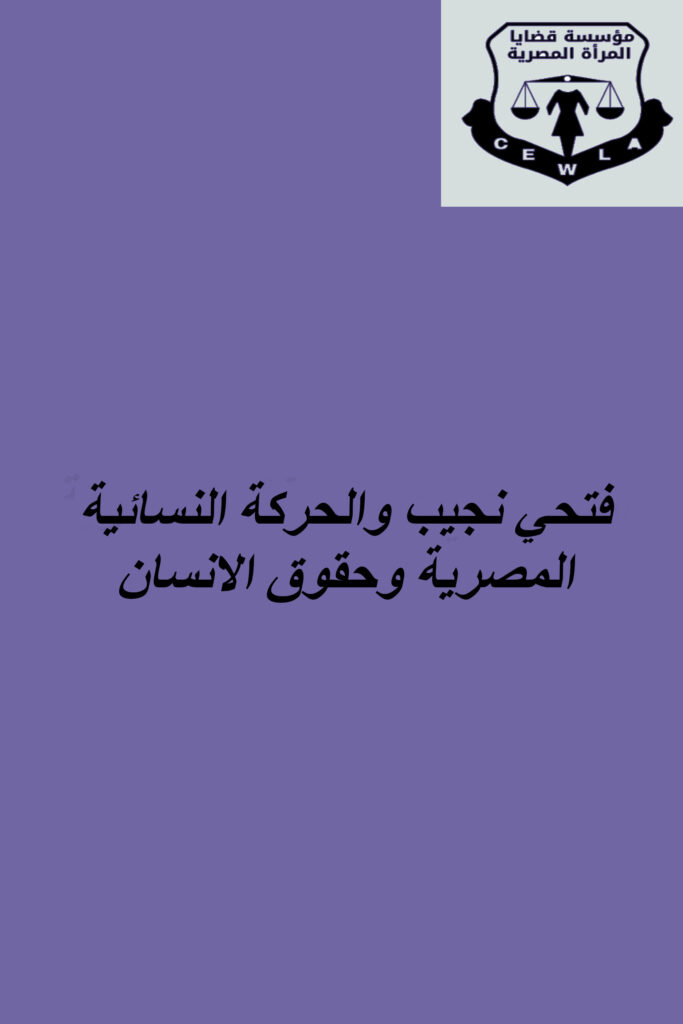سلطة الخطاب في إنتاج الوعي بالذات والآخر
أهمية المقاربة الثقافية
كثيرًا ما ينظر إلى الثقافة على أنها نسق يخص النخبة, لأن هناك اعتقادًا أن الثقافة تتعلق أساسًا بالفلسفة, والفنون, والأدب ؛ وهي نظرة شديدة القصور والانتقائية, بل تتناسى أن الناس العادية هي التي تصنع الثقافة؛ إذ إن ثقافة المجتمع تنعكس – في الواقع – في إجمالي تصرفات أفراد هذا المجتمع في حياتهم اليومية. فهي تترجم في المعارف التي يحملها هؤلاء الأفراد, وفي سلوكهم, واتجاهاتهم, وهي أيضًا ما يشكل التاريخ (أي الماضي), والصيرورة القادمة (أي المستقبل).
وحسب تعريف منظمة الأمم المتحدة للثقافة والتربية (اليونسكو), فإن الثقافة هي“حزمة معقدة من الخصائص الروحية, والمادية, والفكرية, والعاطفية التي تميز مجتمعًا ما أو مجموعة اجتماعية معينة. وهي لا تتعلق فقط بالفنون والآداب, بل تتضمن أيضًا أنماط الحياة, والحقوق الإنسانية الأساسية, ونظم القيم, والتقاليد, والمعتقدات“(1). ويمكن القول, بكلمات أبسط, أن الثقافة قد تتعلق بأنماط الحياة اليومية مثل نوعية الغذاء الذي نضعه على مائدتنا، وطريقتنا في طهى هذا الغذاء، والأواني التي نستعملها للأكل، والعلاقات المتبادلة بين الأفراد الجالسين حول المائدة, والأفراد الذين يقومون بالطهى وتقديم الغذاء لآخرين, وطريقة التصرف في بقايا الطعام, والمناقشات الدائرة أثناء تناول الطعام, والقيم الاجتماعية والأخلاقية التي يحملها أولئك الناس, حيث تتضمن الثقافة الرؤى, والأحلام المستقبلية, والتطلعات الإنسانية بصفة عامة.
إذًا, هل يمكن الحديث عن تنمية اقتصادية واجتماعية دون الاهتمام بالثقافة؟ وبكلمات أخرى, هل ما نصبو إليه هو فقط النمو المادي؟ وهل يمكن أن يحدث هذا النمو المادي, دون التدخل الثقافي؟ فحينما نتطرق إلى موضوع مثل الأمية – وهي ظاهرة واسعة الانتشار في مجتمعنا – كيف يمكننا تناول هذه المسألة دون تحديد ما ينبغي قراءته, وتعلمه, وما الأوليات التي نحددها؟ بل كيف يمكن القضاء على الأمية, دون تحديد ما نريد القضاء عليه؟ إن التنمية القابلة للديمومة – والتي ننادي بها – غير ممكنة, أو قابلة للتحقق, دون توجيه اهتمام خاص بالثقافة. ذلك أن التنمية التي ننشدها تحتاج إلى حدوث تغييرات جذرية تتعلق بإدراك الناس, ووعيهم, وقيمهم, أي ما يرتبط في الصميم بالجوانب المتعلقة بتشكيلهم الثقافي.
كذلك, تولد الثقافة المهيمنة اجتماعيًا أشكالاً من الثقافات الفرعية المرتبطة بها. وعلى سبيل المثال, فإن سيطرة القيم الأبوية داخل المجتمع تؤدى إلى إعادة إنتاج ثقافات التسلط, والطاعة العمياء, والتراتبية, والتبعية, إلخ. كما أن هيمنة الثقافة والقيم الذكورية داخل المجتمع تساهم في تعزيز ثقافة الصمت لدى النساء, وثقافة ممارسة العنف ضدهن, وقبولهن بهذا الأمر وكأنه حدث طبيعي, وثقافة التمييز القائم على النوع, إلخ. ويجب الانتباه هنا إلى أن ثقافة الصمت لدى النساء تقود إلى تشوهات لا تقل خطورة عن آثار الفقر عليهن. فهذا الصمت هو, في الوقت ذاته, سبب للفقر ونتيجة له؛ مما يولد حلقة مفرغة من العلاقات المتبادلة بين الفقر والصمت, لابد من السعى إلى كسرها.
إن معظم البرامج المتعلقة بتنمية الأوضاع الاقتصادية للنساء, وتوفير التعليم لهن, وتفعيل مشاركتهن السياسية, إما نابعة من ثقافة أبوية, غالبًا ما تكون ذكورية, أو أنها تأتى كمحاولة لفرض ثقافة الجهات المانحة, أي أنساق ثقافية مستوردة, غير قابلة للتنفيذ في كل الأحوال. وبالتالي, فهي تحمل في مقاربتها عيوبًا مفاهيمية فيما يتعلق بقضايا النساء. فالمقاربات التي تركز على تغيير الجوانب القانونية, مع تجاهل الموروث الثقافي لا تؤدى إلى تغيير جذري بالنسبة لأحوال أغلبية النساء, أي بالنسبة للكتلة الصامتة الواسعة التي تضم النساء الفقيرات. أما الأنشطة الثقافية التي تطرح التساؤلات حول أوضاع النساء, وقضاياهن, مع الاشتباك في الوقت نفسه مع الثقافة الموجودة, فهى تمثل عنصرًا أساسيًا يمهد الطريق لنهوض النساء.
الإعلام والتشكيل الثقافي:
إن الإعلام مكون أساسي في تشكيل الوعي المجتمعي, وتوجيه اتجاهات الثقافة السائدة اجتماعيًا، خاصة الإعلام المرئي والمسموع، نظرًا لانتشار معدلات الأمية الأبجدية, وتوافر هذا النوع من الإعلام على نطاق واسع, حتى في أفقر الأماكن. ونظرًا للطابع الأبوى الذي يتصف به مجتمعنا, فإن الكلمة المنشورة, أو الخطاب المرئي والمسموع, يحظيان عمومًا بالتصديق لدى المتلقي, نظرًا لغياب الروح النقدية التي لم يتعلم المواطن ممارستها, سواء في المنزل, أو المدرسة, أو الشارع, أو في علاقته بمؤسسات الدولة.
ويخضع عالم اليوم إلى هيمنة ثقافية إعلامية تتدخل بقوة في تشكيل وعي الناس، بل وفي أحيان كثيرة في إفساد هذا الوعي, وتطويعه في اتجاهات تخدم مصالح فئات اجتماعية بعينها, طبقية كانت أو نوعية. وهذا الدور تقوم به أساسًا أجهزة وأدوات إعلامية مصنعة في الغرب, أو منقولة عن النموذج الغربي, فيما عدا بعض الاستثناءات البسيطة التي بدأت تظهر مؤخرًا.
إن أحداث الأيام الأخيرة المتعلقة بالعدوان على العراق, وما يواكبها من تغطية إعلامية واسعة, تشير إلى أن الحروب لا تحسمها فقط المعارك العسكرية, بل أن هناك حربًا تديرها الصور, وطريقة صياغة وعرض الأنباء, والتأثيرات الصوتية المصاحبة لها، والإيحاءات الضمنية الكامنة وراء الكلمات, وتعبيرات الوجوه, أو لغة الجسد بصفة عامة. ذلك أن الكلمة, والصورة, والأوضاع والمواقف الجسدية, ونبرات الأصوات, تؤثر جميعًا في خلق انطباعات تتراكم داخل الوعي, لتشكله في الاتجاهات التي يريدها من يصيغون ويبثون تلك الخطابات. وفي الحالة التي نتحدث عنها – أي حالة العدوان على العراق – لا تكتفي الصور والكلمات بالتأثير في تشكيل التصورات حول مجريات الحرب, واحتمالات النجاح أو الفشل العسكري لدى كل جانب من الجانبين, بل إن إبراز النموذج أحادي الطرف, المهيمن على مقدرات العالم يساهم بدوره في تكريس النزعة الأبوية والرؤية القدرية للنهايات المحتومة. كما لاحظنا أن صورة النساء والأطفال العراقيين في هذه الحرب, كثيرًا ما قدمت على هيئة ضحايا صامتين, مغلوبين على أمرهم، وهو أيضًا ما يساهم في تكريس وعي زائف حول هذه الفئات الاجتماعية.
وبغض النظر عن الحرب الإعلامية المواكبة للغزو العسكري للعراق, يمكننا القول من واقع بعض البحوث والدراسات المصرية والعربية, أن هناك اتجاهًا واضحًا في الإعلام لتأكيد عدد من المفاهيم الخطيرة فيما يتعلق بالنساء, بل في تشكيل وعي ذاتي مغلوط للمرأة. وقد لوحظ من خلال الرصد الدقيق أنه يتم تنميط صورة المرأة في الإعلام على مستويين: يتعلق المستوى الأول بالأدوار المرسومة اجتماعيًا وتقليديًا للنساء؛ فإما تظهر المرأة كأم, أو زوجة, أو ابنة, أو أخت, أو حبيبة. أما إذا حاولت المرأة الخروج عن هذه الأدوار, لتكون مجرد إنسان له وجوده الخاص, وتطلعاته وأحلامه الذاتية، ونجاحاته المستقلة, فعادة ما يتم تناول هذا الخروج عن المألوف بسخرية, أو بطريقة تولد لدى المتلقي إحساسًا باللوم تجاه هذه المرأة, أو حتى بالإدانة لهذا السلوك الذي يخرج عن الأعراف المتوافق عليها. فإذا رغبت امرأة أن تكون“عالمة ذرة“, كان نصيبها التهكم, ولّىْ الموضوع, وتقديمه على هيئة كوميدية, تبدو فيها المرأة بمظهر المجنونة. أما إذا رغب الرجل أن يكون عالم ذرة, فهذا أمر يحمد عليه, وينظر إليه بعين الاستحسان.
أما المستوى الثاني من التنميط, والذي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالمستوى الأول, فهو يتمثل في تقديم أنماط مقولبة للنساء فيما يتعلق بالسلوك, والشكل الخارجي. فإما نرى المرأة الجسد, وهي المرأة التي تمارس الرذيلة, وتعيث في الأرض فسادًا. أو أنها امرأة فاضلة, وأم مثالية, وزوجة مستكينة, غالبًا ما تكون مغلوبة على أمرها, ممتثلة لتوجيهات الرجال المحيطين بها, وتكون راضية بهذا الدور, بل يمكن أن تغالي في تأدية الأدوار التي يتوقعها منها المجتمع الذكوري. أما إذا كانت الصورة التي نراها لامرأة قوية، فغالبًا ما تكون شريرة, جبارة, طاغية, وهي تعيد إنتاج أنماط من الذكورة, أي إنها امرأة“مسترجلة“.
وقد أشارت نتائج أحد الأبحاث التطبيقية(2) التي تناولت العنف الواقع ضد النساء من خلال الدراما التليفزيونية المقدمة في مصر خلال شهر رمضان (1423هـ – 2002م) إلى عدد من النتائج المهمة؛ نشير هنا إلى بعض هذه النتائج: هناك انخفاض ملحوظ في نسبة ظهور الوجوه النسائية مقارنة بالرجال, أي أن نسبة الممثلات تصل إلى ما يقرب نصف نسبة الممثلين؛ هذا بينما تتساوي تقريبًا نسبة الإناث إلى الذكور على صعيد المجتمع, أي في الواقع المعاش. وهو ما يشير – بداية – إلى تهميش الأدوار النسائية.
ويمكن القول أن هذا الاتجاه قد بدأ يتصاعد في السنوات الأخيرة, حيث لم تعد هناك نجمات في السينما المصرية, بل أصبح الأمر يقتصر على النجوم الذكور, الذين قد توضع حولهم بعض الممثلات في أدوار مساندة, لا يؤثر وجودهن أو غيابهن كثيرًا على مجرى الأحداث الدرامية. كما كان ملفتًا أن أيًا من المسلسلات التليفزيونية المرصودة لم تخلو من شكل – على الأقل – من أشكال العنف ؛ وفي هذا السياق تم رصد ممارسة ما يزيد عن خمسمائة حالة عنف ضد النساء من خلال 12 مسلسلاً مرصودًا. وقد توصل هذا البحث إلى نتيجة أخرى ملفتة للنظر, وهي عبارة عن ارتفاع مظاهر عدم المبالاة لدى المجتمع المحيط في مواجهة ظاهرة العنف ضد النساء. إن هذه النتائج تشير كلها إلى رسائل يتم بثها للمجتمع, وتساهم في تكوين رؤيته للأمور. بل إن التوسع في نشر صور العنف بصفة عامة يؤدي – بدوره – إلى تعميق ثقافة العنف, وإباحته اجتماعيًا، ودفع الكبار والصغار إلى ممارسته, وإعادة إنتاجه.
وفي إطار هذه الهيمنة الإعلامية, فإن كل ما يخرج عن المألوف, وعن القواعد الموضوعة اليوم على مستوى العالم, يخضع للبتر, أو التشويه, أو التهميش, أو التحقير, أو حتى الإهمال إلى درجة تؤدي إلى النسيان. وهو ما يحدث إلى درجة أكبر حينما يتعلق الأمر بقضايا النساء. ذلك أن هذا المجال بالذات يرتبط بمجموعة من الآليات الاجتماعية تؤدي إلى إسكات أصوات النساء, وتنفي صلاحية خبراتهن, وتستبعدهن من المشاركة في بلورة الخطاب السياسي بالمعنى العام. ويهدف ذلك التعتيم على الظروف الحقيقية التي تحياها النساء, والظلم الواقع عليهن على أساس النوع؛ فإسكات الناطقات القادرات على بلورة الأفكار, والتعبير عن هموم عموم النساء, هو أفضل طريقة لممارسة الضغوط على الأخريات, وإثارة تخوفهن من المطالبة بحقوقهن.
إن التاريخ هو ذاكرتنا التي تبين لنا من أين أتينا, وكيف تم تشكيلنا, وتعرف مقومات ثقافتنا؛ كما أن قراءة التاريخ هي التي تساعدنا على رسم بعض خطواتنا المستقبلية. إلا إن صياغة التاريخ – كما حدث بالنسبة لوسائل التعبير الأخرى – قد اقتصرت لفترات طويلة على أقلام الرجال, والتي اتسمت – بالإضافة – بالانتقائية الشديدة, مغلبة تاريخ القادة على تاريخ الشعوب, وتاريخ الرجال على تاريخ النساء.
وبالتالي, فقد تم تقديم تاريخ النساء من خلال رؤية ذكورية, تراتبية, مما ساهم بدوره في تشكيل الإدراك العام حول النساء. بل إن كثيرًا ما وصلت إلينا صور الرائدات النسائيات مشوهة بطرق متعددة, تراوحت ما بين التشهير الأخلاقي, والتقليل من الشأن، والإلحاق بأدوار الرجال, وصولاً إلى التجاهل. وتشير إحدى الباحثات(3) إلى أنه“نتيجة لصورة المرأة المشوهة في التاريخ, يتم تكريس فكرة استغلالها لأنوثتها وجمالها للوصول إلى دوائر السلطة“.
إن اكتشاف النساء لتاريخهن الحقيقي يعد في حد ذاته أداة من أدوات تغيير أوضاعهن، وكسر جدار الصمت المفروض عليهن, ورسم معالم ثقافة نسائية جديدة… ثقافة تتطلع إلى التواصل مع الثقافات التقدمية الأخرى الموجودة في المجتمع. كما أن هذا الاكتشاف يعد أداة لطرح ثقافة بديلة في المجتمع… ثقافة تؤمن بالعدالة والمساواة بين البشر, وتستمد أصولها من التاريخ الإنساني للنساء. وهو الأمر الذي انتبهت إليه بعض المجموعات النسائية المصرية في السنوات الأخيرة, فبدأت تبلور مشروعاتها الخاصة في إعادة كتابة التاريخ؛ بهدف“إعادة التوازن المنشود للذاكرة الجماعية التي تم تشويهها بسبب عملية الإقصاء والاستبعاد، التي عانت منها النساء والفئات المهمشة في المجتمع“(4)؛ ولم تكتف هذه المجموعات بتقديم سير النخبة, بل اهتمت بالحكايات البسيطة, و“الحواديت” الشعبية التي تلعب دورًا في تشكيل وعي النشء, وقامت بإعادة كتابتها من منظور نسوي يعيد الأمر إلى نصابها(5).
وفي مواجهة مصادرة تاريخ النساء, بل ومصادرة أصواتهن, وإغلاق قنوات التعبير أمامهن, قررت أربع نساء من بوسطن (أمريكا) في عام 1974 تأسيس مكتبة سميت“كلمات جديدة“, استهدفت نشر وتوزيع كتابات أعدتها نساء, أو كتبت لأجلهن, أو عنهن. وقد برز تساؤل حينذاك: هل يمكن أن يدعم العملاء والقراء مثل هذا المشروع؟ لقد تكاثرت هذه المكتبات منذ السبعينيات, ليس فقط في الولايات المتحدة, بل وفي أقطار أخرى أيضًا, من أوروبا, وأفريقيا, وأمريكا اللاتينية, وآسيا. وقد عملت هذه المكتبات على تشجيع الإبداع النسائي, كما ربطت ما بين هذا الإبداع والحركة النسوية الأوسع(6).
وبدأت تظهر مبادرات مماثلة في المنطقة العربية, نذكر منها على سبيل المثال, لا الحصر, تأسيس“نور – دار المرأة العربية للنشر” في عام 1993″لتوفير من جديد لآراء النساء, وطرح وجهات نظر متعددة حول القضايا التي تهم المرأة العربية ودورها في المجتمع في عالمنا المعاصر“(7) والتي قدمت عددًا من الكتب المهمة التي تعد إضافة حقيقية للمكتبة العربية, وقامت بنشر مجلة فصلية تناولت بالمراجعة, والنقد, أعمالاً أدبية وعلمية, كتبت بأقلام نساء, أو كتبت عن النساء؛ كما نظمت“نور” أول معرض لكتاب المرأة العربية بالقاهرة, في عام 1995, والذي شاركت فيه مجموعة متميزة من المفكرات والمفكرين, وتضمن المعرض ما يزيد عن 5000 عنوانًا حول المرأة العربية، جمعوا من دور نشر مختلفة، عربية وأجنبية.
إن صور المرأة في الكتابة – سواء التاريخية أو الرومانسية – لا تقل تشوهًا أو تهميشًا عن تلك التي تظهر في وسائل الإعلام, وهو الأمر الذي تشير إليه فريدة النقاش في عرضها لأحد الكتب(8), كما أنها الرسالة الضمنية التي تبثها إلينا فاطمة المرنيسي(9). وعلى الرغم من تهميش أصواتهن, وإسهاماتهن, أخذت النساء العربيات في الكتابة. كانت البدايات بأسماء مستعارة, وأحيانًا بأسماء رجال. ثم بدأ صوتهن يعلو، وكتابتهن تتكاثر, وإن كانت ما زالت هناك كاتبات يعدن إنتاج الثقافة الذكورية والتصورات الاجتماعية حول طبيعة النساء, والأدوار الموكلة إليهن. وكثيرًا ما تقابل الكتابات النسائية ذات التوجه النسوي, بالعدوانية, والتحقير, والتهميش, أو الإهمال؛ مما يصعب من وصول هذه الأصوات إلى أوسع جمهور من القراء, وبالتالي القيام بدور مؤثر حقًا في تغيير الوعي المهيمن, في مواجهة الكتابات ذات الطابع الذكوري, أو ذات التوجه السلفي, التي تنادي بعودة المرأة إلى المنزل, وفرض حجاب الرأس والذهن عليها.
يتسم النظام التعليمي في مصر – كما هو الحال في عديد من الأقطار العربية الأخرى، بل في أغلبيتها – بحمل قيم ومعايير تكرس البلادة الذهنية, وتنسف القدرات الإبداعية, وتقتل النظرة النقدية الخلاقة؛ وهذا النظام ينحاز إلى خلق جيوش من الجنود المطيعين, أي من“المواطنين الصالحين“. وقد أدى ذلك إلى محاصرة العقل, وتغذيته بقوالب جامدة من النماذج, تتجه إلى وعي وإدراك الطلاب – وخاصة النشء. لتشكلهما وفقًا لصيغ معدة بدقة, وهو ما تشير إليه إحدى الباحثات:”… لا مجال للإدراك والفهم, وإنما هناك مجال للتخزين, بمعنى حفظ المعلومة في عقل التلميذ على أنها الشيء المسلم به الذي لا شك فيه..”(10) كما يساهم هذا المضمون التعليمي في تأكيد ثقافة المجتمع الهرمي, التراتبي, حيث لا مجال أمام من هم أسفل الهرم – أو أقل مرتبة – إلا الطاعة, والامتثال.
هذا, فيما يتعلق بالتعليم بصفة عامة. أما فيما يتعلق بالصور والأنماط التي يتم تقديمها لكلا الجنسين, فهي – في الواقع – صور تكرس أدوار الجنسين المرسومة اجتماعيًا. فالصبيان هم الذين يقرأون الكتب, أو يجلسون أمام الحاسب الآلى. أما البنات, فإما يلعبن بالدمى, أو يساعدن الأمهات في الأعمال المنزلية, أو يقمن بخدمة الإخوة الذكور. وتقدم النساء البالغات بصفتهن أمهات, أو زوجات, أو بنات, أو أخوات, أي في الحدود الدنيا التي يرتضيها لهن المجتمع. و“يبث المنهج رسائل مباشرة, أو غير مباشرة, عن أحادية دورها في الحياة كأم وزوجة (..) ويحدد أدوار المرأة في أدوار منزلية في إطار الأسرة الحضرية النووية السعيدة, حيث يعمل الرجل, ويكافح خارج المنزل, وتعمل زوجته داخل المنزل على راحة ورفاهية أفراد الأسرة, في روح تضحية سامية, تنكر لها أي شخصية أو كيان خارج إطار هذه الأسرة“(11).. وفي هذا الإطار, وفي اتجاه تعميق هذه الرؤية, تسند إلى المرأة العاملة أدوار تتسق وأدوارها الإنجابية والرعائية؛ فهي, إما معلمة, أو ممرضة, أو سكرتيرة.
وفي حين تقوم الجهات الرسمية بممارسة هذا التمييز ضد النساء, فإن الأدوار التي تقوم بها الأسر لا تقل أهمية؛ فهم الذين يقررون عدم أهمية الاستثمار في تعليم الإناث، وهم الذين يقومون بتحطيم أحلام المبدعات بزعم الحفاظ على قيم الاحتشام, والحفاظ على أسرار العائلات(12). كما تتواكب هنا أهمية الدور الذي يلعبه المعلمون حينما يثنون الفتيات عن الاهتمام بأمور تتعدى المسائل المتعلقة بالإنجاب وبممارسة الأمومة. وهو ما تؤكده مؤشرات التحاق الإناث بالتعليم الجامعي وما بعد الجامعي, خاصة في مجال التخصصات العلمية.
عند التطرق إلى أنثروبولوجية اللغة, يشير نصر حامد أبو زيد(13) إلى الطابع الطائفي والعنصري للخطاب العربي حول المرأة. وهو يبرز القصور في النظر إلى البشر ككتل مصمتة؛ أي النظر إلى إجمالي المرأة كأنها شيء واحد, بدلاً من التوجه إلى تنويعة من النساء, في مواجهة إجمالي الرجال, بدلاً من القبول بتعدد أنماط الرجال. كما يشير إلى دلالات اللغة في تشكيل الوعي الإنساني. وهو الأمر الذي وقعت فيه النساء أنفسهن – في البدايات – عند الحديث عن“قضية المرأة“, بينما يقول الواقع إن هناك“قضايا النساء“, فالمرأة الريفية مختلفة عن المرأة الحضرية, والغنية غير الفقيرة, والمتعلمة تختلف عن الأمية, والمرأة العاملة ليست كربة المنزل, إلخ. ولكل واحدة من هؤلاء النساء أولوياتها وقضاياها.
كذلك, يشير أحد كبار التربويين على مستوى العالم إلى منظومة اللغة/ الفكر في علاقتها الجدلية بالواقع الثقافي والتاريخي, وهو ما يجعل هذه المنظومة (الفكر/ اللغة) تتسم في المجتمعات التابعة بسمات الاغتراب, وهي لا تمتلك فكرًا أصيلاً خاصًا بها، حيث تفترض المجتمعات القائدة – أو الموجهة – أن ما تنتجه من فكر هو الصائب، وينبغي بالتالي أن تقتاد بها المجتمعات“المتشيئة” على حسب تعبيره. هذا نوع من أنواع القهر؛ أما النوع الآخر, فهو ذلك القهر الذي يحدث داخل المجتمع الواحد، والذي تمارسه الطبقات الحاكمة ضد الجماهير. إن ممارسة أشكال القهر المختلفة تولد لدى المقهورين ما يسميه بـ“ثقافة الصمت” (14), الأمر نفسه ينطبق – ليس فقط على النساء – بل على أي فئات مهمشة اجتماعيًا.
لقد ظهرت منذ القرن التاسع عشر في أوروبا إرهاصات لتغيير اللغة المنطوقة, واستخدامات اللغة, للمساهمة في الحفاظ على كيان المرأة؛ وجاءت هذه الجهود على أيدي بعض الناشطات اللاتي طالبن بالاحتفاظ بألقابهن الأصلية بعد الزواج, بدلاً مما كان معمولاً به من تسميتهن بألقاب الأزواج. ولحسن حظنا – كنساء عربيات – أننا نحتفظ بألقابنا الأصلية بعد الزواج, ولكن هذا لا ينفي وجود أشكال أخرى من التمييز اللغوى سوف أشير إليها فيما بعد.
كما اهتمت النسويات بإلقاء نظرة جديدة على مضامين اللغة. ومن هنا بدأت التعديلات تدخل على اللغات الأجنبية المختلفة, وأصبح هناك حرص في الوثائق الدولية على مخاطبة النساء والرجال على حد سواء, وظهرت تعبيرات جديدة تراعى البعد النوعي, مثل Chairperson بدلا من Chairman, وأمثلة أخرى كثيرة.
أما نحن, فإن لغتنا تنفى إمكانية تأنيث الوظائف, والمناصب, فهناك الأستاذ, والعميد, والمستشار, إلخ. ويعتبر الحديث عن المستشارة, أو المديرة, خطأ لغويًا جسيمًا. كما توجد أمثلة لغوية أخرى مرتبطة بالانحياز الذكوري للغة العربية, مثل حالات الجمع. هذا إن تحدثنا فقط فيما تعلق بقواعد اللغة, ونحينا جانبًا الدلالات المتضمنة في بعض التعبيرات, والتشبيهات, أو المفردات المستعملة – عند العامة – في حالة النسب, أو الصفات التي ترتبط تقليديًا بالإناث, وتلك التي تخص الذكور.
وتواجه المطالبة بتطوير اللغة العربية لتواكب مستجدات العصر مقاومة شديدة. وفي الجمود الذي يتسم به مانحو الصكوك لسلامة اللغة, ما يهدد اللغة العربية بالتحول إلى لغة ميتة, على غرار اللاتينية, أو لغات أخرى, انتهى استعمالها اليوم. والواقع أن هذا الجمود لا ينطبق فقط على ما يخص التأنيث, بل هو صحيح أيضًا فيما يتعلق بالتطورات العلمية المختلفة.
إن اللغة – باعتبارها وسيطًا فكريًا – تحتاج إلى عملية إعادة تغذية مستمرة, بل تحتاج أحيانًا إلى إدخال تغييرات“ثورية” عليها. وهذا الدور منوط بالنساء, نظرًا لحاجتهن الملحة إلى هذا التغيير, من جهة. كما أن النساء – بحكم تطلعاتهن إلى العدالة, والمساواة – أكثر ثورية من قطاعات أخرى. ذلك أن الجرأة على التغيير على مستوى اللغة سوف تصحبه بالضرورة التجرؤ على محاولة التغيير في مجالات أخرى, لأن خوض النضال في هذا المجال سيكشف أمام ملايين النساء التمييز الذي يمارس ضدهن، في أبسط صوره, أقلها وضوحًا على مستوى الإدراك.
إن إحدى وسائل الضغط على النساء تتمثل في منحهن دور الحارسات للتقاليد. إن تحمل النساء – وخاصة بصفتهن أمهات – لهذا الدور, وهذه المسئولية, يولد لديهن الإحساس بالاندماج في المجتمع, أي بالقبول؛ كما ينمي لديهن إحساسًا بالأهمية. وهو عند الكثير منهن وسيلة لممارسة سلطة ما, طالما منعن من ممارستها في مجالات أخرى, ومجالاً لتبرير وجودهن ذاته. فهن موكلات بدور يضفى لهن الاعتبار, ولابد إذًا من القيام بهذا الدور بأي ثمن, وهو ما يترجم أحيانًا في صور من العنف والاستبداد تجاه النساء الأخريات.
وتترجم العادات والتقاليد في ممارسات وسلوكيات معينة, أملتها علينا معتقدات, وأقوال مأثورة, وثوابت ورثتها إلينا أجيال سابقة. والواقع, أنه على الرغم من هذا التوكيل للنساء بحراسة التقاليد والأعراف, إلا أن تلك الموروثات نابعة في مجتمعنا بالأساس من فكر ذكورى, يعلى من شأن الذكور, ويعمل على الهيمنة على أجساد وعقول النساء, كما يكرس التمييز بين النوعين, ويتسامح أمام أشكال من الانتهاكات الموجهة ضد النساء. فباسم التقاليد, تنتهك أجساد الإناث, من خلال ممارسة عادة ختان الإناث التي لا تستند إلى دين أو علم, وهو ما يؤكده الواقع المصرى, الذي تمارس فيه هذه العادة مع المسيحيات أسوة بالمسلمات؛ وهي ممارسة تستهدف السيطرة على مع أجساد النساء, لا تختلف كثيرًا عن“حزام العفة“, الذي كان يستعمل في القرون الوسطى في أوروبا, لضمان عذرية النساء. وقد اقترنت هذه الممارسة باسم“الطهارة” في اللغة الدارجة المصرية, مما يشير هنا أيضًا إلى دلالات اللغة, والاتجاهات التي يصاغ بها وعي وفكر الناس.
كما تمنع العادات والتقاليد النساء من المبادرة في التصريح للرجل بالحب, لأن هذا يعتبر“فجراً” ويبعدنا عن صورة المرأة“الحشمة“, التي يجب أن تظل في وضع الانتظار السلبي, حتى يتفضل الرجل باختيارها. وفي ذلك ما لا يقتصر على تشكيل صورة المرأة لذاتها, والسلوك الذي ينبغي عليها الالتزام به, بل يضع على الرجال أعباء المسئوليات التي يتصورون أنها مرتبطة بأدوارهم كذكور, في علاقتها بتصوراتهم حول النساء والأنوثة. فهذا ما يجعل بعض الرجال, على سبيل المثال, يعرّفون الرجولة على أنها الذكورة, والقدرة الجنسية, أو أنها“عبارة عن مظهر, فيجب أن يكون الرجل قويًا جنسيًا, له صدر عريض, ولحية, وشعر على الصدر والوجه“, بينما يتوقعون أن ما يجذب النساء عند الرجال هو“الرجل الخشن من حيث السلوك, (أو) الرجل القوى من حيث الطباع, (أو) المظهر الخارجي, (أو) القدرة المادية“(15)
كذلك, تمنع العادات والتقاليد – وليس القانون – النساء الريفيات من الحصول على ميراثهن من الأرض, لأن هذا معناه أن الأرض ستذهب إلى رجل غريب, ربما من خارج القبيلة. وعلى الرغم أن القانون برىء في هذه الحالة, إلا أنه ليس بريئًا في أحوال أخرى كثيرة. ولكن هذه نقطة أخرى – تخص هي أيضًا التشكيل الثقافي –ولكنني لن أتطرق إليها, لوجود أخريات أقدر منى على ذلك.
ويتضمن الموروث الثقافي فكرة أن الرجال لا يبكون, فهذا يتنافى مع رجولتهم؛ وهو ما يدفع عديد من الأمهات إلى نهر أطفالهن الذكور حينما يبكون, مما يجعل كثير من الرجال يمتنعون عن البكاء طوال حياتهم, ويحرمهم بالتالي من أحد أشكال التعبير الإنساني
وحول صورة المرأة في الأمثال الشعبية, يقول أحد الكتاب (16) إن الأمثال الشعبية“… بطبيعتها كإبداع ثقافي إنساني هي محاولة فكرية لتجريد الواقع إلى مطلق لإظهار المضمون من خلال مقولة محددة“. وهي لا تكتفى بوصف الواقع, بل تقدم السلوك الواجب اتباعه. وانطلاقًا من هذه الرؤية, يقوم بتحليل مضمون تلك الرسائل المتضمنة في الأمثال الشعبية المصرية حول المرأة, ويخلص إلى أن هناك ما يثبت في أذهان المرأة المصرية المعاصرة, منذ نشأتها, أنها تقوم بأدوار ثانوية ومساعدة في الحياة, بل إن هناك نظرة سائدة تكرس دونية النساء, وتبعيتهن للرجال. وإذا ما نظرنا إلى بعض هذه الأمثال الشعبية, سنجدها في الرسائل التي تبثها – هي الأخرى – إلينا. ومنها على سبيل المثال, لا الحصر:”الولد للكفن, والبنت للعفن“, و“اكسر للبنت ضلع يطلع لها 24 ضلع“, وأمثلة أخرى كثيرة تؤكد إعلاء شأن الرجال, والتقليل من قيمة النساء.
لا يبدو التدخل على مستوى الثقافة صنفًا من صنوف الترف؛ بل إن الترف هو بالذات ترك الأمور على ما هي عليه؛ ففي استمرار النظرة الحالية لأدوار النوعين, ما يؤذيهما معًا. إن إعادة صياغة هذه الأدوار عملية يمليها التاريخ, ليس فقط من منظور التطور التاريخي, بل أساسًا من منظور الاحتياج الحتمي, والمصيري, للتخلص من الأفكار والمعتقدات البالية والمغلوطة, التي تمنعنا من الانطلاق لبناء مجتمع يستطيع أن يعيش فيه الإنسان بكرامة.
قد يقول البعض إن أصالتنا تتمثل في التمسك بثقافتنا, ولكن الثقافة – بالمعنى الذي أشرنا إليه سابقًا – ليست أمرًا جامدًا, أو كتلة مصمتة, غير قابلة للتطور. كما أننا نرحب بالجوانب المضيئة الموجودة في ثقافتنا, والتي ساهمت في تشكيل عدد من الصفات الجميلة التي يتميز بها الشعب المصرى؛ ولكننا نرفض السلوكيات، والمعتقدات، التي تكرس التمييز ضد النساء, وممارسة العنف ضدهن, وتهميش أدوارهن، وإقصائهن من الحياة العامة, وتهميش وجودهن في الحياة الخاصة, وتقليصه إلى أدوار مساندة؛ بالضبط كما نرفض العادات التي تدفع المواطنين إلى إلقاء القاذورات في الطرقات العامة, أو التي تجعل الآباء يعتقدون أن أفضل أسلوب لتربية أطفالهم هو الضرب.
وعودة إلى المثال المقدم في بداية هذه الورقة للترميز عن الثقافة, فإن الثقافة التي نتطلع إليها هي تلك التي تجعل جميع أفراد الأسرة يتعاونون في شراء الطعام, وإعداده, ويجلسون سويًا حول الطاولة نفسها, ويستمعون إلى بعضهم البعض, ويتعلمون من بعضهم البعض, ويستمتعون بالموسيقى الراقية, ويشاهدون الأفلام الجميلة, ويحترمون الإنسانية كقيمة توجه سلوكياتهم, وفكرهم, ونظرتهم للذات وللآخر.
نولة درويش: عضوة مؤسسة بمؤسسة المرأة الجديدة.
(1) World Conference on Cultural Policies, Mexico City, hggp://www.unesco.org/ culture/development: 1982.
(2) لمزيد من التفاصيل, يمكن الرجوع إلى مشروع“الراصد الإعلامي للدراما التليفزيونية” الذي قام به مركز دراسات المرأة الجديدة.
(3) شيرين أبو النجا: الآليات الثقافية التي تمنع تقدم المرأة في مصر, في المرأة والقانون والتنمية, مركز دراسات المرأة الجديدة, القاهرة, 1997.
(4) هدى الصدة, رسائل الذاكرة, العدد صفر, يناير 1998, ملتقى المرأة والذاكرة, القاهرة.
(5) لمزيد من التفاصيل, يمكن الرجع إلى مقال منى إبراهيم حول“جدليات المقاومة والتمكين“, مجلة طيبة, العدد الثاني يناير 2003.
(6) Estelle B. Freedman, No Turning Back, Ballantine Books, New York, 2002.
(7) نشرة تأسيس نور – دار المرأة العربية.
(8) فريدة النقاش, حدائق النساء (في نقد الأصولية)، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، القاهرة, 2002 ، ص ص 129 -132.
(9) فاطمة المرنيسى, السلطانات المنسيات, دار الحصاد للنشر, دمشق, 1994. (10) ملك رشدي, الصورة الاجتماعية للمرأة في التعليم الابتدائي المصرى, المعرض الأول لكتاب المرأة العربية في مواجهة العصر, نور – دار المرأة العربية للنشر, القاهرة, 1996.
(11) هند واصف,”صورة المرأة في مناهج التعليم للمرحلتين الإعدادية والثانوية“, ورقة غير منشورة, 1995.
(12) لمزيد من التفاصيل، يمكن الرجوع إلى مشروع“مبدعات في الظل” الذي قام به مركز دراسات المرأة الجديدة. تشير إحدى الشهادات من أسوان: وقد بدأت معوقات الإبداع عندي من المنزل لاعتقادهم أن كتابتي للشعر تؤثر على دراستي, وكذلك ففي الصيف تزيد الأعباء المنزلية, ويكون هناك رفض تام للتعامل مع الأوراق والأقلام, وكأنه عقاب الأجازة.
(13) نصر حامد أبو زيد: دوار الخوف.. قراءة في خطاب المرأة, المركز الثقافي العربي, الدار البيضاء, الطبعة الثانية, 2000, ص من 29 -51.
(14) باولو فريرى, الفعل الثقافي في سبيل الحرية, ترجمة إبراهيم الكرداوي, مركز الدراسات والمعلومات القانونية لحقوق الإنسان, القاهرة, 1995, ص ص 25- 30.
(15) نادية واصف وعبد الله منصور, البحث في أنماط الذكورة, وختان الإناث في مصر, المركز الوطني لمساندة المنظمات الأهلية للسكان والتنمية, القاهرة, 1999, ص ص 195 -201
(16) صفوت كمال: صورة المرأة في الحياة اليومية من خلال الأمثال الشعبية, في هاجر: كتاب المرأة, دار سينا للنشر, العدد الأول, 1993, ص ص 21- 27.